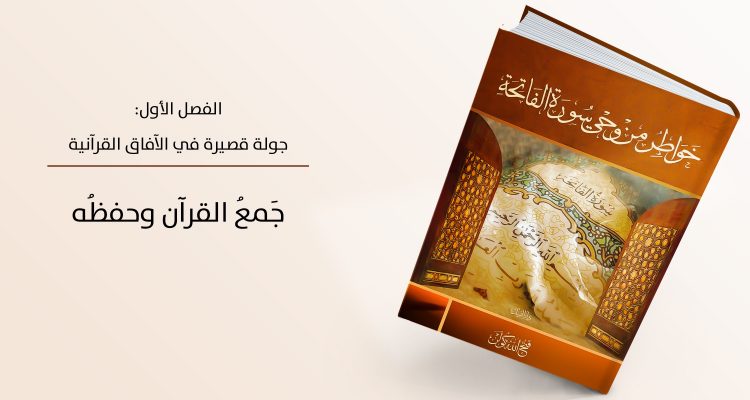إن الصحابة الكرام و التابعين العظام كانوا يقطعون المفاوز والقفار في سبيل تَجْلِيَةِ حقيقةٍ واحدةٍ من حقائق القرآن؛ وفي هذا الخصوص يَروي الإمام الشعبي حادثةً من سِيرةِ مسروق بن الأَجْدَع؛ يقول:
“ما رأيتُ أَحَدًا أَطْلَبَ للعلم في أُفُقٍ من الْآفَاق من مَسْروقٍ، خرج مسروق إلى البصرة إلى رجلٍ يسأله عن آيةٍ، فلم يجد عنده فيها علمًا فأخبره عن رجل من أهل الشام فقدم علينا هاهنا ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها”[1].
فهيا نفكر قليلا: إنَّ عملاقًا مِثلَ مسروق يَجُوبُ المَهامِهَ والبواديَ، في ظروف تَشقُّ فيها الأسفارُ، ويَقطع المسافرُ بحارًا من الرِّمال، ولا توجد فيها مِن وسائل النقلِ السريعةِ إلا الخيلَ والآبالَ… ولكنه يخاطر ويتحمّلُ كلَّ ذلك حتى يتعلمَ تفسير آيةٍ من كتاب الله غيرَ مبالٍ بما قد يتعرَّضُ له من المهالك والأهوالِ، ومع ذلك حينما لا يجدُ ما يطلبه لا يستنكف من أن يستأنف الرحلة ثانية بكلِّ عزيمةٍ وراحةِ بال.
وها هو المفسر الكبير عِكْرِمة تلميذُ ابن عباس رضي الله عنهما ومولاه، يقول:
“طلبتُ اسمَ الرجل المعنيّ بقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ﴾ أربع عشرة سنة حتى وجدتُه”[2].
ولا شك أن السبب في بذلِ سيدنا عكرمة كلَّ هذا الجهد في البحث عن اسم هذا الشخص طوالَ هذه المدة هو أن العثور عليه والتعرّفَ على طبيعته وموقعِه الاجتماعي سيُلقي الضوء على تفسير الآية الكريمة.
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: مكثتُ سنةً أريد أن أسأل عمرَ بن الخطاب عن آيةٍ، فما أستطيع أن أسأله هيبةً له، حتى خرج حاجًّا فخرجتُ معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفتُ له حتى فرغ ثم سِرتُ معه، فقلتُ:
“يا أمير المؤمنين مَن اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه (أي اللتين تعنيهما الآية الكريمة: ﴿إِنْ تَتُوبَۤا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلٰيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (سورة التَّحْرِيمِ: 66/4)؟”.
فقال: “تلك حفصة وعائشة”.فقلت: “والله إن كنتُ لَأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك”.
قال: “فلا تفعلْ، ما ظننتَ أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علمٌ خبَّرتُك به”[3].
وهناك آلاف من الأمثلة يمكن سردها على هذا المنوال؛ فالصحابة والتابعون كانوا يكِدُّون في سبيل الكشف عن حقيقة قرآنيّة واحدة، ويَقْضُون في ذلك أيامًا بل أسابيع وشهورًا وسنين… لا يعرفون كللًا ولا مللًا.
إن القرآن الكريم نزلمنجّمًا على ثلاثة وعشرين عامًا، وطوالَ نزولِهِ كان يُكتب إمَّا على العُسب وقِطع الأحجار أو العظام، أو جريد النخل، أو الرقاعِ حسب الإمكانات الضئيلة لتلك الحقبة، وكذلك كان في تلك الفترة عدد غيرُ قليل من الذين يستظهرون القرآن كاملًا، لأنهم كانوا يحفظون كلَّ آية من القرآن فورَ نزولِها؛ فقد كان ابن مسعود وزيد بن ثابت وأُبَيّ بن كعب وسيدنا عثمان ومئات غيرهم قد حفظوا القرآن كاملًا عن ظهرِ قلب، وكان للنبيّ كُتَّاب يكتبون الوحيَ، فكان إذا أنزلت عليه الآية أو الآيات دعا بعض كُتَّابه، فأملى عليه ما نزل، فكتب بين يديه، وكان يأمرهم بوضع الآيات في مواضعها المخصوصة من سُوَرِها، فهم بِدَورِهِم كانوا يضعونَها موضعَها ويحفظون القرآنَ على هذا الترتيب، فكانَ ترتيبُ السور أيضًا من الأمور التوقيفيّة التي تمّت بالوحي.
ولما استُشهد في واقعة “اليمامة” عددٌ كبيرٌ من القرَّاء؛ قَلِقَ سيدنا عمر رضي الله عنه قلقًا شديدًا فقال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه:
“إنّ القَتل قد استحرَّ -أي اشتدَّ وكَثُرَ- يومَ اليَمامة بقُرَّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحرَّ القتلُ بالقرّاء بالمَواطن، فيذهبَ كثيرٌ من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني أرى أن تأمرَ بجمعِ القرآن”.
أما أبو بكر t فقد كانت فرائصه ترتعد تجاه هذا الأمر البالغ الحساسيّة، فهو الذي سبقَ له أن قال: “أيُّ سماءٍ تُظِلُّني وأيُّ أرضٍ تُقِلُّني إن قلتُ في كتاب الله ما لا أعلم”[4]. نعم لقد ارتبكَ الصِّدِّيق أمام هذا الاقتراح، وزأرَ مثل الأسد الهصورِ قائلًا: “كيف تفعلُ شيئًا لم يفعله رسولُ الله r؟”.
ولكن سيدنا عمر شرحَ له بالتفصيل مدى حساسيّة هذا الأمر وأهمّيّتِه مما دفعَ بسيدنا أبي بكر إلى أن يقول: “فلم يزل عمرُ يراجعني حتى شرح اللهُ صدري لذلك، ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمرُ”، أي إن عمرَ مصيبٌ في هذا الأمر؛ فلا بدَّ مِن جمعِ ما تفرَّق من صحف القرآن بين دفّتي مصحف وعلى هيئة كتاب.
ولكن من ذا الذي كان سينهض بهذه المهمّة!؟
تذاكرا وفكَّرا في الأمرِ مليًّا، إلى أن اجتمع رأيهما على زيد بن ثابت، حيث كان من الذين يَثِقُ رسول الله r بحفظهم وضبطِهم للقرآن، يقول زيدٌ رضي الله عنه:
قال لي أبو بكر: إن عمرَ أتاني فقال: إن القتلَ قد استحرَّ يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بالقرّاء في المواطن، فيذهبَ كثيرٌ من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تَجمع القرآنَ، فقلتُ لِعُمَر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله؟ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدري، ورأيتُ الذي رأى عمر، إنك (يا زيد) رجلٌ شابٌّ عاقل ولا نتّهمك، كنتَ تكتبُ الوحيَ لرسول الله، فتَتَبَّعِ القرآنَ فاجمعْه.
يقول زيد: فوالله لو كلَّفَنِي نقلَ جبلٍ من الجبالِ ما كانَ أثقلَ عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلتُ: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزلْ أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرحَ الله له صدرَ أبي بكر وعمر، ورأيتُ في الذي رأيا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَنْسَخُهُ مِنَ الصُّحُفِ وَالْعُسُبِ وَاللِّخَافِ (الحجارة الرِّقاق) وَصُدُورِ الرِّجَالِ[5].
وكذا فقد جُمِعَ كلُّ ما كان متفرِّقًا من القرآن، وتمَّ هذا تحت إشراف سيدنا أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فحصلَ الإجماع على القرآن الذي جُمِعَ على شكلِ كتاب.
وفي عهد سيدنا عثمان ظهر نزاعٌ سبَبُهُ اختلافُ وجوه القراءات، فقد روي عن رسول الله “إِنَّ هٰذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ”[6]، فمهما كان المقصود بـ”سبعة أحرف” -على اختلاف ما قيل فيها- فقراءة القرآن بأشكال مختلفة أدَّى إلى حدوثِ خلافٍ بين المسلِمِين.
يقول أنسُ بن مالك رضي الله عنه:
إن حذيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان وكان يغازي أهلَ الشأم في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأَفزع حذيفةَ اختلافُهم في القراءة، فقال حذيفةُ لعثمان: “يا أمير المؤمنين، أَدْرِكْ هذه الأُمَّةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود والنصارى”، فأَرسلَ عثمانُ إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: أنْ أَرسِلي إلينا بالصُّحُف نَنسخها في المصاحف ثم نردَها إليك، فأَرسلتْ بها حفصةُ إلى عثمان، فأَمر عثمانُ زيدَ بن ثابت، وعبدَ الله بن الزبير، وسعيدَ بن العاص، وعبدَ الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمانُ للرهط القرشيِّين الثلاثة: “إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم”، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردَّ عثمانُ الصُّحفَ إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف، أن يُحرق[7].
فما زال القرآن محفوظا إلى يومنا هذا بالرسمِ العثماني الذي أُقِرَّ في عهدِ عثمان رضي الله عنه طبقًا للأصل الذي أُخِذَ منه… والواقع أن الله تعالى هو الذي تولَّى حفظه كما بيَّن ذلك في قوله الكريم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/9)، وسيحفظه إلى يوم القيامة، وإذا نحن رعيناه وتولَّيناه فسنكون نحن وسائل حفظه، وبذلك ستتنوَّرُ بيوتُنا وبلادُنا بنورِهِ.
نعم، إننا إذا اتخذناه تاجًا ورفعناه فوقَ هاماتِنا، فسنرتقي إلى مستوى نكون فيه التيجانَ على رؤوس الإنسانية.
[1] أبو نعيم: حلية الأولياء، 2/95.
[2] القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 1/26؛ أبو حيان: البحر المحيط، 4/44.
[3] صحيح البخاري، تفسير القرآن، تفسير سورة التحريم، 2؛ صحيح مسلم، الطلاق، 31.
[4] موطأ الإمام مالك، الجامع، 70.
[5] صحيح البخاري، فضائل القرآن، 3
[6] صحيح البخاري، فضائل القرآن، 27، الخصومات، 4، التوحيد، 53؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، 270.
[7] صحيح البخاري، فضائل القرآن، 3.