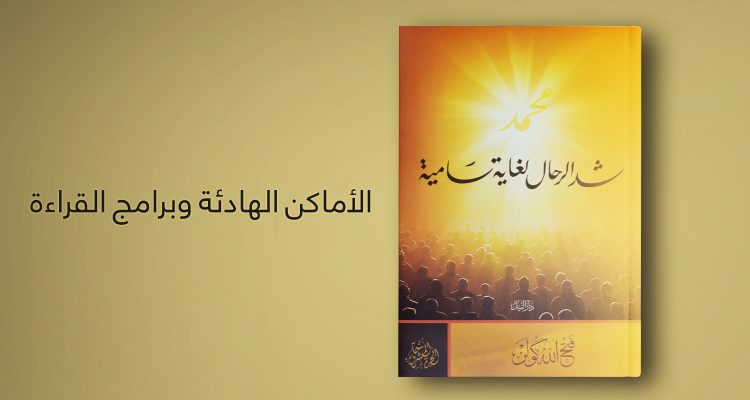سؤال: إن الإنسان المعاصر يضيق صدره في خضم أنواع وأنواع من ضوضاء الحياة ومشاغلها اليومية، فكلما وجد الفرصة سانحة بحث عن مكان هادئ وشرْم منعزل، وإنّ القلوب المؤمنة لَترغب في الاستفادة من تلك الأماكن الهادئة من أجل حياة القلب والروح؛ فما الأمور التي يجب الانتباه إليها حتى نستطيع الاستفادة الكاملة من برامج هدفُها تحقيقُ هذه الغايةِ؟
الجواب: لكلٍّ منّا مجموعة من الوظائف في الحياة الاجتماعية يجب عليه أداؤها؛ والواقع أن على المؤمن أن يُخالِط الناسَ ويتعايش معهم إن كان يريد نفعهم وتوجيهَهم إلى أفق معين، وإرواءَ أراوحهم بما لديه من قِيَم؛ أجل، على من يؤمن بالله وباليوم الآخر إيمانًا حقيقيًّا أن يخالط الناس وأن يكون كبوصلة القبلة يرشد من حوله إلى قبلة الحق والحقيقة دائمًا، يقول مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم: “اَلْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ”[1]؛ ولهذا أرى أن العزلة الدائمة والخلوة المستمرة معناهما التنصل من المجتمع ومن الوظائف الاجتماعية، فأظن بناءً على هذا أن من يهرب من تلك الوظائف يأثم، حتى وإن كانت عزلته لنيل الكمالات والفيوضات الشخصية؛ لأن الأصل في الإسلام هو مصاحبة الحقّ بين الخلق، والسعي لخدمة الإنسانية.
نعم، إننا نواجه ما نكره خلال مخالطة الناس لتحقيق غاية عُلوية؛ حتى إننا قد نمشي في الوحل بلا قصد فتتلوث ملابسنا من باب عموم البلوى؛ أجل، قد تتلوث عيوننا ونحن في الحياة الاجتماعية، وتتدفق الشوائب إلى آذاننا دون أن ندرك، فيتعكر عالمنا الداخلي بعدة ملوِّثات.
ومن يصبر على كل هذه السلبيات في سبيل غاية مثالية سامية يحتاج أحيانًا إلى العزلة في مكانٍ نقيّ يستنشق فيه الأُكسجين حتى يستوفي حاجته منه، ويستعيد طاقته هناك ليتنقَّى مما علِق به من أوساخ، ويطَّرِح ما أصابه من القذر؛ وأعتقد بأن برامج المذاكرة والقراءة في إطار غاية كهذه تعدّ من ضروب العبادة.
ثمة أمر يتعيّن الانتباه إليه في هذه النقطة: تلك الأماكن الهادئة والشروم المنعزلة التي يتطلب الوصول إليها تكبُّدَ مشاقَّ ونفقات كثيرة ينبغي أن يُستفاد منها، وأن لا تُضيع منها لحظة واحدة، وأن تُعمر بفعاليات القراءة المنتظمة، وتُحيا بالأوراد والأذكار؛ أجل، يجب أن تُؤلَّف سمفونيات وجوقات موسيقية من الأذكار والتسبيحات التي تتفجر من القلوب وتهزّ الأرض والسماء، حتى يهمّ سُكّان الملإ الأعلى بالمشاركة فيها.
مناخٌ منفتحٌ على الرُّوحانيّات
في مخيمات القراءة القديمة التي تُقام في أشهر الصيف كان الأصدقاء ينزوون ليلًا هنا وهنالك يتلون القرآن ويبتهلون بالأدعية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفسي؛ ويقرؤون في هذه المخيمات 200-300 صفحة يوميًّا حول الحقائق الإيمانية، ويتذاكرون موضوعات شتّى.
والحياة في هذه المخيمات متواضعة جدًّا، فهم يرقدون على الأرض فوق حصير، وأنا الفقير أطهو الطعام وأقدمه لهم.
وذات يوم زارنا شخص مرموق، فلما رأى ما يجري في ظل هذه الظروف العسِرة قال: “لا أظن أن في الأرض الآن مكانًا تسوده الروحانية كهذا المكان”، ثم عاود المجيء في العام التالي.
وعلينا في هذه الأجواء النقيّة أن نحاسب أنفسنا ونرصد تقصيرنا في أعمال الخدمة، وأن نحسب المسافة بين ما نحن عليه وما ينبغي أن نصل إليه، وأن نتخلى عن اللذات، ونتجرد من الحيوانية، ونطرح القاذورات البشرية جانبًا، ونعزم السفر على مِحْوَر حياة الروح، ونسعى للانفتاح على الروحانيات.
وأنوّه هنا بأمر مهم:
كنت أفكر في أيام المخيمات أن أوصي إخواني بمائة ركعة كل ليلة، ثم خشيت أن يكون هذا تكليفًا بما لا طاقة لهم به، لكن من ينظر في سيرة العظماء يجدهم يصلّون مائة ركعة كل ليلة حتى في طفولتهم.
فعلى من شهد مثل هذه المخيمات والبرامج أن يصلّي مائة ركعة كل ليلة إن أمكن، وأن يستغلّ تلك الليالي التي تفيض بالأسرار والأحزان بالدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والأذكار.
مؤلَّفاتٌ مألوفة غلبت عليها الإلفة
لو أن أهل المخيم قرؤوا 300 صفحة يوميًّا؛ حتى يتسنى لهم حسن الاستفادة من برامج الاسترواح التي يمكن تسميتها “العزلة المؤقتة”، فإذا كان البرنامج 15 يومًا، فسيقرأ الفرد 4500 صفحة؛ فإن قام بذلك البرنامج مرتين سنويًّا قرأ عددًا كبيرًا من الكتب التي تبحث في قِيَمنا الذاتية.
ومن المفيد جدًّا التخلص من الرتابة، والاشتغالُ بالقراءة المقارنة بين هذه المؤلفات النفيسة والمؤلفات الأخرى؛ وتحققُ هذا بالطبع رهنٌ بموافقتهم جميعًا.
وهذا الأمر سيُجهِد مَن لهم الريادة في عالم القراءة والمذاكرة حتى يأتي يوم نتخلص فيه من الإلف والطرز القديم للقراءة.
وليُعلَم أن الناس يتشكلون تبعًا لرُوّادهم، فإن عُني الرُّوّاد بهذا الأمر وألحّوا على تطبيقه تأسَّى بهم الأتباع؛ فيا للأسف لقد استولت علينا وأسَرَتْنا حالة عقيمة، إنها القراءة العابرة لهذه المؤلفات القيّمة، والمرورُ عليها مرورَ الكرام دون إجهاد النفس في فهمها بعمقها الحقيقي؛ وذلك لأنه لم يتكون عندنا منهج قراءة يعتمد على المقارنة والمحاكمة العقلية.
كنوز من جوهر وياقوت وزبرجد قضى عليها الإلف، وأعتقد أن هذا الأمر قد يُفضي إلى امتعاض أصحاب هذه المؤلفات القيّمة مِنّا.
مسألة أخيرة:
إن تحقيق مثل هذا الصفاء والنقاء -ولو مؤقّتًا- في مكان هادئ كأنّه “صُوْبَة” صيانة تصوننا في حياتنا الاجتماعية القادمة.
والحق أنه منذ أن تشرَّف مجتمعنا باعتناق الإسلام لم يتلطخ بمثل هذه القذارة التي نراها اليوم، فالشوارع والأسواق وصحون المعابد والمؤسساتُ التعليمية ملطخةٌ بالنجاسة؛ لذا فإن التخلص من هذه الأدران، والتطهرَ في مكان طاهر، والإحساسَ والابتهاج بالطهر مرة أخرى، أمور لها أهمية بالغة في مضيّ الإنسان في حياته على نهج طاهر قويم.
إن اللجوء إلى العناية الإلهية بالأدعية والأذكار مصدر قوة يصون الإنسان ويرعاه، يقول تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 2/152)، فهذه الآية تشير إلى أننا إذا ذكرْنا الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ذَكَرَنا هو بعنايته عند المصائب وانقطاع السبل، وتشير هذه الآية أيضًا إلى ما يلي: “تَوَجَّهوا إليّ بفقركم وعجزكم، أؤيّدكم بحولي وقوتي”؛ وإننا لنستشعر مدى تجلّي اللطف الربّاني في هذا التوجه الإلهي الذي أتى على صورة العقد، وكأن ربنا جلّ في علاه يتنزل إلى مستوانا ويعهد إلينا عهدًا فيقول لنا: “افعلوا لي هذا، أفعل لكم ذاك”.
ومجمل القول أننا جميعًا بحاجة ماسّة إلى مثل هذه العزلة المؤقتة حتى يكونَ بوسعنا تنقية أعيننا وآذاننا وألسنتنا من الذنوب والآثام، وتزكيةُ قلوبنا كي نتجدد، والمهم في مثل هذه اللقاءات أن تركّز العقولُ على قراءة الكتب، والقلوبُ على الأدعية والأذكار، وأن نعفّ عن الخوض في أمور تافهة، وألا نخوض في اللغو ولهو الحديث، وأن يكون كل كلامنا في الأمور السامية.