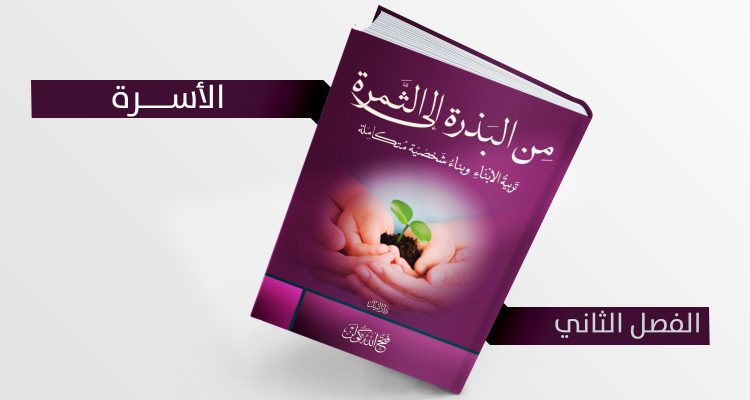1- كيفية بناء الأسرة
ذكرنا في الفصل السابقِ أنّ الأسرة هي أهمّ ركنٍ في المجتمع، وشددنا على أهمّيّة التزام عشّ الزوجية بالمبادئ الدينيّة، وأرجعنا إمكانيّة تحقيق الكمال في أيّ شيءٍ إلى الخطّة المتكاملة، ونوّهنا إلى ضرورة أخذ هذا الأمر الخطير على محمل الجِدّ وهو لا يزال في طور الفكرة.
أجل، إن تخلينا عن الجِدّ في مرحلة الإعداد لأيّ أمرٍ ولم نستند إلى المنطِق السليم، أفضى ذلك في المستقبل إلى مشاكلَ يصعب التغلّب عليها، فإن لم تكن خطّتنا في بناء البيت متماشيةً مع الحاجة ومساهمةً في تجميل البيت فسنظلّ نهدم ونبني في دوران دؤوب.
إن الأسرة هي أهمّ ركنٍ في المجتمع، وسلامة هذا الركن يعني سلامة الأمّة والدولة، وعلى ذلك علينا ألا ندع هذا الركن الأساس في الأمة والمجتمع بلا خطّةٍ أو برنامج ألبتّة؛ لأن الإهمال في هذا الركن بمثابة إهمالٍ للأمّة بأسرها، فمن الضروري إذًا التزامُ الجِدّية عند إقامة الأسرة وتنشئتها، فهذا أمرٌ في غاية الأهمّيّة، خصوصًا وأنّ مجتمعنا اليوم تُثْخِنُهُ الجروح بسبب العلاقات غير المشروعة.
أجل، إن بيتًا بُني على الأهواء والرغبات والأطماع والأحقاد لا يعِدُ بمستقبلٍ زاهر، وسيظلّ هذا البيت عنصرًا سلبيًا أصيلًا في جسد الأمة، وقد يُخرِّج لنا أبناءً مشرّدين في الشوارع؛ لأن هذا البيت لم يعتمد على حساباتٍ دقيقة وخطّةٍ متكاملة عند تأسيسه، وهذه الخطّة نطلق عليها اسمَ “النكاح”، وإننا لنرى ضرورة أن ينطلق هذا الطريق المؤدّي إلى النكاح من المنطق والفكر والقلب لا من الرغبات والشهوات، فمثل هذا الشعور والفكر الديني سيكون نافعًا جدًّا في الحياة الزوجية، فإن انعدمت الصلة بين الأبوين وبين الله فمن المتعذّر أن يَحمل أولادُهما شعورًا واعيًا متوازنًا منتظمًا، بلهَ أيّ شعورٍ بالمسؤولية، فلو جاءت النتيجة إيجابيّة -رغم صعوبة ذلك- فعلينا أن نعتبر هذا فضلًا وتلطّفًا كبيرًا من الله تعالى، وأن ننكّس رؤوسنا وننحني امتنانًا له.
إن كلّ ما في عالم الكون والفساد هذا متوقّفٌ على الأسباب، وبمراعاة الأسباب نحصُل على ما نرمي إليه -بفضل من الله وتوفيقه- بنفس الشكل الذي أمّلناه وأجهدنا فكرَنا فيه، ولا نصِل إلى الثمرة المرجوة غالبًا إذا ما غضضنا الطرف عن الأخذ بالأسباب في أعمالنا وتصرّفاتنا، فإن كنّا لا نريد الوقوع في الخيبة والخسران فعلينا أن نتناول كلّ مسألةٍ بأسبابها ومقدّماتها ونراعي الدقّة البالغة في هذا الأمر، ثمّ ننتظر النتيجة الرابحة منه سبحانه وتعالى دون سواه؛ ثقةً في فضله وعنايته.
أجل، علينا أن نثق ثقة ًكاملةً في ربّنا سبحانه وتعالى، وألا نقصّر في الأخذ بالأسباب في كلّ أفعالنا التي هي بمثابة الدعاء الفعليّ، ويشرح هذا الأمرَ قولُ القائل: “مراعاةُ الأسباب لا تُنافي التوكّل”، هذا مبدأٌ إسلاميٌّ، ونحن نعتقد بضرورة مراعاة هذه المبادئ عند تشكيل مؤسّسةٍ حيويّة مثل الأسرة.
فإذا ما سلّمنا بضرورة تأسيس الأسرة على هذا المنوال أَجْدَت هذه المبادئ في الحصول على أجيال كاملة، ولكن إن كان هناك عطبٌ في أساس المسألة قلّ بنفس القدر تأثير العلاج، إن أسرة يحفّها اليمن والبركة، في بيتٍ يتكون من أبوين مستقيمين مسلمين مؤمنين يقومان بمسؤولياتهما على أتمّ وجه، فلا بدّ إلا وأن يكون كل شيء فيها في نصابه، ويُصبح هذا البيت روضةً من رياض الجنة، وأحسب أن الصيحات المفعمة بالنشاط والحيوية التي يطلقها الصغار في هذا البيت ستكون عند الله بمثابة الدعاء؛ مقدسة وكأنها تسبيحات للملائكة.
وعند حديث القرآن الكريم عن المجتمع السعيد بنسائه ورجاله يقول: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سُورَةُ الأَحْزَابِ: 33/35).
إن هؤلاء الرجال والنساء مؤمنون مسلمون، تجمعهما الأسرة التي هي أصغر خليّة في الأمة، وثقوا في الله، واتجهوا إليه بإخلاص، ووصلوا إلى معيته، وقضوا حياتهم في عبادةٍ وطاعةٍ له سبحانه وتعالى.
أجل، إن الصادق في كلامه وتصرّفاته -ذكرًا كان أو أنثى- هو الذي لا يكذّب كلامُه أفعَاله ولا أفعالُه كلامَه، حتى إنه من المتعذّر مصادفة خلاف الواقع في هذا البيت الذي يشكّله هذا الرجل وهذه المرأة، فكلّ شيء في هذا البيت صحيحٌ ويبدو في صورته الحقيقية، وكما يُصلح الإنسانُ من هندامه أمام المرآة فكذلك الطفل سيُصلح من نفسه أمام لوحات الصدق في هذا البيت، ولن يضطلع بأيّ فعلٍ خاطئٍ أو أيّ بيانٍ يخالف الواقع، إذ كلّ ما يحدث في هذا البيت صحيحٌ وسليم؛ لأن هذا البيت يجمع الصادقين والصادقات.
أجل، فإن كان الزوجان من الصابرين والصابرات؛ من الذين يتحمّلون مشقّة العبادة والطاعة وقسوة المصائب التي يُبتلون بها، ويصمدون أمام الذنوب، ويحفظون فروجهم، ويكرهون أن يرتكبوا المعاصي كما يكرهون أن يُقذفوا في النار؛ فهم -بلسان حالهم- يؤثّرون في أولادهم كما يؤثرون مجتمعاتهم كلّها؛ حتى إنني أعتقد أن كل ما تتفوّه به ألسنتهم سيصغر أمام لسان حالهم.
فلا جرم أن الجدّية والوقار والحساسية والدقّة البالغة هي ما سيراه الطفل دائمًا لدى هذين الأبوين؛ اللذين تفيض أعماقهما بتوقير خالقِهما، وتهتزّ جنباتهما دائمًا من خشيته، ويسعيان إلى أداء ما أُنيط بهما من تكاليف على أكمل وجه؛ مخافةَ ما ينتظرهما في الآخرة من حساب وجزاء، ويترقّبان في كلّ لحظةٍ بلوغَ نهاية الطريق ودعوتهم إلى القبر، سيرى الأطفال في مثل هذه الأُسَرِ قلقًا لطيفًا يعلو الوجوهَ، تتبعه عذوبةٌ ثم نشوةٌ أنشأتها مهابة الله والرجاء في الجنة، وعند ذلك ينشؤون في رفاهيةٍ ولكن مع الحذر، في سعادة ولكن مع سعة الأفق، في لذةٍ وهناءٍ ولكن رجالًا للمستقبل.
ولا بدّ أن يكون الزوجان في البيت من المتصدّقين والمتصدّقات، مهيَّأَين لعمل الخير، يجب أن يكونا كذلك حتى ترتقي وتربو روح الكرم لدى أطفالهما. أجل، علينا أن نكون كرماء أوّلًا حتى يكونوا هم كذلك، ولقد شهدتُ حادثةً مثل هذه: كان الرجل يتصدّق فيُخفي عن زوجته، والزوجة تتصدّق فتُخفي عن زوجها، غير أنني لا أدري ماذا كانا يقولان لبعضهما، ولكن الذي أعلم يقينًا هو أنه من المتصدّقين، وأنها من المتصدقات، وإن الأولاد الذين يَنشؤون في كنفِ هذه الأسرة وأمثالها مهيّؤون لأن يكونوا كذلك، إن أي مجتمع أو أمة تتشكل من أُسَرٍ مثل هذه مهيَّأةٌ لتشكيلِ بُعدٍ متميّزٍ من أبعاد الأمن والسكينة، إن هؤلاء الناس يراعون الدقة البالغة في مسألة الحفاظ على أعراضهم وعدم المساس بها؛ فهم يعيشون ما يعيشون من أجل دينهم وأعراضهم، وهؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة، لقد تناول القرآن الكريم في خطابه الرجلَ والمرأةَ على السواء ونظّم من كليهما بنيةً أُسَرِيَّةً، فإن حقّقت هذه البنيةُ النتيجةَ المرجوّة منها عُدّت أقدس البِنى.
فإذا ما هبّت نسائم الروح الدينية على هذه الأسرة التي تقوم على هذين الركنين نال أولادهما وأحفادهما أيضًا قسطًا من هذه النسائم نفسها، والصلاح الاجتماعي مقدّرٌ ومرهونٌ بدوام هذا الجوّ بين أفراد الأسرة؛ أي خلايا المجتمع، وإلّا تلاشت كلُّ الآمال.
ولنحاول الآن تلخيص قضايا المجتمع والزواج والأسرة والعش السعيد من زاوية مختلفة.
2- الأبوة والأمومة
عند النظر إلى المسألة في ضوء النصوص القرآنية والأحاديث النبوية يتبين لنا أن القرآن الكريم يوصي بكثرة الذرية التي يحبها الله ويرضى عنها، والحق أن جميع الأنبياء والصالحين وغيرهم ممن يحظون بالقبول عند الله كانوا يرغبون في تكثير ذراريهم الطيبة، واتخذوا لهذا أنظمةً مختلفة.
والقرآن الكريم يعبّر عن أصدق المشاعر التي كانت تهيمن على سيدنا زكريا عليه السلام في دعائه وتضرّعه لربه فيقول: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 3/38).
ولو لاحظنا سنجد أن سيدنا زكريا عليه السلام لم يطلب الذرية على إطلاقها، بل قيّدها بالطِّيبِ فقال: “ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً”، وكأنه يقول: “ربّ هب لي ذرية طيبة ترضيك، وتقرّ عين نبيك، وتكون ركنًا ركينًا في الأمة”.
كما كان إبراهيم وابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام يتضرعان إلى الله وهما يرفعان القواعد من الكعبة قائلَين: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 2/128).
ولنا أن نقول إن انحدار مئات الأنبياء من تلك السلالة الصالحة وفي مقدّمتهم مفخرة الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهو إشارةٌ على قبول الله تعالى لهذا الدعاء المبارك، فضلًا عن ذلك كان جميع الصالحين في الأمة يتضرّعون إلى ربهم أن يهبهم الذرية الصالحة: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (سُورَةُ الفُرْقَانِ: 25/74).
ويمكننا أن نرى في نصوص أخرى مثل هذه الأماني والتضرّعات التي تعبّر عن الرغبة في الذرية الطيبة. أجل، إن معظم هذه الأدعية تكتنفها الإشارة إلى الذرية المسلمة المؤمنة البريئة النقية التي لا ترتكب جرمًا ولا تكسب إثمًا، وعلى ذلك فالعبرة ليست بالكمّ وإنّما بالكيف والارتباط بالجذور المعنوية، والقبول عند الله، وربما هناك مناهج وسبل معيّنة لبلوغ مثل هذا القبول.
وأريد الآن أن أفرّج الباب قليلًا عن عددٍ من هذه السبل والمناهج:
3- مهام ربّ العائلة
أ- تدابير ما قبل الولادة
بعضها مسائل متعلقة بالمادّيّات كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
ب- التعليم والتربية
وهذا يشمل حسن تسمية الطفل، والرضاعة، والنفقة، وإعداد الخطط التربوية وفقًا للمراحل العمريّة.
ج- الشعور بالمسؤولية في التربية
بمعنى أن يتخلّقَ كبار الأفراد في الأسرة بأخلاق الإسلام العالية ويجعلوا من أنفسهم قدوةً حسنةً للأجيال الجديدة.
والآن لنفصل هذه الأمور واحدًا تلوَ آخر:
أ. تدابير ما قبل الولادة:
نقاء البذرة
لا بد لسلامة تربية الجيل المنشود من إلقاء البذرة في تربة صالحة، ثم تعريضها للهواء النقي والأشعة النافعة، وريّها بالماء النقي، وتعهّدها بالرعاية، ويؤيد هذا ما ذكره سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتمادًا على حديثٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: “الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ”[1].
أجل، لا بدّ من أخذ كافّة التدابير اللازمة والطفلُ لا يزال في بطن أمّه، فإن غذاء الصغير بعد التقاء مَنيّ الرجل ببويضة المرأة، وتصرّفات أمّه، وسلوكيّات أبويه قبل الولادة وبعدها… لكل هذه الأمور أثر كبيرٌ في سعادة الطفل أو شقاوته.
ويجب أن نعلم جيّدًا أنه لا جدال أن القَدَر يُراعى فيه إرادتُنا وتصرفاتُنا؛ فكلّ تصرُّفٍ نتصرّفه وكل خطوةٍ نخطوها وما يتولّد عنها من نتائج، كل هذا وأكثر يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقد قدّر سبحانه الأشياء تقديرًا راعى فيه إرادتنا، فرُبَّ طفلٍ ساء حظُّه من حيث الوسط الذي نشأ فيه والأسباب التي تحيط به، لكن الله بفضل منه ومنّة حوَّل حالَه إلى أحسن حالٍ.
أجل، كلّ شيءٍ يبدأ من اللحظة التي تُلقى فيها البذرة، فلا نستهين بأثر اللقمة الحرام وفسق الأبوين في شقاوة الطفل وهو ما يزال بويضةً في بطن أمه، فإن أُلقيت البذرة دون تسمية الله، فأمرُ نشوء الثمرة مباركةً موكولٌ إلى لطف الله وإحسانه، فمن الصعب -إن لم يكن محالًا- أن نحصل على نتيجةٍ سليمةٍ من عملٍ معوجّ، ولا نقول محالًا، لأنه قد يخرج من أصلاب غير الموحّدين -أحيانًا- مَن يعبد الله، كما خرج سيدنا “عكرمة” من ظهر “أبي جهل”.
ويقول الحقّ سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/189)، فبينما تكشف هذه الآية الكريمة عن بعض الرغبات التي يمكن أن تكون لدى الوالدين قبل ولادة طفلهما فإنها ترشد في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتوجّها إلى الله رغبةً في الولد الصالح.
اللقمة الحلال
من المهامّ التي تقع على عاتق الأبوين أيضًا ضرورة أن يتحرّيا الحلال عند كسب الرزق، وأن يطعما أبناءهما رزقًا حلالًا طيّبًا، وكما ذكرنا سلفًا -وإن كان هناك بعض الاعتراضات- أن الزواج يحرم على المسلم أو يكره إن كان الرزق الذي سيسوقه إلى أهله حرامًا أو فيه شبهة الحرمة. أجل، لا يجوز لأحدٍ أن يُطعِم غيره حرامًا.
ومن ثمّ فلزامٌ علينا أن نُطعم أبناءَنا والمنوط بنا رعايتُهم والعنايةُ بهم الرزقَ الحلال الطيّب، ولا نطعمهم حرامًا أو ما تشوبه الشبهة على اعتبار أنها بلوى عامّة؛ حتى وإن تغيّر الزمان وتبدّلت العصور وسلك الجميع في تحصيل الرزق سبلًا غير مشروعة، وإذا حصّلنا المال من الطرق غير المشروعة ثمّ غذّينا أبناءنا بهذا المال؛ سيُصبحون ذاتَ يومٍ مثل زقّومِ جهنم، يُصدّعون رؤوسنا ويسوموننا سوء العذاب.
فإذا ما أدّينا المهام التي سردناها آنفًا؛ فمن المتوقّع أن يكون وليدُنا سعيدًا، بابُه مغلقٌ بقدرٍ ما دون التعاسة والشقاء، ولكن إن كان مأكلنا حرامًا ومشربنا حرامًا وملبسنا حرامًا وتسلل الحرام إلى كلّ جوانب حياتنا فربما يعني هذا أننا قد قضينا على احتمالية السعادة لوليدنا.
أجل، إن طعِمنا حرامًا وشربنا حرامًا وغذّينا بالحرام فقد يتسلّط الشيطان على حياتنا الروحية، وفي الحديث: “إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ”[2]. أجل، إن الشيطان يجري في الأوردة الدموية للإنسان، ينفذ إلى كرياته الحمراء وكرياته البيضاء، حتى يسري بشروره إلى النسل والأنساب.
ومن هنا جاءت العناية بمأكل الطفل ومشربه وملبسه، وضرورة أن يتمّ كلُّ هذا في الدائرة التي شرعها الدين، مع تجنب الحرام في المأكل والمشرب والملبس.
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ شَخَصَ فِي غَيْر طَاعَةِ الله، فَإِذَا أَهَلَّ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (أَي الرِّكَابِ) وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ: لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: “لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، كَسْبُكَ حَرَامٌ، وَزَادُكَ حَرَامٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ، فَارْجِعْ مَأْزُورًا غَيْرَ مَأْجُورٍ، وَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوءُكَ”. وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِمَالٍ حَلالٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: “لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَدْ أَجَبْتُكَ، رَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَثِيَابُكَ حَلَالٌ، وَزَادُكَ حَلَالٌ، فَارْجِعْ مَأْجُورًا غَيْرَ مَأْزُورٍ، وَأَبْشِرْ بِمَا يَسُرُّكَ”[3].
ولذا علينا أن نتحرّى الدقةَ حتى في مخيطِ ملبسنا بألا يكون حرامًا أو به شبهة، وأن نستعيذ بالله ممّا لا نعلم، وأن تقشعر قلوبنا من الحرام في كل لحظةٍ وآن، وعلينا أن نعلم بالتأكيد أنّ كلّ بذرة نزرعها إما أن تكون زقّومًا يسمّم الآخرين، أو شجرة مباركةً أصلها ثابتٌ وفرعها في السماء، تُظلّل الإنسانية بثمارها وظلالها وأغصانها، وتَظلّ تخدم الأجيال المتلاحقة، وتُسهِم في سعادة الإنسان وإعمار الأرض.
ب. التربية والتعليم
من الوظائف الأولية للأبوين تسميةُ الطفل باسمٍ حسنٍ محبّبٍ إليهِ، وذلك في إطار وصايا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، حيث أولى عليه الصلاة والسلام أهمّيّةً خاصّةً لتسمية الطفل فقال: “تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّة”[4]، وغيَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم “عاصية” وقال: “أَنْتِ جَمِيلَة”[5].
وبعد ذلك يأتي حقّ الرضاعة، ثم التكفّل بنفقة الطفل عند الفطام، والتعهد بتربيته.
“مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ”[6]. أجل، إنه كورقة بيضاء فارغة، لك أن تدوِّنَ فيها كلّ شيءٍ، ولكن احرص على أن يكون ما تدونه في سبيل مرضاة الله تعالى؛ حتى يصبح نقوشًا تكبُرها الملائكة ويُعمل بها يوم المحشر، وترجحُ بها كفة الميزان… نقوشًا في سبيل مرضاة الله، وعلى نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فما يجب على الأبوين هو أن ينقشا في روح أبنائهما هذه النقوش في موعدها وعلى نحو لا يندثر أو ينمحي. أجل، إن كلّ من يعول طفلًا عليه أن يخصّص جزءًا من حياته اليوميّة لتربية طفله وتعليمه، وسنتناول إن شاء الله المراحل الأخرى للتربية والتعليم في الفصول التالية.
إن الأسرة هي أول محضنٍ وأول مدرسةٍ في التربية والتعليم، فعلى الأبوين أن يرجِّحا الوقت الذي يخصصانه لتربية طفلهما وتعليمه على أورادهما وأذكارهما ووظائفهما الشخصية، فتربية الطفل تفضُل العديدَ من الوظائف الشخصية، بل إن تعريف الطفل بالله، وغرسَ فكرة الإيمان في قلبه حسبَ عمره ومستوى ثقافته يفضل الفيوضات المادية والمعنوية، ولذلك فإذا ما سافرتم لزيارة بيت الله الحرام، وأهملتم أطفالكم وتركتموهم في البيت للتعاسة والشقاء فستنادي عليكم الوظيفة من خلفكم قائلة لكم: إلى أين أنتم ذاهبون وتتركون الوظيفة الأهم والأخطر في حياتكم؟!
ويجب على الأب أن يعلّم طفله الدين والتديّن والقراءة والكتابة وقراءة القرآن، حتى السباحة والرماية وركوب الخيل، كما عليه أن يعلّمه كلّ الرياضات المهمّة في مجالها، لا التي تقوّي من ساعديه وعضلاته فقط، بل النافعة لصحّته وحياته، والتي يعمّر بها مستقبله.
ج. الشعور بالمسؤولية في التربية
نريد أن نستهلّ هذا الموضوع باقتباسٍ من زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما في نصيحة له بكتابه “رسالة الحقوق”:
“وأما حق ولدك: فتعلم أنه منك، ومضافٌ إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وإنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب، والدلالة على ربه، والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينه وبينه بحسن القيام عليه، والأخذ له منه، ولا قوة إلا بالله”.
ولما أحسّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنوّ أجله قال للصحابة رضوان الله عليهم يومًا: “إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ”، فبكى أبو بكر وقال: “فديناك بآبائنا وأمهاتنا”[7]، أجل، لم يتوان الصديق رضي الله عنه في إدراك أن العبد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي حجة الوداع سأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصحابةَ رضوان الله عليهم قائلًا: “أَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟”، لقد قام عليه الصلاة والسلام بمهمّة جليلةٍ، ومع ذلك فلقد كان يساوره القلق هل أدّاها بحقّها أم لا؛ بيد أن تلك المهمة كانت تصرخ وتقول: لا داعي لمثل هذا القلق يا رسول الله.
وعندئذٍ صاحت كلّ القلوب المؤمنة معترفةً بفضله؛ حتى تردّدت أصداؤها في كلّ جنبات ذلك الوادي الفسيح قائلةً: “نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، ثُمَّ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: “اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ”[8].
حقًّا، بهذا القلق البالغ تحدّث النبيّ صلى الله عليه وسلم عن تلك المهمّة التي تسع دائرة الأمّة كلّها، وأشهدَ أصحابَه رضوان الله عليهم على ذلك، فيا ترى لو سُئلنا نحن أيضًا عن أولادنا الذين تكفلنا بمسؤوليتهم ورعايتهم، فهل نحن في وضعٍ يسمح بأن يُقال لنا: ستُسألون عنا، فبِمَ ستجيبون؟ أو هل نتوقع منهم جوابا أن قد أدّيتم؟ وإلا فالويل لنا، من أجل ذلك يقول زين العابدين رضي الله عنه: “إنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب، والدلالة على ربه، والمعونة على طاعته فيك وفي نفسه فمثاب على ذلك ومعاقب”؛ لأن الأهمّ بالنسبة للإنسان هو الارتقاء بأفراد أسرته إلى أعلى مراتب الكمالات الإنسانية، وإشعارهم بمتعة الوجود الأبدي في الآخرة.
أحيانًا نشتري لأولادنا الهدايا في محاولةٍ لإدخال السرور عليهم، بل إننا نفتقدهم حتى عند زيارة بيت الله الحرام أو مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأعمال المباركة والخدمات الجليلة لا تمنعنا من تذكّرهم، غير أن أعظم هدية لا بدّ أن نقدّمها لأبنائنا هي تلقينهم الآداب الإسلامية والآداب المحمديّة، فلا شيءَ يُعادل مثل هذه الهدية التي تكون سببًا في سعادتهم الأبدية في الآخرة.
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ”[9].
د. الأسوة الحسنة
لا شكّ أن كلّ أبوين مؤمنَين يبتغيان تربية أولادهما تربيةً صحيحةً ليكونوا جزءًا من المنظومة السليمة في ذلك المجتمع المثالي الذي نحاول أن نرسم حدوده ونضعه في إطار يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم، غير أن مشاعر هذين الأبوين إن لم تنعكس على حياتهما العملية، ولم تتعمّق بالعبادات كالصلاة والصوم والحجّ والزكاة…إلــخ، والأحرى إن لم تتأكّد الأقوال الحسنة التي تردّدها ألسنتهما بالأفعال الحسنة، أو إن لم تكن أفعالهما أصدق من أقوالهما؛ فلا تأثير حينذاك لكلامهما في أولادهما، بل قد يؤدّي هذا الأمر إلى ظهور ردّ فعلٍ معاكس، ولذا يجب على كلّ الآباء والأمهات الذين يطمحون إلى بسط سيطرتهم على أولادهم أن يُفعّلوا ويُطبّقوا بأنفسهم بدايةً ما يريدون قوله، ويتحرّوا الدقة البالغة في هذا الأمر، وبعد ذلك يطلبون من أولادهم تنفيذَ ما يقولون.
ولعلّ الحادثة المنسوبة للإمام الأعظم رضي الله عنه تفيدنا في تسليط الضوء على هذا الموضوع:
أُتي الإمامُ رضي الله عنه بصبيٍّ يضره العسل إلا أنه يعاند ويصرّ على أكله رغم نصح أبويه الدائم بعدم تناوله، فقال والدُه: يا إمام، إن هذا يأكل العسل، ورغم نصحنا له بعدم تناوله فإنه لا يزال يُصرّ على أكله، فقال الإمام رضي الله عنه: ائتياني به بعد أربعين يومًا، ولما انقضت المدّة جاءا به مرّةً أخرى إلى الإمام الذي أقعدَ الصبيَّ أمامه وأوصاه بالإعراض عن تناول العسل، فلما نهض الصبيُّ لثمَ يد أبيه، وقال: أبتاه، لن آكل العسل مرّة أخرى، فاندهش الحاضرون وقالوا: لِمَ لَمْ تنصحه عندما جيء به أوّل مرّة، وأنظرْتَهم أربعين يومًا، فقال لهم الإمام:
“حينها كنتُ آكل العسل، فلو أنني حاولت أن أثنيه عن فعل شيءٍ أفعله لما وجدَتْ نصيحتي صداها في نفسه، ثم إنني أردت أن أطرح عن جسمي أثر العسل خلال الأربعين يومًا، ثم أنصحه”.
أجل، لا بدّ من صدق القول والعمل معًا؛ لأنه إن وقع تضادٌّ بين أقوالنا وأفعالنا اهتزّت ثقة الأولاد بنا، فإن لاحظوا كذبنا أو مغايرة أقوالنا مع أفعالنا ولو مرّةً واحدةً فقدوا ثقتهم بنا طالما احتفظ أذهانُهم بهذه الذكرى، وقد تتسبب هذه الذكرى السيئة في شيءٍ من الاستياء منا في المستقبل إبان صدور ما يثير غضبهم منا، فلا تجد أقوالُكم صداها في أنفسهم ألبتة، من أجل ذلك لا بدّ أن نضبط سلوكيّاتنا حتى يعتبرنا أولادُنا في البيت كالملائكة لا مجرّدَ والدين له، يجب أن يروا فينا الجدّية والوقار والدقة، وأن يثقوا بنا ثقةً كاملة، فإن نجح الأبوان في نقل هذه المشاعر والأفكار وتمثيلها تمثيلًا صحيحًا فقد يُعدّان من أعظم المعلمين.
4- مسؤولية الأُبوّة والأُمومة
إنّ كلّ شخص مسؤولٌ عن رعيّته؛ مسؤولٌ عن كلِّ مَن يقع تحت مسؤوليته، وكلُّ نجاحٍ يحقّقه بخصوص العناية والرعاية سيُكتب له في دفتر حسناته، وكل قصور سيُكتب له في دفتر سيّئاته.
يقول سيد بني البشر محمد صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري ومسلم: “كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، (قال راوي الحديث: وحسبتُ أن قد قال:) وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”[10].
ولمّا كان الموضوع متعلقًا باعتبار الأبناء أمانة رأينا الحديث التالي متعلقًا بموضوعنا: “مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ”[11].
أجل، إن كلّ مولودٍ يولَد على فطرةٍ نقيّةٍ مهيّأةٍ لتقبّل كلّ شيء، ثم يُعهد إليكم بالعمل على رُقيّ قابليّاته واستعداداته؛ أي تربيته، ثم قد يغدو هذا الطفل يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا تبعًا لعقيدة أبويه أو للبيئة التي يعيش فيها، وقد يصبح مارقًا أو مُلحدًا -نسأل الله السلامة-، ولذا كان التديّن من الأهمّيّة بمكان في مسألة تنشئة الجيل وتربيته.
والحقّ أننا إن لم نعمل على صياغة أبنائنا وفقًا لجذورنا الروحيّة والمعنويّة وهم الذين جاؤوا مهيّئين لتقبّل كلّ شيء فلا مناص من أنهم سينشؤون مصطبغين بقوالب أخرى، تودي بهم في دركات الضلال والضياع، ومن يدري فقد تجدون أنفسكم يومًا ما آباء لأبناء ملحدين نسأل الله السلامة، ولذلك لا بدّ أن نؤصّل في هؤلاء الأبناء عصارةَ ولبّ أرواحنا في حينها، وأن نحول بينهم وبين اغترابهم، فإذا كنا نلقّح الأشجار في حدائقنا وبساتيننا، ونستخدم حقّنا في التدخّل في هذه الموجودات وفقًا لما يقتضيه العلم والتقنية في محاولةٍ للحصول على أفضل الثمار، ألا يجدر بنا أن نوجّه العناية والرعاية -في إطار مبادئنا- لأبنائنا الذين لا يقلّون في المرتبة عن الحطب والحجر والشجر والتراب؟ فإذا كان من المحتمل تعرّضهم لخطرين اثنين في حياتهم: توقُّف النمو الروحيّ بسبب عدم الرعاية، والطغيان بسبب محاولات الإفساد، فإنهم يتفردون بميّزة وحيدةٍ وهي التربية الحسنة التي يقوم عليها أباؤهم وأمهاتهم.
أجل، قد يتعفّن أولادُنا أو يتعرّضون للفساد على أيدي الآخرين إن لم نسعفهم بالتدخّل الإيجابي، وفي كلتا الحالتين يتبعون منهجًا على خلاف رغبتِنا.
ولقد أَهمل الآباء أولادهم في وقتنا الحاضر بسبب انشغالهم الكلّي بالأمور الدنيوية، بل إنه من المتعذّر أن نجد عصرًا شاع فيه إهمال الأبناء مثل عصرنا هذا.
يُروى في مصادر الشيعة[12] عن زين العابدين رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
– “وَيْلٌ لِأَبْنَاءِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ”.
– قالوا: يا رسول الله مِن آبائهم المشركين؟
– “مِنْ آبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ”.
– كيف هذا يا رسول الله؟
– “لَا يُعَلِّمُونَهُمُ الْفَرَائِضَ، وَإِذَا تَعَلَّمَ أَبْنَاؤُهُمْ مَنَعُوهُمْ، وَرَضُوا مِنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَهُمْ مِنِّي بُرَآءُ”.
نعم، أُهملت الفرائض الدينية في سبيل الحياة الدنيا القصيرة، لقد أهمل المسؤولون كليةً التعليم والتربية الدينية، ووجّهوا أنظارهم إلى الحياة المادّيّة ليس إلّا، وركّزوا هممهم وجهودهم عليها، ولم يُعنَوا بالحياة الروحية والقلبيّة للأجيال، بل لم يأبهوا بتدريسهم القرآن وإبراز ما فيه من أبعاد روحيّة ومعنويّة، وبتعليمهم الدين والتديّنَ والعلومَ الشرعية بحجّة أن ذلك يشغل حيّزًا كبيرًا من أوقاتهم.
وهذا يتوافق تمامًا مع الآية الكريمة: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَة $ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ (سُورَةُ القِيامَةِ: 75/20-21).
فقوله: “فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَهُمْ مِنِّي بُرَآءُ” يعني أن الأبوين اللذين يُهملان أولادهما ويغضّان الطرف عن ضياعهما؛ بل ولا يصيبهم الاضطراب والرجفة من جرّاء هلاك النسل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريءٌ منهم، وهم بُرآء منه.
وأحسب أنه ينبغي على كلِّ الآباء الذين لم تمُتْ مشاعرهم أن تأخذهم الرجفة والقشعريرة إزاء هذا التنبيه والإنذار الشديد، بل لا بدّ من ذلك.
ولما أُثيرت أمامَ الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مسألةٌ تتناول مثلَ هذه المسؤوليّة الحياتيّة المهمّة وقع مغشيًّا عليه، ولم يفق لمدة أربعٍ وعشرين ساعة، حتى إنهم اعتقدوا أنه سيموت، وأخذوا يقرؤون القرآن بجواره، فلما أفاق من غشيته أخذ يشهق بالبكاء، ولـمّا سألوه؛ أخبرهم بأنّ ما أصابه إنما هو من خشيته لله تعالى.
أجل، لقد شعر بقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه رعيته، وكان يرتجف خوفًا من أن يكون قد اعتدى على حقوقها.
ولكن ما بالنا نحن اليوم؟ إننا أناسٌ غلاظ القلوب؛ كيف يمكن لأبوين أن يُؤسّسا بيتًا لإشباع ملذّاتهما الشخصية فقط، ويُهملا قلوب وأرواح أولادهما الذين تسبّبا في وجودهم؟!… فيا تُرى كم مرّةً يجب أن نقع مغشيًا علينا أو تصيبنا الرعشة والرجفة؟
والحقّ أن كل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع قد جاءت من باب الترغيب والترهيب، ولذا سنتناول نحن أيضًا الموضوع من هذه الزاوية، ولكن هذا الموضع تكتنفه مهامّ ومسؤولياتٌ ينيطها بنا الإسلام والقرآن في قضية تربية الأبناء وصياغتهم صياغةً صحيحةً، وهناك مبدأٌ أساسٌ سردناه سابقًا ووعدنا بشرحه لاحقًا، وهو: مسألة أن يكون الأولاد أصحاب شعورٍ وفكرٍ عميقٍ وأخلاقٍ ودينٍ، يروننا في هذا البيت آباء أعزّاء أو أمّهات كريمات ويحترموننا، بل يروننا حكماء في كل أحوالنا، فهذه الأمور من مسؤولياتنا التي تحتلّ قدرًا كبيرًا من الأهمّيّة.
ولنفصّل هذه المسؤوليّات على النحو التالي:
أ. العدل بين الأبناء
يأتي على رأس هذه الأمور مبدأ عدم تفضيل أحد الأبناء على الآخر. أجل، إن أيّ تقصير في هذا الأمر كفيلٌ بأن يُفقِدَنا السيطرة على أبنائنا، وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لها مغزى كبير وعميق:
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما –له ولأبيه صحبة وأبوه من أصحاب بدر- قال: “أعطاني أبي عطيّةً، فقالت عمرة بنت رواحة (وهي أمُّ النعمان وزوجة بشير): لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أُشهِدك يا رسول الله، قال: “أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟”، قال: لا، قال: “فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ”[13].
أي راعِ كلّ أبنائك، وليس واحدًا منهم فقط، فإن وجّهتَ عنايتك واهتمامك بواحدٍ منهم فقط وأجزلتَ له في الهبة والعطيّة؛ ضعُف شعور البِرّ لدى باقي الأولاد تجاهك، وتزعزَعت ثقتهم بك.
حقًّا، لقد وضع النبي صلوات ربي وسلامه عليه حلًّا جذريًّا لهذه المسألة، وحلّ المشكلة المحتملة من الأساس، إن تفضيل أحد الأبناء على الآخرين من شأنه أن يثير مشاعر الآخرين نحوه، بل ويجعلهم أعداء له، لا تعتقدوا أننا نشرح هذه المسائل اعتمادًا على المبادئ الضيّقة لعلم النفس، وإنما نحنُ نركّز هنا على عالمية الحقائق التي يريد القرآن أن يرسّخها في أرواحنا، وعلى موافقتها لطبيعة الإنسان ومعقوليّتها ومنطقيّتها وإنسانيتها.
وكما هو معلومٌ أن نبي الله يوسف بن يعقوب عليهما السلام رأى في منامه أن النجوم والشمس والقمر يخرّون له ساجدين، فما كان من أبيه الذي كان من المفترض أن يسعد ويفتخر بهذا الأمر إلا أن ﴿قَالَ: يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (سُورَةُ يُوسُفَ: 12/5)، لأن هذا النبي العظيم كان يدرك كنهَ الطبيعة البشرية بمقتضى أفضليّة النبوة؛ فأحسّ أن هذا الأمر سيثير غيرةَ إخوته نحوه، فقصُّ مثلِ هذه الرؤيا لا بدّ وأنه سيفضي إلى غيرة الذين لـمّا يبلغوا بعدُ مرتبةَ تزكية النفس، ومع الأسف تحقق في النهاية ما كان منه يقلق عليه السلام؛ حيث ألقوا أخاهم يوسف عليه السلام في غيابة الجُبّ، وقد كشفوا بصنيعهم هذا أثر الغيرة في الإنسان حتى وإن كان في بيت النبوّة.
أجل، بدهيّ أن تفضيل أحد الأبناء على إخوته سيثير لديهم شعور الغيرة والحسد وكرهًا لاشعوريًّا بسبب اختلاف المعاملة.
ويمكننا أن نستوعب هذه الأفكار بشكلٍ أفضل من خلال العوامل النفسيّة الشعورية واللاشعورية التي ينتج عنها حبّنا وكرهنا وصداقتنا وعداوتنا:
فعلى فَرَضِ أن لكم صديقًا صدوقًا حميمًا، لكنه ذات مرّةٍ لم يتعامل معكم بروح الإيثار، وتغلب عليه شُحُّه، فقام بتصرّفٍ غير متوقّع ألبتة، فلا شك أن هذا التصرّف سيظلّ محفورًا في ذاكرتكم إن شئتم أم أبيتم، لأن كلّ حادثة تمضي بعد أن تترك أثرًا في حفيظة الإنسان، فإذا ما أعقبتها حادثة أخرى سرعان ما تنبعث وتحيا من جديد، وهكذا أنتم؛ إن قابلَتْكم حادثة أثارت هذه المشاعر البغيضة -التي تنام في سكون ضمن دائرة اللاشعور عندكم- وألهبتها؛ ثارت ثائرتُكم على الفور، وإن تراكمت هذه الحوادث السلبية فوق بعضها وانبعث عددٌ منها من جديد؛ فإنكم سرعان ما تقومون بتوبيخ هذا الشخص وتجتهدون في الدفاع عن أنفسكم.
هكذا الأطفال! فأي موقف سلبيٍّ بينكم وبينهم يستدعي أفكارًا مترسّخة في عقولهم أو في منطقة اللاوعي عندهم، ومن ثمّ يتسبب هذا الموقف في حَنَقِ الطفل عليكم وعدم إطاعته لكم بالكلية.
إنّ ما ذكرناه يشكّل جانبًا واحدًا فقط للمسألة، فإذا ما فكّرنا في المسألة على أنها شاملةٌ لكلّ مراحل حياة الطفل بات الأمر أكثرَ تعقيدًا، وخاصّة إذا ما اعتبرتموه طفلًا لا غير، ولم تقدّروا الوضع الذي سيكون عليه في المستقبل، فسيأتي يوم تتضررون فيه أنتم وأبناؤكم بسبب خطئكم هذا.
الذي يشهده الطفل في البيت من أقوال وأفعال متناقضة قد لا تظنون أنه يدركها، إلا أنها تثبت في ذاكرته وكأنها مقيّدة في دفترٍ، فإذا ما آنَ أوانها برزت كلُّها إلى الوجود على الفور. أجل، إنها تَظهَر لدرجة أنها تجرف العائلة والأبوين وتنحدِرُ بهم.
ومن ثَمّ فعلى كل مَن يبغي أن يكون أبًا أو أمًا أن يأخذ قسطًا من علوم النفس والتربية، أو يتعلّم مبادئ القرآن الأساسية في هذا الشأن إجمالًا على الأقل، ثم يشرع في حياته الجديدة.
إن تربية الأبناء ليست أمرًا بسيطًا، في فترةٍ ما تطلعتُ إلى تعلّم النحالة، وبالفعل ذهبتُ وأخذتُ دورة في هذا الموضوع، فأدركتُ مدى صعوبة الاشتغال بالنحل، فينبغي للإنسان أن يتعرّف على سبيل تربية الأجيال الصالحة؛ حتى يزوّد المجتمع بمواطنين صالحين، فالإنسان كائنٌ عظيم لديه استعداداتٌ كبيرة وطاقات عظيمة تؤهله لأن يرتقي إلى “أعلى علّيّين” أو ينحدر إلى “أسفل سافلين”، وعلى ذلك لا بدّ لكلِّ شخصٍ أن يعلم مدى أهمية تربية ذلك الكائن العظيم والارتقاء به إلى مستوى الإنسانية الحقيقية.
ب. إنزال الأطفال منزلة الكبار
كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يحتفي حفاوة كبيرة بالأطفال، وكان إذا ما قابلهم جاملهم ولاطفهم وكأنهم رجالٌ كبار؛ ويضع بعضهم على ظهره، ويأخذ الآخرين في حضنه، ويعاملهم بالتساوي وبأسلوبٍ يُرضي الجميع، وإذا ما مرّ عليهم في الشارع وهم يلعبون نظر إليهم بإكبار وعاملهم بوقارٍ وبادرهم بالسلام، فكانوا يردّون عليه بدورهم قائلين: “وعليكم السلام يا رسول الله”.
وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقدّرهم ويبجّلهم كثيرًا، فإذا ما وعد أحدَهم وعدًا كان يفي به في حينه وأوانه وكأنه عاهد إنسانًا كبيرًا.
ج. إشعارهم بالثقة
من الأمور التي تعدّ وصمة عار على جبين الإنسانية فقدانُ الناس ثقتهم ببعضهم، فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدِّد دائمًا على الثقة والأمانة، وكان عليه الصلاة والسلام رمزًا لذلك عند الصغار كما الكبار، كان الجميع يدعوه “الصادق الأمين”، ولا شكّ أنّ الأمة التي يشكلها مثل هؤلاء ستغدو أمينةً أيضًا.
فضلًا عن ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ اللهَ لا يَرْحَمُ مَنْ لا يَرْحَمُ وَلَدَهُ”[14]، يدعو أمّته أن يكونوا رجال قلب، فيوصيهم بوصايا عدة معناها الإجمالي: أحِبُّوا أولادكم، وأوفوا بعهودكم معهم مهما آلت إليه الظروف، فلا يروا منكم تناقضًا بين أقوالكم وأفعالكم… والرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا يشير إلى أسمى النقاط المثالية في التربية.
وهنا نشير إلى حديثٍ مهمٍّ في هذا الباب:
عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِنَا، فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْطِيكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيهِ؟” قَالَتْ: أُعْطِيهِ تَمْرًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ”[15]، وهذا التصريح يبيّن مدى الخطإ الذي نقترفه عندما نقول: “لا ضير في الكذب على الطفل أو خداعه، فهو مجرد طفل”.
أجل، إن كلّ خداعٍ أو قولٍ يناقض الواقع يترسّخ كالبذرة في ذهن الطفل، ثم يغدو يومًا ما -اليوم أو غدا- كشجرة الزقوم؛ ومن ثمّ لا يجدي كل ما بذلتموه من جهودٍ تربوية، فلا بدّ أن يتحرّى الأبَوان الاستقامة على الدوام، ولا بدّ أن تكون من مبادئ أرباب الصراط المستقيم انسيابيّة الصدق من بين أفعالهم.
أجل، عليكم ألا تسمحوا بأن ينظر الطفل إليكم على أنّكم كاذبون، تنقضون العهود، وتطمعون في عرض الدنيا الزائف، بل يجب أن يلمس فيكم ويتعرّف من خلالكم على الدوام على خصال الإيثار والتصدّق والإيمان والإسلام والصبر والخشوع والعفة.
د. التدرّج في التربية
يجب علينا أن نعلّم أطفالَنا ما يجب أن يعرفوه، وأن نجنّبهم من المعارف ما يجب أن يجتنبوه، لا بدّ أن يتعرّفوا على المسائل التي تعينهم في حياتهم القلبية والروحية، ويتشبّعوا بالعلوم النافعة حسب سنّهم ومستواهم، وهذا الموضوع سنتناوله بالتفصيل في الفصول القادمة إن شاء الله.
وكما تلجؤون إلى طبيب الأطفال في مسألة تغذية الطفل؛ ليضع لكم نظاما تسترشدون به في تغذيته الأسبوعية والشهرية، فكذلك عليكم أن تلجؤوا إلى أهل العلم والاختصاص في تربيته وتعليمه وتعرضوا عليهم حالة ولدكم وتستعينوا بآرائهم؛ كأن تقولوا: لديّ طفلٌ في الخامسة من عمره فماذا عليّ أن أفعل تجاهه، أو لدي ابن في العاشرة أو الخامسة عشر من عمره، فماذا يمكنني أن أفعل معه؟. وهكذا يجب أن يكون كلّ موضوع مقيّدًا بأفكارهم وآرائهم.
أجل، على كلّ الآباء والأمّهاتِ أن يلجؤوا إلى أهل الاختصاص ويأخذوا الوصفة منهم، ويجتهدوا في تربية أبنائهم وفقًا لهذه الوصفة والمبادئ التي تحتويها، فإن تحديثكم أبناءكم عن الله تعالى بلا سندٍ أو دليلٍ وقد بلغوا سنَّ الثانوية قد لا يُنتِجُ سوى كفرهم وإلحادهم والعياذ بالله، ولربما يجب في هذه المرحلة العمريّة أن تتداخل العلوم الدينية مع قدرٍ من العلوم الطبيعية حتى يجدي حديثكم التأثير المرجوّ في أنفسهم، ولكن إن حاولتم تلقينهم بعض العلوم الفلسفية وهم لا يزالون في المرحلة الابتدائية فلا ريب أنكم ستشوّهون أفكارهم كليّةً، ومن ثمّ عليكم أن تكونوا كالأطباء في معاملتهم مع مرضاهم؛ وتقدّروا مستوى أولادكم وظروف عصرهم ومحيطهم الثقافي، ثم تزوّدونهم بالمعلومات اللازمة وفقًا لهذه الأمور.
[1] الطبراني: المعجم الأوسط، 3/107، وانظر: سنن ابن ماجه، المقدمة، 7.
[2] صحيح البخاري، الاعتكاف11، الاحكام 21، الأدب، 121؛ صحيح مسلم، السلام، 23،24.
[3] مسند البزار، 15/221؛ الطبراني: المعجم الأوسط، 5/251.
[4] سنن أبي داود، الأدب، 69؛ سنن النسائي، الحيل، 3؛ مسند الإمام أحمد، 4/345.
[5] صحيح مسلم، الآداب، 14؛ سنن أبي داود، الأدب، 62.
[6] صحيح البخاري، الجنائز، 79؛ صحيح مسلم، القدر، 22.
[7] صحيح البخاري، المناقب، 45؛ صحيح مسلم، فضائل الصحابة، 2.
[8] صحيح مسلم، الحج، 147؛ سنن أبي داود، المناسك، 56.
[9] سنن ابن ماجه، الأدب، 3؛ القضاعي: مسند الشهاب، 1/389.
[10] صحيح البخاري، الجمعة، 11؛ صحيح مسلم، الإمارة، 20.
[11] صحيح البخاري: الجنائز، 80؛ صحيح مسلم، القدر، 22.
[12] لعدم وجود هذه الرواية في الكتب الصحاح لأهل السنة فقد رأينا من المفيد التصريح بمصدره للخلاص من نقد الناقدين.
[13] صحيح البخاري، الهبة،12؛ صحيح مسلم، الهبات، 18.
[14] مسند البزار، 12/14.
[15] سنن أبي داود، الأدب، 80.