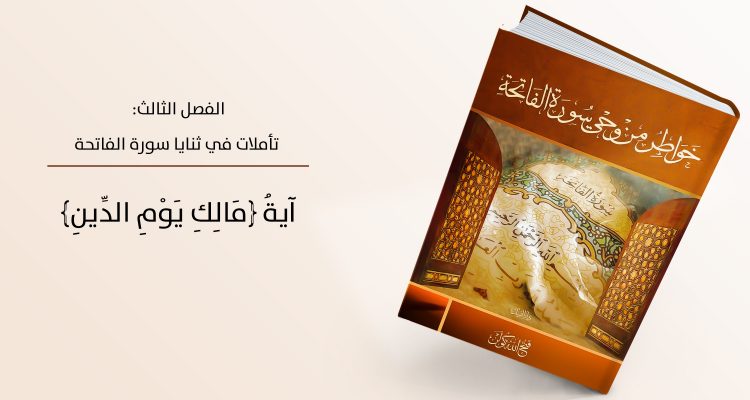إنَّ الأسلوب القرآني ليتمتَّعُ بالانسجام والتناسقِ في أبهى صوره، حيث إنه ذَكر في ﴿اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مِن مسؤولياتنا نحن بني الإنسان، على طريق الرمز والإشارة، وفي هذه الآية يذكره في غاية الصراحة، فأُعقبت الآيةُ السابقة مباشرةً بما يفسِّر ويجَلِّي ما خفي فيها من الجوانب.
إنه هو “الله”، وهو “رب العالمين”، وهو “الرحمن الرحيم”، وإنه سيجازيكم حسب استخدامكم لما منحكم من “الإرادة”؛ لأنه المالك الوحيد لـ”يوم الدين”.
و”يومُ الدين” يعني يوم الجزاء والحساب، إنه اليوم الذي سيلقى فيه الخيرُ والشرُّ جزاءَه، ففي ذلك اليوم سيُنفخ في الصور، وسيكون الحشرُ والنشور، وسيؤتَى الناسُ صحائفَ أعمالهم، ومِن بعد ذلك سيَلقَى الأبرارُ ثواب حسناتهم والأشرارُ عقابَ سيئاتهم.
إن الله ربُّ العالمين، هو المعبود المطلق والمعبود بالاستحقاق، فلا يُعبد سواه، وهو الرحمن الرحيم، أَرسَل الرسلَ، وأنزلَ الكتبَ، وهَدى إلى سبيله، وكل هذه الأمور تقتضي يومَ الجزاء، ذلك اليوم الذي سيتجلى الله فيه برحمته وقهره، وسيعاقَب فيه الظالمُ ويكافَأ فيه المظلوم، سيَحظى المحتاجون إلى الرحمة بالرحمة، في حين أن الذين فَقدوا هذا الحقَّ سيَلقون العذاب، وكل النعم التي تَظهر وتتموَّجُ باعتبارها تجلِّياتٍ للرحمة الإلهية، مع أنها مُعرَّضة للانقطاع “في الدنيا” لكنها ستستمرُّ في الآخرة بمقتضى عنوان “رب العالمين” و”الرحمن الرحيم”، وإن الفراعنة والشدّادين والظالمين وكلّ من يدَّعون “المالكيّة” في هذه الدنيا سيَمْثُلون أمام الله في ذلك اليوم خاضعين؛ في حين أن الذين أطاعوا أوامرَ ربِّهم في دار الدنيا سيدخلون دار السلام بين يدَي “مالك يوم الدين”، إن الله يقول في الحديث القدسي: “وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ”[1].
وإذا نظَرْنا إلى الأسسِ الإيمانيَّةِ ضمن هذه المعادلة والموازنَةِ فسنرى كَم أنها ملائمة للفطرة الإنسانية وسنشاهد كَم أن الأركان الإيمانية متلازمةٌ فيما بينها، وأن بعضَها يقتضي البعض الآخَر.
أ. القيامة: اليوم الذي يقوم فيه كلّ شيءٍ
إن يوم القيامة هو ذلك اليوم الذي سيقوم فيه كلُّ شيء، وسيكون الإنسانُ أيضًا في ذلك اليوم قائمًا -بأعماله ومشاعره- بحمده وثنائه أو بطغيانه وضلاله؛ بشكره وشكرانه أو كفره وكفرانِه، وسيظل ثناؤه لله قائمًا، وفي ذلك اليوم الذي سيقوم فيه كلُّ شيء فإن الله -بعظمته وجلاله- سيقوم بحساب الخلق في عظمتِهِ الظاهرة الجليةِ، والقرآنُ العظيم يتحدَّثُ عن هذا بقوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (سورة الفَاتِحَةِ: 1/4).
قال هنا: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ مع أن الله مالك المُلكِ كلِّهِ وليس يوم الدين فقط، إنه مالك كلِّ شيءٍ وبيده ملكوت كل شيء حقًّا، ولم يكن له شريكٌ في الملك صِدقًا، وفي ذلك اليوم الخاصّ المهيب سيَرى الكلُّ بجلاءٍ ووضوحٍ مَن هو الربُّ ومن هو المالك ومن هو الخالق…
هنا وردت كلمة “يوم”: إنّ عمر الإنسان “يوم”، وأعمار الملل والجماعات “يوم”، وعمر الدنيا “يوم”… وثـمَّةَ يوم آخَر يُقابِلُ الدنيا بأكملِها وهو: “اليوم الآخِر”؛ فالدنيا يوم والآخرة يوم، فإن الدنيا والآخرة ليستا في جنب سلطنةِ الله العظيمة إلا عبارة عن يومين اثنين، فكل الأزمنة بالنسبة لهذه السلطنة طرفةُ عينٍ، تمضي سريعًا، إلّا أن الله تعالى منزَّهٌ عن أن يمرَّ عليه زمان.
نعم، إن البشريَّةَ تُحاسَب على “يومها” بعدما تقضيه، وكذلك الدنيا إذا قضَتْ يومَها فإنها ستُحْرِزُ موقِعَهَا اللائقَ بها هناك، وستُستَخدم بكلِّ ذرَّاتها في بناء العالم السرمديّ.
أجل، ذكرنا آنفًا أنَّ لكَ ولعالَمِكَ، وعالَـمِ أمَّتِكَ وعالـمِ جميع المخلوقات، ولكل العوالم الخصوصِيَّةِ والعموميَّةِ “يومٌ”، وحصيلةُ كلِّ هذه الأيام ستُبسَطُ أمام الأنظارِ على شكلِ لطفِ الله وقهرِهِ في ذلك اليوم الذي عبّرت عنه الآية الكريمة: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (سورة الطَّارِقِ: 86/9)، فذلك اليومُ هو ما سماه الله: “يوم الدين”.
ب. يومُ الدين: يومُ يَظهر الدينُ
إن مِن معاني “يوم الدين” هو: اليوم الذي تظهرُ فيه حقيقة ما أتى به الدين؛ فنحن في حقيقة الأمر نؤمن بالله وملائكتِهِ وكُتبِهِ ورُسلِهِ واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه من الله تعالى، ونعتقِدُ بفرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج، إلى غير ذلك بفرائض الدين وشرائعه، فكل هذه الأمور التي نؤمن بها ستظهر في ذلك اليوم على حقيقتِها، وفي ذلك اليوم سنرى ونشاهدُ اللهَ ، وسنرى النبيَّ فنترجَّى منه الشفاعة، وسنرى الملائكة وهم صافّون حافّون من حول العرش، وسنشاهِدُ السماءَ وهي تتشقَّقُ وترتجفُ بنزول الملائكة، سنرى ذلك اليوم الذي سيظهر فيه ما أتى به الدين بأكملِهِ، وما سطرته أقلام القدَرِ، وسنرى أقدارَنا نحن، وستظهر للعيان مشاعرُنا وأحاسيس قلوبِنا، وسنرى صلواتِنا، وصيامَنا؛ جُوعَنا وخَلوفَ أفواهنا؛ بل ما يُعبِّر عنه هذا الخلوفُ، وكيف أن الله تعالى يَرضى به ويحبُّه، وباختصار: سنرى وسنعاين كلَّ ما ذُكر لنا في الدنيا عن الآخرة.
نعم، إن كل الحقائق التي ورد ذكرُها في الآيات والأحاديث النبويَّةِ من أمورِ الدين، ستظهر في ذلك اليوم بكلِّ جلاءٍ ووضوحٍ، بدءًا من أصغر الأمور وانتهاء بحقيقة “الألوهيّة” التي هي أكبر الحقائق.
ج. الدينُ والتديُّنُ
إن الدينَ وضعٌ إلهيٌّ، ونظامٌ وضعه الله تعالى، وأصلُه ومعناهُ وماهيَّتُه عنده تعالى، وكما أنه يظهرُ هنا في الدينا سيظهر هناك في الآخرة أيضًا، والدِّينُ -كما عرَّفه بعضُ العلماء-: “وَضْعٌ إلهيٌّ سائقٌ لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات”، فالدين قانونُ الله، ويُطلَقُ عليه: “الشريعة”، فـ(الدين – الشريعة – الإسلام) مجموعةٌ من القوانين الإلهية، والدين يسوق الناس إلى الخير “بإرادتهم واختيارهم”، ولا يسلُب من الناس إرادتهم، فالإنسان لم يُحبَسْ في حدود الفطرةِ مثل الجمادات التي قُيِّدت في إطار نمطِ حياةٍ خاصٍ بها، إنه مُنح “الإرادة والاختيار”، فأُطلق عنانه وأُعطِيَ “الحريةَ” في الاختيار بين الخير والشر.
ومَن أمعنَ النظرَ فسيلاحِظُ في هذا التعريفِ أن الدينَ سائقٌ إلى الخير، فلا بد لتسمية أمرٍ مَّا “دينًا” أن يكون بِيَدِ من يستطيع أن يَسُوق إلى الخير، ويجعلَنا نحصلُ على النتائج التي يَعِدُنا بها، وأن يعطيَنا ما ينبغي إعطاؤُه بحيث يُشبِعُ كلَّ مشاعِرِنا وأحاسيسنا بالإضافة إلى تلبيةِ متطلَّباتِنا العقليّة والقلبيّة.
ولذلك نقول: إن الذين أرادوا وحاولوا أن يَسُوسُوا البشريَّةَ بمجرَّدِ “الضمير”؛ قد انحرفوا بها إلى سبلٍ ضالَّةٍ بدلًا من هدايتِها وسَوقِها إلى الصراط المستقيم؛ لأنهم وضعوا أمامها عديدًا من السبل بعددِ الضمائر.
والعقلانيُّون الذين يقولون: “إن العقلَ يَحُلُّ كلَّ القضايا”، قد انطلقوا بالعقل فقط من دون أن يُدرِكوا حقيقة القلب والروح ويَنفُذوا إلى أعماق الإنسان، فتعثَّروا وانقطعت بهم السبل، ولم يَحُلُّوا أية قضية، والحقيقة أن العقل ليس إلا آلة لفهمِ الدين الذي هو “وضعٌ إلهيٌّ”؛ فالعقلُ مهمَّتُه أن يَفهم الدينَ والقوانين الإلهيَّة حتى يصلَ إلى التديُّن المكنونِ في روح الدين، ولقد كُلِّف البشر بأن يحصلوا على التديُّنِ بعقولهم وتصرُّفاتهم الإراديَّة أي بِكَسبِهم، والواقعُ أنه ليس لِدين أن يعيشَ من دون تديُّنٍ، كما أنه ما كان لتديُّن أن يقوم ويستمرَّ من دون دِين، فالدين والتديُّنُ وجهان لحقيقةٍ عظمى، فالدين قانونُ الله وشريعتُه، أما التديُّن فهو كسبٌ بشريٌّ يتمثَّل في جعل الدين روحًا للحياة.
الإنسانُ لا يكون متديِّنًا إلا بمقدار ما يجعل الدين روحًا لحياته، وبمقدار ما يجعل مبادئَ الدين ودساتيرَه غايةَ حياته وهدفَها، وإذا كان يؤمِنُ ويعتقدُ بأن ما يعمله حقٌّ وصدقٌ ولا يلتمسُ مِن وراء ذلك إلا رضا الله تعالى؛ فلن يذهبَ أيُّ شيءٍ مما يعمله باسم الدين سدى؛ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ $ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (سورة الزَّلْزَلَةِ: 99/7-8)، ولكن الإنسانَ إذا توخَّى مِن وراءِ عملِهِ منفعةً عاجلةً، فذلك يدلُّ على عدمِ إخلاصِهِ، ولِعدمِ إخلاصه لا يحظى بالقَبول الحَسن عند الله ، فتُضرَب عبادتُه وعملُه في وجهه، إن الغايةَ والهدفَ الوحيد من العبودية لله والتديُّنِ له إنما هو تلبية “أمر الله”، بمعنى أن الإنسانَ عليه أن يتديَّنَ لمجرَّدِ أن الله أمره بذلك، ويبتغي -في نهاية المطاف- رضا الله تعالى ولا يرجو منفعةً أخرى، وفي هذه الطريق التي يبتغي العبدُ فيها رِضَى الله تعالى فقط يأملُ العبدُ ويتطلَّعُ إلى أن يُحصِّلَ في الآخرةِ ثمراتِ الأعمالِ التي وفَّقَهُ الله إلى القيام بها في الدنيا، ومِن هذا المنطلق يمكن القول: إن التديُّنَ هو: تنفيذ ما أمر الله به، لتحصيلِ مرضاته هو، وابتغاء الثمرةِ والنتيجةِ منه.
د. كلمة: ﴿مَالِكِ﴾
كلمة “مَالِك” قرأها هكذا من القُرّاء السبعة عاصمٌ والكسائيُّ، والباقون قرؤوها: “مَلِك”، المالكُ هو مَن يملك شيئًا مطلقًا، أما المَلِكُ فهو مَن يملك الحُكمَ، وهو رئيس الدولة وحاكمُها ومدبرها ومن يُعِدُّ لها العُدَّةَ، ويُسيِّر أمورَها ويديرها.
والله يَذكر -حسب اختلاف القراءات- في آيةٍ واحدة الـمَلِكَ والمالك معًا؛ فإنه لولا الـمَلِك لما كان هناك لا مالكٌ ولا مِلك، فلا بد أوّلًا من مَلِكٍ ينظِّمُ أمورَ دولَتِهِ وشعبِهِ، ويقسِّم الحقوق المعينة بين الأفراد ويعيِّنها ليمتلك كلُّ ذي حقٍّ حقَّه ويصبح مالكًا لذلك الحقِّ الذي تَمَلَّكَه، ورئيسُ الدولة هذا، في حين أنه مَلِكٌ هو في الوقت ذاته مالكٌ لذلك الـملْك، وكلُّ فردٍ من الأفراد الآخرين مالكٌ باعتبار أنه صاحبٌ لحصَّتِهِ وممتلكٌ لعينِها.
ولا بدَّ هنا من التنبُّه إلى أمرٍ في غاية الدِّقَّة، وهو أن الله في هذه الآية يعيِّن نظام الدولة التي سيؤسِّسُها الإنسانُ باعتبارِهِ خليفةً لله على وجه الأرض، ويضعُ أُسُسَ هذا النظام.
والحقيقة هي أن تأسيسَ الدولة عبارةٌ عن تَظاهُرِ عنوانِ “المالكية” (بالمعنَيَين السابقين) التي أعطاها الله الإنسانَ وديعةً.
فإذا أُسنِدت الدولةُ إلى أساس “المالكية” فقط، فَسَيَنْتُج من هذا “الليبراليّةُ”، والأساسُ في هذا النظام هو الفردُ والحقوقُ الفردية، في حين أنه في نظام الدولة التي يريدها الله تعالى والذي أشار إليه في هذه الآية تُوجَّه الأنظارُ إلى “المالكية” من جانبٍ، وإلى “الـمَلِكية” من جانب آخر؛ فيوصَى بأنْ تؤسَّس قواعدُ الدولة وتُرسَى على هذين الأساسين.
ففي البلاد التي تؤخَذُ فيها مصالحُ الدولةِ فقط بعين الاعتبار تُغصَب حقوق الفرد، فلا يَسعد برغد العيش إلا ثلّة قليلة ممن هم في الطبقات العليا من الدولة، ويصبح من سواهم مفلوجين مغلوبين على أمرهم تعساء، أما في الأنظمة التي يؤخذ فيها الأفرادُ فقط بعين الاعتبار فالدولة تصبحُ مشلولةً؛ لأن في مجتمعٍ كهذا من حيث إنه يتوخَّى “اللامركزية”، فإن الدولة لا تصبح إلا بمثابة جسمٍ قُطِّعت أعضاؤه، إن النظام المثالي يجمع بين هذين الأمرين ليحصل الرؤساء والمرؤوسون على حقوقهم بأكملِ وجهٍ.
فإن الله بقوله ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يتحدث لنا عن مشاعر “التملك” التي أودعها فينا وأعطانا إياها مِن مالكيَّته هو، وعما مَنَح الإنسانَ من صلاحيته لإقامة الدولة، وعن أسُس الدولة ومبادئها… ويَلفت أنظارَنا إلى أمرٍ آخر، وكأنه يقول لنا: تُمنح لكم في الدنيا مالكيَّة “نسبيّة”، ولكن الملك في الآخرة سيكون بتمامه لله تعالى، ولذلك فعليكم أن تبحثوا عن وسائل لتحويل ما تملكون إلى ملك خالد.
إن الملك لله، والذين يرثونه هم عباده الصالحون، فكما أن الأمر هكذا في الحقوق الفردية فكذلك في قوانين الدول والقوانين الدولية، ولذلك فرض الإسلامُ “إعلاء كلمة الله” في الأرض حتى يبلُغ دينُ الله إلى كلِّ الناس.
والإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه، يتصرَّفُ على وجهِ الأرض نيابةً عن الله تعالى، وبهذا التصرف التي يُجرى باسمه تتحقَّقُ العدالة والنظام.
هـ. إن الله هو المالكُ الوحيدُ ليوم الدين
وهناك أمر آخر يمكن أن نفهمَهُ من هذه الآية وهو: أن مالكَ يوم الدين هو الله، فمالكيَّةُ سائر المالِكِين أمرٌ نسبيٌّ مؤقَّتٌ، وهي وديعةٌ أودَعَها الله لهم، وكأن الله تعالى، بإشارة من هذه الآية يقول: “أيها الفراعنة والنماردة والذين يعيشون مختالين فخورين قائلين: أنا المالك أو أنا الـمَلِك، أيها السلاطين والأمراء والرؤساء والملوك! سيأتي عليكم يومٌ يزولُ فيه هذا الـمُلكُ من أيديكم، فأنا المالك الوحيد لذلك اليوم الذي ستنجلي فيه الحقيقة العظمى التي تتحدَّثُ عنها آيةُ: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (سورة غَافِرٍ: 40/16)، فانظروا -وأنتم تمارسون الحُكمَ- من جانبٍ إلى مُلكِكُمْ أنتم، ومن جانبٍ آخرَ إلى مُلك ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، فإذا قلَّبتم أنظاركم وتوجَّهتم بها -بين الحين والآخر- أثناء تصرُّفِكم في دائرةِ ملكِكُم الصغيرة، إلى ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فستكسبون حقَّ الإدارة في صلاح واستقامة، وإلا فإذا اعتمدْتم على مالكيَّتِكم فستذهبُ حياتُكم هباءً منثورًا، ويذهب ملكُكم أدراج الرياح، ويسوء مصيركم، ويؤول إلى تعاسةٍ وشقاء.
وأما إذا لم تعتمدوا على مالكيَّتِكم واتَّكلتُم على مُلكِ الله؛ ففي ذلك اليوم الذي سيُنزَع مُلكُكُم ومالكيَّتُكُم ومَلِكيَّتُكُم من أيديكم سيتجلى الله باسمَيهِ: الرحمن والرحيم، ويضعُ ذلك الملك في ضمن الرحمانيّة والرحيميّة، ويمنحكم سلطنةً ومُلكًا لا ينتهيان ولا يتزعزعان.
والله بهذه الآيات الكريمة يريد منا التوجُّهَ إليه، ويقول لنا: إن كنتم تريدون أن تَحمَدوا أحدًا فعليكم أن تَحمَدوني أنا؛ لأنني أنا الله رب العالمين، وأنا -فقط- صاحب الجمال والكمال في ذاته، وإذا كان لديكم في مستقبل أمركم أيُّ مطلبٍ وحاجةٍ وَوَطَرٍ لدى أحدٍ فاطلبوه مني أنا؛ لأنني أنا الذي أتجلّى باسم: “الرحمن الرحيم”، وكذا إن كان لديكم أيُّ تخوُّفٍ أو توجُّسٍ، أو تَحمِلون بين جوانحكم خوفًا من أن تُحاسَبوا حسابًا عسيرًا؛ فراجعوني أنا؛ لأنني “مالك يوم الدين”، وأنا الذي سأحاسبكم هناك.
وفي بداية سورة الفاتحة الشريفة بدأنا بالحمد والثناء لله؛ الذي جَعَلَنا مسلمِين، وجعلَنا من أمة محمد وربَطَنا بنبيّه رَبْطًا وثيقًا وجعلَنا خيرَ أمَّةٍ، ووَجَّه قلوبَنا نحوه، وبذلك حبانا بنعم كثيرة، ومِن بعد ذلك قلنا: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وأَجَلْنا أنظارَنا -باعتبارِ أنَّنا عرفناه تعالى- في أنفُسِنا، وشاهَدنا ربوبيَّتَه في كلِّ شيءٍ، بدءًا من دورانِ وجولان الذرَّات التي تتشكَّلُ منها أجسامُنا وانتهاءً بـحركات الأنظمة والمجرّات وسيرِها، وشاهَدْنا أنه يَسوق كلَّ شيءٍ سوقًا حثيثًا ويُلجئُها نحو الكمال، ورأينا أنه يحوِّل كلَّ شيءٍ إلى عناصر سيستعملها في بناء الجنة والنار، ولاحَظْنا أن كلَّ شيءٍ يتلقى تربيته.
نعم، إننا شاهدنا تصرُّفاته العظيمة هذه، ومِن بعد ذلك أدرَكنا أن الله الذي يدبِّرُ كلَّ هذه الأحداث المطَّردة المتعاقبة في ديمومة وانتظامٍ؛ خلطَ هنا الخيرَ بالشرِّ، وفسح المجالَ للجميل بجانب القبيح، وللإيمان بجانب الكفر، ولا بدَّ أنه سيخلق يومًا دارًا أخرى يميز فيها بين ذلك كلِّه، فذلك اليوم هو “يوم الدين”، وتلك الدار هي “الدار الآخرة” التي فيها “المحكمة الكبرى”، يومئذ تظهر الأعمال بخيرها وشرها، ويُكافَأ المحسنون بباقات من الثواب، بينما يبحث المسيؤون عن مهربٍ من عاقبةِ إساءتِهم، فالله هو المالك الوحيد لـ”يوم الدين” هذا، ويَبرُز في ذلك اليوم الدينُ وحاكميةُ الله ناصعًا جليًّا؛ فإنه لن يحكم فيه إلا هو، ولن يجازِي إلا هو، فينبغي لنا -ما دمنا على قيد الحياة- أن لا ندعو إلا إيّاه، وألا ننطق إلا باسْمِهِ، ولا نتوجَّهَ إلى أحدٍ سواه.
[1] ابن حبان: الصحيح، 2/406؛ البيهقي: شعب الإيمان، 1/483.