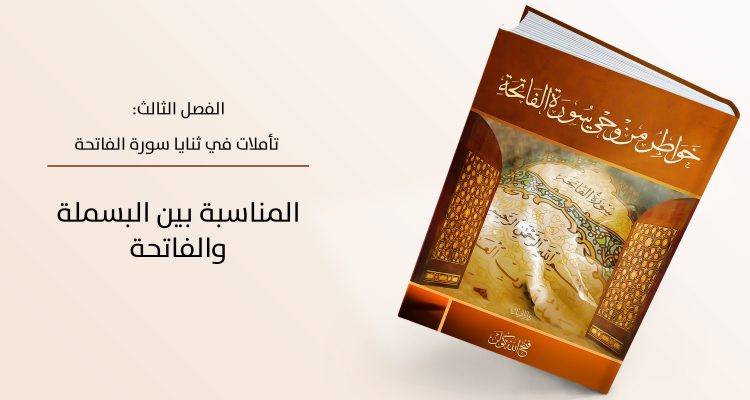لسورة الفاتحة أسماء عديدة، فالقرآن الكريم قد عبَّرَ عنها بـ”السبع المثاني”، ووردَ عن الرسول تسميتُها بـ”أمِّ الكتاب” و”الشافية” و”الوافية”.
سورةُ الفاتحة كنزٌ إلهيٌّ، وكلُّ مهمومٍ سيجِدُ فيها تفريجَ هَـمِّــهِ، وهي سورةٌ ذاتُ أسرارٍ، تُقرِّبُ الخَلقَ من الخالقِ.
وكما أن لسورة الفاتحة علاقةً قويَّةً وارتباطًا وثيقًا مع ما تليها من السور؛ فلها كذلك ارتباطٌ مع ما قبلها من البسملة، وهذا هو ما يسمّونه: “السياق”، ومن المعلوم أن الكلامَ يُقَيَّمُ على حسب سباقِهِ وسياقِهِ، وفي ضوء ذلك يمكن التفطُّن إلى التناسب بين مكوِّنات الجمل.
سورةُ الفاتحة أوَّلُ سورِ القرآن الكريم، فليس قبلَها سورة، ولكن إذا قدَّرنا في بداية السورة فعلًا يكون هذا الفعل بمثابة سِباق لها، كما يمكن أن نعتبرَ البسملةَ أيضًا سِباقًا لها؛ يمكن تقدير هذا المتعلَّق بـ”اقْرَأْ” أو “قُلْ” في بداية الفاتحة.
فقد ورد في قصَّةِ بدءِ الوحي كما روى البيهقي في دلائل النبوة[1] أن رسول الله بينما كان كسيفَ البالِ مغمومَ القلب حزينًا على ما دهى البشريّة من هموم؛ وبينما كان يَبحث في غارٍ مباركٍ عن الحلولِ؛ وبينما كان قد توجَّهَ بقلبِهِ نحوَ الفيض الأقدس، فتحوَّل ذلك القلب الطاهر في تلك الأماكن المظلمة إلى قلبٍ سماويٍّ صالحٍ لكونِهِ مهبطًا للوحي ومظهرًا للتجلّيات الإلهيّة… فبينما هو كذلك كان يَسمع بين الفينةِ والأخرى صوتًا، وكلما كان يسمعُ هذا الصوت يرجع إلى منزلِهِ على جناحِ السرعة، وفي يومٍ من الأيام باحَ بما في قلبِهِ لرفيقةِ حياتِهِ سيِّدَتِنا خديجة رضي الله عنها، تلك التي كانت رمز الإخلاص والوفاء له طيلةَ حياتِها المباركة، فقال لها:
“إِنِّي إِذَا خَلَوتُ وَحْدِي سَمِعْتُ نِدَاءً وَقَدْ وَاللهِ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْرًا”.
فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ، مَا كَانَ اللهُ لِيَفْعَلَ بِكَ، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ.
فَلَمَّا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ ذَكَرَتْ خَدِيجَةُ حَدِيثَهُ لَهُ وَقَالَتْ: يَا عَتِيقُ اذْهَبْ مَعَ مُحَمَّدٍ إِلَى وَرَقَةَ.
وكان ورقةُ بن نوفلٍ ابنَ عم سيدتنا خديجة رضي الله عنها، وكان قد تنصَّر، وكان يكتب الإنجيلَ بالعربية، ويعلِّمه الناسَ، وبما أنه كان يقرأ في الإنجيل إشاراتٍ وبشارات حول مَقْدَم الرسول كان كأنه يحسُّ بظلِّهِ فوق هامَتِهِ، ومَن يَدري لعله هَمَسَ بذلك في أُذُنِ كثيرٍ ممن حَوْلَه، وبينما كان يبحث عنه ويتلمّسه في أعالي السماء كسحابة من الرحمة ستظهر عن قريب فتسقي البشرية، فيتحول بها وجه الأرض إلى جِنان؛ إذ بالرسول شاخصًا أمامه، فقال له:
“إِذَا خَلَوتُ وَحْدِي سَمِعْتُ نِدَاءً خَلْفِي: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا فِي الْأَرْضِ”.
فقال ورقة: “لَا تَفْعَلْ، فَإِذَا أَتَاكَ فَاثْبُتْ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي”.
فلما خلا ناداه: يا محمد! قُلْ: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰـنِ الرَّحِيـمِ $ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ $ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ $ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ $ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ $ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ $ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 1/1-7)، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.
فأتى ورقةَ فذكر ذلك له، فقال له ورقةُ: “أَبْشِرْ، ثُمَّ أَبْشِرْ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ ابْنُ مَرْيَمَ، وَأَنَّكَ عَلَى مِثْلِ نَامُوسِ مُوسَى، وَأَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ.”
فهذه الرواية تفيد أن سورة الفاتحة من أوَّلِ ما جاء به جبريل عليه السلام من الوحي.
الفاتحة هي أُولى السور، هي فاتحةُ القرآنِ وفاتحةُ كلِّ شيءٍ في الوجود، نَزَلَتْ على القلب التقيِّ المبارَكِ لِأفضلِ بشرٍ، وبعد أن نزلَتْ تفرَّعَتْ أغصانُها وأفانينُها وانتشرَتْ ظِلالُها حتى لَكَأنَّ الإنسَ والجنَّ جميعهم دخلوا تحت ظلالِ أجنحتِها، فهي كافيةٌ وافيةٌ بحلّ كلِّ معضلاتِ البشريّة.
وهناك تناسُبٌ وثيقُ الصِّلةِ بين البسملةِ وبين الفاتحة، ممّا أدَّى بكثيرٍ من الفقهاء إلى عدِّها واحدةً من سبعِ آياتٍ من الفاتحة، وقد ذكرنا سابقًا في سياق محاولتنا لبيان المعاني الجليلة للبسملة: أن الله تعالى خَضًّ المخلوقات بجلالِهِ خضًّا، فخَلَقَها، وألقى بذورَ الوجودِ على أرضِ العَدَمِ، وطوَّر الكونَ حولَ بذرةِ النور المحمّديّ، وأضفى عليها المعنى، وجَعَل الإنسانَ ثمرةً لِشَجَرَةِ الكون.
إن البسملةَ تبدأُ باسم الله، إذ “كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ”[2]، وتختتم باسم “الرحيم” الذي وُصف به النبيُّ صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤوفٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/128)، إن الله تعالى خلقَ نورَ سيدنا محمد ثم أتبَعَهُ بِخَلْقِ سائرِ الكائنات على التوالى، فتَسَلْسَلَتْ الأحداثُ الكونيّة، سمِّها -إن شئتَ-: المراحل الجيولوجية، أو المراحل التي تلاحمت فيها الغازات، فالبَذرة التي بُذرت قد تحوَّلت إلى شجرةٍ وأَخذت طريقَها نحو النموّ.
فالإنسان قد يغرسُ في حديقتِهِ شجرةً لِتُثْمِر، وبعد الغرسِ تكون هذه الشجرةُ نُصْبَ عينيهِ وتحتَ رعايَتِهِ، فيرعاها في مختلف مراحلها، ولا يفتأ مُــركِّـــزًا بِنَظَرِهِ على مظانِّ الإثمارِ في انتظار ما تؤتي من ثمار، وقد لا تكون في بذور الشجرة أمارات الحياة، وقد لا تَعنِي قشورُها شيئًا بالنسبة لناظرها، حتى إن أغصانَها وفروعَها وأوراقَها قد لا تَعنِي شيئًا قبل أن تؤتي ثمارها، في حين أن تلك الشجرة إنما غُرِسَت لمعنى كبير؛ فالذي غَرَسَها تكونُ نَظراتُهُ مُنصبَّة ومتركِّزة على تلك الثمرة التي ستطلّ برأسِها فوق الشجرة باسمةَ الثغرِ بين الزهور، وتُلقي بنفسِها في الأحضان على هيئة معلَّبات مجهَّزة تجهيزًا ربّانيًّا.
وهكذا؛ فالله تعالى ألقى نور محمد كبذرة إلى أرضِ العَدَمِ، وهذا الوجودُ نشأَ من ذلك النور ومن تلك البذرة، وإن شئتَ فَقُلْ: الإلكتروناتُ قد تشكَّلَتْ منه، وعالم الذَّرَّةِ انبثَقَ عنه… ولكن هذه القضايا كلها خارجة عن نطاق معلوماتنا وإدراكنا، ومَبْلَغُنا من العلم هو أن شجرة الكون قد نبتت ونَمَتْ من البذرة المحمدية التي أُلقيت إلى أرض العدم، وتدلَّت إلينا من العرش الأعظم، وهذه الشجرة أثمرت في نهاية المطاف، وثمرتُها هي الإنسان، وثمرة تلك الثمرة وخلاصتها هي سيدنا محمد الذي سماه ربه: “المصطفى” أي الصفوة والخلاصة.
و”بسم الله” تعبر لنا عن هذه المعاني، فالله بجلاله ورحمانيته خضَّ الكائنات خضًّا، فأخرج منها شجرةً، وبـ”رحيميته” منحَنَا الإرادةَ، ووفَّقَنَا لإدراك معنى الكون وجَسَامَتِهِ، وإذا استحضرنا هذه المعاني فإننا سنستطيع أن نجد المناسبة بين “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ” و”الحمد لله”.
[1] ابن أبي شيبة: المصنف، 7/329؛ البيهقي: دلائل النبوة، 2/158.
[2] صحيح البخاري، التوحيد، 22.