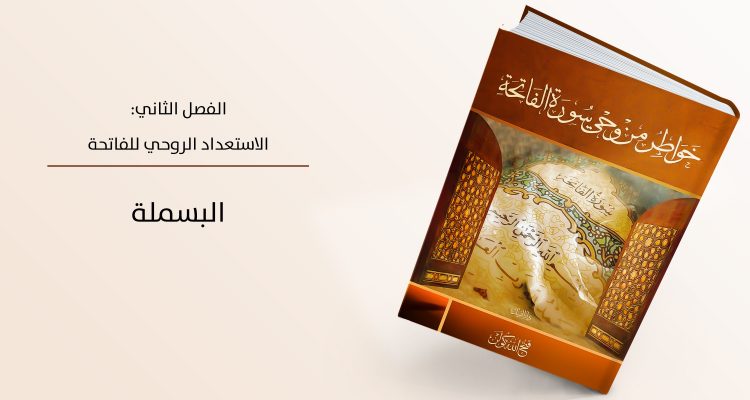والآن لنحاول أن نَعْرِض معاني البسملة الشريفة.
إن البسملةَ فاتحةُ كل خير، وهي عبارةٌ عن خيطٍ نورانيٍّ دُلِّيَ من العرش الأعظم، فمن يُمسِك به يستطيع أن يتحدّى الكائنات كلها، لأن البسملةَ تعني الثقةَ بالله، والاتّكالَ والاعتمادَ عليه تعالى، إن بابَ هذا العالَم فُتِح بـ”بِسْمِ اللهِ”، وأُنْشِئَت الكائناتُ بـ”بِسْمِ اللهِ”، وكلُّ الأحداث تقعُ بـ”بِسْمِ اللهِ”، والقيامة ستقومُ بـ”بِسْمِ اللهِ”، والحشر والنشور والجنة والنار ستتأسَّسُ بـ”بِسْمِ اللهِ”، والمؤمنون إذا قالوا “بِسْمِ اللهِ” ستُفتَح لهم أبواب الجنان، وهناك سيرى المؤمنون الذات الإلهية الوارد ذكرها في ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾، و كما بدأَ العالمُ بـ”بِسْمِ اللهِ” فإنه سينتهي بـ”بِسْمِ اللهِ”.
أ. الباء
إن البسملة تبدأ بحرف الجر (الباء)، وحرف الجرِّ يجرُّ الاسمَ الذي يدخل هو عليه، وكلمة “اسم” هنا مجرور بالباء وعلامةُ جرِّهِ الكسرةُ، والكسرةُ والانكسار من جذر صرفيٍّ واحد، وكأن الكسرةَ هنا في بادئِ الكلام تُعلِّمنا الولوجَ إلى بابه تعالى بقلبٍ منكسرٍ، والحقيقةُ أنه لا بدّ لنا ونحن نباشِرُ أيَّ أمرٍ ذي بالٍ أن تكون قلوبُنا منكسرةً تجاهَ الحقِّ تعالى وأن نتبرَّأ من حولِنا وقوَّتِنا معتمدين على حولِهِ وقوَّتِهِ، حتى يكون عجزُنا وفقرُنا بمثابةِ شافعٍ ومُسْتَدْعٍ لحولِهِ وقوَّتِهِ…
وللباء معانٍ، منها: “المصاحبة”، وباءُ المصاحبةِ لغةً: هي التي يحسنُ في موضِعِها (مَعَ)، فالإنسان إن كان يريد معيَّةَ اللهِ ورسولِهِ والقربَ منهما فليقل: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾، ومِن معانيها: “الإلصاق”، فالإنسان بالبسمَلَةِ يلتصِقُ ويتشبَّثُ برحمانيّة الله ورحيميته، وهذا هو كمالُ المقصودِ، وكلُّ السرِّ يبدأُ بنقطةِ الباءِ، وينتهي عند ميمِ “الرحيم”.
وإذا حذفنا نقطة الباء فسيخطر على البال خطٌّ كالألِفِ يمتد من الأزل إلى الأبد، والألِف عند الصوفية ترمز إلى الله تعالى، وقبل أن نضعَ نقطةً تحت هذا الخطِّ فنجعلَه باءً، كان ذلك النور العظيم اللامتناهي غيرَ معروف أو معثورٍ عليه؛ لأنه لم يكن هناك ظلٌّ في تلك المرحلة، إذ كل شيء يُعرف بضده.
والنقطة ترمزُ إلى سيدنا محمد، والرسولُ نواةٌ وخُلاصةٌ للكائنات، ولولاه لما أمكننا معرفة الله، والله تعالى كان يَرَى ذاته في ذاته، ويَعلَم ذاتَه بعلمه الذاتي، ولكنه تعالى أراد أن يُرَى بعيون أخرى،ويُعرَفَ مِن قِبَلِ آخرين، ولذلك خَلق نورَ سيدنا محمد وخَلقَ الكونَ من نورِهِ، وفي نهاية المطاف ظهر الإنسانُ وبرز للعيان كثمرةٍ للكون، وهذا هو مصداقُ المقولة المشهورة: “إن الله لَيُرى في المرآة المحمدية دائمًا”، إن المرآةَ وكلَّ ما يَتراءى فيها لَيُوجَد في ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾.
وأوَّلُ اسمٍ في البسملة هو لفظُ الجلالة: “الله”، فنحن نبدأُ أعمالَنا باسم الله تعالى، و”الرحيم” في آخر البسملة هو من صفاتِ الله تعالى، إنه صفةٌ مشتركةٌ بينه تعالى وبين حبيبه صلوات الله عليه، فلقد وَصف حبيبَهُ الكريمَ في القرآن بصفتِهِ هو، فقال: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ يعني بذلك سيِّدَنا محمدًا.
وهو تعالى إذ يقول: ﴿وَمَۤا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/107) فإنه يؤكِّد رحيمية سيدنا محمد الذي بُعث رحمةً للعالمين، ففي البسملة يُتحدَّث عن الله، مع الإشارة إلى سيدنا محمد الذي عرَّفَنَا بالله.
وللباء فِعلٌ يتعلَّقُ هو بِهِ، والحقيقة هي أن الكونَ كلَّه عبارةٌ عن أفعال، وهذا الفعلُ مقدَّرٌ مقدَّمًا أو مؤخَّرًا. فنحن نأتي بلفظِ الجلالة “الله” في صدرِ الكلامِ، حيث إن الله تعالى كان ولم يكن فعلٌ، فالله كان “فاعلًا” بِذاته، ويمكن أن نقول: إن أفعالَهُ كانت مُصاحِبةً لذاته، فحينما يَصِلُ الأمر إلى هذه النقطة فإننا نُمْسِكُ عن الكلام.
والمتعلَّق المقدر هو “أبدأ”، ويمكن أن يقدَّرَ المتعلَّقُ: “ابتدائي”؛ فإن قدرناه: “أَبْدَأُ” فالفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره: “أنا”، وإن قدرناه: “ابْتِدَائي” فالفاعل هو ياء المتكلم.
ب. كلمة “اسم”
هي مِن “سَمَا – يَسْمُو” أو من “وَسَم -يَسِمُ”.
فعلى الأول يكون معناه: الارتفاع والعلوّ؛ والله تعالى متعالٍ بذاته وأسمائه، وهذا مِصْداقُ قولِه تعالى: ﴿وَلِلهِ الْأَسْمَۤاءُ الْحُسْنَى﴾ (الأعراف:180).
وعلى الثاني يكون معناه: العلامةُ والأمارةُ، فلا تُطلَقُ لفظةُ “الله” على غيرِهِ تعالى، فإذا أطلقت هذه اللفظة فالذي يتبادر إلى الذهنِ هو الذات الأَجَلُّ الأعلى الذي يَحْكُم الكونَ والذي نعرِّفه بـ”واجب الوجوب”.
وينبغي لنا أن نقفَ قليلًا عند كلمة “اسم”؛ فالله تعالى يَذكُر هذه الكلمة قبل اسمه تعالى ليقول: “بسم الله” ولا يقولُ -مثلًا- “بالله”، مع أنَّ لِقائلٍ أن يقول: كان بالإمكان أن يؤدَّى هذا المعنى لو قيل: “بالله”، إلا أنه لو قيل -بدلًا عنه-: “بالله” لالتَبَس بالقَسم، والحالُ أنه ليس المرادُ هنا القَسَم، بل المرادُ والمقصودُ هو الارتقاءُ من حضيض ظلمات الجسمانية إلى مستوى الروحانيات ونورانياتِ القلب، وذلك بعناية الله والتشبثِ بأوامره، بمعنى أننا نقول هذه الكلمة ونتشبَّثُ بها للارتقاء والصعودِ بها إلى الكمالات الإنسانية.
وحينما تُطلَق كلمة “اسم” يتبادر إلى الذهن جميعُ أسماء الله الحسنى، ولله تعالى أسماءٌ بعدَدِ تصرُّفاتِهِ في الكون، فكأنَّ هذه الأسماءَ التي تمثُلُ أمام أنظارِنا بِذِكْرِ هذه الكلِمَةِ، قد تعلَّقَتْ النيّة بها أثناء ذكر لفظ الجلالة “الله”، وكأنّها كلُّها وردَ ذكرُها بتمامِها، وذلك على قدرِ سَعةِ النية واستيعابها؛ أي إنَّ من يقول: “بسم الله” يكون كأنه نوى أن يَذكُر: “الملك، القدوس، العزيز، الرزاق، الخالق… وغيرها مما لا يُحصَى من أسماء الله واستَشفَعَ بها… وبما أن كل الحركات والمَطالبِ منوطةٌ بهذا الاسم؛ فإن القوة الخارقة اللامتناهية التي في البسملة جديرةٌ بالاهتمام، وتحمِلُ دلالاتٍ عميقةً، فالذي يقول: “بسم الله” يكون كأنه ذكر الأسماء الحسنى كلَّها واستشفَعَ بها في نَيل ما يريد.
والإنسان الذي يقول: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ يكون في الوقت نفسه في مقام “الغَيبة”، أي في مقام “الفَرْق”، أي في مقامٍ يتحدث عن الله بـ”هو”، ففي مقامٍ كهذا حينما يقول: “بسم الله” تَحُولُ كلمة “اسم” بين الإنسان وبين لفظِ الجلالة.
إن الكون عبارةٌ عن تجليات الأسماء الإلهية، والذي يتموَّجُ في كلِّ مكانٍ هو أسماء الله، وحينما يُقال: “اسم”، فكلُّ هذه التموُّجات تتبادرُ إلى الذهن، فنحن نُعَبِّرُ بلفظِ الجلالةِ عن هذا المعنى اللاهوتيِّ المتعلِّقِ بالألوهية.
فنحن عبارةٌ عن النقطة التي تحت باء البسملة، سئل الشِّبلي: “هل أنت الشبلي؟” فأجاب: “لا، بل أنا نقطةٌ تَسْتَظِّل تحت خطٍّ مستقيمٍ نورانيٍّ، وأنا مرآة لوجوده “.
ج. لفظُ الجلالةِ الأشرف: “الله”
لا يروق لي القولُ بأن هذه اللفظة أعجمية نُقِلَتْ إلى العربية، ولا يطيب لي البحث عن أصلٍ لها حسبَ علمِ الاشتقاقِ كأنْ يُقال: إنها مأخوذةٌ من هذا الجذر أو مشتقة من ذاك… صحيح أن من العلماء من أرجعها إلى بعض الكلمات وحاوَلَ أن يجد لها أصلًا، ولكني -وأنا العاجز الفقير- أقول حسبَ رأيي المتواضع: “كما أن ذاتَ الباري أزليّةٌ؛ فكذلك اسمه من الأزل هو “الله”، وليس من المناسب البحثُ عن أصلٍ لكلمةِ: “الله”، ولكن هناك كلمات تدور في فَلَك هذه اللفظة الجليلة، وكأنها تقول: أنا لي وجهُ شَبَهٍ بهذه الكلمة، ونحن بدورِنا سنقوم بعرضِها وسردِها:
إن كلَّ شيءٍ منوطٌ بالله، وكلُّ شيءٍ قائمٌ بالله، ونورُ وجهِ الكائنات وضياؤُه هي لفظةُ: “الله”، وكلُّ مكانٍ لا توجد فيه كلمة “الله” فسيكون ما فيه من العلوم والمعارف عبارةً عن خيالٍ وسرابٍ، وستُصْبِحُ ركامًا من أفكارٍ غيرِ مفهومةٍ، ومستعصيةً على الحلّ، فدخولُ كلِّ العلوم في القرن العشرين في مأزقٍ وطريقٍ مسدودٍ إنما هو بهذا السبب، وكلُّ العلوم والتقنيات والفنون التي لا تستند إلى كلمة: “الله” مسدودةٌ وغير نافذة، وتنطوي على عديد من التردّد والشبهات، ورجلُ العِلْمِ قد يسمّيها بأسماء مثل: “الفرضيّة” أو “النظريّة” أو أسماء أخرى، ويحاولُ أن يقدِّمها للناس وكأنها معلومةُ الماهيةِ؛ ولكن الحقيقة أنها لم تُعرَفْ بعدُ لا بمعناها ولا بماهيَّتِها.
إن كلَّ شيءٍ في الكون يستند إلى حقيقةٍ، ولا بدَّ أن يكون في أساسِ كلِّ شيءٍ حقيقةٌ، ويجب أن يكون في أساسِ هذا الكون الرائع أيضًا حقيقةٌ كبرى يستنِدُ إليها ويجدُ بها معناهُ، وإنَّ صرحًا فنّيًّا رائعًا مثل الإنسان الذي هو ثمرةٌ لشجرةِ الكون لا يمكن إسنادُهُ إلى بعضِ الفرضيّات، كأنْ يستند -مثلًا- إلى ما يسمَّى: “الأميبا” (AMİP) التي تعيشُ تحت البحار، ولا إلى الدِّيدان، ولا لرياح الصُّدفة، بل لا بد أن تكون وراء هذه التحفةِ الفنّيّة حقيقةٌ كبرى، وتلك هي ما تعبّر عنها كلماتُ: “الله”، “الرحمن”، “الرحيم”.
وأودُّ هنا أن أَلفتَ الأنظارَ إلى نقطةٍ؛ وهي أن هناك تياراتٍ علميةً نشأت في شرقيِّ العالم وغربـيِّه وشماله وجنوبه، وأن ثـمَّةَ دُوَلًا قَطعتْ أشواطا بعيدة في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولكن عندما تنسدُّ كلُّ الطُّرُقِ فإن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله سيستنجدون بأولئك الذين تعلَّقت قلوبهم بالله والذين يحلِّقون بكلِّ مشاعرهم كالفراشة حول الإيمان به تعالى، ويؤمنون حقّ الإيمان.
وإذا كان هناك مَن يريد تنسيقَ العلومِ، فإن هذا إنما يتأتَّى بإسنادها إلى لفظةِ: “الله”، وحينَها ستكون العلوم والمعارف مستنِدَةً إلى حقيقةٍ، وستجدُ لونَها وصبغتَها الحقيقيّة.
إن “المؤمنين بالله” هم الذين سيوجِّهون العلوم والمعارف إلى مَجرًى جديدٍ، وسيؤسّسون العلومَ والمعارف على أسسٍ متينةٍ… فإن لم يتحقَّقْ ذلك ولم يُفهَمْ معنى الكون، فإن الله U سيدمِّرُ الكونَ ويبعثرُهُ، بسبب أنه لم يعُدْ معناه مفهومًا ولم يعد يُستخدَمُ في السبيل التي خَطَّها الله له…
إن الله المعبود بالحق والمقصود بالاستحقاق، إنه الموجودُ الوحيد الذي يستحقُّ العبادة…
والله محبوبٌ بذاته…
والقلوب بذكره تطمئن، وكل القلوب المنكسرة إذا وصلتْ إلى أعتاب بابه صُبَّتْ فيها السكينة…
والله هو العلي الأعلى، فليس لشرك المشرك أن يصل إلى مقامِ عزِّه وعظمته…
إنه لا تدركه الأبصارُ، وهو متعالٍ علوًّا كبيرًا، وهو الذي يُدبِّرُ الكونَ كلَّهُ… إننا لا نراه بأبصارِنا ولكنّنا نشاهدُ ونُعاين في كلِّ شيء آثارَه التي هي أبرز من كلِّ عيان وأنصعُ من كل ناصعٍ أو برهان… فندركُ أنه تعالى “مُختَفٍ من شدة ظهوره”.
وهو ملجأُ المنكسِرة قلوبُهم أجمعين، وهو منبعُ حيرةٍ للمؤمنين؛ فكلُّ مَن زادت معرفَتُهُ بالله سيغوص في بِحارِ الحَيرةِ..
والله معبودُ كلِّ إنسان، إنه تعالى المعبود بحقٍّ لأنه هو: “الله”.
والآن لنستخرجْ هذه المعاني من تلك الكلمات القريبة من لفظة الجلالة: “الله”.
1- تحليل لبعض الألفاظ القريبة من لفظ الجلالة “الله”
أ. “أَلَهَ – يَأْلَهُ”:
“أَلَهَ”: بمعنى “عَبَدَ” لأنه تعالى هو المعبود، أي المتفرِّدُ باستحقاق العبوديّة، و”أَلَهْتُ إِلَى فُلَان” أي سكنتُ إليه، إن الإنسان يسعى دائمًا للوصولِ إلى الكمالِ، وفي سبيل ذلك يعمل دونما كللٍ أو مللٍ، فيقطع المسافات الشاسعة، وإن الذي لم يَفقد إنسانيَّتَهُ ويحملُ بين جوانحه القلبَ والوجدان سيكدُّ ويكدح من دون توقُّف حتى يصل في نهاية المطاف إلى الكمال الذي قُدِّرَ له، والله ذو الكمال المطلقِ هو الذي سيمنحُهُ ويدلُّه على الكمال… وهذا الإنسان سيرتقي إلى مقام الأسماء، ومن مقام الأسماء إلى مقام الصفات، ومن ذلك إلى مقام الشؤون الذاتية، وكلَّما ارتقى سيزداد حيرةً ودهشةً، وسيظلُّ مهرولًا حتى يَصِلَ إلى الكمال، وعندما يأذنُ اللهُ له بالنضجِ والكمال تنزِل السكينة في قلبه، ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، فالمحطَّةُ الأخيرة التي يلجأ إليها الباحثون عن الكمال هي الله، وبالتالي فهناك مناسبة بين لفظةِ “الله” وكلمةِ “أَلَهَ”.
ب. “أَلِهَ – يَأْلَهُ”
منها فعلُ “أَلِهَ” بمعنى لجأ؛ يقال: “أَلِه الفصيلُ”؛ أي ولعَ بأمه، فكما أن هذا الفصيلَ يَجعلُ عجزَه وفقرَهُ شفيعًا فيلجأُ إلى أمِّهِ، حتى إن أمَّهُ تركله أحيانًا ولكنه لا يتلكَّأُ في اللجوء إليها مرارًا وتكرارًا؛ فكذلك الإنسان العاجزُ الفقير كسيرُ القلبِ مهيضُ الجناحِ المغلوبُ على أمرِهِ، يلجأُ إلى رحمةِ الله ورأفَتِهِ، والحقيقةُ أنه ليس هناك مَن يُستجارُ به فيعود بالنفعِ على المستجيرِ إلا الحقُّ I، فمعنى الالتجاء هذا مكنونٌ في لفظ الجلالة.
جـ. “وَلَهَ – يَلِهُ”
“وَلَهَ” بمعنى تَحيَّر وذهبَ عقلُهُ، وهذه الكلمة تُعبِّر عن مقام الحيرةِ، والحقيقةُ أن كلَّ إنسانٍ إذا تجلَّى له نور التوحيد تأخذه الحيرة والاندهاش، إن بعض الناس لا يستطيع أن يتخطى جسمانيته، فيظلُّ سجينًا في قَفَصِ بَدَنِهِ ذي الجوِّ الخانِقِ الكئيبِ، ولا يدري ماذا عليه أن يفعل، وهذا نوعٌ من الحيرة، في حين أن البعضَ الآخر يتخطّى مقام “الأسماء” ويكون على مشارفِ مقامِ الصِّفات، ولكنه لا يتسنَّى له الكشفُ عمَّا وراءَ ذلك، وهذا يكون أيضًا في “حيرة” ولكن من نوعٍ آخر… وأيًّا مَّا كان نوعُ الحيرةِ فهذه الحيرةُ لونٌ من ألوانِ تجلِّي نورِ التوحيد… وهذا المعنى العظيم أيضًا مكنوزٌ في لفظ الجلالةِ “الله”.
د. “لَاهَ – يَلِيهُ”
ومن تلك الكلمات التي تَمُتُّ إلى لفظ الجلالة بصلةٍ فعلُ “لَاهَ” أي احْتجَبَ واختفى؛ إن الله لا يُرَى بالعين، والحال أنه أظهرُ من كلِّ ظاهرٍ؛ فعدَمُ رؤيَتِنا له إنما هو لكونه في ذروة الكمال أي لشدَّةِ ظهوره، بالإضافة إلى أن الله تعالى ليسَ له ضدٌّ ولا ندّ؛ والشيءُ إنما يُرى إذا كان له ضدّ ولم يكن مرتقيًا إلى درجة الكمال في مراتب الوجود، فالليل يُرى ويُدرَك لأن له ضدًّا وهو النهار، وكذلك الأمرُ بالنسبة للنهار لأنه ضدُّ الليل، والحرارةُ كذلك إنما يُحَس بها بالبرودة، والعكسُ صحيحٌ…
ذلك الله الذي إنما تتحقَّقُ كلّ الأمور من الرؤية والسمع، والحياة والموت، والإيمان والكفر، والعدل والظلم، وسائرُ الأضداد بتجلِّيه تعالى، والخير والشر منه، فهل يمكن رؤيةُ الله الذي منه كلُّ شيء وليسَ له ضدٌّ ولا ندّ! ولذلك نقول: “إنه مختفٍ مِن شِدَّةِ ظهورِهِ”، يدعوه أرباب القلوب في مناجاتهم قائلين: “يا من احتجبَ لشدَّةِ ظهورِهِ وخفيَ عن الأبصار لعظيمِ نورِهِ”.
و”لَاهَ” يأتي بمعنى “ارتفع” أيضًا… فالـمُشرِكُ مهما اتَّخَذَ على وجهِ الأرضِ شركاء لله، وجاوزَ حدَّهُ فقال: “إني سبحتُ في أجواء الفضاء فلم أعثر -حاشَ لله- على الله”[1]؛ فالله الذي تَنزَّه عن الزمان والمكان، والذي يحكُمُ الكونَ كلَّه، والذي يقلبُ كلَّ شيءٍ في قبضةِ تصَرُّفِهِ كيف يشاءُ؛ لهوَ مرتفعٌ ومتعالٍ عن كلِّ أنواعِ الشِّرْكِ والشركاء…
2- خصوصيّة لفظ الجلالة
ومن خصائص لفظ الجلالة “الله” من التميُّزِ ما لا نَجِدُهُ في الأسماءِ الأُخرى؛ فإنك إذا حذفتَ منهُ الهمزةَ يكونُ الباقي “لله”، وإذا حذفتَ اللامَ الأولى يبقى “له” ويمكن أن يُحمل على معنى “لأجلِهِ تعالى”، وإذا حذفت اللامين مع الألف يبقى “هُـ” أي: “هُو”، وهذا الضمير يمكن أن نشيرَ به إلى الله تعالى.
فلفظ الجلالةِ لفظ معجز بهذه الدرجة، فلنقف باختصار على هذا الحرف الأخير منه (هُ)، ثم لنعرِّجْ مرة أخرى على معناه بشكل عام.
إن “هُـ” (هُوَ) بحدِّ ذاتِهِ معجزٌ، والإنسان حينما يقول: “هُـ” (هُو) يستذكر المعنى التالي أو إن استحضار المعنى التالي يجعله يقول: “هُـ” (هو)، حيث إن العبد يقول: يا إلهي! أين أنا منك، فأنا المخلوقُ من ماءٍ مهين، وأنت المعبود بحقٍّ سلطانُ الأزل والأبد، فأنا لا أستطيع أن أخاطبك بـ”أنت”، بل إنما أناجيك بـضمير الغيبة “هُـ” (هو) في سياق التعبير عن معاني جميع أسمائك التي مَلَأَت الكونَ، وإنما أشفي غليلَ صدري بأن أقول: “هُـ” (هو).
والإنسان في كثير من الأحيان حينما يذكر اسمًا من أسماء الله تعالى، يستحضرُ علاقة ذلك الاسم بالموجودات ويأخذ بعين الاعتبار علاقةَ ذلك الاسم بنفسِهِ، فمثلًا: حينما يقول: “يا كريم” قد يستحضر إكرام الله له ويقوله طالبًا إكرامَه، وحينما يقول: “يا مُحسِن” طالبًا إحسانَ الله تعالى، وحينما يقول: “يا جميل” يستحضر تجليات الله الجمالية، وهكذا قد تشوب الإخلاصَ هَناتٌ ولو إلى حدٍّ ما، في حين أنه حينما يقول: “هو” فإنه يكون قد تَخطَّى كلَّ الأماني والمطالِبِ، وأَعلَن أن الله تعالى هو المعبودُ الـمُطلَقُ لا لشيءٍ بل لأنه هو “الله”، وهذا سيشفي غليلَ صدرِه بحيث لا يدرك مدى الذوق الرفيع الذي يَشعر به هذا القائل إلا مَن سَبق له أنْ قال من أعماق أعماق ضميرِهِ: “هوووو”، فهذا اللفظُ له تأثيرٌ كبيرٌ على التربية الروحيّة.
وأيضا فإن الله يعرِّفنا بذاته من خلال أفعاله وآثاره، ونحن بِدَورِنا نَعْرفُهُ بِقَدْرِ تجلِّياتِهِ وآثارِهِ الموجودةِ لدينا، ولكن هذه المعرفة نسبية، وتُعدُّ معرفةً ناقصةً إذا قارنَّاها بالمعرفة الحقيقيّة، لأن الإنسان لن يتأتَّى له أن يُدْرِكَ ويستوعبَ كلَّ هذه الأفعال الجارية في الكون، ويحيطَ علمًا بفاعِلِها، من خلالِ عدسةِ ما أُسدي إليه من الألطاف والإحسانات، بل إنه سيُقَيِّم القضيَّةَ في إطارِ موازينِهِ الشخصيَّةِ، فالعبدُ حينما يستشْعِرُ بأنه ماثلٌ بين يدي الله، الذي يُعرِّفنا بذاته من خلال آياته الآفاقيّة والأنفسيّة، فإنه يستحيي أو يُكسَفُ من التوجه إليه تعالى بلفظةِ الخطابِ: “أنت”، فيقولُ في مقام الغَيبة: “هو”، والواقعُ أنَّ كلَّ زفيرٍ وشهيقٍ منَّا عبارةٌ عن “هو”، أي إنَّ “هو” منبعُ حياةٍ لنا، ولا يمكن لنا مواصلة حياتِنا إلا بِهِ.
وهناك أمر آخر وهو: أن الإنسان بين يدي ذلك السلطان وأمام سلطنته العظيمة ينسى جوعه وعطشَهُ، وينسى كذلك كلَّ أنواع أبَّهَتِهِ وبهرَجَتِهِ، بل إنه ينسى كيانه ووجودَه، فيَصرِف نظرَه عن كلِّ شيءٍ آخر، فيوجهه إليه فقط، وهناك يقول: “هو”، فكلُّ شيءٍ ينمحي وينعَدِمُ مِن أمامِ نظراتِهِ مع كيانِهِ وذاتِهِ.
فنحن إذ نقول: “بسم الله”، نكون قد تَصوَّرنا وشاهدنا هذه المعاني…
د. الاسمان الجليلان: الرحمن، الرحيم
إن لفظة “الرحمن” من الصفات المشبهة الدالَّة على المبالغَةِ، وهي صفةٌ خاصَّةٌ بالله عزَّ وجلّ؛ حيث إننا حينما نقول: الرحمن، فالذي يتبادَرُ إلى أذهانِنا هو الله، فالله هو المقصود من قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (سورة طَهَ: 20/5) أو ﴿الرَّحْمَنُ $ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (سورة الرَّحْمَنِ: 55/2)، ومعنى الرحمن: الذي يرحمُ رحمةً لا نهائيَّة، والذي يغذّي بِنِعَمِهِ تغذيةً سرمديّة.
و”الرحيم” أيضا من أسماء الله تعالى كـ”الرحمن”، لكن الرحيم صفةٌ لا تختصّ بالله تعالى، وهي تُطلَق على المخلوقِ أيضًا.
والآن تعالوا بنا نُقارِنْ بين هاتين الكَلِمَتِين:
هـ. مقارنة بين كَلِمَتَي “الرحمن” و”الرحيم”
إن كِلَا الكلمتين مشتقَّتان من “الرحمة”، وتُعَبِّران عن رحمةِ الله، ولكن في حين أن إحداهما تُعَبِّرُ عن رحمتِهِ الشامِلَةِ العامَّةِ في أوسعِ أشكالِها، تُعَبِّرُ الأخرى عن “رحمةٍ خاصَّةٍ”، وبتعبير دقيق نقول: إن الرحمن تجلٍّ لـ”الواحديّة”، وأما الرحيم فهو تجلٍّ لـ”الأحديّة”.
إن كلمة “الرحمن” متوجهة إلى “الأزل” بينما تتوجّه كلمة “الرحيم” إلى “اللايزال”، واللهُ قد أوجد الكونَ من العدم بتَعلُّقِ المرحمة التي في روح الاسم الجليل: الرحمن، فالأنظمة والأجرام السماوية وبنو الإنسان والأشجارُ والطيورُ وسائرُ الأشياء قد وُجدت بالاسم الجليل: الرحمن، وكلُّ الموجودات مَعكسٌ لتجلِّي الاسم الجليل: الرحمن، فهذه الرحمة العامة الشاملة قد وَسِعَتِ الكون واستوعبته قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/156)، فأحاطت “الرحمانيةُ” بجميع الكائنات.
وكلُّ شيء يخضع للأوامر الإلهية -طوعًا أو كرهًا- تحت الرحمانيّة، ففي الرحمانيّة نوع من الجبريّة، حيث إن الله تعالى لم يستأذِن الكونَ حينما خلقَهُ، لم يستأذِنَّا ولم يستأذن الطيورَ والأشجارَ والأحجار، فهذه الجبريّة تنبع من واحديّة الله تعالى، إنه مالك الـمُلك يتصرَّفُ في مُلكِهِ كيف يشاء، وليس لأحدٍ أن يتدخَّل فيما يفعل، فإن تناولْنا الأمرَ من منظورِ اسمِ الرحمن فقط فلا يبقى أيُّ فرقٍ بين إيمان العبدِ وكُفرِهِ، وبين العدل والظلم، وبين الحقِّ والباطل، وبين الحُسنِ والقُبح، وبين الخير والشر… لأنه ليس هناك مجال لإرادة الإنسان، وهكذا يكون الإنسان مثلَ سائرِ الموجودات؛ غيرَ مُدانٍ على سيِّـــئاته، ولا مُثابٍ على حسناتِهِ، بل يكون مثلَ أيِّ شجرٍ أو حجرٍ أو بهيمةٍ يعيشُ في حدود الفِطرة، فلو كانت تجلِّيات “الرحمن” فقط هي التي تَحكُم الكون؛ لكانَ الوضعُ على هذا المنوال، ولكن شاء الله U أن يُودِع في الإنسان “الإرادةَ”، فاقتضَتْ حِكْمَتُهُ أن يجزيَ بالحسنى مَن استَعمل إرادتَهُ في الخير، وأن يُعاقِبَ من استعمَلَها في الشرِّ، وذلك هو تجلّيهِ تعالى بـ”رحيميَّتِهِ”، وبهذا يكون الله تعالى قد مكَّنَ الإنسانَ ويسَّر له السبيلَ من أسفل سافلين إلى أعلى عِلِّيِّين؛ فإما أن يرتقي إلى أعلى عِلِّيِّين، أو ينحطّ إلى أسفل سافلين.
أجل، إذا كان الطيرُ يُرفرِفُ بجناحيه فيطيرُ ويُحلِّقُ في الآفاقِ عاليًا ثمَّ يرجعُ إلى فراخِهِ؛ وإذا كانت الأشجارُ تنمو وتطولُ وتَبْسقُ؛ والعيون تجري نضّاخةً؛ والنباتاتُ تَخْرُجُ مخضرَّةً؛ والأشجارُ تؤتي أُكُلَها في موسِمها؛ والبهائمُ تُعامِلُ أولادَهَا بمنتهى الشفقة والرأفة… فإنما ذلك كلَّه من تجلِّيَّات “الرحمن”، ولكن هذه الموجودات لا تملك الإرادة، بل إنها مضطرَّةٌ للعيشِ في إطار الحدود التي رَسَمَها وعلَّمها وقدَّرها لها “الرحمن”، في حين أن لله تعالى نوعًا خاصًّا من تجلِّيات الرَّحمة، وهي متعلِّقة بـــ”الإرادة”، وهذا هو ما نفهمُهُ من كلمةِ “الرحيم”.
وحاصلُ القولِ هو: أنه لولا “الرحمن” لم نأتِ إلى عالم الوجود، ولَانْعَدَمَ الكونُ وسائرُ الموجودات… ولولا “الرحيم” لما كنا نستعمل “الإرادة”، ولَـــكُــنَّا نعجز عن إدراك دقائِقِ صُنْعِ الحقِّ .
فـ”الرحمن” بَسَطَ الكونَ أمام أنظارنا مثل كِتابٍ كبير، و”الرحيمُ” مَنَحَنا “الإرادةَ” لكي نقرأَ ذلك الكتاب، فنُحوِّلَ باقاتِ الأنوار التي نلتقطُها من ذلك الكتاب إلى إيمانٍ في قلوبنا، وكذلك مكَّنَنَا “الرحيمُ” من أن نجتازَ حدودَ الكائنات، ونقتربَ من سواحل الأسماء الإلهيّة ونبحثَ في مكنونات كيفيّات الصفات السبحانيّة وأحوالها، ونتعرّفَ على ذات الباري، إنَّ إدراكَ ذات الباري غير ممكنٍ؛ فلو حاوَلْنا أن نشرح بألفِ اسمٍ من أسمائِهِ بل بملياراتٍ منها لَمَا استطعنا أن نأتيَ بشيءٍ يُذكَر في بيان ذات الباري، يقول سيدنا أبو بكر : “العجزُ عن دَركِ الإدراك إدراكٌ”[2]، وفي الخبر: “مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفُ”[3]، ومن هذا المنطلق فنحن أيضًا نقول في مقام الاعتراف بعجزنا والإعلانِ عنه: (شعر)
إن إدراك المعالي ليسَ من شأن هذا العقل الصغير
فإن هذا الميزان ينوءُ بهذا الحِملِ الكبير
(ضياء باشا)
وفحوى الكلام أن الحقَّ فتَحَ لنا أبوابَ هذا الكون بـ”بسم الله”، ودعانا إلى مشاهدته، وسَيُغْلِق أبوابَ الكون بـ”بسم الله” أيضًا، ويفتح أبواب دار السلام بـ”بسم الله” وسيدعو بني الإنسان إلى الجنة للفوزِ بالسعادة الأبديّة.
و- البسملة: حبلٌ نورانيٌّ يَربط قلبَ الإنسان بالعرش الأعظم
نلاحظ أن البسملة تتجلّى في كلِّ مكان، لأنها تحتوي على لفظِ الجلالة “الله” تلك الكلمة التي تتضمَّن كلَّ الأسماء الإلهيّة الحسنى.
إن كلَّ الحقائق التي يتولَّى القرآنُ شرْحَها وبيانها مندرجةٌ بشكلٍ مختصرٍ في البسملة، ومن المؤكد أن لهذا انعكاسًا على قوَّة تأثيرِ البسملة؛ وهذا يوضِّحُ سرَّ قول الرسول: “كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ” أَقْطَعُ”[4]، وفي رواية: “أَبْتَرُ” وفي أخرى: “أَجْذَمُ”، وكل هذه الألفاظ متقاربةُ المعاني، وهي في مجملها تعني أن كلَّ الأعمال التي لا يُبدأ فيها باسم الله فهي ممحوقةُ البركةِ قصيرةُ العمرِ مبتورةُ الجذورِ ناقصةُ الثمرِ.
والقرآن يتناول أربع حقائق كبرى، وهي: التوحيد والنبوّة والحشر والعدل، والبسمَلَةُ تتضمَّنُ هذه الأمور الأربعة بشكلٍ مجملٍ؛ فالاسمُ الأوّلُ فيها وهو لفظُ الجلالة “الله” متوجِّهٌ بشكلٍ صريحٍ نحو التوحيد، والثاني وهو “الرحمنُ” يدلُّ على النبوَّة، والثالثُ والأخيرُ فيها هو “الرحيمُ” وهو يُعَبِّر عن الحشرِ والعَدْلِ.
والبسملةُ موجودةٌ في بدايةِ كلِّ سورةٍ من سُوَرِ القرآنِ إلا سورة “براءة”، ويجب -بالإجماع- على كل من ينسخ المصحف أن يكتبها في بداية السور، وإذا تركها يكون قد ارتكب إثمًا.
وفي قراءة البسملة في الصلاة قبل الفاتحة اختلافٌ بين فقهاء الأمة، فعند بعضهم واجب، وعند بعضٍ منهم سنة، وعند البعض مندوب، في حين أن قسمًا منهم يرونها مكروهًا.
ومن العلماء مَن عَدَّ البسملةَ آيةً برأسِها، ولم يعدّها آخرون آيةً قائمةً برأسِها وإنما هي أُنزِلت للتبرُّكِ والفصلِ بين السور إلا التي في سورة النمل.
والبسملة هي بمثابة المفتاح لكلِّ شيء في الحياة، كما أنها بمنزلةِ المفتاح للسُّوَرِ القرآنيَّة، فالبسملة في بداية السورة؛ -سواء كُتبت للفصل بين السور، أو للتبرك والاستعانة بالله تعالى على فهم السورة والعمل بمقتضاها، أو لأيِّ غرض آخر- هي حبلٌ نورانيٌّ دُلِّـيَ من العرش الأعظم إلى قلب الإنسان؛ فالذين يدركون المعاني السامية لـ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ويستفيدون من فيوضاتها، يستطيعون الاستمساك بها والارتقاءَ إلى عرش “الإنسانية”.
إن الله تعالى شَرَحَ وبيَّن في الكتب التي أنزلَها كلَّ الحقائق الموجودة في الكون، حيث إنه عبَّر عن هذه الحقائق الكبرى على شكلِ معانٍ في صدور الأنبياء الذين يمتلكونَ قلوبًا مؤهَّلةً لِتَجلِّي تلك الحقائق وبروزِها، وأَعرَب عنها في صورةِ حروفٍ وكلمات على ألسنتهم، وقد فصَّلَ القرآنُ الكريم خاتمُ الكتب كلَّ ما سبقَ إجمالُه في الكتب والصحفِ والألواحِ المقدّسة السابقةِ، والقرآنُ الكريمُ هذا بتمامِهِ تتضمَّنه سورةُ الفاتحة، كما أن الفاتحة ملخَّصَةٌ في البسملة، فالبسملة خطٌّ نورانيٌّ يربطُ بين كلِّ الأنبياء والكتب، وكلُّ الحقائق الموجودة في الكون موجودة -لا محالة- في البسملةِ على شكل نواة، ولكن لا يوفَّق كلُّ أحدٍ للعثور عليها واستخراجها.
[1] يُحكى أن رائدَ الفضاء السوفيتي “يوري جاجارين” الذي يُعتبر أول إنسان تمكن من الطيران إلى الفضاء قال هذه المقالة. (الناشر)
[2] الغزالي: إحياء علوم الدين، 4/252؛ المقصد الأسنى، ص 54؛ السيوطي: شرح سنن ابن ماجه، 1/103.
[3] المناوي: فيض القدير، 2/410؛ الألوسي: روح المعاني، 4/79، 17/202.
[4] رواه عبد القادر الرُّهاوي في “الأربعين البلدانية”.