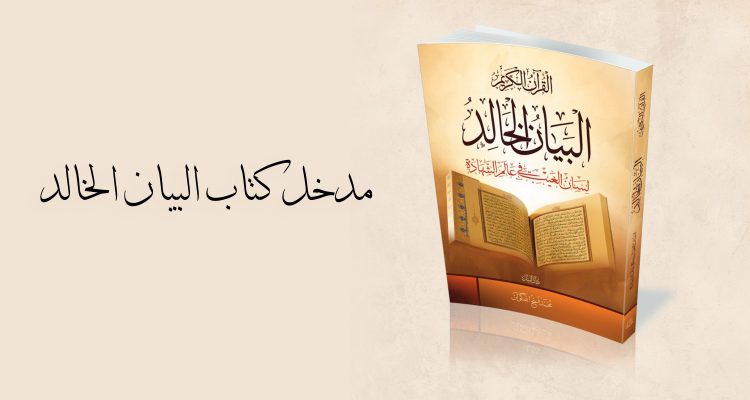“الكتاب “لغةً: الجمع والضم، وإنما سُمِّيَ المؤلَّفُ كتابًا لأنه يجمع مسائل شتّى تبحث موضوعًا مَا ويؤلف بينها؛ ومثله الكون من حيث معناه ومحتواه، فهو أيضًا كتابٌ؛ فالفيزياء والكيمياء وعلومُ الفلك وآلاف العلوم الأخرى تشتبك وتتآزر في صفحات الكون؛ كيف لا، وَيَدُ “القدرة” و”الإرادة” هي التي خَطَّتْه فتَحقّقتْ مفرداتُه كما سبق به القَدَر الإلهي، فالكون بحروفه وسطوره مرآةٌ لتجلياتِ الأسماء الحسنى والصفات الإلهية.
وكلمة “كتاب” إنما تتجلى بأسمى معانيها ومبانيها في القرآن الكريم:
إذ ليس كمثله كتاب جمعًا وإحاطة؛ فهو أحق بأن نسمّيَه “مَجمع البحرين”؛ ففيه يجتمع البحران، ويلتقي المحيطان.
وبه وحده انكشف للأنظار ما اجتمع في لُباب الوجود وقشوره ومظهره ومخبره
من إعجاز.
ولن تجد في الذروة كتابًا سواه يتآزر فيه اللفظ والمعنى ويجتمعان، ويوازنُ فيه بين الدنيا والآخرة بموازين القسط، وفي جمعه وتصديقه لما بين يديه من الكتب السماوية وجهٌ معجزٌ لا تراه في سواه.
وبهذه الوجوه يمثّل القرآن “مقام الجمع” في عالم البيان. أجل، إنه لكتاب عزيز جَمع “الحقائق الثابتة” و”الأعيان الثابتة”؛ ففيه اجتمع المُلك والملكوت، والشاهد والغائب من العوالم، وهو لسان عالم الغيب في عالم الشهادة، يخبر عنه على وجه لا يأتيه الباطل؛ فهو من هذا الوجه جامع مانع؛ ولهذه الخصائص صار لفظ “الكتاب” إذا أُطلق لا يتبادر منه إلى الذهن إلا القرآن.
واليوم كثيرون هم المفكرون المجمعون على أن في قابل السنين حقبةً يُقبل الناس فيها على القرآن؛ وحسبُك قليلٌ من التأمُّل لتدرك أن عصرنا هذا يغذّ السير نحو القرآن غذًّا لا تبلغه مَداركنا وتصوُّراتنا.
ولك أن تقول: إن من تدبّر القرآن -وإن على عَجَل- بوسعه أن يدركَ ما بين القرآن والكون من صلات، ويقف على صدقه في حديثه عن الكون، ولا يسعه إلا أن يقف مبهورًا أمام ما تحمِل رسائله من قوة ونور.
ومما يؤثَر عن أهل العلم والحكمة: لقد كَشَف هذا الكتاب الجليل لأنظار أولي العلم والمعرفة ما أُودِعَ في الكون من أسرار وما تكنّه روح الطبيعة من دقائق وكأنه كتاب يطالع بذوق ونهم.. إن القرآن هو الذي استقرأ جزئيات الوجود وكلياته، وبيَّنَ غايتَه ومحتواه وأُسُسَه، وعرضها للأنظار عرضًا لا يلتبس معه شيء.
وهو المعجزُ في بيانه، الذي يُنظِّم حياة القلب وما يليه من روح وفِكر، ويهديه إلى أسمى الأهداف، وما يزال به حتى يبلغها، ثم يأمره باللطف والرحمة والشفقة والعدالة في المعاملة، ويضرب بينه وبين السيئات والشرور بأسوارٍ يكاد يتعذر تَسَوُّرها.
وهو البيان الإلهي الذي ينبِّه الإنسان إلى طرق استثمار ما حباه الله من صحة وطاقة واستعدادات وقابليات وإمكانات وقدرات… ويعلِّمُه كيفية الاستفادة المُثلى من هذه النِّعم، وهو بهذا يربأ بالناس أن يتواكل أحدٌ على أحد.
هذا الكتاب هو منبع النور؛ فالذين نِيطَت قلوبهم به واتَّـبَعوه تتّقد في أرواحهم جذوةُ مبادئ الحرية ومفاهيم العدالة وروحُ الأخوَّة ورغبةُ العيش من أجل الآخرين… وهكذا يُعلِّم هذا الكتاب مخلوقاتٍ من لحم ودم آدابًا تَغْدُو بها ملائكة، ويدلُّهم على سعادة الدارين، ويدَعُ أبوابها مُشْرَعةً أمامهم.
وهو الكتاب المرشد القدوة؛ يهدي عيونًا تفتَّحَتْ بفضله على الحقيقة، فيطوّف بها في العوالم الغيبية، ويسيح بالقلوب الشَّبْعى بالطمأنينة في أقاليم المهابة، ويجعل الأرواح السائحة منتشيةً بمشاعر الدهشة والإعجاب مما تلقاه، ويمدّ ذا الوجدان النزيه بنفحاتٍ جديدة في كل حين.
لقد أَنْقَذَ هذا الكتابُ الناسَ من شتى أنواع الضلال، وأرشدهم إلى سبيل الفضيلة، وبيَّن للناس أنَّ مَن أطاع أوامر الله تعالى فله من الجزاء الحَسَنِ والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنَّ مَن عصاه وضيَّع حدودَه فله من العقاب الشديد ما تَزيغ منه الأبصار، وتَبْلُغُ به القلوبُ الحناجرَ… وفي هذا التبيان توازن رائعٌ يبهر العقولَ والألباب.
وها هو ذا القرآن لم يزلْ كما نزل يوم أن شرَّف هذه البسيطة، وظلَّ الرسالةَ الإلهية الفريدةَ التي تقلَّدَت وسامَ المحافظة على أصلِها -أعني الوحي السماوي- رغم أن الجاحدين التُّعسَاء ممن دأبوا على العداوة والبغضاء بذلوا كمًّا هائلًا وهم يمارسون العدوان عليه محاولين تغييره وتحريفه.
والقرآن هو أبهى دُرّةٍ لِلَّوح المحفوظ، ويوم أن نزل لم يكن له مثيل أو نظير، وما يزال إلى اليوم مختصًّا بهذا التميز والقيمة والبيان، بل إنه لَيزداد أبّهة وروعة، وسيكون الزمنُ القادم إن شاء الله زمنَه الذي يعلو فيه بحقائقه فوق هامات الشموس.
ومنذ أن نزلَ وهو يحيط بجهات الكون شرقها وغربها وشمالها وجنوبها بأذرع نورانية، وينشر العلوم في كلّ مكان حتى غدت أنحاء المعمورة كلها من ربوع الجنان؛ وكان حَمَلة رايته يومئذ يُبَصِّرون الإنسانية بمسالك “حضارة القرآن”، ويمثّلون رسالته النورانية على أكمل وجه حتى لو أن من يُدعون أساتذة العالم اليوم كانوا
في زمنهم لَمَا صلحوا أن يكونوا من تلامذتهم المبتدِئين.
نزل القرآن المجيد برسالات نورانية أزلية وأبدية؛ لقد ربَّى أبداننا، وزكَّى قلوبَنا وأرواحَنا وعقولنا ووجداننا، وهيَّأَنَا لنكون “جيل المستقبل”، ونَصَبَ أمامنا الأهداف السامية التي تسمو على الذرى المادية والمعنوية، حتى أيقَنّا أنه سيصبح في المستقبل القريب كوثرًا ومنهلًا للأمم والدول الواعية؛ ولا ضير في عُمْيٍ لا يرون هذه الحقيقة وصمٍّ لا يسمعونها.
ولو أنّ مسلمي اليومِ ساروا على نهج القرآن وبلغوا مستوى المسلمين الأوائل في الصفاء -ولنا أن نزعم بأن ثمة جهودًا تسعى نحو هذا- لاستعادوا بحملة واحدة مكانَهم اللائقَ بهم في التوازن الدولي، ولَتَحرّروا وتخلّصوا من التسلي بتُـرَّهات الآخرين في عَمَايات التقليد. نعم، إنَّ التحلي بأخلاق تلامذة القرآن الكريم الأوائل من إيمان وإخلاص وفضيلة وحركية أذهلت العالمَ وحَيَّرتْه مِن أهم ما على إنساننا اليوم تأمُّلَه بدقّة فائقة.
ومما يجدر تأمّلُه مليًّا وتقويمُه تقويمًا صائبًا، ويُعَدّ مثالًا بارزًا على المؤمنين أن يرجعُوا إليه دائمًا: ذلك الانقلاب العظيم الذي أحدَثَه في الإقليم النوراني للقرآن بضعةُ آلاف من الصحابة انبعثوا في مكة المكرمة من بين تلك الصخور الصماء، فأناروا بحَمْلة واحدةٍ شتى أصقاع المعمورة..
والقرآن منذ نزوله لم يكن ليُخَاتِل أو يُضلِّل من تعلقتْ قلوبُهم به، ولن يفعل ذلك بمن يقصدون رحابه النورانية، ولا يخذلهم ولا يخيِّب رجاءهم؛ فنحن نؤمن أنه إذا استنارت العقولُ بالحقائق العلمية وفاضت القلوب بمعرفة الحق تعالى، وخضع الوجود للبحث والتدقيق تحت مجهر العلم والحكمة، فإن كل ما يقرره العلم سيَخرج هو والقرآن من مشكاة واحدة.
والقرآن من حيث رسالته التي هي أكمل الرسالات: هو جملة القوانين الإلهية، نزل من أعلى الأعالي فبزغ في الآفاق الإنسانية، والقلبُ والروح والعقل والجسم مَرْعِيَّاتٌ له، كلٌّ بقدره.
هذا القرآن الذي لا مثيل له ولا شبيه، والذي يستطيع بمبادئه الإلهية الأبدية الثابتة أن يبلغ بالبشرية جمعاء السعادة من أقصر طريق وأقومه وأنوره؛ يتبعه نحو مليار من الناس اليوم.
وللقرآن سلطان لا تضاهيه سلطنة ما من حيث إنّه كان منبع النور لتلك الجماعة الأروع والأنور من بين من أداروا دَفّة الكرة الأرضية، واجتمع فيها ملايينُ العلماء وآلاف الفلاسفة والمفكرين.
ومنذ أن نزل القرآن كان عُرْضة لشتى أنواع الاعتراض والتحدي، لكنَّ القرآن غالبٌ فكان أن قضت كلُّ المحاكم التي نُصبت لذلك ببراءته وفوزه.
إن من آمن بالقرآن مؤمن بمحمد ، ومن آمن بمحمد مؤمن بالله تعالى؛ ومن كفر بالقرآن فهو كافر بمحمد ، ومن كفر بمحمد فهو كافر بالله تعالى، هذه هي أبعاد الإسلام الحقيقية.
وما القرآن إلا نورٌ يتجلّى في القلوب، ومنبعٌ للضياء يُنير الأرواح، وهو من أوله إلى منتهاه مَعْرِض للحقائق، ولن يعرفه حق المعرفة إلا الأرواح المؤمنة التي تستطيع أن ترى محاسن الكون كلها في زهرة، وأن تشاهد المحيطات في قطرة.
وأسلوب القرآن نسيجُ وحدِهِ، فما إن سمع آياتِه بلغاءُ العرب والعجم حتى خروا له ساجدين، وعندما رأى أهل النَّصَفة من الأدباء محاسنه ذَلَّت أعناقهم خاضعين بأدبٍ وتقديرٍ جمّ لسلطانه المُبين.
ولن يتحد المسلمون إلا إذا صدَّقوا القرآن تصديقًا عمليًّا، وآمنوا به إيمانًا يقينيًّا، وإلا فليسوا بمسلمين حقيقيين، ولا يمكن أن يؤسّسوا وحدة دائمة.
إن القول بأنَّ “الإيمان مسألة وجدانية” معناه أن الإيمان بالله تعالى وبرسوله وبالقرآن لا يكون باللسان فقط بل بالجَنان أيضًا، ومفهوم الإيمان هذا يجعل كل عبادة من العبادات مَظهرًا من مظاهر الارتباط.
عندما كانت الإنسانية غارقةً في ظلام الجهل والكفر والوحشية ظهر القرآن كبحرٍ لُجّي من نور يَمْخُر دياجير ذلك الظلام، إنها أول مرة في التاريخ يحدث فيها مثل هذا الانقلاب الكبير الشامل الذي لم يشهد له التاريخ مثيلًا، ولولا القرآن لما كان، وكفى بالتاريخ شهيدًا.
القرآن هو وحده الذي يعلّم الإنسان بأدق ميزانٍ معنى الإنسانية وماهيتها والحقَّ والحكمةَ وذاتَ الله تعالى وأسماءَه الحسنى وصفاتِه العليا، وليس كمثله كتاب في هذا الباب، ومن أراد أن يقف على ذلك بنفسه فحسبه أن يطالع حِكم الأصفياء والأولياء والفلاسفة الباحثين عن الحقّ.
والقرآن هو وحده الذي أمر بالعدالة الحقة والحرّية الحقيقية والمساواة المتوازنة والخير والشرف والفضيلة والشفقة حتى بالحيوان، وحرّم الظلم والشرك والجهل والرشوة والربا والكذب وشهادة الزور تحريمًا قاطعًا.
وهو وحده الذي صان اليتيم والفقير والمظلوم وسوَّى السلطان بالعبد، والقائد بالجندي، والمدَّعِي بالمدَّعَى عليه أمام المحكمة.
والذين يرون القرآن -حاشا لله- مصدرًا للأساطير والخرافات، هم الملحدون الذين ورثوا هذا الهذيان الأحمق عن عصر الجاهلية قبل أربعة عشر قرنًا، وإنّ الحكمة والفلسفة الحقيقية لَتَسْخران من هذه النظرة.
لقد بلغ من بيان القرآن الباهر أنَّه يَعِد هذا الإنسان -الذي أرسـل إلى الدنيا بأسمى روح في أحسن تقويم- بأفضل صور السـعادة والهناء، وبأفضل أشكال السمو والعلو والرقي، ويبلغ به أكثر أنماط الحياة إنسانيةً بأقوم الطرق ليرقى به إلى ذروة “الإنسان الكامل”.
ألم ينظِّمْ هذا الكتاب المجيد حقوقَ الفرد والمجتمع والعلاقة بينهما في التعامل والسـلوك والوظائف والمسؤوليات؟! ألم يحدّدِ المفاهيم الصحيحة لحقائق الحرية والعدالة والمساواة ويحقِّقْها دفعةً واحدة يومَ أنْ كان العالم أجمع يغرق في دياجير الظلام والغفلة والضلالة؟! ألم يقمْ بأقوى صراع ضد الظلم والطغيان؟! ألم يدعُ إلى رحمة وشفقة إنسانية شاملة لكل ذي روح؟! ألم يضع للحرب والسِّلم مقاييسَ إنسانية، فجعل من أتباعه دعاةً ورُعاةً للأمن والاطمئنان في الأرض ورموزًا للتوازن فيها؟!
يا لـه من كتاب نوراني يذكّر الإنسان بعجزه وفقره، فيكسر حدة غروره وأنانيته، ويؤجّج أشواقه ويدعوه لأن يبسط أشرعته للرحيل إلى ما وراء هذا الأفق.
يا له من نفحات ربانية! في كل أمر منه آلاف الفوائد، وفي كل نهي تذكير بأضرار لا تخطر على بال، إنَّه ليحملنا إلى سفوح الأمن والأمان، وبينما يحدو قلوبَنا برسائل العدالة والإحسان والأمانة ويُشهِدنا آفاق الجنة، يُمطرنا بالوعيد على المنكرات وسوء الخلق والعدوان على النفس والعرض والمال والحقوق، ولا يفتأ يدعونا لنلوذ بكنف الله وحفظه.
إنه كتاب يؤمن بسموّ درجات جميع الأنبياء والمرسلين السابقين وبجميع الكتب والصحف المنـزلة عليهم ويسميها كتبًا وصحفًا مباركة، لا سيما التوراة والإنجيل والزبور.. لقد فصل فيما اختلفوا فيه، وصحّح ما حرّفوه، وصدَّق ما حُفِظ منها ولم يطله التبديل، أي إنه عثر على الكتب السالفة المفقودة بوجه ما وأظهرها، وذكر أنبياءها بكل تقدير وتوقير، لا سيما موسى وعيسى ، وعدّهما من “أولي العزم من الرسل”، فبرهن أنه كتاب ينطق بالحق؛ ثم ذكر بأن والدتي هذين النبيين العظيمين كانتا مصدرًا للإلهام، أي كانتا تملكان قلبًا وروحًا متميزين عن سواد الناس؛ وبذلك أثبتَ لذوي القلوب السليمة أنه إنما نـزل لإحقاق الحق ووضع كل شيء في نِصابه.
ألم يكن ينبغي للذين يعترضون على القرآن وقيمه أن يقدموا أي بديلٍ صالح للنظام البشري وأمنه وسعادته ولو مؤقتًا، والحقيقة أنه يتعذر فهم سبب هذا العناد والتمرّد على القرآن ونحن نرى الحضارات المخالفة لنهج القرآن تتخبط وتعاني الويل والثبور وتتجرع الآلام، والقلوبَ المحرومة من نور القرآن تعاني أزمات نفسية حادة مؤلمة.
إن نمط الحياة الذي حضَّ عليه القرآن هو الأفضل للإنسانية والأكثرُ تنظيمًا، بل قل: جلُّ محاسن المدنية -مناط التقدير والإعجاب في أرجاء العالم كافة- ليست إلا شيئًا مما دعا إليه القرآن وحض عليه قبل قرون؛ إذًا فمن المقصِّر والمُلام؟!
ومن دأبوا على المغامرة في الاعتراض على القرآن واتخذوا هذا ديدنًا ومسلكًا لهم أكثرهم جَهَلة حتى بجهلهم، والأدهى والأمرُّ أن هذه الفئة البائسة لم تقرأ شيئًا عما تعترض عليه ولم تقم بأي بحث أو تدقيق علمي فيه؛ ولا فرق بينهم وبين الجاهل الذي يعادي الحقائق العلمية، وكأنه لا بد من الوقت لكي تصل الحقائق إلى الجماهير.
استطاع الإنسان بفضل القرآن أن يبلغ مرتبة سامية وهي مرتبة مخاطبة الله تعالى، وهو إن وَعَى هذه المرتبة وأقسم أن الله تحدث إليه وسمع كلامه سبحانه من خلال القرآن الكريم لم يحنث.
والذي يعيش في الجو النوراني للقرآن يحس ويشعر وهو في الدنيا بعالم القبر والبرزخ، ويشاهد المحشر والصراط، فيرتجف من هول جهنم، ويطير فرحًا في رياض الجنة.
ومن يَحُولون دون أن يفقَهَ المسلمون قرآنهم ويغوصوا في معانيه؛ إنّما يحولون بينهم وبين روح الدين ولُبَاب الإسلام وجوهره.
وفي المستقبل القريب ستقف الإنسانيةُ لتتأمل بإعجاب وتقدير أمواجَ العلوم والفنون وهي تتدفق نحو القرآن وتصب فيه، وعندئذ سيُلقي العلماء والباحثون والفنانون أنفسهم في هذا البحر.
والقول بأن المستقبل هو عصر القرآن ليس من المبالغة في شيء، إذ ليس ثمة غيره الذي يبصر الماضي والحاضر والمستقبل معًا.
فهو الكلام النفسي واللفظي الذي نزل به الوحي مُنجَّمًا على الرسول في ثلاثة وعشرين عامًا، والمنقول إلينا بالتواتر، المعجز لفظُه، المكتوب في المصاحف، وهو الآن كما كان يوم أن نزل.
دع الحديث عن الحروف والنقوش، وقل: إن كلام الله اللفظي والنفسي راجع إلى صفة “الكلام الإلهي”؛ لأن القرآن الكريم من صفة الله تعالى: “الكلام”، وصفةُ “الكلام” أزلية أبدية؛ فالقرآن كان قبل أن يُخْلق الكون بالنظر إلى “الكلام النفسي”؛ لأن الله تعالى متكلمٌ قبل أن يُلبِسَ الكونَ لباسَ الوجود الخارجي، وقبل خلق الإنسان الذي ظهر إلى الوجود ثمرةً يانعة من ثمرات شجرة الكون الذي هو أحد التجليات من بين ألف تجلٍّ وتجلّ من تجليات ألف اسمٍ واسمٍ من أسماء الله الحسنى؛ فله تعالى كلام نفسيٌّ من هذا النوع، والقرآنُ منه، فكان أزليًّا وسيبقى أبديًّا؛ وليس لغيره خاصِّيةٌ كهذه.
أ. الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب
لا ريب أن البشر بحاجة إلى الكتب السماوية، لأنه يتعذر عليهم أن يحلوا مشكلاتهم من دون توجيه الرسالات الإلهية؛ لذا أوحى الله إلى أول إنسان آدم رسائل إلهية، كتبها آدم في صحف، وهذه الصحف كالقرآن الكريم كلاهما نزل به الوحي، وهذا خلافًا لِما ادُّعي أن الكتابة اكتشفها الإنسان من بعدُ، لقد ظهرت الكتابة بظهور الإنسان الأولِ آدمَ ، علَّمها له ربه بالوحي، وإلا لاستحال تدوين ما أنزل الله إليه.
ولم تنزل هذه الصحف مكتوبةً؛ لأن الكتابة ليست من طرائق الوحي، وليس في القرآن أو السنة ما يفيد أن من الوحي ما نزل مكتوبًا، وقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (سورة الشُّورَى: 42/51)؛ يؤيد ما قلناه، وبهذا يتبين أن الوحي نزل على سيدنا آدم، ثم دوّن ما نزل على الورق، ومعلوم أن الله تعالى علم آدم ما يلزمه بقدر الحاجة، والأمورُ التي جرى الحديث عنها من بعد هي تفصيلٌ لِمَا أُجمل من قضايا توالى ذكرُها بحسب مقتضيات الأزمنة والأحوال؛ ولنا أن نحرِّرَ المسألة كالآتي:
الأصل أنه لا فرق في أصول الدين بين صحف آدم وما أُنزل على سائر الرسل من صحف وكتب، فما في أول الصحف هو عين ما يذكره آخر الكتب، والفرقُ إنما هو في الإجمال والتفصيل؛ فما أُجمِل لسيدنا آدم فُصِّلَ لسيدنا محمد ؛ أي إن ما نزل على آدم كالبذرة، وما نزل على سيدنا محمد هو الشجرة بأغصانها وفروعها وثمارها؛ وأسلوب الإجمال ثم التفصيل من نُظُم الإعجاز.
إن الجيل الأول من بني الإنسان لم تكن قد تكشفت واتسعت مداركهم وأفكارهم بعدُ، فكان مستوى تعليمهم مناسبًا لفهمهم، ولم تفصَّلْ لهم الأمورُ كثيرًا، بل عرضت لهم القضايا كما تُعرَض لتلاميذ الابتدائية، لأن هذا هو مستوى المخاطبين، فلزم تيسير ما يُقدَّم لهذا الجيل غير العارف بلدنيّات الأشياء، ومن له حظٌّ من هذا العلم يدرك أن ما ذُكر في القرآن من حقائق كان في صحف آدم .
وكذلك الكتب السماوية الأخرى، فالحقائق التي في القرآن يمكن تلمُّسها -ولو إجمالًا- في التوراة والإنجيل؛ وليُلاحَظْ أنّ أيّ كتاب إذا تُرجم إلى لغة أخرى قد يُمنَى بالتبديل والتحريف، لا سيما إذا تكررت الترجمة، فإنه يتعذّر المحافظة على النص الأُمّ، ناهيك عن تلمّس القرآن فيه.
ولعلنا نلحظ أنه منذ أن هبط الإنسان إلى الأرض والرسالة الإلهية توجِّه مسارَ حياته فردًا وأسرةً، وتنظم الحياة الاجتماعية وتهديها إلى الخير والفضيلة والرشاد، وهذا برهانٌ على أن البشرية لن تستطيع أن تحُلَّ أيًّا من قضاياها دون دليل إلهي يدلُّها على الطريق؛ وهذا مقتضى الخِلقة والفطرة.
فالله تعالى خَلَقَ الكونَ على هيئةِ كتاب، وإنه لَكتابٌ رائع ألفى الإنسانُ نفسَه بين يديه فكان لا بد له من مرشدٍ يبينه ويفسِّره، مرشدٍ لا ضال ولا مُضل، هؤلاء هم رسل الله ومعهم الكتب السماوية.
وفي كتاب الكون صفحات تُخاطب مَشاعر الإنسان؛ فلو أمعن الإنسانُ النظرَ فيه لَأَلْفى نفسه أمام هذه الشجرة الرائعة (شجرة الكون) التي أبدعتها يدُ القدرة والإرادة بغِراسها وجذورها وفروعها وأفانينها وزهورها وثمارها، وعندئذ يغدو كالنحلة، يجمع من هذه الشجرة رحيق عصاراتِ المعاني ليتخذ منها خلايا يُودِعُها أمانةً لدى القلب والعقل ليحلِّلاها ويجتهدا في فهمها وإدراكِ مغزاها، ولا ريب أنهما عاجزان عن ذلك من دون مرشد مفسِّر شارح، ولنمثل للتوضيح:
لو أن إنسانًا لم يرَ في عمره مسجدًا ولا يعرف شيئًا عن صلاة الجماعة، فذهبنا به إلى جامع كبير رائع ليُعرب لنا عما شاهده فيه، فلا مرية أنه لن يعبِّر ولن يُعرِب بل سيحار مما يراه، وسينظر إلينا والحيرةُ مِلءُ عينيه. نعم، إنَّه لن يَفهم وظيفة المِنبر والغرض منه وما هو المحراب وما هو كرسيّ الوعظ!! ناهيك عن فهمه وتفسيره لمعنى اصطفاف الناس خلف إمامٍ واحد، وقيامِهم وقعودهم استجابة لنداء واحد، لن يستطيع تفسير ذلك ولو كان عبقريًّا في مجالات أخرى، إنه لن يدرك ما يدركه صبي اعتاد المسجد وآدابه، ولن يستطيع الإدلاءَ بأية معلومة في هذا؛ فإنه إذا لم يكن له مُعلِّم، يتعذر أن يَعْلم ما هي وظيفة المسجد وأهدافه، وكذا كل ما فيه من مِنبر ومحراب وغيرهما.
لا فرق بين هذا وبين من يدخل “مسجد الكون” من دون نبي مُرْشِد؛ فإنه إذا ما يشاهد في كل ربيع آلافًا بل ملايين من أنواع النبات تخْضرُّ وتنمو بفروعها وأغصانها، وتُزهر وتثمر، فستحمله الحيرة على إسناد ذلك كلِّه إلى “الطبيعة”، وإذا ما لاح له ما لا يُعَدّ من النجوم، فحاول تفسير ما بينها من انسجام مُذهِل للعقول تَأْتَأَ كطفلٍ يهجِّي: هذه قوانين الطبيعة؛ ومهما بيَّن له علم الفيزياء والكيمياء -كلٌ بِلُغتِه- ما بين الأشياء من نظام وانتظام، وأنْ ليس في الأشياء ما هو سدًى، فسيُسنِد هذا التفاعل إلى الأشياء ذاتها، وسيتوهم أنه يدرك كل شيء؛ أي إنه لن يدرك الحقيقة كما هي، ولن ينجوَ من ظلمات الجهل، ولن يبلغ نور “المعرفة” من دون نبيٍّ مرشدٍ، وكلّ علم لا يبلغ بصاحبه مثل هذه “المعرفة الإلهية” لا يُعَدُّ “علمًا”، فـ”الجاهل” في مفهومنا هو من لا يعرف الله. نعم، إن من لا يعرفه لن يبرأ حقًّا من الجهل ولو حلَجَ آلافًا من أصناف العلوم؛ أما من يعرف الحق تعالى فلا يُعدُّ جاهلًا عامّةً ولو كان أمّيًّا؛ لأنه عَرف ما ينبغي عليه معرفتُه، وعَرف الصانعَ الخبير الذي أنشأ قَصْر الكون، وعرف المؤلِّفَ البديع الذي ألَّف ذلك الكتاب (كتاب الكون)؛ وهذا المستوى من المعرفة هو آخر ما يجب الوصول إليه في العلوم، والله الذي كتب “كتاب الكون” لا ريب أنه به أعلم.
وقد يَنظِم عاميٌّ مصراعين يضمِّنهما من الأسرار ما يعسر على غيره إدراكُها، ومن التلميحات والإشارات ما لا يكاد يفهمُها سواه؛ فما بالك بكتاب الكون هذا، الذي فيه آلاف الأسرار؟ من الطبيعي ألّا نفهم، ولما لم يكن قصورنا عن فهم كتاب الكون بمستنكر؛ أفليس من الضروري أيضًا أن يوجَد هنا لزامًا إرسال معلمين ومرشدين يبينون ويُفسّرون لنا مسائله المعضلة، أولئكم هم “الأنبياء” ومعهم الكتب السماوية التي أُرسلوا بها.
وإنه ليستحيل كشفُ الحقيقة كما هي من دون رسول وكتاب، وأدلّ دليلٍ على هذا هو المرحلة التي وصلت إليها الفلسفة في عصرنا؛ فإن الآلاف من الفلاسفة الذين يبحثون عن الحقيقة منذ آلاف السنين، بل إن رواد مدرسة فلسفية بعينها لم يلتقوا في خطٍّ واحد؛ فأرسطو و”ديكارت (Descartes)” رغم أنهما من أنصار “المذهب العقلي (Rationalism)”، إلا أنّ بين أفكارهما فروقًا شاسعة، ولكل منهما مسلك مباين في الاستكشاف؛ فما أبعَدَ ما بين تصورات أفلاطون عن الكون وتصورات أرسطو أو سقراط أو ديكارت!!
إن بين أفكارهم وتصوراتهم بونًا شاسعًا لا يَدَعُ مجالًا للتقريب والتوفيق؛ ويكشف لنا أن العقل الإنساني البحت “غير كاف”؛ وخير دليل على ذلك مدى الاختلاف الذي بلغه الإنسان في قراءة سطور الكائنات، ناهيك عمَّا كُتب بحروف عريضة كبيرة يكاد العمي يُبصرونها؛ علمًا بأن النجوم في هذا النسيج عُدَّت كلماتٍ، والسُّدُمَ سطورًا، والنُّظمَ كالمجرة ودرب التبانة فِقْرات.
فإذا كان الإنسان يَعجَز عن قراءة هذه الصفحات، فأنى له إدراك أسرار قضايا الإنسان الروحية العميقة الدقيقة حتى يقدِّمَ لها حلولًا تربوية ونفسية واجتماعية؛ فالتجرُّؤُ على مثل هذا هو عين الجهل والحيرة والتيه، ولا يزال إنسانُ عصرنا يعيش منذ أمدٍ مديدٍ أسيرًا لهذا الجهل.
إن الله هو الذي كتب كتابَ الكون هذا، لا أحدَ سواه، وهو الذي أقام العلاقة بين كتابه هذا وبين الإنسان، وهو الذي جعل الإنسان فهرسًا لهذا الكتاب الكبير، وهو الذي اختزل خصائص البحار في قطرة، فهو وحده من يَعلم تمام العلم معنى هذا الكون وماهيتَه، وهو الذي يَعلم ميول الإنسان وسريرته، وبنيته المادية والروحية وغرائزه الفطرية؛ لأن الكونَ “كونُ الله” والإنسان “عبدُ الله”، ومِسبارهما هو القرآن وهو “كلام الله”، والذي يَعرف ما بينهما من المناسبة حقَّ المعرفة واضع المناسبة وهو الله، فله وحده كلمة الفصل في هذا؛ فهو الذي أحاط بكل شيء علمًا، وأما الإنسانُ فإنه لا يعلم من هذا شيئًا إلا إذا علّمه ربّه.
نعم، لا بدّ أن نتخذَ قولَهُ تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/255) وِرْدًا يلهج به لسانُنا.. وعلم الإنسان ليس سوى ما ذكره سيدنا الخضر لموسى : “يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ” ؛ وآراؤه مردُّها إلى هذه المعارف الضئيلة، ناهيك عن أن ثمة علومًا لا تُحصى ينبغي عليه تعلُّمُها ما زال جاهلًا بها؛ ورغم ذلك يدَّعي العلمَ والمعرفة ما أَصْلَفَه! وهذا وجهٌ آخر مِن أحلكِ جوانب جهله، ومن البدهي أن تكون أحكامُ الإنسان الغارق في ظلام الجهل هذا ترهاتٍ وعبثًا ولغوًا من الكلام، حتى أحكامه على نفسه، أما الأحكام الإلهية فهي حقٌّ صِرف.
وحُمادَى القول: من أسلم أمره لربه تعالى ولكتابه المعجز أنقذ نفسه من الفوضى المادية والمعنوية والفردية والأسرية والاجتماعية، وعاش في “جو ذهبيّ” من السكينة والسعادة الحقيقية، وإلا كانت التعاسة قَدَرَه المحتوم.
وقد أنجى الله تعالى الإنسانية من عاقبةٍ كهذه بواسع رحمته وبما أنزل من كتب، ونجزم بأن الإنسانية لن تستغني عما شرعه الله لها، وهذا الأمر ذو قدْر في عصرنا لأنَّ القرآنَ أكملُ كتاب خُصّ به أكمل مخلوق.
ب. القرآن والكتب الأخرى
إن الحقائق التي أُوحيت إلى الأنبياء مجملةً ذُكرت لنبينا محمد في القرآن مفصلةً أيما تفصيل؛ لأن القرآن خاطَبَ فيمن خاطَبَ مجتمعات بلغت الغاية في التقدُّم، ولما كان خاتمة الكتب السماوية؛ كان لا بد أن يتخذه الإنسان مرشدًا وهاديًا مهما علا وبلغ من الرقي فرديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا وتقنيًّا.
ومن الملاحظ أن الإنسانية قد سبرت أغوار الكون، فتقدَّمت علومُ الفيزياء والكيمياء خطى واسعة، وترقّت علومُ الفضاء إلى مستوى يُذهِل العقول، وتوجهت نحو الكشف عن المجرات، وانشطرت المادة، وكُشفت “اللَّامادَّة”، ولربما حلت الطاقةُ الشمسية محلّ البترول قريبًا لأن العلوم والتقنيات تتقدّم بأرقام خيالية، وقد يصعب تتبُّع هذه الاكتشافات الجديدة كلها. نعم، إن هذه التطورات تحقّقت، وفي الطريق الكثيرُ منها، ولا ريب أن كلّ تطوّرٍ جديد سيلتقي مع القرآن في نقطةٍ ما، وسيقف بإجلال بين يدي الأصول الكونية القرآنية.
والكتاب الذي يخاطِب مرحلة كهذه ينبغي أن يكون مفصَّلًا، والقرآن كذلك، ففيه كلُّ ما في الكون “برطبه ويابسه”، وكأنّه فهرس له، فهل يا ترى عُنِي به إنسانُنا وأفاد منه كما يجب؟ لعل إثبات ذلك عسير.
واليوم هجر البشر القرآن أو حيل بينهم وبينه، فأصبحوا غرباء عنه؛ ولعله ما من مسلمٍ اليوم إلا وهو على علم بما يجري في أصقاع العالم، أما القرآن ربيع القلوب ورياضها فلا يَعلَم عنه ولو عدد آياته، بل إنك لَتجد الآن مَن يُعنَوْن بمتعةِ يوم أكثر من عنايتهم بالقرآن الذي يضمن لهم السعادة الأبدية؛ فلا هم يقرؤونه، ولا هم ممن يحبون أن يسمعوا عنه، بينما هو ينادي مَن هو شغوفٌ به ومُقبِلٌ عليه بقلبه وعقله ومشاعره وأحاسيسه، ولو أن المسلِم عُنِيَ بـ”كتابه” واستقامَ عليه، لَتَغَيَّرَ “طالع البشرية السيئ” لا المسلمين فحسب؛ وتنمية هذا الوعي اليوم ليست حاجة ماسة فحسب بل هي ضرورة من الضروريات.
ولو اجتمعت الإنس والجن بما لهم من قوة وسلطة، واستغلوا نفوذهم وسلطانهم، فلن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن؛ إنه حبلُ اللهِ الممدودُ إلى البشر، من استَمسك به لم يتردَّ في مهاوي الضلال، بل سيَتَرَقَّى إلى أسمى مقامات الإنسانية، ليُثْبتَ من خلالها أنه صار مَظهرًا لسرِّ: “أحسن تقويم”، وبهذا سيكون “محلّ نظرِ الله تعالى”… أي إنه سيُصنَع على عينه، ويباركُ فيه.
وسنبرهن على ما قلناه هنا، ليستبين أن القرآن “كلام الله”، لا طاقةَ لأحدٍ أن يأتي بمثله، ويقيننا أن خير من يفهم القرآن ويَقْدُرُه حقَّ قدْره هو سيدنا محمد ؛ لقد فهمه ووعَاه بكل عمقه وسعته، فكان لسانُه رطبًا بالقرآن ليل نهار، وشوقُه إليه لا يُحَدُّ ولا يُوصَف، شوقٌ مُلتاعٌ أثَّر فيمن خَلَفُوه ولو بعد قرون، فربَّى ما لا يكاد يُحْصَى من تلاميذ القرآن المهرة؛ كان منهم الإمام طاووس بن كيسان، والفقهاء الأربعة والإمام مسروق، وغيرُهم كثير؛ ومن هؤلاء من كان يتهجد بمائتي ركعة يختم فيها القرآنَ مرتين، ولعله بورك له في وقته، لقد تمكَّن القرآن من سويداء قلوبهم فأذاقهم حالًا يفوق الكمالات الإنسانية كلها، فكأنهم صاروا “قرآنيين”، تأسّوا بأمر الله تعالى لحبيبه : ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ (سورة النَّمْلِ: 27/91-92) لقد وَعَوْا وفهموا مقصدَ ما قاله الرسول ؛ وفي تعاقب الآيتين إشارة إلى ما بين الإيمان الحقيقي وتلاوة القرآن من آصرة محكمة، لا تتحقق بتلاوة جوفاء، بل بجعل القرآن روحًا للحياة، وبالتخلّق به، وبصيرورةِ المرء قرآنًا ناطقًا كما كان الرسول ؛ حيث وصفته السيدة عائشة فقالت: “كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ” ، أي جَعل مِن نفسِه قرآنًا ناطقًا.
وتلاوة كهذه تسمو بأصحابها إلى مقام عالٍ في الدنيا، وإلى أعلى عليين في الآخرة، وأما تلاوته من دون غوص في أعماقه، ولا فهمٍ لمعانيه وتدبرٍ لمقاصده، فإنها لن تثمر شيئًا من هذا.
ولعل الحقيقة المذكورة في الآية السابقة من باب “ذكر الخاص المراد به العام”، فكأنه تعالى يقول: “أيها المسلم كن مسلمًا حقًّا، وادخلْ في عالم السِّلم والسلام، واستسلم لأوامري، وتَفانَ فيّ، ولتكن في امتثال أمري كالميت بين يدي المغسّل؛ دع نزواتك، واضربْ بأهوائك عُرْض الحائط”.
إذًا إنَّ كونَ المسلم مسلمًا حقًّا مَنوطٌ بتلاوته للقرآن؛ فإذا كان يتلوه ويغوص في أعماق معانيه فهذا في طريقه نحو التسليم لأمر الله، ومن يسعى جاهدًا لفهم حقائق القرآن وإدراكها، فسيدرك بعضها حتمًا يومًا ما، كأن يبلغ الصراط المستقيم الذي لا يَضل سالكه، وهو سبيل تذَوُّق الإسلام.
روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله قال: “إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ” .. يا له من تشبيه ظريف صوَّر حالة المحروم من القرآن بالبيت المتداعي!
فمَن هو المحروم أو المحرومون مِن القرآن؟ عموم اللفظ في الحديث يفيد أنه قد يكون فردًا أو أسرة أو مجتمعًا أو دولة. نعم، سيغدو كلُّ شيء كالبيت الخرب إذا لم تَسْرِ في الحياة الشخصيةِ تلك الروحُ والمعنى واللدنياتُ التي في القرآن، ولم تنظَّم حياةُ الفرد حسب موازين القرآن ولم تهتدِ به، ولم يكن القرآن نبراسًا للحياة العائلية؛ وسيقع يومًا ما أمثال هؤلاء الناس والأُسر والمجتمعات في مصيدة أحابيل الشيطان وشِراكه، ولا منجى لهم من أيّ لون من ألوان حياة الذلة والمسكنة.
وبتنزيل معنى الحديث على الواقع المرير لأمتنا نجد أن نحو مليار مسلم لمَّا هجروا القرآن رزحوا تحت البؤس والهوان نحو أربعة قرون، وهذا يزيدنا إيمانًا بأهمّية العودة إلى القرآن لأن الكون قائمٌ بهديه وفضله.
فالقرآن روح الكون وحياتُه، وفي البعد عنه انهيار الكون وزواله، وإلى هذا يشير الرسول بقوله: “الْقُرْآنُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ” ، وبسرّ هذا القرآن تقوم السماوات والأرض، فإذا ارتفع القرآن زالتا هما أيضًا، “وإذا ما غاب القرآن وفارق الكون، جنّ جنونه وفقدت الكرة الأرضية صوابها، وزلزل عقلها، وظلت بلا شعور، واصطدمت بإحدى سيارات الفضاء، وقامت القيامة” كما قال ذلك العالِمُ النِّحْرِير مصنع الفكر ومنجمه.
إذًا فلنجتهد في فهم القرآن على هُدَى أفق سلطان الأنبياء ، فالتلاوة وحدها لن تبلغ بالإنسان المستوى المنشود من التعمق والشعور، وإن الذين يسبرون أغوار القرآن سيتمتعون بالعمق الروحي ويُوفَّقون لتأسيس رابطة بينهم وبين القرآن، ولن يتسنى إدراك الصلة بين الله والكون والإنسان إلا بالقرآن، إنها حقيقة لا تُدرك إلا بالقرآن، وهذا مغزى حديث القرآن عن كلٍّ من الأنفس والكائنات وذات الله ؛ فهو الخالق وأنت المخلوق، وهو الذي جعل من الكون كِتابًا أنت فهرسُه، وحريٌّ بمن استطاع أن يَقرأه أن يفهم الكتاب، وبمن وعى الكتاب أن يدرك ماهية فهرسه، فتأمّل تُلْفِ في القرآن صِدْقَ ما قلنا، وإذا تفكرت في عالَمك الداخلي -والهدف نفسه حاديك- وتعمَّقْت في روحك ولَدُنِّيّاتك، فستُحس وتَشعر بالحقيقة ذاتها، وتوقن عن دراية أن الإنسان والقرآنَ وجهان مختلفان لحقيقة واحدة، وأن الإنسان كالساعة كلُّ ما فيها من عقارب ومُسَنّنات وعجلات تدور نحو حقيقة واحدة؛ فهذه المُسنّنات تتيامن وتلك تتشاءم ومحورها واحد أو قل: إنها تدور حول حقيقة واحدة وهدف واحد، وحينما نتناول أجزاءها تبرز أوجُه متعددة لكن الحقيقة واحدة وهي جريان الزمان.
وهكذا (الإنسان-الكون-القرآن) ثلاثتها أوجُهٌ مختلفة لحقيقة واحدة، أي كلُّها مرايا لأسماء الله الحسنى، فالإنسان الذي هو مَظهر لـ”أحسن تقويم” مرآةٌ لـ”قدرة الله” و”إرادتـِه”، والقرآنُ الذي هو “أحسن الكلام” أثرٌ من آثار صفة الله: “الكلام”، والكون يتجلى فيه ألف اسمٍ واسمٌ من أسماء الله، وما لم يكن لهذه الثلاثة محور واحد تدور عليه فلا يمكن فهمُ أيٍّ منها، يقول يحيى بن معاذ: “من عرف نفسه فقد عرف ربّه” ، يا لَهُ من تعبير عالي النبرة يبين قدْر البصيرة بالأسماء الإلهية! وهذا قصارى ما يبلغه إيجاز البيان عن الصلة بين “الرب” والإنسان، ولك أن تتلمَّس خصائص الربوبية في الصفات الإنسانية لدى تأمُّل علاقة العبد بربّه.
وقُلْ مثلَ هذا في القرآن، ولكن هذه النسبة ليست كما ذهب إليها الفلاسفة من تشبيه وتجسيم وتجسيد وحلول واتحاد، تلك ضلالتهم، فاللهُ سبحانه ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوًا أحد، فالعلاقة بين الله والإنسان هي علاقةُ (الخالق بالمخلوق) أو (التجلي بالمظهرية للتجلي)، أمّا تفسيرُها بعقلية الفلاسفة فهو محض ادّعاء، والحامل عليه الجهلُ بمعارف القرآن وعلومه.
ومن أبحر في القرآن سرعان ما يدرك أن الإنسانَ نفسه من مواضيعه، فيفكر قائلًا: كأنَّ الحقيقة المنتشرة في الكون نتاج فسيلةٍ غرست في جوانية الإنسان وتشعّبت أغصانها في الأرجاء؛ فعلى الإنسان ألّا يكف عن السير في الآفاق وأن يصله بالسَّير الأنفُسي،
فإنه إذا تنبّه ولو هنيهة فسيجد أن كل ما يَبحث عنه موجود في ذاته، فإذا وجد ذاته فسيجد “الرب” الذي يتجلى فيها، ولما أدرك أحد الأولياء هذه الحقيقة ووعاها أنشد قائلًا:
وجوابًا منك كنت أرتقبُ
إذ بالنفس أبصرها وانجابت الحُجُبُ
ونقطع بأنّ أيَّ تلاوةٍ لم تصل إلى اللباب لن تمنحَكَ فَهْمَ كلِّ شيء من هذه الحقائق وإدراكَها وترقيتَها إلى مستوى الشعور بها واستنباطها من القرآن.
وجاء في الحديث الترهيبُ من قراءة القرآن دون أن يجاوز الحناجر: “سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَؤونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ” .
ولعلّ معنى عدم تجاوز القرآن الحناجر أنه لن يكون “حياة للحياة”، بل إن هناك بونًا شاسعًا ما بين الفرد والأسرة والمجتمع والإدارة وما بين الموازين القرآنية، والأسوأُ أن كل من في المُسْتنقع يعد نفسه في غنى عن اتباع هذه الموازين، حتى إن القرَّاء سيقرؤون القرآن لغيرهم، وينصحون دون أن ينتصحوا.
وهذا كله قد حدث وما يزال، ومن بُلِي بهذا الضرب فلن يفلح حتى ولو كان مَلَكًا، وعاقبتُه ستكون كعاقبة فرعون لا منجى له منها ولو أتاه ألف مرشد وناصح.
فما هو جوهر هذا البلاء، وما نوعه؟ وبمَ يهوي العبد إلى هذه المَهْلَكة؟
العلة هي العُجب، فهو لم يَصِلْ بعد وظنّ نفسه قد وصل، لم يشمَّ الحقيقة ولم يمخر عُباب القرآن ويُخيَّل إليه أنه قد عبر، أو قل: إنه ليرى نفسَه عالمًا ذا بصيرة غواصًا واصلًا بينما رُؤاه كلها في الحقيقة ضحْلةٌ سطحية، ويسعى جاهدًا ليَرى نفسه ويُرِيَنا أنه بحرٌ بعيدٌ غورُه، بل إنه ليعتقد أنه كذلك في واقع الأمر.
وكان ينبغي على كل امرئ كما هو مقتضى الأخلاق القرآنية أن يرى نفسه أنه في ذاته “لا شيء”، وأن يتوجه بشوقِ “الفناء عن نفسه” إلى من هو “كل شيء” لا بلسانه فحسب بل بأن يذعن له بوجدانه، وهذا هو طريق العظماء. أجل، ففي التاريخ مئات بل آلاف من الصفوة الذين تخلّقوا بأخلاق القرآن لهم مَواقف يُحتَذى بها في هذا المضمار، منهم الوليّ المدفون في بلدة “جُورُومْ” التركيّة، أوصى أن يُدْفَن جهةَ قدمَي الصحابيِّ الجليل عمرو بن معديكرب، واليوم على شاهد قبره قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (سورة الْكَهْفِ: 18/18).
وفي حقبة من التاريخ تفرق أكثرُ الصحابة في أنحاء المعمورة للجهاد في سبيل الله، وصاروا بين شهيد معركة أو غربة أو مجهول الحال لأسباب لم تُعرف، فلم يرجع جُلُّهم إلى بلادهم؛ استشهدوا وما زالوا دعائم معنوية لمن حولهم، فالصحابيّ عمرو بن معديكرب لم يكن من كبار الصحابة، ولم يُؤمَّرْ على سَرِيَّة ولو من خمسة أشخاص، ما هو سوى مجاهد قام بما عليه.
لقد كان بطلًا قويًّا، باسلًا مِقدامًا، يهبُّ في ميادين الحرب كالأعاصير، فيفرق جموع الأعداء، ولعله كان في طريقه إلى فتح القسطنطينية، فوافته المنية في بلدة “جوروم” ودفن فيها، وقبره ما زالَ بها يُزار.
كان ذلك الولي الكبير الذي تربى في “جوروم” ممن يعرفون قدر الصحابة ؛ فأوصى أن يُدفن عند قدمي عمرو بن معديكرب، وأن يُكتَبَ على شاهد قبره آيةٌ ذات دلالة عميقة، وهي التي تتحدث عن هيئةِ كلب أصحاب الكهف: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (سورة الْكَهْفِ: 18/18).
ففي هذا المشهد الذي رسمَه هذا الولي ما يدعو للتأمل، لقد آَثَر أن يُدفَن عند قدمَيْ عمرو بن معديكرب على أي مكان، وعمرٌو من صغار الصحابة سنًّا، وليس في الصحابة الكرام صغير، يا له من نموذج يدلّ على مدى تعمُّق المتخلقين بأخلاق القرآن في باب التواضع ومحو الذات!
والصحابة هم خير من ينبغي أن نتأسى بهم بعد الأنبياء، فكل فرد منهم كأنه قرآن ناطق، يقوم ويقعد، ويرقد ويسعى والقرآن بادٍ في أحواله وأطواره وتصرفاته كلِّها، فهو من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه نموذجٌ معبّر عن القرآن.
نعم، إن كل حال من أحوالهم كان قرآنيًّا، وهم والتابعون أُشْرِبت قلوبهم وعقولهم القرآن، فصارت حياتهم مرآةً للقرآن، حتى إنهم في ذلك العصر النوراني لم يبق فيهم أميّ، حتى إن الأعراب ضربوا بسهم في مدارسة مسائل القرآن، وتذاكروا في مجالسهم العادية قضايا علمية عميقة.
وهذا كلُّه تَحقَّق في هنيهة تبلغ عقدين أو ثلاثة، إنهم ما أصبحوا سلاطين الإنسانية ومرشدين ومعلمين لأرباب الحضارات إلا بالقرآن، وكانوا من قبل بدوًا تعساء أذلاء عبيدًا لغيرهم لا يجد أحدهم نعلًا لنفسه ولا سَرْجًا لفرسه.
“فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ، طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ” ، فمن اعتصم به عزَّ وسما، ومن تركه ضلّ وهوى.
إنَّ مِن أبرز علامات محبة الله ورسوله محبة القرآن؛ فمن أحبَّه أحب الله ورسوله أيضًا، والعكس صحيح؛ فمن أحبهما نال حبهما، ومن أراد وأحبّ أن يكون محبوبًا فعليه بمحبة القرآن، عن ابن مسعود موقوفًا قال: “لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ عَنْ نَفْسِهِ، إِلَّا الْقُرْآنَ، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ” ، وسواء كان المراد محبة الله ورسوله له أو محبته هو لهما، فكلاهما إنما يتحقق بمحبة القرآن، ولا يُتصوَّر أن يكون المرءُ “مؤمنًا حقًّا” ولا يحب القرآن.
وقدْر المرء منوط بقراءة القرآن وهجره، وهذا هو ما يميز المؤمن عن المنافق ففي الحديث: “مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ…” .
وفي تشبيه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة معانٍ كثيرة مثل: تذوق حقيقة “التكامل بين الإيمان والعمل” وتذويقها للآخرين، والشعور والإشعار، فمن ابتعد عن القرآن فعن الله ابتعد، علم أم لم يعلم؛ لأنَّ القرآن أوثقُ عُرى الصلة بالله، من استمسك بها اقترب من الله ومن تركها بَعُد عن الله.
“رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ”: من ذاقها فقد ذاق شيئًا طيّبًا وعَمِل عملًا نافعًا، ورائحتُها تثير شهيةَ الآخرين ورغبتهم.
نعم، إن القرآن كلما قُرئ ملأ الأفئدة نورًا وفيضًا وبركة، لذلك كان الرسول يردّد الآية الواحدة ويكرّرها، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ النَّبِيَّ تَلَا قَوْلَ اللهِ فِي إِبْرَاهِيمَ : ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة إِبْرَاهِيمَ: 14/36)، وقول عِيسَى : ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/118)، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: “اللهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي”، وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ : “يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟”، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: “يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، وَلَا نَسُوءُكَ” .
وعن عباد بن حمزة، قال: “دخلتُ على جدتي أَسماءَ وهي تقرأ: ﴿فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ (سورة الطُّورِ: 52/27)، قال: فوقفتْ عَليها، فجعلَتْ تستعيذ وَتدعو، -وزاد في رواية: “فطال عليَّ ذلك”- قال عباد: فذهبْتُ إلى السوق، فقضَيتُ حاجتي، ثمّ رجعْتُ وهي فيها بعدُ تستعيذ وتدعو” .
فهذه أسماء بنت أبي بكر تغوص في القرآن، وتُبحر بقلبها في أعماقه، ولا تريد أن تخرج، إنها ابنة أحدِ الغوَّاصين في بحر القرآن الكريم، وهي بهذا أعربت عن حبّها للقرآن وشغفها به.
فالصحابة والتابعون والذين اتبعوهم بإحسان كانوا يرون أن القرآن فيه كل شيء، وبدهيّ أن المحروم من القرآن ينتقد هذا ويعدّه مبالَغة، فليقل ما شاء، ولا نرتاب في خطإ من يطلقون أحكامًا كهذه في قضايا لا صلة لهم بها ولا علم.
وأنا شخصيًّا أنظر إلى القرآن وكأنَّه صورة بلورية واعية رعت مستوى إدراك البشر، أو كأنَّه كائن حيٌّ يحيط بأحوالنا كلّها، ودليل هذا من البيان النوراني المحمدي: “وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ” ، ومَن يدري كم هو لحالنا أسيفٌ شفيق؟! لكنَّا نأمل أنه سيكون في الآخرة رفيق من عُنُوا به في الدنيا ولو يسيرًا.
ج. تدبر القرآن الكريم
ينبغي أن ننظر إلى القرآن بهذا المستوى من الإدراك والوعي لندرك أنه كتاب يبثُّ الحياة والروح، فهو لم ينزل لِيُتلَى ويُستمعَ إليه فحسب، أو ليُقرأَ على الأموات، إنه نزل ليكون “روحًا للحياة”، وينفخَ الروح في أجساد موات؛ أو قل: إنه أُنزِل ليَرفعَ مَن في الأرض إلى سماءِ الروحانيين، فلا بد أن يُتلى مع تفكّر في ظاهره وباطنه وعمقِه الداخلي وسعته لعالم الغيب حتى يمكنَ الإحساسُ بالغيبية التي يحملُها جوهره.
هذه هي التلاوة التي تُعتَبَرُ تكليمًا من الله للإنسان، ففي الأثر: “مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَ اللهَ فَلْيَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ فَلْيَقْرَأ القُرْآنَ”.
نعم، إن القرآن حديث اللهِ للإنسان، كلما قرأه غمرته حالة روحية لا يخطر له فراق مصدرها.
إن هذه الحال -ولنا أن نسمّيَها: “تدبُّر القرآن”- تأسِرُ وجدانَ الإنسان عند استماعه إلى القرآن، فكأنه يأخذه عن الله، وأنى لمن لم يذقْها أن يدركَها؟!
وفي القرآن ما يُغني رسولَ الله عن غيره في قضاياه التي تناولها؛ لذلك كان يرى ما سواه من كتب عبثًا، وكثيرًا ما كان يَمنع أصحابه من قراءتها، حتى إنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ كِتَابًا حَسَنًا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ : “أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي” .
فَقَالَ عُمَرُ: رَضِينَا بِاللهِ تَعَالَى رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ ، وَقَالَ: “وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى، ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ، وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ” .
إن اتِّباع القرآن ضروريّ لكلّ فرد، ففيه شفاء لكل داء، وفيه روح الكونِ والإنسانِ والحقائقِ الكبرى ومدلولاتها، وفيه تجلى الحقُّ؛ وما أصدق قول جعفر بن محمد الصادق فيه: “لَقَدْ تَجَلَّى اللهُ لِخَلْقِهِ بِكَلَامِهِ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ” ، ولو أمعنّا بدقّة في الكلام الإلهي، لوجدنا تجلِّيَ اللهِ تعالى فيه، وهذا التجلّي ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، بل هو تجلٍ لكلام الله منزّه عن الكم والكيف؛ ولا يعي الإنسان هذه الأمور إلا بـ”التدبر”، وبه تنجاب الحُجُب عن خبايا لا تدرك إلا به.
نعم، إنما ينفُذ إلى روح القرآن من يديمون تلاوته بتدبر وتفكُّر، ويبذلون قصارى جهدهم ليفهموه ويُدْركوا معانيه، ولن يفهمه حقّ الفهم إلا أولو الألباب، لأنه يخاطب العقول ويدعو إلى تحكيمها، ولن ينفذ إلى أعماقه إلا من يحكم عقله، فكم عظيمٍ من العباقرة والأدباء والشعراء تأمله من هذا الوجه فدان له، وكم من ذوي الهامات السامقة ذلَّت رقابهم له وجَثَوا يتعلّمون منه.
لقد دانت للقرآن شخصيات نادرة كسيدنا أبي بكر وعمر ، وأخذ بلب أكابر شعراء عصرهم من أمثال لبيد والخنساء، ثم بَهَرَ بعدهم مئاتٍ من سلاطين البيان أمثال مولانا جلال الدين الرومي، وعبد الرحمن الجامي، وحافظ الشيرازي، وأنوري، وحتى علماء الغرب فشهاداتهم الإيجابية في حق القرآن لا تتسع لها مجلدات، فما منهم إلا تحدَّث في مؤلفاته عن إعجاز القرآن وعظمته.
وكذلك جهابذة العربية وعلماء البيان الذين لهم يد طولى فيه أمثال عبد القاهر الجرجاني والسكاكي والزمخشري وقفوا حياتهم للتلمذة على القرآن؛ لأنه أشبعَ مشاعرهم وأفكارهم وقرائحهم كلّها، وأخذ بمجامع قلوبهم، فلم يجد هؤلاء الأجِلّاءُ حاجة إلى مراجعةِ مصدر آخر غيره؛ ومما يُروى وفيه عبرة أنّ لبيد بن ربيعة من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قرض الشعر في الإسلام، فسأله عمر في خلافته عن شعره واستنشده، فقرأ سورة البقرة، فقال: إنما سألتك عن شعرك، فقال: ما كنت لأقرض بيتًا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران، فأعجب عمر قوله، وكان عطاؤه ألفين فزاده خمسمائة .
يقول “الدكتور موريسون (Dr. Morrison)”: “اللغات كلها مدينة للعربية، والعربية مدينة للقرآن”، وعليه فالقرآن له يد على اللغات كلها في القواعد والضبط، وهذا موضوع جليلٌ جدير بعلماء اللسانيات أن يبحثوه، فلندعْه للمتخصصين، وغاية ما نريد أن نقوله هو أن إعجاز القرآن وعلوّه على سائر الأشياء -كما أشار الدكتور “موريسون”- أمر حقيقٌ بالدَّرْس..
ولو أنَّ الناس تدبّروا القرآن لاقشعرّت جلودهم منه، ولَحوَّلتْ هذه المهابةُ عالمَهم الداخلي إلى ربيع إيماني، ولم يخلُ عصر من المتدبِّرين أرباب العقول النيرة وذوي القلوب المؤمنة، الذين صوّر الله حالهم وهم بين يدي القرآن بقوله: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (سورة الزُّمَرِ: 39/23)
فوا أسفاه على جيل اليوم ما أبعده عن مثل هذا التدبّر!
إن القرآن منبع هداية، فمن أراد الهداية في كل ميدان فعليه بالقرآن، يسترشد بهديه ويسير في نوره، وتحقيق هذا يقتضي الانسجام مع القرآن وتلاوتَه والاستماعَ إليه بـتدبّر.
ومن استقرأ سيرة الرسول علم أنَّه كان عظيم العناية بتلاوة القرآن والاستماع إليه، بل طالما رغّب في تلاوته بلسان الحال والمقال، وهذا سيدنا أبو بكر أقرب أصحابه إليه لم يترك تلاوته في العهد المكي مع أن ذلك عرَّضه للأذى الشديد من الكفار، لكنه أَلَانَ بتلاوته كثيرًا من القلوب القاسية، وهدأت بها بعض النفوس الكارهة للإسلام، وكان الشبان والشيوخ رجالًا ونساءً يجتمعون عنده حول كوخ بناه أمام بيته ليستمعوا إلى تلاوته .
وكانت تعجبه تلاوة أصحابه ويوصي بالأخذ عنهم، ومنهم ابن مسعود ، روى الشيخان عنه أنه قال: قال لي رسول الله : “اِقْرَأْ عَلَيَّ”، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: “فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي”، فقرأت عليه سورة “النساء” حتى بلغتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/41)، قَالَ: “أَمْسِكْ”، فإذا عيناه تذرفان .
وكلما قرئ القرآن كان الرسول يرتجف من خشية الله، لذلك لم يتحمّل وقال لابن مسعود : “أَمْسِكْ”، ومَن يدري فلعلّ قلبه وقتئذٍ لم يعد قادرًا على الاستمرار لأنه كان أخشى الناسِ لله وأعرفَهم بمعاني القرآن؛ فلو كانت طاقته وتجلُّده كأيِّ إنسان، لَمَا استطاع تحمُّلَ ذلك ولفاضت روحه الطاهرة من هذه الخشية والخوف، إلا أنه رغم هذه الحساسية البالغة كان يستطيع تحمُّل تلاوة القرآن والاستماع إليه، بل كان ذلك شغلَه الشاغل.
وكان الأسوة الحسنة في ذلك، كما أنه أفضل من يُحتذَى به في سائر مناحي الحياة، فلنجَعْلِ استمساكه بالقرآن نبراسًا ننير به طريقنا، ولنجتهد في الاستنارة بنوره بأن نعكف على تلاوته ومطالعةِ تفاسيره في مواقيت خاصة به، وعندئذٍ يُظلّنا الله بعنايته بفضل القرآن، وتُعْمَرُ دنيانا وآخرتُنا معًا.