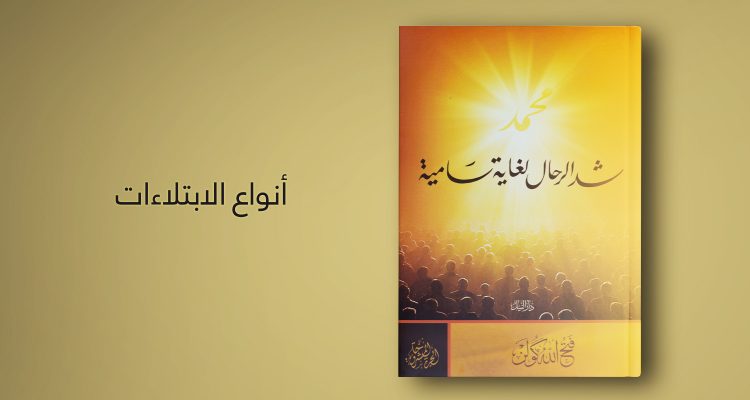سؤال: لا جرم أنّ الإنسان عُرْضة لأنواع شتّى من الابتلاءات، فما أخطرُ أنواعها على القلوب المؤمنة في وقتنا الراهن؟
الجواب: اقتضت سنّة الله سبحانه وتعالى أن يمتحن الناس بابتلاءات شتى طوال حياتهم؛ حتى يَمِيْزَ الخبيث من الطيب والصالحَ من الطالح كما يستخلص الألماس من الفحم، والذهب من الحجر والتراب، وما من ابتلاء إلا ويعرّفنا بماهية أنفسنا؛ أي إن الله سبحانه وتعالى -وهو أعلم بقدرنا وقيمتنا في الأزل- يكشف لنا من خلال هذه الابتلاءات عن مدى جلدنا في المصائب والبلايا وكيفيةِ تعاملنا معها، وهل صبرنا عليها أم انسلَلْنا منها، وهل تجلدنا وتحملنا أم وقفنا منها موقف المعترض على القدر الإلهي.
أجل، إن هذه الابتلاءات تكشف لنا حقيقة أنفسنا، وأشار الشاعر التركي يونس أمره إلى حقيقةٍ مفادها: أنّ الناس في حياتهم الدنيا سيظلون دائمًا في مكابدة وعناء بين تمحيص وتصفية وانصهار كما يُصهر المعدن في البوتقة، قال يونس: “إنه لَطريق طويل، ومنازله كثيرة، وممراته مسدودة، ومياهه غائرة”.
كلما عظم الهدف اشتدّ الابتلاء
يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 2/155)، ذكر الله تعالى في مستهلّ هذه الآية أن الناس في هذه الدنيا يخضعون لابتلاءات شتى، ثم زفّ البشرى للصابرين عليها، فكما أن العبادات تَرفع درجة العبد فإن الابتلاءات التي تُعدّ من “عبادات السَّلْب”[1] تطهِّره من الآثام إن صبر عليها، وترفعُه إلى أعلى المقامات وأسماها، فعلى المؤمن أن يصبر على ما يسوقه الله من ابتلاءات مختلفة ومتتابعة، ويتجلّدَ أمام كلّ ابتلاء يعرِضُ له، ويعدَّ هذا الموقف فرصةً لمساءلة النفس ومحاسبتها، ويتساءل في نفسه: هل وقفتُ من كل هذه الأمور موقف المؤمن الكامل؟
والقاعدة الثمينة “الغُنْمُ بالغُرْم” تدلّ أن الثواب والجزاء يكون على قدر المشقة والعناء؛ فشدة الابتلاء تتفاوت تبعًا لقيمةِ الهدف المنشود وعظمته.
مثال هذا أن الاستشهاد أي التحليق نحو “مرتبةٍ أخرى من مراتب الحياة” شرفٌ عظيم، لكنه لا يتأتّى إلا بالجهاد في سبيل الله والتضحيةِ بالنفس ابتغاءَ مرضاته سبحانه وتعالى، فمَن تعلَّق قلبه بغاية سامية وأخذ يجتهد في إعداد ما تقتضيه هذه الغاية من وسائل فليتحمل في سبيلها وليتجلَّدْ ويصبر على ما يحل به من ابتلاء أو مصيبة مهما كانت، بل فليمضِ في مسيرته رغمًا عن نفسه.
وأستميحكم عذرًا هنا لنتوقف قليلًا حتى نصغي لهذه الكلمات من الأستاذ النُورْسي رحمه الله: “لم أذق طوال عمري البالغ نيّفًا وثمانين سنةً شيئًا من لذائذ الدنيا؛ قضيت حياتي في ساحات الحرب، وزنزاناتِ الأَسر، أو سجون الوطن ومَحاكمِ البلاد؛ لم يبق صنف من الآلام والمصاعب إلا وتجرّعتُه: عوملتُ في المحاكم العسكرية العرفية معاملة المجرمين، ونُفيت وغُرِّبْتُ في أرجاء البلاد كالمشرّدين، وحُرِمْتُ من مخالطة الناس في زنزانات البلاد شهورًا، وعُرِّضْتُ للتسميم مرارًا، وعُرِّضْتُ لإهانات متـنوعة، ومرت عليَّ أوقات رَجَّحْتُ فيها الموتَ على الحياة ألف مرة، ولولا أن ديني يمنعني من قتل نفسي، فلربما كان “سعيد” ترابًا تحت التراب”[2].
أجل، لما كانت الابتلاءات التي تعرّضَ لها الأستاذ النورسي قاسيةً كلّ هذه القسوة، رفعه الله تعالى إلى ذروة الكمالات الإنسانية؛ ولا ندري، فلعلّ الله تعالى لما رأى صبره رحمه الله على الابتلاءات والشدائد التي نزلت به جعله هاديًا مرشدًا لمن خلفه تفضلًا منه وتكرمًا وإحسانًا.
عثرات الطريق
إنّ حياة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها سلسلة ابتلاءات، ولا يُبتلَى في هذه الدنيا بالبلايا والمصائب فحسب، بل يُمتحن كذلك بالنعم والإنجازات المادية والمعنويّة؛ أجل، قد ينزل الإنسان منازل ويمر بمراحل في حياته، فيعجبه بعضها، وتزلّ قدمه في بعض آخر، وقد تَعْلَق به في هذه المقامات والمنازل بعض الفيروسات والميكروبات، فتتحكم بحياته المعنوية، والمعنى أنَّ مَنْ مرَّ بمثل هذه المقامات والمناصب كما يُبتلى بالراحة والرفاهية قد يُبتلَى بالصيت والشهرة، أو بالمقام والمنصب، أو بتصفيق الناس وتبجيلهم.
ويَضرب الإمام الغزاليّ عدة أمثال على ما يحلّ بالإنسان من ابتلاءات[3]، وملخصها: أنه قد يسمع امرؤٌ بجمالٍ رائعٍ خلابٍ لبلدةٍ ما كأنها الجنة، فيقصدها ويسلك طريقَهُ إليها بعزمٍ ماض وحزم بالغ، ثم يعترض طريقه مكانٌ مريح لطيف أطربه فيه خرير الماء وحفيف الأشجار وشدو الطيور، فدعته الظلال إلى الركون والراحة، ونسي البلدة التي قصدها، وقرّر البقاء في هذا المكان، وقاوم من فوره ببناء كوخ، وأقام فيه”.
تلك هي رحلة الإنسان في هذه الحياة أوجزها الإمام الغزالي في مثال جديرٍ بأن نتوقف عنده.
وفي منازل حياة الإنسان صُوَر أخرى من الابتلاءات غير ما ذكرنا، أي إنه سيظل طوال الطريق يتعثر بكثير من الأشياء، ويميل إلى الدعة والراحة ويُولَع بهما، علمًا أنه لا يتأتى دخول الجنة وبلوغ رضا الله دون اجتياز هذه المراحل.
الطمع في الثروة
ومن أشدّ الابتلاءات في الحياة الدنيا الرغبةُ في المتاع والملك، والطمعُ في المال، بل يمكن القول: إنها كانت وما تزال أكبر نقاط الضعف للغالبية العظمى من الناس على مرّ التاريخ، وهي الحقيقة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: “لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ”[4]؛ أجل، إن الاستكثار من المال بشرَه وطمع لا ينقطع، والسعيَ إلى امتلاك مصانع وشركات قابضة أكبر حجمًا، ومحاولةَ السعي لامتلاك كل شيء، نقطةُ ضعف لدى غالبية الناس؛ والواقع أن سرّ كثير من الصراع والشِّجار في المجتمع اليوم هو السباق على هذا الضرب من المصالح.
ولما ضُيّق على محيي الدين بن عربي في دمشق ضرب الأرض رجله وقال: “معبودكم تحت قدمَيَّ هاتين”، فكفّره بعضهم،، وإنما كان يقصد أن مخاطبيه شُغفوا بالمال حتى كأنهم يعبدونه، مَثلهم في ذلك مثل قارون، ثم تبين بعد زمن طويل أنه أراد بقوله: ” معبودكم”، كنزًا عظيمًا كان مدفونًا تحت موطِئ قدميه.
والحقيقة المؤسفة أن كثيرين اليوم يُهلكون أنفسهم في هذا السبيل؛ وتجدون كثيرًا من عُبّاد الدنيا سلكوا هذا الطريق من منطلق: “لا بد لي من بيت”، ثم يتملكهم مبدأ يقول: “لا بد أن أشتري بيتًا لِابني أيضًا، وآخر لابنتي، وفيلَّا لحفيدي…إلخ”؛ بل قد تجدون أناسًا انطلقوا من الخدمة في سبيل الله، ثم هرْولوا وراء هذا الضرب من الرغبات حتى كأنهم من عُبَّاد المال، ومنهم من لا يكتفي براتبه، فيترك خدمات ضرورية جدًّا للدين والأمة كي يجني أموالًا أكثر، فيخوض في طريق أهل الدنيا ويترك منهج السلف الصالح.
الولع بالشهوات
إن الولع بالشهوة ابتلاء آخر من الابتلاءات الخطيرة الصعبة في يومنا هذا خاصة؛ نعم، كانت مصيبة الشهوة اختبارًا صعبًا على مرّ التاريخ لكنها اليوم صارت أصعب وأخطر.
ولمولانا جلال الدين الرومي في المثْنوي مقالة عن الشهوة مفادها: أن الشيطان يطلب من الله ما يُغوي به البشر ويضلهم، فيعطَى الثروةَ والمنصب والشهرة… غير أنه لا يرضى بأي منها، وفي النهاية يُعطَى القدرة على تزيين المرأة للرجل، والرجلِ للمرأة، فيفرح بهذا كثيرًا.
نعم لم ترد هذه المقالة في المصادر الأصلية، والمهم هو تلك الحقيقة التي عبرت عنها؛ أجل، إن الشهوة أصعب امتحان في الدنيا لبعض الطبائع، دَلَّ على هذه الحقيقة الحديث النبوي الشريف: “حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ”[5]؛ أجل، فطريق الجنة طويلة، ومراحلها كثيرة، وتقطعها سيول وأنهار من الدم والصديد، أما طريق جهنم ففيها ما تشتهيه الأنفس من مأكل، ومشرب، وملذات، ومَن سار فيها انساق واندفع خطوة فخطوة إلى أسفل سافلين دون أن يشعر ألبتة.
الرغبة في الشهرة
من الامتحانات التي خسر فيها كثيرون حبّ التعظيم والمنصب والمكانةِ، والرياءُ وحبُّ تقدير الناس وثنائهم؛ فالشهرة التي ذكرها الأستاذ بديع الزمان في رسالته: “الهجمات الست” وسمّاها: “حبّ الجاه”، وشبَّهها في “المثنوي العربي النوري” بـ”العسل المسموم” إحدى نقاط الضعف الخطيرة التي قد يعلق بها بعض الناس؛ نعم، إن هذا الإنسان الضعيف الذي يحاول نقل بلاهة الشهرة إلى الآخرة لن يتوانى عن فعل أي شيء في الدنيا ليحطى بها.
اللهم إنا نعوذ بك من التردي في تلك الوهاد السحيقة، وخذ بأيدينا إلى الآخرة بتأشيرة الإيمان وشعور الإحسان.
[1] والمقصود بـ”السلب في العبادة” أن المصيبة تُكفّر خطايا المؤمن مع أنه لم يقم بأي عبادة بإرادته، فالمراد بـ”السلب” هنا العَدَمية، فكأن تكفير الذنوب يترتب على العدم وهو الحرمان من الصحّة واللذائذ والراحة ونحوها، ثم يؤجر عليها إن صبر. (المحرّر)
[2] سعيد النورسي: السيرة الذاتية، ص 491.
[3] إحياء علوم الدين، 3/214-219.
[4] صحيح البخاري، الرقاق، 10؛ صحيح مسلم، الزكاة، 117.
[5] صحيح البخاري، الرقاق، 28؛ صحيح مسلم، الجنة، 1.