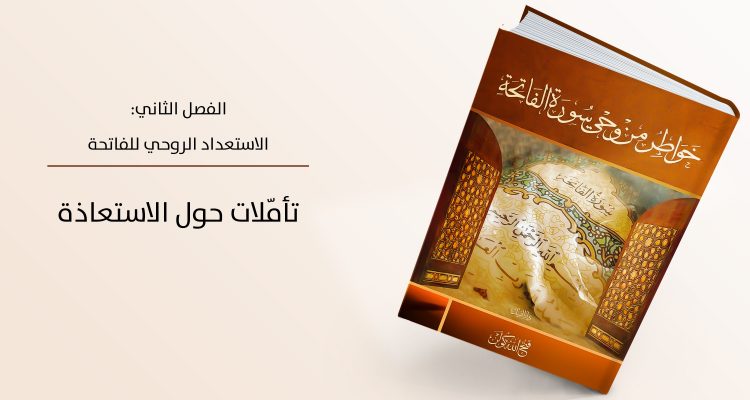إن الإنسان إذا أراد أن يدخل في عالم كلام الله فعليه أن يستعدّ لذلك بـقلبِه وروحِه ومشاعرِه، وإنما يتأتى له ذلك بتنقيّة هذه الآليّات وتنظيفِها من سُلطة الشيطان؛ فإن الله تعالى انتزعَ الشيطانَ من بينِ صفوف الملائكة، وطَرَدَه من بابه، وحَرَمَه مِن رحمَتِهِ، وحرَّم عليه الصعودَ إلى السماوات… فعلى المؤمن أيضًا أن يطردَهُ من قلبه الذي هو أعظمُ حرمةً من الكعبة، حتى يكونَ متخلِّقًا بأخلاق الله، مستحقًّا للولوجِ إلى رحاب القرآن.
فبهذه المشاعر حينما نبدأُ بتلاوة القرآن نقول في البداية: “أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”، واستحبّ بعضُ الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل زيادةَ: “السَّميع العليم” حيث تكون الصيغة: “أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”.
أ. شرح المفردات وتحليلها
1- أعوذ
هو مشتق من العَوْذ، وله معان: الالتجاء إلى أحد، والاستجارة به، والتعلُّق والتشبُّث به، فيكون المعنى: إليه ألتجِئ، وبه أستجيرُ وأتشبَّث.
أي ألتجئ إلى لطف الله وعنايته وإحسانه، واعتمادًا على لطفه تعالى أستجير به من كلِّ شيءٍ يؤذيني ويضرُّني، ولاعتمادي عليه أتشبَّثُ به وأعتصِمُ بحبلِهِ.
أي إني في منتهى الضعفِ والضحالة، لكنّي باتِّكالي عليه أقاوم كلَّ شيءٍ؛ وهكذا أبوءُ بمنتهى القوَّةِ تجاه الشيطان الذي يتربَّصُ بي الدوائر، ولا يألو جهدًا في وضعِ مختلفِ الفخاخِ والمصائدِ في طريقي.
2- بِاللهِ
إن لفظة “الله” تختَزِلُ معاني جميع الأسماء الإلهيّة المتجلّية في الكون، ومسمَّاه هو الذات المنزَّهُ عن صفاتِ النقصانِ كلِّها، والمتَّصِفُ بصفات الكمال كلها، الذي تتموَّجُ جميع الكائنات بتجلِّيات أسمائِهِ وصفاتِهِ، والذي لا يحيطُ به إدراكُ البشر، وليس كمثلِهِ شيءٌ.
ومعنى قولنا: “أعوذُ بالله”: ألتجئُ وأعتمد على من بِيَدِهِ التصرُّفُ في كلِّ الكون، مِن كلِّ الشرور والأشرار والشياطينِ الذين يأتوننا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
3- الشيطان
كلمة “الشيطان” مشتق إما مِن “شَطَنَ – يشطُن” أي بَعُدَ، وإما مِن “شَاطَ – يَشِيطُ” أي هَلَكَ واحترقَ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: “الشيطانُ كلُّ متمرِّدٍ من الجن والإنس والدوابّ”.
وعلى الأول فكلُّ من ابتعد من رحمة الله فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو الجن، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/112).
وأما إذا اعتبرناه مشتقًّا من “شاط – يَشيط” فيكون السبب في تسميته “شيطانًا” أنه كان بإمكانه أن يقوم بأعمالٍ مفيدةٍ له وأن يتقرَّب إلى الله بالسجود، لكنه تَمرَّدَ على الله وجمحَ، وبذلك أهلكَ نفسَه.
4- الرجيم
الرجيم بمعنى المرجوم، كاللعين بمعنى الملعون… أي المطرود من باب الله، والـمُبْعَد عنه تعالى.
إن الإنسان قد لا يَشعُر بوساوسِ الشيطان، وحتى إنْ شعر ببعضها فلا يستطيع التخلَّصَ منها، فكأن الشيطان أَسَّسَ محطَّةً في قلب الإنسان، وقعدَ على رأسِهِ ليتحكَّمَ فيه، ومِن بعد ذلك ركَّز فيه لاقطًا أو جهازَ استقبالٍ خاصٍّ بالوساوسِ الشيطانية.
فكما أن في قلب الإنسان جهازَ استقبالٍ أو آلةً يستطيع أن يتلقَّى بها ما يَرِد من الحقِّ تعالى؛ فكذلك هناك محطّة للشيطان.
فالشيطان يلقِّن مشاعرَ الإنسان وأحاسيسَه أمورًا قد لا يُحسُّ هو بها غالبًا، وإنْ أحسّ بها فالوساوس التي تستقبلها المشاعرُ لن يكون بمقدورِ الإنسان دفعُها في كثيرٍ من الأحيان، فحينئذٍ نقول: “أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”، ونلتجِئ إلى السميع الذي يَسمع ما يُلقيه الشيطانُ في قلوبنا من الوساوس التي لا نَقْدِر على سمعها، وإلى العليم الذي يَعلمُ حقيقةَ تلك الوساوس ويَقْدِر على دَفْعِها، لأنّه هو الأعلمُ والأحكمُ والأقدرُ والأبصرُ…
ب. ما تنطوي عليه الاستعاذة من الغايات والحِكَم
1- الاستعاذةُ وماهيةُ الإنسان
الإنسان كائنٌ مُعَرَّض لكثيرٍ من البلايا، وله أعداء كُثُرٌ، إنه مخلوقٌ ذو كمٍّ هائلٍ من الأعداء المفتَرَضين، بدءًا من البعوضة مرورًا بالحمَّى ووصولًا إلى الأجرام السماوية، حتى إنه معرَّض -مثلًا- لأن يأتي نجمٌ من السماء فيصطدمَ بالكرة الأرضيّة التي يعيش هو عليها، فإذا كان لا يستطيع أن يدفعَ أيَّ واحدٍ من هذه الشرور والأخطار؛ فلا بدَّ له أن يلتجِئَ ويعتمدَ على مَن هو قادر على فعلِ ذلك، ومِن جانبٍ آخر؛ فالإنسانُ مضطرٌّ إلى كثيرٍ من الأمور، لعلَّ أبرزَها هو جلبُ ضياءِ جمال الله -ذلك الجمال الذي ليست الأرضُ والشمس والجنَّةُ وكلُّ الأضواء والأنوار إلا قبسًا من ضيائه-، وكلُّ هذه الأمور التي هو بحاجةٍ إلى دفعِها أو جلبِها تفوقُ طاقَتَهُ وتتوقّف عندها قدراتُه.
فإدراك الإنسان لهذا الوضع وشعورُه به يُسَمَّى “معرفة النفس” أي معرفته لنفسه، فالإنسان يبدأُ في كلِّ أعمالِهِ بهذه المعرِفة.
إن الإنسان عليه أن يدافِعَ عن نفسِهِ ولكنه لا يملك سلاحًا، وعليه أن يقاوم البلايا والمصائب، ولكنه لا يملك طاقةً وقوَّةً، وعليه أن يُشبع رغباتِه التي تمتدُّ إلى الأبد ولكن ليس بإمكانه ذلك.
فالإنسان الذي يصل إلى مستوى “معرفة النفس” يرى نفسه في البداية على الوجهِ الحقيقي مسكينًا عاجزًا ضعيفًا، فإذا بقلبِهِ يغمره التواضع والانكسار… فيعود كسيفَ البالِ، منكسرَ الروح والأحاسيس، مَهِيضَ الجناح، محنيّ الرأسِ؛ بحيث إنه بوضعه هذا حتى وإن لم ينبس ببنتِ شفة؛ فالمولى تبارك وتعالى سيَرْأَفُ بحاله وسيرحمه.
وهذا جانبٌ آخر من الموضوع…
وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام حالةٍ مختلفة، وهي ما نسميها “الفعل والعمل”؛ ففي القلب يبدأ تمنّي حفظ الحق تعالى وعنايتِه وكرمه، فكأن الإنسان بكلِّ كيانه يبحثُ في داخلِهِ عن سبلٍ للسموِّ والارتقاء، واللسانُ يكون ترجمانًا لهذه الحالة التي تنبعث من الفؤاد ويقول: “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”، والمعنى: “اللهم يا ذا الطَّول والقوة، إني ألتجئ إليك بكلِّ كياني، فلا ملجأ إلا إليك”.
وكم من الناس من يتمنّى أن يكون مؤمنًا صادقًا، ذا عقيدةٍ قويّةٍ، وأن يحيا حياةً مستقيمةً، ولكن الشيطان الوسواس الخناسَ ينحرفُ به، فكما لا يستطيع أمثال هؤلاء أن يَحيَوا حياة مستقيمةً فكذلك لا يستطيعون أن يحافظوا على عقيدتهم. فمَن هذه حالُه عليه أن يقول تجاه الأمور التي لا طاقةَ له بها: “أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”، تلك الجملة التي تعني الالتجاءَ إلى عناية الله تعالى.
إن الله أَدْرَجَ في ماهيّة الإنسان مشاعر طبيعيّةً مثلَ الشهوة والغضب وغير ذلك، وجبَلَهُ عليها حتى تكونَ مَدارًا لارتقائه وسُمُوِّه، فهذه الأمور تكون منابع ووسائل لِتَرَقِّيه، فالله الذي خَلق النارَ ليستفيد بها الإنسان خَلق الشهوة أيضا للغاية نفسها؛ حتى يتناسل الإنسان، ويَكثُر عددُ الأمة المحمدية، وتزيد أعداد مرايا الأسماء والصفات الإلهية، وتتحققَ بذلك المَقاصدُ الإلهية… فغريزة الشهوة التي مُنحت الإنسانَ لتحقيق هدفٍ سَامٍ كهذا نراها في كثيرٍ من الأحيانِ تُودِي بالإنسان في مَهاوي الظلمات وتُغرقه، والإنسانُ فُطِر على حبِّ التحليق في الذُرى، ومُنِحَ الاستعدادَ لذلك، فإذا بالشهوة تُجبره على الذوبان في مراجل الجسمانية، وتُحيط بكيانِهِ حتى تخنقَهُ في سجنها.
والغضب وسائر الغرائز الطبيعية كلها قد أُودِعت في ماهية الإنسان وجَذرِهِ لأهدافٍ سامية؛ ولكنَّ الإنسان الذي يَنُوءُ بحمل ذلك كلِّه يضيق ذرعًا ويَبلُغ منه القلبُ الحنجرةَ، في حين أنه يودّ أن يرفرف بجناحيه مثل الحمائم ويحلِّقَ في الأعالي، وحينما يَعجز عن ذلك يخطرُ على باله الالتجاءُ إلى الله والاستجارةُ به فيقول: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
2- الاستعاذة علامة صِدْقِ الولاء
إن الاستعاذة في أحدِ معانيها: ضربٌ من ضروب الاعتذار، ومن جانبٍ آخرَ هي: علامةٌ على صدق المحبّة وسلامةِ الولاء، وحسب تعريفٍ آخر هي: تفويضُ المخلوقِ للخالقِ كل أمورِهِ وكلَّ ما يتعرّض له من الارتباك والحيرة، فها هو سيدنا نوح u الذي كان من أولي العزم من الرسل، حينما نبَّهَهُ الحقُّ تعالى في ابنه بقوله: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ نراه على جناح السرعة يقول: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْاَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ (سورة هُودٍ: 11/46).
وسيدنا يوسف u كذلك جابَهَ طلبَ امرأةِ العزيز وتهديداتِها بقوله: ﴿مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾، فنحن نلاحظ ههنا حالًا يعكس مدى الإخلاص وصدق المحبّة لله تعالى، فسيدنا يوسفُ الذي يصوِّره القرآن رمزًا للعِفَّةِ، كان قد أيقنَ بأنَّه إنما يتخلَّص من هذا الأمر بالالتجاءِ إلى الله، وهذا ما حصل فعلًا، فما خابَ ظنُّه ولا كَذَبَ رجاؤُه.
وسيدنا موسى u لمَّا تردد قومه وتساءلوا في ذبح البقرة بقولهم ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/67) قابلهم بقوله: ﴿أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/67).
فمن كان ذا معرفة بالله لا يسمى “جاهلًا” مهما قَلَّ نصيبه من العلم، ولكن من لم يَعرِف اللهَ فإنه “جاهلٌ” يمهما كان غزيرَ العلم، فهنا يُسنَد الاستهزاءُ إلى نبيٍّ من الأنبياء وهو يستعيذ بالله من ذلك؛ فإنه ليس من الممكن قطعًا أن يَصدُر الاستهزاء من نبيّ؛ لأن ذلك ديدنُ الذين لا يعرفون الله.
والحقّ تعالى يُعَلِّم نبيَّه بلسان القرآن أن يقول: ﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ $ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (سورة الْمُؤْمِنُونَ: 23/97-98).
ومن جانب آخر يوصيه في سورتَي الفلق والناس بالاستعاذة من جموع الشياطين إلى الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ $ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ $ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ $ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ $ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ (سورة الفلق: 113/1-5)، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ $ مَلِكِ النَّاسِ $ إِلَهِ النَّاسِ $ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ $ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ $ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (سورة النَّاسِ: 114/1-6).
3- الاستعاذة نداء إلى تفويض الأمور إلى الله تعالى
يروي معاذ بن جبل وغيرُه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم حادثة شاهدوها عند الرسول، في حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من المحدّثين:
اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ.”[1]
وهذا الرجل أساء الأدب مع الرسول، ومن المحتمل أنه كان في قلبه نفاق أو أنه لم يَفهم كنهَ هذا الأمر، مع أن غرض الرسول كان مختلفًا تمامًا، حيث كان يريد أن يبعده عن هذا الجوِّ الخانق الذي يعيشه، بمعنى أنه:
كان يقول له: إنك إذا قلت هذا القول تكونُ قد فوَّضْتَ أمرَك وأمرَ الشيطان إلى الله، وتنبه! إن أنواع الانتقام التي تحيكها في خيالك تجاه هذا الرجل الذي غضبتَ عليه إنما هيَ ستؤثِّر فيك، وفي نهاية المطاف سيَرجع ضررُها إليك لا إليه، وفي المقابل إذا فوَّضْتَ الأمرَ إلى الله فإنه سينتقم لك انتقامًا لن تَقْدِر على مثله ولو عُمِّرتَ ألف عام، فلذلك عليك أن تستعيذ بالله.
إن الرسول بقوله هذا يذكِّره بما يلي: أحيانًا يتخاصم اثنان ويترافعان، ولا يُدْرَى مَن المُحِقُّ منهما ومَن المُبْطِل؟ ففي مثل هذا يكون الأنسبُ تفويضَ الأمر إلى الله تعالى، فقولُ المرء في هذه الحالة “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” يعني: “أعوذ بالله من شرِّ الشيطان، ومن أن أتَّخِذَ قرارًا خاطئًا، أو أنحازَ إلى أمرٍ بغير حقٍّ…”. فقوله هذا سيَصبُّ الماء على هذا اللهيب الشيطاني الهائل…
والرسول ضمنَ ذلك يشير إلى نقطةٍ مفادُها: إنك بما تملك من القوّة والطَّاقة والجبروتِ تتجاسَرُ وتُـقْدِم على شَجِّ هامة خصمك، والحالُ أنك مهما كنتَ قويًّا فالله أقوى منك، فالتجِئْ إليه واسْتَجِرْ به.
فهذا الرجل -الذي يعاند تجاه هذه الجملة المباركة التي تَصْدُر من الرسول، والتي تحتوي كلَّ هذه المعاني السامية- سيُحْرَم من ذلك كلِّهِ، ويصبحُ مغلوبًا ومقهورًا أمام نفسِهِ وشيطانِهِ.
4- الاستعاذة: الملجأ الوحيد تجاه كلِّ شرٍّ وشرِّير
أخرج مسلم والترمذي عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسولَ الله r يقول: “مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: “أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ”، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلِكَ”[2].
هذا الحديث يلفت أنظارَنَا إلى النقطة التالية: هناك -من الملإ الأعلى إلى أسفل سافلين- صراع دائرٌ بين الأشرار والأخيار، وبين الأرواح الخبيثة والطيبة، وبين الشياطين والملائكة، فبينما الأشرارُ يَسْعَوْن للإضرار بالإنسانية يَكِدُّ الأخيارُ لخيرها، وفي حين أن الأشرار يُضِلّون الإنسانَ عن طريق الهدى؛ يدعوه الأخيار إلى الطريق المستقيم، فأينما ذهب المؤمن وحيثما حَلَّ فعليه أن يَلجأ إلى الله ويستجيرَ به من شرّ الجنّ والشيطان، ومن شرِّ الحشرات والهوام، لأن هذا يعني الابتهالَ إلى الله تعالى ليتكلَّل هذا الكفاح في نهاية المطاف بالتوفيق والنجاح.
يُروى أن أبا أمامة الباهلي كان جالسًا في المسجد مهمومًا حزينًا، مكدَّرًا كسيفَ البال منحني الرقبة، فسأله الرسول: “يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟” قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: “أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ U هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟” قَال: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: “قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ”، قَالَ أبو أمامة t: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ U هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي.[3]
إن كلَّ واحدٍ من هذه الأمور لَمِن الجواهر الفريدة التي تُعبّر عن حقائق عظيمة في غاية الأهمّية، فكأن الداعي بهذا الدعاء يريد أن يقول: اللهم إنَّ هناك كثيرًا من الناس لم يُضَحُّوا بحياتهم في مواطنَ يجب عليهم التضحية بها فيها، لكنهم اضطرُّوا في نهاية الأمر أن يُضَحُّوا بها وهم صاغرون، فأعوذُ بك اللهمَّ أن أضحِّي بحياتي هكذا بِذِلَّة… وكم من أناس كان بإمكانهم أن يُنفِقُوا أموالهم وهم أعزّة فيحافظوا على عزّتهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك فسُلِبَتْ منهم أموالُهم عنوةً، فأعوذ بك ربي من هذا أيضًا، وأعوذ بك من أن يغلبني أعدائي… فهذا معنى الدعاء الذي وصَّى به الرسول سيِّدَنا أبا أمامةَ الباهلي.
وفي القرآن الكريم مئات من الآيات تدل -دلالة واضحة أو خفية، على سبيل الصراحة أو الإشارة أو الرمز- على التعوذ بالله من شرِّ الشيطان والنفسِ ونوائب الدهر وكثيرٍ من الحوادث التي لا نعلم حِكمتها، ولن نسردَ كلَّ تلك الآيات حتى لا يؤدّي ذلك إلى التطويل بل سنجتزِئُ بما ألمَحْنا إليه، ونحاولُ بيانَ ما في الاستعاذة من الدقائق والنُّكَتِ فنقول:
5- الاستعاذة، وحاجاتُ الإنسان الممتدَّةُ إلى الأبد
إن الإنسان كائنٌ تمتدُّ حاجاته إلى الأبد؛ فكما أنه يطلبُ زهرةً واحدةً فهو يطلب ربيعًا أيضًا، فهل –يا ترى- ستَشْبَع رغباتُه بالحصول على الربيع؟! إنه عند حصولِه على الربيع سيطلب الجنةَ، وهو لن يرضى بالحصول على جنة مؤقَّتة، إنه يطلب الخلود فيها، ولكن خلودًا في سعادة، إلا أنه بعد مرحلةٍ ما لن تُشبعه هذه ولن تشفيَ غليلَه، فسيطلب مشاهدة الحقّ تعالى؛ فكلُّ ما يُمنَح للإنسانِ يلفت نظرَه ويفتَحُ أفقَهُ إلى ما وراءه مما هو أكبر وأكثر، فيشرعُ هو بدورِهِ بالتَّطلُّعِ والنظَرِ إلى ما وراء ذلك؛ وهكذا دواليك أبدًا…
فالإنسان كائنٌ تتوالى طلباتُه، ولكنه مع هذا الشَّرَهِ ضئيلُ الإمكانات محدودُ الوسائل، فإمكاناته منحصرةٌ بما تطالُه يداه؛ حتى إنه قد يعجزُ عن بعض الأمور الخاصة بهذه الدائرة؛ فيُغلَب على أمره؛ فماذا على إنسان كهذا..؟! فمهما قال القائلون، فالطريق الأنسب والمعقول هو أن يقول: إنني ألتجئ إلى عناية الله، فالله تعالى يجعلنا نُعَبِّرُ عن هذا المعنى بأن نقول حينما نبدأ بتلاوة القرآن: “أَعُوذُ بِاللهِ”.
6- الاستعاذة اعتراف للإنسان بعجزه
إن الاستعاذة هي -في أحَدِ جوانبِها- اعترافٌ للإنسان بعجزِهِ، والإنسان المعترِفُ بعجزِهِ يتوجَّهُ بقلبِهِ المنكسِرِ إلى الله تعالى، فحينئذٍ تميط الرحمةُ الإلهية اللثامَ عن وجهها، فترتَسِمُ البسمةُ على مُحيَّا هذا الإنسان الذي هو بِأَمَسِّ الحاجة إلى الشفقة والرحمة، فهذا الإنسان المشرَّف بقربٍ كهذا سيُدْرِك معنى ما يُروَى أن داود عليه السلام قال: أَيْ رَبِّ أَيْنَ أَلْقَاكَ؟ قَالَ: “تَلْقَانِي عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُم”[4].
7- الاستعاذةُ تخليةٌ وتزكيةٌ للقلبِ
لا بُدَّ لإحراز الإنسان مرتبةَ الطاعة التامّة من أن يَطرُدَ الشيطانَ المتربعَ على عرش قلبه، ويهيِّئَه لله تعالى، والإنسانُ إذا لم يَطرُد الشيطانَ مِن قلبه، ولم ينظِّف ضميرَه، ولم يزيِّن عالَـمَه الداخليَّ؛ يكون ما يقرؤه من القرآن خارجًا من قلبٍ وَسِخٍ ولسانٍ دَرِن، فمن كان كذلك فلا بدَّ له من القيامِ بعملية التخلية والتزكية، وهذا ما يتحقَّق بالاستعاذة، فنحن حينما نقول: “أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” نفكِّر في هذا المعنى العُلويّ، وبذلك ننظِّفُ القلبَ ونُنَقِّي اللسان، ونقول هذه الكلمةَ المباركةَ ونحن نؤمنُ بقوةِ تأثيرِها.
إن القلب بيتُ الله، والسلطانُ يَنزِل إلى قصره في جنح الليالي، والرسولُ يوصينا إذا أوى أحدنا إلى فراشه بأن يتوضَّأ، ويقرأَ الدعاء المعروف، ويتوجَّهَ إلى الله، ويتعوَّذَ بالله من شرِّ الشيطان، ويقرأَ “المعوِّذتين”، ذلك لأنه من المحتمَل أن ينزل سلطانُ قلوبنا في تلك الليلة إلى بيته، فإذا كان القلب منغلِقًا وسخًا ولم يُنَظَّفْ لله، فذلك مستحيل ألبتة، يقول العارف بالله إبراهيم حقي (شعر):
“القلب بيت الله، فنظِّفْه مما سواه..
حتى ينزل السلطان إلى قصره في جنح الليالي…”
وفي الحديث: “يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: “مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ”[5].
لا ندرك كنهَ هذا النزول، إلا أن اللهَ سبحانه وتعالى لا يشرِّف قلوبنا بنزوله إلا إذا جهَّزْناها له وأعدَدْنا العدّة لذلك.
إن الله تعالى أعدّ لنا الجنةَ، وسمَّاها دار السلام، فكأنه تعالى يقول لنا: “إنني أعددتُ ذلك المكان وجهزْتُه للطاهرين والنظيفين، وبَرَأْتُ فيه حورًا مقصوراتٍ لم تقع عليهن عيونُ الإنس ولا الجان، ولي أيضًا قصرٌ منيفٌ هو قلبُكَ أيّها المؤمن، فهل تحافظ لي على نظافة قصري ونقائِهِ مثلما أحافظ لكَ على نظافةِ الجنة ونقائها؟!
هناك أثرٌ مشتهر على الألسنة، يُروَى على أنه حديث قدسي: “مَا وَسِعَتْنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي، وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ”[6].
إنَّ الله تعالى جعل القلبَ مَعْكِسًا ومرآةً لتجليّاته، واتخذه لنفسه عرشًا بكيفيَّةٍ لا ندرك كُنْهَها، إنه حَفِظ دارك ومأواك (الجنة) من الشرورِ والأشرارِ، فهلّا حافظتَ على نقاوةِ وطهارة قلبكِ الذي هو بمثابة بيتٍ له عزَّ وجلّ.
فالاستعاذة ستحقِّقُ هذا النقاءَ وستحافِظُ على هذه الطهارة، ولذلك كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه ينفثُ في كفَّيه بـسورة الإخلاص والمعوِّذتين جميعًا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده”[7]، وهكذا كان يتعوَّذ من كلِّ شيءٍ بالله، وكأنه يقول: لا يمسَّنّ الشيطانُ جسمي، ولا يدخلنَّ قلبي.
يقول صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ”[8]، وكأنه يتَّخِذُ الكريات الحمراء والبيضاء مَركبًا، فيَنْفُذُ عبرها إلى قلب الإنسان، ويبثُّ فيها الوسوسةَ، وبذلك يُعَكِّرُ صفوَ القلبِ الذي هو محطّ التجليات الإلهيّة، فبسبب ذلك ينظر الإنسان إلى كلِّ ما حوله مما يُذَكِّر بالله، بنظرٍ عكرٍ وضبابيٍّ، وفي النهاية يتراءى كلُّ شيء في ماهيّتِهِ عَكِرًا وضبابيًّا، فالله تعالى يأمرنا بالاستعاذة ويقول: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللهِ﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/200) (سورة النَّحْلِ: 16/98) (سورة غَافِرٍ: 40/56) (سورة فُصِّلَتْ: 41/36) ويذكر الاسم الشريف: “الله” الذي هو الاسم الخاص بالذات الإلهية ويتضمَّن سائرَ أسمائه الحسنى ويشملها، ولا يقول: “استعِذْ بالرحمن، أو استعِذْ بالرحيم، أو بالقدوس…”.
8- الاستعاذة أمام نوعَي الجهاد
والآن لنذكُر نكتة لطيفة:
إن لكم صنفين من الأعداء، ولكم تجاه هذين الصنفين نوعان من الجهاد:
فأولهما: “الجهاد الأصغر”؛ وهذا النوع من الجهاد يكون تجاه أعداء مادّيّين يواجهون إيمانكم ودولَتَكم ووطنكم، ويعملون على إزالة وجودِكم المادّي، ونَهْبِ ثرواتكم، واستعمار بلادكم، فهؤلاء يجابهونكم ببنادقهم ومَدافعهم ودباباتهم وطائراتهم، فكلما طلبتم النصر من الله تعالى أمام هؤلاء الأعداء؛ جاءكم نصرُه وأَرسَل ملائكتَه وهَزم أعداءَكم:
﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ $ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة الأَنْفَالِ: 8/9-10).
﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ $ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ $ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ $ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/123-126).
نعم، إنكم طلبتم النصر من الله، والله أمدكم بألف أو بثلاثة آلاف أو بخمسة آلاف من الملائكة.
وفي معركة “جَنَقْ قَلْعَة” (الدَّرْدَنِيل)، وبشهادة الضابط الإنكليزي “هاملتون (Hamilton)”: أرسل الله الملائكة على صورة رجال معَمَّمين، وجَعَلَهم يركضون أمام حفنةٍ من جيش المسلمين الـمُثخَنِ بالجراح، دَحَرَ بهم جيشًا عرمرمًا جرَّارًا لدولةٍ متغطرِسةٍ مثل الإنكليز، فحالوا دون عبورِهم من مضيق الدَّرْدَنِيل؛ فلما جاشت قلوب المفعَمين بالإيمان بنداءِ: ﴿مَتَى نَصْرُ اللهِ﴾ أرسل الله ملائكتَهُ ونَصَرَ عِبَادَهُ.
وثانيهما: “الجهاد الأكبر”؛ وفي هذا النوع من الجهاد هناك حاجة إلى سندٍ أقوى؛ فالجهاد الأكبر نقوم به تجاه الشيطان الذي يتسلَّط علينا وتجاه النفسِ الأمارةِ بالسوء، وفي كفاحنا هذا الذي نجريه أمام النفس والشيطان نُزيحُ كلَّ الوسائطِ ونلتجِئُ مباشرةً إلى الله تعالى؛ لأن هذا الكفاحَ ليس من النوع الذي يُقَدَّم تجاهَ العدوِّ الذي يحتلُّ البلاد، بل هو كفاحٌ تخوضُ فيه تجاه الشياطين والأشرارِ الذين يحتلُّون القلبَ الذي هو “بيت الله”.
كم من فئة قليلة ضعيفةٍ مادّيًّا غَلبت فئةً كثيرةً أقوى منها بإذن الله وعنايته وبقوة صِلَتهم بربهم في الجهاد الأصغر، كذلك لن يُحرِز الإنسانُ النصرَ في هذا الجهاد الأكبرِ أمام النفس والشيطان، ولن يتخلَّصَ من الهزيمة أمامهما إلا بعناية الله ونُصرَتِهِ، فالطريقة المُثلى في هذا الجهاد هي الاحتماء بالحق والالتجاءُ إليه مباشرة، و”التعوُّذُ” -بالفعل- عنوانٌ لهذا الالتجاء والتوجُّهِ إليه تعالى بشعورٍ ووعيٍ…
9- الشيطان الرجيم.. بين الماضي والحاضر
إن الحقَّ يَصِفُ الشيطانَ بـ”الرَّجِيمِ” أي المطرود من باب الحضرة الإلهية، ومن هذا التعبير نفهمُ أنه في سابق عهدِهِ كان من المقرَّبين إلى الحضرة الإلهية ومن المطيعين، لأنه لو لم يكن مقبولًا لدى الحضرة الإلهيّة قبلَ ذلكَ لما كان يُتصوَّرُ كونه من المطرودين، والشيطانُ راحَ ضحيةَ كبرِهِ وغرورِهِ، فأدَّى عصيانُه وتمرُّدُه إلى رَجْمه، فطُرِد من الجنة التي أعدَّها الله لعبادِهِ المؤمنين، أي إن اللهَ طَرَد الشيطانَ من الجنَّةِ حفاظًا على عبادِهِ وسلامتِهِم، ولكن يا تُرى هل نَقَّيْنَا قلوبَنا -التي هي مرآةُ الصمدانيّة- من شرِّ الشيطانِ وَرِجْسِه؟! فهذا هو لبُّ القضية وبيتُ القصيد، وإنّ الاستعاذةَ لَتُذَكِّرُنا بهذا على الدوام.
“اَلشَّيْطَان”: هذه الكلمة مُعَرَّفة بأداة التعريف، وذلك يعني أنه شيطانٌ معروفٌ ومعهودٌ، ذلك الشيطان الذي عادى آدم عليه السلام وما زال يعادِي ذرِّيَّـــــتَـــهُ إلى اليوم.
نعم، إن الشيطانَ في الماضي، بتلك السلطنة التي أسَّسها لِحِساب الكفرِ والإلحادِ، ولا يزال يفعل ذلك في الحال وسيواصل ذلك في المستقبلِ، وسيبقى إلى قيام الساعة يعملُ جاهِدًا لِتحقيق هذا الهدف، وفي كلِّ مرحلةٍ سيجدُ له من يمثِّلُون دعواه، ولن يألوَ جهدًا في سبيل هدمِ النظامِ الإلهيِّ، إنه عدوكم القديم، ذلك الشيطان الذي تَسبَّبَ في طردِ أبيكم من الجنة، فأنتم تعرفونه جيِّدًا، ولكن اعلَموا أنه سيحاول أن يفعلَ بكم مثلَ ما فعل بأبيكم، فَحَذَارِ من أن تغفُلوا عن ذلك فتتَّخِذُوهُ وليًّا، بل تَعوَّذوا بالله منه، وهذا المعنى على ما إذا كانت “أل” التعريف للعهد الخارجي، وأما إذا كان للجنسِ فيكون المعنى حينئذ: أعوذ بالله من شرِّ كلِّ شيطانٍ إنسيٍّ وجنّيٍّ؛ مِمَّن أَخرَج سيدَنا آدم من الجنة، ومَن أغوى قومَ سيدنا نوح، ومَن أطغى قومَ سيدنا هود، وشرِّ سائر الشياطين الذين هم وراء كلِّ ضلالة ورذيلة وشناعة في عصرنا هذا.
ج. أحكام فقهية تتعلق بالاستعاذة
وأما الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستعاذة، فمن العلماء من يرون الاستعاذة بعد الانتهاء من تلاوة القرآن وهم قلّة، والجمهور يرونها قبل البَدْءِ بها، ولكلٍ دليلُه ومستنده.
وللقراء والعلماء آراء مختلفة في صِيَغةِ الاستعاذة، نُجمِلُها على النحو التالي:
1- “أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم”، بها يتعوّذ جمهورُ السَّلَفِ من الصحابة والتابعين.
2- “أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم”، وهي ما اختاره بعضهم.
3- وبعضهم كان يتعوذ بـ”أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”.
فالتعوُّذ بالله من شرِّ الشيطان في كلِّ الأحوال؛ في الصباح وفي المساء، وعند النوم وبعد الاستيقاظ، سيكون بمثابةِ وثيقةٍ للعيش في أمان، والوصولِ في أمنٍ إلى الجنة دارِ السلام.
والاستعاذةُ علامةُ الالتجاءِ إلى الله، وتقديمِ المعذِرَةِ، وأمارةُ الإخلاص، والقرآن المعجزُ البيانِ يوصينا بأن نقول: “أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”، وأن نبحث عن مدى طاقتنا وحجمنا تجاه نوائب الدهر، وأن نتعلّم المهارات التي يتطلَّبها هذا الأمر، ويسوقنا إلى أن نتصرَّف وكأننا مهيضو الجناحِ كسيفو البالِ، وأن نحلِّق إلى آفاق الكمالات الإنسانية بجناحِ العجز والضعفِ، ونفهمَ أننا “لا شيء” حتى نعتمدَ عليه ونستعينَ به في كلِّ خَطْبٍ ونازلةٍ.
[1] صحيح البخاري، بدء الخلق، 11؛ الأدب، 44؛ صحيح مسلم، البر، 109؛ سنن الترمذي، الدعوات، 51.
[2] صحيح مسلم، الذِّكْر، 54-55؛ سنن الترمذي، الدعوات، 99؛ سنن ابن ماجه، الطب، 46.
[3] صحيح البخاري، الدعوات، 36؛ سنن الترمذي، الدعوات، 70؛ سنن أبي داود، الوتر، 32.
[4] البيهقي: كتاب الزهد الكبير، ص 162.
[5] صحيح البخاري، التهجد، 14؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 168.
[6] انظر: العجلوني: كشف الخفاء، 2/230.
[7] انظر: صحيح البخاري، فضائل القرآن، 15، الطب، 39؛ سنن الترمذي، الدعوات، 22؛ سنن أبي داود، الأدب، 108.
[8] صحيح البخاري، الاعتكاف، 11-12؛ بدء الخلق، 11، الأدب، 121، الأحكام، 21؛ صحيح مسلم، السلام، 23-24.