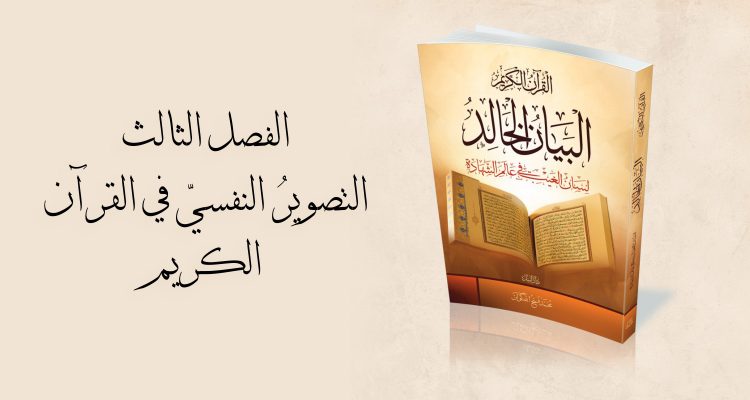ما سبق من مطلع الكتاب إلى هنا وما أسهبنا فيه يبين أن القرآن تحفة إلهية رائعة يستحيل أن يأتي البشر بمثله، فله -قبل كل شيء- أسلوب تعبيري بياني ذو سَمت خاص، إنه بهذا الأسلوب التعبيري الرائع يعم الناس دائمًا بدفء غامر فريد، فامتاز بهذا عن سائر الكتب السماوية ، بله كلام البشر وتآليف قرائح كُمَّل العقلاء.
وإليك مرادنا بعبارة “السمة التعبيرية” للقرآن أو”الأسلوب القرآني”:
إن القرآن يطرق قضايا عديدة، ويتناول بسبرٍ مواضيع كثيرة، فإذا ذكر مثلًا الماضي أو المستقبل بصّرنا بهما بخطوطهما، فيعرض الأمكنة والأشخاص والجماعات من كل وجه.
إذا حدَّثَنا عن الماضي نشعر وكأنه يعرض لنا دفعة واحدة شخصية الأقوام السابقين بملامحها وأطوراها وأفعالها وحركاتها وسكناتها؛ وإن أشهر الأدباء الإنجليز “شكسبير” الذي تميَّز بمهارته وسعة خياله في تصوير الأحداث، والذي ما زالت مؤلفاته تُقرأ بإمتاع إلى الآن؛ لا تخلو أدبياته السامقة من نقاط الضعف التي تعاني منها القريحة البشرية.
فالكاتب -وإن كان شكسبير- عند تصويره أحداثًا من العصور الغابرة بخصوصياتها، تراه يعكس صوتَ عصره وصورته حتى يُخيّل للقارئ أنها قصة عصرية، والحقُّ أن البشرية اختلفت وتغيرت تغيُّرًا كبيرًا عن الحقبة التي جرت فيها تلك الأحداث؛ فظروف الحياة ومستوى المعيشة والآفاقُ الفكرية تبدّلت واصطبغت بصبغة أخرى، فأين هو من رؤية كل هذه التحولات والإحاطةِ بها؟
وإذا بحثنا في القرآن عن الغابرين وجدنا قوم نوح وعادًا وثمودَ بأدق أحوالهم وأطوارهم وملامحهم الخاصة كما هي، وكأنها لوحات رأيَ العين، صلى الله وسلم
على الأنبياء الذين بلّغوا رسالات ربهم لهؤلاء العصاة الطغاة.. ولا نقصد أن نقارن بين كلام الله المعجز وكتابات القرائح البشرية الأسيرة لضروب من الضعف مثل شكسبير أو غيرِه؛ بل نقصد أن حديث القرآن عن شتى أحوال الإنسان في سالف العصور يجعلنا نحسّ ونعايش أناسًا من مختلف الحقب والعصور؛ فقد تتغير الشخوص وتتبدل الشخصيات ولكنها مختارة مباشرةً من واقع الحياة، لتُقدِّمَ آلافًا من الدروس في حلقةِ واحدة، خلافًا للروايات الأدبية والمسرحيات التي تتقطع فيها المشاهد وتختلط فيها الشخصيات بالوحوش والغيلان.
يا لها من خصيصة فريدة في القرآن المعجز البيان، يرسم ببيانه النوراني في خيال القارئ صور الأشخاص بأماكنها ومراحلها فتتجسم هذه الوقائع بأطوارها وأجوائها الخاصة وكأنها صروح ماثلة؛ ورغم ذكره لمئات الأحداث والأشخاص، فلا خلط فيها ولا التباس في ذهن القارئ لا باعتبار كيفياتها ولا أزمنتها.
من أشهر الرسامين في القرون الوسطى “ميكيلانجيلو بوناروتي”(Michelangelo Buonarroti) نَحَتَ تمثالَ سيدِنا موسى ، ولا ندري هل أراد بذلك أن يعبر عن ذاته هو أم عن شخصية هذا النبي الكريم؟! ولا جزم بواقعية هذا التمثال، فقد يُذكِّر بملامحه العريضة ، ولكن الفنانين والمتفكرين بعد “ميكيلانجيلو” قد أبدوا إعجابهم بعمله هذا، بل إنه بَهَرهم بلا تقييم لمدى نجاحه في التعبير عما أراد.
أما القرآن فيقدِّم مادة موضوعاته بنهجه وأسلوبه التجريدي دون أن يجعل منها أوثانًا أو طواطم، إنه يقدم معاني مجردة لكنه يعبر عن المقصود بكيفيةٍ تفُوقُ الأسلوبَ التشخيصي بكثير، فالقارئ يتخيل الشخوص ويتصورُها كأنها حية نابضة رأي العين.
ومن خصائص الأسلوب القرآني أنه حينما يُصوِّر القضايا ويعرضها يستخدم أسلوبًا يبعث في نفس المتلقي رغبة فيها أو رهبة منها، فإذا ذكر الذنوب مثلًا حمل النفس على أن تَعَافَها؛ فالسيئات والشرور في التعبير القرآني مستهجنات تَـــنفر منها النفوسُ وتَعافُها الأرواح.
تَحدَّثْنا آنفًا عن التمثال الذي حاول “ميكيلانجيلو” أن يصوِّر به سيدنا موسى ؛ فالفن من وسائل التعبير عن المشاعر والأفكار؛ يعبر به الفنان للمجتمع عن أفكاره ومشاعره، فهو يَعرض للآخرين خلاصة أفكاره أو ما في الأشياء من جمال بتشخيصها أو عرضِها في إطارٍ مجرّد، لكنه قد يُخفق إذا لم يوائم الفن واقع المجتمع وجمالياته، وقد يُسفر التشخيص عن الوثنية وأمثالِها من سلبيات تُناقِض طبيعةَ المجتمع وأخلاقَه.
إن الفن لا سيما المشخَّص ضربٌ من الأسلوب والتصوير، وشتان بينه وبين أسلوب القرآن وتصويرِه؛ لأن الفن يتناول الأشياء من بُعد واحد، وهكذا يَعكسها، فيبقى جامدًا منحطًّا، لا تجد فيه حيوية وحركية وجمالًا متألِّقًا متجدِّدًا باستمرار؛ أما القرآن ففيه ذلك كله؛ ففي أمثاله خصائص وافية بموضوعه، فلا تناقض في تعابيره ولا جمود عند البُعد الأحادي للزمان والمكان، بل تراها مليئة بالحيوية مهما تقادم الزمن.
ثم إن القرآن المعجزَ البيانِ يعبر عن مقصوده بمنتهى الإيجاز، فيتألق بذكر كل شيء في بضع كلمات أو جُمل، يتعذّر بلوغ ذلك المقصود بغيرها، فيحار المرء في جمل معدودة منه يرى فيها مِن فيض المعاني وثراء المحتوى ما تضيق عنه كتب أخرى.
وإذا ذكر القرآن الأنبياء السابقين وأقوامهم وأماكنهم، فلنا أن نفهم من جملتين أو ثلاث في آية واحدة حالَ هؤلاء الأقوام، وأساليبَ حياتهم، ومشاعرهم وأفكارهم، ومبادئهم في حياتهم، ومستواهم الحضاري وأن نميز بِيُسرٍ بين هذه الأقوام بخصائصها ومميزاتها كما سيأتي في الأسلوب البديع للقرآن الكريم.
هذه ومضاتٌ عن التصوير القرآني وأسلوبِه الخاص وثرائِه الذي يفوق تصوُّر البشر، أظهرت كيف عبَّر القرآن بأسلوبه الفريد عن الإنسان والجماعاتِ الإنسانية، وأبرزت ما للقرآن من قوة تصويرية وثراء تعبيري باهر، والأحداث والقضايا الغابرة كلها تغدو باهرة بتكثيفها في لوحات معينة، فالأقوام تتَتَابَعُ، بخصوصياتها ومميزاتها في خيال القارئ وكأنها في عرض رسمي، كقوم لوط بشذوذهم الذي تعافه النفوس، وأصحاب الأيكة قوم شعيب بفسادهم التجاري، وبتطفيفهم ومضارباتهم وطبيعتهم الخدّاعة؛ وكذا قوم سيدنا موسى وحيلهم وطبائعهم المَكَّارة، فهذه الجموع كلها تتمثل نصبَ أعيننا بشخوصها تباعًا.
وفي هذه اللوحات ما يغني عن الاطّلاع على تفاصيلها، فألوان الكلمات والأضواءُ المنعكسة على السِتارة اختيرت بدقة فائقة، وإن المرءَ ليشعر وكأنه أمام مسرحية لا يَشبع من مشاهدتها ومتابعتها.
ولدى تتبُّع شخصيات المِلل والمجتمعات في القرآن نراه يعرض لنا كثيرًا منها أثناء ذكره للأحداث وتصويرِها، وهي إما واحدًا من الأنبياء أو من أمته؛ فلنبحث بعضًا منهم ممن لمعت شخصياتُهم في القرآن بخصائص وأحوال ممتازة:
عندما يتحدث القرآن عن بني إسرائيل يصوّر رسولهم سيدنا موسى ويقدِّمه وهو يتحدث بأبرز سجاياه الأمّ، فقد نعرف من الأسلوب القرآني سيدنا موسى بوصفه إنسانًا وبوصفه نبيًّا؛ وإن لم نترسم قسمات وجهه، وإن كادت سماتُه الخَلقية لتلوح وتتجسد لأنظارنا قيافةً.
نعم، يمكن أن نعرف سيدنا موسى وندرك تكوينه النفسي، وأثره الفعال في الحياة الاجتماعية، وشخصيته البَنَّاءة الجامعة، وقدرته الفائقة على البناء، ومدى درايته وكياسته في تربيته وإرشادِه لهواة الفوضى والتخريب في المجتمع، بل لك أن تستشف من التصوير القرآني منكبيه وقواه العضلية، ولحيته وقسمات وجهه ونظراته وأغوارها، وهكذا يَعرض القرآن كل شيء حيًّا نابضًا يقرّ في الذاكرة ولا يبرحها.
والقرآن هنا لا يضع عنوانًا رئيسًا باسم “موسى”، بل يلفت الأنظار إلى مئات الأشخاص معًا، وإلا فالحديث عن سيدنا موسى وحده يستغرق مئات الصفحات، هذا وإذا تحدث عن الآخرين وخصائصهم الرئيسة أتى على ذكر سيدنا موسى، وألقى الضوء على صورته الظلية في بُعد آخر بكلماته وتحركاته وحملاته المتنوعة، فكم وكم من الأحداث والأشخاص يعرضها القرآن فيتخير الأنماط والشخصيات ويصبها في عواطف الإنسان ومشاعره دون أي خلط أو تنافر بينها، بل يتناول كل حدث بالحلاوة والتلون والحيوية ذاتها.
وذِكرُه لسيدنا إبراهيم ليس غفلًا بل كأنه نقشٌ في لوحة، حتى إن الرسول بنى على التعبيرات القرآنية التي نزلت بعد عهد سيدنا إبراهيم بقرون، فقال: “وأنا أَشبهُ ولدِ إبراهيم به” ، فالمسألة من الوضوح والبداهة بحيث إن هذا النمط من الشخصيات استبان بتفاصيله الدقيقة كلها، وخُطَّت صورته وهيئته بوضوح، حتى لكأن الرسول يَنظر إليه ويقول لمن معه: إنني أُشْبِه هذا الرسم الذي تشاهدون، روحًا وحالًا وطبعًا وجوانيةً.
يقول الرسول هذا وكأن الصحابة عرفوا من القرآن جيدًا شخصية سيدنا إبراهيم؛ فطابقوا قوله ووافقوه، فلو لم يكونوا مدركين لما يعنيه الرسول لَمَا فهموا شيئًا من قوله، لكنهم فهموا هذا جيّدًا من التصويرات القرآنية الواضحة، فغنوا بها عن مزيد البيان.
ولو فهمنا القرآن مثلهم لأغنانا عما سواه، بل لَتوجَّه كلٌّ منا وبيده القرآن إلى مولاه العلي القدير ومَثَلَ بين يديه بخشوع وإذعان، ولَشهدنا محافل العلم والتقنية تُبجِّل القرآن وتُجِلُّه وتَطرُق بابَه أولًا في كل ما ينتابها وتتيمنُ به.
وإذا ذكر القرآن الكريم النبيَّيْنِ العظيمين سيدنا يوسف وسيدنا سليمان عرضهما لنا بخصائصهما، وكذلك يفعل بشخصياتٍ أمثال فرعون، فهو يرسم الشخصيات الخاصة والعامة في لوحات ويقدمُها بطريقة لم يصل إليها فن التصوير الحديث، وأنى للتصوير التقليدي أو الحديث أن يرقى إلى أفق القرآن؛ لأن القرآن من علم الله المطلق، إنه منهل له من العمق والسعة ما لو تدفق أبد الدهر، ونَشر وارداتِه على الملإ، لما نضب ولا نفد.
وحينما يصوِّر القرآن شخصية “المُرائي”، يتراءى لكم كل المرائين حولكم، وإذا فعل ذلك بشخصية جليلة من أهل التقوى وأولي العزم فسرعان ما يرد إلى أذهانكم كأنه رأي عين، فتقفون له بإجلال وتبجيل.
ولنا أن نقول هنا: إن القرآن حينما يصور الشخصياتِ الخاصة أو العامة يُهيِّئُ لنا مسرحًا ممتازًا أبعاده وأضواؤه في منتهى درجات التناغم والتكامل؛ كلُّ شيء فيه قد بلغ الكمال، واللوحة فيه حيّة نابضة كأحسن ما يكون، والقصة بديعة، متعدّدةُ الوجوه، فهل من مُشاهد للمَشاهد وقارئٍ لها؟ فإذا اتّحد هؤلاء بالمشهد بحيويته ذاتها، فإن هذا يعني أنه تحقَّقَ الهدف كله وحصل المقصود؛ هكذا كان فهمُ الصحابة للقرآن ومُنزله.
وفي هذه الفقرات سنأتي على شخصيات مختلفة صوَّرَها القرآن، لنمضي في مشاهدة القوة التصويرية للقرآن الكريم.
أ. قوم نوح كما يصوّرهم القرآن الكريم
إن القرآن حينما يذكر الأقوام والملل السالفة يَعرض كل مجتمع بخصوصياته وطبيعته؛ فيسهُل تمييز كلِّ قوم عمن سواهم بأحوالهم، ولو استقرأنا آياته في ضوء هذا لرأيناها تُعنَى بالطبائع الأمّ لبعض المجتمعات، فتتراءى لنا هذه الأقوام تباعًا بكل ما فيهم، وبعلومهم وفنونهم سواء تلك التي أُسيء استخدامها أو لا، وبرجالهم الذين خلَّد التاريخُ ذكرَهم؛ فنراهم في عيشهم الباذخ، في أبنيتهم وقصورهم المشيدة الدالة على مدى تَوهُّمهم للأبدية والخلود، وقد نشاهد صروحًا بارعة، وقلوبًا وأرواحًا تهفو نحو الخلود، ولا ترضى إلا بالخلود.
في القرآن يتمايز أقوام الأنبياء؛ فالمستقرئ للقرآن يلحظ عرضه كثيرًا من الجماعات، وكيف رسم بأسلوبٍ ممتاز كلَّ المجتمعات والشخصيات من لدن آدم بجميع طبائعها وسجاياها حتى ليحسب الناظر أنه بين ظهرانيهم؛ ويتعذّر في مبحث محدود كهذا سردُ الأمثلة وحسبنا آيات من سورة هود والشعراء لعلها تفي بالمقصود.
يقول الله في سورة الشعراء: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/109).
في هذه السورة زبدةُ حياة الأنبياء وكفاحهم وروح رسالاتهم، وطرز حياتهم التي كانت تسير على نهج الاستقامة؛ وهي تَذكُر تترى أحوال الجماعات والقبائل والأقوام، وكثيرًا ما تتكرّر بعض آياتها إشارةً إلى موقف الأنبياء المتّحد وهم يؤدون الرسالة،
وإلى تشابه سجايا الأقوام وطبائعهم؛ إذ إنها نتاج الكفر، فمن البدهي ثبوت بعض وجوه الشبه، هذا ولم يخلُ كل تكرار من أحداث مختلفة.
أجل، إننا نسمع اليوم أقوالًا قيلت في عهد سيدنا آدم؛ يُطلقها المتغلّبون والمتسلّطون ويجعلون المجتمعات تتبنّاها عبر الإعلام؛ فلو أمكن مقارنتُها بأقوال أقوام ما قبل التاريخ وصداها لوجدنا أنها هي هي.
ولكل من هؤلاء خصائص، فلنتبينها في ضوء ما قلنا لنعرفهم بما يميزهم عن الآخرين.
﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/105).
إن نوحًا وصاهم بوصايا صادقة نابعة من قلب مخلص من مثل: “ادخلوا في كَنَف الله، واقرؤوا واستفيدوا من النواميس السارية في الكون قراءة صحيحة، ولا تمضوا في حياتكم خبط عشواء، بل امضوا بوعي وإدراك، فلا ملجأ ولا منجى إلا إليه سبحانه، وإياكم والإعراض عن الأوامر الإلهية”.. يبلغ هذا ثم يعقب بقوله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/109)، فلا أبتغي منكم أجرة أو عوضًا على المشاق والصعاب، بل أطلب أجري من الله وحده، إن قلبي لا يطلب إلا رضوانه، وروحي مشبعة بالإخلاص له، فلا أبتغي شيئًا من أحد سواه، فرضاه ورضوانه لا يعدلهما شيء، حتى إني لا أطمح إلى ثمرات مجاهدتي، وإن شاء ربي شيئًا منها في الآخرة فلتكن يومئذ.
ففي هذه الأثناء إذا بنا نصادف ردَّ قوم نوح بنوازعهم وعقليتهم وطباعهم على هذه الأهداف الخالصة الحانية، معبرين عن سجيتهم وأنفاسهم، قالوا: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/111)، أي من اتبعك هم أراذل الناس ورعاعهم، أوَتنتظر منا أن نتبع دين الأراذل والسفلة؟!
والناس يومئذ في خواء قلبي وروحي مهما كان وعيُهم، ومن خصائصهم تعصُّبٌ منشؤه الفراغ الفكري والعلمي، وغرورٌ وخُيلاء مصدرهما الضَّعة، وغطرسةٌ مردُّها إلى قصور المناهج الفكرية وتناقضها؛ إنها آية من بضع كلمات لكن فيها دلالات كثيرة على أبرز سجايا القوم وطباعهم، لقد كشفت هذه الآية قلوبهم المشحونة غرورًا وكبرياءً بجلاء ووضوح بأدقّ أوصافها.
وهلمَّ نقرأ أبرز صفاتهم في الآيات القرآنية:
إن قوم نوح لم يكن ظاهرًا أنهم سيؤمنون رغم كل تلك الجهود المخْلصة التي كان يبذلها سيدنا نوح.. وكان الشركُ والكفر قد ضرَبَا بجذورهما في قلوبهم، بل كانا يسيطران على أعرافهم وتقاليدهم.. فلذلك كان لا بد لهم أن يتمرّدوا تجاه هذا الإنسان الكبير الذي يطفحُ قلبُه بمشاعر المسؤولية، رغم دعوته الخالصة، ومحاولاتِه وكفاحه.. حتى إنهم كانوا، بين حين وآخر، يقفون على رأسه ويقولون له بكلّ وقاحة وسوء أدب: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/116).
نعم، كانوا يقولون له: لَنُرشقنَّك بالحجارة تمامًا مثل الزاني الذي عوقب بالرجم.. ويفهم من هذا التعبير أن هؤلاء القوم المتغطرسين للغاية كانوا يجاهرون بالتحدي تجاه هذا النبي المنكسر البال، والذي ليس وراءه جماعة قوية مؤمنةٌ به.. ومن المحتمل أن كل قُرَى وبلادِ هؤلاء كانت تحت سيطرة الكفر والوثنية.
وكما وَرَدَ في آية أخرى فإن هذه الجماعة الوثنية، على الرغم من كل الجهود التي بذلها هذا النبي، لم تلِن قلوبها ولم ترجع إلى وعيها مثقالَ ذرة، بل عبَّرت عن طبيعتها الغليظة جَراء كفرها وعنادها فقالت: ﴿يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة هُودٍ: 11/32).
لننظرْ إلى هذه الغلظة؛ فهم لا يقولون له: “إنك جاهدت وأمرت بالمعروف” بل يقولون له: “إنك جادلت وماريت”. نعم، إنهم لا يقولون له: “إنك بينت الحق، وصرت دليلًا على الصدق” بل فحوى كلامهم: “إنك أردت إغفالنا بطريق الجدال والمراء”.. بل إنهم بقولهم: ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ قطعوا شوطًا آخر في إساءة الأدب معه حيث يَعنُون بهذا: “أنك استعملت كل دهائك وطاقتك وجهدك في سبيل المجادلة”؛ ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
فهذه الآيات تحمل معاني جمّة في التعبير عن العالَم الداخلي لجماعة مجبولة ومطبوعة على العناد.. فكأنهم يقولون: إنك تتحدّث عن الآخرة، وتتحدّثُ عن الوقوف بين يدي الله والمحاسبة أمامه، وتُسهِبُ في ذكرِ ما عسى أن ينزل بنا من البلايا والمصائب إذا لم نؤمن بذلك.. ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾؛ وهذا يعني أن هؤلاء
لن يؤمنوا بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر.
فنحن نستخرج كل هذه الأمور ونستنبطها من تلك الآية التي تتألف من بضع كلمات؛ حيث إنه من الممكن أن نرى كيف صُوِّرت في هذه الآية طبيعةُ جماعةٍ عنيدةٍ مُنكِرة وَقِحةٍ، نراها كأنها رُسمت في لوحة ماثلة أمامنا.. وهناك بالمقابل نبيّ يئنُّ متوجِّعًا ملتجِئًا إلى الله وداعيًا: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (سورة القَمَرِ: 54/10).
وننتقل إلى سورة القمر، لنرى كيف يتمّ تصوير هذا الأمر؛ ففي هذه السورة يُذكر كيف كان سيدنا نوح يبتهل إلى الله تعالى بأسلوب يُعبِّر عن عجزه ومغلوبيته: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (سورة القَمَرِ: 54/10).
لعلنا نستشف في هذا الأنين والابتهال، كيف أن نبيًّا من أولي العزم قد أصبح كئيبًا كسيرَ الفؤاد، وكيف يتحرّق قلبُه ويضيق صدره إزاء قوم يُصِمُّون أسماعهم عن رسالته التي هي عبارة عن أوامر الله ونواهيه.
نعم، إنه دعا ربه: ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ﴾، وماذا عسى أن يفعل في مثل هذا الوضع؟! فقد كان أمام جماعة جامدة هامدة كالجثث لا روح لها ولا إحساس، لا تُحركها المواعظ ولا تؤثر فيها الزواجر، بل إنك إذا نظرت إلى الجثث العادية فقد تحسّ بمعنى لطيف، لكنك لن تجد -قطعًا- في هؤلاء حتى ذلك المعنى.. فقد كانت هذه الجماعة صلدة كالحجارة وفاقدةً للروح الإنسانية كالجمادات، وكانت محرومة من الأُنس والأُنسية، وكانت لهم حالة من الجمود أشبه ما تكون بِصَمَمِ الجبال.. ولهذا نرى أن المولى تعالى استجاب لابتهالات نوح المخلصة النابعة من الأعماق ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾ (سورة القَمَرِ: 54/11).
أي إننا بعظمتنا أنزلنا سيلًا من البلايا والمصائب من السماء التي يَنزل منها الخيرُ والبركةُ عادةً، فانقلبَت الرحمة بلاء وعذابًا، وصار الماء عينَ البلاء، وتحمَّست الأرضُ للبلاء، وفارت به.. وكان نوح قبل نزول البلاء مشغولًا بصنع تلك السفينة التي ستكون وسيلة للنجاة الدنيوية لمن آمن معه، وأما الآخرون فقد كانوا يزورون نوحًا بين فينة وأخرى للسخرية منه، فيتخذونه هزوًا من منظورهم هم.
﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (سورة هُودٍ: 11/37).
ومن الممكن أن نستنبط من هذه الآية أن هذا النوع من السفن لم يكن معروفًا إلى ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ أي اصنع سفينةً تحت إشرافنا ورعايتنا، وأنا الذي سأمنحك مخططَ تلك السفينة، لأن تلك السفينة ليست للإبحارِ على متن البحر فقط، بل لا بد أن تكون بحيث توصلكم إلى جوديِّ النجاة إذا طغى الماء وغطَّى جميعَ أقطار الكرة الأرضية أو جزءًا مهمًّا منها.. ولذلك لا بد أن تَصنَعها تحت إشرافنا المباشر.
فقوم نوح الذين ما سبق لهم أنْ رأوا شيئًا من هذا القبيل كانوا يأتون إلى هذا الموقع الذي يَصنع فيه السفينة، فكانوا يستهزئون به، لأنهم لم يكونوا قد أدركوا بعدُ خطورةَ ما يُعَدّ لهم.
فالقرآن الكريم في هذا السياق، حينما يتحدّث، كيف أن هذا الوضع استثار غيرةَ الله، فبذلك فجرت الأرضُ عيونَها، وأرسلت السماء أمطارَها، وأن الله تعالى هدى رسوله ومن آمن معه إلى سبل النجاة. نعم، إن القرآن إذ يتحدث عن كل هذا فإنه يستخدم أسلوبًا جاذبًا يفوق كلّ الأساليب؛ حيث إن البيان الإلهي يسرد كَمًّا هائلًا من الأحداث ببداياتها ونهاياتها في بضع آياتٍ، ولو أراد أحدُنا سردَها لضاقت عنها المجلّدات.
أجل، إنَّ سَرْد ما كان من هذه الجماعة الكافرة من التمرّد، وشرْحَ سيرة ذلك النبي المليئة بالكفاح، وبيانَ ملامح كِلا الطرفين وتصرّفاتِهما بل حتى أدقّ حالاتهما النفسية بخطوطها الدقيقة في بضع آيات وجمل قصيرة.. خصوصيةٌ لا تتيسّر إلا للقرآن.
ب. سنة الكفاح الممتدةُ من سيدنا نوح إلى سيدنا هود
إننا نشاهد في مجادلة هود مع قومه وتمرُّدِهم عليه مثلَ ما كنا نشاهد في قوم نوح؛ فهناك رجلان مؤمنان ونبيان عظيمان، وبالمقابل هناك جماعتان طاغيتان.. ونحن في سياحتنا الفكرية في سورة الحاقة والشعراء وغيرهما من السور نكاد نشاهد قوم عاد وهم صرعى وبيوتهم خاوية على عروشها، فنرتعد من هول هذا المنظر الرهيب.
ويقول الله تعالى في سورة الشعراء ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/123-127).
وكما يُفهم من هذه التعبيرات فإن همَّ كل نبي ودعواه كان واحدًا، وكلهم كانوا يقولون الأمر نفسه.. نعم، كانوا يطلبون من الناس أن يلتجئوا إلى الله، ويحترموا أوامر الله، ويطيعوه.. وهم إذ كانوا يؤدّون هذه الوظيفة لم يكونوا يقولون: “إنني قمت بمهمة فهاتوا الأجر”، بل كانوا يقولون: “إننا نحتسب الأجر من الله فيما بذَلْنا من الجهد لأجلكم، ولا نطلب الأجر إلا من الله مقابل تَعَبِنا وبَذْلِنا قصارى ما نملكه من الطاقة إلى أن تتقطع أنفاسُنا وأصواتنا”.. فكانوا بذلك يطلبون الأجر من الله وحده.
وكان عهد نوح قد ولَّى منذ زمان بعيد، ولكن يظهر أمامنا هذه المرةَ قومُ هود ، فمع أن هناك تشابهًا بينهما في الطبيعة الأساسية، إلا أن قوم هود كانوا مختلفين عن قوم نوح اختلافًا كبيرًا؛ فقد حال بينهما زمن طويل، وبُني العمران، وأُسِّست حضاراتٌ جديدة، ومن المحتمل أنه صارت القراءة والكتابة والعلوم والمعارف في هذه المجتمعات الجديدة من الأمور العادية.. ومع أن علم التاريخ الحديث يُرجع بدايةَ اختراع الكتابة إلى بعض الحقب التاريخية إلا أننا لسنا مضطرين لقبول هذا الطرح كما هو، كما أنه ليس من المعقول بتاتًا إرجاعُ بدايات الإنسانية إلى وحشية خيالية مثل عهد الكهوف (الإنسان البدائي).
إننا نرفض من الأساس هذا الخط التطوُّري رفضًا باتًّا، وننظر بعين الحيطة والحذر إلى مقولة: عصر الكهوف، العصر الحجري، العصر البرونزي… إلخ، إذ من المحتمل أن كل ذلك من الأمور غير المعقولة والتي لا سند لها علميًّا ومن الأراجيف التي دسّها التطوُّريون الملحدون في تاريخ الملل المتديّنة وغير المتدينة، بل إن في الغرب من المؤرّخين النقّادين من يقول: إن هذا الطرح ليس له أساس من الصحّة.. أجل، إن نشأة الإنسان على وجه الأرض بدأت بالنبوة فلذلك نقول: إن التاريخ البشري لم يبدأ بالتوحش والبدائية، بل إنه بدأ بالحضارة ضمنَ ظرف تلك الحقبة.
ونَرجع إلى ما نحن فيه من قوم هود، حيث يتحدّث عنهم الله بما خاطبهم به نبيهم: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/128).
وهذه التعبيرات مهمة للغاية من حيث تصويرها لحضارة تلك الفترة وأفقها الفكري والنهضوي؛ فهذه الحقبة تُمثِّل مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، مرحلة القلاع والأبراج؛ فقد كانت عاد تبني قلاعًا للاحتماء من أقوام آخرين، طِبقًا لما كان يعمله الجَنويون من بناء الحصون على جميع المرتفعات التي كانوا يذهبون إليها.. وكانوا أيضًا يبنون مثل هذه الأبنية للعبث واللهو.. فقوله تعالى: ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/128)، أي تبنون بكل ما ترونه من مكان مرتفع بنيانًا للعبث واللهو.
وفي هذه الآية الوجيزة أمور أخرى يتم بيانها؛ إذ نفهم من الآية بطريق الإشارة أنه كان هناك أقوام يعتدون على الآخرين، وكان الناس يبحثون عن طرق للخلاص من هذه الاعتداءات، وكانوا في ظروفِ تلك الأيام يبنون على الذرى والجبال حصونًا وأبراجًا.
وإلى جانب هذه الخصلة نلاحظ في الآية الكريمة خصلة أخرى لهؤلاء القوم:
﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/129). و”مَصَانِعَ” جمع مصنع أو مصنوع، أي تعملون آثارًا فنية، وتريدون أن تخلِّدوا -عن طريق الفنون- كلماتِكم الفانية وذكرياتِكم المعرَّضةَ للفناء والزوال، وتُنشئون قصورًا وصروحًا رائعة تُباهون بها كلّما نظرتم إليها وكأنكم ستخلَّدون في الدنيا، وتُنتجون أعمالًا فنية وهياكل من شأنها أن تؤدي بكم إلى نوعٍ من الوثنية، بحيث إنكم تظنون أنكم ستظلون تفتخرون وتتبخترون في ظلالها إلى الأبد.
وفيما سبق لاحظْنا قومَ نوح الوثنيّين وكيفيةَ تمردهم عليه، ولاحظْنا أن المرحلة التي وصلت إليها البشرية هي أنه بعد تسعة قرون من كفاح سيدنا نوح لم يلتحق بركبه إلا حفنة من المؤمنين.. أجل، إن هؤلاء القوم كانوا قد بلغوا هذا المَدى من العناد والكفر والطغيان.
ومن خلال التعبيرات القرآنية المتعلقة بقوم هود نلاحظ الخصائصَ البارزة لقومٍ مغرورين ومتكبِّرين جراء نحتِهم للصخور وتشكيلِها، ونقشِهم مشاعرَ الخلود عليها وعلى الجبال والصخور.. أجل، إننا حينما نجمع بين تلك الآثار التي بنوها وبين أقوالهم وأفكارهم نرى أن ما أنتجوه باسم الفن والعمارة هي صروح وأوابد تعبِّر عن التمرد والخيلاء أكثرَ من كونها آثارًا فنية.. نعم، إننا إذا قارَنَّا قوم نوح بقوم هود فسنرى أن بينهما فرقًا كبيرًا.
فإليكَ جانبًا من تصرفات قوم هود:
يقول الله تعالى على لسان نبيهم: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/130)، أي إنكم إلى جانب عبادتكم للأشياء المادية ووثنيتكم، محبُّون لذواتكم وأنانيُّون وغدّارون وظالمون بالقدْر نفسه، وإذا ظفرتم بمن يخالفكم الرأيَ تُذيقونه أشد أنواع العذاب، وأعتى ألوان القهر.. وإذ تفعلون ذلك فإنكم تمارسونه كأنه جزء من طبائعكم، ولا تجدون في صدوركم حرجًا منه.
وحينما كان نبيُّهم يقول لهم هذا فإنهم كانوا يقابلونه بقولهم: “﴿يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ (سورة هُودٍ: 11/53)، أي فالذين ذهبوا إلى الآخرة لم يعودوا حتى نؤمنَ بوجود الآخرة، ثم إنك قلت: “الله موجود وواحد”، ولكنك لم تُرِنا إياه حتى نؤمن بوجوده، وادَّعيتَ أنك نبي الله ولكننا لم نر آية ومعجزة تُبرهِنُ على ذلك حتى نؤمن بأنك رسول”.
فمن الملاحَظ أن كل الاعتراضات التي أوردوها تُشَمُّ منها رائحة البدائية، وكلها معاذير تافهة للناس البدائيين المنكِرين الذين انحدرت عقولهم إلى أبصارهم، وقد أبدى المشركون تجاه الرسول أفكارًا مشابهة لهذه ولكن بأسلوب مختلف.. وفي عصرنا هذا تتوفّر نماذج من هذا القبيل.
فقولهم: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ (سورة هُودٍ: 11/12) أو ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (سورة الزُّخْرُفِ: 43/31)، وأمثالُها إنما هي من المقولات التي تنبئُ عن الصلف والتكبُّر والقساوة في كل العصور.
إن القرآن يتناول مراتٍ عديدة قومَ هود ويَذْكُرهم بقلاعهم الحصينة وصروحهم المذهلة الشامخة وأصنامِهم الماثلة، فهم يَظهرون أمامنا في نوعٍ مختلف من الكفر ونمطٍ آخر من الكافرين.. فالقرآن يتغير أسلوبُ عرضه وتقديمه حينما يتغير مَن في المشهد من الأقوام، فنراه يقدِّم كلَّ قوم وكلَّ جماعة بخصائصهم التي يمتازون بها.
نعم، إننا إذا تعمَّقنا وسبرنا أغوار العالَم الداخلي لهؤلاء الأقوام الذين يتناولهم القرآن، فسنرى أن القرآن المعجزَ البيانِ استَخدم في تصوير الشخصيات أسلوبًا، بحيث إنه يستحيل قطعًا على أيِّ بشر أن يصوِّر بمثل هذه التعبيرات الوجيزة وبهذا الكم القليل من الكلام كلَّ واحد من هذه المجتمعاتِ التي تركت بصمات في التاريخ، ولا يسعنا إلا أن نقول: إن هذا كلام الله، ويستحيل أن يكون كلام بشر.
ج. الجماعة التي أطغتها الحياة المترفة: ثمود
إن المؤرخين المعاصرين كانوا ينكرون وجود ثمود، ولكن الحفريات والبحوث التي أجراها علماء الآثار أخيرًا أسفرت عن وجود قوم يسمَّون “ثمود” أو “تمود”، وقد عاشوا قبل عصور طويلة، وهؤلاء هم قوم صالح (ثمود) الذين تَحدَّثَ عنهم القرآن الكريم؛ فآثارهم التي خلَّفوها مِن ورائهم تروي لنا الكثير والكثير من أحوالهم وأخبارهم وأطوارهم ونمط عيشهم.
فآثارهم تلك إنما هي ترجمان جليّ البيان لطبائعهم وأقدارهم، فهي تعبّر عنهم بلسان فصيح من كل جوانبهم؛ بدءًا من طريقة تفكيرهم، وعقليتهم في نظرتهم للحياة، وصولًا إلى أسلوبهم الفني ومستواهم الحضاري… ومع أن التاريخ البشري لا يقدِّم لنا معلوماتٍ قطعية واضحة حول المرحلة الزمنية التي عاشوا فيها ومدةِ حكمهم وكيفية غيابهم عن مسرح التاريخ، إلا أن القرآن يفك لنا رموز “ثمود” بأدقِّ سِماتهم وخصائصهم المميِّزة والمشخِّصة، ويَعرضُها أمام الأنظار، حيث يقول:
﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/141-145).
إن الدعوة هي هي كما كانت من قبلُ؛ الدعوة إلى الحقّ وإلى الله وإلى الإيمان بـالبعث بعد الموت والحشر والحساب، والإيمان بكتب الله.. ولكن ثمود مثل أسلافهم، لم يقابِلوا كل هذا إلا بالرد والإنكار، ومع ذلك استمر سيدنا صالح ينبّههم وينذرهم دون كلل أو ملل:
﴿أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/146-150).
نعم، كما هو عهدُ القرآن فيما سبق، فهو يأخذ -على لسان نبيٍ صالح- بتلابيب ثمود، ويهزّهم هزًّا ويقول لهم: هل تحسبون أنكم ستُخَلَّدون على هواكم في هذه الدنيا التي تعيشون فيها فرحِين فخورين؟! وهل تظنون أنكم ستخلدون عند العيون الجارية المتدفّقة، وبين بلابل غنّاء تصدح عذب ألحانها المتنوّع في كل حين.
وبما أننا نشرح هذا الموضوع فتعالوا بنا لنرى كيف يتطابق القرآن مع المعلومات التاريخية حول هذه المنطقة؛ فـالمؤرخ “إسماعيل حامي دانِشمند (Danismend)” (ت: 1967م) الذي ألَّف كتابًا حول التسلسل التاريخي للدولة العثمانية، كان ينوي أن يؤلف كتابًا آخر حول التاريخ الإسلامي وفقًا للتسلسل الزمني، ولكنه بعد أن كتب المقدمة لم يواصل الكتابة.. ففي هذه المقدمة، أثناء حديثه عن جزيرة العرب يسهب بالكلام حول صنعاء.. وعلى حسب ما يذكره هذا المؤلف، فقد كان الرجل يسافر من صنعاء إلى الشام في جوٍّ تصل درجة حرارته إلى o60 درجة مئوية، ولكنه كان يستطيع قطع كل هذه المسافات والمراحل من دون أن تصيب الشمس هامته؛ حيث كان يتنقل تحت ظلال الأشجار والحدائق إلى أن يصل إلى الشام.
وإنه لذو مغزى عظيم أن يتحدث هذا المؤرخ عن الحدائق والبساتين في منطقة حوَّلتها ستون درجة من الحرارة إلى صحراء قاحلة، مع أنه ليس من الممكن في أيامنا هذه أن يرى الإنسان في هذه المناطق، إلا فلاة مترامية الأطراف، وعواصفَ صحراوية، وأشلاءَ ميتة عفنة… وهذا يعني أن علم التاريخ وعلم الآثار يسيران جنبًا إلى جنب مع القرآن في الحديث عن الأمور نفسها.
ومن جانب آخر، يَجري الحديث عما بَنَتْهُ ثمود من السدود، وهذا من المواضيع التي تستحق التركيز عليها.. والأخبارُ التي هي من قبيل الإسرائليات تتحدث عن هذا الموضوع؛ فسدُّ “العرم” أو -حسب التعبير القرآني-: “إِرَم” من أهم الأمور التي احتفظَتْ بها ذاكرةُ التاريخ.
نعم، إن السدود التي أنشأها هؤلاء لِريِّ أراضيهم وفق التقنيات الحديثة لأيامنا هذه، لهي من المواضيع التي تستحقّ بحثًا مستقلًّا.
وحينما يتحدّث التاريخ القديم عن هذا السدِّ المشهور، يَنقُل لنا أنه كان له ثلاثة منافذ على مراحل متتالية.. فيبدو أن المياه كانت تأتي من مختلف الأودية والأنهار، فتجتمع في هذه السدود أوَّلًا، ومن بعد ذلك كان المنفذ الأول يُفتح لسقي الأراضي، فيُملأ منه حوض موجود في الأمام، وينقَل منه الماء إلى الأراضي التي يراد سقيها.. فإذا نفِد الماء في الحوض الأمامي فُتح المنفذ الثاني، وهكذا كان الماء يُستعمل من دون هدر ولا إسراف.. ولكننا لا نرى هذه التفاصيل بشكل مباشر، لا في القرآن ولا في السنة، بل هي موجودة في الأخبار والنقول من الإسرائيليات.. فقد تكون هذه التفاصيل صحيحة وقد تكون خاطئة، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو: أننا نشاهد مطابَقَتَها لما يرسمه القرآن من الحياة المدنية والحضارية لتلك الحقبة.
نعم، إن ثمود كانوا يظنون أنهم سيخلدون في جِنان إرم وحدائقها الخضراء، فجاء سيدنا صالح وحاول أن ينبّههم من تلك الغفلة، فقال لهم: هل تظنون أنكم ستعيشون مخلدين في هذا العالم، تحت وارف النخيل، وبين الحدائق والجنان المثمرة، وفي تلك الأراضي التي تسافرون فيها من اليمن إلى الشام دون أن تَضرب الشمسُ هاماتِكم.
أجل، إنه يمكن العثور على هذه التنبيهات في سور مختلفة من القرآن الكريم، ولكن ثمود لم يُعِيروا سمعًا لذلك، ولم يستمعوا لسيدنا صالح على الرغم من أنه قد بيَّن لهم كل ذلك بإخلاص وجدية.
ثم يتحدث القرآن عن جانب آخر من طبائع ثمود الذين كانوا يواصلون حياتهم في الخط الممتد من اليمن إلى الشام، فيؤكِّد أنهم كانوا حريصين على إشباع رغباتهم البدنية ويبحثون عن تلبية رغباتهم.. وبقوله تعالى: ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/149) يَلفت الأنظارَ إلى جانب آخر لهم؛ حيث إنهم، على غرار ما نشاهده في تركيا في منطقة “كورَمه-قبادوقيا” كانوا ينحتون الأحجار بعقلية فنية ماهرة، فيبنون البيوت والقصور والصروح.. فهذا الجانب منهم –سواء قلنا: إنه الطاقة الفنية أو اعتبرناه القوة البدنية- قد طَوَّر فيهم توهُّم الأبدية والخلود إلى حد كبير.. وكان هذا الشعور يمنّيهم بآمال لا تنتهي.. فعمليات الحفر والتنقيب الرسميةُ تدل دلالة واضحة على مشاعرِ هؤلاء وأشواقِهم وطبائعهم، وتُبرز للعيان كيف أنهم نحتوا الصخور ونقشوا عليها بدقّة فائقة بدافع من توقٍ عارم وحرص شديد نحو الأبدية والخلود.
نعم، إن ثمود على غرار الأقوام الآخرين قد أبرزوا طبيعةً خاصةً بهم.. وما كان ابتلاؤهم بناقة خرجت من الصخور التي ينحتونها، ثم عَقرُهم لها، ونزولُ بعض المصائب عليهم، وأخيرًا هلاكُهم ودمارهم إلا مشهدًا صغيرًا من قصة حياتهم.. والقرآن يلخّص هذه الأمور بقوله: ﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (سورة هُودٍ: 11/62).
ونحن حينما نجمع بين هذه الآية والآيات الأخرى التي تتعلّق بالموضوع يمْكننا أن نستخلص منها أنهم قالوا: “يا صالح، إنك كنت قبل هذا عاقلًا، وكانت لنا فيك آمال وكنا ننتظر منك تحقيق بعض الأمور، وكنا نعلم أنك رجل ذو عقل ودراية، لكنك اليوم تريد أن تَحُول بيننا وبين عبادة الأوثان التي كان آباؤنا يعبدونها، فما أنت بالذي كنا نراه لآمالنا”.
فهذا النوع من الجواب منهم كان ينمُّ عن نوع آخر مما هم فيه من الخواء والفراغ؛ حيث إن هذا يعني أن عبادة الأوثان قد رسخت فيهم وضَربت بجذورها في أعماقهم، وأصبحت دينهم الذي لا يبدلونه،وهذه الأجوبةُ سبق وأن قوبل بها أيضًا رسولنا .
ويُمْكِن أن نستفيد من كل ما سبق أن الكفر في عهد سيدنا صالح قد أصبح ذا قواعد ومعادلات، ووُضعت له قوانين، وصار نظامًا لا يمكن التخلي عنه ولا يجوز تخطّي حدوده؛ بمعنى أن الكفر بكل أنواعه قد أصبح مسيطرًا على الساحة وتحوَّل إلى قيم اجتماعية تحت مسميات وعناوين مختلفة.
وتمام القصة مشهور ومعلوم؛ فهناك معارضة القوم للمعجزة، وعقْرُهم للناقة التي كان قد أُخِذَ عليهم العهدُ على أن لا يمسوها بسوء، ونزولُ الغضب الإلهي عليهم، وكان عاقبة أمرهم زوالهم من الوجود.. فحينما نطالع كل هذه الأمور في القرآن نكون كأننا نشاهد قوم صالح وهم يمرون مِن أَمامِ أنظارنا بجميع رموزهم في مشهد رسمي يعكس سجاياهم.
د. تصوير طبائع الشخصيات في القرآن
1- سيدنا إبراهيم وطبيعته
في الفصل السابق ركَّزنا على تحليلات القرآن العمومية للطبائع، وألقينا نظرة عامة على طبائع بعض الشخصيات أو الأقوام أو الملل.. وكما حاولنا أن نَعرِض فيما سبق: أن القرآن حينما يقدم لنا قصةَ حياةِ بعض الشخصيات أو الأقوام يشير أيضًا من بين ثنايا السطور إلى بعض الأمور التي تنم عن طبائعهم وتفصح عن سجاياهم.. فنحن بدورنا سنركز في هذا الفصل والذي يليه على بعض الشخصيات التي يرسمها القرآن الكريم، من دون أن نخل بوحدة الموضوع.
والآن تعالوا بنا لنَرى كيف يتناول القرآن تلك الطبيعة الخاصة لسيدنا إبراهيم الذي عبر عنه بقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ (سورة هُودٍ: 11/75).
إن القرآن قد أطنب في الحديث عن سيدنا إبراهيم، لأنه من جانبٍ “أبو الأنبياء”؛ إذ يُعتبَر أبًا لسيدنا إسحاق وسائر أنبياء بني إسرائيل، ومن جانب آخر يُعتبر أبًا لمفخرة الإنسانية، وفخرِ الكائنات سيدنا محمد ، عن طريق إسماعيل .
وقد قضى صباه في الكهوف للاحتماء بها عن شرور النماردة والمتغطرسين المتكبرين.. وهذا الأمر نفسه ينطبق على جميع الأنبياء أيضًا بشكل عام.. بمعنى أن سيدنا هودًا أيضًا لم يكن في مأمن، وكذلك سيدنا صالح وسيدنا لوط عليهم السلام.
وكما أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون ولادة سيدنا موسى سرًّا، فكذلك شاءت إرادة الله أن ينشأ سيدنا إبراهيم أيضًا في كهف.. فهذه التربية التي تلقّاها في الكهف وسار بذكرها الركبان جعلته مضرب الأمثال في الحلم والصبر والتأني، وأسوة حسنة لمن أتوا مِن بعده؛ ففي حين أن السماوات كانت فتنة بالنسبة لغيره إلا أن الجانب الروحاني الذي يهيمن على الحياة في الكهف قد سمَا به نحو السير في آفاق ملكوتية، ووجَّهه إلى أن يَقرأ صفحات السماوات قراءة صحيحة من منطلق “الفطنة النبوية؛ فنراه ينظر إلى الكواكب والقمر والشمس، فيحاول إرشاد مَن حوله انطلاقًا من فكرةِ أنه لا بد أن يكون هناك صانع للكون.
فتسقط عيناه -أوَّلًا- على نجوم وكواكب السماء، ولكنه عندما رأى أنها تأفل:
﴿قَالَ لَا أُحِبُّ الآفِلِينَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/76)، بمعنى أنني لا أتعلق بمثل هذا تعلُّقًا قلبيًّا؛ فالأشياء التي تأفل وتغيب مثلي لن تكون دواء لأدوائي وأمراضي.. فلي هموم أبدية، ولي أشواق ورغبات لا نهائية؛ ولذلك أحتاج إلى قوة تفوق قوتي، قوةٍ لا تغيب ولا تذبل، بل تلبّي كل حاجاتي هذه، وتَروي عطشي نحو الأبدية.. فلذلك لن تكون الكواكب ربي.
فسيدنا إبراهيم كان يتحدث بهذا الأسلوب ليهدمَ كفرًا كان مسيطرًا على الأفكار العمومية في ذلك العصر.
ثم يتوجه إلى القمر، فلما رآه يأفل هو الآخر قال: ﴿لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/77).
ثم يرى الشمس التي تطلُع كل يوم بسِحرٍ جديد، فيتحدث عنها بما تستحقه، وأخيرًا يعلن أفولَ أصنامِ عبدةِ النجوم، وبالتالي عدم صلاحيتها لأن تكون إلهًا بقوله: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/79).
نعم، إنه أخذ يوجه الأنظار والأفكار إلى المولى المتعالي الذي فطر السماوات والأرض، ووضَعَ الشمسَ ضمن نظام معين، وسيَّر النجوم في انتظام واطّراد.. وبهذا يكون إبراهيم قد هدم ما ينبغي أن يُهْدَم، وقَطَعَ أصواتَ عبدةِ النجوم وأسكتهم.. وحينما ننظر إلى الآيات الأخرى التي تتناول الأحداث التي جرت بين سيدنا إبرهيم وقومه، نراه بطبيعته التي تثور على الأصنام والوثنية والكفر والطاغوت.. ومن ذلك نستنتج أنه بموقفه ومَقولاته تجاه الكواكب والقمر والشمس، يريد أن يلقن درسًا لقومه الوثنيين الذين يعبدون الأجرام السماوية والأصنام.
وفي يوم من الأيام دعاه قومه إلى الريف (للنزهة) ولكنه تَعلَّل بالمرض ولم يذهب معهم، كما في قوله تعالي: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (سورة الصَّافَّاتِ: 37/89). وتُبيِّنُ الآياتُ التي تليها (90-93) أنه لما تخلّف عن قومه الذين ذهبوا إلى الريف، حطم الأصنام إلا الكبير منها، وبعد ذلك تنحَّى جانبًا، وانتظر رجوع قومه ليلقنهم درسًا آخر، فلما رجع القوم اندهشوا أمام ما رأوه مما فُعل بأصنامهم.. فقالوا فيما بينهم في غضب عارمٍ وحنقٍ شديد: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/59)..
فبينما هم يتبادلون هذا القول فيما بينهم اتهم البعضُ منهم سيدَنا إبراهيم بهذه الجريمة! فذهبوا به إلى الساحة التي اجتمع بها الناس، فسألوه قائلين: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/62). لكنه ما لبث أن أجابهم بوقارٍ وجدّية تليقان بنبي من أنبياء الله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/63).
فهذه الجملة الوجيزة منه تحمل في طيّاتها من الحِكم العديدة والحُجج العتيدة ما يجعلها من قبيل: “السهل الممتنع”؛ فمهما استَخدم العقلُ البشريُّ الأساليب المنطقيةَ لإثباتِ أنَّ الأصنام لا تَصلح لأن تكون معبوداتٍ، فلن تَرْقَى في الإيجاز إلى مستوى
ما في هاتين الجملتين القصيرتين من البيان.
نعم، إنه قال: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، وهذا القول يحتمل الكذب أيضًا، ولكن من المحال أن يَصْدُر الكذبُ على لسان نبي، وإسناد الكذب إلى نبي من الأنبياء له وِزرٌ ثقيل.. فلذلك من الأنسبِ أن يؤخذ هذا الكلام على مَحمَل التعريض في القول.
ومن المعلوم أن سيدنا إبراهيم صدرت عنه ثلاث تعريضات؛ فنرى أن بعضًا من ذوي المنطق الاستشراقي لا يأخذون عصمة الأنبياء بنظر الاعتبار، فيجازفون بالقول في أمثال هذه التوريات.. ولكن هناك بالمقابل من نحَى مَنحى المحققين من العلماء فأتوا في هذا المجال بتفسيرات وتأويلات أخرى سنَعرِضها فيما يلي.
من المناسب ونحن نتحدث عن طبيعة سيدنا إبراهيم وعصمته، أن نتعرض لما نُسب إليه من هذه “الكذبات” -وبالأحرى “المعاريض”- الثلاثة.
إن صدور الكذب عن نبي من الأنبياء من الأمور المناقضة للعصمة، فإن الكذب من شيم الكفار، ولن يجدَ له مأوى في القلوب المشبعة بالإيمان، صحيحٌ أنه قد روي
عن النبي أنه قال: “لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ” .
ولكن كما يكون الكذب “ضد الصدق”، فكذلك يجوز أن يحمل على معنى “التورية”.. صحيح أن حمله على هذا المعنى سيكون فيه شيء من التكلف من الناحية اللغوية، ولكنه مناسب للمعنى المراد بيانُه.. وسينجلي ذلك بعد بيانه.
فلا بد هنا من التنبّه إلى التعابير. أجل، كما أنه لا يجوز أن يُقال: إن سيدنا إبراهيم قد “كذب”، فكذلك لا يستعمل الكذب هنا بالمعنى اللغوي المتعارف عليه؛ فإن هذه الأمور وإن بدت في ظاهرها كأنها على خلاف الواقع، لكن إذا تنبّه الإنسان إليها ولو قليلًا فإنه سيلاحظ أنها مطابِقة للواقع.. ومثل هذه التعبيرات تُسمّى “تعريضًا”، وكما يقال: “إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب”، ولنشرح هذا بشيء من التفصيل:
إن من بين المجالات التي يتحقّق فيها الكذبُ مجالَ المزاح، وقد مزح الرسول أيضًا، إلا أن المادة التي استخدمها كانت من نوع البيان الصادق؛ فمثلًا: قال لأنس : “يَا ذَا الْأُذُنَيْن” ، وقد كان أنس -في الواقع- ذا أذنين.
وفي موقف آخر رُوِيَ أنَّ امرأة تُدْعى أم أيمن، جاءته فقالت: إن زوجي يدعوك، فقال لها: “مَنْ هُوَ؟ أَهُوَ الَّذِي فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ؟” قالت: والله ما بعينه بياض، فقال: “بَلَى إِنَّ بِعَيْنِهِ بَيَاضًا”، قالت: لا والله، فقال: “مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَبِعَيْنِهِ بَيَاضٌ” .
وكذلك رُوي عن الحسن البصري قال: أتت عجوزٌ إلى النبي فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يُدخِلني الجنة، فقال: “يَا أُمَّ فُلَانٍ! إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ”، قال: فولَّت تبكي، فقال: “أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾ (سورة الوَاقِعَةِ: 56/35-37)” .
أجل، إن الأنبياء قد احتاطوا في تعبيراتهم التي استعملوها حتى في مزاحهم، لأنهم واعون بأن مقامهم وموقعهم لا يتحمّل الكذب حتى في حال المزاح.. نعم، إنهم في موقع الأسوة للناس بكل حركاتهم وتصرفاتهم، فإذا اشتمل كلامهم على “ما يخالف الواقع”، حتى ولو مزاحًا، فإن ذلك سيشجع الآخرين على الكذب في جدهم، والنبي
لا يكون قدوة سيئة للآخرين.
إن سيدنا إبراهيم كان مفطورًا على الحنيفية وعداوةِ الأوثان؛ فهو قبل أن يُبعث نبيًّا كان يُكافح الأوثان والوثنية، وهذه المشاعرُ والأفكار هي التي أدت به إلى أن يصمم فيما بينه وبين نفسه أن يحطم الأصنام، وفي نهاية المطاف حقق ما كان يفكر به.
وكان من عقائد تلك الفترة الزمنية أن ينظر الناس إلى النجوم فيستخرجوا من أوضاعها المختلفة أحكامًا يقوِّمون بها الأحداث ويؤوّلونها؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة هي في السماء بين النجوم، وأن النجوم هي القوى التي تَحكم الكونَ.
فسيدنا إبراهيم نظر نظرةً في النجوم على حسب معتقدات تلك الأيام.. وهذه النظرة كانت بغرض إقناع المخاطبين هناك بما سيُلقى عليهم، وكان هدفه منها إقرار فكره لهم.. وإلا فإن إبراهيم لم يكن يؤمن بما يعتقد به قومه بتاتًا.. وبعدما نَظر إلى النجوم قال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (سورة الصَّافَّاتِ: 37/89)، فهذا هو التعريض الذي صدر منه على سبيل التورية.. وسنوضح لاحقًا ما وراء ذلك من الأسباب والخلفيات التي أدت إليه، وكيفيةَ وقوع ذلك.
وأما التعريض الثاني الذي صدر منه، فهو الذي يتعلق بحادثة تحطيمه للأصنام؛ حيث إنه أخذ بيده فأسًا فحطّمها، ثم علّقه في عنق كبيرهم.. فلما سألوه قائلين: ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/62)؛ أشار إلى الصنم الأكبر: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ… كَبِيرُهُمْ هَذَا… فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/63)، أي إن الفاعل هو ذاك… وهذا كبيرهم.. فاسألوهم… إلخ.
وأما التعريض الثالث: فلم يَرد ذكره في القرآن، وهو أنه قال لامرأته: “إن هذا الجبار، إنْ يَعلمْ أنكِ امرأتي، يغلبْني عليك، فإن سألكِ فأخبريه أنكِ أختي، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ” .
فهذه هي المعاريض التي صدرت عن سيدنا إبراهيم.
فالآن تعالوا بنا نَذكرْ هذه الأحداث بشيء من التفصيل حتى تتجلى لنا في وجه هذه الأحداث بالذات عصمةُ هذا الرجل العظيم:
الحدث الأول: “إِنِّي سَقِيمٌ”
يقول الله في القرآن الكريم:
﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ (سورة الصَّافَّاتِ: 37/83-90).
فسيدنا إبراهم في قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ يتحدّث عن الشيء الذي يؤلمه في حقيقة الأمر، وهو أنه لم يزل متألّمًا من الأصنام منذ صباه ولم يكن من المتوقَّع أن يزول منه هذا الألم ما لم يَقضِ على هذه التماثيل والأصنام، ولكن الذين سمعوا منه هذه الجملة تَبادر إلى أذهانهم أنه يَعني بذلك السقمَ البدني، فتخلَّوا عنه مدبرين، وإلا فإنهم كانوا يريدون ويصرُّون أن يصطحبوه معهم في طقوسهم الدينية.. وبالفعل ما إن ذهبوا عنه حتى فَعل ما فعل بالأصنام، فأبرَزَ السببَ الحقيقي الذي يكمُن وراء أوجاعه وآلامه.
أجل، إن سيدنا إبراهيم بتحطيمه الأصنام يكون قد عبَّر عما يُكِنُّه تجاهها من الكراهية، ولكنه باستخدامه عبارة فيها توريةٌ أَوْهَمَهم معنًى آخر، وبذلك استطاع أن يتخلص منهم.. بيدَ أنه لم تكن في هذه العبارات التي استَخدمها كذبٌ قط.. غايةُ ما في الأمر أنه لم يكن لدى المخاطَبين علمٌ مسبق بما يقصده إبراهيم، فذهب ظنهم إلى مذهب آخر.. وليس هذا منهم بمستغرب؛ لأنهم لو لم يكونوا على حمق كبير، لاستمعوا إلى الحق وفهموه، ولكنهم عانَدوا وكابروا طوال حياتهم، ولم يُحاولوا استماعَ الحقّ والحقيقةِ ولو لمرة واحدة.. وأنى لهم أن يفهموه وهم بهذه العقلية.
فكلام سيدنا إبراهيم كان تعريضًا، ولم يكن كذبًا بتاتًا.. ولكن هذا التعريض سيحزُّ في وجدانه حتى يوم الحشر، ولذلك فإنه حينما يأتي إليه الناس مستشفعين به يوم القيامة سيعتذر عن ذلك، ويقول لهم بأنه ليس أهلًا للشفاعة، لأنه يَعتبِر هذا التعريض “كذبًا” من حيث مقامه السامي .
وحين نرى البعض يحسون كل يوم مراتٍ عديدةً بالحاجة إلى اللجوء إلى المعاريض على غرارِ ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، فيقولونها من حيث يشعرون أو لا يشعرون.. حينما نأخذ هذا الوضع بعين الاعتبار؛ نُدرك مدى البراءة والبساطة في تعريض سيدنا إبراهيم في عمره مرةً واحدة بقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وكم يكون هينًا في مقارنته بذلك.
ولكننا مع ذلك إذا أخذنا بالاعتبار ما في عصرنا من التداخل بين الصدق والكذب، فإنه يجب التريُّث بجدية تجاه تجويز اللجوء حتى إلى المعاريض ناهيك عن الكذب؛ فإنه في هذا الزمان أصبح الصدقُ والكذب يُسَوَّقان في سوق واحد، وصارا كأنهما متداخلان.
ولذلك أستطردُ فأقول: إذا كان ذلك كذلك، فإنه ينبغي لنا أن نكون متنبهين حذرين حيال الكذب حتى في المواضع الثلاثة التي رخّص فيها الرسولُ للكذب ، فإنه كان في عصر السعادة النبوية هوةٌ سحيقة بين الصدق والكذب؛ حيث كان الرسول وصحابته يمثِّلون الصدقَ، وكان مسيلمة ورجاله يمثلون الكذب.. أجل، كانت المسافة بين الصدق والكذب شاسعة إلى هذا الحد، وأما في عصرنا فالوضع مختلفٌ تمامًا.
ولذلك نقول: ينبغي للذين يمثِّلون الحق أن لا يفسحوا المجال للكذب البتة، سواء في حياتهم الاجتماعية أو الفردية، فهذا التصرف -قبل كل شيء- شرط أوَّليٌ لمن يمثِّل الأمن والسلام. نعم، لا بد أن يكون الكذب بعيدًا عنا ونكونَ بعيدِين عنه.. فإذا كان موقعُنا هذا يَفرض علينا أن نكون حساسين تجاه الكذب إلى هذا الحد، فما بالك بالأنبياء الذين منهم تعلمنا الصدق؛ وبالأخص إذا كان ذلك النبي هو سيدنا إبرهيم، جد النبي الذي هو أصدق الصادقين.
الحدث الثاني: “بَلْ فَعَلَهُ”
يتناول القرآن الكريم هذه القصة كالآتي:
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَذَا، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/51-63).
فهو بعد أنْ حطَّم الأصنامَ واحدًا تلو الآخر، علَّق الفأس في عنق الصنم الأكبر، ولفَت أنظارَهم إليه.. ولا شك أنه بصنيعه هذا أظهرَ نموذجًا رائعًا للفطِن النبيه، وخاصة فيما سيقوله أثناء مجادلته لهم في قابل الأيام.
فلما رجع المشركون ورأوا ما وقع للأصنام قالوا مستفسِرين يملؤهم الغضب:
﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ فأجابهم إبراهيم بقوله: “بَلْ فَعَلَهُ” وتوقفَ -على قراءة البعض- عند هذه الكلمة.
والحقيقة أن سيدنا إبراهيم إنما قَصَدَ بالضمير المستتر في قوله: “فَعَلَهُ” نفسَه، ثم وجَّهَ أنظارَهم إلى الصنم الأكبر ليسألوه عمن فعل ذلك ليسفه عقولهم بعبادة من لا يدافع عنه نفسه ولا يرد جواب سائله وهكذا أصبح المشركون غيرَ مدركين لما ينطوي عليه كلامه من تلك النكتة الدقيقة الخفية.
نعم، إن قوله: “بَلْ فَعَلَهُ” يحتمل معنيين. فالمشركون رأوا الفأس معلَّقًا في عنق الصنم الأكبر، وسألوا إبراهيم عن الفاعل.. فلما أجابهم بقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كبيرهم هذا﴾ [على اعتبار أن قوله: “كبيرهم” ليس فاعلًا لقوله “فَعَلَهُ” بل هو مبتدأٌ وخبره الجملة الفعلية بعده، والجملة مستأنفة]؛ كان مجيبًا لهم على سبيل التعريض الذي هو من أساليب الكلام البليغ.. فقصدُه بقوله: “بَلْ فَعَلَهُ” هو شخصُه هو، وقوله: “كَبِيرُهُمْ هَذَا” معناه أن هذا الصنم هو كبيرهم.
وأيضًا في هذا الكلام نوع استهزاء بالكفر والوثنية؛ فسيدنا إبراهيم بقوله: “كَبِيرُهُمْ هَذَا” كان يستهزئ بعقليتهم البسيطة هذه، ولكنهم من كثرة تعلقهم بالوثنية، لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالتفطن لذلك؛ فإذا كان إبراهيم قد اعتَبر صنمَهم كبيرًا فلا يهمّهم ماذا كان يعني بذلك.. بل إنهم حتى لو فهموا ذلك، فإنه لم يبق لديهم ما يُدْلون به من الكلام أو يدافعون عنه أمام هذا النوع من الكلام المُوَرَّى به، جراء ما ذاقوه من تسفيه عقولهم وغلبتهم في الخصام.
ولما فشلوا في الدفاع عن دعواهم بالكلام وبسبب هذا الموقف المُخجِل شعروا بضرورة تحويل مسار الصراع مع سيدنا إبراهيم إلى مجال آخر، فقرروا تصفيته جسديًّا.
فكِفاحُ جميع الأنبياء تقريبًا مرَّ بمثل هذه المراحل.. فالمشركون دائمًا حين يعجزون في الحوار مع ظنّهم إجادته يستخدمون الأساليب نفسها تجاه مبلّغي وممثلي الحق والحقيقة.. فهاهم المشركون في الماضي، وهاهم مشركو هذا العصر.. ما أشبه الليلة بالبارحة.
ومجمل القول هو أنه رغم مرور كل هذه المدة المديدة لم يحصل هناك أيُّ تغيُّر في العقلية؛ حيث إن الوثنية تَناقَلها أصحابُ الأدمغة المشحونة بالتعصب إلى يومنا هذا بفوارق طفيفة.. فتبًّا للوثنية! وويلٌ للعقول التي تفسخت وفسدت بوبائها، وويلٌ للصدور المنغلقة تجاه الإيمان والمحبة!
الحدث الثالث: “هَذِهِ أُخْتِي”
وهو أن سيدنا إبراهيم تحدَّث عن زوجته بتعبير: “أختي”..
فهذا التعبير قد أدى ببعض السفَلَة إلى أن يفسروه بتفسيرات خاطئة. أجل، إن هؤلاء بلغوا من الدناءة إلى دركة أنهم لم يتورعوا عن إسناد “الكذب” إلى نبي من أنبياء الله حتى وإن كان في ذلك خطر الوقوع في الكفر.. صحيح أن بعض الملحدين على مرِّ التاريخ قد تحاملوا على مثل هذه التعبيرات الواردة في القرآن، لأنهم عجزوا عن إدراك دقائقها، فصدور مثل هذه الدناءات من الملحدين أمرٌ متوقَّع، لكن الذي يصعب علينا فهمه ويحزّ في نفوسنا هو محاولة بعض أبناء جلدتنا إسنادَ الكذب إلى الأنبياء رغم ادعائهم أنهم مؤمنون؛ اعتمادًا منهم على مثل هذه التعبيرات.
وفي الحقيقة أنه ليس هناك مثقال ذرّة من الكذب -حاشاه- في هذه القولة الصادرة من سيدنا إبراهيم. بل ولا يسمى تعريضًا أيضًا.. بل هو صادق من كل النواحي، وصدقُه واضحٌ عيانًا بيانًا؛ فقد اتفق سيدنا إبراهيم مع سيدتنا سارة على أنه إذا سألها المَلِك أو رجاله عن طبيعة العلاقة بينها وبينه فلتقل إنها أخته، وإذا سألوا سيدنا إبراهيم فإنه سيجيبهم بأنها أخته؛ لأنه كان من المحتمل أن يمسوها بسوء إذا علموا بأنها زوجة إبراهيم ، وهذا كان سيُحرِجهما معًا، بل كان سيضطرُّ سيدَنا إبراهيم إلى أن يتركها.. لكن هذا التعبير (الأخت) كان منقذًا لهما من شرِّ هذا الموقف، ومطابقًا للواقع، لأن الله تعالى قد اعتبر جميع المؤمنين إخوةً عندما قال : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (سورة الْحُجُرَاتِ: 49/10).
إن رابطة الإيمان هي أول نقطة للالتقاء بين المؤمنين، فالذين لا يترابطون فيما بينهم بهذه الرابطة لا يُعتَبَرون “إخوة” ولو كانوا من نفس الآباء والأمهات، والتفاوت في الزمان والمكان لن يكون حائلًا أمام الأخوَّة الإيمانية.. فالمؤمنون جميعًا بعضهم إخوة لبعض، وليس في هذا الباب فرق بين الذكر والأنثى، وأما سائر الأواصر فإنها تأتي في الترتيب بعد هذه القرابة.. فمثلًا لو طلَّقَ الرجلُ زوجتَه فإن ما يربطهما من علاقة الزوجية يعتبر لاغيًا، ولكن أخوَّة الإيمان ستظلّ باقية.
فسيدنا إبراهيم لفَتَ الأنظارَ إلى هذه القرابة التي هي الأساس، فعبَّرَ عن أمّنا سارة بـ”الأخت”.. وهذا القول هو عين الصدق، بل إنه ليس من التورية في شيء، إلا أن من عمِيت بصيرتُه وصُمّت أذناه لن يُدرِك هذه الدقائق اللطيفة في وقتٍ من الأوقات.
وخلاصة الموضوع:
1- إن إبراهيم لم يَكْذِبْ قط.
2- إن على سالكي سبيل الحق أن يتجنبوا الكذب، فالمؤمن الحقيقي يتألم أشد الألم ويسكب الدموع طول عمره إذا ما وقعت عينه على حرام، أو زلّ لسانه بكذبة، فالذي ينبغي على المرشدين إلى طريق الإيمان -مهما كان مستواهم- أن يواصلوا حياتهم كلها مثل الروحانيين.
2- سيدنا إبراهيم وتكاملُ التعبير القرآني
لعلنا نتساءل: ما مدى توكل إبراهيم حينما أتى بولده إلى المكان الذي نسميه اليوم: “الحرم الشريف”، ليذبحه؟! نعم، إن رجل الصبر والابتلاء هذا، كان مُجدًّا ومصمّمًا على تنفيذ ما أمره به ربه حينما أَضْجَعَ ابنَه في منطقة “العقبة” القريبةِ جدًّا من مكة -والتي صافح فيها سيدُ الأنبياء الأنصارَ بعد قرون، وأَخَذ منهم البيعة لأول مرة- وبطبيعة الحال كان ابنه يقول له في تسليم مطلق لا تردد فيه يليق بابن نبي: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ (سورة الصَّافَّاتِ: 37/102).. والواقع هو أننا إذا تابعنا في القرآن المواضعَ التي يَرِدُ فيها الحديثُ عن طبيعة سيدنا إبراهيم، فإننا نكاد نرى في جميعها هذا التوكّل والتسليم العميق.. بحيث إننا لن نعثر فيه على جَزَع ولا تصرفٍ يُخلّ بمقام نبوته.
إن هذا الإنسان القدوة وهذا النبي العظيم الذي يمتلئ قلبه بالإيمان والتسليم، نراه يَظهر أمامنا بشخصيته هذه أيضًا لكن في مشهد آخر في القرآن الكريم؛ حيث يأمره الله بأن يُسْكِنَ زوجته التي وَلدت للتوّ بوادٍ في صحراء خاوية.
ورغم هذا التكليف الذي يَصعب على النفس البشرية تحمُّلُه نراه يقول في توكُّل تام وتسليم مطلق واطمئان ثابت: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (سورة إِبْرَاهِيمَ: 14/37)، فيطلب من الله تعالى أن تقيم ذريتُه الصلاة، وأن يَسيروا على طريقه ، وأن يتوجهوا بقلوبهم نحو الكعبة، وأن يَسكُنَ الناسُ ذلك الوادي الأجرد، ثم يمضي في طريقه من دون أن يلتفت إلى الوراء.. فنادته زوجته من ورائه وهي تقول: يا إبراهيم!
ولكن إبراهيم لم يلتفت إلى هذا النداء الذي يرتجف منه الفؤاد.. فأعادت النداء، ولكنه لم يلتفت أيضًا؛ لأنه كان يخشى أن يُخِلَّ ذلك بما يُكِنُّه في نفسه من التسليم والتوكل تجاه مولاه .
فكما يُلاحَظ، فإننا يُمْكن لنا أن نشاهد سيدنا إبراهيم في هذا المشهد أيضًا بنفس تلك الحالة التي شاهدناه وقد تلَّ ابنَه للجبين ليضحِّيَ به.. نعم، تناديه زوجه مرة ثالثة قائلة له: “آللهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِذًا لَا يُضَيِّعُنَا” .
أجل، يُمْكننا أن نشاهدَ في هذا المشهد أيضًا ذلك التسليم والتوكل عينه.
وفي آية أخرى نشاهد بطلَ الصبر والحلم هذا، وهو ينصح أباه، وهذا مهمٌّ للغاية:
﴿إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/42).
فقد كان يئنّ باعتباره ابنًا يحترق فؤاده وهو يتمنى هداية أبيه بأسلوب يغلب عليه طابَعُ الشفقة على أمل أن يُرزَق الهدايةَ، فالإنسان إذا حاول تصور هذا المشهد ولو قليلًا فإنه سيجدُ أمامه رجلًا تنعكسُ على وجهه مظاهر الألم، وسيجده ذا شفةٍ ملتويةٍ، وطلعةٍ متقلّصة، وسِيما متجعدة، ولكنه في الوقت نفسه سيرى وجهًا يتلألأ بالرضا بما قدَّر الله.
نعم، إن الإنسان إذا لاحظ فإنه سيَمثُل أمام ناظرَيه إنسان من أبطال التوكل والتسليم، يظهر على محياه وقار وجدية الإيمانِ بالله.
فهذا الدعاء الخالص من سيدنا إبراهيم لأبيه أدى ببعض السفلة إلى الطعن فيه ، فعَدُّوا ذلك زَلَّة منه.. لذلك نرى من المفيد التركيز على هذا الموضوع إضافة لما سبق.
فنتساءل: تُرَى لماذا استغفر إبراهيم لأبيه الضالِّ؟! أمَا كان يليق بنبي مثلِه أن يكتفي بالذين استجابوا لرسالته التي أتى بها؟! ولماذا اهتمّ إلى هذا الحد بأب غير مؤمن، حتى إنه بعد ذلك تضرَّع إلى الله ليغفر له؟ هل كان هذا -حاشاه- زلةً منه ؟ فإذا كان هذا خطأً منه -حاشاه- فكيف يليق ذلك بالمقام السامي لهذا النبي؟! فإذا سلَّمنا ذلك وقبِلناه جدلًا أفلا يؤدي ذلك إلى أن يقول بعض الناس باحتمال وقوع الأنبياءِ في الخطإ في أمور أخرى أيضًا؟ فإذا كان الأمر كذلك فكيف نتَّبعهم باطمئنان وراحةِ بال؟ فهذا هو أساس تلك الاستفهامات التي كان يثيرها الملحدون في الماضي والمنكرون المشكِّكون في الوقت الحاضر.
وقد دعا إبراهيم لأبيه بقوله: ﴿وَاغْفِرْ لأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/86)، فذَكر لنا القرآنُ الكريم السببَ الذي دفع بسيدنا إبراهيم إلى هذا الدعاء حيث قال:
﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ ِلأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/114).
وقد ذكر القرآن هذه الموعدة أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (سورة الْمُمْتَحَنَةِ: 60/4).
ففي هذه الآية الكريمة يشار إلى أن العداوة بين الإيمان والكفر أبدية، وأن الكفر بروحه منطوٍ على الكراهية تجاه الإيمان، وأن هذه هي طبيعة الكفر، وبالتالي فلن يحبَّ الكافرُ المؤمنَ بشكل من الأشكال.
فالقرآن يدلُّ على أن أبا إبراهيم كان في الضلالة، وهذا يتطلّب منا الوقوف على أربع نقاط على النحو التالي:
النقطة الأولى: إن كونه في الضلالة لا يقدح في إبراهيم ولا يقلل من شأنه؛ إذ يمكن القولُ بأنه كان في أجداد سيدنا محمد من لم يَصِلوا إلى مستوى التوحيد الخالص، ولستُ أدري كيف كانت فكرة التوحيد لدى عبد المطلب وهاشم وغيرهم.. ولكنني أستطيع القول بكل راحة بال: إنهم سيعامَلون معاملة أهل الفترة، ولكنْ مع ذلك نقول: إن ما قد يكون فيهم من النواقص والأخطاء لن يكون منافيًا بتاتًا لأن يبعث الله من نسلهم سيدنا محمدًا بمهمّة الرسالة.
وعلى تقدير أن “آزر” كان أبًا لسيدنا إبراهيم، فقول سيدنا إبراهيم: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ لن يضر بنبوته؛ فقد يخلق الله من أشخاص مثلِ آزر أنبياءَ من أمثال سيدنا إبراهيم، وقد يَخلق من أمثال سيدنا نوح أولادًا على غرار كنعان. نعم، قد يحتضن أناسٌ كالشياطين أفراخًا كالملائكة، وقد يحتضن الملائكيون شياطينَ، فالله يُخرج الحيَّ من الميت ويخرج الميت من الحي، وَسِعت قدرتُه كلَّ شيء، ولا يُسأل عما يفعل. نعم، إنه قادر على أن يُخرج من ميتٍ مثلِ آزر حيًّا يَنفخ الحياةَ في الناس مثلَ سيدنا إبراهيم، وأن يجعله مَبدأً لسلسلتين ذهبيتين؛ حيث إن كِلَا ابنيه من الأنبياء.
النقطة الثانية: أن دعاءَ سيدنا إبراهيم أمرٌ فطريٌ وإنسانيٌّ بكل معنى الكلمة؛ حيث إن سيدنا محمدًا أيضًا دعا عمّه أبا طالب إلى التوحيد، ومِن بعد ذلك قال: “أما والله لأستغفرنَّ لك ما لم أُنْهَ عنك” ، فإن أبا طالب احتضن الرسول أربعين عامًا، وكان مناصرًا له على الدوام، وقاسَمَه كل همومه، بل إنه لم يتخلَّ عنه حتى حين أعلنت قريش مقاطعتَه.
فكما أن إصرار الرسول على دعوة عمه الذي خدمه طوال حياته وحاول حمايته، وحرصَه على دخوله الإسلام أمرٌ معقول وفطري بكل ما في الكلمة من معنى، فكذلك دعاء سيدنا إبراهيم طبيعي بتلك الدرجة؛ لأن أباه هو السبب المادي لوجوده، وقد رعاه ورباه في فترة معينة.. وأيضًا فالإسلام حرص على احترام الوالدين وحرَّم على الإنسان أن يقول لوالديه: “أفّ” مهما حصل، ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/23).
النقطة الثالثة: أن سبب وجود الأنبياء هو التبليغ، وأما الهداية فليست بأيديهم، ومهمّتهم هي المواظبة على بيان الحقّ والحقيقة، واستخدام كل الوسائل المشروعة في سبيل ذلك.. فسيدنا إبراهيم قد حاول استعطاف أبيه لهذا الغرض، واستهدف تهيئةَ قلبه للهداية إلى الحق.. ولعل ذلك الاستغفار الذي وعد به أباه من هذا القبيل.
النقطة الرابعة: أن سيدنا إبراهيم بصفته نبيًّا ينبغي عليه أن يكون على مسافة متساوية في علاقته بكل الناس؛ بمعنى أن موقعه ومهمّته التبليغية توجب عليه أن يُبين دعواه في صدق وإخلاص لكل الناس قريبين كانوا أم بعيدين.. إضافة إلى أن الدعاء من وسائل الهداية، وعلى الإنسان ألا ييأس في هذا الأمر.. صحيح أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/6) صريحٌ في أن بعض الكفار لن يحظوا بالهداية، ولكن الرسول رغم ذلك ذهب مرّات ومرات إلى أبي جهل وأبي لهب وابن أبي معيط ومن على شاكلتهم من الكفار، وواصل دعوتهم إلى سبيل الحق.. فالهداية بيد الله، وقلوب الناس بيده أيضًا، فـ”السواء” في الإنذار وعدمه إنما هو بالنسبة لأولئك الذين انغلقت قلوبهم تجاه الهداية، وإلا فليس الأمر “سواء” بالنسبة للدعاة؛ فهم مأمورون بالتبليغ ولا علاقة لهم بالاستجابة.
فسيدنا إبراهيم من حيث إنه كان يدرك هذا ويؤمن به جرَّب كلَّ الوسائل المشروعة بما فيها الدعاء.. وهذا أيضًا مَظهرٌ من مظاهر إيمانه واطمئنانه.. ولكنه لما أدرك أن المشيئة الإلهية ليست في تلك الجهة، فإنه سرعان ما تخلَّى عن أدعيته تلك، وتبرَّأ من أبيه ومِن كل من كان على خطى أبيه وما يعبدون من دون الله من الأوثان.
أجل، إنه ما كان له أن يستثني أباه من تلك الدعوة التي كلفه الله بتبليغها، لا سيّما إذا أُضيفت القرابةُ الفطرية إلى ذلك.. فلننظر إلى هذه الآيات الكريمة في تناوُلها الرائع لحالة سيدنا إبرهيم باعتباره ابنًا ونبيًّا، وكيف أنه يناشد والده ويتلهف ويتحرق أمامه مُرَدِّدًا: “يا أبت.. يا أبت”.. ويدعوه إلى الحق، من دون مبالاة لما يلقاه من الفظاظة:
﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/41-45).
أجل، إن إبراهيم كان يقدِّم لوالده أيضًا تلك الرسالة النورانية التي يقدمها للآخرين، وكان يقاسي في سبيل ذلك كل المحن وكأنه يتجرّع كؤوس الموت.. وهل هناك ولد لا يبذل جهودًا خالصة في أسمَى درجات الجدية والاحترام من أجل هداية والده، وبالأخصّ إذا كان هذا الولد من أمثال سيدنا إبراهيم؛ نبيًّا حليمًا سليمًا أوَّاهًا؟!
فرغم كل شيء لم يكن سيدنا إبراهيم يغمره ظلُّ والده، كما أنه لم يكن ليستغفر لأبيه بعدما تَبيَّن له أنه عدو لله، وبالتالي فهو في هذا الدعاء الذي دعا به في البداية بريئًا نزيهًا، ونبيًّا عظيمًا معصومًا، وكان من القدسيّين الذين ظلوا يقولون الحق وكانوا بجانب الحق دائمًا.. والقول بأنه قد يذنب ليس إلا تعبيرًا عن جهالة نكراء وضلالة عمياء.
3- نبيٌّ من أولي العزم: سيدنا موسى
إن القرآن الكريم يَلفت الأنظارَ بعد سيدنا إبراهيم إلى رجل عظيم آخر، إنه كليم الله موسى الذي يُقال إنه كان سريع الغضب.. وفي الحقيقة فإن تعبير “الغاضب/الغضبان” لا يجازَف به في حق نبي من أنبياء الله، ولكنه بحكم مهمته ورسالته كان متهيّجًا بفطرته، يغضب للحقّ، ويفعل كل ما يفعل بشوق وحماس عاليَين.
وإرسال سيدِنا موسى إلى بني إسرائيل لم يكن إلا من حكمة الله الذي له في كل فعل من أفعاله حكمة بالغة، لا يدرك كنهَها إلا الله، وقد كان سيدنا موسى نبي العزيمة والإصرار، إذا عزم على أمر فإنه يحث الخطى نحوه ولو أدى به إلى الموت، ولا يحيد عنه بتاتًا ولو بدا للناظر أنه لن يطيق النهوض به؛ فهو إذ ينفِّذ ما أمر الله به لا يبالي بكل ما يَعترض طريقه إلى ذلك.
ومن هذا المنطلق، كان لا بد من نبي من أولي العزم لإصلاح هذه الجماعة التي كُلِّف بإرشادها، فكان من حكمة الله أن يخضعوا للعملية التربوية طوال أربعين عامًا في صحراء التيه، لتأهيلهم وتعويدهم على معاناة المحن.. ولكن هذه المرحلة لم تكن من نوع “الأربعينيات” التي تُعَدُّ بالأيام والشهور، بل كانت “أربعينية” استغرقت أربعين عامًا.
وتذكر بعض المصادر الإسلامية وكذلك التوراة أن فرعون احتضن سيدنا موسى وهو صبي فتعلق موسى بلحيته وجذبها بغضب.. فارتاب فرعون من هذا، وهمَّ بقتله خوفًا من أن يكون هو من يزول ملكه على يديه، إلا أن الحاضرين هناك قالوا له: إن هذا صبي لم يبلغ من العمر ما يؤهله لأن يميِّز بين الأمور، وعلامته أن تقرب منه التمرة والجمرة فقُرِّبَتَا إليه فأخذ الجمرة .
وهذه الروايات -على ضعفها- تلائم طبيعة سيدنا موسى تمام الملائمة.. فسيدنا موسى قد نشأ في قصر فرعون، ونشأتُه هنالك لها أهمية كبيرة بالنسبة لاستعداده لأداء مهمته الكبرى.
ويتحدث القرآن الكريم عن موسى في مواضع متعددة وبمناسبات مختلفة.. ومع أنه تم تناوله في القرآن الكريم الذي نزل في غضون ثلاثة وعشرين عامًا في آيات مختلفة وضمن مواضيع متباينة وبأساليب متعددة إلا أن موسى يَظهر أمامنا بالطبيعة نفسها وبالتصرفات عينها.
ففي سورة طه التي هي من السور الطوال يَرِد ذكر سيدنا موسى بإطناب وحسبَ ما يَرِد فيها: كان الناس في مصر يتخبطون في متاهات الغفلة؛ حيث كان الأقباط وبنو إسرائيل في تخاصم دائم.. وذات مرة شاهد سيدنا موسى رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخَر من الأقباط، فبطبيعة الحال غضِبَ موسى -وحُقَّ له ذلك- ووكز القبطيَّ، فمات، وبالفعل إنَّ ضربة واحدة من رجل قوي سريع الانفعال مثل موسى تكفي لأن يخر المضروب صريعًا على الأرض.. ولكن القرآن الكريم يترجم مشاعر موسى التي تنم عن عميق محاسبته لنفسه قائلًا: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/20)، أي: إنني فعلت ذلك خطأً ومرتبكًا من دون دراية بما يأتي به من العواقب ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة الشُّعَرَاءِ: 26/21).
وفي مشهد آخر يجلس تحت شجرة في رحلة طويلة وبعد عناء كبير يناجي ربه بأسلوب ينم عن تأدب عميق مع الله: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ (سورة القَصَصِ: 28/24).
نعم، إنه التضرُّع والابتهال بين يدي خالقه، فقد فَقَدَ الأمنَ بالجوع والعطش والخوف.. وجاء يبحث عن المأوى، فليس لديه إلا توكله على ربه.. ولذلك اتّجه إلى مولاه بتضرُّع وابتهالٍ قائلًا: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾، بمعنى أنه يبث شكواه وهمه لمولاه قائلًا: إنني في هذه البراري جائع ومُنهَك ومحتاجٌ إلى عظيم إحسانك.
فقائل كل هذه الكلمات هو سيدنا موسى، ذلك الرجل المتهيج القلبِ، والنبيُّ الذي يحمل أشكال الطبيعة التي تخص قومه.. فكل الكلام مطابق لمقتضى الحال مطابقةً تامة، ولنتابع مسيرة هذا النبي من خلال الآيات القرآنية ولنصعد إلى جبل الطور؛ فهناك أيضًا سنرى ما يقوله بالأداء والأسلوب نفسه: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/143).
فهو حينما صعِد الطورَ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، فقائل هذا القول هو نبي عظيم الشأن، وكل الأنبياء قد رضوا بما آتاهم ربهم وقنعوا به دون قيد أو شرط.. ولكنه قام بهذا الطلب باعتباره نبيًّا لبني إسرائيل الذين سبق أن طلبوا مثل ذلك قائلين: أرنا الله جهرة، ومن ثمّ كان على دراية بحالتهم الروحية، بالإضافة إلى أنه قد نوى أن يقصم ظهر المادية.. كما أنه كان يتشوق إلى ربه.
وكما عرفناه بسجيته العالية وفطرته المتهيجة؛ حيث رأيناه يتعلق بلحية فرعون وهو لا يزال صبيًّا، ويَصرَع قبطيًّا بضربة واحدة على الأرض، فكذلك نراه على الطبيعة ذاتها حينما يتحدث بكلمات لم تصدر من أيّ نبي آخر.. نعم، إن القرآن الكريم، بأسلوبه الخاص في التصوير، يرسم لنا ملامح الشخصية نفسها.
ولنواصل متابعة سيدنا موسى من خلال الآيات القرآنية: فقد تحقق اللقاء مع الرب، فرجع موسى من الطور، ولما أتى قومَه ورأى أنهم قد تم إغواؤهم من قِبل السامري وعبدوا العجل، ألقى ما بيده من الألواح، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وهزه هزةً عنيفة، فإذا بأخيه يقول له إزاء هذا الانفعال: ﴿يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ (سورة طَهَ: 20/94).
فهذه ردّة فعل من صاحب قلب طافح بالحماس، تجاه ضلالة مَن خلَّفهم وراءه.. حتى إنه بلغ به الأمر أن يأخذ برأس أخيه ولحيته ويجرَّهما إليه مع أنه نبي مثله.. فكل هذه الأمور مَظاهِرُ من عشق موسى للحقّ وتمسكه به.. فذِكرُه يرِد في معظم القرآن على هذا الوجه.
وإذا لاحظنا كل هذا فإننا نكاد نتصوّر جسامة كَتِفَي سيدنا موسى، ونُشاهد كيفية طبيعته من خلال تقاسيم وجهه، إلى جانب تضرّعه ولجوئه إلى مولاه، وبحثِه عن مرضاته، ونرى مدى شدة تمسكه بالحق فيما يراه حقًّا.
4- سيدنا يوسف في القرآن الكريم
يحدثنا القرآن عن سيدنا يوسف فيُبرِزه لنا شخصية مختلفة تمامًا، والنبي حينما يُعَرِّفه لنا يرسمه على أنه رجل عظيم بعلمِه وحكمتِه وصبرِه وأنّاتِه وتدبيره.. ويمكن استخراج هذه الجوانب من رؤياه التي رآها وهو لا يزال في مُقتبل العمر.
فقد رأى الكواكب والشمس والقمر ساجدين له.. ورؤيته تلك ما هي إلا إشارة بأنه سيصبح بطلًا من أبطال الحكمة؛ فالقمر والشمس والكواكب إنما هي صحائف وكُتبٌ سطرَها الحق، فكما أن سجودها له وإبداءَها الخضوع أمامه دلائلُ على نبوّته، فهي أيضًا أمارات على أنه سيكون صاحبَ حكمة وعلم وتدبير.. ومع تدبيره وحكمته فهو إنسانُ التسليمِ والتوكل، فمن مظاهر عميق تسليمه لأمر الله وقدره أنه لم ينبس ولو بكلمة حينما ألقاه إخوته في الجب.. ولما أخرجته القافلة المارة من الجب وأرادوا أن يذهبوا به ليبيعوه في المدينة، لم يحس بالحاجة إلى أن يتحدث عن نفسه ويُثبتَ ذاته فيقولَ: “أنا كذا وكذا”، بل حاول أن يتابع ما يدبره له المولى بحكمته.
وهو -في الوقت ذاته- إنسانٌ يتّسم بالعلمِ والحكمةِ، يفكّر بتؤدة في عاقبة الطريق الذي يسير فيه، ويحاول أن يؤوِّل الأحاديث.. ونراه على الشاكلة نفسها بعدما دخل السجن وعبَّر الرؤى لمن طلب منه ذلك.
ولم يكن يقف عند حدود تعبير الرؤيا، بل كان في الوقت نفسه يُلقنهم درسًا حقيقيًّا في التوحيد والإيمان.. والقرآن الكريم حينما يتحدّث عن هذه الأمور ينير الطريق لرجال الإرشاد ويبين الأمور والأساليب التي يجب عليهم الالتزام بها تجاه من يريدون إرشادهم.
وإني لأرى من المفيد أن أتطرّق إلى نقطةٍ بعيدة عن الموضوع، وهي أن بعض الناس يأتوننا ويوجّهون إلينا أسئلة لأغراض مختلفة، وهذه الأسئلة تحمل جوانب متعدّدة كالاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية.. وفي هذا السياق قد تكون هناك أسئلة تأتي من قِبل بعض الأطراف العلمانية واللادينية لمجرّد الجدال والمراء، وهؤلاء من حيث المبدأ لا يعترفون بالله ولكنهم مع ذلك يأتون ويوجهون الأسئلة من أمثال: هل القَدر موجود؟ كيف تؤدَّى الصلواتُ في المناطق القطبية؟ وإلى أين يَتوجه من يصلِّى على سطح القمر.. وغير ذلك من الأسئلة.
أجل، إن هذه الأسئلة تُوجَّه بغرض الجدال والمراء ليس إلا، وهؤلاء قد يظنُّ السامع أنهم سيقومون بالعبادات فورَ الجواب عن سؤالهم، ولكنهم لن يؤمنوا حتى لو أجيبوا عن كل أسئلتهم وهم مع ذلك يَظَلُّون يطرحون الأسئلة.. ولو أُفحموا في موضوع فسيقفزون إلى موضوع آخر، فإذا أُسكتوا في هذا الموضوع فسيُنتجون قضايا أخرى، وهكذا ستتواصل الأسئلة تترى.
ولنا في سيدنا يوسف درسٌ عظيم ومثال رائع في هذا الموضوع، فنحن نتعلم من صنيعه -باعتباره رجل الحكمة والعلم والمعرفة- أنه ينبغي للداعية أن يستمع جيّدًا إلى من يدعوه حتى يتعرّف على مقاصده الأساسية، كما يستمع الطبيب إلى مريضه الذي يشرح له همومه بإسهاب، ويُفْرغ له كل همومه وشكواه.
نعم، إن الطبيب الماهر يستمع أوّلًا إلى جميع شكاوى المريض، ولا يبادر بمعاينة موضع الألم لمجرد أن المريض يضع عليه إصبعه؛ فقد يضع المريض يده على رأسه الذي يعاني من الصداع، في حين أن الألم نابعٌ من التهابٍ في أسنانه.. وقد نراه يتلوّى مِن وجع يظن أنه في كليته، في حين أن هذا أيضًا ناشئ من التهابٍ أو تسوُّسٍ تَعرَّضت لهما أسنانه.. كما أنه من المحتمل أن يكون صداعُه انعكاسًا لالتهاب في الجيوب الأنفية، أو انسدادٍ في العروق.
أجل، ليس من الضروري في تشخيص المرض البدءُ من الرأس لمجرد أن به صداعًا؛ بل ينبغي البحث عن السبب الحقيقي للمرض، وجسُّ الأعضاء الأخرى في سبيل محاولة تشخيص العلة.
فنلاحظ أن سيدنا يوسف حينما أراد أن يدعو إنسانًا ملحدًا لله، تناوَله بعقلية الطبيب وحساسيته.
فعلى سبيل المثال إنه -على غرار الطبيب الحاذق- قبل أن يُعبِّر الرؤيا لمن جاءا يستفتيانه؛ رأيناه يجلس أمامهما فيلقّنهما درسًا في التوحيد، ويحاول أن يشرح لهما بالتفصيل أنه لا يمكن تفسير هذه الأمور من دون إسناد الكون وجميعِ ما فيه من الشؤون إلى الله وأنه قد آمن بالله، واتَّبعَ ملة آبائه إبرهيم وإسحاق ويعقوب، ويبين لهم مدى ما يَكسبه الإنسان من السعادة والطمأنينة والسكينة عندما يوحد الله.. فقال تعالى على لسانه: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِله أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/37-40).
وبعدما لقَّنهما درسَ التوحيد هذا، انتقل إلى تعبير الرؤيا، فقال: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/41).
نعم، ينبغي لنا نحن أيضًا أن نتحدث عن الله لمن يجادلنا ويمارينا، ونبيّنَ له ماهية الكتاب والنبي والنبوة، آخذين بعين الاعتبار -على الأقل- احتمال أن يكون غيرَ مؤمن بالله وبالكتاب، ومنكرًا للرسول .. ومن بعد ذلك نجيب على سؤاله أو نهتم بشؤونه الأخرى كتعبير رؤياه -مثلًا- إن وُجِدَت، وإلا فلو ظللنا نعبر الرؤى سنوات طويلة لن نحقّق شيئًا سوى “تعبير الرؤيا”، ولن نتقدّم إلى الأمام ولو خطوة واحدة.. وأما هذا النبيُّ ذو الشأن الجليل فلم يجب عمّا سئل فقط، بل تَناوَلَ كل الأمور بالحكمة أثناء تعبيره للرؤيا.
نعم، إنَّ شَرْح مسألة القدَر لِمن جاء يسأل عنها لن يكون ذا فائدة تُذكر! بل لا بد لهذا السائل أن يؤمِن بالله حتى يفهم معنى القدر فهمًا صحيحًا، لأن هذه الأمور مترابطة فيما بينها.. فلا بد لمن يتحدث عن الله أن يتناول ذلك في إطار البدهي من الأمور، وكأنه وصل إلى نتيجة في المختبر، أو كما يبينُ حقيقة هندسية أو يوضحُ قضية مادية، حتى
لا يدَعَ مجالًا للإنكار والشكّ.
فالإنسان إذا أراد شرح القضايا بأسلوب علمي وسهلٍ وطبيعي، يكون قد مهَّد لما بعده، فشرح الألوهيةِ أو النبوة مثلًا يحتاج إلى توطِئةٍ محكمة وأسلوب رصين حتى نجعلَ الآخرين يُصدِّقون، ومن الطبيعيّ أنه لن تكون هناك أي جدوى للخوض في الجدال والمراء الفارغ، فإننا إن خضنا في الجدالات أتحنا الفرصة لغيرنا حتى يطحنَنا، ونكونُ قد أرهقْنا أنفسنا من دون فائدة.
فعلى الإنسان أن يتصرف مثل سيدنا يوسف؛ فهذا النبي الجليل راح يلقن بكل أحواله وأطواره دروسًا للآخرين، ويمتاز عن غيره بهذا الجانب حتى في معتقلِه.
وفي موضع آخر يلفت القرآن الكريم الأنظار إلى شمائل يوسفية أخرى؛ إلى عفته وتأنِّيه ووقاره؛ فهو فتًى وسيمٌ ورائع يقيم في بيت امرأة فاتنةٍ جميلة، نازعَتْها نفسها إليه فغلَّقتْ دونه الأبواب، ويرسم القرآنُ الكريم لنا صرح العفة الشامخ هذا بقوله:
﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/23).
فالأبواب قد غُلِّقت.. وهناك امرأة فاتنة ازّينت، وأظهرت مفاتنها ورمت حبائلها، وسيدُنا يوسف لم ينبّأ بعدُ، ولم يقل له أحد: إنك نبي، ولكنه مع ذلك إنسانٌ عفيف، ورجلٌ حكيم، يَعلم جيدًا كيف يَصرع الزنا الإنسانَ ويكبّه على وجهه.
ومن الصعب جدًّا أن يصمُد الإنسان أمام مشهدٍ كهذا، ولا يحترقَ بلهيبِ هذه النار الرهيبة.. ولكن هذا الإنسان المرشح للنبوة صمَد صمود الراسيات وبقي شامخًا شموخ الجبالِ.
ففي مثل هذه الحالة يَكبُر سيدنا يوسف في عين الإنسان أكثر فأكثر. نعم، إننا نراه وكأنه صرحٌ للحكمة والعفّة؛ حيث نراه يواجه بطبيعته النقية الصافية هذه المراودات الصريحة بقوله: ﴿مَعَاذَ اللهِ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/23). نعم، إن هذا هو ما يتمتع به النبي من عميق الخشية من الله، والشعور بالعفّة وصون العرض.
نعم، إن كل حركة وتصرُّفٍ منه لهو تعبيرٌ آخر عن بُعد عميق من أبعاد النبوة؛ فعلى سبيل المثال إنه بتلك التصرفات الدقيقة اللطيفة التي كانت تصدر منه وهو سَجين، كان دائمًا ما ينقش أشكالًا طريفةً من الحكمة.
لقد دخل السجن بفرية رُميَ بها.. وهناك عبرَ رؤيا الملك، فاعتبره الملك تعبيرًا صائبًا وحكيمًا، فأرسل أحدَ رجاله إلى السجن وقال: ﴿ائْتُونِي بِهِ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/50)، ولكنَّ “صَرْح العفةِ” يوسف الصديق قال لذلك الرسول الذي أتاه ليأخذه معه: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/50)، بمعنى أن سيدنا يوسف بقوله هذا قد أرسل رسالة إلى الملك مفادُها: إنني دخلت السجن ظلمًا بسبب فرية، ولا أريد أن يتكرر مثل هذا، فليُحقَّق في القضية، حتى تنجلي الحقيقة ويتميّز المجرم عن البريء بوجه كامل.
وقد استحسن نبينا الذي هو سيد الأنبياء ومفخرة الإنسانية، حَزْمَ يوسف وصبْرَه حين دعاه الملك، إذ إنّه لم يبادر على الفور، بل تمنّع طمعًا في إجراء تحقيقٍ حول القضيّة السابقة، حيث قال: “لقد عجبتُ من يوسف وصبره وكرمه، واللهُ يغفر له، حين أتاه الرسول فقال: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/50)، ولو كنتُ مكانَه ولبثت في السجن طول ما لبثَ لأسرعت الإجابة، وبادرتهم الباب، وما ابتغيت العذر، إن كان لحليمًا ذا أناة” ، وفي نهاية التحقيق لمَّا قالت النسوة: ﴿حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/51)، اعترفت “زليخا” بالحقيقة فقالت: ﴿الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/51).
فمن خلال هذه القصة التي تَحدث لنا القرآن عنها بكل تفاصيلها التي قد تُعد من الأمور الفرعية، نلاحظ أن سيدنا يوسف “رجلُ التمكين والتدبير” بكل معنى الكلمة، حيث إنه لا يستعجل بتاتًا، وينتظرُ بكل أناةٍ تلك اللحظةَ التي تنبلج فيها الحقيقة بكلّ جلاء.
ونلاحظ هذا التمكين والأناة منه في مشهد آخر أيضًا: حيث إنه في تلك السنوات العجاف التي عمّ فيها القحط الشديد، عَرض عليه الملكُ أن يكون مستشارًا خاصًّا له، ولكنه قال له: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/55).
فنحن في أول وهلة قد نجد صعوبة في فهم مغزى طلبه الوظيفةَ، ولكنه على وعيٍ تام بأنه رجلُ هذه المهمة، وأنه ليس له بديل في هذا الشأن.. وبالفعل نرى تخزينه للمواد الغذائية بشكلها المناسب، وإنقاذَه البلاد من الأزْمة، ومراعاته لمبدإ المساواة أثناء تنفيذه لهذا الأمر، بل عدم محاباته حتى لإخوته -على ما نشاهده في القرآن-.. كل ذلك من الأمثلة الدالة على أهليته لهذا الأمر.
أجل، فكل هذه الأحداث تدل على مدى ما كان يتحلّى به من الأناة والعلم والحكمة والتدبير.
وقد استنتجنا كل هذه المعلومات من التعبيرات والتصويرات القرآنية التي تتسم بالتناغم والتناسق والانسجام.
فهذه هي القوة التصويرية القرآنية التي تَعرِض أمام أنظارنا شخصياتِ الأنبياء وطبائعهم الفائقة على المستوى البشري، وتُصوِّرُ لنا أولئك الأنبياءَ “رجال الحق” من دون خلط بعضها بالبعض الآخر في أروع توازن.. بحيث إن الإنسان إذا نظر إلى القرآن من هذه الجهة، فإنه لن يتمالك إلا أن يقول: إن القرآن كلام الله ولا يمكن أن يكون كلامَ بشر.
إن علم النفس الحديث يصنف الناس إلى فئات معينة ويتناولهم في إطار ذلك، فيقول: إن الفئة الفلانية هكذا.. والناس الانطوائيون يتصرفون هكذا… إلخ”، فيبدو أنه بهذه العموميات يُضيِّق واسعًا.. حتى إننا نراه في كثير من الأحيان يظل يردد الأفكار نفسها.
لكن القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنًا من الزمن قد نفذ إلى العالم الروحي والحياة القلبية لبني الإنسان، فكأنه سَلَّط عدساتٍ مكبّرةً على انفعالاتهم ورغباتهم وغرائزهم ونياتهم، وقدَّمَها لنا بخطوطها العريضة واضحةً جلية. أجل، إنه رَسَم لنا كلَّ شخصية وخَطَّ لنا صورتها القلمية وكأنها كونٌ مستقل وكتابٌ آخرُ؛ بمعنى أن القرآن المعجزَ البيانِ قد وضح أكثر المجالات التي عجز عنها علمُ النفس الحديثُ، فحلَّل كل صغيرة وكبيرة منها بأدقِّ تفاصيلها وعرَضَها أمام الأنظار.
ولا يمكننا أن نتناول مئات الشخصيات التي تَحدَّث عنها القرآن الكريم في هذه العجالة؛ فغاية ما نستطيع عمله هو محاولة إبراز تفرُّدِ القرآنِ الكريم في أسلوبه وبيانه وتعبيره من خلال التركيز على عدة شخصيات.
ومن الممكن أن نتحدّث في هذا السياق عن فرعون أيضًا، ولكنه قد يكون من سوء الأدب الحديثُ عن العقعق في روضة الورود.. فلذلك سنتجاوز شخصياتٍ من أمثال فرعون والنمرود.. نعم، سنتجاهل شخصيات تغاضَوا في حياتهم الدنيا عن الله وكُتبه ورسله، وسنكتفي بالتطواف في روضة الأنبياء والمؤمنين الذين عمَّروا قلوبهم بالأنوار، ولا مكان في روضة الورد هذه لمن عاش حياته حبيسَ فكرِه الأسود.
5- القرآن الكريم وسيدتنا مريم عليها السلام
تبتدِئ السورةُ التي سمّيت باسم “مريم” بالحديث عن البلايا والمصائب وبعضِ الابتلاءات التي ابتُليتْ بها سيدتنا مريم.. “فمن أمهات المواضيع التي تتناولها هذه السورة هي قصة حمل سيدتنا مريم بسيدنا عيسى بكيفيةٍ يمكن أن نعتبرها من قَبيل الأمور الخارقة للأسباب، في حين أنها كانت قد تربت في الإقليم الروحاني للمعبد، وكانت امرأةً حريصة أشد الحرص على صون عرضها وعفتها.
ومن أسباب ذكر هذه القصة في القرآن وحِكَمِها -والله أعلم- تسلية الرسول الذي كان يتعرض لشتى ألوان المصائب والبلايا، فكأن الله يقول له: أيها الحبيب! إنك لست وحدك في هذه المصائب التي تعاني منها، فلقد ابتُليَ مَن قبلك بالكثير من هذه المحن والبلايا وأضرابِها فصبروا، ومنهم المصونة مريم العذراء.. وهناك الكثير من الحِكم والأسباب التي يمكن سردها في ذكر هذه القصة.
وغاية القول: إنه لا يمكن فهم حقيقة سيدنا عيسى وسيدتنا مريم إلا من خلال الآيات التي تتعرض لهما.. كما أنه من خلالها يُمْكنُ دحض قضيةِ: “الأقانيم الثلاثة” التي لا تزال موجودة في النصرانية إلى أيامنا هذه.. فالنصارى مدينون من هذه الناحية للقرآن الكريم إلى حد كبير؛ حيث إن انتقال النجاشي مَلِك الحبشة من النصرانية إلى الإسلام إنما تَحقَّق في الجوِّ النوراني لهذه الآيات.
وعلى كل حال، نتجاوز الحديث عن الأسباب والحِكَم حول تناول القرآن الكريم لقصة سيدتنا مريم، لننتقل إلى تحليل الشخصية في إطار الآيات المتعلقة بتلك المرأة العظيمة:
إن سيدتنا مريم حسب الآيات القرآنية والمعلومات التاريخية كانت امرأة مباركة نذرها أبواها لخدمة المعبَدِ قبل أن تُولَد، والقرآن يَذكر أن قومها خاطبوها بقولهم:
﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/28). وليس المقصود بـ”هارون” هنا هو ذلك النبي أخو موسى، فبينهما قرون طويلة، إلا أن هارون هذا -كما هو معلوم لدى الكثيرين- كان قيِّمًا على المعبد وخادمًا فيه.. فمن هذه الناحية كان قومُها يشبِّهونها بهارون في تبتُّلها فيقولون لها: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ﴾، وتَذكُر بعض الروايات أنها كان لها -بالفعل- أخٌ يسمّى هارون.
ومن حيث إن سيدتنا مريم كانت موهوبة للمعبد فقد قضت جُلَّ أيام طفولتها وشبابها في المعبد، فهذه المرأة العظيمة التي وَجدت نفسها -بإرادتها أو خارجَ إرادتها- في هذا المكان الذي تتنسَّم فيه نسماتٍ لاهوتية صباحَ مساءَ، قد اكتَسبت بمرور الوقت عمقًا روحانيًّا وصفاءً نفسيًّا؛ فكانت تهبّ عليها صباح مساء نسماتٌ من العالم الغيبي، فقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/37) يعبِّر عن هذه الأمور الخارقة.. وبعضُ العلماء يرى أن هذا الرزق طعامُ الصيف في موسم الشتاء، وطعام الشتاء في موسم الصيف .
فهذه المرأة التي أصبحت رمزًا للعفة وصونِ العرض، وقضت عمرها في هذا الجو المعنوي، وتنعمت بالنعم المادية والمعنوية التي تأتي من العالم الغيبي؛ إذا بِها تصبح حاملًا بطريقةٍ خارقة للأسباب.
ويروي القرآنُ الكريم ذلك الحديثَ الذي دار بين سيدتنا مريم وبين الملَك الذي جاء يبلِّغها الأمرَ الإلهي بالحمل.. ويُروى أن هذا الملك هو سيدنا جبريل ؛ وقد نزل في هذا الحين على صورة إنسان، فحينما قابلَتْه سيدتنا مريم قَالَتْ: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/18) فرد عليها الملك قائلًا: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/19) فردت عليه مريمُ قائلةً: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/20)، وفي نهاية الأمر حملت سيدتنا مريم بمشيئة الله.. ولكن كيف كانت ستشرح هذا الأمر لقومها؟! نعم، إنها ستصبر صبرًا بالغًا أمام أمر تَعْلمُ بأنه من عند الله، ولكنه مِن شبه المستحيل عليها أن تُفهّمَه قومها.
ولنتخيل تلك الحالة الحرجة التي كانت سيدتنا مريم تعاني منها.
وانطلاقًا من هذه الحالة قررتْ مريمُ أن تتنحى إلى مكان بعيد عن قومها.. وما كان يجذبها إلى العزلة إلا عفّتها وطهارتها، ولا ندري كم من الوقت قضت في العزلة، ولا يصرح القرآن في هذا الأمر بشيء، بل ينتقل مباشرة إلى ما قبل المخاض.. ففي الوقت الذي كانت تتلوّى فيه مريم من آلام المخاض، استندت بسَوْقٍ إلهيٍّ إلى جذع النخلة، وبدأتْ تَسْبَح في لجج الأفكار العميقة البعيدة تجاه ما لاقته من صنوف الابتلاءات، فإذا بلسانها يلهج بالقول: ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/23).. ولكن السيدة العذراء التي لم تزل منذ بداية أمرها تنظر من منظور إيمانها العميق إلى ما يدبّره لها القَدرُ الإلهي، فلا بد أن يُحمل قولُها هذا على أنها قالته بتأثير الأحاسيس التي فارت منها تحت وطأة مشاعر العفّة وضغطاتِها.
ويَلفت أنظارَنا أمران آخران هنا:
1- الألم النفسي
2- ألمُ المخاض
ففي هذا الموقف الذي تتلوّى فيه مريم عليها السلام من آلام المخاض، ويكاد قلبُها ينفطر وأطرافها تُشَلُّ عن الحركة، وقد أنهكتها الأوجاع من جانب، هناك من جانب آخر وخزٌ في ضميرها يَطغَى ألمُه على كل هذه الأوجاع.. فهي بحاجة ماسة لدواء يقضي على آلام المخاض وفي الوقت ذاته يُطفئ لهيب تلك النار التي شبّت في ضميرها.
ولم يمضِ عليها طويل وقتٍ حتى تداركتها رحمة من ربها برسالة جاء بها المَلَك:
﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/24-25).
وإثر هذا البيان الإلهي الإرشادي تتخلص السيدة مريم من حالتها النفسية الصعبة، فيتحقق بذلك الهدف الأول من وراء هذا التنبيه، وهو انتشال هذه السيدة رمز العفة والعفاف من هذا الجو الخانق الذي حطّم نفسيَّتها.
حيث إن هذا التنبيه أو الصوت الإلهي قد أبعدَها عن عالمها الفكري الذي خاضت فيه، وسحَبَها إلى عوالمَ فكريةٍ أخرى.. فبعد أن فرَّت من قومها وحيدةً فريدةً إلى صحراء قاحلة إذا بها تجد نفسها أمام قدرة إلهيّة جعلتْ ما حولها بستانًا مخضرًّا محاطًا بالنخيل، فينشرح صدرُها ويرتاح فؤادُها.
وفي هاتين الآيتين الكريمتين أمرٌ يلفت الأنظار ومن الضروري البحث فيه، وهو قضية العلاقة بين الحمل، -وعلى الخصوص الفترة التي تسبق الولادة- وبين الماء والرُّطب.. ومع أن هذا الأمر لا يدخل في نطاقِ تخصُّصي إلا أنني، اعتمادًا مني على القرآن، سأتطرق إليه على وجه الاستطراد؛ حيث أعتقد أن الماء والرطب بصوتهما وجوهما وتناولهما بالأكل والشرب، يعودان بالفائدة على المرأة أثناء الولادة سواء كانت تلك الفائدة بدنية كتأثيرهما على انفتاح الرحم، أو نفسيةً؛ كتأثيرهما على رفع معنويات المريض.. وانطلاقًا من هذه الفكرة يمكن التركيز على مشاريع الطب الحديث حول “الولادة في الماء”.
ويواصل الملَك في رسالته قائلًا: ﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (سورة مَرْيَمَ: 19/26).
فكأنه بهذه العبارات يُربّتُ على كتف امرأة تعاني من امتحانات روحية وأوجاعٍ جسدية جراء المخاض، فيهدأ عالَمُها الداخليُّ، وتملأُ السكينة والطمانينة قلبَها.. ولِعلم النفس الحديث في هذا المجال توصيات مشابهة لهذه، ولكن معظمها بعيدة كل البعد عن النفوذ إلى روح الإنسان، بل إنها تدفع الإنسان إلى جو المرض، وكلها تعكس العالَم الفكري لـ”رجال العلم”(!) الذين يُدْلون بهذه التوصيات.. وتُطرَح معظم هذه الأساليب على اعتبار أنها تُصلِح ما فَسد، إلا أنها -بدلًا من ذلك- تؤدي بالإنسان إلى أن ينفصم عن ذاته ويبتعدَ عن فطرته.. ففي حين أن الغاية منها جلب الشفاء لمرض إذا بها تَجلب معها عشراتِ الأمراض.
وأخيرًا، وُلد سيدنا عيسى، فأتت مريمُ به إلى قومها تحملُه في حضنها، فشخصت العيون مستغرِبة ونطقت الألسنة بالتهمة، فردَّ هذا الصبيُّ الذي في المهد على ما رماها به قومها من الاتهامات… ويمكن متابعة باقي القصة من سورة مريم؛ حيث إننا نريد أن نرجع إلى ما نحن بصدده، ونستخرجَ قواعد عامة في هذا الإطار.
وما يهمّنا في هذه القصة هو أن نستنبط من القرآن كيفيّةَ تحليله لأحاسيسِ المرأة، وبيان حالتِها النفسية، ومشاعرِها وعواطفها، وموقعها في المجتمع.
فيُلاحَظ أن القرآن يحلِّق في الآفاق اللدنّية التي لم يصل إليها بعدُ علمُ النفس الحديث، ونرى أن رايته ترفرف خفَّاقة في أعلى الذرَى.. فإذا نظرنا إلى القرآن من هذه الناحية، فسنرى أن التحليلات التي قدَّمها قبل قرون لهي مبهرة للعقول وفي غاية العمق.. ومن المعلوم أن تحليل مختلفِ الحالات النفسية مهمة جدًّا من ناحية علم النفس وعلمِ النفس الاجتماعي.
أجل، إننا نجد أن القرآن يتناول في أماكن عديدة ما يَعتري الإنسانَ بشكل عام من الانفعالات والتأثّرات، وما يصاحب ذلك من التغيرات والتحوّلات المادية والمعنوية، حيث نراه يتحدّث عن طبائع الشخصيات غير العادية، وأصحابِ الذكاء المفرِط، وأصحاب العقول الكبيرة من الدهاة والعباقرة، والذين كلّلوا حياتهم بالانتصارات، ويُشار إليهم بالبنان في النصر والغلبة، والذين أصبحوا أقطابًا في الطاعة والعبادة، وأصحابِ الذوق الذين يُشاهِدون لوحات من عالم المثال وهم في عالم الشهادة.. إلى غير ذلك من الشخصيات الكثيرة يحللها القرآن الكريم.
والآن، كيف يمكن أن يفسَّر ما لدى البعض من العزوف والاستغناء عن مثل هذا المَعين العميق الذي لا ينضب؟ فمن الواضح الجلي أنه ينبغي لعلماء النفس والاجتماع المسلِمين أن يبذلوا جهودًا كبيرة؛ فما سيقومون به من الدراسات في ضوء الأهداف والمقاصد القرآنية العامة، سيوجِّه إنسانَ اليومِ -الذي ابتَعد أو أُبْعِد عن ذاتيته وروحه- مرةً أخرى نحو القرآن وسيحلق به في آفاقه.
هـ. التحليل النفسي والتصويري للمجتمعات في القرآن الكريم
إن الناظر في القرآن الكريم نظرة متأنّية سيرى أنه يحلّل المجتمعات في إطار مبادئ معينة.. وفي نتيجة تلك التحليلات تتبلور طبيعة تلك المجتمعات وتبدو للعيان واضحة جليّة.
إنه في هذه التحليلات لا يصرح بالأسماء بل يستخدم أسلوبًا من نمط فريد يجعل تلك المجتمعات تنجلي وتتراءى ملامحُها للعين من فورها.. نعم، إنها تتجلى للعيان وتتراءى بحيث لا تدَع حاجة إلى أن يكون الإنسان عالِمًا نفسيًّا أو اجتماعيًّا حتى يستطيع فهمَها وإدراكها؛ لأن جميع اللوحات التي يرسمها القرآن لهي من وضوح التعبير بحيث لا تدَع مجالًا لما يناقضها.
ولذلك كان الناس في عصر السعادة (العهد النبوي) سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين أو المسلمين ترتعد فرائصهم خوفًا من أن يفتضح أمرهم وما يدور بدواخلهم.. ومِن بين هؤلاء كان المسلمون -بالأخص- يشعرون دائمًا بالحاجة إلى أن يُلملموا شملَ قلوبهم وشتاتَ وجدانهم وضمائرهم تجاه الوحي السماوي؛ حيث كان قائلهم يقول: كنا على عهد رسول الله، نخاف من أن يدور على قلوبنا شيء، مع العلم بأنه لا يصرح بالأسماء، ولكننا كنا نبحث عن مهرب جراء ما كانت أنظارنا تُلفَت إلى عِظَم الذنب الذي نقترفه وما يترتب على ذلك من العقاب الأخروي.. فهذا القول تعبير صريح عن مشاعرهم تجاه هذه الأمور.
حتى إنه يمكن أن يقال في هذا الصدد: مع أن ارتحال سلطان الأنبياء إلى أفق روحه قد أدْمى فؤادهم، إلا أنه أصبح وسيلة إلى التسري عنهم نوعًا ما، لأن نزول آية في مثل هذه المواضيع على هؤلاء الذين هم رجال الأدب والوقار والجدية كان يؤثر فيهم كأنها صدمات تكاد تتفطر منها أكبادهم.
وأكثر النقاط التي تلفت الأنظار في مثل هذه الآيات هي أن القرآن لا يذكر الأشخاص والمجتمعات بألقابهم وأسمائهم بل يتناولهم بأوصافهم.. بمعنى أن المشهد الذي كان يُعرَض على الشاشة لم يكن مشهد الكفار بأشخاصهم بل الذي كان يُعرض هو وصف الكفر ليس إلا، وكذلك لم يكن المعروض هو المنافق بل النفاق، وليس الفاسق والضالّ بل الفسق والضلال ذاتهما.
والمأمول من رجال العلم المهتمّين بقضايا الأفراد والمجتمعات أن يستنبطوا من خاصية القرآن هذه دروسًا وعِبَرًا عظيمة.
ففي هذا الإطار يتميز القرآن بأنه يستعمل في تحليل الأفراد والمجتمعات أسلوب “التعميم”؛ بحيث إنه يمكن -دائمًا- مشاهدةُ السمات العامة للمشركين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمسلمين وغيرهم في سطور القرآن أو في ثنايا سطوره.. وهذا مبدأ في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وعلى منواله نستطيع أن نؤسّس علاقاتنا مع الآخرين سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.. فهذه الأمور الآنفةُ الذكرِ من الأهمية بحيث إنها تُعلِّمنا كيفيةَ إصلاح الأعطال، وماذا نقدم للآخرين، وكيف نقدّم ما نقدمه.
ويمكن أن نورد أهم المميزات البارزة التي تَلفت الأنظارَ في تحليل القرآن للأفراد والجماعات كما يلي:
1- مراعاة المصالح الفردية والاجتماعية.
2- جُرِّدت التحليلاتُ من الأشخاص، ولم يُنظَر إلى الأفراد بأسمائهم بل بخصائصهم وصفاتهم.
وبهذه الطريقة تم تسجيل قُبحِ تلكَ الأوصاف مع التمويه -نوعًا ما- على الأفراد بين ذويهم، وعلى المجتمع ضمن محيطه من المجتمعات الأخرى.. وهكذا يكون القرآنُ قد دلَّ الفردَ والجماعةَ إلى الطريق المؤدي بهم إلى المثاليّة، دونما أن يُشعرهم بشيءٍ من الضيق والحرج.
3- مراعاة آداب المعاشرة المشروعة وقواعدُها وأصولها التي تَلقَّاها المجتمع بالقبول.
4- استخدام الأساليب البَنَّاءة بدلًا عن النقد الهدَّام.
5- مراعاة مبدإ الإيجاز بأقصى قدْر ممكن، والتعبير عن القضايا بأساليب موجَزة مختصرة للغاية.
1- بنو إسرائيل في القرآن الكريم
سبق لنا أنْ ذَكرْنا أن القرآن يُحلل شخصياتِ الأفراد والمجتمعات من جهات مختلفة، وذَكرْنا أبرزَ ما في هذه التحليلات من النقاط، والأمورَ التي روعيت في ذلك.. فلنحاول تفصيل ذلك أكثر من خلال عرضِ بعضِ لوحاتٍ يتناول فيها القرآنُ أهل الكتاب بشيء من التحليل:
لعل بني إسرائيل من أكثر الأقوام الذين حلَّلهم القرآن الكريم، فإذا نظرنا مثلًا إلى سورة البقرة فقط فإننا سنجد فيها مادة وفيرة تتعلق بهذا الموضوع.. فيا تُرى، لماذا ركز القرآن إلى هذا الحد على هؤلاء القوم؟! وإذا كان كلام الله يخلو من كل ألوان الإسراف، فما الحكمة أو الغاية من كل هذا الإسهاب؟
بادئ ذي بدء نقول: إنه ليس هناك أيُّ فرق -لا من حيث العقلية ولا من حيث الطبيعة- بين تلك الجموع التي تَحدَّث عنها القرآن الكريم وبين الحشود المتغطرسة غير المتسامحة في عصرنا؛ فلذلك إذا نظرنا نظرة ثاقبة إلى القرآن فسنرى فيه -بكل سهولة- صُوَرَ متغلّبي ومتغطرسي عصرنا، وإذا تفحّصْنا هؤلاء المتغلّبين والمتغطرسين في عصرنا فسنشاهد فيهم أولئك المتعصبين الذين يتحدث عنهم القرآن، فما ذكره القرآن من الأحكام قبل أربعة عشر قرنًا لا يزال معتبَرًا ينطبق على أمثالهم.
نعم، إن المفاسد الاجتماعية والإدارية والسياسية والعسكرية والثقافية بل والدينية التي جرت طوال التاريخ الإنساني تستند في أساسها إلى بعض الأفكار المتعصبة والعقليات المتعنّتة؛ فالرأسمالية جَعلت العالم بأسره سُوقًا لصالح الإمبريالية، والشيوعيةُ صارت وسيلة إلى تفشي الفوضوية على وجه الأرض، والعنصريةُ جَعلت الشعوب معادية لبعضها البعض، والنوازع والشهوات أصبحت ألهة تُعْبَد.. كل ذلك نتائج لتلك الفكرة المتفلتة والمنطقِ المتحرر عن كل القيود.. فالكثيرون ممن ظهروا واكتسبوا الشهرة في العصور الأخيرة -بالأخص- من أمثال “دوركايم (Durkheim)” و”فرويد (Freud)” و”ماركس (Marx)” و”سارتر (Sartre)” و”إنجلز (Engels)” وغيرهم ممن سارت بذكرهم الركبانُ في مجال تخصُّصاتهم، هؤلاء كلهم من أبناء هذا الفكر المتفلّت الذي لا يَعرف أيَّ ضوابط وقواعد.
فالكثير من الأنظمة التي أنتجها هؤلاء -وعلى رأسها الرأسمالية والشيوعية والفاشية والنازية- قد ظلّت في فترات مختلفة تُفْسِدُ الموازين الاجتماعية، وتَجرّ المِلَلَ نحو الانقراض في بنيتها الداخلية، وتحوّلهم في نظرة الشعوب الأخرى إلى أعداء.. وفي نهاية المطاف حوّلت الدنيا إلى بحر من الدماء.. وها هي النتيجة: الحرب العالمية الأولى والثانية باعتبارهما أبرزَ مثالٍ وأوضح دليلٍ على ما نقول.
فمن هذه الناحية نرى أن القرآن الكريم ينبّه سائرَ الناس مرارًا وتكرارًا ويدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه بعض الجماعات والأشخاص الذين يحاولون إغفال الإنسانية، ويُذْكُون نيران الفتنة، ويستبيحون كل شيء في سبيل مصالحهم المادية.
ولا يذهبْ هذا ببعض الناس إلى القول بأن الله تعالى يُسهب بالكلام في حق بعض الفوضويين ويَلفت إليهم الأنظار ويروِّج لهم.
إن الله قد أرسل إلى هؤلاء العديدَ من المرشدين والمصلحين -وعلى رأسهم أولو العزم من الرسل- حتى يدعُوهم إلى الصراط المستقيم، ولكنهم لم يُعِيروا انتباههم لتعاليم الأنبياء الذين أُرسِلوا إليهم، حتى إن منهم من قَتلوا بعض الأنبياء وأذاقوا بعضهم صنوف التعذيب التي تنوء عن حملها الجبال، فما يفعله القرآنُ هو تنبيه الناس وتحذيرهم تجاه هؤلاء الأشرار الذين لم يتَّبعوا الصراط المستقيم رغم كل ذلك.
وما نراه -في الواقع- مما يجري من الأحداث في الساحة السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية يصدِّق القرآنَ ويدل دلالة واضحة على مدى مصداقية هذه التنبيهات والتحذيرات التي كررها.
فأمثال هؤلاء الناس الذين لم يزالوا منذ أزمان بعيدة يتناولون كل شيء في إطار منافعهم ومصالحهم الشخصية، قد أَرجَعوا كل شيء إلى المادة، وبحثوا عن كل شيء في المادة.. وهؤلاء -الذين انحصرت عقولهم في عيونهم- على درجة من العمى جعلتهم لا يرون شيئًا سوى المادة.. وهم بخصوصيّتهم هذه صاروا ممثّلين للاستغلال في كل أنحاء العالم.
فهؤلاء قد بالغوا في تبنِّي الفكر المادّي إلى مدى بعيد، وانسجموا مع العقلية المادية، بل إنهم حاولوا فهم الأمور المعنوية أو تفسيرها بالمادة، ومن بين هذه الأمور المعنوية ذاتُ الباري؛ فالقرآن الكريم والكتبُ السماوية الأخرى تَذكُر أن صاحب هذه العقلية كان ينتصب أمام نبيّه بأداءٍ وَقِح فيقولُ: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/55).. فهذا الادعاء والطلب من السمات المميزة لهؤلاء.
وهذه العقلية هي التي تشكِّل الفكرة الأساسية للمدارس الفكرية والإدارية من أمثال الفلسفة المادية والرأسمالية واللادينية والوضعية.. وفي هذا الإطار، نجد أنه لا فرق بين هذه المقولة التي قيلت لنبي من الأنبياء، وبين ما قاله “جاجارين (Gagarin)”
الذي صعد القمر في القرن العشرين؛ حيث كان يقول: “إنني صعدت إلى السماء أبحث عن الإله فلم أجده” حاشا وكلا! فهذا هو ممثل العقليةِ المادية، صاحبُ الروح المنحطّة الذي “انحدر عقلُه إلى عينِه”، وهو كذلك الوقح الذي لا يعرف اللهَ ورسولَه والذي يقول: ﴿أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/153).
ومن الممكن أن نرى تأثير هذه العقلية في تركيا اليوم، وكم يحزّ في النفس أننا نُحِسُّ بتأثير هذه العقلية وثقلِها الكامل -حتى- في بعض الأمكنة التي هي دُورٌ للعلم والمعرفة.
نعم، ما أشبه الليلة بالبارحة! حيث إن هناك عددًا غير قليل من الأساتذة والطلاب الذين يقولون: إننا لا نرى الله! ولذلك لا نؤمن به.
وحتى نستوعب جيدًا تحليلات القرآن لهذه المسألة، وفضحه لنواياهم وأفكارهم وتصوراتهم، وتشريحهُ لها شريحة شريحة، وللاطلاع اطّلاعًا تامًّا على ما تنطوي عليه نفوسهم وقلوبهم من الفساد والمرض والأدران.. لا بدَّ من العيش بين ظهرانيهم، بل أن نكون مثلهم.. فلذلك لا أظن أنه من الممكن الاطلاع التام على كنه معنى الآيات المتعلقة بهم من دون أن يكون الإنسان مثلهم أو واحدًا منهم.
وبعد هذه المقدمة التمهيديّة نقول: إن هناك حاجة للتنبيه إلى بعض الوقائع التي جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين أُرسِلوا إليهم، حتى يمكن التوصّل من خلال ذلك إلى تحليلاتٍ وتقويمات أخرى حول طبيعةِ هؤلاء بدرجةِ علمٍ قد تصل إلى علم اليقين.
فمن المعلوم أن بني إسرائيل ظلوا يَرزحون زمنًا طويلًا تحت ظلم فرعون؛ فكان هذا الظالم يستخدم جموع الناس في أشق ألوان الأعمال، وكثيرًا ما كان يَقتل رجالهم ويَستبقي نساءهم في ذلّة ومهانة، لكن الله نجَّاهم بواسطة أنبيائه من هذا الظلم والمذلة والهوان، فأخرجهم إلى بيئة يرتاحون فيها، ووسطٍ يعيشون فيه بِحُرية، حتى إنهم عندما عوقبوا في تيه الصحراء كانت تأتيهم موائدُهم بالمنِّ والسلوى اللَّذَيْنِ كانت تَعجز أيدي أكثرِ الأمم تحضُّرًا وثروةً عن الوصول إليهما.
فكانت هذه وأمثالها من النعم التي باتت تنصبُّ من عالَم الغيب إلى آفاق أنبيائهم جُزْءًا طبيعيًّا من حياتهم اليومية.. فهم من هذه الناحية كانوا في بُلَهْنِيَةٍ من العيش المليء بالسكينة والسعادة، إلا أنهم -وخاصة المنحطون منهم الذين تأصلتْ في نفوسهم العبوديةُ والخضوع لأوامر الغير- لم يدركوا قيمة ما هم فيه من الحرية، فتمردوا على الأنبياء وبالتالي على الله، وأصبحوا يحِنُّون إلى أيامهم التي عاشوها تحت ظلم فرعون، ويطلبون من أنبيائهم الخضار والبصل والثوم والخيار والعدس وغير ذلك مستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير… ومن المحتمل أنهم لم يكونوا يعرفون غير هذه المواد الغذائية.
وما حصل منهم إنما كان انعكاسًا لما قد تأصَّل في نفوسهم من العبودية وكفرانِ النعمة؛ لذلك استبدلوا المن والسلوى بما تعودوا عليه في الماضي من الخضار والبصل والثوم وغير ذلك. فالقرآن الكريم في سياق الحديث عن الأمور التي تنمّ عما تنطوي عليه نفوس هذه الجماعة من الكفران يقول: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/61).
فمِن باب تحليل الطبائع من خلال هذه الواقعة التاريخية نستطيع القول:
إن الإنسان قد يعتاد خوارق العادات ويألفُها إذا عاش في جوٍّ قاتل للألفة والأُنْس، فلا يعجبه أي شيء، فتَفقد الخوارقُ سرَّها ومميزاتها عنده، فيتطلع إلى المزيد من النعم مهما كانت.. حتى إنه في كثير من الأحيان قد لا يتساءل هل هذا التطلع صحيحٌ أو خاطئ؟! فكما في المثال الآنف الذكر: إن بعض الناس على الرغم من أنهم نَجَوا من ظلم فرعون وأصبحوا يتمتعون بالراحة ورغد العيش، نراهم لم يأخذوا هذه الحال بنظر الاعتبار بل أخذوا يطلبون -تعنُّتًا وعنادًا- ما كانوا يتناولونه من الطعام والشراب في سالف الأيام.. وما هذا إلا كفران بكل معنى الكلمة، ولكن -كما سبق أن أشرنا إليه- قد لا يُدرِك الإنسانُ في مثل هذه الحالات مدى فداحة ما يرتكبه من الأخطاء.. فمع أنه لم يكن لموسى أيُّ دخل في وقوعهم في هذه الحال وإرغامِهم على الاستمرار في صحراء التيه على مدى هذه السنوات الطوال، إلا أن بعضًا من أولئك الذين لم يكونوا يعرفون آداب التعامل مع النبي، كانوا قد اتخذوا موقفًا سلبيًّا من سيدنا موسى وكأنه هو المتسبب في ذلك.. وإلا فكيف يمكن تفسير سبب قولهم: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾.. الآية.
أجل، إنهم ما كان لهم أن يتصرّفوا تجاه سيدنا موسى الذي تَسبب في جلب هذا الكم الهائل من النعم إليهم لو لم يعتقدوا في بواطن نفوسهم أنه سبب من أسباب تيهِهِم.
والحقيقة أن الذين خاطبوا سيدَنا موسى بمثل هذه التعبيرات الفظّة كانوا -حسب بيان القرآن- بفطرتهم من الجاحدين الناكرين للجميل.. ولقد جاء أناس على غرار هؤلاء الجاحدين للنعمة إلى النبي يطلبون من أموال الصدقة، فقالوا له: “أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، فأعطِنا من الصدقة”.
فالقرآن الكريم في سياق الكشف عن شخصية هؤلاء الذين كانوا يمنون على النبي يقول: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورة الْحُجُرَاتِ: 49/17)، فهذا يدل على أن مثل هؤلاء الناس ليسوا منحصرين في قوم سيدنا موسى.
ويمكن أن نستخرج من كلام هؤلاء الذين كانوا يطلبون من سيدنا موسى الثوم والبصل ونحوها حكمًا عموميًّا كما يلي:
إن كل إنسان بشكل عام يألف الظروف المعيشيّة التي يعيش فيها ويستأنس بها بعد مدة، ولكنه يبدأ من بعد ذلك بالبحث عن أمور جديدة ويجري وراءها؛ فمثلًا إن الإنسان الذي يخوض حياة المدن الرتيبةَ التي تجري على نسق واحد، يتمنى أن تكون له بساتين وحدائق وحقول يحرثها ويزرعها ويحصدها ويسقيها ويرعاها.. فإذا حصل على هذه الإمكانات، إذا به يطلب بعد مدة أشياءَ أخرى، وهكذا تتوالى طلباته إلى ما لا نهاية، فهذه المشاعر هي انعكاس لما جُبل عليه الإنسان من المَلَلِ تجاه الأمور الرتيبة.
ولنرجع إلى ما نحن بصدده، فنقولُ:
إن سيدنا موسى قد ردَّ على هؤلاء الذين توجهوا إليه بمثل هذه المطالب قائلًا:
﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/61)،
إلا أن عقوبة الله لهم على ذلك كانت أشدَّ؛ حيث تُواصِل الآيةُ قائلةً: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/61).
نعم، إن القرآن الكريم يَلفت الأنظارَ إلى هذا الحدث ويلقي الأضواء عليه، وعند إشارته إلى الطرق المؤدية إلى الإنسانية الحقيقية يتطرَّق بين فينة وأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأوصاف التي لا بد للإنسان أن يتّسم بها حتى يكون إنسانًا حقًّا، فالمهم في هذا الأمر هو أن يَقْدِرَ الإنسان على النظر إلى القرآن من هذه الناحية، ويستخرجَ منه الدروس والعبر اللازمة، وأهمُّ من ذلك أن يستطيع نقله إلى واقع الحياة العملية.
2- المترفون في القرآن الكريم
إن المشاعر والانفعالات التي تجيش وتفيض في فطرة الإنسان، لا تزال تتنقل من مَسيل إلى آخرَ، في تناسُب مع سَيْر حياته؛ فما يلاقيه الإنسان في واقع حياته العمليةِ من الشدائد، والمسرّات والأفراح، والمصائب والمحن له تأثيرات عميقة في مشاعره، والحياةُ التي تنقضي في راحة ورغد تورِث الإنسانَ -بطبيعة الحال- بعضَ المشاعر الخاصة التي قد تتسبّب أحيانًا في الكبر والغرور، فتُسقطه إلى مهاوي الردَى.
إن الإنسان عندما تغمره النعم ويَقضي عيشه في اللذائذ، يطلب المزيد ويبحث عن الجديد؛ لذلك تراه يَشد الرحال ويخوض الأسفار بحثًا عن الملذّات والأذواق. أجل، إنَّ سفر الإنسان عبر السفن العابرة للقارات، وركوبَه البر والبحر والجوّ متّجهًا لبلاد بعيدة، ومشاهدتَه لخيرات الدنيا ومحاسنها المادية، قد تُكسِب روحَه وعواطفه الكثير الكثير من الأذواق والملذات.. فإذا كان هذا الإنسان يمتلك من سعة أفق التفكر ما يستطيع به أن يحلِّل ويركِّبَ ما يشاهده من المحاسن والجمال، فسيكون لهذه السياحة لذّة لا تعلوها لذة، فالمحاسن التي يشاهدها الإنسان في معرِض الكون، وما تثيره هذه المشاهد فيه من الانطباعات، تصبح أذواقًا فتنصبُّ في أفق التفكر الإنساني.. فمثلُ هذا التفكر الذي يرتبط بالتوحيد الخالص يفتح ممرات التفكر بين الصنعة والصانع، فكما يُلاحَظ، إن لمثل هذه الرحلات فوائدَ لا تُحصى على حياة الإنسان المادية والمعنوية، ويحتاج جسم الإنسان وعالَمُه الداخلي بين فينة وأخرى إلى هذا النوع من الأسفار.
ولكن هناك مِن بين من يخرجون إلى مثل هذه الرحلات مَن لا يتكلّفون عناء التحليق في آفاق التفكر، ولا يلاحظون العلاقة بين الأشياء وخالقها، وبالتالي لا يبحثون إلا عن الأذواق الدنيوية والبدنية.. فهؤلاء يختارون في رحلاتهم أرقى وسائل السفر، وإذا كانت هناك سيارةٌ حديثةُ الصنعِ لا يلتفتون إلى قديمها.. فهؤلاء الذين نستطيع أن نسميهم “رجال البدن” ينفقون باهظ الأثمان في سبيل الحصول على أعلى درجات اللذة، ويحاولون تسخير كلِّ إمكاناتهم من أجل التمتّع بالحياة.
ولا شك أن كل لذة في هذا العالم تنتهي بألم، وأنّ كلَّ عمل يُقصد منه اللذة والذوق فقط؛ فإنه في نهاية الأمر كثيرًا ما يجلب الألم، وهناك طريق وحيد للتخلّص من هذا الأمر، وهو أن يبذل الإنسان غايةَ الجهد في سبيل التحليق في آفاق التفكر، ليصل إلى الصانع عبر المصنوع، ويضيفَ إلى جانب الملذات البدنية قيمةً إضافية إلى عالَمنا الفكري والروحي -وبالتالي- إلى عالمنا الأخروي، فإذا أضفنا إلى هذا أساسين من أسس الإسلام: الصبر والشكر، فإن الأمر يتحوّل بالكلية إلى مصدرٍ للربح؛ بمعنى أننا إذا قابلْنا الملذّات التي نعيشها بالشكر، وتَحلَّيْنا بالصبر إزاء ما نعانيه من البلايا والمصائب، فإننا سنفوز بالدارين، وستأتينا مُتَع الدنيا راغمة.
وفي هذا المقام أشعرُ بالحاجة إلى الحديث عن أمرٍ آخر، حتى أرسمَ لوحة فكريّة وتصوّرية تساعد على الدخول إلى أعماقنا، فلنتصورْ أن لكم أرضًا زراعية في غاية الإنتاجية؛ وقد زرعتم فيها القطن وأشجار العنب، فحلَّت البركةُ فيها وأخذت تنمو وتزيد.. ولكم في هذه الأثناء أحلامٌ وآمالٌ مستقبليّة تعقدونها.. فمثلًا: ما زلتم تحلُمون باستثماراتٍ ستحقّقونها من وراء الأرباح التي ستجنونها من محاصيل هذه الأراضي.
فمن أجل ذلك أخذتم تتجوّلون بين هذه الأراضي بجولات مكوكية؛ أحيانًا بِنفسيةِ “رجال الشوق والطرب”، وأحيانًا أخرى بحالة من الغرور.. وقد يؤدّي بكم هذا الأمر إلى أن حالتكم الروحية تُخيِّل لمن ينظر إليكم وكأنكم أنتم الذين أمررتم من خلال عيدان أشجار الكرْم اليابسة ذلك الشرابَ الحلوَ، وكأنكم أنتم الذين أسستم تلك العلاقة بين الإشعاعات الشمسية وبين الغازات التي تُصْدرها تلك العِيدانُ، وأنتم الذين حققتم هذا التركيب السُّكَّريَّ.. في حين أنه لم يتحقق شيء من هذا بالأعمال التي عملتموها في هذه الأراضي.. بل إن الله هو الذي أَعطَى كلَّ هذا بفضله وإحسانه، وليست أعمالُكم إلا عبارةً عن معالجات صحيحة أو خاطئة تَعملونها في تلك الحقول والكروم التي تَفَضَّلَ الله بها عليكم.
فلو بدت لكم سُحُبٌ محمَّلة بالأمطار وبروقٌ لامعة ورعودٌ مُدَوّية مبشّرةً بالغيث، فإنكم في هذه الحالة التي تغمركم فيها مشاعر الفرح بخير المطر سترتجف أفئدتكم خوفًا من كارثةٍ محتمَلَةٍ يحملها هذا الجوّ المخيف، وسيُثير كلُّ برقٍ لامعٍ في جوّ السماء آلافًا من العواصف والأعاصير في قلوبكم.. فهذا الوضع سيزعجكم كلّيًّا وسيؤرّقكم ويقضُّ مضجعكم، وفي نهاية الأمر تقلّبون النظر مرةً إلى السماء وجوِّها ومرة أخرى إلى مزارعكم وكرومكم، وتبدؤون بالتفكير: كيف أنَّ حَبَّاتِ البَرَد الشديدةِ النزولِ، ستقلب أحلامَكم رأسًا على عقب؛ حيث إنه قد تتدمر المزارع كلّيًّا أو جزئيًّا بسبب المطر الشديد أو البرد القارس ومن المحتمل أنْ تحدُث في هذه الأثناء تقلُّباتٌ في الأسواق، وتنشطَ السوق السوداء، ويَعقُبَ ذلك تعاطي الرشوة، ويتفشّى الفساد، وتزدادَ العلاقاتُ غير المشروعة، وقد يصل الأمر إلى أبعد من ذلك، فقد سرى هذه التقلبات التي تحدُث في المجال التجاري إلى كل المجالات السياسية والإدارية والأخلاقية على حسب طول هذه الفترة أو قِصرها، وقد تمتد تأثيراتها أعوامًا طوالًا، بل قد ينجرف المجتمع إلى حافة الانهيار.
ولنتابعْ مع القرآن الكريم ما حاولنا إيضاحه هنا من عملية تطبيق التحليل النفسي للمشاعر التي أَبطَرَها الترفُ والراحة والرخاء؛ فالآية في سورة يونس تَرسم اللوحةَ المتعلقة بهذا الموضوع كما يلي:
﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/22).
ولنلقِ الضوء على النقاط المتعلقة بما نحن فيه، ونركّزْ على المعاني اللازمة بشيء من التفصيل:
﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي إنه هو وحده الذي يتيح لكم المجال حتى تسافروا بوسائط التنقل في البر والبحر والجو من أمثال الحافلات والسفن والطائرات وغيرها.
﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾ أي تخيلوا أنكم تسافرون عن طريق البحر، والبحرُ هادئ، وهناك ريح طيبة وأنتم فرحون بهذا الوضع، وبالأحرى إنكم في حالة نفسية وكأنكم أنتم الذين وضعتم قانون “طاقة الطفو للماء”، وقانون السباحة، وقد بلغتْ بكم الغفلة آفاقًا أوهمتكم بأنكم أنتم الذين خلقتم كل أنواع هذا الجمال الرائع الذي تشاهدونه في نشوة، وكأنكم ستخَلَّدون في هذه الملذات المتعددة المتنوعة.. والحال أن هذه الحالة، شأنُها كشأن سائر الحالات الدنيوية، نوع من الابتلاء والامتحان.. وبالفعل سترون أن الابتلاء يقرع الأبواب:
﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ أي إذا بعاصفة هوجاءَ تجتاح كل شيء وتُبعثِرُه، وأمواجٍ هائجة هائلة تهجم من كل الأطراف وتحيط بالسفينة.. ففي ذلك الحين تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويتحوّل الفرح إلى ترح، ويَترك الضحكُ مكانَه للبكاء، ويخضع الجميعُ لحالة من الهلع والارتباك، ويصبحون حائرين لا يدرون ماذا يفعلون!
﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وأخيرًا بعد لَأْيٍ، أصبحوا يظنون أنهم قد حوصِروا من كل الأطراف..
ففي مثل هذه الحالة التي تسقط فيها كل الوسائل الدنيوية والأسباب المادية، لا يبقى هناك من شيء سوى التوسّل بالله الذي هو مسبِّب الأسباب وخالقُها.. وهذا من مقتضيات الطبيعة الإنسانية أيضًا.. فهم كذلك يفعلون، ولكن تَوجّهَهم هذا يشوبه شيءٌ من النقصان؛ حيث إنهم يقولون:
﴿لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾، أي إنهم حتى في هذه الحالة الحرجة يسيئون الأدب مع الله، فيشترطون عليه شروطًا… إلا أنهم حينما ينجون من هذه النائبة، يتناسَون هذا الشرط.
فهيهات هيهات! إنهم ليسوا بمخلصين في مشاعرهم ولا صادقين في كلامهم؛ إذ لو كانوا صادقين في الحقيقة لما كانوا على ما هم عليه قبل حلول المصيبة، وبالتالي فإن دعاءهم هذا أيضًا ليس صوتًا نابعًا من أعماقهم بل صوتٌ جاء مما حاق بهم من الهلاك.
فهذه الآيةُ رغم مرور قرون على نزولِها تخاطِب أهل عصرِنا الذين أَبطرَتْهم الراحةُ والرخاء، فتُحلِّل ما هم فيه من الحالة النفسية، وتُجَلِّي بوضوحٍ أنَّ ما يقولونه في الحالات الحرجة ليس إلا تمتماتٍ غير مخلصة وغير صادقة، وتُحذّرهم في ثنايا السطور وترشدهم بأسلوب في غاية الوضوح.
وعلى هذا الخطّ نفسِه، يدلّنا القرآنُ الكريم في آية أخرى على الوجه الحقيقي للدنيا، فيؤكِّد أن ما يَحصل عليه الإنسانُ أو يَفقده من الأمور الدنيوية بالغفلة والحرص والطمع وغير ذلك ليس من الأمور المهمة، بل إن المهم هو التوجّه إلى الحياة الأبدية.
فهاك خلاصة لما يحتوي عليه هذا الرسم:
﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
(سورة يُونُسَ: 10/24).
إن فقدان الإنسان فجأةً لِما يتمتع به من الشباب والثروة والمنصب والأُبَّهة وأمثالِ ذلك إنما يُشْبِه حال الإنسان حينما يأتي مطر شديد في وقت الحصاد فيَذهب بكل ما زَرَعَه، أو يفاجئُه مرض فيَصْدِمه وهو في قمة ملذاته البدنية والجسمانية.. فهذه الأمور كلها ألوان من التنبيهات الإلهية.. والحقيقةُ هي أن هذه الأمور تُهَيِّئ الإنسانَ للآخرة، وتُطْلعه على الوجه الحقيقي لما تَؤُولُ إليه الأشياء التي يتم الحصول عليها في الدنيا.. حتى لا يموت الإنسان روحيًّا بالملذّات الدنيوية، بل يظلَّ في بحثٍ دؤوبٍ عن الأمور الأبدية.
ففي أثناء بحثه هذا سيكون قوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/25) دليلًا ومرشدًا حقيقيًّا له.. وبهذه الآية التي تدعو إلى الأمل تنبعث الحياة مرة أخرى في أصحاب المشاعر المتهالكة والأرواح الميتة؛ الذين تعرضوا للخزي والهوان.
و. نماذج بَشرية مختلفة في القرآن الكريم
1- الشخصية المتمرِّدة
إن القرآن المعجزَ البيانِ حينما يحلل الأحداث في بيانه النوراني لا يستهدف شخصًا بعينه بل يورد نموذجًا تشخيصيًّا عامًّا يكون محور التحليل ليصل الهدفُ للمخاطبين، فمثلًا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ [أي الذين تَجاوَزوا الحدَّ فأهدَروا حياتهم التي هي رأس مالهم] مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/12) يَعرِض نماذج التصرّفات والأفكار وأنماطَ الغرور التي يمكن أن تنطبق في كل الأحيان على كل إنسان بشكل عام.
فإذا تنبَّهْنا قليلًا فسنلاحظ أن الآية الكريمة لا ترسُم لنا هذا الشخص أو ذاك بل إنها ترسم وتسجّل لنا خاصّيّةً من خاصّيّات الإنسان على إطلاقه، وتتحدّث بأسلوب رائع عن نفسيّة الإنسان وهو في تلك الحالة.
أجل، إن الإنسان إذا أصابه أيُّ مكروه: بأنْ تُوفِّي ابنه أو ابنته أو زوجه، أو أصيبت أرضه ومزارعه بسوء، أو انقلبت أوضاعه وأعماله واتجهت تجارته نحو البوار، أو أوشك على فقدان منصبه وموقعه.. فإنه يظل يدعو ويناجي ربه.. فهو وإن لم يلهج لسانه دائمًا بالدعاء القولي، فإن وجدانه يردّد دعاءه بالأمور نفسها، ولا يبرح يفكّر فيها، ويُطْلِق مِن أعمق دواخله صرخات التضرع إلى ربه ليخلّصه مما هو فيه.
فإذا ما رفع الله تعالى عن الإنسان ما أصابه من المصيبة والضرر، ووضع عن كاهله ذلك الحِمل الثقيل؛ وألبسه ثوب النجاة وتاج القبول من جديد، ونظَّم له أموره ووضعها في مسارها الصحيح، إذا بهذا الإنسان نفسِه يتّخذ موقفًا مختلفًا تمامًا، ويتغيّر وكأنه لم يتعرّض للمصائب من قبلُ ولم يفتح أَكُفَّ الضراعة ولم يتلهّف إلى المولى سائلًا متذلّلًا.
وعلى هذا المنوال نرى القرآن في سياق رسمه لحالةٍ نفسيّة أخرى يقول: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/83).
فالقرآن يصوّر هنا شخصية الإنسان الذي حباه الله بنعمته وإحسانه ولكنه يتنكر للخالق ولنعمه وكأن الأسباب هي التي منحتْه هذه النعمَ أو كأنه هو الذي خلقها.
والحقيقة هي أن هذا النمط من الإنسان الذي تحدَّث عنه القرآن الكريم يرمز إلى شخصيّة رأيناها ويمكن أن نلتقي بها ونراها في كل العصور. نعم، إن عدد أولئك الذين يقولون في معرض الحديث عمّا أوتوا من النعم: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (سورة القَصَصِ: 28/78) ليس بالقليل.. وكثيرًا ما نسمع هذا النوع من الكلمات في عصرنا هذا، وهي كلمات نابعة من أفكار فرعونية ونمرودية، وهي تعبيرٌ عن كفرانٍ وجحودٍ فظيع تجاه نِعَمِ المولى، ونسيانٍ لحضرةِ مسبِّب الأسباب، وغفلةٍ عمن أسدى كل النعم التي يتنعّم بها الإنسان، ويتحدّث القرآنُ بعباراته النورانية عن شخصية أخرى بقوله: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/83).
والحقيقة أن هذا أيضًا من صفات الكافر.. وقد لا يَشعر الإنسانُ بهذا في أول وهلة، ولكنه إذا تأمّل قليلًا وأمعن النظر في الآية، فإنه سرعان ما يفهم مِن وراء هذه التعابير شخصيةً فرعونيةً متمرّدةً على المولى؛ فاليأسُ شعارُ الكافر وصِفةٌ لازمة له. أجل، فالذي تتحطّم آماله وينهدُّ عالَمُ أمنياته وينقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض لأدنى ضرر، ما هو بذي إيمانٍ صلب ولا يقين متين.
فمِن خلال التعبيرات القرآنية العميقة التي مرت بنا في الآيات التي قدَّمْنا نماذجَ منها نلاحظ أنه قد صُوِّرَتْ شخصياتُ أولئك الذين يعيشون المدَّ والجزر في عوالمهم الداخلية، ورُسمت ملامحهم، بحيث إن الذين يُحسنون استخدام عقولهم مع قلوبهم، ويستمعون إلى مشاعرهم وصوت ضمائرهم، ويستطيعون مشاهدة قصة حياتهم التي تمر مِن أمام خيالهم وكأنها شريط سينمائيّ سيشاهدون نصاعة البيان القرآني في رسمه للشخصيات، وسيقولون بكل كيانهم: ما هذا إلا كلام الله، وليس غير.
فـ”الشخصيات العامة” التي يرسمها القرآن ويسجلها بتعبيراته العميقة لها أهمية كبيرة أيضًا.
وأحيانًا نرى أن القرآن أثناء رسمه لشخصيات مختلفة يضعنا أمام شخصية مصابة بداء الرياء وجنون العظمة، فيتحدّث لنا بتعبيراته المعجزة، في بضع كلمات عن هؤلاء بأسلوب رائع فيقول: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (سورة الْمُنَافِقُونَ: 63/4).
فالقرآن يرسم لنا هنا شخصية طبيعة متقلّبة عائدة لشخص متلوّن؛ فهذا الشخص يكون في البيت بلونٍ، وحينما يكون بين الناس يظهر بلون آخر، فيتقلب هنا وهناك.. فأصحاب هذه الشخصية يحسبون كل صيحة عليهم، ومهما ظهر على حالهم من أبّهة يرتدونها زورًا، ويتصنّعون بها أمام أعين الناس، فهم في الحقيقة “إنسيُّون” ذَوُو طِباع شيطانية.. وهم من الجبن بحيث إنهم إذا سمعوا صوتًا خفيفًا، أو صيحةً، أو أرعدت السماءُ أو أبرقت، فإن مرارتَهم تكاد تتفطّر من الخوف، فلا يستطيعون إخفاء حالهم هذه وسرعان ما ينكشف حالهم وينهتك سترهم ويَشْعُر بهم مَن حولهم.
ولننظر: كيف يفضح القرآنُ قبحَ حالهم فيقول: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/188).
وكما يُفهم من الآية، فإن هؤلاء هم الذين يحبون أن يُحمَدوا بما فعلوه، كما أنهم يحبون أن تُسنَد إليهم الأمور التي لم ينجزوها.. فهدفُهم وهمُّهم وغايتُهم الوحيدة من عملهم “الخير” هو أن يَحظَوْا بالمدح والثناء على ما فعلوه وما لم يفعلوه، ولذلك لا تؤثِّر أقوالُهم ولا تَحظى بالقبول الحَسن لدى الرأي العام.
ومن جانب آخر هناك شخصية أخرى على خلاف هؤلاء، يراها القرآن لائقةً بالمدح والثناء؛ وهي شخصية رجال المحاسبة والمراقبة الذين عزموا على ألّا يُمدحوا بما فعلوه، ناهيك عن تمدّحهم بما لم يفعلوه، فالقرآن الكريم يلفت الأنظار إلى صورتهم في موضع آخر قائلًا: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/146-147).
ولقد حظيت هذه الأدعية بالقبول بدرجة كبيرة، حيث إننا نلاحظ أن كثيرًا من المحتسبين المضحين في مختلفِ مراحلِ التاريخ الإسلامي كانوا يَدعون بهذا الدعاء؛ فعلى سبيل المثال كانوا يقولون:
“اللهم لا تُرِني ذلك اليوم الذي ستُجنى فيه ثمرات هذا الجهد الذي أبذله، واجعلني لا أرى أيام البيدر التي تُحصد فيها المحاصيل وتداس وتذر في الهواء.. اللهم إننا جاهَدنا في سبيلك ففلَّتْ أيدينا وكُسرت أجنحتنا، ولم يبق في أجسامنا مقدارُ درهم إلا وقد أصابه سهم أو رمح أو رصاص، ولم يمض علينا يوم إلا وقد أدير بنا في المحاكم، أو طُبِّقت علينا صنوف التعذيب، أو مَثُلْنا أمام المحاكم والنيابات.. ولكني أدَعُ كلَّ هذه الأمور جانبًا، فإن كان ولا بد أن يرى المظلومون ثمارَها، فأبعدها عني ولا تُرني إياها! ولا تُذِقْني ثمراتِ سعيي في الحياة الدنيا، بل أحتسبه عندك يوم القيامة فادَّخِرْه لي عندك، واقبض روحي يوم يفيض كرمك على عبادك ويتنزل إحسانك عليهم، حتى لا يعرفني مَن بعدي وكي لا يطّلع على عملي أحدٌ غيرك، ووفِّقني للخدمة الإيمانية، واجعلني خادمًا للقرآن والإسلام، ولكن لا بد لأصحاب الكهف من قطمير، فاجعلني قطميرًا للمجاهدين في هذه الفترة من الزمان!”.
نعم، إنه يقول هذا، لأنه لا يرضى أن يختلط عمله الصالح مثقال ذرة بالرياء والسمعة، بل ترتعد فرائصه من أن يتورَّط في أوحال الأفكارِ والمقولات التي تفوح منها رائحة الشرك الخفي من أمثالِ: “إن راية الإسلام رفرفرت في كل بقاع الأرض بفضلي أنا”.
وفيما يلي نماذج من الشخصيات التي مدحها القرآن:
إن سيدنا عمر لما حدّثته نفسه بالشهادة، إذا به -وهو الخليفة العظيم- يناجي نفسه قائلًا: “وأَنَّى لك الشهادة يا عمر؟!” .
نعم، إن هذه هي الشخصية التي يقصدُها القرآن ويُرغِّب فيها، وإذا كان هذا هو مطلوب القرآن ومقصودُه فلا بد للذين يعتبرونه مرشدًا ودليلًا لهم أن يكونوا متشبِّعين بهذه الأفكار والمشاعر.. وهؤلاء هم فرسان الخدمة الذين لا يتمدحون بما أَنجَزوا ولا يحبون أن يُحمَدوا على ذلك، وهم بسجاياهم العاليةِ أبطالُ هذا الخط المستقيم.
وحينما يَعرِض القرآن أمام أنظارنا طبائعَ عامة الناس وأوصافَهم بأسلوب خاص، فإنه إلى جانب ما يظهره من ذمٍّ للشخصيات المرائية العجولة ذات الوجهين، يَعرض شخصيّاتٍ اهتدوا، ويُثني عليهم ويَرسم أحوالَهم وأطوارهم، وحالاتِهم الروحيةَ والقلبية، وانسجامَهم الإيماني داخليًّا وخارجيًّا، بل إن القرآن الكريم يزيد الصورة وضوحًا فيَذكر حياتهم التي قضوها كـرجالٍ للاتزان والتوازن، لتتبيّن طبيعة المؤمن الصادق وشخصيّة المسلم الحقيقي.
وفي الفقرات التالية توضيح لهذا الأمر على النحو التالي:
2- الشخصيات التي حظيت بالهداية
إن بلاغة القرآن الكريم في تصوير طبائع الشخصيات المهتدية وتكوينها العام، وتقديمها بأوصافها الأساسية في وضوح تام تجعل من يقرأ الآيات المتعلقة بها يحس في داخله تجاهها بإعجاب بالغ، بل إنه يشعر في قلبه بشوق ورغبة في تمثل تلك الشخصيات بما فيها من الأوصاف.. والأوصافُ الأساسية لهذه الشخصيات هي إيمانها بالله واليوم الآخر، وتنظيمُها حياتها وفق ذلك الإيمان.
وحينما يستمع الإنسان إلى حديث القرآن الكريم عن أولئك الأبطال من أولي العزم، أو يقرأ الآيات القرآنية المتعلّقة بهم، فإنه يشاهد بوضوحٍ وجَلاءٍ كيف أن أولئك العظماء سبقوا عصورهم وسمَوا على أزمانهم.. فهؤلاء الذين اتسمت تصرفاتهم بالوقار والجدية ظلوا طوال حياتهم يحملون أوجاع قضيتهم التي عشقوها، ومن سُعد بالتعرف عليهم عن قرب، فإنه سيشعر كأنه يشاهد اصطفاف أهل السماء خلفهم.. كيف لا؟! وهم الذين سَبقوا إلى تلبية نداء النبي الذي جاء بحياة جديدة وقضيةٍ جديدة ورسالة جديدة، حيث إنهم لما دعاهم النبي إلى الحق والحقيقة، قالوا، مِن دون تردد: “آمَنَّا”.
فهناك لوحة مختلفة من القرآن حول الموضوع: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/193).
فإذا حاولنا أن نتابع بخيالِنا هذا الكلامَ والمشهدَ الذي من ورائه، فلا شك سنشعر وكأن هناك مناديًا يتجوّل بيننا ينادي إلى الحق والهداية، وفي هذه الحالة ستسمو أرواحُنا فلا تتوجس خيفة من الموت، بل تعيش حياة جديدة وتَرْقى إلى أن تصبح وكأنها تشاهد من الآن ذلك اليومَ النوراني الذي تبتسم فيها لحُسْن طالِعها، وأنتم في قصور تجري من تحتها الأنهار وتسمق فيها الأشجار، على سرر متقابلين بوجوه ضاحكة مستبشرة. بل إننا نشعر من الآن في أعماق قلوبنا بالعالَم الذي نلقى فيه ذلك المولى المتعالي الذي خلقَنا وأرسلَنا إلى هذه الدنيا، وسخر لنا كل شيء، فنهتف بهذا الدعاء الذي يتفجّر من أعماق أفئدتنا قائلين: “ربنا إننا سمعنا مناديًا كان يطرق الأبواب بابًا بابًا حتى نفوز بالسعادة، وكان يُفسّر لنا الوجود وما وراء الوجود، فآمنا به!”.
أجل، إن من يؤمن بالله فسيكون شعوره كذلك بلا ريب، فالله يرسم لنا في هذه اللوحة نموذجًا لـ”المؤمن” الذي يَحذَرُ الآخرة ويَظهر على ملامح وجهه آثارُ ذلك الحذر، ويخطو كلَّ خطواته على حسب الآخرة، ويحمل دائمًا مسؤولية الإيمان.
ولنصغِ إلى أنفاس تلك الأرواح المحتسِبة المتواضعة غاية التواضع، والتي تَحمل وجدانًا عميقًا يحاكي وجدان أولي العزم، حيث يستقبلوننا بهذه الكلمات: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة الْحَشْرِ: 59/10).
فما أسمى علوّ جنابهم، ومروءتهم! حيث إنهم لا يَحصُرون دعاءهم في أولئك المؤمنين الذين هم رفاق دربهم، بل إنهم يُشرِكون في تضرعهم ويشملون بدعائهم هذا أولئك الذين ساندوا القضية نفسها وخدموا حقيقة الإسلام قبل قرون.. أجل، إن هذا من أروع نماذج الوفاء.
والحقيقة أن هذا الكلام الذي قاله هؤلاء بروح أولي العزم يحمل في طياته المعنى الآتي: “اللهم إنك أنت الغفار فلتسعنا مغفرتك ولتسع من سبقنا بالإيمان فهم لهم السبق فلا تحرمهم من مغفرتك فهم الذين أسّسوا هذا الأمر وبذلوا الجهد في إبلاغ هذه القضية إلينا فاشملنا كلّنا بعفوك”.
فهكذا يستجيب من يحملون روح أولي العزم لنداء ربّهم ونبيّهم.. وهكذا يكون الإنسان الذي يحمل هذه الروح حيث يقف بين يدي ربه ويدعو لنفسه ولرفاق دربه ولكل المؤمنين الذين تعلقت قلوبهم بحب الإسلام، ويتضرعُ إلى الله تعالى بأن لا يجعل في قلبه مثقال ذرة من غلٍّ وحقد تجاه المؤمنين، ويسألُه تعالى أن يحبِّب إليه كلَّ من آمن به ويبعدَه عن الممقوتين لديه.
فهذا هو التصوير القرآني لروح أهل العزم وللقلب الذي تَوجَّه إليه تعالى توجُّهًا تامًّا.
وبالمقابل تعالوا بنا لنشاهد هذا النمط الإنساني المرائي ذا الوجهين، كيف يصوره القرآن: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/8).
فهذا النمط الذي يصوره القرآن، يَبدو وكأنه من المؤمنين، ولكنه إذا رجع إلى جماعته وانفرد بأعوانه، يقول قولًا مغايرًا تمامًا، فما قوله: ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ إلا من الخداع فما هو بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر؛ فمثلًا قد نلاقِي عددًا غير قليل من الناس في النوادي، أو الشارع أو السوق يقول أحدهم: “أنا أيضًا أومِنُ بالله”، أو يقول: “كان والدي شيخًا عالمًا بالدين”، أو “كان جدّي حافظًا لكتاب الله” أو “كانت جدتي تصلي الخمس”، أو غير ذلك من الأقوال والادعاءات التي لا قيمة لها؛ لأن المهم والأساس هو وضع الإنسان ذاتِه وليس ما كان يفعله أسلافه.
أجل، ليس المهم أن يكون والدُ الإنسان شيخًا، بل المهم هو مدى ما يحمل بين جوانحه من الشوق والحماس تجاه نشر الإسلام.. إنَّ كون الإنسان ابنَ فلان وعلان لن يَعني شيئًا، كما أن كونه ابن الشيخ الفلاني أو الحاج الفلاني لن يعود إليه بأي فائدة أخروية.
إن هذا النمط من الناس ليس بصادق وما هو بمخلص بتاتًا في قوله: “آمنا”.. وما ذلك إلا تظاهُر بالإيمان وتغطية للكفر من خلال تعداد الأقارب، وهذا هو عين النفاق والمراءاة، وقد بين الله هذا النوع من الناس بقوله: ﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/143).
وليس لهؤلاء المرائين وِجهة ثابتة.. ولأنهم ليسوا مثل الشجرة التي ضَربت بجذورها في الأرض وسَمقت قامتُها وتفرعت أغصانها في السماء، فليس لها أن تأتي بالثمار قطعًا. فهم يعيشون في حدود الزمن الضيق، همُّهم أن يَقْضوا يومهم في إشباع نزواتهم وشهواتهم.. وليس لهم ثباتٌ على أي أمر، بل هم مثل الحرباء يتلوّنون بألوان مختلفة، ويتحولون من مكان إلى آخر على حسب مصالحهم.. فتراهم في هذه الجبهة مرة وفي تلك أخرى؛ وفي صفوف المؤمنين أحيانًا وبين الكافرين أحيانًا أخرى.
فهذه الأمور التي يتحدّث عنها القرآن في بضع جُمل لو أننا حاولنا شَرْحَها في صفحات عديدة لما تَسنَّى لنا ذلك على وجه كامل.. وقد بيَّن القرآن في بضع كلماتٍ هذا النمطَ الذي حاول علمُ النفس الحديثُ بيانَه في ألف صفحة، ورغم هذه المحاولة فقد جاء ناقصًا مبتورًا وخليطًا من الخطإِ والصواب.. نعم، إنها بضع كلمات ولكنها تكفي لأن تُصوِّر طبيعة الموضوع بكل تفاصيله، لكأن السامع يُشاهد كل أحوال المنافق وأطواره في صورة متكاملة ماثلةً أمامه.
3- شخصية المجادل بغير علم
وفي سياق حديثه عن الطبائع العامة، يتحدّث القرآن عن شخصيّة من أكثر الشخصيات التي نلقاها في أيامنا هذه، ولا تقلّ أهمية عن تلك الشخصيات الأخرى، يقول الله تعالى: ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/66).
أجل، إن المجادلة بغير علم من أخطر أمراض عصرنا؛ حيث إن الجميع يُدلي بدلوه في جميع القضايا وبخاصة في القضايا الإسلامية، مع أنها من أكثر الأمور التي تتطلب التخصّص.. فمثلًا من تلقى تعليمًا في أي مجالٍ على مستوى الشهادة الثانوية، فعليه أن يتحدّث على حسب مستواه.. فمن لم يكن متخصّصًا في مجال الطب أو الهندسة فلن تُتاح له فرصة الإدلاء برأيه فيهما ولو بكلمة، فكل علم له من يتكلم فيه من أهل الاختصاص، إلا القضايا الإسلامية، فالكل يخوض فيها ويقول كل ما يدور بباله. أجل، حين يدور النقاش حول قضية إسلامية ترى الجاهل ينبري لها فيحلل القضايا اللغوية ويُصدر الأحكام.
فالقرآن يذم وينتقد هذه الشخصية قائلًا: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ (سورة الْحَجِّ: 22/8).
فهذه هي شخصية أخرى من الشخصيات التي عرضها القرآن وقدمها للأنظار في بيانه وأسلوبه المعجز الذي لا يُجارَى فيه، ونحن من خلال هذه الموازين القرآنية نستطيع أن نميز بين كل واحد من هذه الشخصيات، ونصْدِر حكمَنا فيها، ففي هذا المجال أيضًا يُثبت القرآن الكريم لمن يستمعون إليه أنه بأسلوبه البديع هذا ليس بكلام بشر بل هو كلام الله.
4- شخصية المتعلق بالقرآن
إن القرآن الكريم حينما يركز على شخصيات الذين تعلقت قلوبهم بالإسلام، واتخذوا قضيةَ الإيمان والقرآن قضيتَهم الكبرى، يلفت أنظارنا إلى ما يبذله هؤلاء من جهد يفوق حدود التصوّر حتى يحيا الإسلامُ بين أهله كرة أخرى، وكي ينتشرَ الإيمان وروحُ المحبة وترفرف رايتهما في كل مكان، فالمشهد في بداية الإسلام كان هكذا تمامًا؛ ففي حين كان الناس عمومًا يعيشون حالة من العشق والشوق والحماس نحو قضية الإسلام، كان هؤلاء يتجرعون مرارة هذا الشوق والحماس في دواخلهم حتى النخاع، واستطاعوا ببذلهم للمال والملك أن يحافظوا على حيوية روح الجهاد لديهم.
ففي مثل هذا السباق كان أمثال سيدنا أبي بكر يأتون بكل أموالهم ويضعونها في سبيل الله، وحين يُسألون: “ماذا أبقيت لأهلك”، كانوا يقولون: “أبقيت لهم الله ورسوله” .. وكان لسيدنا عمر أيضًا مواقف بطولية قريبة من هذا (رضي الله تعالى عنهم ملء السماوات والأرض).. بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا يقفون في التضحية عند حدود المال فقط، بل كانوا يجودون بأرواحهم أيضًا.. وكان هناك من لا يستطيع أن يشاركهم في سباقهم هذا، ويظل يرى ما يحصل دون أن يقدر على الإنفاق لكنه في قرارة نفسه وفي أعماق فؤاده يتمنى المشاركة في السباق بكل ما يملك، ولكنه لا يجد ما ينفق فلا يملك إلا دمعة تفيض من عينيه حزنًا أن لا يجد مالًا ينفقه في سبيل الله.
والقرآن الكريم يصف لنا هذا المشهد، ويذكر لنا ما تطفح به قلوبهم من مشاعر التشوق إلى الإنفاق قائلًا: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/92).
فكأنما يُقال للرسول : “يا حبيب الله، إن هناك جماعة لا تعرفهم، لا يملكون شيئًا لينفقوه، وكانوا يراقبون من الخارج، فينظرون إلى مَن في الداخل فيشاهدون وضعهم.. فكان من الحريّ أن ترى حالهم وكيف يَرجعون إلى بيوتهم وهم يسكبون الدموع جرّاء حزنهم على عدم الإنفاق”.. وهكذا كان القرآن يمدحهم ويذكُرهم بخير.
ولو تعمّقنا في الموضوع بشكل أكثر لربما كان بإمكاننا أن نشاهد هؤلاء ماثلين أمام أعيننا، وهم يَرجعون إلى منازلهم كئيبين كاسفي البال يحاولون أن يبرِّدوا حرارة قلوبهم بما يسكبون من دموعهم التي تنحدر وكأنها حبات لؤلؤٍ متناثرة على خدودهم.. أجل، لو أننا استطعنا أن نخوض بتصوُّرنا وخيالنا غمار التعبيرات القرآنية، لَاستطعنا أن نتلاقى مع هذه الشخصيات التي مدحها القرآن، بمشاعرهم وأفكارهم، ولَأحسَسْنا بكل ما لديها بدفءٍ بالغٍ.
ومن الشخصيات التي يصورها القرآن الكريم وهي تتمتّع بروحِ أولي العزم هي شخصيّة “أصحاب الإرادة” الذين ظلوا يقاومون سيولَ البلايا والمصائب الجارفة، ولم تنثنِ عزيمتهم أمام الأحداث، وظلوا صامدين أمام الكفر والظلم مثل الجبال الراسيات؛ حيث يقول الله تعالى فيهم: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/173)، وكأنه يضعهم في مستوًى مُساوٍ لأهل السماء.
أجل، فحينما يُقال لهؤلاء: “إن الناس قد اتفقوا ضدكم، وسيقابلونكم كل يوم بفخ جديد، وسيضعون قوانين جديدة، وسيضايقونكم، وسيتجوّلون بكم من محكمة لأخرى، وسيذيقونكم أسوأ أشكال التعذيب لاستنطاقكم، وسيفعلون بكم أفاعيل لم تخطر على بالكم، ويضيّقون الخناق عليكم”؛ فسيقابلون كل هذا متبسمين غير مُبالين.
أجل، إنه لم يزل هناك عصابة مُفسِدة ومثيرة للفتن تُجابه مَن يخدمون في سبيل الحق، وتقول لهم مثل هذه المقولات؛ فكما قيل هذا للسابقين في عصر السعادة (العهد النبوي والخلافة الراشدة)، قد قيل مثل ذلك في العصور التالية وسيقال لكل اللاحقين.
فقد يؤسّس البعض فيما بينهم تحالفاتٍ سرّيّة، ويُصدِرون ضدهم قوانين وتعليمات، وقد يريدون أن يُغرقوا روح الخدمة وهي لا تزال في بداية نشأتها.. وبالمقابل سيقول المؤمنون بصوتٍ موحَّد نَدِيٍّ مليء بالإيمان مفعم بالرضا والتسليم لله: ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾.
فنحن أيضًا انطلاقًا من هذه الأفكار إذ نُحسّ في أعماقنا ما عاناه وقاساه المعانون في هذا السبيل بدءًا من سيدنا إبراهيم الذي قُذف في نار نمرود، إلى سيد الأنبياء -عليه وعليهم الصلاة والسلام- الذي مُرّغ رأسُه بالتراب ورُشق بالحجارة، وبُصق في وجهه المبارك.. نستشعر أمام أسلوب القرآن الرائع الذي يقص علينا تلك المَشاهد بأنه ليس إلا كلام الله، ونزدادُ يقينًا بذلك، وتمتلئ قلوبُنا بمشاعر الإعجاب.
5- الشخصية المتفكرة
إن للشخصيات المتفكّرة موقعًا مهمًّا بين الشخصيات التي حظيت بثناء القرآن؛ فهؤلاء ينسجون كلَّ جزئية من حياتهم بأعمق المشاعر والأفكار، ولا يُضيعون أيَّ جزء من الزمان الذي هو عبارة عن خطٍ اعتباريٍّ يمرُّ عليهم، بل يستثمرونه أبلغ استثمار.
﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/191).
أجل، إن هؤلاء الذين زيّنوا حياتهم بالتفكّر، يَدْأَبون على التفكّر في حال قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم، ويُمعِنون النظر بعمقٍ في العلاقة بين الخالق والمخلوق، ويفتحون أشرعتهم صوب الأزلية في سبيل الوصول إلى معرفة الصانع.. وينظرون بعين العبرة إلى خلق السماوات والأرض وما بينهما من التناغم العجيب والتوازن الكامل، وبفضل هذا التفكر يصِلون إلى نتيجةِ أنه ليس في الوجود شيء ولا هدف ولا غاية من دون مالك.
وهم ينتقلون من حيرة إلى حيرة تجاه الكون الزاخر بالخوارق بدءًا بالسماء وما فيها من الكيفية المذهلة لمختلِف الأنظمة والمجرات السماوية، وانتهاءً بالأرض وجميعِ ما عليها من الأمور التي تنطوي على الحكمة والمصلحة والفائدة، قائلِين: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ بمعنَى أن في كلِّ شيءٍ تجلّيًا للحكمة وطريقًا يوصل إلى الحق تعالى، ومِن بعد ذلك يتوجهون إليه بالدعاء قائلِين: ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.
وحينما يتحدّث القرآن عن هؤلاء يَلُوح لنا في نظراتهم نَمَطٌ إنساني يكتب على كل جزء من الوقت الذي يمر علينا اسمَ المولى .. نمطٌ لا يُضيِّع أيَّ جزءٍ من وقته، بل يضفي على كل آنٍ يعيشه روحًا، وبذلك يتمتع بحياة تمر كل حين نابضة بالحياة، ويعرِّف “أينشتاين (Einstein)” الزمانَ بأنه “خط اعتباريٌّ”، ويقول بأن الزمان ليس له وجود في حدّ ذاته، بل هو بُعدٌ ذو أسرار للمكان.. إلا أن شريط الزمان الذي ليس له روح ولا وجود حقيقي، يكتسب الحياةَ بفضل المؤمنين الذين يَنقُشون على كل جزء منه المعانيَ المتعلّقة بالله.. ويتحول بفضل إيمانهم وعملهم إلى مشهد متعلق بالعالم السرمدي.
إن عَرْض القرآنِ لهذا النمط وتصويرَه له ببيانه الخالد وأسلوبه العذب لَيَسحرُ العقول ويأخذ بالألباب؛ ويجعل القلب المؤمن في غاية السرور، وإن الذي يَرقى إلى هذا المستوى يملأ الشوقُ قلبه ومشاعره وحماسه وتفكُّرَه وتذكُّرَه.. فإذا بك تراه يتعمق في كل آية من آي القرآن، فيحاول تذوُّقها باعتبارها “كلام الله”، فيبدأ يَشم بكل كيانه رائحةَ الجنة التي أتى بها القرآن.
ز. الدروس التي ينبغي على المؤمنين أن يستخرجوها
1- تعرُّف المؤمن على ذاته
وفي هذا الفصل سنحاول -ولو قليلًا- بيان مدى أهمية ما سردناه إلى هنا مما في القرآن من تحليل الشخصيات.. فكما هو معلوم لدى كلّ من يتفكّر ويعيش حياته متفكّرًا، أن إنسان اليومِ قد أصبح خارجَ عصره فتأخّر من ناحية الشعور والإدراك والفكر.. فهذا المستوى من اللامبالاة قد أدى بالمؤمنين إلى حالة من الشعور بالغربة عن أنفسهم
وعن بعضهم؛ وكما يقول الصوفية فإن الذي لا يَعرف نفسه ولا يَعرف ذاتَه وجوهره ليس بالإمكان أن يَعرف غيره ولا ربه، وبالتالي فلن يمكن له أن يؤسّس بينه وبين خالقه علاقة على المستوى المطلوب.
إننا حينما شرحنا بعض الآيات وحللنا فيها بعض الشخصيّات، لم نسرد بعض الأحداث التاريخية ولم نذكر أهلَ الكتاب ولا ما فعلوه بأنبيائهم بهدف إثارة مشاعر الكراهية والبغضاء تجاههم؛ بل إننا حاولنا انطلاقًا من هذه الشواهد أن نسبُر العالَم الداخلي لأولئك الذين مرت بهم هذه الأحداث وننبشَ عن فراغاتهم البشرية، لعلها تكون عبرة لأمثالهم الذين يعيشون في عصرنا.. وإلا فنحن نؤمن بعدم جدوى نقل الأحداث التاريخية بغرض اتخاذها وسيلة لإثارة الحقد والكراهية والبغضاء.
إن الإنسان عليه أن يتعرف قبل كل شيء على نفسه، وأن يتعرف -بالأخصّ- على جانبه المعنوي؛ فهذا من أهم العوامل التي تؤثّر على نظرته للأمور والأحداثِ، بل إنني أستطيع القول: إنه مَهما قطع المؤمن شوطًا كبيرًا في صلاته وصومه وحجه وسائر عباداته، ومهما زاد منها من الناحية الكمّيّة، فإنه لا بد له من المنافذ التي تطل على عالمه الداخلي حتى تتحقّق له الاستفادة الكاملة من كل العبادات، فالعبادات بمفردها لا تفي بالغرض الروحي والسموّ اللدني.
أجل، إن المؤمنين التقليديين الذين ليس لهم معرفة بالعوالم اللدنية، وليس لهم عمق إيماني لن يجنُوا ثمراتِ عباداتهم على الوجه المطلوب؛ فمثلًا لو طافوا بالكعبة صباحَ مساءَ ولم يستطيعوا أن يطوفوا حول أعماقهم الداخلية عند طوافهم حول الكعبة فلن يجنوا ثمرة طوافهم على الوجه المطلوب، وبناء على ذلك فإننا نجد الكثيرين ممن يطوفون حول الكعبة يطوفون كأجساد جامدة أو جثث هامدة، والقليلون يطوفون بقلوبهم ومشاعرهم.
بل إننا قد نشاهد هذا الوضع بالفعل حول الكعبة، حيث إننا نرى هناك أمورًا كثيرة عظيمة عند الله ولكن يُستهان بها هنالك كالاختلاط، وبالمقابل هناك أمور هينة عند الله ولكنها تُعظَّم هنالك؛ فترى البعض يرتكبون المعاصي أثناء الطواف، وينتهكون عددًا كبيرًا من المحرمات والمكروهات في سبيل أمر مندوب.. وإذا أخذنا بالاعتبار أن المعاصي والذنوب التي تُرتكب هناك تتضاعف فإن الأمر يزداد خطورة وهَوْلًا.. وقد يكون هناك من يدعي أنه لا مفر من اختلاط الرجال بالنساء، ولكن من الممكن إيجاد طرق عدة بديلة تُبطل أمثال هذه الادعاءات.
وما مباشرةُ الحرام في الكعبة أثناء العبادة التي يُتقرب بها إلى الله، إلا دليل على البُعد عن الله تعالى؟! ويمكن أن يُقال هذا القول نفسُه في سائر العبادات؛ من الصلاة -بالأخص- والصيام والزكاة والإنفاق في سبيل الله وغيرِها من صنائع المعروف وسُبُل الخير.
ولعلّنا نلاحظ أن الحياة القلبيّة فينا وبخاصة في العصور الأخيرة قد خمدت وانطفأت جذوتها، وأَهمَل الإنسانُ -كليًّا أو جزئيًّا- الإنصاتَ لنفسه ومراقبتها ومشاهدةَ عالَمه الداخلي، بل يمكن أن يقال هذا القول نفسُه في حق التكايا والزوايا، مع أنها كانت من الأماكن المباركة التي كانت تبعث في نفس الإنسان روحَ الحماس الديني، وتبثُّ فيها الحيَويَّةَ، وينطلق فيها الشوقُ والعشق للغاية الأسمى.
ولذلك لا بد لنا من أن نكون على وعي تام بواقعنا الذي نعيش فيه ونحملَ على كاهلنا مسؤولية إنعاش هذه الروح وبثِّ هذه الفكرة في المجتمع من جديد.. لأنه ينبغي أن تكون القضية الأساسية هي أن يتعرف الإنسان على عالمه الداخلي ويتعمّق في لدنياتِه؛ فإن الإنسان الذي خمدت لدنياته، ناهيك عن إحساسه بالبعد عن الله تعالى، سيكون فاقدَ الوعي بالكلية.. فيا لَله، ما أفظعها من طامة كبرى؟!
فانطلاقًا من مثل هذه الأفكار، أرَدْنا أن نُعيد الحديث عن بعض التحليلات القرآنية للشخصيات، لعل ذلك يساعد أولئك الذين يريدون أن يكتشفوا ذواتهم ويَعرفوا أنفسهم ويتعرّفوا عليها حتى يتسنى لهم تحليلُ أنفسهم وذواتهم.
أجل، إن الذي لا يدري شيئًا عن ذاته ويكونُ غريبًا عن آفاق المعرفة الإلهية، ولا يعرفُ الغاية من خلقه، فلا مفرّ له من أن يتخبط في حياته الفكرية والقلبية ويرتكبَ الأخطاء الفادحة واحدةً تلو الأخرى.. ومن يدري، لعل الذي يقضي حياته لا يحمل مسؤولية كهذه، سيضرّ دنياه وآخرته.. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يَعرف نفسه أوَّلًا، وأن يكونَ سائرًا في طريق الكمال دائمًا، وأن يحافظ على حالته هذه وكأنما يرابط على ثغور الوطن يحرسُه من هجوم الأعداء، علمًا بأن كِلا الأمرين من الأمور التي حث عليها الإسلام.
ولنفصِّل هذه الفكرة في ضوء هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، حيث يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/200).
فقوله تعالى: “اصْبِرُوا” يأمرنا بالصبر، وقوله تعالى: “وَصَابِرُوا” يأمرنا بالمصابرة؛ فكأنه يقول لنا: ليوصِ بعضُكم بعضًا بالصبر والثبات، وبتعبير آخر: ليشارك بعضكم بعضًا في حالة السرور والحزن، وإذا كان أحدكم جريح الفؤاد ومهمومًا والآخرُ معافًى فليقاسم أخاه همَّه وغمه، فينبغي للمؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يكونوا عونًا لبعضهم
في كلّ الأحوال.
وقوله تعالى: “وَرَابِطُوا” أي ترصَّدوا المنافذ التي يُتوقّع منها الخطر، ولا تدَعُوا الفرصة لأعدائكم المادّيين والمعنويين حتى لا يتسللوا إليكم سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.. وكونوا بالمرصاد لشتى أنواع الفساد التي تُفسد حياتكم الفكرية أو الذهنية أو القلبية أو الروحية؛ فمِن البدهي أنه ما إن يتسلط الفيروس على جسمٍ فرديٍّ أو اجتماعي إلا ويهزُّ كيانه ويُعرِّضه للتفكك والتمزق، وتَفسُد كلُّ القيم المادية والمعنوية على المدى القصير أو البعيد، ويبتعد المجتمع عن هويته الذاتية، وتتخلخل كلّ موازين المجتمع.. وفي مجتمع كهذا تحصل دوامات الفوضى الرهيبة، وتتوالى حركات التمرّد، وتدوي أصوات الانقلابات في كل الجهات، ثم تتوالى الخلافات والنزاعات وموجات الفساد، فتتعرض الدولة والشعب لانحلالات هدامة لا تقاوَم.
ففي مثل هذه الحالة التي يمكن أن نعتبرها بداية لمثل هذه النتيجة سيظهر أن هناك ثغرات في باب القيم التي تتعلق بـالملة والدين.. فمن هذه الناحية لا بد من الحفاظ على الكيان الفردي والاجتماعي بنفس مستوى الحفاظ على الثغور وحدود الوطن.. والحقيقة أن تاريخنا القريب مليءٌ بالأمثلة على ذلك؛ وأعتقد أن السبب الأساس الذي يَكمُن وراء انهدام الدولة العثمانية التي حملت راية الإسلام على مدى عصور، هو أنها انخدعت بحِيلِ وألاعيب أعدائها في الداخل والخارج، فابتعدت عن قيمها الدينية.. وما أشبه الليلة بالبارحة! ففي العالم الإسلامي الذي يفوق المليار نسمة لا يَعرف الفردُ المسلم ذاته، وإذا استثنينا بعضَ الأفراد فإنَّ جموعًا غفيرةً لا تزال بعيدةً عن الحياة القلبية والروحية والحسية.. والحياة إنما تَكتسب المعنى بفضل الوعي والإدراك، وإذا لم يكن لدى الإنسان وعيٌ وإدراك على هذا المستوى فمن الصعب جدًّا تسميةُ حياته “حياة”..
وأما الحياة الأخرويّة لهؤلاء فهي كلها دمار، والقرآن الكريم يصف هؤلاء بأنهم
﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/98)؛ فهم قد عاشوا في الدنيا من دون شعور ووعي، ولم يستطيعوا أن يؤسّسوا علاقة مع الوجود وما وراء الوجود، ولم يروا ما يجري حولهم من الأمور البارزة أو الخفية، وظلوا بعيدين عن التفكّر والتذكّر.. وباختصار: إنهم لم يستطيعوا أن يستغلوا الفرص والإمكانيات التي منحهم الله إياها استغلالًا حسنًا، و-إن صحّ التعبير- فقد عاشوا مثل الجمادات أو الخشُب المسنّدة، وحسبَ قاعدة: “الجزاء من جنس العمل” سيعاملون في الآخرة معاملة الحطب.. فكأن قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/98) يفسّر لنا هذه الحقيقة.
والخلاصة: أنه ينبغي على الإنسان أن يَعرف نفسه، ويبذل الجهد في سبيل فهم العلاقة الموجودة بينه وبين الكون بكلّ أبعاده، ويتعمّق في اللدنيّات، لعله يصل إلى نقطة الكمال التي قُدِّرت لكل إنسان، فإذا قُرِئَ القرآن بتدبر، فإنه يَمد لقارئه يدَ العون في هذا الإطار، ويرشده الطريق، ويحدد له الوجهة. فالآية التي ذكرناها آنفًا من سورة آل عمران هي واحدة من هذه الآيات التي تشهد على ما قلنا.
2- بابُ الرجاء للقلوب الحزينة
﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/139).
إن هذه الآية نزلت بعد أُحد.. ومن المعلوم أن المسلمين عاشوا في أحد هزة مؤقتة، وحَزِنوا لذلك حزنًا شديدًا.. ومع أن هذا ليس له علاقة مباشرة بموضوعنا إلا أنني
لا أستطيع أن أنتقل إلى موضع آخر من دون إبداء مشاعري التالية:
إن ضميري لا يَرضى في سياق الحديث عن أُحد بأن تسمَّى الأحداث التي وقعت فيها “هزيمة”، ولا أن يُوصَفَ المسلمون بالمغلوبين أو نحو ذلك؛ فهناك واقعٌ ثبت تاريخيًّا أن المسلمين بعد انتهاء المعركة بيوم واحد، تتبعوا المشركين وطاردوهم إلى ما بعد حدود المدينة بكثير، فلذلك ليس من الصحيح قطعًا التعبير عن ذلك بـ”هزيمة أحد”.
وأيضًا إنني لا أرى من اللائق بنظرتنا للصحابة ومقامِهم السامي أن يقال في حقِّ هذه الواقعة التي هي من حيث الظاهر هزيمة: “إن الصحابة الذين كانوا على “جبل الرماة” عصوا أمر الرسول طمعًا في الغنيمة”.. بل الأنسب على ما يبدو لي أن يُقال: “إنهم
لم يدركوا السرّ الدقيق الذي تنطوي عليه إطاعة الأمر”.
ونعودُ لما نحن فيه فنقول: إن هذا الوضع كان قد أثَّر في نفوس الصحابة تأثيرًا بالغًا وقَلَبَ معنوياتِهم رأسًا على عقب، لأن عددًا كبيرًا منهم لم يكونوا قد شاركوا في معركة بدر التي حصلت قبل عام.. فمع أن الرسول اقترح عليهم البقاء في المدينة على أن يحاربوا المشركين “حربًا دفاعية”، إلا أن هؤلاء اقترحوا أن يحاربوا “حربًا هجوميّة”، فلما قُبِل اقتراحُهم هذا، انطلقوا إلى أُحد وهم يحملون بين جوانحهم الشوقَ لانتصارٍ كالذي حصل في بدر.. ولكنهم فوجِئوا بأمر لم يكونوا يتوقعونه أو ينتظرونه، بل عاشوا هزةً زلزَلَتْهُم وأحزَنَتْهُم؛ فقد استُشهد من الصحابة -الذين كلٌّ منهم قيمةٌ فوق القيم- سبعون صحابيًّا ، فكل هذه الهزّات كانت قد أحدثتْ فيهم هزّة عنيفة مؤقّتة أوقعَتْهم في حزن عميق.
ففي هذا الوقت بالذات جاء النداء القرآني: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/139)، فأنعشَهم وأيقظهم من غفوتهم فانتبهوا للحياة وحقائقِ الحياة.. أجل، إن الغالبية أو المغلوبية، والحاكمية أو المحكومية هي من الأمور التي تدور بطريقة تداولية حسب السنن الكونية التي وضعها الله، ولا تجري بشكل مطّرد على حسب أهوائنا، ولا تمشي في طريق مستقيم.. وبالفعل فإن أبا سفيان قد حدَّثَ سلطانَ الأنبياء بكلامٍ مِن هذا القبيل قائلًا: “يَومٌ بِيَومِ بَدْر، أَلَا إِنَّ الْأَيَّامَ دُوَلٌ، وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ، فَيَومٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا، وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَومٌ نُسَرُّ، وَحَنْظَلَة بِحَنْظَلَة، وَفُلَانٌ بِفُلَانٍ” ..
فما إن دوَّتْ هذه الآية في آذان الصحابة، حتى أَنعَشتْ قلوبَهم، فعدَّلت أفكارَهم، ووسعت آفاقَهم، وأعلمتْهم أن ما عاشوه من التشتت المؤقت ليس عبارةً عن كل شيء، وذكَّرتْهم بأنه من الممكن أن يؤدِّي النهوضُ من جديد إلى انتصارات.. ولكني أرى من اللازم التنبيهَ إلى أن الأرضية التي تنبني وتتأسّسُ عليها هذه المشاعرُ والأفكارُ إنما هي الإيمان، وإلا فمِن غير المتصوَّر أن ينتفض القلبُ الخالي من الإيمان ويدَعَ أحزانه جانبًا وينتعشَ من جديد تجاه هذه الآية وما تحتوي عليه من الحقائق.
أجل، إن هذه الآية الكريمة التي أوردناها آنفًا، تُذكِّرنا بواقع الحياة، كما أنها تُنعِش الأرواح التي سقطت في دوامة اليأس، وتلامس القلوبَ الميتة فتبثّ فيها الحياة ومن خلال السطور تَدُلُّهم ضمنيًّا على المَخرج من كل مأزق.. وإن الذي تَعلَّق قلبه بالقرآن، وآمن به من أعماق قلبه وروحه، واستَلهمَ معانيَه التي ينشرها، وأراد أن يستنشق أَرِيجَهُ الفَوَّاح؛ ليستطيعُ أن يُدرك ما قلناه ويحسَّ به ويقرأه من بين سطوره وثناياه، كلٌّ على حسب استعداده وقابليته.. وإن مَن ينظر إلى القرآن سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات فإنه بلا شك سيستطيع استشراف المستقبل الآمن والغد المشرق، فلا حياة بدون القرآن الكريم.