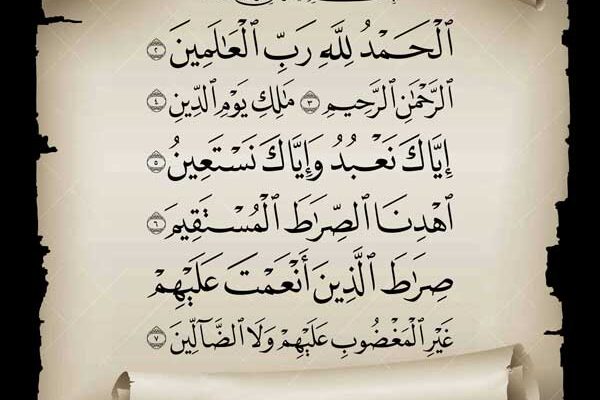إن الفاتحة تبدأ بكلمة “الحمد”، وقد استُعمل الحمد باعتبار معناه اللغويّ مرادفًا لِكَلِمَتَي: “الشكر” و”المدح”، ولكن هناك فروق كثيرة بينه وبينهما، ولذلك لم تبدأ سورةُ الفاتحة بـ ” الشكر لله ” أو “المدحُ لله”.
أ. مقارنة بين كلمات “الحمد” و”الشكر” و”المدح”
الحمد:
إن مفهومَ الحمدِ يعني: مقابلة المحمود تعالى بالشُّكْرِ على ما أسدى من النِّعَمِ باختياره ومشيئتِهِ، والاعتراف بأنه منبعُ جميعِ الخيرات التي تستحقّ الحمد، وليس بالمهم في الحمد أن تكون هذه النعم قد وصلت -بالفعل- إلى الحامد أوْ لَا… بل المهم أن يكون المحمود مستحِقًّا للحمد، فإن إظهارنا لمشاعر الثناء والتبجيل لعظمة الله تعالى وألطافه نوعٌ من أنواع الحمد.
الشكر:
وأما الشكر فهو عبارةٌ عن الثناء بالجميل لمن نشكُرُه مقابل ما أسدى إلينا من نِعَمِهِ، فهذا الثناء يكون مقابل النعمة، وكما يمكن أن يؤَدَّى الشكرُ باللسان يؤَدَّى كذلك بالجوارِحِ وبالقلب أيضًا، فقولُ الإنسان: “الشكرُ لله” شكرٌ قوليٌّ لله تعالى، والصلاةُ شكرٌ بالجوارِحِ، وإحساسُ القلب فيها بالامتنان تجاه نِعَمِ الله، أو دخولُهُ في حالةٍ من السرورِ والوجدِ والاستغراقِ مقابل هذه النِّعَمِ التي تُذَكِّرُه بأن اللهَ تعالى قد رَحِمَهُ؛ كلُّ ذلك من أنواع الشكر.
المدح:
وأما المدح فهو يُستَعْمَلُ في العقلاءِ وغيرِهم، فيجوزُ مدحُ الله تعالى، فإذا قال العبد: “اللهم إنك جميلٌ، وكل أنواع الجمال التي تتموَّجُ في الكون ما هي إلا انعكاسٌ لجَلوةٍ من تجلِّياتِ جمالِكَ”، فهذا نوع من المدح، وبالإضافة إلى هذا يمكنُ مدحُ شجرةٍ أو طعامٍ أو نحوها من غير العقلاء، ولكن قد يكون المدح أحيانا في سبيل التزلُّفِ إلى الآخرين من غيرِ ضرورةٍ تدعو إليه، ولذلك فإننا نعبر عن ثنائنا لله تعالى وعن مشاعر الامتنان تجاه نعمه بـ”الحمد” و”الشكر” لا “المدح”؛ يقول الرسول r في ذم المدح: “إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ”[1]، فيمنع من ذلك، وبالمقابل يقول: “مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّهَ”[2]، وهناك نقاطٌ مشتركةٌ تَداخَل فيها الحمد والشكر ونقاطٌ افترقا فيها وتمايزا بها.
الشكرُ علامةُ الصادقين، وقَلَّ مَن يوفَّق لذلك، قال الله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سورة سَبَأٍ: 34/13)، ونِعمُ الله تعالى لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، ويقول الشيخ “سعدي الشيرازي”، في بداية كتابه “كُلِسْتان”: إن الإنسانَ في كلِّ نَفَسٍ يجب عليه أن يشكرَ اللهَ مرَّتين، فعندما يستنشق النَّفَس شهيقًا وعندما يُطلِقُه زفيرًا، فإن الذي يمدُّهُ بالحياة مرَّتين هو الله تعالى، فَمِنَ الواجبِ عليك أن تشكرَ الله على هذه النِّعَمِ بلسانِكَ وحالِكَ وقلبِكَ، ولذلك نقول: إن الشكرَ أمرٌ عظيمٌ، وهو مقام الصدقِ والوفاءِ، فالمحافظةُ على شكرِ الله تعالى والاعترافُ بِنِعَمِهِ في كلِّ الأزمنة والأحوال هو أسطعُ برهانٍ وأنصعُ بيان على الصدق والوفاء.
أما الحمد فيقول فيه الرسول r: “اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْر”[3].
والحمدُ أعلى من الشكر من بعض النواحي؛ حيث إن الحمدَ هو إدراكُنا لعبوديَّتِنا وعجزِنا، والتعبيرُ عن امتنانِنَا وشكرِنَا تجاهَ الله تعالى من صميمِ قلوبنا، سواء وَصَلَتْنا منه النِّعمُ أوْ لا، فالحمد بِـمِيزَتِــهِ هذه يؤدَّى في مقامِ الإخلاص المحضِ، فإدراكُ العبدِ عبوديَّتَهُ وقولُه: “اَلْحَمْدُ لِلهِ” -بغضِّ النظرِ عن كمِّ النِّعَمِ الذي يُحيطُ به- يُعتَبَرُ من دأبِ المخلصين.
وإلى هنا حاولنا أن نشرح معنى كلٍّ من الحمد والشكر والمدح، والآن لنَعرض -ولو باختصار- مقامَ الحمد.
ب. مقامُ الحمد
إن الحمد هو مقام إدراكِ المنعَم عليه لعمليَّةِ الإنعام، وهذا المقامُ أعلى من مقام الاستفادة من النعمة بالفِعْلِ، لأن إدراكَ الإنعام يكون طريقًا إلى إدراكِ المنعِم، والمقام الذي وعد الله رسولَه صلى الله عليه وسلم به سمّاه عزَّ وجلّ “مقامًا محمودًا”، وفي هذا المقام تجتمِعُ “الحامدية” و”المحمودية”، ولنوضح هذه المسألة الدقيقة على النحو التالي:
إن هديةً تأتيكَ من السلطانِ تُذَكِّرُكَ بأمرين:
أحدهما: القيمة الذاتية لهذه الهدية؛ فاللذة التي يحسّ بها الإنسان منحصرةٌ في ذات الهدية…
والأمر الثاني: هو كون هذه الهدية “هدية سلطانيّة”، ومن هذا الجانب فلا يُنظر إلى القيمة الذاتية، بل المهمُّ في هذا المقام هو كون هذه الهدية “مِن قِبَل السلطان”…
فما يبعثه هذا الجانب الثاني من اللذَّةِ والمسرَّةِ يفوقُ -بِأَلْفِ مرَّةٍ- ما يبعثُه الجانبُ الأوَّلُ، فإن في هذا الجانبِ الثاني انتقالًا من الهديَّة إلى السلطان الذي أرسلَها، والمهمُّ هو هذا الجانب.
وهكذا الأمرُ بالنسبة لإنعامِ الله وإحسانه من دون فرق، وشتان ما بين الاستفادة من النِّعم وبين الانتقال منها إلى المنعِم، والشعورِ باللذة الروحانية والسكينة منها.
ج. الحمد ومفخرةُ الإنسانية سيدنا محمد
إن الإنسان “حامدٌ” وفي الوقت نفسه “محمود”؛ فهو “حامد” من حيث أداؤه الحمد للحق، و”محمود” من حيث إنه يُحمَد ويثنى عليه في السماوات والأرض، وهذه الكلمات: “أحمد” و”محمد” و”محمود” التي هي أسماءٌ لخلاصةِ الكائنات ومفخرةِ البشريَّةِ، هي أيضًا مشتقَّةٌ من “الحمد” ودائرةٌ في فَلَكِهِ.
واسمه: “أحمد” هو أول كلمة افتتحَ فيها ألِفُ كلمةِ “الله” الرمزيَّةَ إنما هي “أحمد”، ثم جاء اسم “محمد” قافيةً لشعر الكون، والكون بدأ بــالحقيقةِ الأحمدية ووصل إلى الحقيقةِ المحمّدية، فهو هناك “أحمد” وهنا “محمد”، وهكذا اكتمل شِعر الإنسانية ونظمُه وقصيدتُه.
إن الرسولَ كلما قام في حياته بالعبودية حُمِدَ، والحامد هو الله U، وكلَّما حُمِدَ زاد هو من عبوديَّتِهِ وحَمدِهِ، فجَمع بين الحامدية والمحمودية، فصاحبُ “المقام المحمود” مَظهرٌ لألطافٍ إلهيّة كثيرة، والشكرُ والحمدُ يستجلبانِ الشكرَ والحمدَ، إذ حظوةُ الإنسان بالحمدِ والشكرِ لله نعمةٌ من نِعَم الله عظيمةٌ تستوجبُ الحمدَ والشكرَ، وحظوتُه صلى الله عليه وسلم بـ”المقام المحمود” تستوجبُ شكرًا عظيمًا، وهذا الشكرُ يستوجبُ شكرًا كذلك وهكذا دواليك، فالله تعالى يقول: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (سورة إِبْرَاهِيمَ: 14/7) وهذا يعني أنه سبحانه وتعالى سيوسِّع دائرةَ “المقام المحمود”، ونحن بِدَورِنَا نقولُ عقبَ الأذان: “وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ”[4]، داعين له بالمقام المحمود، وسائلين المولى أن يوسع له تلك الدائرة على أكملِ أشكالها.
فإن صاحب المقام المحمود بيده “لواء الحمد”، والبشرية دخلت عالم الوجود بـ”أحمد”، ووَجدت نورها بـ”محمد”، وستحرِز الأمنَ والخلاصَ من العذاب بالدخول تحت لواء “الحمد”، وبفضل ذلك ستَدخُل الجنةَ ويكون آخر دعواها: أنْ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة يُونُسَ: 10/10).
والحمد بدايةُ الكون وروحُه، والحمد يدور حول ذلك المحورِ النورانــيّ الذي يتركَّــز فيه نظرُ الحق، وهذا المحورُ وهذا المركزُ هو سيِّدُنا محمد، والحمد لا يفتأُ يُعبّر عنه تعبيرًا وينسجُه نسجًا، ونحن بدورنا نرجو من الحق تعالى أن يجمعنا تحت لواء الحمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ونقل إلينا صِفَتَهُ ونعتَهُ في الكتب السالفة: “أُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ”[5]، وفي حديث آخر: “خَيْرُ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ”[6]، والحمَّاد هو الذي يَحمد الله تعالى دونما انقطاعٍ أو فتور، فعلينا أن نحمده تعالى مع فاتِحةِ كلِّ أمرٍ وخاتِـمَتِهِ.
د. كلمةٌ تملأ الميزان: الحمد لله
وفي الحديث الذي يرويه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمرُ لعليٍّ رضي الله عنهما: قد علِمْنا سبحان الله، ولا إلَه إلا الله، فما الحمدُ؟ فقال عليٌّ: “كلمةٌ رَضِيَها اللهُ لنفسه”[7]، فهذ الجواب يُعَبِّرُ عن سِرٍّ دقيقٍ مهمٍّ.
وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عمر أن رسول الله r حدثهم: “أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ-: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالَا: يَا رَبِّ إِنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: “اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي، حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا”[8].
وفي حديث آخر: يقول r: “اَلْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيزَان”[9]، والمعنى أن العبد إذا حمد الله بقلب خاشعٍ، ومَثلَ أمام الحقِّ ولهجَ لسانُه في هذا الاتجاه، وهاجَ قلبُهُ وارتعَدَ من جلالِ الوقوف أمام حضرةِ الحقِّ تعالى، فإن ذلك يكفي لأن يملأ الميزان، مهما كان ما في الكفَّةِ الأخرى ثقيلًا.
هـ. كلمة “رَبّ”
إن كلمة الربّ مصدر بمعنى “التربية”، وهي استخدمت هنا بمعنى اسم الفاعل، أي “المربِّي”، وهناك حكمةٌ ونكتةٌ في التعبير بالمصدرِ عن اسمِ الفاعل؛ أي بـ”ربِّ العالمين” بدلًا من: “مربِّي العالمين”، ومعلومٌ أنَّ التعبيرَ بالمصدَرِ يُفيدُ حصرَ الفِعلِ بالفاعِلِ، فكأنه يقال: إن المربِّي هو عين التربية، وهو المربي حصرًا، ولا تصدُر التربية من غيره تعالى؛ ومثلُه في اسم الله تعالى “العَدْل”، أي هو مصدرٌ سمَّى اللهُ به نفسَه.
إن الله هو الذي يفعل جميع ما يلزم لتربية الكمّ الهائلِ من الأنواعِ الموجودةِ على طبقات الكون وصحائفها، إننا إذا أخذنا بالاعتبار تربيةَ البشرِ فقط، فإن الذي خلقَهم وسوّاهم ثم دلّهم على الجنة هو الله، والذي عرَّفهم بجهنَّم وحذَّرهم منها، والذي أرسل الرسولَ وحثَّ على اتِّباعه، والذي دلَّ الإنسانَ على حقائق القرآن وفتحَ عينَه وقلبه، والذي تحدَّث في القرآن عن الكون، وشرَحَ الكونَ فَبَسَطَ الحقائق أمام الإنسان حتى يُعاينَها ناصعةً جليَّةً هو الله، والذي يتصرَّفُ في هذه الدوائر الكونيّة الواسعة هو الله…
إن الله هو الذي يربّي كل الكائنات؛ يربّيها مباشرة كُلًّا في حدود دائرةِ فطرتِهِ، فلن ترى أيَّ موجودٍ خارجًا عن حدود هذه التربية، والصاحبُ الوحيد لهذه التربية الكونيّة الشاملةِ هو الله ربُّ العالمين.
والذي يربّي الإنسان أيضًا هو الله… إن الحق ربّاه بأنْ شَرَحَ له طرق الهداية والضلالة، وجعلَ الأنبياء أئمَّةً الحياة الدنيويَّة والأخروية وروَّادَها، فكما هو يربِّي النبيَّ يربِّي البدويَّ، لكنْ كلٌّ على حسب قابليَّاتِهِ واستعداداتِهِ.
ولن تَصِلَ البشريَّةُ إلى الكمال الحقيقي إلا بتربيتِهِ ، والطريقُ الأرشدُ لهذا هو الاسترشاد بِهَدْيِ القرآنِ، والتربيةُ هي أن يتَّخِذَ كلُّ موجودٍ طريقَهُ نحو الكمالِ في نطاقِ حدودِهِ، والذي يوصله إلى الكمال هو الله “ربُّ العالمين”.
إن الفلسفة الموصِدَةَ أبوابها أمام الوحي تُصوِّر الموجوداتِ وكأن بينها عداءً وصراعًا، في حين يذكر القرآنُ في مناسباتٍ عدّة أن السائد في الحياة هو “التعاون”، ويُعلِّمُنا أن ننظُرَ إلى الحياة من هذا المنظورِ.
نعم، إن النواميس والقوانين السارية في الكون لَتَدُلُّ على ما فيه من “تعاون”؛ فالعناصر الجامدة تُمِدُّ النباتات، والنباتاتُ تمد الحيوانات، والحيوانات تمد بني الإنسان، وهذا في الوقت نفسه يُعتبر ترقيةً لكلِّ نوعٍ على حِدَتِهِ نحو الكمال، وإذا كان التراب يربي في أحضانه النبات وكأنه أمٌّ شفوق حنونٌ عليه؛ فكيف يمكن أن يسمَّى هذا التكاملُ صراعًا وجِدالًا!؟ لكن الفلسفة تنظر إلى القضية بمنظارٍ معكوس، فإنها تَرى هذا التعاون والإمداد كأنه قهرٌ وغصبٌ للطرف الآخر، وهذه مقاربةٌ مرفوضةٌ لا تمتُّ إلى الصحّة أو الواقعيّة بِصِلة.
إن الله تعالى يسيّر الكون والأحداث في نظامٍ وانتظامٍ عن طريق النواميس، ويسوق كلَّ شيءٍ نحو الكمال، والحكمةُ الفريدةُ التي تترتَّبُ على ذلك هي تمييزُ الخبيثِ من الطيِّب، والخيرِ من الشر، والنورِ من الظلمة، والألماسِ من الفحم، وبهذا يصير المؤمن أهلًا للجنة، والكافرُ أو العاصي أهلًا للنار، والله كما يميز في هذه الدار بين الصِّنفين، سيميز بينهما في الدار الآخرة أيضًا وسيقول: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة يس: 36/59)، وكلّ هذا يدل على أن الأمرَ الوحيد الساري في الكون هو “تربية” الحق ، والله تعالى يربي الأشياء ويُسيِّر الأحداث باسْمِهِ: “الرب”، وإن من يستطيع أن يشاهِد حال الإنسان، وكيف أنه يُساقُ إلى الكمالِ، فإنه سيَقبل هذه الحقيقة ولن يَشعر بالحاجة إلى البحث عن دليلٍ آخر.
إن الأحداث بِيَدِ الله ، وكما أن المحرِّك الأول دائمًا هو الله، فكذلك الذي يُديم تلك الحركة ويمنحُها استمراريّةً كفيلةً بإيصالِها إلى غايةٍ وهدفٍ معيَّنٍ هو الله أيضًا، فالأشياء بهذا التحريك الأول تُساقُ نحو الكمال، فلو تناولنا طفلًا -على سبيل المثال- فالذي جاء به إلى عالم الوجود ليس هو الحيوان المنويّ ولا البويضة أبدًا؛ فإن الذي خلقَ الأبوين أوَّلًا ثم طوَّرَ ذلك الولد في ظلماتٍ ثلاثٍ في رَحِمِ الأمِّ، إنما هو الله لا أحد سواه، فلا بدَّ من وجودِ تناسبٍ بين السبب والنتيجة، وليس من الصحيح قطعًا التغاضي عن هذا..
ويمكن أن نوضِّح هذا بمثال:
هبْ أنك شاهدتَ صرحًا شامخًا، ورأيتَ بجانِبِهِ ولدًا مكبَّلَ اليدين والرجلين، فادَّعى ذلك الولدُ بأنه هو الذي بنى هذا الصرح، فإنك لن تصدِّقه؛ لأنه لا بدَّ من وجود تَناسُبٍ بين الفاعل والأثر، وعلى غِرار هذا؛ فههنا الكونُ أمامنا كأنه صرحٌ كاملٌ بكلِّ معنى الكلمة، وهنا وهناك “أسبابٌ” كأنها ذلك الولد المكبل، فكما أنه ليس من المعقول أن نُسنِدَ بناءَ الصرحِ إلى الولَدِ المكبَّلِ فكذلك إسنادُ خَلْق الكون إلى هذه الأسباب العاجزة عن ذلك مُحالٌ عقلًا، فالذي خَلَقَ هذا الكون وربّاه، فساقه نحو الكمال ليس إلا الله رب العالمين، والحقيقة أننا لا نفهم كيف يصرّ المنكِرُ على إنكارِهِ، في حين أن الكونَ كلَّه من الثرى إلى الثريّا، ومن الأرض إلى السماء مشحونٌ ومزيَّنٌ بالأدلة، وكلّ الأحوال والكيفيّات تدلّ على وجود الله تعالى، فإنكارُهُ الحقَّ تعالى وعدمُ معرِفَتِهِ به رغمَ دلالةِ كلِّ شيءٍ عليه؛ هو تمرُّدٌ رهيبٌ وكُفرٌ مخيفٌ تحارُ له العقول.
فإذا تناوَلْنا مفهومَ “ربِّ العالمين” من هذه الزاويةستصير الأشياء كأنها كتابٌ يُقرَأُ.
ولو أن البشرية نظرت إلى نفسها بالمنظورِ القرآنـيّ، وأمعنَت النظرَ في كلام الله بهذا الشكل، ولو مرّة واحدةً؛ لكانت في وضعٍ مختلفٍ تمامًا عمّا هي عليه الآن، ولكانت تَفهم الكلامَ الإلهيَّ على غير ما تفهمه الآن.
ذلك هو الله الذي خلقَ الإنسان برحمته، فتدارَكَهُ بالقرآنِ نتيجةً لِرَحْمَتِهِ أيضًا، وجَعل هذا الإنسان الذي خلقَهُ على صورتِهِ[10] مخاطَبًا للقرآن الذي تتلاطمُ فيه أمواجُ رحمتِهِ، فلو أن الإنسان دقَّقَ النظرَ في نفسِهِ وفي الكتاب الذي أُرسل إليه، من هذه الزاوية وبهذا المستوى؛ لكان يحسّ على كاهِلِهِ بِثِقَلِ التكليف الذي عبَّرَ عنه الرسول بقوله: “لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا”[11]؛ ولكان يبحث أيضًا عن مكان يهربُ إليه ويختبِئُ فيه جرَّاء ما يُحسّ به من الخشية والخجل. نعم، إن نظرةَ الإنسان إلى ذاتِهِ من سماء الصفات الإلهيّة، ومن برجِ الأسماء الإلهية، من شأنها أن تجعل الإنسانَ هكذا، وإنما يتسنَّى له هذا إذا خاضَ بحارَ القرآن مثل الغَوّاص، أو حلَّق بين نجوم القرآن ورفرفَ بجناحيه.
فالإنسان من الرعيل الأول من هذه الأمة نظرَ إلى نفسه بهذه النظرة، فاكتَشف ذاتَه، فجعله الله حاكمًا على الجميع، مصداقًا لقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/30)، فكلما توجهت إليه Uالقلوبُ والعقول والمشاعر توجُّهًا كلِّيًّا تجلَّى هو أيضًا بحقيقةِ ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/105). أجل، إنه تعالى ورَّث كلَّ ما ورَّثه لعباده الصالحين، فلذلك كانت الكلمةُ المسموعة في ذلك العصر للمسلمين وحدهم.
إن الله تعالى أجرى مقابلةً بينه وبين الإنسان والكون؛ حيث إنه اتخذه مخاطَبًا، ووَضَعَ دائرة “العبودية” في مقابلِ دائرة “الربوبية”، وعامَلَهُ برحمانيَّتِهِ ورحيميَّتِهِ، وعلَّمَنا وبلَّغنا ذلك في البسملة، فنحن بدورنا نُقابِل رحمانيَّتَهُ ورحيميَّتَهُ اللانهائيّتين بـ”اَلْحَمْدُ لِلهِ”، ونقوم له بالشكر والامتنان على كل ما أسداه لنا.
و. “اَلْحَمْدُ لِلهِ” وأركانُ الإيمان
إن الجملة المقدسة: “اَلْحَمْدُ لِلهِ”، تحتوي على كلِّ الأركان والأسسِ الإيمانيّة التي يُطلبُ منا الإيمان بها، وسأوضح ذلك فيما يلي:
1- “اَلْحَمْدُ لِلهِ” والإيمانُ بالله
إن الحمد يعني وقوفَ الإنسان تجاه آثار الحقّ موقفَ الإعجاب والاستحسان، وأن يخرّ ساجدًا أمام كمالها بالحيرة والانبهار، ويَفيض محبّةً واشتياقًا تجاه جماله، ويتذلَّلَ خاضعًا مقابل إحسانه، وسبق لنا أنْ تَطرَّقنا لهذا الموضوع أثناء شرحنا الجوانب اللغوية للفظ الجلالة “الله”، ولكن قد يكون من المفيد أن نُذكِّر به مرة أخرى:
إن كلمة “الله” تنطوي على معانٍ مثل: “المعبود” و”الذي ينقاد له كلّ شيء”، و”الذي يُلجأ إليه” و”الذي يُعتَمَدُ عليه”، و”الذي يقفُ الآخرون أمام عظمتِهِ بالإعجاب والانبهار”، و”الذي يوثَقُ به ويُطمَأَنُّ إليه”، وهذا يعني أنه إذا قيل: “الحمد لله” يكون المقصودُ: نفيَ المعبوديَّةِ عن كلِّ ما سوى الله، وأنّه هو المقصودُ الأوحد، والملجأُ الـمُفْرَدُ لا سيما في أوقات الحيرة والاندهاش، وأنه هو من تُرفَعُ إليه أكفُّ الضراعة عند الحاجة.
وكذلك إذا قال القائل: “الحمد لله”، فإنه يستحضر في ذهنه: التصرُّفَ اللانهائيّ لحضرة الحقّ تعالى، ويستشعرُ الحيرة والانبهار أمام جماله في كماله، وبالتالى يخرّ ساجدًا، وينتشي مندهِشًا تجاهَ جمالِهِ، ويرى نفسَه عبدًا مغلولَ العُنُقِ مكبَّلَ الرجلين ببابه تعالى، والذي يُفَسِّرُ هذا المعنى الكبير الذي ينبثِقُ من الحمد ومن لفظِ الجلالةِ، هو “لا إلهَ إلا الله”، وكل الحقائق الكونية مندمجة في “لا إلهَ إلا الله”، وبهذه الجملة المقدَّسة يتميّز المؤمن عن الكافر، والمسلم عن الملحد، والمستسلم تمامًا لله عن الزنديق، والمخلصُ عن المنافق، فكأنَّ “لا إلهَ إلا الله” علامةٌ بها يُفرَّقُ بين أيِّ زمرةٍ وأخرى..
ولكن هناك أمر وهو أننا لن نستطيع -بذكرها بألسنتنا فقط- الرقيَّ والوصولَ إلى هذه الحظوة وهذا الأفقِ الذي ينبغي لنا إدراكه، فالحقيقة هي أن هذه الكلمةَ إذا تجلَّتْ في القلب “إذعانًا”، وفي النفس”تقبُّلًا”، وسيطرَتْ على مشاعر الإنسان، فحينذاك يُسمَّى “إيمانًا”، وإلا فكما أن الإنسانَ الذي يشعرُ بالبردِ لن يدفأَ بذكرِ مجرَّدِ النار وتردادِ اسمِها، والمسمومُ لن يتعافى من تأثير السمِّ بمجرَّدِ أن يقول: “لن يضرّني السمّ”، فكذلك الأقوال بمجرَّدِ تردادِها باللسان؛ لن تصلَ إلى مستوى الإيمان والإذعان، فالإنسان إذا قال: “لا إلهَ إلا الله” لا بدَّ أن يكون إيمانُه بأنه لا معبودَ بحقٍّ إلا الله، -على الأقلّ- في مستوى إيمانِ من يعتقد أن السمّ يقتل وأن النار تُحرِق، حتى يُعتَبرَ اعتقاده إيمانًا.
أجل، إن الإنسان عليه أن يحصر نظرَه إلى الله وحدَه وأن يُقدِّم عبوديَّتَه له وحده، فحينذاك تجتمع كلمةُ “لا إلهَ إلا الله” التي تجري على لسانه بالّتي في قلبِهِ، ويصيرُ مؤمنًا حقًّا، وأما الإيمان دون هذا الشكل ليسَ إيمانًا حقًّا، لا وألفُ لا، إنه إذا لم يتحقّق الإيمان بالله يقينًا تامًّا لا شكَّ ولا ريبَ فيه كما الإيمانُ بأن النارَ تُحرِقُ وأن السّمّ يقتُلُ؛ فلن يسمَّى إيمانًا حقًّا.
وعلينا أن نذكرَ نقطةً مهمّةً وهي: أن إحراقَ النار، وقتلَ السّمِّ ليس من خاصيتهما الذاتيّة، فحرقُ النار وقتلُ السُّمِّ من النواميس الكونيّة، والذي وَضَعَ هذه النواميس هو الله عزّ وجلّ، ولذلك فنِسبةُ الإحراقِ في النارِ إلى ذات النار، أو نسبةُ التسميم إلى ذات السمِّ؛ تُخالِفُ عقيدَتَنا وطريقَ أهلِ السنّة والجماعة، فالنار إنما تُحْرِقُ بمشيئةِ الله، حيث إنها لم تُحْرِقْ سيِّدَنا إبراهيم، وكذلك السمُّ إنما يقتلُ بمشيئةِ الله، إذ إنّ اللحمَ الذي جَعلت اليهوديةُ فيه السمَّ في خيبر قَتل بِشْرًا ولم يقتل الرسول.
وهذه الأحداثُ تدلُّ على أن الذي يخلق الأفعال وآثارَها هو الله لا غير، وكلُّ مَن يؤمن بالله يجب عليه أن يؤمنَ بهذا الأمر على هذه الشاكلة، وإن الإنسان المربوط -مادِّيًّا- بالدنيا؛ لن يرقى في مراقي السماء إلا بمثل هذا الإيمان.
ثـمّة قوّة خفيّة تدفعُ الإنسان نحو “الـمَعبَدِ”، حتى إنه في الأوقات التي لا يتمكّن فيها من العبادة يجد نفسَهُ أمام “وخزِ ضميرٍ” لا يُمكن تصوره، فكأنَّ هناك قوَّةً تدفعه أو تجذبه نحو الآفاق السامية، فهو يبحث في هذه الآفاق عن السكينة والاطمئنان، وبفضل الإيمان يسلِّم الإنسانُ إرادته وعقلَه لهذه القوة الدافعة أو الجاذبة، وسيوصله هذا “التسليم” إلى الجنَّةِ والجمالِ الإلهيِّ السرمديِّ، فهو بفضل ذلك إنسانٌ مطمئنٌّ، قد ارتقى الإيمانُ في قلبه إلى مستوى اليقين، وكما أن عالَمَـهُ القلبيَّ يكون منفتحًا على الجنةِ ومِرآةً صافيةً تعكسُ “جمالَ الله”؛ كذلك يكون بيتُه والمجتمعُ الذي تَكوَّن ويتكوَّن من أمثالِهِ ناشرًا لأريجِ العالَم الماروائيّ وشذاهُ عبقًا عبقًا.
إن مشاعرَ العبوديَّةِ مغروزةٌ في فطرةِ البَشَرِ، واللهُ خلقَ الإنسانَ في فطرةٍ وقِوامٍ يؤهِّلانِهِ للعبوديّة، ولكن الإنسانَ في كثيرٍ من الأحوالِ أساءَ استخدامَ ذلك واستعْمَلَهُ في غيرِ موضِعِهِ، فتوجَّه نحو مخلوقات لله عاجزةٍ ضعيفة لا تليق بمقامِ المعبوديّة أبدًا، من أمثال الحجر والشجر والنجوم والشمس والقمر، ونصَبَها في محراب المعبودية، فانحط من مقام العبودية لله الذي هو في أعلى علِّيِّين إلى دركاتِ الشِّرْكِ التي هي أسفل سافلين، وهذه النتيجة تُذكِّرنا بالحقيقة التي ذكرناها آنفًا، من أن العبوديَّةَ عاطفةٌ مغروزةٌ في طبيعةِ الإنسانِ وفطرتِهِ، فاختلاقُ الناس معبوداتٍ عديدةً وانحناؤهم لها إذا لم يجدوا المعبودَ الحقَّ؛ إنما هو انحرافٌ من هذه الحالة الطبيعيَّةِ ليسَ إلا.
والحالُ أن سيَّدَنا إبراهيم الذي هو رائدُ الحنيفيّة التي هي دينُ الفِطْرَةِ، داسَ -كما قصَّه علينا القرآن- على كلّ الأسبابِ والوسائلِ، ودلَّنَا على أساليب الرقيِّ إلى الله تعالى، فهو u قد أعلن على الملإِ أن هذه الكواكب المتلألِئَة والتي تُبهر عين الإنسان؛ لن تَصلح للألوهية، واستَدَلَّ على ذلك بأفولِـها، كما استدلَّ على ذلك أيضًا بِأُفُولِ الشمس والقمر، وهو إذ كان يُبَيِّنُ أن الأشياء التي تأفل لن تكون آلهةً؛كان يستخدمُ أسلوبًا ولغةً يفهمُها كلُّ إنسان على مختلف مستويات الإدراك[12].
فالبشرية كلَّما وَعَت هذا الأمرَ تمسَّكَتْ بالعروة النورانيّة التي ينطوي عليها معنى قوله: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/79)، فإنها سترتقي في الممرات النورانيّة، وترتفع إلى مقام العبودية التي هي الكمال والذروة، ولن تدرك معنى “الإنسانية” إلا بهذا الارتقاء.
ولن تَصِلَ البشرية إلى هذا المستوى إلا بفضل الأنبياء ووساطَتِهم، ففي طريقهم النوراني ينكشِفُ الغِطاء عن بصيرةِ الإنسان، ويصير كأنّه يلاقي الله ويراه، وإنما يمكن إدراك هذا السر بالعبوديّة، وهو سرٌّ يُتذوَّقُ فقط؛ لا تكتبه الكتبُ، ولا تحتوي معناه الكلماتُ والسطورُ، ويعجزُ مَن تذوَّقَهُ عن التعبيرِ عنه، وهو شعورٌ لن يَصِلَ إلى مستوى الإحساسِ به إلا القليلُ من الناس حتى أثناء تلاوة القرآن، فصاحبُ هذه الحال يشعرُ وكأنَّ الوسائط والوسائل قد انمحَتْ دونها، وتفضَّلَ سلطانُ القلوب بالنزول إلى قصره، والإنسانُ في مثل هذه الحال يعيش حالةً من الغيبوبة، بل هو في وضعه هذا يكون ناسيًا حتى لنفسه، في غايةِ الدهشة والحيرة.
والذي يعتريه مثل هذه الحال ماذا عساه أن يقول؟ وكيف يعبر عن حالته؟ فبعضهم قال: “لَا مَوْجُودَ إِلَّا هُو”، والبعض الآخر قال: “لَا مَشْهُودَ إِلَّا هُوَ”، ومنهم من قال: إني لا أشاهد في الكون شيئًا سوى تجلّيه، وكلٌّ مِن هؤلاء حاول أن يُعبِّر عن هذه الحال بأسلوب يخصُّه، ولكن مهما حاول المحاولون وماذا قال القائلون، فكلُّ ما يقالُ في هذا المجالِ ليس إلا ترويحًا عن النفس مقابلَ ما يُشاهَد ويعاشُ، وإلا فالتعبير عن أصل هذه القضية بالألفاظ والكلمات من باب المستحيلات.
إن الإنسان لا يصِل إلى السكينة والطمأنينة إلا بالتوحيد والإيمان بالله، وقولُنا: الحمد لله، يحتوي على معنى أننا نشكر الله تعالى الذي لَطَفَ بنا فعرَّفَنا بذاته، وبذلك أوصَلَنا إلى التوحيد.
و”الوحدانيةُ” من لوازمِ الألوهيّة لا تنفصلُ عنها؛ فمن المحال التفكُّرُ في الله من دون التفكر في “وحدانيّته”، فنحن نعبِّر عن هذا ونقول: الحمد لله، وهكذا نُخصِّصُ الحمدَ بالله تعالى لأنه هو المتفرِّدُ بالألوهية، وبيده الخير والشر، وتسجّل لديه الحسنات والسيئات فيثيبُ على الطاعات ويجازي على المعاصي.
ولا مجال في الكون للشِّرْكِ ولو مثقال ذرَّةٍ؛ إنّ “برهانَ التمانُعِ”[13] يدحضُ دعوى الشِّرْكَ ويرفضها رفضًا قاطعًا، فلا يجوز أن يكون في قريةٍ واحدةٍ مختاران، ولا في قضاءٍ مديران ولا في محافظةٍ واليان، وإلا حَصَلت الفوضى، فهذا الوضع يُبَيِّنُ أن الحاكميّةَ لا تقبلُ الشركة، فلا يمكن أن يكون لهذا الخالِقِ العظيمِ الذي جعلَنَا نحسُّ به من خلال هذا النظام والانتظام السائدِ في الكون ندٌّ أو شريكٌ، إن الله هو الذي يستوي أمام قدرتِهِ خلقُ ذرَّةٍ واحدةٍ وخلقُ الكون بأسره، وهو الذي خَلقَ الإنسانَ كما خَلَقَ الكائنات، وكما خلقَ زهرةً خلقَ الربيعَ بأكمَلِهِ، وكما خلق الربيع خلق الجنّةَ بكلِّ مراتبِها وخلق عالمَ الأبديّة بكلّ طراوته، فتصوُّرُ الشريكِ لله يُفْسِدُ الخيالَ ويؤدِّي إلى الفِسْقِ ويقضي على طمأنينةِ البالِ، وهو مَرَضٌ ذهنيٌّ يُربِكُ الإنسانَ ويزعجُهُ، ويُشَتِّتُ فكرَه ويُفْسِدُ ما في نظامِهِ الفكريّ من التناسُقِ والانسجامِ.
فقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا اٰلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/22) يُعَبِّرُ عن هذه الحقيقة بشكل واضح، ولذلك فنحن نعزلُ الأسباب، فنتحاشى ما تورَّطَ فيه النصارى، ولا نَدَع مجالًا أبدًا لِأَنْ يدخلَ قلوبَنا محبَّةٌ يُشَمُّ منها رائحةُ الشِّرْكِ، ولو كانت تجاهَ سلطانِ قلوبِنا سيّدنا محمد، ونقولُ: “إن الألوهية لله وحده، لا إله إلا هو، وهو المعبود المطلق والمقصود بالاستحقاق، وأما الرسول فهو عبدُهُ ورسولُهُ”، وبذلك نحاولُ الحفاظَ على التوازن.
إن الله هو الذي بيده مقاليدُ السماوات والأرض، وهو الذي يُدَبِّرُ الكون كلَّه، وسيدُنا محمد هو ذلك السلطان الذي رأى ذلك المعبودَ المطلق، وتلقَّى منه الأوامر، وشاهَدَ بعين اليقين ما نعتقد ونؤمن به بظهر الغيب، وعايَشَه بالفعل، فبرزَ أمامنا باليقين الذي حصلَ له نتيجةَ المشاهدة والمعاينة والمعايشة، فكما أنه آمن بما يدعو إليه من دون تردُّدٍ؛ فكذلك دعانا إلى هذا الإيمان والاعتقاد، فتلك العباراتُ والألفاظُ التي كانت تنطلِقُ وتُقْلِعُ مِن قلبِهِ بقوَّةٍ وَجدَتْ لها صدًى في قلوب كلِّ المؤمنين؛ لاحِظُوا، إنه رغمَ مرورِ أربعة عشر قرنًا من الزمن؛ فإن الأمواجَ التي حصلَتْ جرّاء الجواهر التي ألقاها رسول الله في بحرِ المعرفة؛ قد وصلَتْ إلى ساحل هذا القرن على شكلِ دوائرَ متداخلةٍ.
فالحقيقةُ القدسيّةُ: “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، كما أنها تُبيِّن أن المعبودَ المطلَقَ هو الله، وأن العبوديّة له فقط، وأنه لا ينبغي الخضوع والخنوع إلا أمامه، فكذلك تَذْكُر لنا أن سيدنا محمدًا رسولُه وصاحبُ التشريفات في قصر الكون، فهذا الكلام يُفصِّلُ ما في القلوب من حصّةٍ لله وما فيها من حصَّةٍ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفهم حقيقةَ “لا إله إلا الله، محمد رسول الله” بهذا الشكل.
والمؤمن إذا ما اكتسب هذا الإيمانَ، وأسندَ كلَّ شيءٍ إلى القدرة الإلهيّة، أسَّسَ علاقةً بينه وبين كلِّ شيءٍ في الكون، فلن يكون بعد ذلك في روحه وحشةٌ وغثيان وتوحُّشٌ تجاه المخلوقات، بل سيتآخى مع الحَجَرِ والترابِ والطيرِ والشجرِ، وهو ينظر إلى الكون على أنه “مهدٌ للأُخوَّة”، لأن كلَّ شيءٍ جاء من “الواحد”، وراجعٌ في نهاية المطاف إلى “الواحد” أيضًا.
وحينما مرَّ الرسولُ ذاتَ يومٍ بجبلِ أُحُدٍ قال: “هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ”[14]، مع أنه قد شُجَّ رأسُه الشريفُ وكُسِرَتْ رباعيتُهُ في أُحُد، وقد فاتَهم نصرٌ محقّقٌ بسبب أن بعضًا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا قد أدركوا بَعْدُ مدى الحساسيّة التي تتطلَّبُها “إطاعةُ الأمر”، قال ذلك وكأنه يريد أن يعمِّق المحبَّةَ والصداقة التي أسَّسهما بينه وبين كلِّ الموجودات، فهذا الجوُّ من المحبَّة قد بَعثَ الأمنَ والاطمئنانَ في نفوسِ الصحابة الذين سبقَ منهم الخطأُ، فهذا جانبٌ من القضية، والجانب الذي أريدُ أن ألفتَ الأنظارَ إليه هو العلاقة بين الرسول وبين الأشياء؛ فكأن هذا الجبل أصابه نوعٌ من الخجلِ والتوجُّسِ لـمَّا استُشهد عليه عددٌ من الصحابة، وكُسِرَت رباعيّة النبيّ الذي هو “الغايةُ من الكون”، فالرسولُ بقولِهِ هذا يسلِّي أُحُدًا ويسرِّي عنه.
وفي موقف آخر لما ارتجَّ أُحُد، قال الرسول r: “اُثْـبُتْ أُحُدُ! فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَان”[15]، فثبت الجبل امتثالًا لأمره صلوات الله عليه. نعم، هذه معجزة من المعجزات الأحمدية على صاحِبِها أفضلُ الصلاة والسلام، وما سردناه آنفًا كان موقفَهُ الدائمَ مما حولَه من الأشياء، و-كما قلنا- إنه كان ينظرُ إلى الكون على أنه “مَهدٌ للأخوَّة”، فحديثُه للشَّجَرِ والحجرِ وكثيرٍ من الموجودات إنّما هو من الحقائقِ الثابتةِ تاريخيًّا، وفي هذا الموقفِ النبويِّ درسٌ عظيمٌ جدًّا للمؤمن الذي يستفيد منه ويعتبر به.
وإنما يتأتى الوصول إلى هذه الحقيقة بالتوحيد والإيمانِ بأن كلَّ شيءٍ جاء من “الواحد” وسيرجع إلى “الواحد”.
ولذلك يتحدث الرسول r عن جملةِ “لا إله إلا الله” التي هي ترجمانُ الإيمان، بهذه العبارات المباركة: “أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ”[16]، فهذه الجملة هي أفضلُ ما يبعثُ علىالحياة، ويا لَـهَا من دلالةٍ ووَقْعٍ وإحاطةٍ! فليس هناك مِن خالقٍ سوى الله الذي حارت العقول في إدراكِهِ وانتَشَت النفوس بذكرهِ وعبادته.
2- “الحمدُ لله” والإيمانُ بالملائكة
إننا كما نرى عقيدة التوحيد في هذه الجملة القدسية: “الحمد لله”، فكذلك نرى في الجملة نفسها الإيمانَ بالملائكة، لأن هذه الجملة تشتمل على حمدِ الله تعالى في أسمى أشكالها، والحالُ أن الإنسانَ بجوانِبِهِ الضعيفةِ وذنوبِهِ الكثيرةِ كثيرًا ما يكون عاجزًا عن حمد الله تعالى على وجهٍ يليقُ بعظَمَتِهِ، فهذا يعني أنه لا بدَّ من وجودِ عِبَادٍ لا يعتريهم العصيانُ والنسيانُ ولا يفتؤُون يذكرونَ الله تعالى ويقومون بالعبودية له. نعم، إن لله عبادًا مُكرَمين يسمَّون: “الملائكة”، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون، يقول العارف بالله “إبراهيم حقّي” معبِّرًا عن هذه الحقيقة:
الملائكة عبادٌ مكرمون من عباد الله
وعوامَّ الإنسِ على عوامِّهم فضَّل اللهُ.
وإنّ الجملة المقدَّسَة “الحمدُ لله” لتَكتَنِفُ في ثناياها تحفيزًا على التشبُّه بالملائكة من حيث العبوديَّة والطاعة، فالذين يُريدون أداءَ العبوديَّةِ دون عصيانٍ ونسيانٍ عليهم أن يتشبَّهوا بالملائكة، إلا أن هناك لطيفةً وفارقًا مهمًّا؛ وهو أن الإنسان إذا قام بعبوديَّـةٍ تُشبِه عبوديةَ الملائكة فسيرتقي إلى مقامٍ أسمى من مقامهم، لأن جوانبَ الضعف في الإنسان تكون وسيلةً إلى ارتقائِهِ وسموِّه إلى مستوى الكمال، في حين أن مقامَ الملائكة ثابتٌ لا يتغيّر، ومن جانب آخر؛ إن الإنسان خُلِقَ خليفةً في الأرض، وأما الملائكة فهم يؤدّون -في طاعةٍ مطلقةٍ- ما كُلِّفوا بأدائِهِ من الوظائف التي جُبِلوا عليها؛ وقد وَصَفَهم الله بأنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (سورة التَّحْرِيمِ: 66/6).
فعلى الإنسان أن يكون -على الأقلِّ- مثلهم ويتحرَّكَ حسب الغاية التي خُلِقَ من أجلِها، حتى يكونَ مؤدِّيًا شكر إحرازِ مقامِ خلافةِ الله في الأرض.
كما أن في هذه الجملةِ القدسيَّة حضًّا على التشبُّه -من ناحية الطاعة- بسائر المخلوقات التي تُطيع أوامر الله، تلك المخلوقات التي تَحدَّث عنها القرآن الكريم بقوله: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (سورة فُصِّلَتْ: 41/11).
3- ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾ والإيمانُ بالكُتب والرُّسل
إن جملةَ ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾ تَحمِلُ في طياتها الإيمانَ بالقرآن الكريم وسائرِ الكتب.
فنحن نحمد الله ونثني عليه على أنه أنزل علينا القرآنَ الكريم؛ فإننا لم نتعلّم العبودية والثناء والشكر لله وتوقيرَ النبي إلا بفضل القرآن؛ فلو لم ينزل القرآنُ لما أمكنَنَا التعرُّفُ على الحمد، ولَمَا كنا نعلم كيف نؤدّي حقَّ العبودية لله، فالله أنزل القرآنَ، وبذلك عرَفْنا اللهَ وتَعلَّمْنا كيفية العبوديّة له، فنحن نؤدِّي عبوديَّتنا حسب البرنامج الإرشاديّ الذي أتى به هذا الكتاب، ولولا ذلك البرنامج لَمَا كان هناك فرقٌ بين حركاتنا وبين ما يُفعل أمام طوطمٍ أو صنمٍ أو تمثال، فلا يمكن إذًا أن نتحدَّثَ عن العبودية والمعبود المطلق بمعزلٍ عن الكتاب الذي يحتوي على برنامج العبوديّة.
ولا مجال لتصوُّرِ العبوديَّةِ والمعبودِ المطلَقِ من دون تصوُّر الكتاب الذي أتى من صفة الله تعالى “الكلام”، والذي نَزَلَ به الرسولُ الكريمُ الـمُطاعُ الأمينُ ذو القوَّة المكينُ جبرئيلُ عليه السلام، وبلَّغه النبيَّ الأُمِّيَّ محمّدًا صلى الله عليه وسلّم،.. فالقرآنُ مندرجٌ -على هيئة بَذرةٍ- في هذه الجملة القدسيّة: ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾ حيث إنه يجعلنا نحمد الله ويعلِّمنا كيفيَّةَ حَمْدِ الله تعالى وشكرِهِ والثناءِ عليه، إن الله أَعَدَّ الكونَ كأنه بستانٌ في غاية الجمال، وجَعَلَه روضةً في منتهى الروعة، وغذَّانا وربَّانَا بمختلف نِعَمِهِ، ثم أراد أن يعرِّفنا بذاتِهِ من خلال هذه النِّعَمِ، وفي سياق تعريفنا بذاتِهِ عَدَّد لنا نِعَمَه في القرآن الكريم الذي هو خطبته الأزليّة والأبديّة، فهل يُتصوَّرُ أن لم يرسل اللهُ مبلِّغًا يبلِّغ لنا كتابه، ويَشرح للمشاهدين الذين يأتون لمشاهدة قصرِ الكون الأسرارَ المودَعة في هذا المعرض الرائع، فلا بد من إرسال الرسل، وهو أيضًا مندرجٌ في عبارةِ ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾، فنحن حينما نتفوَّه بهذه الجملة نكون كأننا نحمد الله تعالى على أنْ أَرسَل إلينا الرسلَ أيضًا، وسيدُنا محمد الذي هو قافيةُ ركبِ الأنبياء اشتُقَّ اسمه من مصدر “الحمد” أيضًا.
قال الشاعر في مدحِ رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
في الأرضِ أحمدُ، في السماء محمّدٌ *** عند الإلهِ مقرَّبٌ محبوبٌ.
نعم، إنه كما حَمِد الله كثيرًا، كذلك هو محطُّ نظر الله تعالى، وهو الفردُ الفريد.
4- ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾ والإيمانُ بالآخرة
إن التلفُّظَ بهذه الجملةِ القدسيَّة: ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾ من صميم الفؤاد ومن أعماق القلب، والمواظبةَ على ذلك يُذكِّرنا بالإيمان بالآخرة أيضًا؛ لأن النعمةَ التي لا تدومُ لا تُعَدُّ نعمةً بل هي نقمة، فالنقمةُ تحوِّل مشاعر الصداقة والمحبَّةِ إلى عداوةٍ ونفورٍ، فصاحب الرحمة اللانهائيّة الذي يعرِّفنا بذاتِهِ ويحبِّبُها إلينا في الدنيا، يجعلُ عبادَهُ يحمدونه في الدنيا، ولن يُنهِي هذا الحمد بقطعِ نعمِهِ بزوالِ الدنيا، بل سيجعلُ الناسَ يستمرُّون بحمِدِه إلى الأبدِ في حياةٍ لانهائيّة، فعبادُهُ يحمدونه في حياتهم الدنيويّة، وسيُبعثون في الآخرة وهم حامدون، وسيَحمد المؤمنون ربَّـهم حينما يدخلون الجنَّةَ بترحيبٍ من الملائكة وهم يقولون: ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (سورة الزُّمَرِ: 39/74).
وهذا يعني أن هذه الجملة المباركة كما أنها تشتمل على خلاصة أمَّهات القضايا الأربعة التي هي المقاصد والأهداف الأساسية للقرآن الكريم، فكذلك تشتمل على جميع الأركان الإيمانية وأصناف العبادة، وما دام الحمد سيدوم في الجنة فإن الاستحقاقَ للجنَّةِ إنما يتأتَّى بالحمد في الدنيا، ونحن نعرف أن الذي يؤهِّل الإنسانَ للجنة إنما هو العبادة والتقوى، فلا يقول الإنسان: ﴿اَلْحَمْدُ لِلهِ﴾ على الوجه الحقيقي إلا إذا استرشد بالقرآن الكريم، وعاش الإسلامَ على أتمِّ وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: فتح الله كولن، خواطر حول سورة الفاتحة، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة.