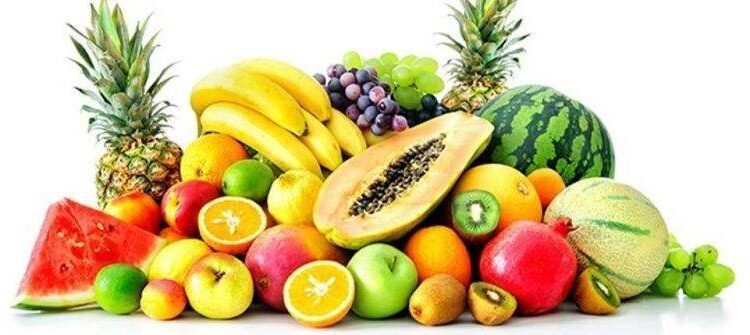سؤال: هل ثمة مغزى من ذكر أسماء الفواكه والخضروات في القرآن الكريم؟ وكيف ينبغي أن تكون نظرتنا للطب البديل إلى جانب الطبّ الحديث؟
الجواب: يَرِد في القرآن الكريم ذكر أسماء بعض الخضروات والفواكه بوصفها من نِعم الدنيا، ومن نِعم الجنة أيضًا، فالنِّعَمُ التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا ما هي إلا نماذج وعيّنات تُذكّرنا بنعم الآخرة.. فإنها حتى وإن كانت تشبه نعم الجنة في مذاقها ورائحتها ولونها فإنها ليست هي ذاتها، والوصول إلى هذه النعم المذكورة في القرآن الكريم، والظفر بها بشكلٍ أبدي؛ يتناسب طرديًّا مع حسن الانتفاع بما تفضّل الله به علينا في الدنيا من نِعم، وعندما يؤدّي المؤمن شكر ربه على النعم التي أحسن بها عليه في الدنيا وأكرمه بها وتفضل عليه بها؛ فإنه سيرى في الآخرة أصول هذه النعم التي تفوق الخيال في شكلها وجمالها؛ وذلك لأن أصول هذه العينات الدنيوية وحقائقها موجودةٌ في الجنة؛ وهو ما عبر عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (سورة الزُّخْرُفِ: 43/71).
الأطعمة في القرآن والسنة، والحكمة من ذكرها
عندما يَرِد ذكر النعم الدنيوية والأخروية في القرآن الكريم يُشار إلى بعض الأطعمة كنماذج وعينات، مثل: العنب والتين والزيتون والرمان والزنجبيل.. والهدف الأساسُ من الإشارة إلى هذه الأنواع من الأطعمة هو تذكير الناس بالله، وحضُّهم على الحمد والشكر لله رب العالمين؛ لأن كل شيء في القرآن الكريم يهدف أوّلًا إلى التذكير بالله، وإلى الأبدية.. ومع ذلك يمكن استنتاج بعض الحقائق العلمية من هذه النعم المذكورة في الآيات، وهذا بدوره يشهد على أن القرآن كلامٌ إلهيّ.
بناءً على ذلك يمكننا أن نُولي الأطعمة المذكورة في القرآن الكريم اهتمامًا خاصًّا، على أساس أنها قد تحتوي على فوائد مهمّة للبشر؛ فذكرُ العنب في القرآن مثلًا يدفعنا إلى دراسة قشرته وبذوره ولبّه في بيئة مخبريّة للبحث عن طرق الاستفادة منه.. وبالمثل يمكننا من خلال تحليل فواكه أخرى بطرقٍ متنوّعة إنتاجُ أغذيةٍ وأدويةٍ مفيدةٍ للصحّة، وتقديم حقائق واكتشافاتٍ بلغة المختبر والعلم الحديث.
وعلى الشاكلة نفسها ثمة إشارات في الأحاديث الشريفة تتعلّق بالطبّ، وقد جمع علماؤنا توصيات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلّق بالمسائل الطبّية تحت مسمى “الطب النبوي”.. فيجب علينا أن نأخذ هذه التوصيات إلى المختبر ونجري عليها الدراسات والأبحاث والاختبارات المتطوّرة.. والمسلم الصادق الإيمان لا يمكنه أن يرفض حديثًا وصل إليه بسندٍ صحيحٍ ولا أن يطرحه جانبًا.. لكن علينا أن نعلم يقينًا أن هذه الحساسية ليست موجودة عند جميع الناس، لذا فلنحذر ولنتجنب إثارة أدنى قدرٍ من عدم الاحترام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، وفي سبيل الفهم الصحيح لتوصيات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلِّقة بالمسائل الطبّية لا بد من الاستعانة بنتائج البحث العلمي والحقائق العلمية المثبتة.
ومن المهمّ للغاية في عصرنا الحالي استخدام لغة العلم ولغة المختبر، فربما كان العلماء مثل ابن سينا والخوارزمي والرازي، قد ركّزوا في عصرهم على بعض الحقائق العلمية وفقًا للمعرفة المتاحة لديهم آنذاك.. لكن اليوم فإن لغة علم العقاقير والطبّ المعاصر قد تغيّرت وأصبحت مختلفة؛ لذلك يجب أن تُعرَض المسائل التي ينبغي إيصالها للناس باستخدام هذه اللغة الحديثة.
الطب الحديث والطرق البديلة
من جانب آخر ولأن علم الطب الحديث يقوم على أسسٍ مادّيّة تجريبيّة نرى كثيرًا من الأطباء ينصرفون عن العلاج بالأعشاب، ولا يولون الأهمية الكافية للطبّ البديل الذي لا يتوافق مع معارفهم وممارساتهم، بل إن البعض يتّخذ موقفًا متشدّدًا حيال هذا الموضوع، ويُصدر أحيانًا تصريحاتٍ حادّة معارضة له، علمًا بأن الطبّ البديل من طرق العلاج المعروفة في الغرب ودول الشرق الأقصى، قد أثبتت فائدتها وكفاءتها في كثير من الحالات، فعلى سبيل المثال، هناك مَن يعالج بعض الأمراض من خلال تدليك نقاط معينة أسفل القدمين، أو العلاج بوخز الإبر، أو عبر موازنة الشحنات الكهربائية في الجسم.
وعندما نأخذ كلّ هذه الأمور بعين الاعتبار ندرك أنه لا بدّ من إبقاء دائرة التفكير مفتوحةً على الأقل على طرق العلاج المختلفة التي تقع خارج نطاق الطبّ الحديث.. فلا يصحّ أن نتجاهل المعارف المتعلّقة بالطبّ والصحة والتي وصلتنا عن طريق كبار العلماء والأطباء مثل ابن سينا والرازي ولا أن نطرحها جانبًا لمجرد أنها قديمة عفا عليها الزمن؛ لأن جزءًا كبيرًا منها يقوم على التجربة؛ ومن ثَمّ ينبغي الاستفادة منها، والسعي إلى تطويرها والارتقاء بها، بل ولا ينبغي التغافل عن بعض أساليب العلاج المنتشرة بين الناس والمعمول بها منذ زمن، ولا يجب أن نرفضها مباشرةً دون دراسةٍ أو تحليلٍ مخبريٍّ، يجب أن ننظر أولًا: هل هناك أساسٌ حقيقيٌّ لما يُقال ويُكتب؟ وهل تستند إلى حقيقةٍ علميّة؟ وإذا كان لا بدّ من رفضها فليكن ذلك بعد معرفةٍ دقيقةٍ وفهمٍ وبيّنة، لا عن أحكامٍ مسبَقَةٍ أو كلامٍ مُرسَلٍ بلا دليلٍ.
فمن المؤسف أنه قد نشأ اليوم تيَّاران؛ لكلٍّ منهما نظرةٌ مختلفةٌ للمسائل الطبّية، وعندما يتحدّثان لا يفهم أحدهما الآخر؛ لأن كلّ واحدٍ منهما يعتقد أن الطريق الذي يسلكه هو الطريق الصواب، ويقلّل من شأن الطرف الآخر.. وفي رأيي أن الطريق الذي يجب اتباعه في هذا الصدد هو الجمع بين دراسة الطب وعلم الأدوية (الفارماكولوجيا)، والاهتمام في الوقت نفسه بطرق العلاج التي يقدمها الطبّ البديل، وفهم جوهرها الأساسي، أو أن يدرس الملمّون بطرق العلاج البديل مجالَ الطبِّ الحديث ويتخصّصوا فيه.
وإن فهم مدى فعالية العلاج المعروف اليوم باسم الطبّ البديل تتوقّف إلى حدٍّ كبيرٍ على دراستها في بيئة مخبرية، وإخضاعها للتجارب والتحاليل، وجعلها موضوعًا للبحث العلمي، وسيكون من المفيد أن يجري المتخصّصون في مجال الطبّ والصيدلة أبحاثًا في هذه المجالات، للتعرُّف على طرق العلاج البديل.
في أماكن مثل أوروبا وأمريكا، تم -إلى حدٍّ ما- تجاوز حالة الانفصال هذه، وجُمع بين هذين المجالين المختلفين جزئيًّا.. وعلى الرغم من أننا -من حيث الأساس- قد استقينا علم الطبّ الحديث القائم على المنظورات الوضعية المعاصرة منهم؛ فإننا لا نزال نُبدي مقاومةً في هذا الشأن، في حين أنه لو بذلنا نحن أيضًا جهدًا لمعالجة هذه الإشكالية التي تمكّنوا جزئيًّا من حلّها، وجرَّبْنا وسائل علاجية وأدوية مختلفة؛ فلن نخسر شيئًا.
الشغف بالعلم والبحث وتحرّي الحقيقة
تعود بداية ركودنا في مجال العلم والبحث إلى القرن الخامس الهجري، وقبل خمسة قرون من الآن، أُهمِل هذا المجال بشكلٍ كبيرٍ.. ربما حقَّقْنا إنجازاتٍ في مجالاتٍ مختلفةٍ بعد فتح إسطنبول، ولكن بدأ يظهر عقمٌ خطيرٌ في مدارسنا الدينيّة، ولم يعد هناك إنتاجٌ حقيقيٌّ لأفكارٍ جديدةٍ، ورغم تقديرنا للجهود الاستثنائية التي بذلها بعضُ العلماء فعلينا أن نقرّ بوجود حالةٍ من الركود الكبير بشكلٍ عام.
فلما عجزنا عن إنتاج أفكارٍ جديدةٍ بدأنا هذه المرّة في نقل المعرفة عن الغرب، ولكنّ فَهْمَ هؤلاء للعلم كان قائمًا على اعتباراتٍ وضعيّة وطبيعيّة وماديّةٍ، فلم يُعيروا اهتمامًا بشكلٍ عامٍّ للروح والمعنى، وعندما شرعنا في استيراد كلِّ شيءٍ من الغرب، وابتعدنا عن قيمنا الذاتية، بدأ يظهر بيننا أناسٌ أكثر داروينية من داروين نفسه، وأكثر لاماركية من لامارك.
لقد أولى الغرب اهتمامًا كبيرًا للبحث والدراسة، وبنى جميع قضاياه على أساس البحث والاستقصاء، ومن ثَمّ لاقت أفكارُه التي تقوم على البحث استحسان الجميع، بينما ظلّت تلك التي لا تستند إلى البحث والتجربة هشّةً غير راسخة.. ورغم أن هذه الأفكار قد تعني شيئًا للبعض، فإنها لا تمثل قيمة حقيقية للأشخاص الذين تربّوا على الفكر الغربي.
ولذلك إذا أردنا أن نبني دراساتنا في مجال الطبِّ على أسسٍ راسخة فيجب أن نصرف اهتماماتنا إلى البحث، وأن نختبر أفكارنا في المختبرات، وأن نعلن عنها بعد تجربتها.. حاصل القول: يجب إجراء الأبحاث والتجارب اللازمة قبل الحديث عن أيِّ موضوعٍ يتعلّق بالطبّ.
وفي هذه المسائل ثمّة حاجةٌ ماسّةٌ إلى الكثير من الجهود الحثيثة، والمساعي الكبيرة، ومعالجة المسألة من الأساس، فمن الضروري أن يُنشئ المؤمنون المختبرات والمستشفيات حتى يتسنّى لهم إجراء الأبحاث، وتقييم النتائج التي توصّلوا إليها بمنظور إيمانهم وفلسفتهم الخاصّة.. عليهم من ناحية أن يؤمنوا بالله وأركان الإيمان الأخرى إيمانًا راسخًا، وأن ينظروا من ناحية أخرى إلى هذه الأعمال على أنها سعيٌ دينيٌّ وجهدٌ وطنيٌّ، وأن يكرّسوا أنفسهم لهذا العمل شغفًا بالبحث وعشقًا للحقيقة وحبًّا للعلم.
إن حبّ الغرب للعلم والبحث يكمن وراء النجاحات التي حقّقها في العديد من المجالات المختلفة، وكما يظهر في بعض البرامج الوثائقية؛ فقد قاموا بتمحيص الكون بدقّةٍ من خلال أبحاثهم ودراساتهم، واطّلعوا على أسرارٍ مثيرة تخلب الألباب نتيجة ملاحظاتهم ومشاهداتهم حول عالم النبات والحيوان.
وهكذا يجب إحياء هذا الشعور لدى المؤمنين، ففي عصرنا الذهبي الذي يمتد من القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس، ظهر آلافٌ من العلماء العظام والباحثين المتعطشين للحقيقة في مختلف فروع العلم، لكن تلاشت هذه الروح في العصور اللاحقة، مما يجعلنا في حاجةٍ ملحّة إلى إطلاق حقبةٍ جديدةٍ كهذه من أجل القضاء على المعضلة التي نعيشها في مجال العلم، وحتى تحظى الأفكارُ التي نطرحها بحسن القبول؛ يجب أن نطرح أفكارنا وفقًا للمبادئ والأساليب المتعارف عليها حاليًّا في الأوساط العلمية؛ لأن سلامة الأفكار التي نطرحها، وحُسن قبولها؛ مرهونٌ بذلك.. من أجل ذلك يجب أن ننكبّ على هذه الأعمال بدافع الشغف بالبحث، وحبِّ الحقيقة.
وليس من الصواب أن نعزو الدراسات التي قام بها العالم الغربي منذ سنوات طويلةٍ إلى وفرة الإمكانات المادية فحسب.. لا أعرف مدى صحة الرواية التالية، ولكن يُقال: إن الذي اخترع السينما مات فقيرا، وإذا نظرنا إلى “نيوتن” أو “أديسون” فسنجد أنهما لم يكونا من الأرستقراطيين، بل كانا ينحدران من عائلاتٍ فقيرةٍ، وهذا يعني أن القوة التي حرّكتهم كانت حبَّ الحقيقة الكامن فيهم.
إعادة بناء العلوم الحديثة على محور الإيمان
ما يعدّونه هم حقيقة هو في ذاته مسألة أخرى.. فرغم أن بعضهم يؤمن بالذات الإلهية؛ فإن ما يطلقون عليه “الحقيقة” يظلّ -في الغالب- محصورًا في عالم المادة.. وبعبارة أخرى: فهي محاولة لفهم ما تشكّله الموجودات والوقائع.. وكما عبّر نجيب فاضل: فقد قاموا بنقض الموجودات والوقائع وتحليلها، وبلغوا بمختلف العلوم حدودها القصوى الممكنة في العالم الفيزيائي.. غير أن المؤمنين لا ينبغي أن يقفوا عند هذا الحد؛ بل لا بدّ لهم أن ينتقلوا من الفيزياء إلى الميتافيزيقا، ومن المادة إلى المعنى، ومن التصورات المادية إلى التأملات الروحية، والسعي لرؤية وجه الحقيقة هناك.. إذ إن الحقيقة -بالنسبة إلينا- لا تتجلّى إلا باجتماع كلِّ هذه الأبعاد.
أجل، هناك حقيقةٌ مطلَقةٌ وموضوعيّة، وهناك حقائق نسبيّة من وجهة نظر الباحث.. وإن إنهاء المسألة عند المادة والعالم الفيزيائي يعني -من جانب- الوصول إلى الحقيقة النسبية.. أما فهم الحقيقة المطلقة، فيتوقّف على القفزِ إلى ما وراء المادة، وتناولِ المسألة بتأمُّلٍ أعمق كما فعل العالِمان “باسكال” و”جين”.. لقد توقّفا عند ذروة المسار الذي بلغاه في عالم المادة، وتأمّلا آثار الذات الإلهية، فذُهلا عن أنفسهما وأجهشا بالبكاء.
ومن المهم جدًّا من جهة أخرى، ألا تكون الأبحاث والدراسات نابعةً من دافع (الأنا)، ولا ينبغي أن تُجرى الاكتشافات بهدف إبراز الذات والتفاخر الشخصي. نعم، ينبغي لنا أن نجري أبحاثنا شغفًا وحبًّا للحقيقة والعلم والبحث كالفرس الأصيل الذي لا يتوقّف عن الركض حتى الموت، وأن نقضي أعمارنا في المختبرات والمراكز البحثية.. ولكن في نهاية المطاف يجب أن نخترق جدار المادة ونعبر إلى ما وراءها، وأن نصل إلى ذلك المقام الذي تحترق فيه كل الأغيار بأشعة “سُبُحات وجهه”، حتى تذوب وتفنى.. وهناك ينبغي لنا أن نذوب ونفنى عن ذواتنا، وبعد أن نبلغ مقام “الفناء في الله”، يجب أن نصل إلى “البقاء بالله”؛ أي بعد أن نفنى من حيث ذواتنا، ينبغي أن نبلغ أفق الوجود الأبدي من خلال تجليات الله وتوجّهاته إلينا، فالأصل في كل ما يجري من أبحاثٍ وجهودٍ هو أن تُفضي بنا إلى “حقيقة الحقائق”.
وحتى يأتي اليوم الذي نمتلك فيه الإمكانات التي تتيح لنا التعبير عن أنفسنا في المحافل العلمية والجامعات والمراكز البحثية والمختبرات؛ فليس بوسعنا الخوض في مزاعم مختلفة، أو تطوير مصطلحات أو لغةٍ جديدةٍ، أو محو الأسباب، أو إهمال الملاحظات الطبيعية والوضعية؛ لأنهم في هذه الحالة سيسألوننا: “على أيِّ أساسٍ تفعلون هذا؟”.. وأعتقد أن بيننا اليوم علماء يمتلكون الكفاءة اللازمة لإنجاز هذه المهمّة.. فلم يضع الله أمامنا كتابًا لا سبيل إلى قراءته أو فهمه.. لقد بسط أمامنا الأوامر التكوينية حتى تُقرأ وتُفهم ويُستخلَص منها المعاني، وشرح لنا المواضع المبهمة فيها بكلامه القديم.. ولذلك يجب على باحثي العالم الذين يؤمنون بقيمنا الإيمانية أن يقرؤوا كتاب الكون المبسوط أمامهم بشكلٍ صحيحٍ، من خلال تدبّر القرآن الكريم بعمقٍ، وأن يعبروا عن الحقائق التي يقرؤونها بلغةٍ يقبلها الطرف الآخر.
ولن يكون بوسعنا التخلّص من هذه الازدواجية حتى يحين الوقت الذي نعيد فيه النظر في جميع العلوم مرّة أخرى، ونضعها على أساسٍ متينٍ ومعقولٍ ضمن إطارنا الفكري الخاص.. على سبيل المثال: يمكننا القول إن علومًا مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطبّ والهندسة والصيدلة تتحدّث عن الله.. غير أن هذا القول لن يعني شيئًا بالنسبة للكثيرين ما لم نستطع إظهار ذلك بلغة هذه العلوم نفسها؛ لأن الآخرين قد جعلوا هذه العلوم تنطلق من منظوراتٍ وضعيّةٍ ومادّيّةٍ، وقالوا في بعض المواضع أشياء لا تتوافق مع الواقع، أما نحن فعندما نصل إلى مثل هذه المواضع نجد أنفسنا مضطرين إلى تجاوز تلك المواضع بعقليةٍ متردِّدةٍ تفتقر إلى الحسم، أقرب ما تكون إلى منهجيّة المتوقِّف المتحفِّظ “لا أدرية”، أو ألا يتجاوز ما نقوم به من دراسات حدود الترقيع؛ لأن القواعد الأساسية لهذه العلوم قد وضعها آخرون، لذا تبدو لنا غير أصيلة.. وبما أن الأبحاث في الأساس مبنيةٌ على رؤًى مختلفةٍ، فإن هذه العلوم لا تقول لنا دائمًا الأشياء نفسها بلغتها الخاصّة.. ولن نتخلّص من هذه الازدواجية إلا عندما نعلّم هذه العلوم لغتَنا الخاصة، ونستنطقها، ونجعلها جزءًا من ذاتيتنا، ونستوعبها، ونهضمها، وإلا سنظل نتدبّر الأمر بما نملك من ترقيعاتٍ مؤقّتةٍ.