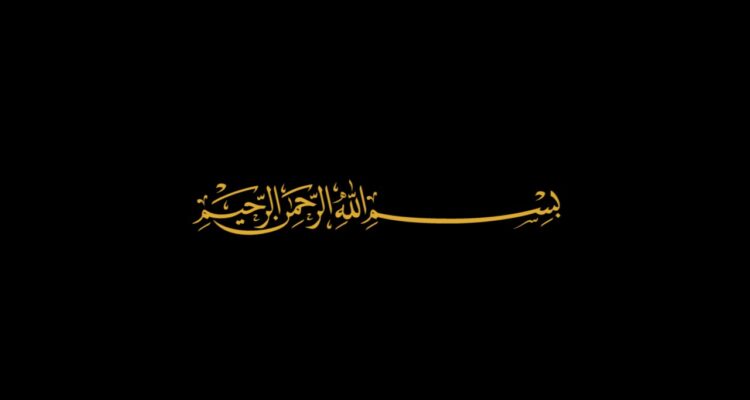إن لفظة “الرحمن” من الصفات المشبهة الدالَّة على المبالغَةِ، وهي صفةٌ خاصَّةٌ بالله عزَّ وجلّ؛ حيث إننا حينما نقول: الرحمن، فالذي يتبادَرُ إلى أذهانِنا هو الله، فالله هو المقصود من قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (سورة طَهَ: 20/5) أو ﴿الرَّحْمَنُ $ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (سورة الرَّحْمَنِ: 55/2)، ومعنى الرحمن: الذي يرحمُ رحمةً لا نهائيَّة، والذي يغذّي بِنِعَمِهِ تغذيةً سرمديّة.
و”الرحيم” أيضا من أسماء الله تعالى كـ”الرحمن”، لكن الرحيم صفةٌ لا تختصّ بالله تعالى، وهي تُطلَق على المخلوقِ أيضًا.
والآن تعالوا بنا نُقارِنْ بين هاتين الكَلِمَتِين:
مقارنة بين كَلِمَتَي “الرحمن” و”الرحيم”
إن كِلَا الكلمتين مشتقَّتان من “الرحمة”، وتُعَبِّران عن رحمةِ الله، ولكن في حين أن إحداهما تُعَبِّرُ عن رحمتِهِ الشامِلَةِ العامَّةِ في أوسعِ أشكالِها، تُعَبِّرُ الأخرى عن “رحمةٍ خاصَّةٍ”، وبتعبير دقيق نقول: إن الرحمن تجلٍّ لـ”الواحديّة”، وأما الرحيم فهو تجلٍّ لـ”الأحديّة”.
إن كلمة “الرحمن” متوجهة إلى “الأزل” بينما تتوجّه كلمة “الرحيم” إلى “اللايزال”، واللهُ قد أوجد الكونَ من العدم بتَعلُّقِ المرحمة التي في روح الاسم الجليل: الرحمن، فالأنظمة والأجرام السماوية وبنو الإنسان والأشجارُ والطيورُ وسائرُ الأشياء قد وُجدت بالاسم الجليل: الرحمن، وكلُّ الموجودات مَعكسٌ لتجلِّي الاسم الجليل: الرحمن، فهذه الرحمة العامة الشاملة قد وَسِعَتِ الكون واستوعبته قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/156)، فأحاطت “الرحمانيةُ” بجميع الكائنات.
وكلُّ شيء يخضع للأوامر الإلهية -طوعًا أو كرهًا- تحت الرحمانيّة، ففي الرحمانيّة نوع من الجبريّة، حيث إن الله تعالى لم يستأذِن الكونَ حينما خلقَهُ، لم يستأذِنَّا ولم يستأذن الطيورَ والأشجارَ والأحجار، فهذه الجبريّة تنبع من واحديّة الله تعالى، إنه مالك الـمُلك يتصرَّفُ في مُلكِهِ كيف يشاء، وليس لأحدٍ أن يتدخَّل فيما يفعل، فإن تناولْنا الأمرَ من منظورِ اسمِ الرحمن فقط فلا يبقى أيُّ فرقٍ بين إيمان العبدِ وكُفرِهِ، وبين العدل والظلم، وبين الحقِّ والباطل، وبين الحُسنِ والقُبح، وبين الخير والشر… لأنه ليس هناك مجال لإرادة الإنسان، وهكذا يكون الإنسان مثلَ سائرِ الموجودات؛ غيرَ مُدانٍ على سيِّـــئاته، ولا مُثابٍ على حسناتِهِ، بل يكون مثلَ أيِّ شجرٍ أو حجرٍ أو بهيمةٍ يعيشُ في حدود الفِطرة، فلو كانت تجلِّيات “الرحمن” فقط هي التي تَحكُم الكون؛ لكانَ الوضعُ على هذا المنوال، ولكن شاء الله U أن يُودِع في الإنسان “الإرادةَ”، فاقتضَتْ حِكْمَتُهُ أن يجزيَ بالحسنى مَن استَعمل إرادتَهُ في الخير، وأن يُعاقِبَ من استعمَلَها في الشرِّ، وذلك هو تجلّيهِ تعالى بـ”رحيميَّتِهِ”، وبهذا يكون الله تعالى قد مكَّنَ الإنسانَ ويسَّر له السبيلَ من أسفل سافلين إلى أعلى عِلِّيِّين؛ فإما أن يرتقي إلى أعلى عِلِّيِّين، أو ينحطّ إلى أسفل سافلين.
أجل، إذا كان الطيرُ يُرفرِفُ بجناحيه فيطيرُ ويُحلِّقُ في الآفاقِ عاليًا ثمَّ يرجعُ إلى فراخِهِ؛ وإذا كانت الأشجارُ تنمو وتطولُ وتَبْسقُ؛ والعيون تجري نضّاخةً؛ والنباتاتُ تَخْرُجُ مخضرَّةً؛ والأشجارُ تؤتي أُكُلَها في موسِمها؛ والبهائمُ تُعامِلُ أولادَهَا بمنتهى الشفقة والرأفة… فإنما ذلك كلَّه من تجلِّيَّات “الرحمن”، ولكن هذه الموجودات لا تملك الإرادة، بل إنها مضطرَّةٌ للعيشِ في إطار الحدود التي رَسَمَها وعلَّمها وقدَّرها لها “الرحمن”، في حين أن لله تعالى نوعًا خاصًّا من تجلِّيات الرَّحمة، وهي متعلِّقة بـــ”الإرادة”، وهذا هو ما نفهمُهُ من كلمةِ “الرحيم”.
وحاصلُ القولِ هو: أنه لولا “الرحمن” لم نأتِ إلى عالم الوجود، ولَانْعَدَمَ الكونُ وسائرُ الموجودات… ولولا “الرحيم” لما كنا نستعمل “الإرادة”، ولَـــكُــنَّا نعجز عن إدراك دقائِقِ صُنْعِ الحقِّ .
فـ”الرحمن” بَسَطَ الكونَ أمام أنظارنا مثل كِتابٍ كبير، و”الرحيمُ” مَنَحَنا “الإرادةَ” لكي نقرأَ ذلك الكتاب، فنُحوِّلَ باقاتِ الأنوار التي نلتقطُها من ذلك الكتاب إلى إيمانٍ في قلوبنا، وكذلك مكَّنَنَا “الرحيمُ” من أن نجتازَ حدودَ الكائنات، ونقتربَ من سواحل الأسماء الإلهيّة ونبحثَ في مكنونات كيفيّات الصفات السبحانيّة وأحوالها، ونتعرّفَ على ذات الباري، إنَّ إدراكَ ذات الباري غير ممكنٍ؛ فلو حاوَلْنا أن نشرح بألفِ اسمٍ من أسمائِهِ بل بملياراتٍ منها لَمَا استطعنا أن نأتيَ بشيءٍ يُذكَر في بيان ذات الباري، يقول سيدنا أبو بكر : “العجزُ عن دَركِ الإدراك إدراكٌ”[2]، وفي الخبر: “مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفُ”[3]، ومن هذا المنطلق فنحن أيضًا نقول في مقام الاعتراف بعجزنا والإعلانِ عنه: (شعر)
إن إدراك المعالي ليسَ من شأن هذا العقل الصغير
فإن هذا الميزان ينوءُ بهذا الحِملِ الكبير
(ضياء باشا)
وفحوى الكلام أن الحقَّ فتَحَ لنا أبوابَ هذا الكون بـ”بسم الله”، ودعانا إلى مشاهدته، وسَيُغْلِق أبوابَ الكون بـ”بسم الله” أيضًا، ويفتح أبواب دار السلام بـ”بسم الله” وسيدعو بني الإنسان إلى الجنة للفوزِ بالسعادة الأبديّة.
البسملة: حبلٌ نورانيٌّ يَربط قلبَ الإنسان بالعرش الأعظم
نلاحظ أن البسملة تتجلّى في كلِّ مكان، لأنها تحتوي على لفظِ الجلالة “الله” تلك الكلمة التي تتضمَّن كلَّ الأسماء الإلهيّة الحسنى.
إن كلَّ الحقائق التي يتولَّى القرآنُ شرْحَها وبيانها مندرجةٌ بشكلٍ مختصرٍ في البسملة، ومن المؤكد أن لهذا انعكاسًا على قوَّة تأثيرِ البسملة؛ وهذا يوضِّحُ سرَّ قول الرسول: “كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ”بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ” أَقْطَعُ”[4]، وفي رواية: “أَبْتَرُ” وفي أخرى: “أَجْذَمُ”، وكل هذه الألفاظ متقاربةُ المعاني، وهي في مجملها تعني أن كلَّ الأعمال التي لا يُبدأ فيها باسم الله فهي ممحوقةُ البركةِ قصيرةُ العمرِ مبتورةُ الجذورِ ناقصةُ الثمرِ.
والقرآن يتناول أربع حقائق كبرى، وهي: التوحيد والنبوّة والحشر والعدل، والبسمَلَةُ تتضمَّنُ هذه الأمور الأربعة بشكلٍ مجملٍ؛ فالاسمُ الأوّلُ فيها وهو لفظُ الجلالة “الله” متوجِّهٌ بشكلٍ صريحٍ نحو التوحيد، والثاني وهو “الرحمنُ” يدلُّ على النبوَّة، والثالثُ والأخيرُ فيها هو “الرحيمُ” وهو يُعَبِّر عن الحشرِ والعَدْلِ.
والبسملةُ موجودةٌ في بدايةِ كلِّ سورةٍ من سُوَرِ القرآنِ إلا سورة “براءة”، ويجب -بالإجماع- على كل من ينسخ المصحف أن يكتبها في بداية السور، وإذا تركها يكون قد ارتكب إثمًا.
وفي قراءة البسملة في الصلاة قبل الفاتحة اختلافٌ بين فقهاء الأمة، فعند بعضهم واجب، وعند بعضٍ منهم سنة، وعند البعض مندوب، في حين أن قسمًا منهم يرونها مكروهًا.
ومن العلماء مَن عَدَّ البسملةَ آيةً برأسِها، ولم يعدّها آخرون آيةً قائمةً برأسِها وإنما هي أُنزِلت للتبرُّكِ والفصلِ بين السور إلا التي في سورة النمل.
والبسملة هي بمثابة المفتاح لكلِّ شيء في الحياة، كما أنها بمنزلةِ المفتاح للسُّوَرِ القرآنيَّة، فالبسملة في بداية السورة؛ -سواء كُتبت للفصل بين السور، أو للتبرك والاستعانة بالله تعالى على فهم السورة والعمل بمقتضاها، أو لأيِّ غرض آخر- هي حبلٌ نورانيٌّ دُلِّـيَ من العرش الأعظم إلى قلب الإنسان؛ فالذين يدركون المعاني السامية لـ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ويستفيدون من فيوضاتها، يستطيعون الاستمساك بها والارتقاءَ إلى عرش “الإنسانية”.
إن الله تعالى شَرَحَ وبيَّن في الكتب التي أنزلَها كلَّ الحقائق الموجودة في الكون، حيث إنه عبَّر عن هذه الحقائق الكبرى على شكلِ معانٍ في صدور الأنبياء الذين يمتلكونَ قلوبًا مؤهَّلةً لِتَجلِّي تلك الحقائق وبروزِها، وأَعرَب عنها في صورةِ حروفٍ وكلمات على ألسنتهم، وقد فصَّلَ القرآنُ الكريم خاتمُ الكتب كلَّ ما سبقَ إجمالُه في الكتب والصحفِ والألواحِ المقدّسة السابقةِ، والقرآنُ الكريمُ هذا بتمامِهِ تتضمَّنه سورةُ الفاتحة، كما أن الفاتحة ملخَّصَةٌ في البسملة، فالبسملة خطٌّ نورانيٌّ يربطُ بين كلِّ الأنبياء والكتب، وكلُّ الحقائق الموجودة في الكون موجودة -لا محالة- في البسملةِ على شكل نواة، ولكن لا يوفَّق كلُّ أحدٍ للعثور عليها واستخراجها.
[1] يُحكى أن رائدَ الفضاء السوفيتي “يوري جاجارين” الذي يُعتبر أول إنسان تمكن من الطيران إلى الفضاء قال هذه المقالة. (الناشر)
[2] الغزالي: إحياء علوم الدين، 4/252؛ المقصد الأسنى، ص 54؛ السيوطي: شرح سنن ابن ماجه، 1/103.
[3] المناوي: فيض القدير، 2/410؛ الألوسي: روح المعاني، 4/79، 17/202.
[4] رواه عبد القادر الرُّهاوي في “الأربعين البلدانية”.
المصدر: فتح الله كولن، خواطر من وحي سورة الفاتحة، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة.