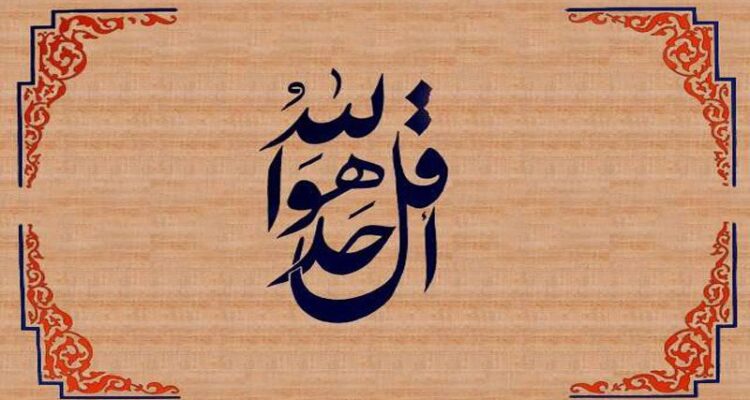إن الطريق الوحيد إلى التخلص من كل أنواع الشرك وشوائبِه هو أن يتوجه الإنسان موحِّدًا خالصًا إلى التوحيد في الفكر والعمل، ويُفْرِدَ الله تعالى في كل الأمور، ولندع المشركين ونتساءل: ما مدى فهم المؤمنين لهذه الحقيقة وتبنّيهم لها؟
لقد بيّن الله هذه الحقيقة التوحيدية العظمى على أكمل وجهٍ وأشملِه في قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (سورة الإِخْلَاصِ: 112/1-4).
أجل، إن الله أحدٌ، وأحديته ليست نسبيّة، بل هي ذاتية وحقيقية؛ أما واحديةُ “الواحد” فواحدية إضافية بالنسبة إلى الاثنين، وأما “الأحد” فهو فرد لا يُتصور في مقابله “الاثنان”؛ بمعنى أنه لا يُتصوَّر له ندٌّ أو مثيل، فهو “أحد” ليس قبله ولا بعده شيء، ولا يَستند إلى شيء، بل إليه يَستند ويرجع كلُّ ما يُطلق عليه: واحد، أو اثنان، أو ثلاثة.
﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ﴾؛ أي الله هو الوحيد الذي يحتاج إليه كل شيء، ويرفع إليه الجميعُ أكفَّ الضراعة، وهو الذي يطرق بابه كل سائل بلسان الحال والوجدان والمشاعر، فمهما اعتمد الإنسان على شيء سوى الله وخضع له فسيرى أنه قاصر في هذا المجال؛ لأن قوله تعالى: ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ يفيد هذا المعنى، أي إنه لا يحتاج إلى شيء، بل هو الذي يقضي الحوائج كلها، وهو الوحيد الذي يسمع ويستجيب ويلبي نداءَ مَن يتوسل إليه ومن لا يتوسل.
أجل، إنه ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ وعلاقته بالأسباب عبارةٌ عن ستارات بينه وبين تصرفاته تعالى، وليس وراء ذلك تأثير حقيقي لها.. فهو سبحانه موجود وراء ما وراء الوراءات، لم يلد ولم يولد، وليس له أبوان ولا أولاد، وهو منزّهٌ ومبرّأٌ من كل هذا القبيل مما يوصف به المخلوقات ويُعدّ نقصًا بالنسبة له عما يقولون علوًّا كبيرًا.
وهذه الآيات تُبيِّن مدى قيمة الأسباب والطبيعةِ والمادةِ والطاقةِ، كما أنها تضيف التأثير الحقيقي إلى الله وحده وتُذكِّر بلزوم اتخاذ الموقف تجاه الشرك وكل ما ينبعث منه رائحة الشرك، وأنه إنما ينبغي مراعاة الأسباب؛ لأن الله أمر بها، وتُنبِّه في ضمن ذلك إلى أنه لا بد من ربطِ كلِّ ما يَجري في الكون من الأحداث بذاته تعالى في كل الأحوال والأوضاع.
أجل، يجب على المؤمنين أن يُصغوا ويستمعوا إلى هذه السورة التي تعبر عن هذه الحقيقة العظمى فتطهر قلوبهم وضمائرهم من جميع أنواع الشرك وشوائبه، وتجعلها طاهرة نقية.
إنه من المُتَحَتِّم على المؤمنين خصوصًا في هذا الزمان الذي سهُلت فيه طرائق الحصول على العلم وأصحبت وسائل النشر المكتوبة والمرئية التي تَنشر الحقائق القرآنية متاحةً سهلةَ الوصول؛ أن لا يتساهلوا في قضية حقيقة التوحيد، وأن يستغلوا هذه الإمكانات التي أتاحها الله تعالى في سبيل الإيمان بالله ومعرفته ومحبته.
فالقرآن الكريم يوجه مثل هذه الدعوة السامية إلى اليهود والنصارى -وإن لم يستوعب المشركون ذلك- فيلفت أنظارهم وأنظار أهل العلم من بينهم فيقول: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/64).
إن تخلُّص العلوم من الانحراف منوطٌ بتعرفها بالقرآن ضمن نظرة توحيدية من هذا القبيل.
“أيها النصارى واليهود وخاصة العلماء منكم، تعالوا نتّفق فيما بيننا على كلمة مشتركة بيننا؛ أي على توحيد الله، فإن الاتفاق في حقّ الله الذي يحتاج إليه كل شيء هو من القضايا الحيوية بالنسبة لنا ولكم، فهلمَّ إلى ترك عبادة غير الله، وعدم إشراك غيره به”؛ بمعنى ألّا نكون عبيدًا لغيره تعالى، ولا نبحثَ عن ندٍّ أو شريك لمن ليس له في ذاته ندٌّ أو شريك؛ لأنه هو وحده الذي يمسك بالكون ويديره في قبضة تصرفه، وكل الأنظمة والكائنات بمثابة الذرة تجاه عظمته وألوهيّته، وبالتالي فإذا كان -سبحانه- ليس له ند أو شريك وإذا كنّا -كباقي عمومِ الكون- محتاجين ومدينين له سبحانه، فتعالوا لا نسرف على أنفسنا بأن نتخذ له في خيالنا ندًّا أو شريكًا، وعلينا ألّا ننحرف عن طريق الحق بأن نتخلى عن الله ويتخذ بعضُنا بعضًا أربابًا؛ فإننا إذا عبدنا غيره، وأعرضنا عنه باحثين عن الفوز والفلاح في وديان أخرى فإنه لن تقوم لنا قائمة، فتعالوا نتوجه بكلّيتنا إلى الله”.
وإذا أعرض هؤلاء رغم كل هذا التحذير والتنوير، فقولوا لهم: “اشهدوا بأنا مسلمون”، وعليكم بعد كل هذه التحذيرات والتنبيهات والتنويرات وإشهاد العقل، أن تُشهِدوا وجدانهم وضمائرهم على أنكم أدّيتم المهمة، ثم انسحبوا إلى الوراء قليلًا.
إن الله تعالى في هذه الآية الكريمة كما يوجِّه النداء إلى جميع أهل الكتاب، ينادي كل أهل العلم والذين يجادلون في سبيل الكتاب ويبنون مؤسّسات في إطار الكتاب من الأجيال القادمة إلى يوم القيامة قائلًا:
“يا أهل العلم، تعالوا نتّفق في أمر قد تشاركنا فيه وأدركناه بقلوبنا وتقبلَتْه ضمائرُنا وصدَّقت به، وهو حقيقةُ أنه ليس هناك معبود مطلق سوى الله، فإننا مهما اشتغلْنا بفرعٍ من فروع العلوم، فإن هذه العلوم إذا لم تستند في نهاية المطاف إلى الله الذي هو الواحد الحقيقي والواجبُ الوجودِ، فلا مفرّ أننا سنلاحظ أنها بدون أصول وجذور.
إن الله أحدٌ، وأحديته ليست نسبيّة، بل هي ذاتية وحقيقية.
والحال أن أصحاب القلوب المؤمنة والقرآنية حينما يتناولون القضايا التي تتناولها العلوم فإن أرواحهم ووجدانهم وضمائرهم تستشعر بها بشكل مختلف تمامًا، فإذا حُلت المشاكل في هذا المجال وتم تخطيها، فستنجلي تلقائيًّا تلك القضايا الروحية والفكرية والعلمية التي كانت متأزّمة.
أجل، إن تخلُّص العلوم من الانحراف منوطٌ بتعرفها بالقرآن ضمن نظرة توحيدية من هذا القبيل.
المصدر: فتح الله كولن، البيان الخالد لسان الغيب في عالم الشهادة، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة.