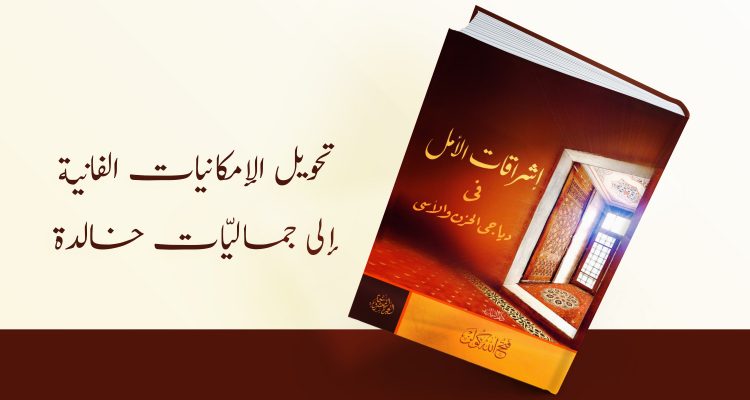سؤال: ما الذي ينبغي أن تكون عليه نظرة المؤمن إلى الدنيا حتى يتسنى له تحويل الإمكانيات الفانية في الحياة الدنيا إلى جماليات خالدة في الآخرة؟
الجواب: لقد خُلق الإنسان ورشّح للخلود، وذهنه منشغلٌ على الدوام في تصوّر السعادة الأبدية الخالدة، وعلى ذلك يجب على الإنسان أن يقدّر الدنيا بقدر فنائها والآخرة بقدر خلودها، ولو كان لنا أن نتحكّم في الطبيعة البشرية وسمحت الأحكام الدينية بهذا فأنا أعتقد أننا إذا ما فكّرنا في الدار الآخرة وخلودها سنقول: “يجب علينا أن نقطع صلتنا بالدنيا تمامًا ولا نيمّم وجوهَنا إلّا إلى الآخرة”، غير أن فطرةَ الإنسان وشهواته وضعفه البشري لا يُجيز مثل هذا الكلام، كما أن الكتاب والسنة اللذين شرعا الأحكام بما ينسجم مع الفطرة الإنسانية لا يُقرّرا مثل هذا النمط من الحياة، ومن ثمّ يجب على الإنسان ألّا يغضّ بصره عن القوانين التي أودعها صاحبُ الشريعة سبحانه وتعالى في الفطرة الإنسانية، وأن يكون على وعي لما هو مرشحٌ له ولنوعية المفاجآت التي تنتظره؛ بمعنى أن يسير في الطريق الذي رسمه له القرآن الكريم ويبتغي الدار الآخرة فيما آتاه الله تعالى، ويجعل لها الأولوية في حياته، ولكن لا ينسى نصيبه من الدنيا أيضًا.
مَن يكسب الدنيا برأس ماله هنا لن يبقى له رأسُ مالٍ يكسب به الآخرة، وسيذهب إلى هناك خالي الوفاض.
وفي هذا الصدد على الإنسان أن يعتبر رغباته وشهواته الدنيوية كَكِسرة خبزٍ أو قطعة عظمٍ -عذرًا لهذا اللفظ غير اللائق- ملقاة إلى نفسه، وبذلك يستطيع أن يواصل طريقه دون أن تغريه جماليّات الدنيا الفاتنة، بيد أن إدراك الإنسان بشكلٍ كاملٍ للدنيا والعقبى وما فيهما من ألوان ونقوش خاصّة بهما يتوقّف على المعرفة الحقّة، فمَنْ لم يستطع أن يُزيّن إيمانه بالمعرفة لا يستطيع أن يشعر بجماليات صعوبات الطريق الذي يوصّله إلى الخلود وإن كان مسلمًا، ومن ثمّ لا يناله إلا التعب والنصب في الطريق الذي يسير فيه.
إن المعرفة في حدّ ذاتها تولّد ضروبًا من المحبة كأمواج البحر المتلاطمة، وأما المحبة فتوجّه نظرَ الإنسان إلى المحبوب الحقيقي سبحانه وتعالى، ومن خلالها يتخلّص الإنسان من دغدغة المشاعر، فيطرح عَظْمَةً لرغبات نفسه وضغوطاتها ويواصل طريقَه، والدنيا مهما كانت فاتنة فعلى الإنسان ألا يثق بها، أما الشيء الوحيد الذي لا بد أن يوليه الإنسان الأهمية القصوى في هذه الدنيا فهو نشر الاسم الجليل المحمدي صلى الله عليه وسلم في كل أنحاء العالم، ورفع كرامة الإسلام الضائعة المنتهكة مثل الرايات التي ترفرف على الأبراج العالية.
إنْ شعَرَ العبدُ بالمعية في الدنيا روحيًّا وحسّيًّا وفكريًّا حظيَ بالمعية الحقيقية في الآخرة.
فلا قيمة للبقاء في الدنيا إن لم ترتبط قلوبنا بهذه الغاية السامية، فإذا جعل الإنسانُ غايتَه مسألة إعلاء كلمة الله وأن تكون الروح المحمّديّة روحًا للإنسانية، فلا غضاضة من بقائه في الدنيا إن كان يسعى لتعريف القلوب بروح سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حتى وإن عمّر ألفا إلا خمسين عامًا مثل سيدنا نوح عليه السلام، أما الحياة التي تمضي دون أن تكتنفها مثل هذه الغاية السامية فما هي إلا خداع يتوازى مع الإفلاس.
وا حسرتاه! لقد خُدعنا، خُدعنا بالتصفيق والأبهة والعظمة!
الحقيقة مع الأسف أن هناك كثيرًا من المخدوعين في هذه الدنيا، وفي الواقع لا يمكن التوصّل إلى قرار صائب في شيء ما إلا بعد تحديد قدر الأهمية التي نوليها له، فإذا ما وصل الإنسان إلى النهاية قد لا يستطيع أن يجد ما يأمله، وحينذاك يقول كالشاعر الصوفي الشيخ “غالب”:
وصلنا إلى ديار الحبيب فلم نلقه
ودخلنا الجنة ولكن هيهات أن نلقاهُ
بمعنى أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يحافظ على التوازن بين الدنيا والعقبى يظلّ في تعبٍ دائم وهو يظن أنه يعمل من أجل الدين، فإذا ما ارتحل إلى الآخرة لم يستطع أن يلقى أو يرى الحبيب سبحانه الذي تلتفّ حوله كلّ القلوب.
قد ينخدع الإنسان بالأعمال الخيّرة التي يقوم بها، بسبب أنها أعمالٌ يشوبها الرياء والسمعة والعجب والفخر وحبّ التقدير والتهليل، وبذلك يُحيل الإنسان أعماله الإيجابية التي بذلها طوال عمره إلى أعمال سلبية، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له:
“رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ”[1].
ومن الممكن ضربُ أمثلةٍ متعدّدةٍ ومتنوّعة، فيمكنكم أن تقولوا مثلًا: ثمّة كثيرون يسعون في طريق الحقّ حتى إنهم لو انتقلوا إلى الدار الآخرة ما استطاعوا أن يروا الحبيب؛ لأن هؤلاء قد دنّسوا الأعمال التي يقومون بها على متن هذا الطريق؛ فلم يراعوا آداب السير، وانحرفوا عن الجادّة، وأخذوا يتعثرون، ولا شك أن نهاية هؤلاء الذين تعثّروا في هذه الدار وضلّوا الطريق هي السقوط والتردّي كليًا -حفظنا الله- يقول تعالى:
﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ $ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾ (سُورَةُ القَمَرِ: 54/47-48).
وهنا يشير ربنا سبحانه وتعالى بهذا البيان الإلهي إلى أن الذين يعيشون حياتهم زاحفين لاهثين وراء شهواتهم وملذاتهم سيُسحبون في النار على وجوههم.
أجل، لقد وقع هؤلاء أسرًى لأهوائهم، وصاروا عبيدًا لأنفسهم، ومن ثمّ كان مآلهم الانكبابَ على وجوههم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، يقول تعالى حكايةً عن مثل هؤلاء:
﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ: 74/48).
وحتى لا نتعرّض لمثل هذه العاقبة الوخيمة في الآخرة علينا أن نراقب الله تعالى في كلّ أمور حياتنا، فلا بد أن يتقرّب العبد بشيءٍ من ربّه حتى يُقبل ربُّه عليه، فلو امتلأت حياة الإنسان بمشاعر التوقير والتعظيم والتبجيل لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أمدّه الله في الآخرة بيد العناية الإلهية، وخلّصه من الذل والهوان وهو في أشدّ الأزمات.
ومِن ثمّ يجب أن نملأ حياتنا بالأعمال الصالحة بقدر الاستطاعة، وأن نَجْبُرَ أوجهَ النقص والقصور عندنا بصِدْقِ النية وصفائِها؛ لأنّ في النية فيوضات وبركات خفيّةٌ تُفيد في جبر أوجه النقص والقصور، وإنّ قطرةً واحدةً منها لتملأُ البحار والأنهار، من أجل ذلك على الإنسان أن يوسّع من دائرة نواياه، فمثلًا عليه أن يقول: “اللهم زوّدني بالفرص والإمكانيّات حتى يتسنّى لي أن أغيّر مدار الكرة الأرضية؛ فيُرفرفَ الاسمُ الجليل المحمّدي في شتّى أصقاع الأرض”؛ لأن قطرةً من النية في هذه المسألة قد يُجازي الله تعالى عليها ثوابًا يعادل البحار؛ بمعنى أن الإنسان إن أنهك نفسَه في التفكير حتى كاد رأسُه أن ينفجر من أجل إنجاز الأعمال التي لا بدّ من إنجازها، ثمّ وصل إلى درجةٍ تتجاوز طاقتَه وقدراته استشفعَ بنيّته قائلًا: “اللهم إني عازمٌ على إنجاز هذا الأمر، ولكن طاقتي إلى هذا الحدّ، ولا أستطيع أن أصل بالأمر إلى أبعدَ من هذا”، حينذاك يقول له مَن لا حدّ لقدرته ولا نهاية لمشيئته وإرادته: “عبدي، سأصل بالأمر إلى ما لا تستطيع أن تصل إليه”.
مَن أحب الدنيا لم ينلْ الآخرة!
ولنا أن نربط هذه المسألة بما قاله الشيخ محمد لطفي أفندي رحمه الله تعالى:
ألا يحبّ المولى مَن أحبه؟
ألا يرضى عمَّن هرول لنيل مرضاته؟
لو وقفتَ له على الباب.. وفديته بالروح والنفس والأحباب…
وعملت بأمره، أما يُجزل لك الثواب؟
لو خررتَ خريرَ الماء، وانهمرت عيناك مثل أيوب بالدموع والبكاء…
واكتوى قلبك بالعشق والابتلاء، أما يُقبل عليك رب الأرض والسماء؟
فهذا الهم دواء للهم، والصمد سبحانه يحب مَن يهتمّ
ألم يُدرككَ فضل الواحد الأحد..فهو بلسمٌ لكلّ مغمومٍ مهتمّ؟
هذه هي خلاصة القول.
إنْ شعَرَ العبدُ بالمعية في الدنيا روحيًّا وحسّيًّا وفكريًّا حظيَ بالمعية الحقيقية في الآخرة، ومَن يعيشون هنا معًا يصلون إلى المعية هنالك، ولذا تمسّكوا دائمًا بهذه المعيّة وتعلّقوا بها، وادْعُوا الله دائمًا في توسّلٍ وتضرّعٍ: “اللهم معيتك، اللهم معية حبيبك صلى الله عليه وسلم”.
أشغلوا أنفسكم بذلك ليلَ نهار، والْهجُوا دائمًا بذكره؛ حتى تحْظَوا بهذه المعيّة عندما ترحلون إلى الآخرة، فلو دخلتم في معيّته هنا انهالت عليكم المفاجآت هناك، حتى تنسوا هذه الدنيا الكاذبة الخادعة التي خلّفتموها وراءكم، ولكن يا للأسف! اضطربت العقول في أيامنا وتشتتت المشاعرُ والأفكار، وأصبح الناس يفكرون في الدنيا أكثر من الحياة الأبديّة والذات الأبديّة.
الإنسان الذي لا يستطيع أن يحافظ على التوازن بين الدنيا والعقبى يظلّ في تعبٍ دائم وهو يظن أنه يعمل من أجل الدين.
ولو اطّلعتم على كلام الصالحين لأدركتم قدر معاناتهم وشكواهم من الدنيا. فمثلًا يقول “يونس أمره”:
عجزتُ أمام نفسي الظالمة
فهي لا تشبع من ملذّات الدنيا الغاشمة
والغفلة غشيتْ بصري
و العمرُ يمضي والنفسُ لا تدرِي
فهل تعتبر يا إلهي “مسلمًا”
مَن يتجلبَبُ بالغفلة ويتّبع هوى نفسه مسلّمًا؟
يكسب ثم يكسب ثم يضيّعه سُدى
وتأبى نفسُه أن ينفق قرشًا منه في سبيل الهُدى
إلهي، أزح عن عينيّ الغفلة والضباب
ولا تسوّد وجهي يوم تسودّ الوجوه وترجف الألباب
يقول يونس؛ أصغوا إلى حديثي ولو كان عجيبًا
من أحب الدنيا لم ينل من الآخرة نصيبًا
أجل، لا بد أن نكون على أهبة الاستعداد حتى نرى الحبيب ونلقاه، لن يضيع هناك ألبتة أيُّ كتاب عشقٍ سطّرتموه هنا، وعندما ترحلون إلى هناك يقولون لكم: ها هي الخطابات التي وصلتنا منكم، كما قال الشاعر نسيمي:
جاءني من الحق تعالى النداء
أن أقبل أيها العاشق فأنت مَحْرمٌ تستحقّ الثناء
وهذا مقام المحارم الأقرباء
وقد وجدناك أهلًا للبرّ والوفاء
فهل هناك قيمةٌ لأيّ مدحٍ وثناءٍ دنيوي إلى جانب هذا المدح والثناء الذي يُخاطب به الإنسانُ في الآخرة: لقد فُتحت القسطنطينية على يد السلطان الفاتح الذي “أفديه بروحي وإن كان لي ألف روح”، ولكن ما قيمة هذا الفتح بجانب السلطنة التي يهبها الله في الآخرة؟ إن هذا كله لا يعادل حتى الذرات بجانب الشمس.
يجب على الإنسان أن يقدّر الدنيا بقدر فنائها والآخرة بقدر خلودها.
الخلاصة: أنّ مَن يكسب الدنيا برأس ماله هنا لن يبقى له رأسُ مالٍ يكسب به الآخرة، وسيذهب إلى هناك خالي الوفاض، ولكن مَن استغلّ إمكانياته في سبيل الفوز بالآخرة انهالتْ عليه كثيرٌ من المفاجآت عندما يرتحلُ إليها.
بعدما أشار الحقّ جلّ وعلا إلى طبيعة الإنسان في سورة القيامة تحدّث عن العاقبة التي سينالها كلا الفريقين في الآخرة، يقول تعالى:
﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ $ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ $ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ $ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ $ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ $ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ (سُورَةُ القِيامَةِ: 75/20-25).
ندعو الله رب العالمين أن يجعلنا من أصحاب الوجوه النضرة في ذلك اليوم الرهيب!
[1] سنن ابن ماجه، الصيام، 21؛ مسند الإمام أحمد، 14/445.