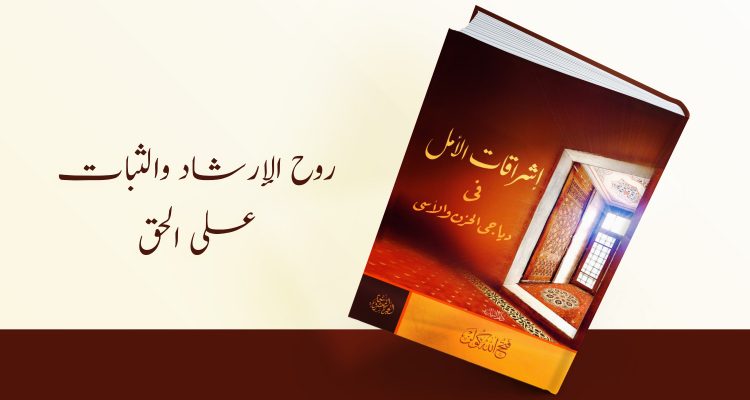سؤال: يقول فضيلة الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي: “إن ما في المصدر من قدسيّةٍ هي التي تحضّ جمهورَ الأمة والعوام على الطاعة وتسوقهم الى امتثال الأوامر أكثر من قوّة البرهان”[1]، فما معنى هذا الكلام؟
الجواب: يُقصد بجمهور الأمة والعوام هنا مَن لا درايةَ لهم بالعلوم الإسلامية، المقلّدون في حياتهم الدينية، المتعذّر عليهم النفوذ إلى روح الدين، فمثل هؤلاء الناس يجهلون غالبًا الأدلة العقلية والمنطقية والفلسفية، أو لا قدرةَ لهم على معرفتها؛ فالاستنباطاتُ العلميّةُ يصعبُ عليهم سبرُها، والعلومُ الوضعيّةُ يعانونَ في فهمِ مُعطياتِها، ومن ثمّ فلا جدوى من مخاطبتهم بالأدلة العقليّة والفلسفية، وهذا ما يُحتّم علينا إذا أردنا أن نحدّثهم عن أيّ حكمٍ شرعيٍّ فرضًا كان أم حرامًا، مباحًا كان أم مندوبًا، أن نقول لهم: “إن القرآن الكريم قد حكم بهذا في هذه المسألة، أو إن السنة الصحيحة تُقَرِّر هذا…”، فهذا الأسلوب هو الأكثرُ فعاليةً وإلزامًا بالنسبة لهم؛ لأن القرآن والسنة مصدران قدسيّان متينان في نظرهم -وهما بالفعل كذلك- لا بدّ من الاعتماد عليهما والامتثال لهما.
لذا يجب علينا في الحديث إلى العوام أن نبتعدَ عن التحليلات الفقهية والقواعد الكلّية، وأن نُعطي الأولويّة للآيات القرآنية وأقوال النبيّ صلى الله عليه وسلم وأفعاله؛ وبتعبيرٍ آخر: علينا أن نربطَ المسائل التي نرغب في الحديث عنها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقول مثلًا: “كان سيد السادات عليه ألفُ ألفِ صلاةٍ وسلامٍ يتعامل هكذا، ويجلس هكذا، ويقوم هكذا، ويأكل هكذا، ويشرب هكذا… إلخ”، فهذا الأسلوب من شأنه أن يكون أكثر إقناعًا وتوجيهًا.
نعم، إن المصدر الأساسَ هو الكتاب والسنة، ومع ذلك فقد نالت بعضُ الشخصيّات العظيمة ثقةَ الناس واحترامَهم؛ نظرًا لأن حياتهم كانت تتمحور حول الكتاب والسنة، ولا تحيد عنهما قيد أنملة، فصارت تُعتبر -بمعنى ما- مصدرًا نسبيًّا بالنسبة لمخاطبيها.
ثباتُ العلماء على الحقّ
يُروى أن الإمام أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله جلس بين يديه آلاف الطلّاب وكان بعضُهم من أمثال الأئمة أبي يوسف ومحمد وزُفر، كما كان يغشى حلقتَه الدراسيّةَ أيضًا العوام والعديدُ من الناس رغم أنهم كانوا لا يستوعبون تمامًا كلّ ما يُقال لهم، حيث كان من العسير عليهم فهمُ القضايا العلمية التي يُحدِّثُهم الإمام بها، ومناطاتها، ومبادئ أصول الفقه الخاصة بها، ومنهجية الاجتهاد، ولكنّ قُربَ هذا الإمام من ربّه وتبعيّته لنبيه صلى الله عليه وسلم وثباته على طريق الحقّ قد أحدث تأثيرًا أقوى من آلاف الأدلة في قلوب هؤلاء الناس.
وكذلك كان الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعًا؛ لم يتخلّ هؤلاء الأئمة قطُّ عن مواقفهم الثابتة على طريق الحقّ، فحافظوا على مستوى الشموخِ في مواقفهم إلى أن انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. أجل، قُيّد الإمام الشافعي بالسلاسل بأمرٍ من الحكام المسلمين وأُتي به إلى بغداد من أجل استجوابه، ولكن لما رأى مَن حوله غزيرَ علمِه وعمقَ معرفَتِهِ أعرضوا عن أذاهم له، وأكبروه وعظّموه، كما زُجّ بالإمام أحمد بن حنبل في السجن وضُرب بالسياط وتعرّض للإيذاء الشديد، ومع ذلك لم يُغيّر موقفَه قطّ، وإذا ما نظرنا لاحقًا إلى الإمام الغزالي رحمه الله لألفيناه رجلًا راسخًا لا يحيد عن الحقّ قيد أنملة، يستهلك كلّ طاقاته ليبعثَ روح التجديد في أعماق الأمة عبرَ شروحٍ تتناول القضايا الدينية بشكل جديد ومنظارٍ فريد… وإنّ جمهور الأمّة والعوام لما شاهدوا هؤلاء العلماء وشهِدوا مواقفهم الثابتة على الحقّ اتخذوهم مرشدين لهم جديرين بالاقتداء والاتّباع.
الثبات على الاستقامة في الدعوة إلى الحقّ
ولقد سارَ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله رحمةً واسعةً على نفس الطريق وذاتِ المنهج؛ فحاول أن يكون صوتَ عصرِهِ وصداه، وسعى إلى أن يقيمَ صرح الإيمان مجدَّدًا بما جاء به من أدلةٍ عقلية ومنطقية وعلمية يواجه بها الضلالات الناجمة عن العلوم والفلسفة، واجتهد في عرض الإسلامِ عرضًا يتوافق مع العقول وينسجم مع الأرواح والمشاعر، ولو نقَّبتم ومحَّصتم فيما صاغه من أفكار لتوصلتم إلى الكثير من الدرر واللآلئ في أعماقها، كما أنكم إذا ما ألقيتم نظرةً على كتابه “الملاحق” لتَعَرَّفْتُم على ما وضعه من دساتير تعصم أتباعها من الزيغ والانحراف وتُنير الطريق أمام من يبغي خدمة الإيمان والقرآن، وإنه -رحمه الله رحمةً واسعة- وإن لم يُدبّج مؤلفًا من مؤلّفاته التي تحار دونها العقول إلا أنّ موقفه الثابت الذي حافظ عليه في حياته التي تخطّت عتبةَ الثمانين عامًا كان يروي غُلّة الكثيرين. أجل، كان رحمه الله يعبّر عن هذه الحقائق التي لا تسعها المجلدات بثباته وشموخه.
وقياسًا على الواقع فإن عوامّ المؤمنين قد وثقوا منذ أمدٍ بعيدٍ بهؤلاء الفضلاء الذين بلغوا هذا المستوى من التوجه إلى الله، واطمأنّوا إلى كلامهم وأفعالهم فاتبعوهم واقتدوا بهم، غير عابئين بالاستدلالات العقلية والقياسات المنطقية، متّخذين من مواقف هؤلاء موقفًا لهم، ومن وجهتهم وجهةً لأنفسهم.
الانبعاث في أفق القلب والروح
ظهرت حركات الانبعاث والتجديد في أزمنةٍ مختلفة على أَضْرُب متفاوتة، بيد أن نجاح عمليّة التجديد في المجتمع كان محصورًا بمن اتجهوا إلى عالمهم الداخلي، واستغرقوا في محاسبتهم لأنفسهم، وعاشوا وفقًا لأفق أرواحهم، وقضوا عمرهم في فلك الحياة القلبية والروحية، ولم يكن النجاح حليفًا لأولئك الذين أهملوا أفق القلب والروح، واكتفوا بعقلهم ومنطقهم فحسب، وأخذوا يحدّثون الناس بعلمٍ يعوزه العمل.
لقد كان أبطال القلب والروح يربضون خلف حركات الانبعاث والتجديد، ويمكننا أن نمثّل لهذه الأنفاس الباعثة على الحياة بعددٍ لا حصر له من أرباب القلوب على اختلاف مشاربهم ومسالكهم؛ فهؤلاء العظام نذروا أنفسهم في سبيل الحقّ، دون تشوّفٍ أو تفكيرٍ إلى أيّ أجرٍ دنيويٍّ أو في أيّ ثمرةٍ تُجنى من العمل، بل ربّوا في المحيط الذي شكّلوه حولهم رجالَ قلبٍ وروحٍ أعظم ممن تُرَبُّونهم وتُعَلِّمُونهم في ألفِ مدرسة من مدارسكم.
ولا يُفهم من كلامي أنه لا بدّ من غَلق الباب دون العلم والحقائق العلمية، أو أن العلم والحقائق العلمية غير صالحَين بالنسبة لنا، فلا جرم أن العلم وسبلَ تحصيله والحقائق العلمية تُعدّ مقوماتٍ مهمّةً لانبعاثنا من جديد، أما ما نتحدّث عنه هنا فهو ما تُحدثه قدسيّةُ المصدر من تأثيرٍ بالغ الأهمّيّة؛ لأن هذا أمرٌ يتخلّله الصدق والإخلاص والقرب من الله والارتباط به والولاء له، وإنّ هذه العناصر لتحوي أسرار التأثير العميق في نفسِ المخاطب.
[1] بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات، اللوامع، 826؛ المكتوبات، نوى الحقائق، 572.