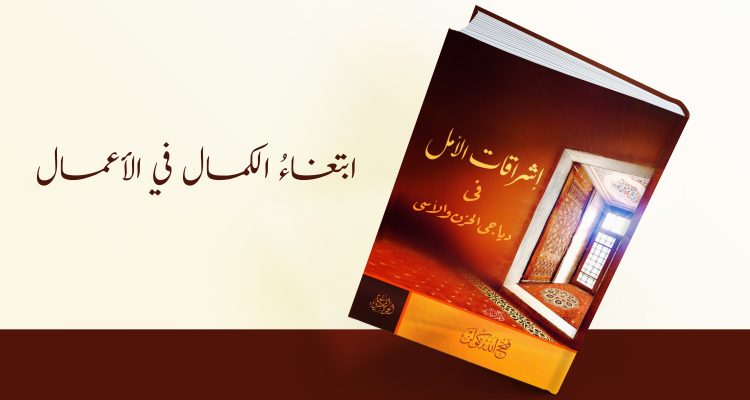سؤال: يقول الحقّ سبحانه وتعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ (سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 5/3)، ففي هذه الآية ربطَ الحقُّ سبحانه وتعالى رضاه بالأكملية والأتميّة، فما هي مناطات تحقيق مثلِ هذه الأكملية والأتميّة المرجوّة؟
الجواب: إن الإسلام عبارةٌ عن حِزمةٍ من القِيَمِ التامّة الكاملة التي لا يشوبها نقصٌ ولا قصور، ومن شأنها أن تلبّي متطلبات كلِّ المجتمعات مهما تنوّعت وتعاقبت إلى قيام الساعة، ومن ثمّ فعلى أتباع هذا الدين الخاتم الذي بلغ الله به حدَّ الكمال والتمام أن ينشدوا الأكمليّة والأتمّيّة في كلِّ شيء؛ أي أن يتحرّوا الدقة والكمال في أداء وظائفهم ومسؤولياتهم؛ حتى يتسنّى لهم الحصولُ -بالمعنى التام الكامل- على خير النتائج وأفضل الجماليات التي وعدهم بها دينُهم، فهذا هو سبيلُ أفق الرضا الإلهيّ، والآية صريحة في هذا المعنى.
“كلُّ خطإٍ وإخفاقٍ بسببي أنا!”
وإنّ تحقُّقَ أفق الرضا هذا متوقّفٌ على شروطٍ؛ أولها: أن يكون لدى الإنسان نيةٌ صافية وعزيمةٌ عالية موجهتان لاستغلال جميع الإمكانيات والقدرات التي وهبها الله له استغلالًا تامًّا على الوجه الأمثل والأكمل؛ فبعض الناس يمتلك نداوةَ الصوت، وبعضهم يمتلك مهارة القيادة والإدارة، وبعضهم يُجيدُ الكتابة والتأليفَ أو الكلام الجميل… لذا فعلى كلِّ شخصٍ أيًّا كانت قدراته ومهاراته أن يستغلّها إلى أقصى حدٍّ حتى يتسنّى له التعبير عن الحقّ والحقيقة، فإن لاحت في الأفق بعضُ الأخطاء والعيوب فعليه أن يفتّش عن عيب نفسه لا عن عيب غيره، وأن ينسبهما إلى نفسه مجتهدًا في البحث عن سبلٍ لتلافيهما.
ويجب على من وهبَ نفسه لخدمة الإيمان والقرآن -بغضِّ النظرِ عن الوظيفة التي يقوم بها في شتى مجالات الحياة- أن يعتبر نفسَه مسؤولًا عن عدم بلوغ هذه الوظيفة درجةَ الكمالِ والتمام والإتقان، وأن ينسب إلى نفسه كلَّ مشكلة تحدث.
والحق أن العبدَ لو قال في نفسه: “لـم أستطع أن أؤدّي بحقٍّ المسؤوليّةَ الملقاة على عاتقي، لقد قصّرتُ في هذه الوظيفة حتى باتت لا تؤتي ثمارَها باطّراد على الوجه الأمثل، وإنّ ما اقترفتُهُ من أخطاءٍ هو السبب في ذلك”، فهذا القول يُعَدّ توبةً ضِمنيّة، بل إنابةً أو أوبةً حسبَ اتساعِ قلبه وعمقِ مداركه، ولا شكّ أن الله تعالى يستجيب بلُطفه وكرمه دعاءَ مثلِ هذا القلب المهموم، وسَيُنعم عليه -إن شاء- بمزيدٍ من فضله وعنايته حتى يتدارك ما وقع فيه من أخطاء.
ولكن إن نظرَ الإنسانُ بِعينِ الكمالِ إلى كلّ أعماله، واعتقد أن أفعالَه معصومةٌ عن أيِّ قصورٍ أو خللٍ، وأنَّ خططَه ومشروعاتِه بلغت من الدقةِ والكمالِ درجةً يكاد أن يكتشف بها حتى السموات، ثم عزا كلَّ الأخطاء إلى أنَّ مَنْ حولَه لا يصغون لكلامه ولا يفقهونه ولا يطيعونه؛ فإنّ هذا هو عينُ الهذيان الفرعوني القائل: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾ (سُورَةُ النَّازِعَاتِ: 79/24)، إلا أن التعبيرَ عنه جاء بأسلوبٍ مختلِف.
نعم، فلا بدّ من التناسب الطرديّ بين ما يقوم به الإنسان من أعمال وبين محاسبة النفس عما يصدر منها من زلّات وهفواتٍ، ولا بدّ أن تتعمّق المحاسبة أكثر فأكثر كلّما ازدادت أعباءُ الوظيفة؛ بمعنى أنه كلّما ازدادت الدوائرُ المتداخلة التي يعمل الإنسانُ في إطارها كلّما كان عليه أن يعزو لنفسه شتّى الأخطاء والإخفاقات التي تقعُ في أيّ دائرة منها؛ فينبغي له أن يُفتّشَ عن الأسباب في طيّات نفسه، وأن يحمّلها مسؤوليّة ذلك كلّه، لأنّها لم تستطع أن توثِّقَ صِلتَها بالله جلّ في عُلاه، ولأنّها لم تستشعر الإسلام بكلّ جوانحه، ولم تستوعبِ الدساتير التي وضعها سيّد الأنام صلّى الله عليه وسلّم، ولم تُقيِّم الظروف التي تعيشُ فيها، ولم تتعرّف جيدًا على الخصوم.
كلُّ جمالٍ منه، وكلُّ خطإ وقصورٍ مِنّا
والحقّ أن القرآن الكريم قد وضع دستورًا واضحًا في هذا الأمر، والآية التالية تُغني عن كثيرٍ من الكلام، يقول تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (سُورَةُ الشُّورَى: 42/30).
وهنا يُبيّنُ الحقّ تعالى أن ما يقعُ من أخطاء وثغراتٍ ناجمٌ عما رنتْ إليه أعينكم، وسمعتْ به آذانُكم، وعالجته عقولُكم، وتشدّقت به أفواهُكم، وأمسكتْ به أيديكم، وخطَتْ إليه أرجلُكم، وعبّرتْ عنه مشاعرُكم… إلى غير ذلك من الأمور التي تتنافى والغايةَ من الخلق، ويعفو الله عن كثير.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ”[1] ، مشيرًا إلى أن الإنسانَ بفطرته مهيّأٌ للخطإِ وعُرضةٌ له، لكن المهم هو أن يعيَ خطأه فيعمل على تداركه، فنجد حتى الخلفاء الراشدين يلومون أنفسهم بعبارات مثل: “ليتني فعلتُ هذا، وددتُ أنِّي لم أفعل هذا…” أجل، لقد كان هؤلاء الخلفاء العظام يحاسبون أنفسهم، ولا يستنكفون عن كشف بعض الأخطاء التي اعترتْ أعمالَهم -عِلمًا أن أخطاءهم وهم المقربون حسناتٌ بالنسبة لغيرهم-.
استقراء الحوادث بشكل صحيح
ينبغي للإنسان أن يعتقد بأنّ المحن والمصائب التي تُلمُّ به إنما هي من عند نفسه، حتى وإن لم تكن مرتبطة من جهة ظهورها بإرادته وحتى إن لم يَتعمّدها أصلًا؛ فمثلًا عليه ألا يعتبر الشوكة التي يُشاكُها في قدمه أمرًا عرضًا أو صدفةً إن جاز التعبير، بل عليه أن يعتقد أنها نتيجة عيوبه وأخطائه الشخصيّة، وللتوضيحِ والتمثيلِ أَسُوقُ الحادثة الآتية فأقول: “إن لكم صديقًا يحقن نفسه بالإنسولين مرتين أو ثلاثًا يوميًّا، فإنه إنْ سقطت من يده حافظةُ إبرة الحقنة فعلّلَ ورَبَطَ ذلك بأنه “لم يبدأ باسمِ الله تعالى” قائلًا: “إلهي! لو أنني بدأتُ باسمك لَـمَا سَقَطَتْ هذه من يدي”، وكذلك أيضًا لو أصابت الإبرة عصبًا أو شعيرةً دمويّةً في بدنه أثناء الحقن فسال منه الدمُ عَزَا الأمرَ إلى انحرافاته وعدم استقامته في الفكر وعجزِه عن الصلة بالله تعالى والارتباط به؛ هذا هو التصرّف والسلوك الواجب علينا اتخاذهُ وانتهاجه تجاه الابتلاءات والمصائب، فالإنسان إنْ لم يؤمن بأنّ ما يصدر من نقص أو خلل أو عيب نابعٌ من نفسه ولم يسائِلْها عن ذلك؛ عجز -مدى حياته- عن التخلُّصِ مطلقًا من سوء الظنّ واتّهام الآخرين، بل إنه يظنّ دائمًا أنّ من حوله من الناس هم مَنْ يُـحَوّلُ تصرّفاته وسلوكيّاته الإيجابية إلى سلبية ويُعرّضُ أعماله للخطر، ونظرًا لعجزه عن رؤية عيوبه وإدراكِها فهو عن تدارُكِها وتلافيها أعجزُ.
هذا وإنّ الإنسان الذي يُدرك أخطاءه ويعِيها يفكّر في الأمر مليًّا كلّما واجهته حادثة سلبيّة، ويبدأ في البحث والتنقيبِ عن سُبُلٍ بديلة تكفلُ سلامتَهَ من الوقوع في الخطإِ نفسِه مجدّدًا. أجل، إن الإنسان الذي يَعتبر أنّ الفشلَ والخطأَ نابعٌ من ذاته يتحرّك لاحقًا في إطار المنطق والعقل كي لا يقع ثانيةً في المشكلة ذاتها، ويسعى لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، فمثلًا: إنّ الإداريَّ الذي يتولّى إدارةَ وتوجيه مجموعةٍ من الناس، إذا ما نشبَتْ خلافاتٌ بين أفرادِ مجموعته فإنّه سيأخذُ الدروسَ ويستقي العِبَر من ذلك، ويدرس جميع الاحتمالات حتى يمنعَ تكرُّرَ المنغّصات نفسِها مرةً أخرى، ويُنتجُ حلولًا متعدّدةً تحسُّبًا لأيّ طارئٍ محتمَل؛ أي إنّ الخططَ والمشاريعَ التي يضعها ويُقرُّها ستحتوي من البداية على حلول بديلة متعدّدة ومختلفة لمواجهة المشكلات المحتمَلَة.
الرجوع إلى العقل المشترك
هناك مبدأٌ مهمٌّ يكفُل تحقيقَ الأعمال كاملةً وتامّةً كما خُطِّطَ لها، ويحمي الإنسانَ من الوقوع في الخطإ والزلل، ألا وهو “الرجوع إلى العقل المشترك”، وقد بيّنَ سلطان الكَلِمِ صلى الله عليه وسلم أنه “مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ”[2]، انظروا: إن سيدَنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رغمَ أنه مؤيّدٌ بالوحي ومرتبطٌ بما وراء السماوات، فإنه يُخضِعُ كلّ أمر للمشورة والرأي؛ إذ كان يستشير أصحابه مــمّن علّمهم هو صلى الله عليه وسلم ماهيّة الدين والحقّ والحقيقة والمشورة. أجل، كان يُنحّي رفعته وتفوُّقَه المطلقَ جانبًا، ويشاور أصحابه بشأن المشكلات والنوازل بصفته واحدًا منهم، لقد كان سيّد السادات صلى الله عليه وسلم يُفعِّل هذا رغم أنّه معصومٌ من الخطإ؛ إذًا فإن أفضل الطرق لتقليل احتمالية الوقوع في الخطإِ من أمثالنا من البشر -الأكثر عرضة للخطإ والزلل- هو إحالة المسائل والقضايا والنوازل إلى نظر العقل المشترك.
وإنّ الفرد والمجتمع اليوم ليعيشُ في مواجهة مباشرة مع سلسلة من المشكلات، فإن لم تُعْمِلوا آليّة الاستشارة التي تستطيع أن تحُلّ أعتى المشكلات المستعصية وتُفَعِّلُوها، فإنكم ستقعون تحت وطأة سلسلة من الأخطاء، ثم يُداخلكم إحساسٌ بالذنب، فتبحثون حولكم عمن ارتكب هذا الذنب، وفي النهاية لا يبقى قلب حولكم إلّا وقد حطّمتموه، ولا إنسان إلّا وقد أغضبتموه، ورغم أنّ الذنب والقبحَ من عند أنفسكم فإنكم لا تفتؤون تتّهمون مَنْ حولكم، وتُزعْزِعون ثقتهم بكم؛ فتُبعِدونهم عنكم وتُنَفِّرُونهم منكم، وكما قال الشاعر:
لا تدوم الدولة والملك لأحد
ولا الفضة والذهب ولا العيش الرغَد
أما الفن والمهارة فإصلاحُ قلبٍ خربٍ
هكذا علَّمَنا الأحدُ الفردُ الصمد
لو بقي الذهب والفضة لأحد ونَفَعَاهُ لكان قارون أولى بذلك، ولكنه خُسف به الأرضَ مع خزائنهِ، وليس هذا فحسب، بل إنّ الناسَ سيظلّون يخسفون به الأرضَ معنويًّا كلّما قرؤوا قول الله تعالى: فَ﴿خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ $ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (سُورَةُ القَصَصِ: 28/81-82)، ومن هنا فإن الفن والمهارة والحذقَ الحقيقي في إصلاح القلوب لا في تحطيمها، وكما يقول “يونس أمره”:
جئنا لنُشَيّد القلوب ونبنِيها لا لنهدمــــها أو نُفنيــــــــــــها
أجل، إن وظيفتنا هي إصلاح القلوب وعلاجها لا هدمها وتخريبها، لذا فعلى الإنسان ألا يَنسِبَ إلى الآخرين ما ارتكبه هو من أخطاء، وألّا يتّهمهم بما قارَفَهُ من زلّات؛ فهو بذلك يحطّم ويهدم قلوبًا كان ينبغي له أن يُشيّدها ويبنيها.
[1] سنن الترمذي، القيامة، 49؛ سنن ابن ماجه، الزهد، 30.
[2] الطبراني: المعجم الأوسط، 6/365؛ المعجم الصغير، 2/175؛ القضاعي: مسند الشهاب، 2/7.