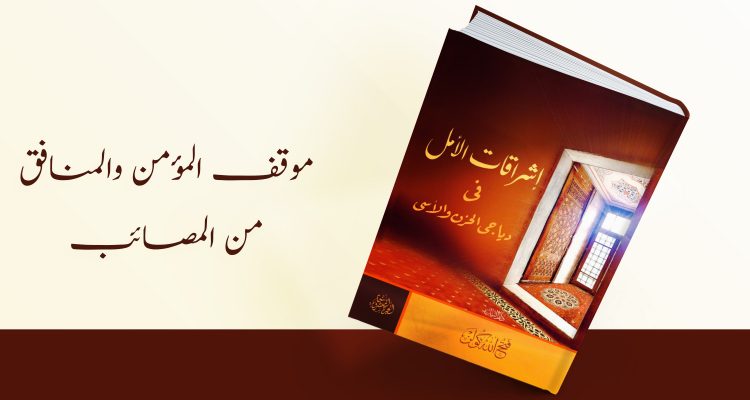سؤال: شبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف له المؤمنَ بالزرع والمنافقَ بشجرة الأَرْز، فما معنى هذا الحديث؟
الجواب: تعددت وجوه رواية هذا الحديث المشار إليه في السؤال؛ فاختلفت ألفاظه، ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ، لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ”[1].
وتشبيهُ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنَ بالزرع إنما يدلّ على أن الزرع هو خيرُ مثالٍ للتعبير عن حال المؤمن إزاء ما يواجهه من بلايا ومصائب، فلا يغيب عن علمكم أن الرياح إذا ما هبّت هزّت الزرع وأمالته إلى اليمين مرّةً وإلى اليسار مرّةً، وإلى الأمام تارةً، وإلى الخلف تارةً أخرى؛ وبالتالي يهيم الزرع بوجهه على الأرض، ولكن لا تكاد تهدأ الرياح والعواصف حتى يعاود الاستواء مرّة أخرى، وهكذا المؤمن يتعرّض دائمًا للبلايا والمصائب، ولكنّه -بفضل الله وعنايته- لا يسقط أبدًا وإن اهتزّ. أجل، إن المؤمن يتعرّض دائمًا لكثيرٍ من الابتلاءات والمصائب في هذه الدنيا حتى يرتقي معنويًّا، وتصفو طويّته، ويرجع إلى فطرته الأصلية، ويحافظ على شدّه المعنوي في كفاحه للشرور والآثام، إلى غير ذلك من الحِكم التي نعلمها أو لا سبيل لنا إلى معرفتها، وثمة مقولةٌ دخيلة على اللغة العربية مفادها “المؤمن بَلَوِيٌّ”؛ وهذا يعني أنّ المؤمن دائمًا ما يتعرّض للبلاء وتحلّ به المصائب كلّ حين، وكما: يقولون العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فقد جاء في الحديث الذي رواه سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: “الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ”[2].
وإذا نظرنا إلى المسألة من منطلق هذا الحديث سنجد أن آل البيت رضوان الله عليهم هم أكثر الناس تعرُّضًا للبلايا والمصائب، فلقد لاقوا شتّى أنواع العذاب والاضطهاد على أيدي مراكز القوّة والنفوذ؛ فقُطّعت أطرافهم، بل وشُنِق بعضهم، وذُبح البعض الآخر، ثم ارتحلوا إلى الحقّ تعالى بعد أن ذاقوا طعم الشهادة، ولكن مع هذا فإن ما أصاب هؤلاء أقلّ بكثير ممّا نزل بالسابقين الأولين، وما حلّ بالسابقين الأولين أقل بكثير ممّا لاقاه مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل إنسان ينزل به البلاء حسب مستواه وقدره وقيمته.
الثلوج والزوابع والعواصف تجد مكانها في الذرى
لما كانت الأرواح السامقة تتبوّأ مكانها دائمًا في الذرى العالية؛ فإن الثلوج إذا ما هطلت تجدها تهطل أوّلًا على هذه الأرواح، وإذا ما نزلت حبّات الثلوج اصطدمت بدايةً بهؤلاء، وعلى نفس الشاكلة تتحوّل رؤوس هؤلاء أوّلًا إلى كتلةٍ من الجليد؛ بمعنى أن هؤلاء هم أوّل مَن يتلقّى الضربات الأولى لكلّ شيءٍ، فمثلًا الإمام الغزالي لم يفهمه المجتمع الذي يعيش فيه خلال فترةٍ معينة من حياته، فتعرّض للتهجير؛ فأخذ نفسَه وانزوى بعيدًا عن أعين الناس، واضطرّ إلى أن يبيت وحيدًا بين المقابر، وإذا ما تأمّلنا في تضرّعات وابتهالات سيدي عبد القادر الجيلاني أدركنا جيّدًا قدر ما أصاب هذا الرجل الصالح من مصائب وابتلاءات، وكذلك لا يختلف سيدي أبو الحسن الشاذلي عن سابقَيه.
وإذا ما نظرنا إلى العصر الحالي وتأمّلنا المعاناة التي كان يكابدها مهندس الفكر في هذا العصر الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي سيُخيّل إلينا وكأن البسمة لا تعرف الطريق إليه، لقد جاء هذا الرجل العظيم إسطنبول وهو في ريعان شبابه، محمّلًا بأفكار رائعة لا تطرق أذهاننا اليوم حتى ولو في المنام ونظرًا لأن “مستشاري السلطان” لم يعقلوا ما جاء به فقد ألقوا به في مستشفى المجانين بحجّة أنه يهذي في كلامه، ولمّا وقف مستشارو السلطان في مواجهة هذه الأراء والأفكار تعذّر حتى على العقلاء من ذوي البصائر في زمانه أن يفهموا كلامه.
والحقّ أن الإنسان لا يصل إلى الكمال في الإيمان ما لم يُتّهم بالجنون بسبب إيمانه[3]، ولأن هذه القامة الشامخة قد بلغت الكمال في الإيمان فقد وصموها بالجنون.
بعد ذلك شارك الأستاذ النورسي في الحرب ضدّ الروس، فقضى أيامًا صعبةً في ظلّ الظروف القاسية هناك، ووقع أسيرًا، فتعرض في الأسْرِ للأذى والاضطهاد، ثم عاد إلى وطنه علّه يجد السعادة والهناء، لكنه تعرّض هذه المرة لتنكيلٍ آخر؛ حيث انزوى وحيدًا إلى غارٍ في مدينة “وَانْ”، فما لبِثَ أن قُبِضَ عليه فجأةً وهو يعيشُ عزلته هناك ولم يتخلّص -طوال خمس وثلاثين سنة عاشها بعد هذه الحادثة- ممّا يكنّه البعض له من مشاعر العداء في الدين، وما يضمره البعض الآخر من غلّ وحقدٍ وحسدٍ؛ فتوالت عليه الأحكام واحدًا تلوَ الآخر حتى إنه تعرّض للنفي والسجن والعزل والسمّ والمحاكمات وحُكم عليه بالإعدام، وغير ذلك.
كل هذا العناء يلاقيه هؤلاء ونحن نسمّي ما يصيبنا عناء!
حُمادى القول: إن أشدّ الناس بلاءً هم الأنبياء ثم الذين يلونهم، فالأقرب والأقرب كلٌّ حسب درجته ومرتبته، ومن أهمّ الحِكم في هذا الأمر أن هؤلاء الروّاد الذين تحمّلوا عبءَ الدعوة إن لم يتعرّضوا لمثل هذه البلايا والمصائب الكبيرة أخذ أتباعُهم ومَن ساروا خلفهم يشتكون ويتذمّرون مِن أدنى بليّةٍ تحلّ بهم، فقرصة البعوضة أو النحلة تؤرّقهم، وإذا ما رأوا عقربًا أو حيةً همّوا بالصراخ والصياح دون أن يقتربا منهم، ولكن إن رأى هؤلاء الأتباع الروادَ السابقين وهم يتحمّلون هذا القدر من المعاناة دعاهم ذلك إلى السلوى وقالوا في أنفسهم: كلّ هذا العناء يلاقيه هؤلاء ونحن نسمّي ما يصيبنا عناء! ولذا فإن أحوال مَن هم في موقع القدوة تنبئ بأمورٍ كثيرةٍ لمن يأتون من بعدهم، فمن ينظر إليهم ويشاهد الأحداث التي نغّصت عليهم حياتهم تختلف رؤيته ومشاعره وقراءته لتلك الأحداث التي مرّوا بها، وفي النهاية تحلو له الآلام التي يعايشها.
أما المنافق “وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ”
فقد شبّه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هنا المنافق بشجرة الأرز، ولا يعنينا هنا أن تكون الشجرة المشار إليها في الحديث هي شجرة السرو أو الصنوبر أو الأرز أو الدلب، أمّا ما يعنينا فهو الوصف الذي اكتسبه المنافق “لا تهتز حتى تُستحصد”؛ يعني أن هذه الشجرة التي تبدو ثابتة في الظاهر إذا ما تعرّضت لريحٍ شديدةٍ انخلعت من جذرِها وسقطت، ولم تستطع الاستواء مرة أخرى. أجل، إن ذلك المنافق الذي يمشي متبخترًا ويظنّ نفسه أنه غير معرّض للسقوط إذا ما اعترضته ريحٌ شديدةٌ سقط على الفور وعجز عن الاعتدال مرّة أخرى، أما الزرع فسرعان ما يستوي مرّةً أخرى وينهض مهما كانت شدة الريح التي عصفت به.
وهنا ملمحٌ لطيفٌ يرِدُ بالخاطرِ ويتعلّق بهذا الحديث الشريف: قد يهتزّ المؤمن ويتمايلُ منفردًا فيدورُ رأسه ويعشى بصره إزاء ما يُلاقيه من مغرَيات، فيتعرّض لهزّةٍ مؤقّتةٍ إن سلم نفسه للذنوب والآثام.
ومن ثمّ يجب علينا أن نأخذ بيديه ونسدي له النصح ونرشده إلى الطريق القويم، ونخلّصه ممّا تردّى فيه، وهذا أمرٌ يسيرٌ عمله بالنسبة للفرد الواحد، ولكن إن عمَّتِ البلوى وانغمس المجتمع كلّه في الذنوب، تفحّم من داخله وسقط سقوطًا مدوّيًا يشبه سقوط شجرة الدلب الضخمة، ولذا علينا أن نمدّ أيدينا إليه، ونساعده على القيام مرة أخرى، ونبثّ الحيوية فيه مجددًا، وهذا بالطبع أمرٌ شاق كثيرًا مقارنةً بما نفعله مع الفرد.
ولكن يجب أن تكون هذه الغاية السامية هي هدف تلك الأرواح التي نذرت نفسها لإقامة دين الإسلام المبين، بمعنى أنّ على هؤلاء أن يحتضنوا جميعَ شرائح المجتمع وأن يكونوا هم القلب النابض في كلّ مكان، وأن يدلّوا المجتمع الذي يعيشون فيه على طرق الانبعاث من جديد؛ لأن الوظيفة الأساسية والمسؤولية الحقيقية التي تقع على عاتق هؤلاء هي رفع شجرة الدلب الساقطة مرّةً أخرى، وبعث الحيوية والطمأنينة فيها من جديد.
[1] صحيح مسلم، صفة المنافقين، 58.
[2] سنن الترمذي، الزهد، 57؛ سنن ابن ماجه، الفتن، 23.
[3] يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ” (مسند الإمام أحمد، 18/195؛ أبو يعلى: المسند، 2/521).