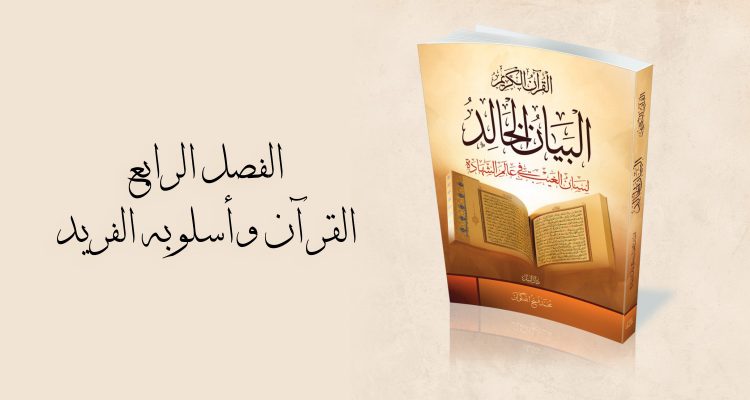لقد نزل القرآن على جماعة شبه بدوية، وقد كانت غريبة عنه غربةَ إنسان عصرنا عن معظم ما جاء به القرآن بل كانت أكثر بعدًا وأشد غربة، فقد قضوا جل حياتهم في صراع وتناحر.
أجل، فهؤلاء الذين كانوا يعيشون حياتهم هائمين على وجوههم بلا هدف وبدون غايات سامية، لم يبلغوا يومًا ما النضج الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، ولم يستطيعوا أن يكوِّنوا -ولو في إطار القبيلة- جماعةً واعية ووحدة مثالية.. وكانوا يتفاخرون بما يفعلون أمام أصنامهم التي أحاطوا بها الكعبةَ، وكانوا يُسَلُّون بهذا أنفسهم، وكان القليل من أهل العلم من مثقفيهم يَعتبِر هذه الأصنام مجرد وسائط مقرِّبة إلى الله، وهذا
ما تميزوا به عن بقية المشركين.
وهكذا استُخدم الشعور بالعبودية الكامن في فطرة الإنسان، في غير موضعه وأسيء استخدامه مرة أخرى، وتَعرَّضَ للخيانة، فقد عبدوا الشجر والحجر والتراب والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، حتى إنهم كانوا يعبدون ما تصنعه أيديهم من أطعمة مثل الحلوى أو الجبن أو التمر، ثم يأكلونها حينما يجوعون، وبلغ الانحطاطُ ببعضهم ممن غاص كلّيًّا في مستنقعات الجاهلية وتوحَّش إلى أن وصل لدرجة أنه كان يَئِدُ بناته ويدسُّها في التراب؛ فمنهم من كان يقوم بهذه العادة الوحشية الغريبة على أنها من عادات الجاهلية، ومنهم من كان يفعل ذلك خشية إملاقٍ، ومنهم من فعل ما فعل حفاظًا على عادات القبيلة اقتصاديًّا حتى لا يذهب المال لآخرين عن طريق البنات.
أجل، لقد كانت الإنسانية في أَزْمة أخلاقية واجتماعية كبيرة، فإلى جانب آلاف الفظائع التي كانت تُقترف في ظلمات الصحراء، كانت الحُفر التي يحفرونها تمتلئ بالكثير من أرواح الأطفال التي أزهقوها ظلمًا وعدوانًا.
حقًّا لقد فاق البشر الضباعَ في الوحشية، ولم يعُد لِمن ليس له أنياب حقٌّ في الحياة، وكان مصيره أن يتمزق بين فَكَّيْ ذئاب البشر.
وفي هذه البيئة التي حاولنا أن نصوّرها في إشارات عابرة، اختارَ القرآنُ من المادة المعرفية ما يتناسب مع الجميع بشكل مثالي للغاية فأذهلَ عقولهم؛ حتى إن راعي الإبل الذي قضى عمره في الصحراء إذا توجَّه إلى القرآن بقلبه، يتزلزل كيانه وترتعد فرائصه جراء ما يعتريه من الخشية عند سماع تعبيرات القرآن الفريدة.
وفي هذا ما يدلّ على أنه لم يتوجه بتعبيراته الفريدة إلى عِلْية القوم، بل جاءت تلك التعبيرات بلغةٍ مفهومة وواضحة لكل مستويات العقول والأفهام، سواء أكانوا من الخواص أو العوام، أو من الطبقة الأرستقراطية، أو ممن يَرعى البهائم على رؤوس الجبال، فالكل سواء في الاستفادة منه.
وكذلك كان أسلوب القرآن الكريم في معالجة كثير من الأمور، فهو لا يهتم بجانب ويغفل جانبًا آخر، بل يهتم بالجانب الروحي والمادي بكل مشتملاته؛ ففي حين أنه كان يعالِج القضايا الإيمانية من ناحية، كان -من ناحية أخرى- يتحدث عن السماوات والأرض ويُطْلِع مخاطبيه على نقاط غامضة لم تصل إليها مناظير علم الفلك حتى بعد أربعة عشر قرنًا.
أجل، إنه القرآن الكريم الذي لم يستطع أحدٌ أن يعترض على أسلوبه الراقي أو يستغرب بيانه الجليّ، ولو حدث ذلك على مر التاريخ لَانتهزَ أعداءُ القرآن ذلك ولتناقلت ألسنتُهم وأقلامهم ما يهمّهم منه وكأنه ملحمة، ولكانت تلك هي فرصتهم الذهبية الكبرى في ساحة عراكهم مع القرآن، وهذا هو مناط القضية.
وحينما ننظر إلى أمثلة القرآن نجدها مختارة بدقّة فائقة من واقع الحياة بالذات؛ فمثلًا، حينما يتكلّم عن السماء والسحاب يتناولهما في إطار حديثه عن سنام البعير، وحينما يتحدّث عن العظمة يضع ربوةً نصبَ الأعين، ثم يكبِّر هذه الربوة شيئًا فشيئًا إلى أن يوصلها إلى سدرة المنتهى، وبالتالي فالبدوي الذي يتجوّل على المرتفعات يستطيع أن يتخيّل سدرة المنتهى من دون أن يحمل مزيدًا من عناء التفكير.
فكان الجميع، يأخذ حظّه من القرآن بدءًا من الأمّي الجاهل وانتهاءً بالعبقري المتعمق في الأدب، فتراهم مندهشين من براعة أسلوبه ودقّة تعبيراته وبديع تصويراته -ولا يزالون كذلك- مما يحسّون به من تذوُّقٍ عالٍ لهذا التعبير القرآني.
ففي حين أن سيدنا بلالًا الحبشي كان يتلقّن درسه على حسب مستواه، كان صرح العلم وجبل المعرفة سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر الذي حاز وصف “رجل الدولة العظيم”، وغيرهم.. كانوا يأخذون حصّتهم من دروس القرآن.
أجل، مهما كان مستوى الشخص فإنه ما إن يدخل في المجال المغناطيسي للقرآن حتى ينجذب إلى القرآن فيتعلّق به قلبه ويظلّ يدور في فَلكه وكأنه مولويٌّ عاشق مجذوب.
ورغم أن القرآن نزل باللغة العربية، فإن كل مَن أصغى إلى صوت قلبه سينال منه متعةً معينة كما قيل في المثل: “لغةُ القلب والفطرة واحدة”؛ لأن لغة القلب لها وضع خاص للغاية، فكما يفهم القلب من كلام الله تعالى أشياء فإنه قد يفهم من لغة الشيطان أشياء أخرى، فانطلاقًا من هذه الحقيقة نقول: إنه لا بد من قراءة القرآن والاستماع إليه بلغة القلب..
إن القرآن يتناول الإنسان من جميع جوانبه، فيؤسِّس معه علاقةً عمادُها الإحساس والمنطق، ويمكن مشاهدة ذلك ظاهرًا جليًّا من خلال الأمثلة التي سنسردها فيما يلي؛ فالمثال الأول هو حول العالَم الداخلي للكافر، والمثالُ الثاني هو حول روحٍ اهتدت، ولكنها بقيت على الدوام في خطر..
المثال الأول:
آية كريمة تُقرِّر بأنه لا ينبغي السجود إلا لله، وتُصوِّر حالةَ مَن يستعين بغير الله لقضاء حوائجه فيخيب ظنُّه؛ وهذه هي الحالة المزرية التي يقع فيها أولئك الذين يدعون من لا يستحقّ الدعاء، فيقول الحق سبحانه: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ [أي له وحده استحقاق العبودية] وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ (سورة الرَّعْدِ: 13/14).
فهذا يعني أن الذي يستجيب الدعاء هو الله وحده، والذين من دونه لا يعرفون الدعاء ولا الهدفَ من الدعاء.
فليس لغير الله أن يستجيب الدعوات وليس له تحقيق المطلوب في الدعاء؛ لأنه غيرُ مطَّلعٍ على سرائر النوايا ولا يَعرف المصالحَ المتوائمة مع الفطرة، فالذي يرفع كفيه ويدعو غيره، يُتعب نفسه من دون جدوى.
ولا يستطيع أن يستجيب دعاءَ من يأتي إلى أعتاب بابه ويرفع كفيه متضرّعًا إليه -سواء أثناء الحاجة أو العبادة- إلا الله الذي هو مالك المُلك والملكوت؛ لأنه بيده زمام كلّ شيء ولديه مفاتيح كلّ شيءٍ، وهو وحده السلطان على القلوب، والمالك للكون، وكلُّ الخزائن والموجودات مُسَخّرة لأمره.. فليس للعبدِ أن يطلب إلا مِن مولاه ولا أن يتوجَّهَ إلا إليه .
والكافر يلقي بنفسه في سبلٍ مغلقةٍ لا توصله لمبتغاه، ويدقّ الأبواب الموصدة لتحقيق مطالبه لأنه لا يدرك هذه الحقيقة.
فالقرآن الكريم يشبِّه حال أولئك الذين يَطرقون الأبواب الأخرى مع علمهم بأنه ما من أحد يستجيب لهم إلا الله، بحال من وصل إلى منبعِ الماء فبسط يده علَّ الماء ينساب من تلقاء نفسه ليده فيبلغ فمه.
وما كان على هذا الشخص الذي بلغ به الجهد كل مبلغ في سبيل الوصول للماء من شدة عطشه إلا أن ينحني ويغترف من الماء ليشربه، أو أن يملأ إناءه ويروي ظمأه، ولكنه لن يبلّ صداه ويُذهب ما به من عطش لأنه سلك ما لا يوصِل إلى الهدفِ قطعًا؛ لذلك سيظلّ في تخبُّط وتحيُّر يدورُ في حلقةِ المستحيل المفرغة.
أجل، إن القرآن الكريم صوَّرَ حياةَ هذا البائس الذي لجأ إلى غير ربه وطرق غير بابه بأسلوبٍ وجيزٍ ولخَّص قصة حياته الطويلة في بضع كلماتٍ قليلة بتصوير لا يفُوقه أيُّ تصوير.
فإذا نظر الإنسان إلى القرآن الذي هو معجزٌ في كل جوانبه، وتأمل من خلال هذه الآية الكريمة فقط في حال الكافر؛ فإنه سيدرك تقلبات أحوال هذا الكافر ماثلة أمام عينيه واحدة تلو الأخرى، وسيرى خيبته وفراغاته القلبية وخواءاته الروحية، وذلك مما يزيد المؤمن إيمانًا بربه ويوصله إلى يقين تام بأن القرآن ليس إلا كلام مالك كل الكائنات ومدبر أمرها.
المثال الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/103).
فهذه الآية الكريمة تخاطب تلك الجماعة التي هداها الله وتوحدت قلوبها بفضله، فعاشت حياة الإسلام ولبست نعمته بعد أن كانت على وشك السقوط في الهاوية، فهي تخاطب الأرواح من طرف خفي فتذكِّرهم بنعم الله عليهم وإحسانه إليهم؛ حيث كانوا أعداء فجمع بينهم بأخوّة الإسلام فأصبحوا جسدًا واحدًا وبنيانًا متراصًّا وكلًّا متكاملًا ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة الأَنْفَالِ: 8/63)؛ فالآية الكريمة تحثهم على التمسك بتلك النعم العظيمة وأعظمها نعمة توحيد القلوب، لأنه ليس لأحد أن يتحكم في القلوب ويؤلّفَ بينها إلا الله.
وهناك بُعدٌ عميقٌ تشير إليه هذه الآية، فهي تلفت النظر إلى شخصية فظّة رغم أنها ما زالت في الدنيا، فإنها تشعر وكأنها في جهنم فما تذرُ من شيء إلا حطّمته، ولأنها
لا تؤمن بالله فهي لا تعيش بأمان ولا تبعث في نفوس غيرها أيّ طمأنينة.
وإذا تعمّقنا في معاني هذه الآية وأمثالها فسنرى أنها بأساليبها وتعابيرها تشكّل في وجدان الإنسان شلالات من المعاني المتدفقة فتنصبُّ في حوض ذهن الإنسان مئات من التصويرات الفائقة الهادفة، ومن غير المتصوَّر أن يكون كلام الله على خلاف ذلك.
أ. الإنسان مولعٌ بالجمال
إن الإنسان ميّالٌ بفطرته إلى الأمور الجميلة، فهو يعشق كل ما يراه جميلًا ويعشق أسباب الجمال ويحبّ دوام الجمال؛ فكما أنه يحبّ الزهرة فكذلك ينظر إلى الربيع العظيم أيضًا بكل إعجاب.
والقرآن الكريم يركِّز في مواضع مختلفة على هذا الجانب من الإنسان، ويتحدّث عن هذا النوع من أحاسيسه ومشاعره، ثم يُذكِّره بما وُهِب من آلاء كثيرة فيُثير ما في دواخله من مشاعر الامتنان.
أجل، إنه يُعدد للإنسان ما بُسِط له على وجه الأرض من أصناف النعم، ويدعوه إلى أن يكون متنبّهًا يقِظًا، فبهذا الإشعار والإرشاد منه تعالى يتولد في داخل الإنسان توجّهٌ للشكر وشوقٌ عميق لهذه النعم التي لا تُحصى.
وقبل أن نورد الأمثلة على ذلك لنتنبّه إلى أن القصد منها تبيان روح القرآن في هذا الباب وأسلوبه البديع المتداخل مع الفطرة وليس المقصود أن نتحدّث عن مجرد الجنة أو النار.
والأمثلة التي تُهيِّج شوق الإنسان وتثير مشاعره، وتحفّزه نحو جماليّات العوالم الغيبية من الكثرة بحيث إننا سنكتفي هنا بقطرةٍ من ذلك المحيط:
﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ
كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ
إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (سورة الدُّخَانِ: 44/51-56).
إن لكل إنسان آمالًا ورغبات لا تعدّ ولا تنتهي، فكلّ واحد يريد شبابًا دائمًا، وعيشًا آمنًا خالدًا يتنعّم فيه مع رفيقة حياة تؤنِس وحدته وتشاركه همّه وفرحته وتزيل وحشته، بين ظلال الأشجار على ضفاف الأنهار؛ ولأن خير النعم ما دامت فهو يتمنى دوام كل ذلك دون انقطاع.
والإنسان الذي يحزن لذهاب شبابه، لن يكون سعيدًا ما دام يرتعد خوفًا كلما فكّر في ذهاب مختلف النعم؛ واللذة التي تزول ليست لذّة، بل هي في الحقيقة نقمة ومصدرُ ألمٍ لمن يرجو بقاءها؛ ورغم ذلك يعتقد الإنسان الذي يسبح في بحر النعم أنه سيظلّ في نعيم دائم.
فالقرآن الكريم يعبِّر -بين فينة وأخرى- عن مشاعر الإنسان ورغباته في هذا المجال؛ فتراه يفرِّح الإنسان بالبُعد الآخر من الوجود، باستخدام تعبيراته التي تستجيب لرغبات وحوائج بني الإنسان من كل المستويات، بدءًا من أدنى أمّيٍ وبدويٍّ، إلى أرقى متحضّر مدني.
و”المتقي” مشتقّ من التقوى، وللتقوى أبعاد كثيرة.. والمتقي بالمعنى الواسع: هو المؤمن الذي يُحلُّ ما أحله الله ويقنع به، ويحرّم ما حرم الله ويجتنبه، ويحترم كل الأحكام الشرعية، ويعيش مطيعًا للأوامر الإلهيّة؛ فما هو إلا “رجُل الإحسان” الذي يحمل في جوانحه وهو في دنياه همّ الحساب في آخرته.
فهؤلاء في الآخرة ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾، ونحن لا نعلم كيفية هذا اللباس، لأنه من عالم الغيب فهو فوق تصوُّرنا، لكننا على يقين أنه من أجمل الألبسة التي تُناسِبنا، فالله المدبّر لهذا الكون جعل لكل شيء ما يتناسب مع خلقته، وذلك من مقتضى تمام القدرة الإلهية والعظمة الربانية.
ومشاعر الإنسان تجيشُ تجاه هذا التصوير القرآني الرائع، فإنه حينما يرتشف كوثر البيان الإلهي يتنفّس الصعداء ويرتاح ويسرَح بخياله في أفياء الجنان والبساتين الخضراء، ويمرح بين أنهار تجري وتتفرّع في كل مكان.. هذه المشاعر تُثير في كثير من النفوس موجات من الجيشان فتجعل صاحبها -وهو لا يزال في الدنيا- وكأنه لابسٌ من سندس وإستبرق، ويمشي في تلال الجنة الزمردية.
وفوق كل ما سبق تُذكِّرنا الآية الكريمة بالأمور التالية:
كما أن الله أنشأَ الكائنات ومدَّ الأرض وما عليها أمام الأنظار وسخّرها لخدمة الإنسان، فكذلك وَضَعَ عالَمًا آخر أروع منها يُرضي فيه عباده الأوفياء؛ فما الدنيا والآخرة إلا كتابان أحدهما صورة من الآخر؛ فالذي أنشأَ هذا العالمَ قادرٌ على أن يُنشِئ العالَم الآخر الموعود على صورة الأوّل، بل ويزيد في خلقه، وللمؤمنين في ذلك العالم نِعَمٌ تفوق حدود التصوّر حيث سينالون سعادةً ما كانت تخطر لهم على بال.
وكذلك تضمنت الآية الكريمة مصيرَ وجزاء أولئك الذين لم يؤمنوا ولم يحترموا الكون وخالقَ الكون، بأنهم سينالون من العذاب أشَدَّه، وحديث الله للمؤمنين عن هذه الفئة يُذكِّرهم ببُعدٍ آخر للنعمة، فهذه الحقيقة التي تَرِد في آخر الآية تَرْفَعُ أهلَ السعادة إلى أعلى درجة باعتبارها أعظم النعم.
أجل، فحتى من خلال هذه الآية القصيرة التي ذكرناها تَبيَّن أن القرآن الكريم لم يهمل أي جانب من جوانب الإنسان، بل أرضى رغبة جميع مشاعره الإنسانية بأروع صورة، وأثار فيه الشوق نحو العوالم الغيبية.
وخلاصة القول: إن افتتان الإنسان -كما يُفهم من الآية- بما هو جميل أمرٌ فطري وطبيعي للغاية؛ فالله الذي أودع فيه هذه المشاعر، قد شفَّر الآيات القرآنية والكونية بهذه المشاعر وأودعها في أحاسيس الإنسان، ولكن رؤية كل ذلك وإدراكه إنما يكون بتطوير البصيرة والفراسة والفطنة ونحوها من القوى الإدراكية عن طريق الأفعال الإرادية.
ب. الإنسان ينفر من القبيح
لقد حاولنا آنفًا أن نبين من خلال بعض الأمثلة كيف أن الإنسان مفطورٌ على الولع بالأمور الجميلة، وكيف أن القرآن يُحرِّك هذه المشاعر ويُثيرها.
ومن المفيد الوقوف عند هذه النقطة ثم النظر إلى الوجه الآخر لهذه اللوحة؛ فالإنسان المولَع بالأشياء الجميلة يحمل -في الوقت ذاته- في داخله الإحساسَ بالنفور تجاه الأمور القبيحة. تُرى، من أين ينبع إحساسه هذا؟ قد يكون من المناسب أن نبحث عن الجواب على هذا السؤال في القرآن الذي هو منبع الحلول لكلّ مشكلاتنا.
إن القرآن يثير مشاعر البغض المغروزة في فطرة الإنسان، ويحرّكُها فيتخذُها وسيلة للوصول إلى الأهداف التي يُتوصَّل إليها بالمحبة، فهو من جانبٍ، يَعرض للأنظار الجنةَ التي تفوق حدود التصوّر، ومن جانب آخر، يُصور جهنم بكلّ ما يثير مشاعر الدهشة والكره ويقدمها لوجداننا في صورة منفّرة: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (سورة الدُّخَانِ: 44/43-49).
ففي حين أن أهل الجنة يتنعّمون بكلّ نعمها ويتلذّذون بأطايب طعامها وينهلون من سلسبيل شرابها نجد أن شجرة الزقوم أمَّ ثمرات الجحيم الخبيثة هي طعامُ أهل النار الذي تتمزّق منه الأفواه، وتتقطّع منه البطون ويا ويلهم من هذا “الطعام”؟!
أجل، يُفهم من خلال هذا التصوير القرآني أن أهل الجنة حينما يرون حال أهل النار يُدركون مدى ما هم فيه من النعمة بكل جلاء ووضوحٍ؛ وبالمقابل حينما يَرى أهل النار الجنةَ يدركون مدى ما حُرموا منه من النعمة.
فما أروع التصوير القرآنيَّ والكلماتِ التي يختارها القرآن في ذلك، والمواضيعَ التي وردت فيها هذه الكلمات؛ حيث تبدأ الآية بالحديث عن الزقوم، فإذا كان الزقوم سيُؤثر في الجسم تأثير المعدن الذائب دائم الغليان، فإنَّ تصور وقوع هذا الغليان في جوف الإنسان يثير كل ألوان الرهبة وصنوف الرعب.
وفي التعيبير القرآني هنا بـ”المُهل” (أي المعدن الذائب) إشارة إلى نكتة لطيفة؛ حيث إن الجميع يعرف أن الماء حينما يصل إلى درجة معينة من الحرارة فإنه يغلي وله أزيزٌ عالٍ، ولكن كثيرًا من الناس لم يكونوا يتصوّرون تمام التصوّر في تلك الأيام التي نزل فيها القرآن كيف أن المعادن من أمثال الحديد والنحاس والفولاذ تُصهر في البوتقات تحت درجات عالية من الحرارة، فالقرآن الكريم لِيوضّح هذا الأمر لأهل ذلك العصر مثَّل لهم بغليان الماء الذي يعرفون كيفيته، فبذلك التشبيه قرّب إلى أفهامهم شجرة الزقوم.
أجل، ما أشد وقْعَ هذه التعبيرات على الأسماع! حقًّا إنها تُعبّر عن فجاعة هذه العاقبة الوخيمة التي تنتظر أمثال قارون والسامري الذين قضوا حياتهم الدنيوية أعزّاء كرماء، ولكنهم لم يتفكّروا فيمن أغدق عليهم تلك النعم ولم يُدركوا الغاية منها! نعم، سيُقال لمن عاش حياته في الدنيا ناكرًا للنعم على هذه الشاكلة: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾، وسيُصبُّ عليه من فوق رأسه الماءُ المَغليّ.. فالإنسان أمام هذا التصوير القراني الرائع يرتعدُ كلُّ كيانه خوفًا من هول جهنم فيلتجِئ إلى الله.
وهناك مثالٌ آخر يتعلّق بالموضوع، وهي آياتٌ من سورة النبإ: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ (سورة النَّبَأِ: 78/21-23)، ومن الجدير ذكره أن المُدود التي فيها هي أيضًا تُشارك المعنى والمضمون في التصوير؛ ففي معرض الحديث عن خلود أهل النار نجد أن كلمةَ “فيها” التي تُمَد مدًّا منفصلًا تعبِّر بجرَسِها عن هذه المُدّة المديدة، وإضافةُ كلمة “أحقابًا” التي تشير إلى الأبدية تؤكِّد على مكوث أهل النار
إلى الأبد.
فكلّ ما هنا من الأصوات والنغمات والتناغم الموسيقي والمدود تتآزر وتتناغم للتعبير عن هذه المعاني، ويمكن القول بأن هذه الخاصية موجودة في جميع القرآن. أجل، إنه لا يوجد فيه ولو كلمة واحدة تَنْبو عن موقعها أو تصطكّ بالآذان، بل إن كل كلمة.. بل كل حرف فيه إنما هو موجةٌ تعبيرية تتلاقى مع الموجات الأخرى بانسجامٍ علويٍّ فريد.
إن القرآن الكريم يُردف الحديث عن مَشاهد أهل النار بذكر الحظوات التي ينالها أهل الجنة، فيجمع بين الترغيب والترهيب، والإنذار والتبشير؛ لينفذ إلى دواخل الإنسان، فيثير كل أحاسيسه ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ (سورة النَّبَأِ: 78/31-34).
فالقرآن يتحدّث بأسلوبه الراقي العظيم هنا عن دخول المتقين الجنة وما يحظون فيها من النعم، ولا يصوِّر الباطل، ويتحدّث عن كل الأمور بشكل يتناسب مع الفطرة الإنسانية، فبتصويره هذا يُلهب شوق الإنسان إلى الجنة، فيتمنى أن يدخلها بحيث
لا يخرج منها أبدًا.
وهكذا تَبيَّن لنا من خلال ما سبق أن القرآن الكريم إذا تناول مثالًا من الأمثلة، يتخيّر الألفاظ التي يعبر بها فيقدّمها بأسلوب يتواءم مع المعنى المقصود وكأن الأداء والصوت يسوقك للمعنى؛ أي إن القرآن حينما يريد إيصال أي معنى فإنه يرسمه في لوحة يتناغم فيها مع الحروف والأصوات، وأحيانًا أخرى يصور طبيعة الأشخاص وشخصياتها، وبذلك يحقق ما يريد من الانسجام بشكل معجز، فتعبير القرآن عن أي شيء لا يكون إلا بصورة متكاملة الأجزاء من الصوت والأداء بحيث تكون قد وصلت إلى نقطة الكمال.. وفي النهاية لا يبقى للإنسان إلا أن يقول: ما هذا إلا كلام الله.
ج. القوة التعبيرية للقرآن
وبعد الحديث -ولو قليلًا- عن كيفية تعبير القرآن عن مشاعر الإنسان، لنتحدّث ببضع كلمات عن المادة التي يستخدمها القرآن:
إن كون الكلام معجزًا، لا طاقة لجميع البشر على معارضته، وتحدّيه على مدى التاريخ لجميع دهاة القول وأرباب الفكر لَيدلُّ على أن كلماته التي وردت في تراكيبه ليست كلمات عادية، بل هي ألفاظ نورانية لها عمق استثنائي ولها لون يخصّها، ولذلك هي مادّةٌ لتعبيرات تفوق حدود تصوّرنا.
فلذلك نرى أن القرآن المعجزَ البيانِ حينما يختار ما يورده من الكلمات يتّخذ أسلوبًا لا مجال فيه للَّبس والإبهام، وحينما نبحث في هذا الموضوع نلاحظ أن هذا الاختيار يقع على شكلين:
الأول: أن الكلمة استُخدمت مباشرة في المعنى الذي سيقت له.
الثاني: أنه لو استُبدلت هذه الكلمة الواردة بكلمة أخرى، لوجدتَها نابية عن مكانها، ولظهَرَ أنها لا تفي بالمعنى المراد على الوجه المطلوب.
ولنوضّح ذلك بإيراد الأمثلة، ولعله من المفيد أن نورد الأمثلة من الشق الثاني الذي يلفت النظر بشكل أكثر:
المثال الأول:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/168).
فالملاحَظ هنا باختصار: هو أن الآية تريد أن تنهى المؤمنين عن الانقياد للشيطان وعن اتِّباعه.. فالكلمة التي اختيرت هنا هي قوله تعالى: “لَا تَتَّبِعُوا” وهي مشتقة من تَبِع، وهي تدل على المعاني التالية:
1- أن يتّبع الإنسانُ شخصًا ويمشي وراءه..
2- أن يتوافق الإنسان مع شخص ويصبح كالقمر بالنسبة إليه.
3- (وإذا كان من باب الافتعال يكون المعنى:) أن تصير متابعة الآخرين طبيعةً للإنسان.
فإذا حلَّلنا الكلمة من خلال هذه المعاني تجلّت لنا الأمور التالية:
إننا إذا زدنا على الأصل الثلاثي للكلمة حرفين وحولناها إلى باب آخر، فستكون الكلمة منبعًا لمعان أخرى؛ بمعنى أن الكلمة حينما تكون في قالب فإنها تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه حينما تكون في قالب آخر.. ففي هذه الآية ورد فعلُ: “تبع” من باب الافتعال: فيكون المعنى على هذا: لا تُطيعوا الشيطان ولا تكونوا أتباعًا له، ولا تُحاولوا أن تتبعوا خُطاه بأن تدوسوا على نفس الموضع الذي يدوسه خطوة بخطوة.
كما أنه يفهم من ذلك معنًى إجمالي كما يلي:
إن الشيطان كائنٌ دسّاس، وحينما يقوم بوساوسه يقوم بها خفية، خطوةً خطوةً، في خطة محكمة؛ بحيث يصعُب على المرء إدراك ذلك؛ فهو يخطو خطوة ويجعل الآخرين يتابعونه، والإنسان الذي يتبعه يستصغر الأمر في أوله، قائلًا: “ماذا يضير؟ كل ما في الأمر خطوة! فيتابعه وهو لا يدري أن الشيطان سيجعله يردف هذه الخطوة بخطوات؛ فما هي إلا خطوتان، تتبعهما الثالثة… وبعدها يصبح عبدًا طائعًا للشيطان فيهوّن عليه المعاصي ويسهل له طريقها ويزين له المنكر حتى يؤدي به في نهاية المطاف إلى أوحال يستعصي عليه التخلّص منها.
فقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ يتحدث لنا عن اتِّباعٍ من هذا القبيل، فهذا الاتباع يكون في البداية من حيث لا يشعر به الإنسان، ولكنه في نهاية المطاف يتحوّل إلى مسيرٍ يُصبح جزءًا من طبيعة الإنسان وبُعدًا من سجاياه. أجل، إنه لا يتأتى للإنسان في كثير من الأحيان الإحساس به، وكثيرًا ما يُصبح الزمام بيد الشيطان عقب تلك الخطوة الأولى.. فبناءً على هذا نفهم من قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ تنبيهًا مفادُه: لا تجعلوا اتِّباع الشيطان طبيعة لكم.
إضافة إلى ما سبق تُصوِّر لنا الآية حالة نفسية أخرى للإنسان؛ فهو عندما يرتكب خطيئة أو يقترف ذنبًا يهوّن على نفسه قائلًا: “لا ضير، إنه أمر هين”، ولكنه لا يدري أن في الخطيئة مهما صغُرت طريقًا يؤدي إلى الكفر، فإذا لم يتب مقترف هذه الذنوب التي تبدو له صغيرة، فستتحول إلى ثعبان شرس يلدغ القلب فلا يصحو بعده، وهذه النقطة هي مرحلة الكفر، والعياذ بالله.. فالآية إذ تتحدث لنا عن هذه الخطايا تستخدم أسلوبًا يحس السامعُ من خلاله بوطأة الذنب وثقله في روحه.
ومن الممكن استبدال كلمة “لا تتبعوا” بكلمة مرادفة لها، لكنها لن تؤدي المعنى الذي تؤديه كلمة “لا تتبعوا” في التعبير عن أحاسيس الإنسان ومشاعره وعواطفه وطبيعته وسجيته، وبذلك لن تؤثر في السامع كما تؤثّر الكلمة الأولى.
أجل، إنها لن تعبر بهذه السهولة عن مراوغة الشيطان، ولا عن تفكيره بالاقتراب نحو الهدف خطوة خطوة، ولا عن انزلاق الإنسان نحو الكفر بالذنوب الصغيرة من حيث
لا يشعر.
ويتضح من الأمثلة التي سردناها إلى الآن، والتي سنسردها لاحقًا، أن القرآن يختار كل مادته كلمةً كلمةً وحرفًا حرفًا بدقة متناهية، حقًّا إنه كلامٌ لِقدير ذي جلال، لم يكن لأحد أن يأتي ببديل له ولن يكون.
المثال الثاني:
ومن الأمثلة البارزة التي تُبين أن الألفاظ القرآنية قد اختيرت بعناية فائقة، وأنه إذا بُدّلت هذه الألفاظ بغيرها فلا يمكن الحفاظ على نفس ما تؤديه هذه الألفاظ قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/38).
فهذه الآية تلوم أولئك المتكاسلين المتهاونين الذين تملّك شعورُ الراحة والدعة من أرواحهم، وبهجةُ الرياض والبساتين وحبُّ الدعة من نفوسهم فتخلّفوا عن الجهاد، فهم لا يُعيرون سمعًا لنداء الدعوة إلى الجهاد الذي يشترك فيه الجميع بأنفسهم وأموالهم فلا يبالون ولا يشاركون.. ففي سياق تصوير حال هؤلاء ورسمه بأبرز خطوطه يقول الحقَّ سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/38).
فكلمة “اثَّاقَلْتُمْ” هنا هي الكلمة المفتاحيّة التي تعبّر تمامًا عن المسألة، وهناك كلمات أخرى مثل: “تَثَاقَلْتُمْ” أو “ثَقُلْتُمْ”، تُفيد معنى المكوث بالمكان جراء الثقل، ولكن القرآن الكريم آثر كلمة “اثَّاقَلْتُمْ” المشتقةَ من الجذر نفسه، ولكن -كما هو معلومٌ لعلماء الاشتقاق- يوجد في هذه الكلمة من التشديد وطريقة التلفّظ بالكلمة ما لا يوجد في غيرها، كما أن ورودَ الفعل على هذه الصيغة له دلالة فريدة من نوعها في تصوير نفسيّة الإنسان الكسول الذي يتهاون عن الجهاد، فطابق ثقلُ اللفظ فيها ثقلَ ذلك المتكاسل.
المثال الثالث:
قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/31).
من البديهي أن رِجلَي الإنسان تحملانه في تنقّلاته.. فلنتصوّرْ أن هناك رجُلًا نحيلًا جدًّا ضعيفَ البنية خائرَ القوى رجلاه لا تقويان على حمله لكنه يحمل على ظهره حِملًا في غاية الثقل فكيف يكون حالُه يا تُرى؟ ومما يثير الاستغراب ويزيد الدهشة أنه يحمل بالإضافة إلى هذه الأعباء أحمالًا لغيره فيرزح تحتها خائر البنيان.
فهذه الآية تَذكُر لنا بتلك القوة التعبيريّة القرآنية الرائعة أن هذا الشخص لم يكتفِ بتورُّطه في المعاصي بل وَرَّط غيرَه، فحَمل أوزارهم مع أوزاره.. ويكفي لإدراك هذه الصورة وتلمُّس أجزائها أن يتصوَّر الإنسانُ صعوبة أن يرزح الجسم الضعيف النحيل مادّيًّا ومعنويًّا تحت ذلك الحِمل الثقيل.. وحينذاك يمكن للسامع أن يلاحظ مدى روعة القرآن ودقته في اختيار الكلمات لرسم هذا الموضوع.
أجل، إن هذه الآية الكريمة تُصوِّر لنا الذنب على أنه وِزر ثقيل يُثقل الكاهل ويُحني الظهر بين يدي المولى، ثم تذكر لنا كيف أن هذا العبء يُذِل الإنسان في الدنيا والعقبى.. فإذا استَحضر السامعُ كلَّ هذه القناطير المقنطرة من أعباء الذنوب وتصوَّرَ إلى جانب هذا العناءِ ما سيقاسيه هذا الإنسانُ في طريقه من منحدرات صعبة ومنعرجات قاسية، فسيدرك ما تحمله الكلمات من المعاني وما في المعاني من العمق مما يزيد التأثير إلى مدى يفوق حدودَ التصوّر.
أجل، إن الذين يحملون على ظهورهم الأحمال هم في الغالب مخلوقاتٌ من نوع آخر؛ لأن الإنسان لم يُخلق بتكوين يستطيع أن يحمل على ظهره الأحمال، إلا أن القرآن قصد مغزى جليلًا حينما عبر عن ثقل الذنوب بالأوزار، وكيفيةِ حملها، وشعورِ الإنسان بوطْأَتها على وجدانه، فحينما يتلو الإنسانُ الآيةَ بهذه النظرة فإنه يَشعر هو أيضًا بجميع ذنوبه وكأنه يحمل على ظهره عبئًا ثقيلًا.. وبهذا نلاحظ بجلاءٍ كيف أن القرآن يستخدم مادّته بدقة متناهية بحيث إننا لو بدّلنا هذه التعبيرت بتعبيرات أخرى لم تؤدّ نفس الغرض والموسيقى ولو كانت مرادفة لها.. وهذا أيضًا من الأمور التي تبرهن على أن القرآن معجز من هذا الجانب.
د. الترابط بين المبنى والمعنى في القرآن الكريم
إن الكلمات التي يختارها القرآن الكريم تؤدّي المعنى المراد من دون أي نقص أو خلل، ولا يمكن العثورُ على أيِّ نقص أو إهمال في هذا الباب، وهذا واقعٌ في كل الألفاظ القرآنية، وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل، وسنكتفي بمثالين تحاشيًا للإطالة:
المثال الأول: قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ (سورة فَاطِرٍ: 35/37).
فهذه الآية الكريمة تتحدّث عن الوضع المزري لأهل النار، وإطلاقِهم للعويل والصرخات، ويستخدم القرآن الكريم هنا فعل “صرخ” على باب الافتعال. ونلاحظ في ذلك عدة معان:
1- الصيحة الشديدة
2- البكاء والعويل بصوت عال
3- إطلاق الصرخات وطلب النجدة
4- صيحات أهل النار وصرخاتهم التي لا يُستَمَع لها
5- وَلْوَلَةُ المرأة الثكلى وعويلها على ولدها الميت
فالكلمة غالبًا إذا زاد مبناها تضاعف معناها، إلا أن “عويل المرأة الثكلى” كأنه هو المحور الأساسي لكل هذه المعاني؛ بمعنى أن حال أهل النار يشبه تلك المرأة التي فَقدت ولدها فاحترق فؤادها وأخذت تُطلِق الصرخاتِ يمنة ويسرة وهي تطلب النجدة ممن حولها.. فحينما يدلّ المعنى على هذا المؤدَّى، يدل اللفظ على نفسيتهم، حيث إن الخاء في “يَصْطَرِخُونَ” توحي -بجرسها وموسيقاها- بصيحات هؤلاء الذين فقدوا الأمل فبدؤوا يُطلقون الصرخات المتتالية في يأس وإحباط.
المثال الثاني: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (سورة النَّاسِ: 114/1-6).
فقد رُتّبت الألفاظُ على هذا النحو، وذُكرت الصفات مقدمًا حتى يبعث ذلك في النفوس نوعًا من الشدّ المعنوي تجاه ذلك الوسواس الخناس.
فهذه الآيات تتكلم عن وسوسة الشياطين وكيفية التخلص منها، إلا أن حديثنا سيكون عن المواءمة بين اللفظ والمعنى.
وقد ذكرنا فيما سبق أن الشيطان مخادعٌ للغاية، وهو بمراوغته يلقي في قلوب الناس الشبهات والدسائس من دون أن يحس به أحد، فهذه الآيات تنبه الإنسان تجاه حيل الشيطان الخفية، ونلاحظ أن القرآن الكريم إذ يتحدث لنا عن هذا الأمر يستخدم أسلوبًا يشعر الإنسان من خلال كل كلماته بهذه المراوغة الخفية.
فكل الآيات في هذه السورة تنتهي بحرف السين، وبذلك تلفت الأنظار عن طريق الجناس الصوتي إلى همسات الشيطان ووساوسه وفتنته، حتى يحذَرها الإنسان، ويُفهم من هذا أن كل ما لدى الشيطان من القوة والسلاح والأدوات إنما هو عبارة عن مكر ووسوسة؛ فهو يحاول أن ينتهز الأوقات التي يضعف فيها الإنسان ليغويه ويصرعه، وحينما يعقد العزم على الغواية فإنه يستعمل ألف نوع من مصائده الخفية ليقوم بعملية الإفساد في القلب والعقل، ويخطط لبسط نفوذه على الإنسان عن طريق التحكم في نقاط ضعفه.
إن هذه السورة إذ تحذّر الإنسانَ بكل حروفها من هذا الوسواس المراوغ، تحفّزه وتشوّقه في الوقت ذاته للتوجّه إلى ربه المطّلع في كلّ وقتٍ على كل شيء، ويمكن أن نتلمس من خلال كلمات سورة الناس أن هذه الروح الشيطانية موجودةٌ في كل روح خبيثة مثيرة للفتن؛ حيث إن الألفاظ تشارك المعاني بهمسها وصفيرها في الدلالة على الهمس والخفاء، وبالتالي فإن الإنسان مهما رفع صوته حينما يقرأ هذه الآيات فإنه لن يتغلّب على ما تدلّ عليه الألفاظ من الأصوات والنغمات.
ويمكن لنا أن نأتي بأمثلة أخرى لزيادة الإيضاح، إلا أن المساحة هنا لا تتسع لإيرادِ المزيد، فليس الهدف الحديث عن جميع ما في القرآن، بل المقصود إيراد بعض الأمثلة التي تدل على إعجازه من هذه الناحية أيضًا، حتى ننبّه العقول والضمائر والمشاعر والأذواق تجاه القرآن، ونستثيرها نحوه.
وقد تَبيَّنَ لنا من خلال ما سردناه من الأمثلة أن الكلمات القرآنية تُوائم بين اللفظ والمعنى؛ فكما أنها لا تهمل المعنى المقصود ولو بجزئية من جزئياتها، فهي تتمتع بنغم صوتي مختلف، فكل من يرغب ويحرص على قراءته فإنه سيتذوق من التناغم والموسيقى ما لا يمكن تقليده، وبالتالي فسيخشع تجاهه.
ونسأل المولى المتعالي أن يرفعنا إلى سماء القرآن معجز البيان.
هـ. الموسيقى اللفظية للقرآن الكريم
إن الإنسان من الكائنات التي تحتاج إلى الاستراحة بعد التعب، وهذه الحاجة فطرية فيه، وإذا لم تُلَبَّ الحاجاتُ الفطرية بِطرقٍ مشروعة، فسيحدث الانحراف نحو الطرائق غير المشروعة، لكن القرآن الكريم كما تولّى تلبية الحاجات الروحية فقد تولى تلبية المؤمن في كل الحاجات المشروعة؛ لأنه نزل ليحل المشاكل الفردية والاجتماعية.
والإنسان إلى جانب أنه كائن اجتماعي، فهو كائن حيٌّ مركّب وله خصوصيات كثيرة.. أجل، إن كل إنسان له مشاعر وأذواق وحالات روحية خاصّة، وإذا كان المجتمع المثالي لا يتكوّن إلا من أفراد مثاليّين، فعليه إذًا أن يُنشِئ أفرادًا مثاليّين للوصول إلى مجتمعٍ مثالي، وكمالُ أيِّ فردٍ من الناحية الروحية والأخلاقية منوطٌ بتربيته من كل النواحي، ومن هذا المنطلق فإن أوّل ما يجب فعله في أيِّ مجتمع هو إعداد أفراد نافعين للمجتمع والحياةِ الاجتماعية، والقرآن قد جاء بقيم مادية ومعنوية وروحية وأخلاقية واجتماعية ونفسية.. و-في الوقت نفسه- أتى بمنظومة تربوية من شأنها أن تكوِّن أفرادًا أقوياء ومجتمعًا متماسكًا.. وهو بهذا الاعتبار كتابٌ صمداني كاف وواف بجميع حاجات البشر إلى قيام الساعة.
ومن خلال ما سبق لعلنا نلحظُ أن:
1- القرآن يلبي حاجات الإنسان الفطرية في التمتّع بالنغم الصوتي
فلدى كل إنسان ميلٌ فطري نحو القول الحسن والصوت العذب، وقد طور الناس في كل أنحاء العالم آلاتٍ موسيقيّة مشروعة وغير مشروعة لإشباع هذه الرغبة الفطرية فيهم، فكلّ هذه الجهود تدلّ على فطرية ما لدى الإنسان من هذه الرغبة.
ولا مرية أن للمسلمين أيضًا ثقافة موسيقية تخصّهم، فالكتب الفقهية تناولت حكم الاستماع إلى الموسيقى وناقشته ووَضعت بعض الحدود بين المشروع منها وغير المشروع، ونحن نحيل الخوض في تفاصيل هذه المناقشات إلى تلك المصادر، وسنتكلم عن موسيقى القرآن.
أجل، فكما أن القرآن المعجز بيانُه دواءٌ لكل داء فهو من السعة والعمق بحيث يلبّي حاجات المؤمن الموسيقية في شتى أحواله، فيجوز له أن يستمع للقرآن قائمًا وقاعدًا وعلى جنْبِه وكل حين، وما ورد في بعض الكتب الفقهيّة مما يدلّ على كراهة تلاوة الإنسان للقرآن وهو يزاول عمله أو يمشي أو يستلقي، فهو أمر يتعلق بالآداب ولا يستند إلى دليلٍ قويّ، بل إن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورة آلِ عِمْرَانَ: 3/191)،
يحثّ المؤمنين -في ضمن ما يحث عليه- على أن يلهج لسانُهم بالقرآن في قيامهم وقعودهم وحتى حينما يكونون على جنوبهم، صحيحٌ أن تعظيم القرآن وتدبر معانيه أمر مهم جدًّا، إلا أن ذلك قد لا يتحقّق في كل حين.
وقد حاول بعض من لم يدرك هذا الجانب القرآني أن يجيزَ نوعًا من الموسيقى الصاخبة المستوردة من الغرب بزعم إشباع النهم العاطفي الفطري لكنه لم يدرك أنها لا تحرّك شيئًا من المشاعر المتجهة نحو المعالي، مثل الشوق إلى الجنة أو حبّ الوطن والأمة أو سائر المشاعر العُلوية الربانية بل على النقيض من ذلك؛ فكل القيم الصاخبة الدنيئة المستوردة تعكّر صفوَ قلوب أبنائنا وأرواحهم وعقولهم، وتُطفئ فيهم الجذوة الروحية الملائكية، وتوقظ كلَّ ما في ماهية الإنسان من المشاعر السفلية، وتُفسِد المشاعر العُلوية، وإذا استمع المؤمن إلى القرآن ولهجَ به لسانُه فقد لبّى حاجته بطريقٍ شرعي، وأشبع كذلك رغبة فؤاده المشتاق إلى المعالي، وبذلك نتخلّص مما يبعث القلق في قلوبنا.
إن المهمة الأساسية التي تقع على عاتق المؤمن هي أن يُثري جميع وقته بالقرآن، وأن يحاول فهمه بحقّ، ويسبر أغوار لغتِه، ويتابع المواضيع التي يتناولها من خلال أحد التفاسير، وإذا استطاع أن يسمع القرآن من قارئٍ يتلوه بأداء متميز، فإنه لن يحتاج إلى أمرٍ آخر، وهذا الأمر له علاقة بتربية المجتمع بأكمله.
أجل، إذا جُهّزت كل الأمكنة بدءًا من المسجد وانتهاء بالمنزل بأنواع الموسيقى القرآنية الربانية، وتذوَّقه الأفراد واستمرؤوه، وخالط شغاف قلوبهم فحينذاك يتّخذ المجتمع سبيله الصحيح.
ولقد قال الناس وكتبوا حول “الموسيقى القرآنية” إلى يومنا هذا أمورًا كثيرة، ولعل هناك من يستغرب هذا التعبير، ولكني أظنّ أن ذلك قد نشأ من الخطإ في فهْمِ المقصود بذلك أو أن القائلين بذلك لم يحسنوا التعبير عما يقصدون كما ينبغي.
أجل، إن بعضًا من الناس إذا ذُكرت عندهم الموسيقى يفهمون أمورًا مخصوصة، ويبنون أحكامهم بناء على ذلك الفهم، ولذلك عندما تُنسَب الموسيقى إلى القرآن يستغربون ذلك، ولكن كما عرفنا آنفًا فالقرآن له جرسٌ وأداءٌ وأسلوبٌ يخصّه، وله لحنٌ فريد في نوعه، وأحسب أن اللبس نابع من نظرتنا الضيّقة للموسيقى.
وإذا صحّحنا نظرتَنا إلى الأمر فلن تذهب أذهانُنا إلى تساؤلات من نوعِ: هل المقصود بذلك الموسيقى الكلاسيكية أم الحديثة؟ لأن القرآن المعجز البيان هو هو بكل جوانبه، ولبيانه وقْعٌ فريد في نوعه.
وكما أشرنا من قبل فإن القرآن يُخاطب فطرةَ الإنسان، ويستجيب للمشاعر الموجودة في فطرة الإنسان، وكما أن الإنسان تتحرّك مشاعره وأحاسيسه المكنونة إذا سمع صوتًا عذبًا فكذلك القرآن فهو على رأس أنواع البيان التي تهيِّج المشاعر الإنسانية على أحسن وجه، وإذا كان الإنسان ميّالًا بفطرته للشجاعة والبطولة والتضحية، فكذلك له ميلٌ نحو الصوت الحسن والترنّم الجميل، فإذا تحقق التوحّد بين القرآن وقارئه فإن قلبَ السامع ينتشي له بحيث لا يبقى بداخله ميلٌ ورغبة نحو أيّ شيءٍ آخر.
ولنوضّح ذلك بشيء من التفصيل:
قد يمتعض بعض الناس من بعض أنواع الكلام، لكن القرآن إذا تم أداؤه بروحه وحقيقته وإيقاعه فلن يمتعض منه أحد منصف.
وقد تطوّرت مراحل قراءة القرآن وفقًا لمفاهيم وتقاليد بعض البلدان؛ فمثلًا: أصبح من عادة القراء أن يقرؤوا القرآن حسب المقامات الموسيقية الكلاسيكية من الصبا والعشاق والحسيني والنهاوند والحجاز والعجم شيران والعجم كردي وغيرها.. ولا يزال في أيامنا هذه من يواصل ذلك نوعًا ما، ولعلهم توخّوا من وراء ذلك تقديم القرآن إلى السامعين بشكلٍ حسن حتى يزيدوا من تأثيره عليهم، وقد يكون هذا صحيحًا أيضًا.. إلا أن هذا التغيير الذي حلّ محل ذلك الأسلوب القرآني واللهجة القرآنية قد أحدث فراغًا هائلًا، لأن القرآن المعجزَ البيان له موسيقى خاصّة تتجلّى في وجوه قراءاته بكل تلويناته المتعدّدة وأدائِه الطريّ الذي لا تملّ المسامع منه، ولذلك إنني انطلاقًا من هذا الهاجسِ وبعد أن أقام الناسُ هذه الأمور مقام ذلك الإيقاع القرآني الخاص المبارك قلت في نفسي مرارًا وتكرارًا: إنه لا يجوز حبس القرآن في القوالب الموسيقية الضيقة، لأن ذلك لن يحافظ على كيفيته ولن يُبقي على خاصّيته المتجلّية في وجوه قراءاته وأدائه الطري الذي لا تملّ المسامع منه، وخاصة إذا تم أداؤه بتلك المقامات الفاسدة المملّة التي تؤدي إلى العبث بروحه، ففي تلك الموسيقى مدٌّ للصوت بدون مبرّر، ودندنة في الفم لا قيمة لها، وإدخالٌ للألفاظ والكلمات في أشكال تُحوِّلها إلى ألفاظ مهملة،
لا يخفى ذلك على أبسط العوام.
نعم، يمكن للإنسان أن يرى مثل هذه الانحرافات النغمية في أحسن القصائد الملحنة، إلا أن القرآن يأبى كل ذلك، ولا تناسبه التمديدات والترجيعات التي لا معنى لها، ولو في نهاية الآيات. نعم، قد يفعل البعض منا ذلك، ولكنه مناف لروح القرآن.. وقواعدُ التجويد تناسب روح القرآن، فالأساس هو مراعاة هذه الأسس أثناء قراءة القرآن، لأن كلّ كلماته وألفاظه جاءت موافقة لهذه القواعد، ولكي يبعث القرآنُ في النفوس الشوق والحماس لا بد أن تطبَّق هذه القواعد، حتى ينسجم القرآن مع جوِّه وأدائه، وعلى القارئ أن يراعي ما تستتبعه قراءته وتوقظ في داخله من المشاعر والأحاسيس، بدلًا من مراعاة القوالب الموسيقية الجافة.
فالقارئُ الذي أرخى لنفسه عنانها من هذا المنظور في شلال البيان القرآني سينسجم مع القرآن، وينتهي الزمان والمكان بالنسبة له فنجده قبل أن ينتقل من كلمة إلى كلمة إذا بلسانه يتلوها تلقائيًّا بما يناسبها من الصوت والجرس والأداء..
والقارئ الماهر يدخل إلى أعماق القرآن، ويسلِّم له قلبَه وأحاسيسه، ويصبح مهيَّأً بحاله وروحه لفهم معنى القرآن ومحتواه، فبعد هذه المرحلة يتدفّق من لسانه ما يترنم ويتغنى به من القرآن عذبًا فراتًا ينتشي منه السامعون ويخالط أفئدتهم.
ولو استطَعنا أن نُسمِع أجيالنا ما يقرؤه القراء المهرة الذين برعوا في هذا الميدان من التلاوات التي تجيش لها القلوب لأنقذناهم مما يريده الآخرون من إفسادٍ لأذواقهم وفطرتهم.
ولعلّنا أخطأنا بسبب ضيق الألفاظ حين وصفنا القرآن بأنه مثل قصيدة منظومة من حيث النغمة واللون والموسيقى وكنا نقصد إظهار حسنه البديع فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذلك.
والقرآن الكريم بعيد كل البعد عن الألفاظ والأشعار المنظومة التي تَنتُج عن القريحة البشرية وتنسكب في قوالب معينة، والقرآن ينص على ذلك حيث يقول: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ (سورة يس: 36/69).
وإذا كان الشعرُ سلسلة من كلمات محبوسة في قوالب الإدراك البشري، وتُستلهم من الطبيعة، وتنبع من فيض المشاعر؛ فإن القرآن لم يدخل قط تحت أسرِ ما في الشعر من الوزن والقافية، ولم يخضع لموازين معينة، فالآيات تشبه في بعض جوانبها نجومَ السماء الطليقة في فلكِها؛ فكلّ نجم مع أنه فرد تابع لمجموعة ينتظم في دائرتها، لكنه يلمع وحده أيضًا.. وكذلك كلّ آية من الآيات الكريمة أيضًا مرتبطةٌ في نظامها الداخلي بغيرها، لكنّك إذا تناوَلْتها بمفردها فإنها تفيدك معاني مستقلّة أيضًا.
ولم يحدُث في أي عصر من العصور أن ارتقى فكرٌ إلى مستوى الأسلوب القرآني فضاهاه في التعبير؛ لأن القرآن الكريم فاق الفكر البشري في كل الأزمان فلا قوالب ضيقة تحدّه ولا فكر بشري يدركه؛ لهذا ولذلك نلاحظ أن كل أنواع الموسيقى القديمة والحديثة تتقادم فتُتْرَك لكن القرآن لا يبلى، بل يظل على ثرائه وعمقه وجدّته بشكل
لا يقبل المقارنة.
ونختم هذا الفصل بسورة “العاديات” باعتبارها خيرُ مثال على ذلك: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ (سورة العَادِيَاتِ: 100/1-11).
تبدأُ الآيات وكأنها تُصوِّر ساحةَ معركةٍ، حيث نرى أن الكلمات التي اختيرت وما فيها من الجرس والصوت والموسيقى تجرنا إلى ساحة معركة حامية الوطيس، وتطوف بنا بين خيول تملأ المكان بما تثيره من النقْع والغبار، والذين يسرحون في عالم الخيال الفسيح ممن تعمقت آفاقهم حينما يقرؤون السورة ويُنصتون لهذه الموسيقى القرآنية سيسمعون بكل سهولةٍ تلك الشرارات التي تنطلق من فُوَّهات الدبابات، ومن حوافر الخيول، وما يُطلقه المجاهدون من صيحات وتكبيرات.
ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الأمر منوط بمستوى ذوق القارئ الأدبي، ومن الطبيعي تفاوت الأذواق فما كلّ أحد يتذوّق ذلك، وإذا توحّدت أجيالنا في المستقبل بالقرآن بتوفيق الله وعنايته فستستشعر بإذن الله كل خاصيات القرآن وستمتلئ حينذاك الأرواحُ والقلوب والمشاعر بدلالاته الفريدة.
2- ملاحظة بسيطة حول القرآن الكريم والصوت الجميل
إن كلّ الناس من لدن عصر السعادة (صدر الإسلام) إلى يومنا هذا قد اتفقوا على أنه يُستحسن تلاوة القرآن بأداء يهيِّج القلوب، وعمقٍ يفيض بالانشراح في الصدور.
وهناك عدة روايات حول قراءة القرآن بصورة جميلة، ومن ذلك:
1- عن البراء بن عازب أنه قال: سَمِعت النَّبِي قرأ في العشاء بـ﴿والتين والزيتون﴾، فما سَمِعت أحدًا أحسن صوتًا منه .
ولا بد لي من القول: إذا كان القارئ هو الرسول، والسامع صحابيًّا فليس من الممكن لنا أن نتصوّر مدى ما يحسّ به السامع من اللذة.
وهذا يعني أن صاحب القرآن إذا قرأه بطعمه الخاص وبأدائه الخاص وبإحساساته واستلهاماته الخاصة، سيجعل سامعه في غاية النشوة وهذا ما جعل أمثال البراء بن عازب ينتشون لِما يشعرون به من اللذة، فقد كانوا يستمعون إليه من سيدنا محمد الذي هو مهبط الوحي الإلهي، وهو خير من يقرؤه، وأحسن من يستشعره، وأفضل من يَعلمه ويفهمه.
2- عن البراء بن عازب أيضًا قال: قال رسول الله: “زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ” ، أي حسنوا ألسنتكم وأصواتكم بحيث تتناسب مع حسن الكلام الإلهي الذي هو حَسَن في حدّ ذاته.
وقد أحسَسْتُ بضرورة ذكر هذا التفسير على وجه الخصوص لأن بعضَ نقاد الحديث المتشدّدين، وبعض الظاهريين لا يقبلون بهذا الحديث رغم وروده في كتب الحديث الصحيحة ويقولون: “إن القرآن جميل ومزينٌ في حدّ ذاته، فلا داعي إلى تزيينه بالصوت، فينبغي أن يكون الحديث: “زينوا أصواتكم بالقرآن”، لأن القرآن لا يحتاج إلى كسب الزينة من خلال أصواتكم، بل على العكس نحن نحتاج إلى أن نُزين أصواتنا به، لأنه جميل في كلّ الأحوال”؛ إلا أن هذا تفسير فيه كثير من التكلّف؛ حيث إن نص الحديث هو: “زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ”.
صحيح أن القرآن له أسلوب رائع وحُسنُ تعبيرٍ يذهل الألباب، ولكن هناك حقيقة يجب التنبه لها، وهي أنه إذا قرأه شخص صوته غير جميل، ولا يعرف قواعد التجويد، ويرفع به صوته بشكل غير مناسب، من دون مراعاة لمخارج الحروف، فلا شك أن هذا سيؤثر في نفوس السامعين وتطنّ آذان الذين يفهمون لغته ولهم باعٌ في موسيقاه، ولا شك أن قراءةً كهذه ستُسئم السامعين منه بدلًا من أن تثير في القلوب الشوقَ نحوه وتحبُّبَه إليهم.
ومن هذا المنظور يمكن القول: إن المقصود من حديث: “زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ”، هو الإشارةُ إلى أمر لطيفٍ آخر؛ وهو أن الاستماع إلى القرآن من شخص عذب الصوت يمزج في أدائه بين الصوت والمحتوى ويراعي ما في القرآن من تناغم موسيقي وأحكام تجويد؛ من شأنه أن يغمر الإنسان بالمتعة والجيشان.
أجل، إن الأصوات الجميلةَ في ذاتها تزداد بتلاوة القرآن حُسنًا وجمالًا؛ لأنه إذا اقترن الأداءُ الحسن مع ما في الألفاظ والكلمات القرآنية من موسيقى وتناغم رائع، فحينذاك تظهر الموسيقى القرآنية الساحرة والفريدة من نوعها.. فعن أبي موسى الأشعري أن الرسول قال له: “يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ” .
ويُروى في سبب ورود هذا الحديث أن رسول الله بينما كان يمرّ مِن أمام دُور الأشعريين سمع تلاوةً قرآنيةً ساحرة تأخذُ بالألباب، فسأل من هناك عن صاحب هذه الدار، فقيل له: إن هذه دار أبي موسى الأشعري، فقال رسول الله: “يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ”.
والمزمار نوع من آلات الموسيقى، وأما تعبير النبي عن ذلك عن طريق تشبيهه بالمزمار، فهو إما لبيان ما تثيره موسيقى القرآن في النفوس من نشوة وحبور أو أنه أراد تشبيه تلاوته بقراءة داود للمزامير، أو يشبه ألفاظ القرآن بتلك الكلمات -أي آيات الزبور- التي كان سيدنا داود يسردها بقلب محترق أثناء توبته.
3- وهناك حديث آخر رواه البراء بن عازب ، عن رسول الله قال: “حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا” .
فجميع هذه الأحاديث التي سردناها تُبيِّن أن تلاوة القرآن الكريم بأداء جميل وصوت حسنٍ يُشكِّل بُعدًا آخر من التعبير عن توقيره، وينبغي أن يُتناول هذا الأمر في باب خدمة القرآن الكريم وأن يتمّ الاهتمام به بحساسيّة بالغة، ولكن لست أدري هل سيتسنّى لنا أن نشرح كيفيّة تحقيق هذا لجيلنا الذي صار غريبًا عن القرآن فحُرم من الذوق السليم، وأنا شخصيًّا لا أظنّه سهلًا ميسورًا.