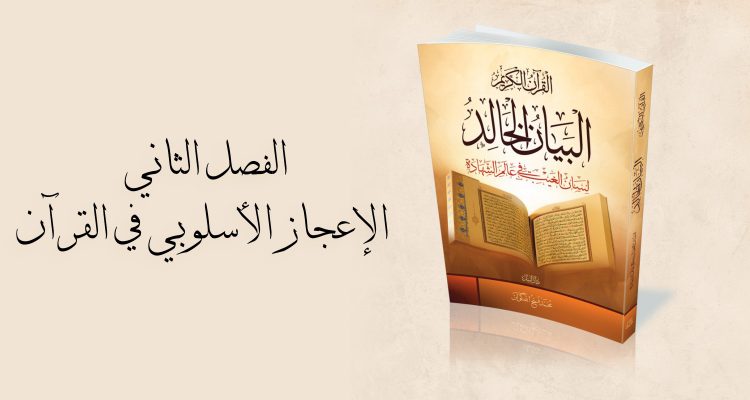من وجوه إعجاز القرآن التنسيق والاتساق والتناغم والانسجام؛ ومنها أسلوبه البيانيّ الذي فاق مستوى البشر، وأعجز طاقتَهم، وبالمثال يتّضح المقال:
لن تجد بين سور القرآن وآياته أو كلماته أسلوبًا أو جملة تُخِلُّ بالتناغم والانسجام، فكأنه سبيكة ذهبية من قالب واحد، رغم أنَّه نزلَ منجّمًا في عقدَين ونيف، بمناسبات مختلفةٍ، وحالات متنوعة، لمخاطَبين شتَّى، وما ذلك إلا لأن كلام الذات المنـزَّهة عن الزمان والمكان، فالعقدان عنده تعالى كأنهما “آنٌ” واحد، والماضي والحاضر والمستقبل سواء.
لكلِّ علم وفنٍّ مصطلحاته وأسلوبه، وله لغة وطريقة خاصّة يعبِّر بهما عن مواضيعه ومباحثه، فلا ريب أن بين لغةِ علم الحقوق ولغة الشعر والأدب أو الهندسة فروقًا واقعة وستقع؛ فلغة الحقوق مثلًا تتّسم بالقطعية والوضوح، وقضاياها تُشرح بتفاصيلها وجزئيّاتها، ويُبيَّن فيها بوضوح عقوبات الجرائم، ومقدارها ونسبتها، فإن أيَّ خطإٍ أو لبسٍ سيُخل بـأساس الحقوق وهو “العدالة”، وسيؤدّي إلى الظلم.
ومن خصائص القرآن أنه كتابُ حقوق (تشريع)؛ ففيه مئات من آيات الأحكام، وبينما يصيب كبدَ الحقيقة مائة بالمائة يتميز عن كتب الحقوق بأسلوبه في هذا الباب؛ فهو يمتاز عن آيات المواضيع الأخرى، لكن لا خلل في التكامل بينهما ولو مثقال ذرة، فالقرآن الكريم رغم ما فيه من إيجاز، وما في تعبيراته من اقتضاب، إلا أن في عباراته ثراءً يُحيّر الألباب.
فعلم المواريث مثلًا يملأ مجلدات من الكتب الفقهية، أما القرآن ففصَّل هذه القضيةَ الطويلة العويصة بنحو عشرة أسطر، وبيّنها من كل وجه بأسلوب أدبي وتناغم لطيفٍ
لا نظيرَ ولا ندّ له.
والمتخصص يسأم وتتعذّر عليه المتابعة لو قرأ نصوصًا كهذه بضع مرات، أما ولا شيء من ذلك يكون في تلاوة مئات آيات الأحكام.. مئاتِ بل آلافِ المرات، وهذا من وجوه الإعجاز، وأنى لكلام البشر أن يضاهي القرآن في هذا أو يباريه.
ولما نزل القرآن وجد ثقافات وحضارات مختلفة، لكنه لم يمر كالحضارات الأخرى بمرحلة نشأة وتطوّر، لقد جاء بأسلوبٍ كَتَمَ أنفاسَ الأدباء العرب وجَعْجَعتَهم، فبذَّهم جميعًا وصار لهم قدوة وإمامًا يُحتذى به، فالأدباء بعد نزوله ما كانَ تميُّزُهم إلا بقدر نجاحهم في محاكاته، ويْكأنَّ القرآن أَسَرَ الأدبَ! فما كان من الأدباء والشعراء إلا أن ذلَّت أعناقهم له خاضعين خاشعين، فيا له من بديع أَسلم الشعراء له القياد!
هذا وجهٌ لا بدَّ مِن النظر إليه لنشهد ما في القرآن من جمالٍ أسلوبي وحسن بياني، فالتعامي عن جلال بيانه وبديع أسلوبه هو التيهُ ذاته.
وليكُن على ذِكْر منك أن معجم أبناء الصحراء ليس إلا بضع كلمات، فنمطُ حياتِهم ومعيشتهم لا يساعدهم على فهم الحياة المدنية ومستوى الحياة فيها، ومعظمُ التصوير القرآني يعكس عالَمًا رائعًا، وتعبيرات هذا السياق كانت مناسِبة جدًّا، تعكس الحقائق بلا مبالغة.
وبعض الأمثلة من هذا المنظار تكشف خصوصية أسلوب القرآن، لأنها غدَتْ حقيقةً لا يطولها الخيال والتَّصور في شِبه الجزيرة العربية يومئذ، وهذه وحدها دليلٌ باهر على أنَّ القرآن كلام الله؛ لأنه يستحيل على من نشأ وترعرع في تلك البيئة أن يأتي بأمثلة وتصويرات من الضرب الآتي.
أ. التصوير الفني في القرآن الكريم
وفي القرآن تصويراتٌ تبعث في النفوس الخوف والخشية وتُرهِب القلوب لكن أساليبها متكاملة مع سياقها، وتبثّ في نفوس قارئيها الخشية والخشوع، وهاك مثالًا لهذا من سورة النور، تليه أمثلة مرتبة وفق ما ذكرنا آنفًا:
يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (سورة النُّورِ: 24/39).
تتحدث الآية الكريمة عن حياةِ وتصوراتِ إنسانٍ هوى في الكفر فأخذ يتدحرج فيه؛ تلك هي عاقبة الكافر البائس اللاهث وراء الأحلام، لقد نذَرَ حياته لتحقيق مستقبلٍ دنيويّ أفضل، وكانت العاقبة السقوط في براثن البؤس والخذلان، إن هذا الإنسان البائس إنما خُلق للخلود، فلن يقنعه إلا البقاء والباقي ، وهكذا يفنى، وسعيُه ليس سوى لهثٍ وراء الفَنَاء.
فما الكافرُ إلا مسافرٌ بائسٌ عاقبتُه وخيمة، يمضي في طريق الحياة متعَبًا مرهَقًا بائسًا، فتتقطع به سبلها، ولا يجد إلا غضب الله وعذابه وشديدَ حسابه.
إن التصوير القرآني لهذا الكافر يجعلنا نستشف حالَته البائسة وكأنها مرسومة على لوحة:
بدأت الآيةُ بتشبيهٍ تمثيلي يدركه ابن الصحراء؛ فالسراب هو ما يتراءى للإنسان في الفيافي من ماء أو خضرة تحت لمعان الشمس وحرارتِها، وهذا مشهد مألوف لساكن الصحراء، ضربه القرآنُ الكريم مثلًا لمشاعر الكافر وهواجسه.
ويزيد التصوير عمقًا قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً﴾، فإن المشاهد للسراب ما هو إلا ظمآن تقطعت به السبل، فهو يلهث وراء ما يظنّه ماء ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾، فهذا التصوير مرآةٌ لمراحل حياته كلّها، فهو في كل مرة يظن أنه وجد الماء فيركض ويُرهَق، ولكنه لا يجد أمامه “شيئًا”، ويمتد هذا الحال إلى أن يلقى اللهَ هكذا، ففي الحديث: “يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ” .
فالكافر كهذا البائس التعيس يجري وراء السراب؛ ولن يحقق أصغر أحلامه ناهيك عنها جميعًا، وستغدو أحلامُه تِباعًا سرابًا، فما خلق الله تعالى الإنسان إلا ليعرّفه بذاته، ولكن الكافر أعرض، لذا سيعرف الله تعالى يوم القيامة قهرًا.
هذه نماذج لا مبالغة فيها، تجتذب المخاطبين إليها وتؤثر فيهم أيما تأثير أيًّا كان مستواهم، ولا تحجر على سعة خيالهم، وبين يدي هذا التصوير الفريد نقول من أعماقنا ونحن نتنسم عبق الإيمان: “إنه كلام الله المعجز، ويستحيل أن يكون غير ذلك”.
وهاكم تصويرًا يجلِّي حالة الكافر عامّة: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ (سورة النُّورِ: 24/40).
إنَّ الكافر غارقٌ في متاهات الوحشة والظلمة، وتأمَّلْ ما كَتَب الأستاذ بديع الزمان النُّورْسي في مؤلَّفاته عن معاناة الكافر في رؤيته للكون الموغلة في الظلمات وتحليله العميق الدقيق للأسباب بِيَراعٍ بارعٍ لتُدرك ما يخسره الكافر بكفره، ويكسبه المؤمن بإيمانه ومعرفته.
ومن لم ينظر بعين الإيمان، أقفر قلبه من نور الإيمان، ومن لم يتأمَّلْ الأشياء والأحداث بنور الإيمان، فما يراه إنْ هو إلا ظلماتٌ بعضُها فوق بعض، ومن ورائها أمواج رهيبة حالكة من الظلمات تُفقِده قلبه وعقله.
وطرافة هذه التصويرات أنها لم تكن تخطر على بال العربي ساكن الصحراء، وكان يستحيل عليه معرفة هذه الأمواج المتلاطمة التي صوّرها القرآن؛ لأن موضعها المحيطاتُ العملاقة؛ فقاع البحر كسطحه فيه أيضًا أمواج كبيرة كالجبال تسمَّى “الأمواج الميتة” ما اكتشفَها البحّاثة البحّارة إلا حديثًا، فأنَّى لِمن يعيش بساحل البحر الأحمر أو في الصحراء أن يتصوَّرَ هذا بَلْهَ أن يصوِّره.
دلت هذه التصويرات الرائعة أن القرآن محيط بأسرار الحياة وبواطن الكونِ، إذ إنه كلامُ مَن يحيط بالكون كلّه ويَعلمُه وكأنه نقطةٌ واحدة.
ولنشاهدْ قوة هذا التصوير في بيانه لحالة الكافر النفسية:
إن عالَمَ الكافر بحرٌ من الظلام، وهو يجري نحو حتفه حثيثًا، وما الموت في ظنه إلا العدم، وما القبر إلا سجن مُوحِش فيه حيَّات وهوامّ وعقارب، فهو في انهيار نفسي وتفكّك اجتماعي، منقطع عن ماضيه المظلم ومستقبله المجهول الذي لا يرى فيه إلا هاوية سحيقة لا يُدْرَك قعرها؛ فهو في دُوّامة من الظلمات لو أخرج يده لم يكد يراها.
وأنَّى لمن لم يسبح في المحيطات ولو مرة، ولم يشاهِد الأمواج الميتة، ولم يعش ولو فصلًا واحدًا من الظلام كما في الدول الإسكندنافية، أنى له أن يأتي بتصويرٍ كهذا؟! إذًا لا يُعقَل أن يُسنَد تصويرٌ بليغٌ كهذا إلى الرسول ، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من عند الله، إنه لَكلامُه المعجز إعجازًا بيِّنًا.
ب. التصوير الإعجازي للحدائق والجنان
مما يستدعي التأمّل طويلًا أمثال القرآن في تصوير الحدائق والجنان، ففيها برهان جليّ على إعجاز هذا الكتاب.
في القرآن تصويراتٌ وافرة دقيقة للحدائق والجنان أنّى يومئذ لأهل الجزيرة العربية المقفرة مشاهدةُ مثلها؟ وأنّى تُسنَد تلك المناظر لمن وُلِد وعاش وترعرع فيها حتى توفّي؛ أعني به سيد السادات ! إن وجودَ هذه التصاوير في القرآن ليدلّ دلالة واضحة على أنه كلامُ المتعالي الذي خلق السماوات والأرض والحدائقَ والجنان وأقامها على هذا النحو، فهذه النقطة من الأهمية بمكانٍ، وهذا وجهٌ له قدْرُه في إدراك إعجاز التصوير القرآني.
وتنم قوة البيان في التصوير القرآني عن إعجاز بديع، منها:
يقول الله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ﴾ (سورة عَبَسَ: 80/25-32).
خلق الله الإنسان فأكرمه بنعمٍ لا تحصى، ثم عدّدها له مفصّلة في كتابه، وساق نظره ليدركها ويَشعرَ بها، فكأنه تعالى يقول: مَن لا تفيض مشاعره وأحاسيسه بين يدي هذه النعم أتراه يدرك أنه إنسان؟!
﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ هل يُعقل إسناد الإطعام والرزق إلى الأسباب أو الطبيعة العمياء؟ ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ تُرى، ماذا لو لم ينـزل المطر إلى الأرض ولو سنةً واحدة؟! وقال تعالى: “صَبَبْنَا” لا “أنزلنا” أو “أمطرنا” لِيذكِّر بعظم نعمته، فكأنه يقول: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ فتفكّروا لو لم ينزل المطر سنة واحدة، أو توارت السحبُ، أو تبخّرت مياه البحار ولم تعد إلى الأرض، فلم يجد الإنسانُ قطرةَ ماءٍ تخرج من الأرض أو تنزل إليها.. ألن تغدو أطراف الأرض كلها صحراء قاحلة، فالأنسب هنا ذكر “الماء المصبوب صبًّا” لا القَطْر، فجاء القرآن يقول: ﴿صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾.
﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ﴾ أي شققنا الطبقة الترابية -وهي صلبة- ببراعم لطيفة رقيقة “شَقًّا”، فتشقّقت الأرض شقوقًا كثيرة، وفي تلك البراعم مِن الرقة ما لو داعبَتها الأنامل لانثنت لكنها بقدرة القدير شقت التراب المتحجر.
﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ (سورة عَبَسَ: 80/27-31).
فيشير بقوله: “حَبًّا” إلى مطعم الحيوانات والطيور والدجاج من حبوب وبذور، وأدرج فيها مطعم الإنسان ومشربه، فسيقَتْ متشابكة؛ فاشتمل قوله تعالى: ﴿وَعِنَبًا وَقَضْبًا﴾ على العنب مأكل الإنسان والقضب مأكل الحيوان.
﴿وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ أي خلقنا لكم أشجارًا تسيرون في ظلالها أيامًا، وحدائق وجنانًا تَعانقت أغصانُها، فإذا طوفّتم في رُباها وسهولها فستشاهدون حدائق النخيل والعنب والزيتون وسترون الأشجار قد اصطفّت: الصنوبر مع الصنوبر، والدلب مع الدلب، والحُور مع الحُور، وهي تتمايل وكأنها أهلُ الذِّكْر.
“وَفَاكِهَةً” كثيرة.. خصّ بعضها بالذِّكْر ثم أطلق قوله: “وَفَاكِهَةً” أي ما هو كائن منها وما سيكون.
“وَأَبًّا” منهم من فسر الأبَّ بالمرعى أو الكلإ، وهذا ليس قطعيًّا، فلعله -والله أعلم بمراده- يعمّ مطعم الحيوان الطبيعي والمصنوع منه، والمتولّد منه كالذي يُنثَر على الأرض من أسمدة صناعية، يُروَى أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾، فلما أتى على هذه الآية: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ قال: قد عرفنا الفاكهة، فما الأبُّ؟ ثم رفض عصا كانت في يده، فقال لعمرُك يا ابن الخطاب: إن هذا لهو التكلف يا عمر! فما عليك ألَّا تدري
ما الأبّ؟ اتبِعوا ما بُيِّن لكم من هذا الكتاب واعملوا به، وما لم تعرفوه فَكِلُوه إلى عالمه .
وكلُّ ذلك ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ﴾ أي إنها نعمة مِنَّا لكم ولأنعامكم، فبهذه النعم التي أعطيناكموها قِوامُكم وقوام بَهائمكم، وبِها تدوم حياتكم، ولولاها لخمدت جذوة حياتكم وانطفأت، وغابت عن الوجود.
فهل لمن يتقلّبُ في وديان مكة أن يدرك هذه الصور البديعة، أو لابن الجزيرة العريبة -وجلُّ غِلالها التمر والبطيخ والخيار- أن يعيَ ويصوِّر هذه الأمور تصويرًا رائقًا كما جاء في القرآن؟!
وأنَّى له ذلك؟ فالقرآن له وحده هذا المستوى من هذه القوة التصويرية الجذابة البديعة الفريدة، فلا تصوير يدانيه.
ج. الانسجام بين الآيات الناسخة والمنسوخة
النسخ لغةً: التغيير والتبديل بوضع شيء مكان آخر، وهو المحو والإزالة.
واصطلاحًا: بيان انتهاء حكمٍ شرعيٍّ بدلالةِ حكمٍ شرعيٍّ آخرَ، وهو ظاهرًا تغيير حُكمٍ قائم وتبديلُه، وهذا في علم أصول التفسير، فلْنُعنَ بالانسجام بين الآيات التي يوهِم ظاهرُها التعارض.
يتدرّج القرآن الكريم مع مدارك بيئة النزول ومشاهدات أربابها، ليألفوا ما سيجليه من حقائق ويؤهلهم لأحكامها، لكن لن تجد مثقال ذرة من التناقض بين السابق واللاحق، فكأن السابق ديباجة ومقدمة للَّاحق، واللاحقَ متمم للسابق، وهذا من خصائص الإعجاز القرآني.
وبالمثال يتضح المقال وإليك مثلًا آيات الخمر:
قال تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/67).
مَن تأمل الآية لاحظَ عطف المقابلة في قوله تعالى: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ على قوله
﴿سَكَرًا﴾، ولم يكن نزل في الخمر شيء، ثم نزل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/219).
أجل، قد يبدو أن لهما نفعًا، والحقيقة أن ضررهما أكبر بكثير.
هذا هو التنبيه الثاني تلاه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/43).
هذه مراحل ثلاث تضمّنت رسائل وتنبيهات أثارت في النفوس علاماتِ استفهام حول الخمر، فآن الأوان لنزول الحكم القطعي بعد هذه الإيماءات والإشارات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/90).
ولنبين ما عُنينا به ابتداءً من تناسب بين هذه الآيات وإن اختلف زمن النزول، فلا تعارض بينها رغم اختلاف زمان نزولها ودلالتها، بل إنها تتدرج بقارئها نحو هدف واحد، وهو تحريم الخمر، وبيانُ ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ (سورة النَّحْلِ: 16/67) دالٌّ على أن ثمرات كلٍّ من النخيل والأعناب من نعم الله عليكم؛ فمنكم من يأكلها، ومنكم من يصنع منها خمورًا مُسكِرة.
وجعل القرآن الخمرَ قسيمًا للرزق الحَسن، أي إنها ليست من الرزق الحَسن ناهيك أن تكون شيئًا يرضاه الله.
إذًا لا تعارض بين هذا الحُكم -ولو كان منسوخًا- وبين الحكم المتأخِّر، فهذا من التلطف بالإنسان الجاهلي آنذاك في الطريق المؤدي إلى التحريم، ففي الآية إشارة خفية إلى الحكم المراد، والآية التالية في النـزول لم تحسم الأمر أيضًا؛ بل طرقته بأسلوب آخر: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/219).
المراد -والله أعلم- أن أضرار الخمر خطيرةٌ مطلقًا، ولكن إذا اعتبرنا “الـ” العهدية في كلمة: ﴿لِلنَّاسِ﴾ تفيد أن نفعها هو ما يربحه صانعها وبائعها وهم قلّة، فلعل فيها نفعًا للمدمنين ولرجال في الدولة أعمت أبصارُهم بصائرَهم، والحقيقة أن فيها أيضًا وبالًا وإثمًا وضررًا؛ فالآية لم تبتّ الحكم، لكن من شمَّر وأبحرَ في روح الآية سرعان ما يُحسّ بوقْع تلك الصفعات على وجه شارب الخمر.
ولما لم يُبَت تحريم الخمر كان في الناس من يشربها، ثم نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/43)، فدلّ أن الله تعالى لا يَقبل أن يقف شارب الخمر بين يديه وهو سكران، والمؤمن عليه أن يقف بين يديه تعالى بين فينة وأخرى يناجيه ويدعوه وهو يعي ما يقول، ويخر له ساجدًا حتى تسكن نفسه، كأنّ نداء الحق يقول: أقبلوا إليّ وأنتم صاحون واعون، فذو الوعي مضطر لترك هذا الضرر، فكثير ممن نفذوا إلى روح هذه الآية تركوا الخمر فور نزولها، وما زال يشربها من لم يسبر غورها ولم يرقَ إلى هذا الأفق.
ورغم تهيئة القرآن للعقل والوجدان وتربيتهما على هذا النحو كان فيهم من لم يدرك هذه القضية، فحان حينُ القول الفصل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورة الْمَائِدَةِ: 5/90)، فحُكِم على الخمر كنظائرها بأنها من “عمل الشيطان” وحرِّمت تحريمًا قطعيًّا.
نعم، إنَّ شُرب الخمر وما شابهه إنما هو من أعمال ذلك اللعين ومِن بقايا الجاهلية القذرة، والشيطانُ كان ولا يزال -كما أشارت الآية- يستخدم الخمر والسكر في الإيقاع بين الناس.
ومن الفقهاء من استنبط من قوله: ﴿رِجْسٌ﴾ أنَّ مَن شَرب الخمر ثم تناول إناءً آخر بفمه المبلّل بالخمر قبل تطهيره تنجَّسَ الإناءُ ووجبَ غسله ثلاثًا.
وفاصلة الآية: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ جديرة بالبحث برأسها.
فلا تعارض بين ناسخ هذه الآيات ومنسوخها، وهي متناسبةٌ منسجمة انسجاما قويًّا، وهذا ضرب من الترابط والانسجام بينها، ولن تَجِدَ مثله في أي كتاب أو كلام آخر.
د. الإعجاز في كلمتين
ومن خصائص القرآن أنه امتاز بالإيجاز، أي تعبيره عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، فهو يضع الكلماتِ والحروفَ في موضعها المناسِب بإيجاز، فلو حُذفتْ إحداها أو قُدِّمت أو أُخِّرَت كان كاستبدال عِقد زبرجدٍ في جِيدِ الحسناء بخرز أطفال.
ولنشخِّص الموضوع بمثال، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/179)، بيّنت الآية باقتضاب ما في القصاص من الردع… فبكلمتين فقط انجلى ما في عقوبة القصاص من ردعِ لأي ضرب من عدوان واعتداء وإضرار قد يقع في المجتمع، وبهاتين فقط تمّ البيان وقُضي الأمر: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾، ومنذ نزولها لم يزل الأدباء يحاولون محاكاتها بمثل إيجازها، ولكن هيهات! وأنّى لهم أن يأتوا بنظير لهذا العِقد الزبرجدي .
من ذلك:
– قول أحدهم: “قَتْلُ الْبَعْضِ إِحْيَاءٌ لِلْجَمِيعِ”، حاول أن يبين بأربع كلماتٍ ما بيَّنه القرآن باثتنين، فوقع في ثغرات يدركها العامة، ومن الزيغ والعبث المقارنةُ بين نفيس وخسيس.
– وقول العرب: “أَكْثِرُوا الْقَتْلَ لِيَقْتُلَ الْقَتْلَ”.
وفيها ضعف كثير، فلم تذكر القصاص ولا سببه، وهي مبهمة تحتمل مشروعية القتل ظلمًا، فالقتل منه ظلم وعدل، أما القصاص فهو عدل محض، وأوجز ما قيل وأبلغه في رأي الأدباء قولهم: “اَلْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ”.
فهذه ثلاث كلمات، وفيها خلل موهم منه تحقيق مناط منع القتل للقتل، فقد يُفهم منه القتل في الحرب، وهو ليس القصاص في شيء.
فلنوازن بين أوجز ما قيل في هذا الباب وبين قوله تعالى: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾:
في هذه الجملة تكررت كلمة “القتل” مرتين، والتكرار في جملة قوامها ثلاث كلمات ليس من البلاغة في شيء، وشملت الانتحار فأوهمت غير المراد ولو إيماءً، وتحقيق المناط وهو الجزاء قبل تنقيحه وإثباته ممتنع أيضًا فهذا الكلام فيه أوهام دلالية تسقطه بلاغيًّا.
وكلمة “القصاص” ليست منحصرة في القتل، بل تشمل وتعمّ أضرب القتل والجروح والكسر والضرب والضرر، فالقصاص فيها جميعًا هو المماثلة، أما “القتل” فهو مقصورٌ على إزهاق النفس بخلاف ما دونه، فكلمة “القصاص” شاملة، وكلمة “القتل” قاصرة.
ومن الأمور المهمة في قوله تعالى: ﴿فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ أن فيها حديثًا عن الحياة بدلًا عن القتل والجراح، فالأساس هنا ليس هو القتل أو الإضرار بوجه من الوجوه، بل المقصود هو جعلُ الفرد والأسرة والمجتمع في مأمنٍ من هذه الأضرار، إذ إنه جعل من القصاص -والقتل من ضروبه- وعاءً للحياة، وهذا اللباب في البلاغة، والآية نصّ في أصل حقوقيّ، وهو قدسيّة الحياة.
وهكذا يتبين جليًّا عدمُ وجود أيِّ نقص أو ثغرة فيها، وهذه الآية هي الأقوم في التراكيب والدلالات، وفيها لقارئها إقناع وإمتاع، ولنفسه سكَنٌ واطمئنان.
إن أوجز ما أتى به الأدباء المخضرمون الخُلَّص بين يدي القرآن ليس إلا كشمعة خافتة ترتعش أمام ضياء الشمس؛ ولهذا خرَّتْ له بلغاء العرب والعجم سجَّدًا، وبأدبٍ جمّ وإجلالٍ مهيب ذلَّت أعناقُ الأدباء القُحّ خاضعين فورَ رؤيتهم لمحاسن هذا السلطان.
هـ. أمثلة على إعجاز القرآن في تعبيره عن مقاصده:
قال تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة الْحِجْرِ: 15/94)، قد يتعذّر على من فهم ظاهر الآية أن يُدرك الإعجاز المذكور لأول وهلة، فلنبيِّنْ باقتضابٍ مقصدَ الآية من الرسول .. ولنرجئ أسرار التركيب.
كأنَّ الآية تقول للرسول : “أَعلِنْ من الآن الحقَّ والحقيقةَ للجموع دِراكًا جِهارًا” فدلَّ هذا على أنَّ المرحلة السابقة كانت سريّة خفيّة، سعى فيها سُعاة لاعتقالِ لسان الحق والحقيقة، ونصبِ العقبات دون الجهر بالإرشاد والتبليغ، وجَذِّ صوت الإسلام ونَفَسه؛ فما صَدَحَ أو ما سُمِع نداؤه الجهوري كما ينبغي، ثم آل الأمر إلى مرحلةٍ كان الإيمان يغلي في الأعماق والقلوب غليانًا لا يُقْدَر عليه، فحان وقت الجهر بالتبليغ، ولما أُذِنَ به لزم أن يكون الصوتُ والصدى مناسبَين لجلال الدعوة وعظمتها.
وأجملت الآية هذه المعاني بكلمة “فَاصْدَعْ”، وجرس حروفها وموسيقاها مطابِق لمعانيها، ومنها: شَقُّ الشيء وإخراج غيره، والجهر بالشيء علنًا، والصدح بالحقائق على الملإ جهارًا، والإعلان عن تولي أمرٍ ما، وذِكركَ المسألةَ مرارًا، والثقل والجدية والوقار، فاختيرت كلمةَ ﴿فَاصْدَعْ﴾ وخُصَّتْ بالذِّكر لملاحظة هذه المعاني كلها فيها.
ولنُعْنَ بدلالة ﴿بِمَا تُؤْمَرُ﴾ على أن الاستحياء والحرج مِن ذِكرك لخصائصك قد يحملك على إغفالها، إلا أن ما تؤمَر به وحي إلهيّ، فمقتضى دقة “الامتثال” أن تُبيّن لهم وتأمرهم بما أُمِرْتَ به.
فيا له من أسلوب عجيبٍ معجِب، ما إن سمعه أعرابيٌّ حتى خر ساجدًا، فقيل له: أأسلمت؟ فقال: لا، لكني سجدت لفصاحته، أي: ما كان لبشر أن يسوق هذه الحقائق كلها بكلمتَين، لقد أَخَذت الآية بمَجامع قلبي، وقَطعتْ صوتي ونفَسي، فسجدتُ لما فيها من روعةٍ وسلطان .
وتمام الآيةِ: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي امضِ كما أنت، وبيِّن الحقائق بأسلوبك، ودع خفافيشَ الظلام وشأنَهم، ولا تُعْنَ بكفرهم وضلالهم؛ فأنت تسلك السبيل النَيِّر، وتجافَ عن طرق الظّلم والظّلام، فبلِّغ ما أُمرتَ به بحزم، وبأسلوب مناسب ومنهج ملائم لعمق القرآن.
فهذه جملة بل كلمة حَوَتْ هذا القدر من المعاني، فبرهن لهم أنَّه معجز، فمَن له أدنى حظّ من الفصاحة والبلاغة لا يسعه إلا أن يخر ساجدًا مقرًّا بإعجاز القرآن كذاك البدوي، فلنُعنَ ببيان دقائقه إذًا.
و. الاستدلال القرآني وروعة الأسلوب
إن القرآن الكريم حينما يريد إثبات أمرٍ ما يورد له الأدلة، ويجافي التمويه والتصنع الأسلوبيَّ كما هي مغالطات بعض الفلاسفة، ولا يخصص موضوعاته وكأنها لِفئةٍ بعينها، فالقرآن في عمق الماء وصفائه ونقائه وزلاله، يلوح للناظر كأنه يرى قاعه، فإذا خاضه أدرك كم هو عميقٌ بعيدٌ غَورُه.
والقرآن كالماء عميق صافٍ رقراق، لا يلبّسُ على الأذهان والقلوب، ولا يمتّ إلى السفسطة بِصِلة، كل ما فيه بيِّنٌ جليّ، يستهدف الحقّ كِفاحًا بجلاء ووضوح، وهذا منهج قرآنيّ مشهود.
ولا يستعجم المألوف ليغدو غريبًا، بل له في كلّ أمرٍ أسلوب لطيف ملائم لأرواح المخاطبين وفكرهم.
أما الفلسفة فإن الأرواح لَتضيق بأوضحِ ما فيها، فكأنها تُحوِّل كل الأمور إلى ظلمات، ويُلَبَّس بها على العقول والأذهان، فتضطرب الأفكار، وتختلط التصوّرات، ولا روح ولا حيوية في أسلوبها، وقد مَجَّها الوجدان العام، فما أبعدها عن عمق المعنى والماهية، وعن واقع الحياة البشرية، لذا سرعان ما تُجابَه بِرَدِّ الفعل إذا ما حاولتْ أن تنـزلَ إلى واقع الحياة.
لكن القرآن في قلب الحياة، وأمثاله موضع قبول واستحسان على الدوام، لأنه يخاطب الفطرة، وينادي الطبيعة البشرية، ولا يُغفل الأحاسيس والمشاعر الأصيلة في روح الإنسان، ولا أيَّ توجُّهٍ نحوه، مثال هذا:
منذ قرون وعلم الكلام يبرهِن على حدوث العالم بالاستدلال العقلي، وكانت للفلاسفة تصورات عقلانية، تصدى لهم علماء الكلام بأدلةٍ تُثبِت هذه القضية الكبرى بأساليب المنطق الأرسطي غالبًا، وهذا هدف نبيل؛ فأثبتوا حدوث العالم بأنه لا يزال يتغير، أمّا المنـزه والمقدس عن كل تغيُّر وتبدُّل فهو الله خالق هذا العالَم، قالوا: العالم متغير، أي هذا الكون بما فيه يتحول ويتغير باستمرار؛ فالذرات والأنظمة في حركة لا تفتر، والفصول تتعاقب، وفي كل مستحدث جديد، فظاهرٌ للعيان أن الكون يطرأ عليه تغيُّرٌ وتحوُّلٌ وتبدُلٌّ مستمرّ دالّ على الحدوث، وكل ما يتحول ويتبدل عُرْضةٌ للانحلال والتفكّك ثم الفناء تدريجيًّا، فكل شيء يتغير، والمتغيِّرُ حادث، ولا بدّ لكل حادث مِن مُحْدِث، وذلك المحدِثُ هو الله.
هذا الأسلوب المنطقيُّ طريقُ علمِ الكلامِ إلى هذه النتيجة، ولكن العامّة لا يدركونها، لأن تصوّرهم ومستوى عقولهم لا يبلغ أفقَ فهمِ ذلك وإدراكه؛ فمن لا يستطيع أن ينظر إلى فصل الربيع نظرةً كلّية، ولا يحيط نظره بعظمته وروعته، ولا يَشعر بتحوّل الإلكترونات، ولا يعرف النواة والنترون والبروتون؛ لن يعرف أو يُدرك ما في الكون من الانسيابية أيضًا، ناهيك عن إدراكه الحركة الكلية في الكون ودلالتها، فأنى له أن يستدل بالحركات والتغيراتِ والتبدلات على وجود الله ؟!
أما البيان القرآني الميسّر الجليّ لهذه الأمور فإن أسلوبه يناسب مدارك الناس ويؤثر فيها وإنْ بقدر.
إن كلًّا من الفيلسوف العقلاني والعامي البسيط ليستفيد من أسلوب القرآن على أتم وجه، ففي مُحَاجَجَة النمرود لسيدنا إبراهم قال: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/258). أجل، إن الله هو الذي يُحيي ويميت، أي هو الذي خلق الموت والحياة، والحياةُ لغزٌ كالموت، فليستا عبارة عن قيام الأعضاء ببعض الوظائف ثم تعطُّلها.
إن الحياة سرٌّ إلهيٌّ، وجوهرُها هو الروح الذي هو نفخة إلهية وتجلٍّ للرحمة في عالم الجمادات، وأما الموت فهو تجلي اسم الله “المميت”، فليس انحلالًا ولا تفكُّكًا؛ أي ليس ناشئًا عن عدم تجلي اسم الله “الحيّ”، فالرابطة بين الله والخلق دائمة؛ ولا يقطع الله عنايته عن خلقه ولو لحظة، والحكم القرآني في هذا مُبين، أدركه النمرود بكلّ جلاء، لكنه عاندَ وأصرّ على كفره فقال: ﴿أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/258).
واحتمل أن ينخدعَ بعض العامة بادّعاء النمرود أنه يحيي ويميت بخُدعٍ بصرية، ففطن سيدنا إبراهيم لهذا، وسلّط الضوء على ما تمتنع محاكاته وليس لغيره سبحانه إليه سبيل: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/258).
منْ لم يدقِّقْ قد تغيب عنه حقيقةُ الحياة والموت، فالإماتة والإحياء يتجليان في دائرةٍ جزئية من تجليات أسماء الله تعالى؛ فانتقلت الآية من التجلي في دائرة جزئية إلى دائرةٍ كلية، وإنّ أكبرَ مدقِّقٍ مفكِّرٍ متفنِّنٍ ليستوي في فهم هذا مع العامة والسذّج، وطلوعُ الشمس وغروبُها أمارة على وجود حياةٍ على وجه الأرض ثم انعدامها، فَلِتَحريك عجلة الكون صِلة قوية بطلوع الشمس وغروبِها وبعمر الإنسان أيضًا.
وأكثر من هذا أن عمر منظومتنا رهن بحركة الشمس أيضًا، فبتعاقب الأيام والفصول يقع ما لا يُحصَى من أحداث الحياة والموت، وهكذا تتجلّى إرادةُ الله تعالى على الأرض أبدًا؛ فإن الله يَبسط أمام الإنسان بدوران الأيام والشهور والفصول فصلَ الربيع وما فيه من جلال وجمال، ويُنشئ الصيفَ وألطافَه، والخريفَ وأشجانه، وقد يَعرض للأنظار بفصل الشتاء المديدِ ما لا يُحصَى من مَشاهد الموت، فهذا كلّه من علائق طلوع الشمس وغروبها، فما في هذه الحياة من بداية ونهاية وإحياء وإماتة ثمارٌ لتجلٍّ ربانيٍّ.
لقد جذَّ سيدنا إبراهيم لسانَ الكافر وأفحمه بدليلٍ جارٍ في دائرة كلّية، والقرآنُ إذ يصف ارتباك النمرودِ أمام هذا الدليل يقول: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾، وكما يقال: لم يستطع أن ينبس ببنت شفة… وظلَّ واجمًا أخرس، ولوضوح الدليل لم يسأل أحد منهم: “ماذا أراد إبراهيم” وما كان لهم أن يسألوا!
تناول القرآن الأمور بهذا الوضوح، وعالجَها بِيُسْر، فالعالم المتفنِّنُ إذا نظر بعين فاحصة مدقِّقة فسيُدرك تفصيلًا ما يحدثه طلوع الشمس وغروبها، وأثرُها في الربيع والشتاء، ومثله العامّي ولو راعيَ أغنامٍ على قدر إدراكه، ومهما كان مستواه فسيلحظ في الموت والحياة معنى من المعاني، وسيُقيِّم مفهوم الإماتة والإحياء ولو بقدر محدود.
إن قضية الخالق والمخلوق شغلت العقول المتفننة المفكِّرة المدقِّقة على مرِّ التاريخ، وفيها أُلِّفت آلاف الكتب.
ومن أدلة علم الكلام “برهان التمانع”، وهو دليل قديمٌ قويّ يمتنع بموجبه
أن تصرِّفَ الكون يدان، والنظام السائد في الموجودات يعضد هذا الدليل.
أو قل: الكون قائم على قانون “رد التدخل”، ويعني كما قال الأستاذ بديع الزمان النُّورْسي أنه: “يُمتنع استعمال عاملين على إمارة، وعمدتين على قرية، وأميرين على بلدة، وواليَيْن على ولاية، وإلا حلّت الفوضى وانقلب النظام رأسًا على عقب”.
هذه الأمثلة تشرح هذا القانونَ بأسلوبٍ يُدْركُهُ العامّة، وهو سارٍ في جهاز الدولة على الدوام؛ فكثيرًا ما يقع الهرج والمرج في الجهاز الإداريّ بتدخّلِ الآخرين، وهكذا تفرز إدارة الكون حالات من الفوضى، والكونُ ذو نظام رائع منتظِم بارع وكأنه سفينة تمخرُ عباب البحر بيسر نحو ساحل ترسو عليه، وهذا يدلّنا على أن إدارة الكون وتسييره بيدٍ واحدة.
وعلى “برهان التمانع” اعتمد علماء الكلام، وهو طريق مهمّ في الاستدلال لديهم.
شَغلت هذه القضية الفلاسفة المسلمين وعلماء الكلام عصورًا، وتَناوَلَها القرآنُ الكريم وبيَّنَها بيُسرٍ في بيان سحري ببضع كلمات لم تتجاوز نصف آية؛ فلو أن العقل أدرك هذه الحقيقة العظمى لظلَّ يكرر كلمات القرآن ويدور في فلكها، وإن لم يدركها ظلَّ أبد الدهر حبيسَ التخبُّط والحيرة.
أجل، إن مستندنا من الأزل إلى الأبد هو هذه الآية من القرآن المعجز البيان: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا﴾ (سورة الأَنْبِيَاءِ: 21/22)، فلو كان في السماء والأرض سوى المعبود المطلق يتصرّف ويتدخل لفسدتا؛ فهذا النظام والانتظام والتناغم وآلاف الكتب الزاخرة بالحِكم تدل على أنَّه لا أحدَ سواه يتدخل في صفحات الكون.
وإذا أمعنَّا النظرَ في فحوى الآية نفسها فسنقترب من حقيقتها أكثر؛ وهَبْ أنّه تَصرَّفَت في خلق السماوات والأرض يدانِ؛ فإما أن تتساويا في القدرة على التصرف في المخلوق نفسه أو تتفاوتا، فإن قدَرت إحداهما عليه فوجود الأخرى عبث، وإلا فهي عاجزة، والعاجزُ لا يَخلق؛ لأنه لا بد للخلق والإيجاد من قدرة مطلقة، وإن تساوتا واختلفتا لزِم اجتماع الضدين، إحداهما تُحيي، والأخرى تُميت؛ فيختلّ النظام ويسودُ التناقض، والعاجزُ لا يكون إلهًا، لأنَّ الله تعالى مبرَّأٌ منزّهٌ عن الضعف والعجز والخوَر.
ز. الإعجاز في سورة الإخلاص
يقول الله تعالى في سورة الإخلاص سورةِ التوحيد: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ الله الصَّمَدُ﴾ (أي كل شيءٍ مفتقر إليه، وهو غنيّ عن كلّ شيء، وإليه وحده يرجع كل شيء وبه يستعين) ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (سورة الإِخْلَاصِ: 112/1-4).
إن القرآن المعجزَ البيانِ يبيِّن بإيجازٍ شديد في هذه السورة المباركة التي تتحدث عن التوحيد الإلهي وجود الله وأنه وحده مدبّر الكون، وإليه توجَّهَ كل شيء، وأنه لا تفسير لشيء من دون إسناده إليه تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ نعم إنه أحد لأنه ﴿الصَّمَدُ﴾.
فهذه الجمل بعضها دليلٌ وعلة على بعض معًا، فإليه سبحانه يفتقر كل شيء وهو غنيّ عن كل شيء؛ فهو لو لم يَخلق الكائناتِ الحيةَ وينشرها في كل مكان، لاستحال ظهورُ شيءٍ منها إلى الوجود، فوجودُ كل شيء مفتقرٌ إليه تعالى.
والعلوم جملةً حتى الآن شاهدةٌ على ما قلنا؛ فمِن المستحيل وجودُ شيء بلا سبب وفاعلٍ؛ فالعلوم كلّها والموجودات كافّة تشهد على اختلاف ألسنتها أن الله هو وحده الخالق القادر، وأنه ليس كمثله شيء، وشهادتها هذه لا تَدَعُ لذوي العقول والأبصار أيَّةَ حاجةٍ إلى دليل آخر، لأن في البيان القرآني السهل الممتنع من الوضوح ما لا يذر حاجة إلى شيء، وأيضًا فالقرآن الكريم غنيّ عن جدل المغالطات الفلسفية العقيمة الجوفاء.
﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾، نشاهد دائمًا في عالم النبات والحيوان والإنسان مَن يَلِد ومن يولَد، فكل نوعٍ محتاج إلى نوعه بعلاقة السبب والمسبب والعلّة والمعلول وكأنه أب له أو أم؛ فالنباتُ يحتاج النباتَ للتكاثر، والحيوانُ محتاجٌ لأبوين للتناسل والرعاية، فلا بدَّ للمسبَّب من سببٍ وللمعلول من علة، وهذا من خصائص قوابل العدم أي الأعراض والجواهرِ، وأما الذات العَلِيَّة (الله) فهو منـزَّهٌ عن كل ذلك؛ فإنه ليس من جنس ما نرى من الموجودات ولا مخلوقًا مثلها، تعالى أن تطاله الأسباب والعلل.
وبهذا أتت الآية على بنيان الأديان والمذاهب المحرَّفة من القواعد في دعواها أن الله اتخذ ولدًا، سبحانه أنَّى يكون له ولد، فليس عيسى بإله لأنه وُلد من أم دون أب، ولا عزير بابن الإله، فالإله هو من لم يلد ولم يولد، إن هذه المزاعم ما هي إلا ترهات السَّفَلة.
ومصطلحُ “العلة-المعلول”، و”السبب-المسبب” حقيقةٌ جليلة أسهب فيها علماءُ الكلام والفلاسفةُ في بحوث مطولة بأمثلة كثيرة شرحًا وبيانًا، وبينَّها القرآن في آية قصيرة، بأسلوب سهل للغاية تدركه العقول أيَّا كانت مداركها، فحَلَّ ضروبًا من المعضلات دفعة واحدة.
ح. اليُسْر في آيات الحَشْر
سُئِل ابنُ سينا عن الحشر والبعث بعد الموت بدليله، فأجاب: “إن المعاد الروحاني وأحواله هو مما يُتوصّل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس، لأنه على نسبة طبيعية محفوظة ووتيرة واحدة، فلنا في البراهين عليه سعة، وأما المعاد الجسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه بالبرهان” ، وفي القرآن الكريم عشرات الآيات في الحشر، تخاطب العقل، وتكشف بيسر ووضوح قضيةَ الحشر التي قد يتراءى للعقل استحالتها.
نعم، إن قضية الحشر وَردت في القرآن بأسلوبٍ سهلٍ مفهوم، لم يَدَع حاجةً إلى التفكّر الطويل العميق، وجُلّ أمثلة الحشر وأدلتها من وقائع الإماتة والإحياء الجارية على مرأى الناس في الفصول جميعها، وهي من عالم النبات شريك الإنسان في البيئة والحياة، وصنوه في الموت والحياة، وهكذا يَفتح له مَعْبَرًا، فهذه نافذة للتفكّر والتصوّر لينفذ من إحياء النباتات بعد موتها إلى بعث الإنسان بعد الموت.
ومعظم هذه الأمثلة تخاطب العقل وإن تفاوتت المدارك في فهمها واستنباطها، وما من مؤمن يقرأ القرآنَ إلا استوقفته هذه الآياتُ؛ فمثلًا هذه الآية الكريمة طرقت بأسلوب خاصّ سهل جدًّا في بضع كلماتٍ البعث بعد الموت: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (سورة الأَعْرَافِ: 7/29)، أي كما أن الله تعالى حباكم الحياة من قبلُ، ستَحيَوْن مرة أخرى وتصيرون إليه تعالى، وستعودون إلى الوجود مثلما كنتم ولو غدوتم رميمًا وترابًا.
فلو قيلت هذه الجملة -ولو لعاميّ- فسرعان ما يدرك المراد.
وإليكَ مثالًا للتوضيح: هبْ أنَّ تحفةً معماريةً خارقةً كانت آية في الفنِّ والجمال بقبابها الرائعة وأعمدتِها الباهرة وبِدْعة زخرفتها الظاهرة والباطنة، فلو هُدّمت ولم تقم لها قائمة ولم يبقَ فيها حجرٌ على حجر، ثم قيل لبانيها: أعِدْ بناءَها كما كانت، فلا ريب في قدرته على ذلك؛ لِجَزْمِنا بأن لهذا البناء مخطَّطًا، بل إنَّ هندستَه تَشَكَّلتْ في الخيال والتصوّر أفضل مما كان؛ لأنه سبق له بناؤه من قبل.
من هذا المنحى أفادت الآية كما أنه خَلَقَكم أول مرة وحباكم الحياة، فبالسهولة ذاتها سيهبكم حياةً أخرى، فهو على ذلك قدير.
هذا، ولو قيل مثلُ هذا لِمن له نصيبٌ من العِلم والمعرفة، لازداد تبحُّرًا في الموضوع وقال في ضوء سعة أفقه وعمق تصوره ومداركه: إننا معشر العلماء لا نزال نعدّ بدايةَ الحياة على الأرض لغزًا مُعمّى، ومهما ارتقت العلوم والمعارف فلن تخترع مثل إكسير الحياة لدى الكائنات الحية.
ومن الشواهد الحية على هذه القضية أنّ “باستور (Pasteur)” أحال وجودَ أيِّ كائن حيٍّ بنفسه إلى الصدفة.. وأنّ “أوبارين (Oparin)” أقرّ بعد تجاربَ في روسيا استغرقت أربعين سنة أن مختبرات الكيمياء لن تستطيع إيجاد الكائن الحي.. وأمّا “مُولَّر (Muller)” فعاد خاليَ الوِفَاض رغم تجاربه الطويلة.
نعم، لو أن الباحثين هيؤوا في الأرض أو الفضاء الظروفَ الملائمة والمواد اللازمة بتمامها لأي كائن حي، فلن ولم يخلقوه بعلم الكيمياء ما لم يُرده الله ويخلقه.
ولنذكِّر أنه لو كان على الأرض كائن عضوي حيّ، فلا بد أن له بداية سواء خُلِق عليها أو أتى من كوكب سيّار آخر، وفي هذا يذكر القرآن الكريم بأسلوب يفهمه ويقتنع به العالِم المتفنن المدقِّق وسُذَّج العوام أيضًا: إن الله تعالى خلقكم على الأرض خلقًا عجيبًا لا تسعه عقولكم، ولا تفسير له بمَوازينكم، ولا اسم له في قوانينكم العلمية، وبعد الموت والدّفن سيبعثكم من جديد إلى مسرح الوجود كالخلق الأول، فلا تشكُّوا في ذلك.
إن الآيات التالية تفتح آفاقًا جديدة للأنظار التي تريد أن تعلم بعمقٍ مدى كون إكسير الحياة لغزًا غامضًا، وتودُّ أن تَرى آثارَه على الأرض: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة العَنْكَبوتِ: 29/20).
أجل، سيروا وطوِّفوا في الأرض، واجتهِدوا أن تروا كيف بدأَت الحياةُ، وتعمَّقوا بالبحوث العلمية، وأمعنوا في أحوال الحياة في فصل الربيع، وأطوارِ النموّ في الصيف، وأحداثِ الموت في الشتاء، وحاوِلوا اكتشاف سرّ الحياة من وجوهها الغفيرة، فمثلما بدأت الحياةُ على وجه الأرض أول الأمر؛ سيبعثكم الله في الآخرة ويهبكم الحياة الأبدية.
﴿وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (سورة فَاطِرٍ: 35/9)، ريح ميت.. وبلد ميت.. فإذا بالسحب المحملة بالمطر؛ ولو لم تتجلَّ إرادة الله فلا حياة ولا وجود يُذْكَر، وكأن القدير المطلق يقول في هذه الآية: “إنَّا نحن هيأنا هذه الأسباب، فأحيينا الأرض الميتة القاحلة الجرداء، وبَعَثْنا فيها الحياةَ، فكأنَّ الذراتِ والكرات تَحرَّكتْ مِن بعدُ بإكسيرِ حياة، ينفث الحيويةَ في كل شيء بعد موتٍ شاملٍ ﴿كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾.
إذًا لِماذا نحكم على الحياة بالفناء ونتعامى عن آلاف بل ملايين من وقائع البعث، فنعكّر صفوَ حياتنا بترّهاتِ “العدم المطلق”؟! فلننظر إلى ما حولنا، ونتأمَّلْ وقائع الحياة بعد الموت لنُضفي على حياتنا لونًا جديدًا من الحياة.
أجل، إننا إذا فكرنا في بعثِنا بعد موتنا، فنظمنا فلسفتنا حول الحياة، وكوَّنَّا معتقداتِنا وفقًا لذلك، فسندرك ضربًا جديدًا من الأحاسيس والمشاعر، ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ فكما أن الورقة الميتة تنبعث من جديد، وتَسري في عروق الأشجار حياةٌ جديدة، وتشق البراعم وجهَ الأرض، كذلك ستخرجون للحشر من أجداثكم بحياة جديدة.
وحسبنا هذا من منهج القرآن في إثبات البعث بعد الموت، وثمة عشرات الآيات الأخرى.
ولا يأتي القرآن الكريم على شيء مما يخوض فيه الفلاسفة والمناطقة من الجدال والمغالطات، ففيه من الأدلة ما يُقنع كلَّ أحد من العاميّ إلى العقلاني العنيد، فلو قرأ الإنسان هذه الآيات حدْرًا، ولم يلبث مليًّا يتفكّر فيها ويتدبر، فسرعان ما ينتقل إلى فحواها من منظار بدء الخلق بهذا اليسر، ويَربِط بينها، ويبني البعث بعد الموت على الانبعاثات الجارية على وجه الأرض، فباتت القدرة على إثبات قضية البعث والنشور بلا سردٍ طويل للأدلة العقلية من خواص القرآن وحده، والذين فسدت عقولهم بمرض الفلسفة فإما أنهم سيقولون بما قاله “ابن سينا”، أو أنهم سينحدرون في واد سحيق من وديان الضلالة؛ وأمَّا المجددون وكبار المرشدين فحادوا عن الطرق الملتوية، ودأبوا على تناوُل القضايا كلها ومنها الحشر بالمنهج القرآني الناصع اللامع أبدًا.
وفي سياق إمكان وقوع الحشر بيسر مطلق يوجّه القرآن الكريم الأنظارَ إلى قضية كبرى مثل خلق السماوات والأرض، فيقول: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (سورة يس: 36/81)، أي: هل تظنون أن الله لن يبعثكم بعد موتكم وهو من نَشر السماواتِ بصفحاتها وأنظمتها، وقسمها على هيئة أنظمة،
وربط بينها بنظام وتناغم معين، ثم بسطَ لكم الأرض فراشًا تستريحون عليها، وقدّر فيها الأنواع المتعددة من النعم ويسّرها، ونَشَرَها أمامكم؟! فما هذا الكون الرائع بما فيه من صنوف الجمال المتعددة، وآلاف الأنواع من وقائع الموت والحياة سوى همسة في آذان أرباب العقول؛ تبين لهم رسالاتٍ ذات أسرار عميقة.
أجل، لو أن الإنسان -حتى البدوي المبتدئ- ألقى نظرة إلى العوالم السماوية التي تلوِّح بنجومها من بعيد، أو نَظَرَ إلى هذه الأرض المرصعة بشتى الألوان، فلن يَسَعَه إلا أن يُذعن بأن الذي خلقها هكذا ويخلق في كل ربيع أمام أعيننا عوالمَ كثيرة قادرٌ على أن يحيي الموتى، ولن يكون المنكر لهذا إلا أعمى أصم ميت القلب.
نعم، إن الحاكِم المطلق للكون هو الله ؛ فلو أن الإنسان راقب العوالم الكبرى بتلسكوب يلتقط الأجرام والمجراتِ والسُّدُم البعيدة عنا ملايين السنين الضوئية، أو بالأشعة السينية “إكس (X)” لرصد الأجرام المتناهية في الصغر، فسيشاهد في كل شيء وفي كل مكانٍ في العوالم كلها كبراها وصغراها أن الحاكم المطلق المتصرف فيها هو الله.
أترونه سبحانه لن يبعث الإنسان بعد موته وهو من جلَّى بجلاءٍ مظاهرَ حاكميته في دائرة واسعة كهذه لا تحيط بها مدارك البشر؟! حاشا لله ثم حاشا، فلترتعدْ فرائص الإنسان وقلبه فرَقًا من الله خشية أن يرِد بباله تصوُّرٌ مبتذَلٌ كهذا.
نعم، إنه خلاق العالمين، بدأ خلْقَ كل شيء، ثم أقام في هذه الدائرة الواسعة نظامًا مُذهلًا، فأنّى يُسنَد إلى الطبيعة العمياء هذا الخلقُ والإيجاد، وهذا الوجودُ الرائع ذو الأسرار الذي جرى بعلمٍ وتقدير من الله ؛ فلا بد للخلق والإيجاد من علم محيط بكل شيء وليس لغير الله خلاق العالمين منه شيء.
وهذا شأن علم مَنْ يَرى كل شيء من أعماق الأرض حتى ما سقط على الأرض وجفَّ وصار ركامًا من الكربون، ويحيط بما لا يسمعه الإنسان نفسُه ولا يبلغه علمه مما يدور في أعماقه من نوايا وأحاسيس، بل يحيط بما في أعماق الكون من المجرات والسُّدُم، فعلمُه أزليٌّ أبديٌّ بكل شيء محيط، وهو وحده الحاكمُ المطلق على الكون، ومالك الدنيا ويوم الدين.
والقرآن المعجزُ البيانِ يوجّه الأنظار إلى ضروب عدّة من هذه الحقائق بأمثلةٍ كثيرة لئلا يندّ العقل والوجدان.
نعم، قد يعتري الوجدانَ الإنساني ما يشبه سُبات بعض الهوام والحشرات شتاءً، ففي هذه الأمثالِ إيقاظٌ للضمائر النائمة والمشاعر الغافية، ودعوة لفهم الحياة بأسرارها على وجه الأرض.
ما أكثر المَشاهدَ التي يَعرض القرآن فيها للأنظار موتَ النباتات شتاءً وانبعاثَها في الربيع تشبيهًا لموت الإنسان وبعثه بها؛ لنفهم وندركَ حقيقة الحشر بأدنى تأمُّل بمنتهى السهولة!
ومن أقبل بإنصافٍ على أسرار القرآن، وغاص فيها بعقله ووجدانه وأصغى إليها، فلا ريب أنه سينبهر بالكون وما أُودِع فيه من أسرار، ويقطع بحقيقة الموت، ويوقن بالبعث بعد الموت يقينه بحياته الدنيا هذه.
ط. تعدُّد الوجوه في الآيات القرآنية
مما لا يخفى أن الكتب السابقة وكثيرًا من التيارات الفلسفية هُمِّشت وطُمِسَت أحكامُها واضمحلَّ تأثيرها لِأنها لم تُواكب التطوّراتِ العلمية والفكرية، ولم ترقَ إلى مستوى الحياة الفكرية والحياة الروحية للمجتمعات المتطوّرة، ولما نزل القرآن وعدَ بشموليته للحياة كلها، وبأن يكون منبعًا للنور وضياءً لكل شيء مهما صغر؛ فكان في ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه مساحةٌ فكرية واسعة لكل مفكر وفقيه ومتفنن وغيرهم؛ فقد أتاح لكل منهم أن يغوص في أعماقه ويفيد منه بِيُسْرٍ دون عقبات.
ولم يكن في القرآن المعجزِ البيانِ تناقض، وهذا قول المنصفين، لقد نزل منجمًا في عقدين ونيّف لأسباب شتّى ولم يُلحظ بين آياته وفواصله وسوره إلا الوحدة والتلاؤم والوئام.
فمثلًا، عند بزوغ الإسلام نزلت آياتٌ في المعاملات من بيع وشركة وميراث تُمهِّد لإنشاء بنية المجتمع الإسلامي، كانت توطئة لآيات تلتها هي أكثر تفصيلًا وشمولًا؛ والنظرة العجلى توهم أن بين المتقدمة والتالية تناقضًا ما، والنظرة الفاحصة تنفيه قطعًا، بل تبينّ أنها متطابقة متكاملة.
قال الله تعالى في المواريث: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/180).
لقد كانت الأعراف السائدة في الجزيرة العربية تمنع الوالدين من أيِّ حقٍّ في الميراث، وتدوس حقوق الوالدين بالأقدام، وكان الناس يتصرّفون في أموالهم كيفما يشاؤون، ولم يكن يدور بخَلَدهم بتاتًا أن يُفرِدوا سهمًا للوالدين.. في حقبة كهذه ذكَّرت الآية ابتداءً بوجوب الوصية للوالدين، فمهّدت لحكمٍ ستحملُه آياتٌ لاحقة أدرجَت الوالدين في أصحاب الفروض.
أجل، إنها سابقة في تقرير حقوق الأبوين المغفلة يومئذٍ، وفي فتح نوافذ من المروءة والاحترام للأبوين أَرومةِ النفع العظيم للذرية، وسبب وجودها، ثم نزلت الآية الكريمة: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (سورة النِّسَاءِ: 4/11).
بينَت الآية نصيب الوالدين من ولدهما المتوفَّى إن لم يكن له ولد أو كان؛ مفصِّلةً حكمَ كل حالة، وهذا نسخ لآية الوصية السابقة، وما يتبادر من توهم التعارض بين الآيتين مدفوعٌ بأن جوهر الأمر لم تصبه أيُّ زعزعة بالنسبة لمكانة الأبوين، وما ذلك إلا رفعُ حكمٍ وإثباتُ آخر، والأبوان ما يزالان على درجتهما الرفيعة.
إذًا إنَّ الآية الكريمة السابقة مهدت للحكم اللاحق، فالسابقة تُمرِّن العقول والأذهان وتهيئها، واللاحقة تعيِّن حقوقهما وتُثبِتُها، ولا يعني هذا أنَّ حكمَ الآية السابقة موقوفٌ أو مرفوع، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا نسخَ في القرآن، والجمهور على القول بإمكانه ووقوعه، والجمع بين القولين ممكنٌ، على اعتبار أن النسخَ واقعٌ، ولما كان المنسوخ تابعًا للناسخ احتمل حكمًا فيه مودة ومروءة لمصلحة الإنسانية، فالآية السابقة دالّة على كلّ حال.
ولمَّا لم يكن المجتمع مهيَّئًا للتّواؤم مع نظام الحياة الذي أتى به القرآن نزلت الأحكام منجمةً، ثم تحققت الأهداف تترى تدريجيًّا؛ لأنّ البنيان البشري والاجتماعي يومئذٍ لم يكن ارتفع كما يجب؛ فنزلت الأحكام في آيات عديدة للمراحل الأولى أو المراحل الانتقالية التالية.
في القرآن أوامر كثيرة قابلة للتخصيص أو التعميم، أو الإطلاق أو التقييد، ومن أخذ بالقرآن جملةً وأمعن فيه ألفاه ذا عرًى وثيقة بترقّي البشرية وتَكامُلِها؛ ففيه أحكام أصلية وأخرى تبعية دون الأولى في القطعية من حيث الإيجاب والتحريم، لكنها تكشف ما يطرأ على الفطرة البشرية وطبيعة المجتمعات من تطوُّرات.
ومن البدهي أن القرآن يخاطب عقولًا شتَّى في مجتمعات وأحقابٍ متعددة؛ لذا استخدم أسلوبًا لحظَ ما عسى أن يَحدث من تطورات، ففي خطابه لمن جهلوا مقصد القرآن، ولم يرتقوا إلى سماء بيانه، وأصرّوا على اعتقادهم الأعمى، نصبَ ميزانًا خاصًّا لمعاملتهم فقال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (سورة الكَافِرونَ: 109/6)، وقد يتأولها متأول “بالعلمانيةَ”، ثم يأتي القول الفصل بآيات تجلي ما ينبغي فهمه من الآية.
نعم، نزلت آياتٌ تبين أن لكلٍّ دينه، ولكنها بينت أنه لا بد من موقف تجاه المشركين الذين غدوا كأفعى الكوبْرا التي تتلذّذ باللدغ، فصاروا سمًّا زعافًا يقتل الحياة الاجتماعية، بعد أن ماتت ضمائرهم، وتعاموا عن الآثار الإلهية في الكون، وتمردوا على الله ، وأعلَنوا الحرب على الإسلام والمسلمين، إذًا إنّ مبدأ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾، سيُطبَّق في هذه المرحلة، وفي مرحلة أخرى سيكون هناك تطبيق آخر وفقًا لحالة الطرف الآخر.
وهاك مثالًا على هذا قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/29).
وأيًّا كانت الشريعة السابقة فلهذا الحكم أحوالٌ وشروط وأوقات معينة؛ أي إذا أذعنوا للإسلام، ولم يَحُولوا دون انتشاره، وتركوا الاعتداء والغطرسة، فكفّوا عن قتالهم على أن يدفعوا في الصلح جزية تدلّ على انقيادهم كما يدفع المسلمون الزكاة.
ومن قرأ الآية مِن هذا الوجه لم يسعه إلا أن يقول: “إنه لكلام الله دون غيره قطعًا”.
تلك حقبة تلتها محطّات تَحدَّث عنها القرآن ستقف عندها البشرية، ففي بعض المراحل الزمنية أمَرَ اللهُ تعالى المسلمين بالعفو والصفح بقوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة البَقَرَةِ: 2/109)، وفهموه حقًّا، فعَفَوا وصفحُوا وعامَلوا الجميع بالتسامح، إلى أن أتى الله بـ”أمره” الذي شرع به حكمًا محكمًا مغايرًا لذاك، فقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (سورة التَّوْبِةِ: 9/29).
وفي مجمل القرآن الكريم إشارات إلى منهج معاملة غير المسلمين حال ضعفنا وقوتنا؛ فكم وكم في هذه الآيات من الحِكَم والمصالح للفرد والمجتمع، والدعوة والإرشاد!
والآيات الناسخة أو المؤكِّدة تبيّنُ ماهية الإسلام؛ فلو اقتصرنا مثلًا على الآيات التي نزلت لتأسيس السلطة وترسيخها، وجعلناها محورًا، فقد نعجز عن تحبيب الإسلام إلى الآخرين، وسيُخيل إليهم أن هذا هو كل ما لدى المسلمين، وأن المسلمين مجتمعٌ يسوده الدمار والخراب، وأنهم فئة يعيثون في الأرض فسادًا، أما إذا اختير طريق المصالحة، فأُخِذت منهم ضريبة باسم “الجزية” كما تؤخذ الزكاة من المسلمين، وطُبقت قوانين عقد الذمة وحوفظ على الأقليات تحت وصاية المسلمين، وأتيح للناس الاطلاع على ما عليه المسلمون من معاملة طيبة، فلا شك أن كثيرًا من الناس سيهتدون للحق بما يشاهدون من محاسن الإسلام؛ والتاريخُ زاخرٌ بكثير من الأمثلة على هذا النوع.
لقد دخل أهل مكة في دين الله أفواجًا لما رأَوا سماحة الإسلام وعفو الرسول وصفحه عنهم، وما ارتضى أجدادنا الأتراكُ الإسلام ولا دخلوا فيه أفواجًا وقبائل إلا بهذه الطريقة، ولم ينتشر الإسلام في زمن قصير خلال نحو ربع قرنٍ في آسيا الوسطى وإفريقيا إلا بفضل هذه المعاملة العالمية الإنسانية.
إذًا إن الآيات القرآنية التي تخاطب الفطرة الإنسانية متعانقةٌ متناغمة على الدوام. نعم، في القرآن ناسخٌ ومنسوخٌ، لكن ما يبدو لنا منه مختلفًا أنار زوايا مختلفة، ونَشَر في كل مرحلة ودورة أنوارَها على طول موجاتٍ مختلفة… وفي مرحلة العفو والصفح استنارت الإنسانيةُ بقبسٍ منها واقتبست منها، وتوجّهتْ إليها في مراحل الحرب والصلح، والتجأت إليها، واتخذَتها ملجأً في شتى معضلاتها؛ والآيات القرآنية خزائنُ إرشاديةٌ فريدةٌ لا تنفد، زاخرةٌ بالأمثلة الباهرة لمن يريد معرفة المكوّنات الداخلية والخارجية للكافرين والمنافقين والمشركين، وكيف أنهم يوظّفون طاقاتهم في الكفر والنفاق، ويفسدون المجتمعات.
نعم، إن في القرآن تعريفًا للإنسان من كل وجه، وفيه وحده سبرًا لمختلف المجتمعات نشأةً وتطورًا وقوةً واندثارًا مرحلةً مرحلة، يستأصل منها شأفة الأهداف والأيديولوجياتِ الضالة، أو يقوِّم عوجها ويُصلح فسادَها في مراحل نضجها بلا مضاعفات سلبية، إنه منبعُ قوة دائمة فاعلة؛ أما الأنظمة والمؤسسات البشرية فليس في صبغتها الأمّ شيء من المرونة؛ ففيها يتوقّف تكامل الإنسان الروحيُّ والفكري والحسي عند نقطة ما، ويبدأ عهد الانحطاط والتقهقر.
نعم، إن لم تنضج الفطرة بأن حادت عن نهح الخالق ولم تبلغ الكمال، فستتآكل ويعتريها النقص؛ وما زال القرآنُ يوصي باستثمار مقومات التكامل البشري والاستفادة منها، ومن أهمها الحركة والحيوية المغروزة في الفطرة، وخيرُ ما يعبِّر عن هذا أن الأيديولوجيات البشرية سرعان ما تقصر عن تلبية حاجات البشر، وتُلجئ الناسَ إلى البحث عن بدائل لها، بينما يظلّ القرآن يحيط بمشكلاتنا ومعضلاتنا ويرشدنا ويهدينا.