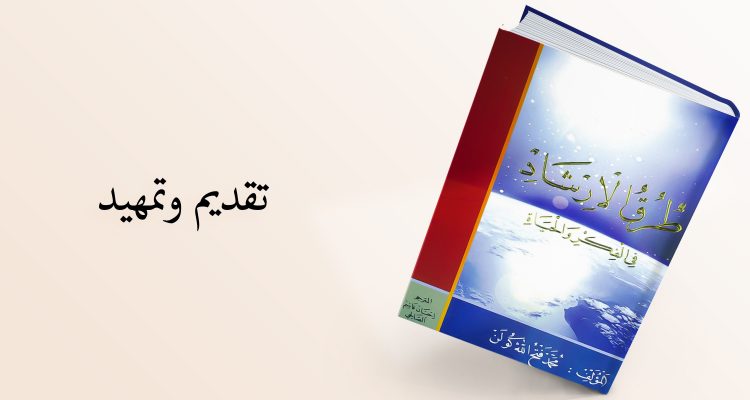عندما لا يحترق القلب شوقاً، والروح عذاباً، والذهن همّاً، فلا تتكلم.. وإلاّ فلن تجد أحداً يصغي إليك.
وعندما لا يملأُك الشعور بأنّ دعوتك هي قلب الكون، وروح الوجود، وأنها ميزان العالم، وصمَّام أمنٍ وأمانٍ له، فكيف تواتيك الشجاعة لمواجهة العالم كله؟!
وعندما لا يلتهب في دمك عِرقٌ بطولي عارم يدفعك لتحدي قدرات هي أعظم من قدراتك، وإمكانات هي أعظم من إمكاناتك، فكيف إذن ستخرق المتحديات وتصنع الأعاجيب؟!
وعندما لا تشعر بمسؤوليتك في إنقاذ الإيمان مما يحيق به من خطر عظيم في العالم كله، فكيف تريد إذن من هذا العالم أن يفتح أذنيه ليسمعك؟!
وعندما لا يصدر كلامك مُحمّلاً بألطاف من الشفقة والرحمة بأولئك المجذومين روحياً ومعنوياً، فإن كلامك معهم لا يزيد عن كونه ثرثرة لا يترك أثراً في أحد.
وعندما لا تحسُّ بأنفاس الملائكة تمازج أنفاسـك وبرفيف أجنحتها يلاطف وجهك شاهدةً على ما ينطق به لسانك فلن تشُمَّ رائحة الصدق الذي من دونه لا تتفتّح لكلامك قلوب الآخرين وعقولهم.
وعندما لا تدفعك مسؤوليات الدعوة لزيادة الإدراك، وفهم توجهات العالم الروحية والفكرية، واكتشاف اللغة التي يمكن من خلالها أن يفهمك فأنت عابث غير جاد، والعابثون من الدعاة يضرون ولا ينفعون ويؤخرون ولا يقدمون.
وعندما تصاب الروح بالفتور، وتنخفض درجة حرارة القلب، ويخبو أوارُ الفكر، فأنت متوعك روحياً، فعليك أن تصمت، لأن الصمت هنا أبلغ من كل كلام ميت تقوله.
وإنْ لم تطرح نفسك التي تضايقك وتعذبك بعيداً خارج نفسك فكيف يطهر كلامك ويتقدس فعلك؟!
وإنْ لم تشرق شمس اليقين بالنصر في سماء كيانك فكيف يكون كلامك دافئاً وصوتك قوياً؟!
وإنْ لم ترتّب بيتَ نفسك أولاً فكيف تستطيع أن ترتب بيوت نفوس الآخرين؟!
وإنْ لم تكن نفسك جميلةً فكيف تستطيع أن تجمّل نفوس الآخرين؟!
هذه بعض ملامح عامّة يمكن اسـتخلاصها من هذا الكتاب القيم. فمؤلف الكتاب الداعية الكبير الأستاذ الفاضل فتح الله كولن -أمدّ الله في عمره- له في مجالات الدعوة إلى الله تعالى معاناة وتجارب وأحداث ووقائع يمكن أن يفيد منها الدعاة في كل مكان، ولـه في هذا الشأن مبتكرات وإبداعات أسهمت في بناء صرح إيمانيٍ عظيم على المستويين المادي والمعنوي تكاد تغطي خارطة تركيا الحديثة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. فضلاً عن إنجازات مثلها في أقطار أخرى خارج تركية.
وعلينا ونحن نقرأ هذا الكتاب ألاّ نتابع انطلاقات قلم الكاتب وحدها، بل علينا إلى جانب ذلك أن نتابع انطلاقات روحه، فالقلم يومئ ويشير إلى هذه الانطلاقات إلاّ أنه قاصر عن التعبير عنها.
وخير ما يترجم عن انطلاقات روحه ويفصح عنها، هذا الصرح الإيماني العظيم بقدميه الراسختين في الأرض، وبقمته التي تكاد تلامس السماء، وعندها نستطيع أن ندرك عظمة الروح وقوة الإرادة عندما يجتمعان في الداعية ماذا يمكن لهما أن يفعلا.
والكتاب -بعد هذا الذي قلناه عنه- كتاب فريد في نوعه، إذْ هو ليس كما قرأنا من كتب في الموضوع نفسه بل يمكن أن نطلق عليه عنواناً آخر، فنقول: إنه كتـاب في (فقه المعاناة والألم) من أجل الدعوة، بالإضافة إلى كونه قدحةً تضيء الجوّانيّة العمي قة للإنسان وما تطفح به من نازع إيماني فطري عميق، والكتاب يكاد كله يكون عملية تحريكية لهذه الفطرة المدركة، وترجمة رؤاها، والتعبير عن أهدافها ومقاصدها، كما أنه -أي الكتاب- ضدّ الفوضوية الروحية والفكرية التي تعاني منها الدعوات. وهو يهدف إلى إرساء قواعد أساسية منظمة في (العمل الدعوي) تحول بين الداعية والتفَلّت إلى مجالات أخرى غير ملتزمة وغير منضبطة، وبذلك تحتفظ الدعوات بقواها وتمنعها من الإنفلات والتبدّد في غير فائدة ولا طائل.
والأستاذ يرى: كما أن الحياة التي نحياها ونستنشق أنفاسها عملٌ فنيٌّ جماليٌّ خلاّق، أبدعه الخلاّق العظيم، فكذلك ينبغي أن تكون “الدعوة” حيـاة تحيا بأنفاس الدعاة وتتحرك بداينمية أرواحهم، وعلى قَدْرِ ما يعطونها من حياتهم، وينفخون فيها من أرواحهم وعقولهم تنمو وتكبر وتتسع، وعلى قدر توجههم إلى الله تعالى والاسـتمداد من رحمته، والتضرع إليه، والوقوف بذلةٍ ببابه، تتقدّس دعوتهم وتطهر وتجمل حتى تصبح ذوقاً كلَّهَا، وخُلُقاً كلَّهَا، وأدباً كُلَّها، وتظلُّ بَصْمتُها بصمةً لا يخطئها أحد بين بصمات الدعوات.
والإيمان عند الأستاذ فتح الله -كما يكشف عنه في هذا الكتاب- طاقة حركية ينبغي أن تتحرك على جميع الجهات، وفي جميع الجوانب، فهي في الوقت الذي ترفع الإنسان إلى سماوات عالية من الإدراكات الروحية، فإنها في الوقت نفسه تجوب الأرضَ وتتسلَّلُ إلى مفاصلها وشرايينها لتبعث الحياة في روحها الثقيلة، ودمها المتجمد. فعظمة الإيمان عظمة كوكبية كونية متحركة، إذا وقفت عن الحركة انطفأت وماتت، كأي كونيِّ آخر من كونيات هذا العالم الذي جعل خالقه حياته في حركته.
وعظمة الروح وقوة الإرادة اللَّتان تنبعثان من شخصية الأستاذ (فتح الله) تتدفقان منه نحو طلبته كما تتدفق شعاعات الفجر في بقايا من ظلمة الليل. فهو يقاسم طلبته حياتهم، ويقاسمونه هم حياته، فهو فيهم باعث دراية ويقظة، وهم فيه باعث نظر وتأمل وحُنوٍّ وإشفاق، هو ضميرهم إذا تكلّم أو صمت، وهم ضميره إذا تكلموا أو صمتوا، وهو دموع أحزانهم وهم دموع أحزانه، وهو قلبهم إذا ترنَّمَ شجىً، وهم قلبه إذا فاض حزناً وأسىً، وإنهم ليرون في أحزان أستاذهم عالماً من القوة الكاسحة التي لا يقف أمامها شيءٌ، وهو يرى في أحزانهم عالماً من قوة إيمانٍ لا يؤودُها شيء ولا تثقلها فادحات الخطوب، وأن يمين الدهر مشلولةٌ دون الوصول إليهم، وإرادة الشرّ على صلابة أصلابهم ستتكسّرُ.
وهم يرون فيه سِرّاً إلهياً خفياً إن تكشَّف لهم بعضه إلاَّ أن أبعاضه الأخرى لم تتكشّفْ بعد، وربما سـيأتي زمانها ويحين حينها، لذا فإنـهم يتلقون ما ينفث به وحيُ ضميره، وينبثق عنه فكره، وينفجر عنه فؤاده، بكل الاحترام والتقدير والولاء.
ولأنَّهم يرونه قبضة من طينة الحق فإنـهم لن يترددوا لحظةً واحدةً في خوض البحار والقفار من أجل الإيمان الذي كرّسوا حياتهم ووجودهم في خدمته. فما الحياة كما يعلمهم أستاذهم إلاَّ لمحة بين أبدين، ولحظة متحركة تفصل أبد الماضي عن أبد الآتي ما أسهلَ أن يتجاوزها الإيمان دون أن تَمُسَّ هدوءهُ الجوهريَّ في الأعماق.
* * *
والأستاذ هنا لا يُعَلِّمُ بَقدْر ما يناجي، إنَّه هنا روحٌ كروح النَّاي يناجي حبَّات القلوب، ويسكب أنينه ونواحه في الأرواح، إن آلام الإسلام في ستة من القرون الماضية قد تجمَّعَتْ كُلُّها في روحه، فذاق حزنـها ولبس شجاها، وغُصَّ بمرارتـها، ولكنَّ هذا الأسى، وهذا الشجوَ ليس أسى يأْسٍ، ولا شجوَ قُنُوطٍ، إنما هو أسىً في ذَوْبٍ من الضياء، وحزنٌ في هالة من الأمل، إنه حزنٌ يعمّقُ قوّة النظر ليرى الأعمق والأبعد، وفي الأعمق والأبعد يكمن الأمل، ويأتي الفرج.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين.
أديب إبراهيم الدباغ رحمه الله