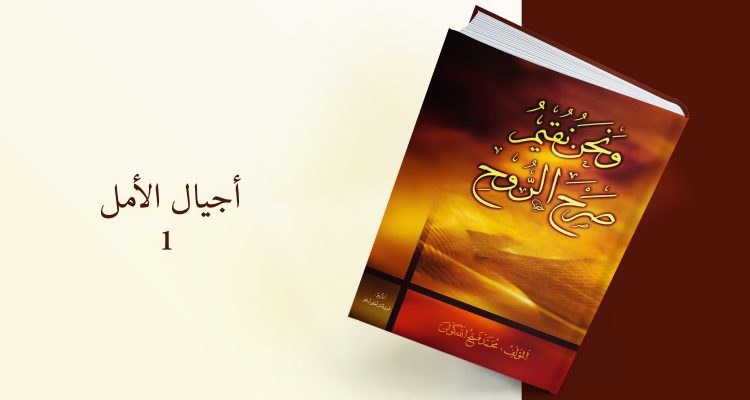إن أجيال الأمل باعتبار الزمن الحاضر هم ممثلو العلم والإيمان والأخلاق والفن، وهم مهندسـو الروح لمن يأتون بعدنا. وسيشكّل هؤلاء تكوينات جديدة في كل شريحة اجتماعية بتفريغ حرارة الإلهام لقلوبهم المتغذية بالأخرويات إلى الصدور المحتاجة إليها. وإن ضيـاع حظ كثير من الأجيال في تاريخنا القريب، وهدرهم، بل سقوطهم في الجنون والهذيان، كان بدرجة كبيرة لعدم التقائهم بمثل هذا الجيل الأمل.
لقد عشنا في القرن الأخير، أو القرنين الأخيرين، هزائم متتالية حتى في وسط النجاح! وكثيراً ما خسرنا في سياق النصر! ففي تلك المرحلة التي كنا نفترس بعضنا البعض كالذئاب، خلفنا للأجيال الآتية من بعدنا إرث الحقد والبغض والتعصب السياسي. ففي تلك المرحلة لم يَخْلُ الذين خاضوا في السياسة أو الذين شاركوا فيها من خارجها على السواء، إما من احتساب كل وسيلة لتصدّر فريقهم وكوادرهم وسيلةً مشروعة، وإما من توهم أن استلامهم للحكم يغير كثيراً من الأمور أو ينقذ الوطن. ولم يفهم الطرفان يقيناً بأن الوصول إلى المقاصد المرجوة لن يتحقق إلاّ بانقلاب يعتمد الدوران في فَلَك الإيمان والعلم والأخلاق والفكر والفضيلة. ولأنهم لم يدركوا ذلك، ظنوا أن التغير والانعطاف الكبير المرغوب فيه، هو هذه التغييرات الجوفاء والخاوية من المعنى، والصوريـة، والشكلية، وتشبثوا متعلقين بأذيال تغيير المكياج والأصباغ والألوان في عملية الترميم التاريخية الكبيرة. وزد على ذلك، أن بعضهم باع للشيطان فكرة “الملّيّة” الراقية بأشـياء بخسة وكأنه “فاوست”( ) غرٌّ لأنه غريب عن قيمنا “الملّيّة” الحقيقية. ولم يَملّ هؤلاء من الاضطراب المسـتمر حسب متطلبات الحـال من حيث المنافع والمطامح المتقلبة، من أجل صياغة شكل للملّة على صورة معينة يوماً، وعلى صورة أخرى يوماً آخر… بـل الأصح على إظهار “الملّة” بهذه الصور الشاذة العجيبة. فتنفسوا هواء “الطورانية” مرة، وهمهموا مرة بمقولات “الشعب، الفلاح، القروي”. وقضوا وقتاً مع “الأرسـتقراطية” مرة أخرى، ثم قالوا: “الديمقراطية”، وغمزوا “للشـيوعية”، … لكنهم لم ينجوا من الهَيْمِ على وجوههم أبـداً! فاتخذ مثقفونا خاصة، حلم فرنسا، والإعجاب بانكلترة، والرغبة في ألمانيـا، وعشق أمريكا والشوق إليها، حركياتٍ لتفسير الحياة وموانئ لرسـو السفائن المبحرة إلى المستقبل، بنَهمِهم المختلط والفاقد للمعايير، وحسب تقلب الزمان.
وكان الحال يقتضي أن تُرسَّخ الفكرةُ المشتركة بيننا كشعب، وأعني الدين والعاطفة الملّيّة، على القواعد المتينة والرصينة التي تسـمو فوق كل الأحلام والمتخيلات وتتجاوز حقائق الأرواح المنفردة، وتعتمد على الإيمان السليم المتين، والفكر المتأصل، والأخلاق المستقرة، والفضيلة المتمكنة من الأرواح. فمثل هذه الحركة تسـتطيع أن تَعِد الأجيال القادمة بالخلاص المأمول… حركة أخلاقية ثابتة التوجه، منفتحة على الامتداد والتغيير في فَلَك ثرائها الروحي والمعنوي الذاتي، غير متزحزحة عن محور “رضا الله”، موصدة الأبواب تماماً في وجه المنافع والمطامح. وبعكس الحال، سنعجز عن احتضان الروح والمعنى الخاص “بِملّتنا” ذاتياً، وإحاطته بالحماية، وإيصال الأمانة إلى الأجيال القادمة بأكمل خصال الأمناء، ما دمنا في انتقال على الخطوط المنحرفة باستمرار، وفي غبش الإيمان المختلط الذي لم يبلغ اليقين في قلوبنا ومفاهيم التوجهات المختلفة والتَلَقيات الحضارية المتنوعة في عقولنا.
لا يغيب عن العارفين بهذه المراحل المضطربة ما فقدناه، وما ضيعناه من قيمنا الذاتية في الماضي القريب. ولم نكفّ إبّانها عن التفكير بابتكار أسلوب جديد وفلسفة حياة جديدة، تُبعد عنا المفاهيم المختلفة اختلافا بيّناً، والتَلَقِّيات البعيدة عن بعضها بعداً شاسعاً، والأفكار المتناقضة تناقضاً كلياً. لكن هيهات، هيهات. فكم عمرٍ انقضى هدراً، وما زلنا نسلو بخيال أن نبتكر أشياء جديدة! ويبدو لي عسيراً أن نجد أسلوباً جديداً وفلسفة حياة جديدة بعد اليوم، كما لم نجد في السابق. ذلك، لأننا لا يمكن أن نصل إلى مركّب فكري جديد وأسلوب مبتكر في التعبير عن الذات من دون احتضانٍ لجذور الروح والمعنى في حياتنا الذاتية. لقد فشلنا في بلوغ نظام فكري جديد وأسلوب مبتكر… بل زد على ذلك، أننا عشنا باستمرار غثياناً واضطراباً تحت تأثير مُناخٍ كثير الأشواك، وكأننا مضطرون إلى الإحساس بأشياء عديدة في وقت واحد! وإبّان ذلك، أُهدِرت عبثاً هنا أو هناك فرصٌ سنحت لنا، وطاقات كامنة للقوة والمنعة.
ومهما بدا علينا وكأننا نعمل شيئاً منذ قرن أو قرنين، فإننا لم نُقِم أثراً نطمئن إليه أو نُغبَط عليه، يجسد إيماننا المنساب إلينا من أعماق تأريخنا ونمط فكرنا وأخلاقنا وثقافتنا وفننا واقتصادنا. ولئن أجريت في مراحل معينة مداخلات جراحية تأجيجاً للأحلام أو لأهواء الشباب، لكن لم نسمع إلا جماً كثيراً من الأمنيات الخادعة عن حاجاتنا الحقيقية مثل تفسير العصر وتقييم العلم وتفهم حكمة الوفاق والاتفاق والتغلب على الفقر الذي يقصم ظهرنا منذ زمان طويل. إن نجاتنا من هذا الذهاب الذي يحبسنا في حواسنا فيلهينا، ومن الأفكار الهزيلة، سيتحقق على يد أبطال الإدراك والبصيرة واللدنيات الفاهمين للعصر والعاشقين للحقيقة بشُبوب اشتياقهم للعلم، والمُحْدَودَبة ظهورهم تحت ثقل المعضلات الحقيقية الحاضرة والقلق المتصور في المستقبل، والمنعكسة دواخلهم على سلوكهم وتصرفاتهم، والمتنفسين هواء قلوبهم، والمتطلعين دائماً إلى ما خلف الآفاق… أبطال اللدنيات الذين يئنون بآلام الأجيال إذ يسعون للنهوض بها إلى درجة معينة، ويحولون مستقبلها الكدِر إلى دموع في أرواحهم فينوحون نواح أيوب u، ويتقاسمون معها أوجاع يومهم وغدهم، ويَشُبّون إلى العلى بالشكر باحتساب لذائذها أنعما من الحق تعالى. هؤلاء الذين يستلهمون من تاريخنا الحي المزدهر بالألوان، الممتد إلى مئات السنوات، ويستقوون منها، فينفخون روح صيرورة “الملّة”، “مِلّة” حقيقية ومتدفقة بالحيوية، ويئزون الشباب بفكر الإيمان والأمل والحركة، ويفتحون تيارات جديدة من حوض فكرنا “المِلّي” المستكين منذ زمن طويل في الشِباك القاتلة للخمود الرهيب. ونحن كأمة سنهرع في هذه التيارات إلى معابدنا التي فقدناها في قلوبنا، فنجهش بدموع الوصال، ونعود إلى مآوينا ومساكننا الدافئة كزوايا الجنة، فنلتقي بانعكاسات الجنان التي ضيعناها منذ أمد بعيد، ونكتشف مجدداً مدارسنا القائمة على قواعد البحث عن الحقيقة وعشق العلم، فنتعرف على الوجود كرة أخرى من خلال منافذه المفتوحة على الكائنات… ونـزداد حباً للجميع، ونتعلم اقتسام كل شيء، ونحتضن الجميع على السفوح الزمردية لقلوبنا بأخلاق العيش في اضطراب وقلق متزايـد… ونطفح بمشاعر الفن والصنعة إزاء الوجود، ونفكر في المناسبات البشرية بالأنّات والخفقات والدموع الحرى، فنعبّر عن أنفسنا.