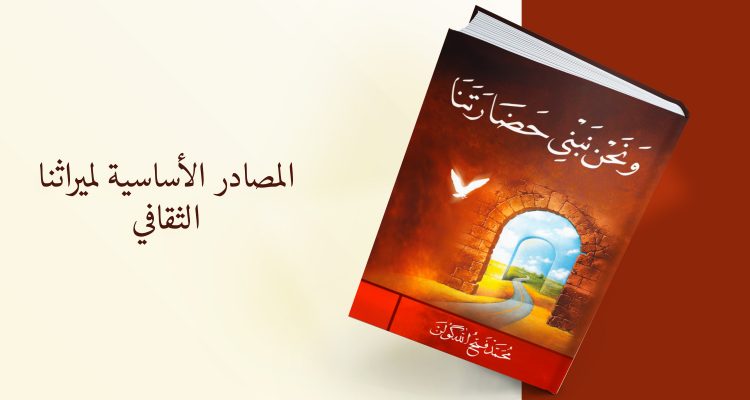يشيع القول بأن “الثقافة” مجموعة نُظُمٍ وقواعدَ تحكم التصرفاتِ الاجتماعيةَ والأخلاقية التي أنتجتها وأَصَّلتها أمة أثناء تاريخها الطويل، وجَعَلتْها بمرور الزمان بُعدًا من أبعاد وجودها أو حوَّلتها إلى مكتسبات في اللاشعور… ومع أن بعض الخصوصيات الأساسية للثقافة حسب هذا التعريف يحمل سمات العالمية، لكن الواضح أن لكل مجتمع في جغرافية اجتماعية معينة، ثقافةً سائدة خاصة. وبدهي أن هذه الخصوصية الثقافية عنصر مؤثر قوي في النُّظُم الفكرية. ولذلك، يُعد الفكر المرتبط بثقافة معينة عند فرد من الأفراد، تعبيرًا عن ذاته بواسطة إطار المرجعية المعنية.
وهناك عدد ليس بالقليل من الذين فسروا الثقافة -وربطوها بالفكر نوعا ما- بأنها مجموع الأحوال التي تعبِّر بها أمة من الأمم -بجميع طرائق التعبير أو معظمِها- عن قيمها الأخلاقية، وملاحظاتها المذهبية (العقدية)، وأفكارِها ورؤاها حول الوجود والكائنات والإنسان، وعن سلوكياتها الاجتماعية والسياسية وأصول تصرفاتها… وأنها المجموع العامُّ للأمور التي تُكتسب في سياق التاريخ في إطار الالتزام بالتفكير والإحساس “الذاتي”؛ من أمثال الفكر والفن والعرف والعادة والعمل. (وهناك قيود على العرف والعادة والعمل سنذكرها لاحقًا).
إن العلاقة بين (الإنسان – الكائنات – الله) -بقراءة جمعيةٍ لم يُراعَ فيها الترتيب بين التابع والمتبوع- من أهم الأسس في نظامنا الثقافي. وجميعُ فعالياتنا الذهنية والفكرية والعملية مرتبطةٌ بهذه العلاقة. أما المنطق الأوروبي الحديث -وهو ميراثٌ يوناني تمامًا-، فيَربط ملاحظاتِه كلَّها بالإنسان والأشياءِ والحوادث. ولذلك، لا يأخذ حقيقةَ الألوهية بنظر الاعتبار البتة، أو يتناولها باعتبارها موضوعًا تبعيًا غير مهم؛ والحال أن (الإنسان – الكائنات)( ) -في نظامنا الفكري- مَشهرٌ وكتابٌ وبيانٌ يُعَبِّر بلغة الحوادث، وهو بهذا الاعتبار لسانٌ ومَعرِض يُعَرِّف بـ”الذات الواجب الوجود” عز وجل شأنه، ويُشهِر آثارَ صنعته، ويَهتف بإجراءاته وشؤونه. فهناك، في الفلسفة اليونانية والمنطقِ الغربيِّ المعاصرِ المستمدِّ منها، عقلٌ فعال، وبجانبه “فهم” لألوهية عاطلة، وأما في ثقافتنا فـ-على النقيض من ذلك- هناك مناسبةٌ دائمة بين الصنعة والصانع، وبين الأثر وصاحبِ الأثر، وبين الخالق والمخلوق. نحن في نظامنا الفكري نَعتبِر الإنسانَ والكائنات كوسائط تَحملنا إلى أفق عرفانيٍّ معيَّن، وبها نتوجه إلى الصانع الجليل الأجل ونطلبه ونقصده. أما أولئك فيقفون عند النتائج العملية لـ”مفهوم” الألوهية، ويُرجعون كلَّ مسألة إلى الأشياء والحوادث. وزد على ذلك، أننا نربط المسائل بالكتاب والسنة والمصادرِ الأخرى التي يرشدنا إليها الكتاب والسنة، إلى جانب العقل الفعال… أما أولئك فيَرون العقلَ والمشاهدة سببًا وحيدًا للعلم، فيُضيِّقون سبل العلم والمعرفة.
الحاصل أن الثقافة هي مجموع المفاهيم والقواعدِ والانسياقات التي تَعلَّمَها الإنسانُ وآمَنَ بها وطبقها في حياته فصارت -بعناصرها الأصلية والتبعية- بُعدا من طبعه، حتى تحولت إلى مصدر للمعلومات في اللاشعور… فهي ظاهرة أبيستمولوحية يُدرَكُ ويُحَسُّ بوجودها وتأثيرِها بين الحين والآخر، حتى في غياب الشعور والإرادة.
فكم من معتقدات ومسَلَّمات وأعراف وعادات مندرجةٍ في الروح وغافيةٍ في اللاشعور، تُحفِّزها المقومات الداخليةُ للعقل بين فينة وأخرى، بواسطة دوافعَ وأسباب مؤثرة في هذه المكتسبات، فتنشطها وتُفعِّلها وتنشئها فتصوِّرها في أشكال؛ فأحيانا في ذات شكلها القديم وأحيانًا في تَماثُلٍ قريب من شكلها القديم ولكن ربما بلون باهت. غير أن هذه المكتسبات مهما كانت مندرجة في طبع الإنسان فلا تَظهر في الحاضر مجدَّدًا بعين الذات القديمة، لأن كل يوم جديد هو عالم خاص بذاته، وإذ يطلع يطلع بخصوصياته، وإذ يغيب يغيب بخصوصياته! لذلك، لا نريد أن نكرر مكتسباتنا القابعة في اللاشعور، كشيء قديم تمامًا، بل بإضافة شيء من العمق إليها حسب متطلبات الأحوال والظروف. بل القول الأصوب أن نعيش تلك المكتسبات بزيادة ألوانٍ وأعماقٍ طرية، صحيحةَ النسب، ومستمدةً من الأصل.
ونلفت النظر إلى خطأ وقعنا فيه –كأمة- دائما؛ وهو أننا -بدلاً عن جعل القديم أساسا متينا ليُقام عليه الجديد، وتطويرِ القديم بمعطيات الجديد- فَصَلناهما في أكثر الأحوال إلى شريحتين ربطناهما بحقبتين منفصلتين؛ فأحيانا استعْدَينا بعضهما على بعض، وأحيانا أخرى عارضنا بينهما، فأدينا إلى حصول معضلات في الأسس؛ فإما قلنا: “الجديدُ يُشم عطره ثم يُرمَى في النفايات، والقديمُ يفوح كالمسك والعنبر كلما رججتَه يتضوع”، فأفرطنا في “وارداتِ” حقبة من الزمان… أو قلنا: “لا نفع في مكتسباتٍ عتيقة لزمان ولَّى؛ الخيرُ في العالم الزاهي للجديد”، وأهملنا تمامًا ذلك الجانبَ للزمان، فأغفلنا مفهوم “الزمان الذاتي”، وتغافَلْنا عن البعد العالمي الكوني.
والحال أننا ملزمون بإعداد البيئة الطيبة لزمانٍ ثقافي جديد يُطوِّر حياتنا الفكرية، بتفسيرِ ثقافتنا تفسيرًا معمَّقا، وتقويمِها تقويما دقيقا، -ليس من أجل منطقتنا الجغرافية وحدها- بل من أجلِ تأسيسِ جسر متين ودائم بيننا وبين العالم المتحضر. بعبارة أخرى: يتحتم علينا -من أجل بناءِ فهمٍ ثقافي أمتن وأسلم وأقوم وأبقى لأمتنا- أن لا نفدي قِيَمَ ماضينا وحاضرِنا ومستقبلنا بعضَها لبعض مع مراعاة الأولوية للمستقبل، وأن نوقر ونصون الديمومة والتوسع بنفس الدرجة.. والحقيقة أن الزمان الثقافي غير مرتبط بفكرة التواجد قبلُ أو بعدُ، على خلاف مفهوم الزمان المعروف لدينا. وأرى من الأنسب أن نسميه بـ”ما فوق الزمان”. بل الأحرى أن ننظر إليه مستقلا عن الزمان ومتعاليا عنه. والواقع أن ديمومة الثقافة بذاتها منوطة باستقلالها. لكن من البدهي وجودُ إطار من المرجعيات تنظِّم بناءها الذاتي والمستقل تماما، وتُشكِّل كيفية علاقتها بالجهات المختلفة. فمن هذه الوجهة وفي داخل إطار كهذا؛ يمكن أن نقول: إن الثقافة هي عبارة عن مجموع المفاهيم المختلفة وسبل التفكير المتنوعة، وأوجهِ الرؤية المتعددة، “والتصوراتِ” الفنية والقيمِ الأخلاقية المرتبطة كلٌّ منها بتفسيرٍ مختلف.
وثَمّ أسس راسخة نجد أنفسنا مُلزَمين بأن نربط كلَّ مضمونٍ ومفهوم وأسلوبٍ فكريٍ وتفسير ومقاربة، بتلك الأسس. حتى إن الثقافة بألوانها المختلفة تحوم وتدور في محيطها، وتنهل من مناهلها، وتتغذى بغذائها، وتنمو بها، ثم تتحول بفضلها إلى حال فوق الزمان والمكان.
وهذه الأسس -باختصارٍ- هي الكتاب والسنة (وسنُذكِّر بهما بإشارات سريعة لاحقًا)، وبالإضافة إلى هذين العمادين -وفي إطار مرجعيتهما- التفسيرُ والحديث وأصول التفسير وأصول الحديث والفقه وأصول الفقه… ونخص بالذكر الفقه وأصول الفقه فهما -من حيث إنهما ثمارُ مساعٍ حثيثة وكدحٍ مضنٍ، ومن حيث إنهما من غير مثيل أو شبيه لهما في التاريخ- مَنبعان لا ينضبان ومصدران قابلان للتوسع والثراء الرحيب بحيث إن الشعوب التي تمتلك هذين المصدرين، تُعَدُّ مالكة لأهم الأشياء الحيوية. إن كل حضارة تَفخر بقيمٍ تخصها بالذات… فالفقهُ وأصول الفقه من أهم وأبرز قيم حضارتنا نحن. وأحسب أننا لو كنا نحتاج إلى أن نَصِف حضارتنا -باعتبار ماضينا- بصفة، لكان من الأنسب أن نصفها بـ”حضارةِ الفقه وأصول الفقه”… حضارة الفقه وأصول الفقه المنفتحة أبوابُـها على مصاريعها للفكر والحكمة والفلسفة. ولئن تميزت حضارة اليونان والإغريق بالفلسفة، وحضارة بابل وحران بالعرفان (Gnostisizm)، وحضارة أوروبا الحاضرة بالعلم والتكنولوجيا، فإن حضارتنا الممتدةَ عبر العصور هي حضارة الفقه وأصول الفقه المتفسحةُ للجميع بتمحورها حول الفكر والعقل والمنطق والمحاكمة. إن الجهود حول أصول الفقه عندنا -كما يؤكد مفكرون كثيرون مع “سيّد بَك” والأستاذ محمد حميد الله- من أهم المجهودات غير المسبوقة لبناء وتطويرِ نظام حقوقي متكامل وعلمٍ قانوني لا يشوبه نقص، وتوسيعه لاستيعاب كل العصور. فهذا العلم بالإضافة إلى سَبْقه منفتحٌ ليكون مصدرًا للحضارات والثقافات الأخرى، باعتباره مؤثرًا في تشكيل العلوم.
وعلى مر الزمان امتلكت مجتمعات مختلفة نُظُما قانونية أو حقوقية، كالرومان والصينيين والهنود واليونانيين. لكن لا اليونانيون في ألواحهم، ولا الرومانيون في قوانينِ كاسيوس، ولا العالَم المعاصر في متونه القانونية، استطاعوا أن يربطوها بأصول أو قواعد مستقرة كما في نظام الفقه الإسلامي. فلذلك لن تجد في أمة أخرى مثلَ هذا العلم المستندِ إلى القرآن والسنة واجتهاداتِ السلفِ الصالح وتحقيقاتهم.
إن الفلسفة في أطوارها المختلفة هي نتاج المنطق المتطورِ دائمًا ليستجيب لحاجة تلك المراحل المختلفة. وفي حضارتنا قام “أصول الفقه” بهذا الدَّور في نظامنا الحقوقي طوال التاريخ. الفقهُ والحقوق يؤديان وظيفةَ إدارةِ المجتمعات بقواعدَ منظمة، وأصولُ الفقه يوجِّه الفقه والقانون. والذي يحدد نوع الأصول والأساليب التي تُتَّبع حسب طبيعة الموضوع أثناء هذا التوجيه هو “العقلُ السليم”. ومن الواضح أن لهذه الأصول أثرًا ظاهرًا وصريحًا في فهم القضايا الحقوقية فهما جيدا. والحقيقة أن ما قيل عن الفقه وأصول الفقه، يقال أيضًا عن العلوم الأخرى المرتبطةِ بالقرآن الكريم والسنة النبوية.
وقد ظهرت دراسات متنوعة وطُوِّرت أنواعٌ من النُّظُم دارت حول الكتب السابقة، لكن المساعي المكثفة والتفاسير المنصبَّةَ على القرآن والسنة، تَبقى مدى الدهر من الظواهر الجديرة بالتقدير والتوقير. إن القرآن الكريم -سواء بالتفسيرات المروية عن رسول الله r أو التفسير والتأويل في ضوء قواعد اللغة العربية وأساليبها، أو أسباب النـزول- لم يزل مصدرًا مهما لثرائنا الفكري، حتى إن من ينظر إليه بالنظر السطحي فلا يخفى عليه كم هو مصدرُ ثراءٍ كبير.. والمعنى عينه جار على الحديث أيضًا. لكن اللازم أن تصان هذه العلوم بالعقول الوفية والمقتدِرة. وإلا، فلا منجى ولا مفر لأمتنا من حياة الشقاء في هذا الثراء، إن دام ما يراد لهذين المصدرين النيرين الفياضَين من تكديرٍ لصفائهما أو إغفالٍ لوجودهما، نتيجةً للعداوة اللدود من الخصوم، والخذلانِ أو السكون من الأصدقاء.
ومن مناهل ميراثنا الثقافي، المصادر التبعية والفرعية الدائرة في إطارِ مرجعيةِ هذين المصدرين الأساسيين: مثل علم الكلام بموضوعاته المقبولة عند أهل السنة، في إتيانه بالبراهين العقلية والنقلية على عقيدة الإسلام، ودفعِه الشبهاتِ والتخرصات عن ديننا، وردِّه على الأفكار الفلسفية المنحرفة الضالة كالتشبيه والتجسيم، وإثباته الصفات الإلهية ووضْع إطار لفهمها، وموضوعات “الأصلح” و “الحُسن والقُبح”… ومن تلك المصارأيضا: المصلحةُ والاستحسان والعرف والعادة والعمل…
ولا يكفي لشرح كل مصدر من هذه المصادر كتابٌ. ولكن لا بأس من لفت الانتباه إلى قسم منها بنظرة كلية شمولية وبإشارات سريعة:
1- الكتاب
إن “الكتاب” المعبَّر عنه بالكلمة المقدسة: “القرآن”، هو المجلِّي للبصيرة والمعمِّق للشعور والموسِّع للفكر.. وهو المصدر الثرُّ بشكل يأخذ بالألباب، والكافي بمرونته لكل عصر بما فيه من مختلف أنواع البيان؛ من محكمه ومتشابهه ونصه وظاهره ومجمله ومفصله، وأيضًا بإيمائه وإشارته وتشبيهه وتمثيله واستعارته ومجازه وكنايته وغيرِ ذلك… لكن الاستفادة من عظيم خيره منوطة بمقدار ما تتسع له العقول المنصفة.
نعم، القرآنُ كتابٌ فوق الزمان والمكان. لكن انحراف النية والنظر أحيانا قد يسحبه من مقامه المتعالي إلى سجن الفكر البشري الضيق. فالناظرون من هذه الزاوية أو المنحرفون في أفكارهم لن يتعرفوا أبدا على أعماقه الخاصة به والتي تأخذ بالألباب. فإن الأرواح الأسيرة التي كَبَّلت فكرَها بالأحكام المسبقة، لن تحيط علما بأسرار هذا الكتاب المعجز ببيانه، ولن تهتدي إلى أفقه الإعجازي أبدًا، في أي عصر من العصور عاشوا. إنه أبدًا كتابٌ ذروةٌ في العلاء يتعدى آفاق البشر، وبيانٌ لا مثيل له بتنوع تفسيراته وتأويلاته بطول موجات مختلفة، وذلك إنما ينجلي لمن يفتح صدره له بإخلاص وصدق. إنه إكرام إلهي مهم للإنسان، والتعرفُ عليه ثم اللجوءُ إليه في كل مسألةٍ حظٌ فوق الحظوط وجَدٌّ فوق الجدود.. لكن -ياترى- كم شخصا هو على دراية بهذه الحظوة؟ والحق أنْ لا حلَّ لمعضلة بشرية من غير اللجوء إلى ضيائه، وأنْ لا سعادةَ باقيةً يَحظى بها الإنسان من غير البناء على أسسِ شلَّالِ بيانه الدفاق.
وكم أستاذٍ في اللسان بنى -على مر الزمان- من البيان صرحًا ساحرًا، وكم مفكرٍ أقام نُظُمًا فلسفية ومثالية… لكنَّ صروحَهم تهاوت، فهي خرائب.. ونُظُمَهم المثالية اندثرت، فهي ذكرى من أسطرٍ ذاوية في صفحات التاريخ. ولم يحافِظ بيانٌ على جدته إلا القرآن… وإذا كان هناك بيان حافَظَ على جدته منذ أن تجلى في أفق البشر، فذاك هو القرآن. وما من نظام يُرسِي بسفينة الإنسانية على بر السلامة إلا محتوى هذا الكتاب المبارك. في بيانه جذب ولَمَعانٌ سِحري يغدو كلُّ كلام معه لغوًا ولغطًا لا معنى فيه. وصاغةُ النُّظُم والأفكار يتحولون إلى فقراء متسوِّلين إزاء محتواه الثر.
هذا الكتاب الذي يفسر حقيقة الإنسان والوجود والكائنات يمحص حقيقة الإنسان تمحيصا بالغ الدقة، ويقوِّم الأشياء والحوادث تقويما بالغ الحساسية ودقيق التوازن، حتى إن كل أحد -بتأملٍ قصيرٍ- يكاد يرى ويلمس غيرَ المتناهي وراء هذا التمحيص والتقويم. ولذلك، فإن رجال الروح والقلب الداخلِين إلى عالم القرآن الآخذِ بالألباب، يرون كل شيء يشعرون به ويحسونه في قرارة أنفسهم كمفرداتِ فهرست، فيطالعونها مفصَّلاً في محتوى كتاب الكائنات، ويستشعرونها، ويُمضون أعمارهم كلها في عالم الإشارات والأمارات، في سعي حثيث نحو القرآن كمن يسيح في الأرض.
نعم، هذا الكتاب ينير أفق عرفاننا بحيث لا يتعرض الإنسان -حينما يسيرُ على هداه نحوَ “عرشِ كمالِ” قلبه- لوحشة الطريق، ولا احتقانِ الفكر، ولا انقباض الروح… يسير دومًا في هذا الطريق الذي يُحس إبّان السير فيه بتداخل العلم وتَمازُجه مع الإثارة والنشوة، والإيمانِ مع المشاهدة، وثقلِ الحِمل مع الاطمئنان، والالتزام بالنظام مع الإحساس بالأمن… ويتسلق السفوح فيرتقي إلى الذرى حتى يصل أصعب الشاهقات منالاً… فيبلغ آفاقًا يرى فيها وجه حظه وجده المستبشر.
هذا الكتاب -للتذكير ببعض الأمور في مقامها المناسب- يرسل إشارات ويلمح بها إلى الأعماق الداخلية للإنسان والكائنات، وإلى سعة روح بني الإنسان، وإلى أهم أبعاده الحيوية مثل الحس والشعور والإرادة والقلب، وإلى الغاية والمعنى في خِلقة هذا الموجود المتكامل (الإنسان) التي تُعدُّ ولادةً جديدة للكائنات، وإلى الفائقية في تجهيزاته، وسعة دائرة فعالياته، وعظمته الكامنة، ورغباته وآماله وهيجان عواطفه… يرسلها بحيث لا يبلغ إليها خيالُ علوم الفلسفة ولا علم الاجتماع ولا علم الأحياء ولا علم النفس ولا علم التربية..
ولا أظن أن من يَعرف هذا الكتابَ يحتاج إلى مصدرٍ غيرِه في المواضيع الأساسية المتعلقة بالإنسان -والكون – والله… إلا في تفصيلِ مجمَلاته وتدقيقِها. وإن تفصيل المجمل وتدقيقه لا بد أن يستند في إطار مرجعيته، إلى بيانٍ للنبي r أو مشاهدةٍ متينة أو محاكمةٍ سليمة أو استدلالٍ عقليٍّ قوي.. وهذا يعنى أن كل شيء يجري في فَلَكه هو.
هذا الكتاب، بنـزوله على أعظم البشر بركةً وأسعدِهم طرًا، في نقطةِ تحولٍ مهمةٍ لسير التاريخ، استهدَف تنظيمَ حياةِ مجتمَعٍ محظوظٍ، فرديًا واجتماعيًا وسياسيًا وإداريًا واقتصاديًا وروحيًا وفكريًا… و-بالفعل- حَقق هدفَه بحَملة واحدة ونفخةٍ واحدة، وصار مصدرَ إلهامٍ فريدًا لانقلاباتٍ متشابكة حصلت في مجتمعٍ بدوي، لكنها تُعدُّ أنموذجًا يُقتدى به في الأمم الحضارية. وهو -لمن يلجأ إليه- لازال حتى اليوم سندا قويًا وثريًا ومقتدِرًا على تحقيق الأمور التي حققها. نعم، القرآنُ لا مثيل له في ثراء وَسَعَةِ بيان العلاقة بين الإنسان والكائنات والله… ولكن مع الحفاظ على التوطّد والتناسب اللازم في المسائل التي يمحصها ويحللها. وإذا توخينا أسلوب بديع الزمان وتعبيرَه، فالقرآن:
صوتُ هذه الكائنات الشبيهةِ بمجمَّع متشابك وقصر ومَشْهر عظيم، ونَفَسُها وتفسيرُها، وأوجزُ تلخيصٍ لتفسيرِ الأوامر التكوينية وتأويلِها، ومفتاحٌ ذهبي مشحونٌ بالسر لهذا “المكان” العظيم الذي مابرحنا مشاهِدين له و”الزمانِ” الذي هو بُعدٌ نِسْبيٌّ له، وأبلغُ لسانٍ وترجمانٍ لذات الله الحق تعالى وصفاتِه وأسمائه، ومرصدٌ فريد للاطلاع على أسرار ما وراء ستار الأشياء والحوادث، ورسالةُ لطفٍ من الله Y مما وراء الكون والمكانِ مدوية أصداؤها في قلوبنا وألسنتنا، ومصدرُ نورِ لهذا العالَمِ الإسلامي الرائعِ وهواؤُه وضياؤه، والشرطُ الأساسُ الضروري للبقاء إلى الآباد، وخريطةٌ وتعريفٌ ومرشدٌ للعوالم الأخرى التي ينتظرها كل إنسان إما بشوق وتطلعٍ بالغ أو بترددٍ وتوجس… وهو للعالم الإنساني أجمع، كتابُ تربية ومجلةُ معرفة وقاموسُ علوم ودائرة معارف، لا يُضِل أحدًا في الطريق إلى الكمالات الإنسانية… وهو للعالم الإسلامي خاصةً مصدرُ علمٍ وعرفانٍ وحكمةٍ أنقى من كل نقيٍّ… غاية القول: إنه، كلياتُ قوانين نَظَّمت ووَجَّهت حياةَ المسلمين؛ الشخصيةَ والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية جميعًا على مدى العصور… ودليلُ السير والسلوك بمحتوياته من الدعاء والذكر والفكر والمناجاة… وكتابٌ معجزٌ يرشد إلى أدق تفاصيل الأشياء والحوادث، يوجِز أشد الإيجاز ولكن بلا إبهام في شيء، ثرٌ أعظمَ الثراء، لكنه أجود مع المؤمنين به، كافٍ ومستوفٍ لكل زمان ومكان، لكنه فوق الزمان والمكان.
فهذا الكتاب الذي لن يَستغني عنه أحد؛ لا الملائك ولا الروحانييون ولا الجن، هو مصدر ميراثنا الثقافي الأولُ الأهم الفذ، الأوسعُ الأندى، الأعمقُ الأنقى الذي لا يهدأُ تلاطمُ موجه كالبحار ولكن من غير تكدر.
هذه الأمور التي سردناها هنا حول هذا المصدر المبارك، ليست إلا إشارات صغيرة عابرة.
2- السنة
السنة في الاصطلاح الفقهي هي مجموع أقوالِ الرسول r وأفعالِه وما أَمَر به أو تفضل بالإشارة إليه. ومن مقتربٍ آخَر؛ هي أقوالُ حضرة روحِ سيد الأنام r وأفعالُه وتصرفاته، التي لم يبيِّن كونَها فرضا أو واجبًا، أو التي يجوز تركها أحيانًا
فالتي هي من قبيل العبادة تسمى “سنن الهدى”، والتي هي من جملة عاداته السَنِيَّة هي “السنن الزوائد”. أما الأصوليون، فلهم مقترب آخر، يتعلق بالقول والفعل والإقرار؛ فما يثبت بالقول فهو “سنة قولية”، وما يتبين بالفعل فهو “سنة فعلية”، وما سكت عنه من الوقائع التي شهدها فهو “سنة تقريرية”. فالسنة بفروعها كافة، المتعلقةِ بالعمل أو الأخلاق، أو البيانات التي صدرت حول التربية والآداب، أو الدساتير الموضوعة في اتجاه تزكية النفس وتربية الروح، هي مصدر لا ينفد في كل المساحات الواسعة، يضيء عيوننا وقلوبنا… فما برح إنساننا ينهل من هذا المصدر المبارك ويستمد منه منذ عصور طويلة، حتى إن قلنا إنه أنموذج حي للسنة، فلا نجانب الصواب.
نعم، السنة سواء بفضل سعة مساحتها في التشريع أو بمرونتها القابلة لتفسيرات متنوعةٍ، لا زالت مصدرًا مباركا لا نجد له نظيرًا في العطاء، في أي دين آخر أو أمة أخرى؛ فهو المصدر في التفسير أو الفقه أو المسائل الاعتقادية أو الأخلاق أو الزهد والتقوى أو الإخلاص.
ونكتفي هنا بما ذكرنا، ونحيل التوسع في هذا الباب إلى المصنفات المكتوبة أو التي ستكتب عن السنة.
3- الإجماع
للإجماع لغةً معانٍ؛ منها: الاتفاق والقصد والعزم والمواءمة. واصطلاحًا هو: اتفاق علماء الإسلام المجتهدين في العصر الواحد على مسألة دينية معينة. والإجماع بهذا المعنى ميزة خاصة بهذه الأمة. فالإجماع ليس عملا يقوم به كل أحد من الناس والعوام منهم خاصة، بل هو اتفاق “المتخصصين” القادرين على إثباتِ وتقييم مسألة معينة بالاستناد إلى الأدلة الأصلية واجتماعُهم على رأي واحد فيها. فلا يعد اتفاقُ العوام على شيء من المسائل إجماعًا، كما لا ينعقد الإجماع في مسألةٍ تُناقض الأدلةَ الشرعية. كذلك، لا عبرة للإجماع فيما ورد فيه من الشارع نص، وفيما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولا في مواضيعَ مثلِ حدوث الكون وعدم أزليته. ويقع خارجَ شمولية الإجماع قضايا مثل ثبوت حقيقة وجود الله ووحدانيته والنبوةِ. ولا يُتصور الإجماع في الأمور التي يتعلق فهمها ببيان الشارع كأحوال الآخرة وعلامات الساعة وأنواع النعم والعذاب في الأخرى.
ونسوق هنا من الأدلة على حجية الإجماع حديث النبي r: “لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة”( ). وهناك الكثير من الآثار الدالة على أن التأييد الإلهي يتظاهر على الجماعة خاصة.
ولا يُعتدّ في شأن الإجماع بالنظرة المختلفة لبعض الفِرق، أو التفسير المختلف للشيعة، أو حصرِ الظاهرية نفاذَه في مرحلة زمنية معينة؛ فإن هذه الخلافات لا ترقى إلى قوةٍ تنقضُ حجية هذا المصدر المهم للثقافة، ولا تمسُّ أسسه، لكن هذا لا يعني الاستخفاف بهذه المعارضات، وجوابِ الجمهور عليها. وتفصيلُ ذلك يضيق عنها هذا المقال، بل يتطلب مجلداتٍ من الكتب، وتم تناولُـها ومعالجتها مرات عديدة من قِبل أهل الاختصاص.. وغاية ما أردنا هنا أن نذكرّ بأن الإجماع مصدر مهم في ميراثنا الثقافي.
4- القياس
معنى القياس: مقايسة شيء على شيء آخر وتعليقُه على حكم أو تقويم مشترك بينهما.
وفي الاصطلاح هو إجراء حكمِ مسألةٍ أو عملٍ على شيء نظيرٍ له أو شبيه به. فيقال -في علم أصول الفقه- للأول: “المقيس عليه” أو “الأصل”، وللثاني: “المقيس” أو “الفرع”، ويقال لوجه المشابهة بين الموضوعين أو العلة المشتركة بينهما: “مناط الحكم”. والقياسُ بهذا المعنى مجال واسع ومهم لانكشاف الثراء الكامن في الكتاب والسنة، باعتبارهما لا يتحددان بالزمان والمكان، نعم، القياس مصدر وافر يُراجَع دائما في إطار الكتاب والسنة لسد الحاجة المحتمل ظهورُها تبعًا للزمان والمكان… فلن تنتهي الحلول حيثما كان القياس. فهو باب مفتوح لأهل الخبرة على مصراعيه في كل زمان وأوان.
وقد يكون وجه المشابهة في المسائل المتناسبة والمتشابهة صريحًا يكتشفه ويفهمه من له أدنى ممارسة. فلذلك سماه الأصوليون: “القياس الجلي”. وقد يكون وجه المشابهة بين المقيس والمقيس عليه مبهما لا يُفهم مِن أول وهلة، ويتطلب تمحيصًا وتدقيقًا، بل قد تَبرز مَناطات بديلة، فسماه الأصوليون: “القياس الخفي”. فالقياس بكلا جناحيه سَعَةٌ وثراء.
ولا يحتج بالقياس في التشريع الجنائي، لأن الرجوع إليه فيه قد يؤدي إلى إحداث جرائم وعقوبات جديدة. وفي ما عدا مثل هذه الحالات الخاصة هو مصدر معرفي يحتج به ويُرجع إليه في كل زمان. وقد اتفق جمهور الفقهاء على حجيته. ونكتفي هنا أيضًا بهذا القدر عن القياس، فليراجع في المصنفات.
5- الاستحسان
معناه عدُّ الشيء حَسنا، ويستعمل بمعنى الإعجاب بالشيء. وله عند الأصوليين تعاريف عديدة. وقد استعمله كثير منهم في موضع القياس الخفي وفي مقابل القياس الجلي. وقد يكون الاستحسان توجهًا إلى دليلٍ أقوى مما يقتضيه القياس في مسألة معينة، أو تخصيصا للحكم الثابت بالقياس، أو استنادًا إلى دليل أرجح، أو تركًا للقياس -في إطار الضوابط الشرعية العامة-، أو تركًا للعسر إلى اليسر بمعنى ترجيح الأيسر على الأعسر في حال جواز الأمرين كليهما. وكثير من الفقهاء -وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة- يقرون حجية الاستحسان. والفقهاءُ الذين يخالفون في حجيته، يعملون به بتحميله على مصادر شرعية أخرى وبعناوين مختلفة لمعنى واحد… فخلافهم لفظي ولا يكدر صفاءَ هذا المنهل العذب المورود. ونكتفي بهذا القدر هنا أيضًا، ونحيل تفصيل الموضوع إلى المتخصصين.
6- المصلحة
المصلحة هي الواسطة أو الوسيلة للصلاح أو الأمر المفيد والصالح والخيِّر. والمصلحةُ باعتبارها مصدرًا للاجتهاد وردت في العهود الأولى حيثما ورد القياس والرأي، حتى أقره بعض أئمة المذاهب كمصدر تبعي مستقل من مصادر الأدلة الشرعية. وحيث إن “المصلحة” -وكما يفهم من معناها- مصدرٌ يحقِّق فائدة العباد ويتحرى خيرهم وصلاحهم، فمقامها مهم في الحياة الدينية. وإن الحق تعالى أنزل الأحكام -في الواقع- لحماية الدين والنفس والمال والعقل والنسل. وبهذا يحتج لـ”المصلحة” في أصول الفقه.
ومع أن “المصلحة” لم ترق إلى مستوى الأدلة الشرعية الأخرى في الأخذ بها كدليل، لكن هناك فقهاء كثيرون وعلى رأسهم السادة المالكية أوْلوها عناية خاصة. ومع أن الإمام الشافعي لم يركز مباشرة على “المصلحة” كدليل مستقل، لكنه تناولها بطريقة أخرى في إطار القياس، فيكون قد اعتمدها ضمنيًا. أما الفقهاء الأحناف، فيتقبلونها بقبول حسن مع اختلاف في التفسير والتأويل. ورأيُ الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة قريب من الإمام الشافعي، كما في كثير من المسائل.
ومع هذا الاختلاف النسبي في النظر إلى دليل “المصلحة”، فالجامع أن المذاهب كلها تقره وتعتبره دليلا تبعيا -ربما بعناوين وأسماء متعددة- إذا كانت المصلحة مصلحة مقبولة ولم تتعارض مع الأدلة الشرعية الأخرى. ولا شك في أنه مصدر مهم للثقافة من حيث المعاني التي حمّلها الشارع عليه والوظائفِ التي أناطها الفقهاء به. ومع أن هناك حاجة إلى إيضاح مفصل، فالمقام هنا لا يسع ذلك.
7- التصوف
نحيل تعريف التصوف على الكتب والرسائل المعنية به، ونشير إلى محتواه في إيجاز:
التصوف الذي يمكن أن نسميه من الوجهة النظرية: “الطريقة”، ومن الوجهة العملية: “الدروشة”،( ) هو مصدر مهم للمعرفة والثقافة في مساحة واسعة تمتد من الحياة الروحية إلى الأخلاق وآداب المعاشرة.
للتصوف تفسيرات متنوعة؛ فمنها أنه الموت باعتبار النفس والأنانية والغرور، والحياةُ باعتبار القلب والروح… أو تسليمُ السالكِ نفسه لإرادة الحق تعالى كالميت في يد الغَاسل، مع وجود الإرادة الجزئية في إطار نِسْبــِيَّـتها الخاصة… أو التحاشي عن مساوئ الأخلاق التي ذمها القرآن الكريم والتحلي بمحاسن الأخلاق… أو الإحساسُ بالأقربية الإلهية في وجداننا بعنوان “القربة”، وتخطِّي “البُعد البشري” الكامن -بمقتضى البشرية- في قلوبنا وأروحنا… أو الاستقامةُ على خط إرشاد الكتاب والسنة واتباعُ أوامر “الرب” تعالى في حياتنا بدلاً عن اتباع الأهواء والنـزوات… أو التوجهُ التام إلى “مسبِّب الأسباب” ووضعُ الأسباب خارجَ التأثير الفعلي… أو التجرد -بقدر المستطاع- من الرغبات الجسمانية والبدنية، والتحلي بالصفات المَلَكية.
فإذا قدمنا المقترب الأخلاقي، فيمكن القول: إن التصوف هو الحفاظ الدائم على طهارة القلب حيال دوافع الشيطان والنفس… وردعُ النفس عن ميولها الخاصة وتضييقُ مجالها بقدر المستطاع… ومواصلةُ السير في طرق الارتقاء نحو “الإنسانية” الحقيقية بالكد الدائم للبقاء في مستوى “الحياة القلبية والروحية”… وتكريسُ الحياة على تحقيق السعادة المادية والمعنوية للآخرين، ومع منتهى الجدية في المناسبات مع الحق تعالى… واتباعُ نهج النبوة في عدم انتظار الأجر حتى في أصدق الجهود وأخلصها وفي أعظم الأعمال وأشدها… والعزمُ على المسير أبدًا في ظلال المشكاة المحمدية r في مساعي العبودية للحق تعالى… وإشهارُ عبودية صافية خالصة لا غرض فيها ولا عوض، بالتقيد الشديد في المناسبات مع الله تعالى بإدراك نوعية المناسبة بين الخالق والمخلوق، والعابدِ والمعبود، والطالبِ والمطلوب، والقاصدِ والمقصود… والقيامُ بمنتهى التحمل والصبر الدؤوب حيال المعاصي… وأداءُ العبادات والطاعات في لذة ونشوة كأنها الغاية والهدف من الحياة… واستقبالُ البلايا والمصائب بالابتسام مع انشراح الصدر لقهره ولطفه تعالى في نفس المستوى… وربط كل أنواع السعي والهمة باستحسان الحق تعالى وليس بتقويمات البشر… والصبر على تباطؤ الزمن صبر الدجاجة الحضون.
فالتصوف بالمعاني الآنفةِ موضعُ تناوُلِه الأساسُ هو الكتب والرسائل المؤلَّفة حول “التلال الزمردية للقلب”… وهو حوض فريدٌ واسعٌ للعلم والعرفان، مسنود بالبيان والبرهان والعرفان، يحتضن الحياةَ كلها ويغذيها ويثريها… فليس لمنهل التصوف نظير في العمق بين “التصورات الروحية” في الشرق، أو “التيارات الفلسفية” في الغرب.
8- علم الكلام
الكلام، معناه في اللغة: القول، والمحادثة، واللغة، والقرآن الكريم، والأوامر والنواهي الإلهية. ومعناه المصطلح عليه هو مجموع المعارف التي يُستهدف بها الدفاعُ عن منظومة المعتقدات الإسلامية بالأدلة العقلية والنقلية، والحفاظُ على استقامة فكر المؤمنين، وردُّ الشبهات والشكوك التي تثار أو يحتمل إثارتها ضد الدين، وحراسةُ “العقائد الإسلامية الحقة” في إطار السُّنة السَّنِية إزاء بعض التيارات الفلسفية الخاطئة.
والكلام -من مقترب آخر- هو مجموع الدساتير والقوانين الحاوية على نظرياتٍ علمية ومعرفية، والتي تَربِط بين أصول الدين وبين الكتاب والسنة وآراء السلف الصالح في ضوئهما. وقد جمع كثير من العلماء والمفكرين وفلاسفة الإسلام هذه الدساتير الكلامية في مصنفات كثيرة، وجرى تدريسها في “المدارس الدينية”.
وقد حرص قسم من المفكرين والعلماء على البقاء في إطار الكتاب والسنة ولم يسوقوا رأيا منهم في هذه المسائل، في حين أن البعض الآخر لم ير بأسًا في مد البيان بالبرهان وإثرائه بالعرفان، وتوسيعِه بالمحصلات الصوفية والفلسفية، بل رأوا أن الاشتغال بها على هذا الوجه خدمة للدين. صحيح أن التوسع على هذا النحو قد أَدخل إلى النظام الفكري الإسلامي أفكارا ضالة من رواسب الميراث القديم، لكن الواقع أيضًا أنه فَتَحَ أمام المسلمين آفاقًا عظيمة وواسعة.
ولسنا بصدد الجدال حول فوائدِِ علم الكلام أو أضراره، بل غاية ما نريده هنا هو الاكتفاء بالتذكير بأنه مصدر رحب ومعطاء في ميراث ثقافتنا. ولا نريد أن نخوض في أمور تفتح الباب لنقاشات جديدة.
9-10-11: العرف، العادة، العمل
العرف: عادةٌ وحال وسلوك تلقاها الناس بالقبول الحَسَن وحظيت بالتوقير العام ولم تخالف العقلَ والطبعَ السليم والدينَ، وإن لم تكن قانونا. وعرفه الفقهاء الأحناف من وجه آخر بأنه مجموع الأمور التي يستحسنها العقل والشرع، ولا يستنكرها الفكر السليم.
وهناك فروق بينة بين العادة والعمل وبين العرف؛ فالعرف أو المعروف يطلق على مجموع العادات الحسنة… والحال أن العادة والعمل قد لا يكونان مستحسَنين أحيانا. وقد يظهر ذلك في أوصاف فارقة تُقيَّد بها العادة أو العمل، مثل “عادة حسنة”، أو “عادة قبيحة”، وأيضا “عمل صالح، أو عمل فاسد”… ولا نجد أوصافًا مثلها تجري على العرف.. كذا، العرف، منه ما هو قوليٌّ ومنه ما هو عملي. أما العادة والعمل فينحصران بالأفعال والأعمال. وكذلك، للعادة والعمل جهة تتعلق “بالعقل العاطل” وتستند إلى التقليد وقبول القديم. وقد ذم القرآن الكريم في مواضع عديدة هذا الفهم وعاب على الكفار التقليدَ والاتباع الأعمى بقولهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾(الزخرف:23)، لكنه مدح العرفَ وحض عليه باسم “المعروف”، أو وصى به على أقل تقدير.
ولم نقصد هنا الإشارةَ إلى العرف والعادة والعمل باعتبار مصدريتها في التشريع واستنادِ قسم من الأحكام إليها، بل باعتبار أن العرف مطلقا، والعادةَ والعمل مقيَّدَين بشرط عدم المخالفة لروح الدين، مَصادرُ مهمةٌ في ميراثنا الثقافي.
وكل من هذه الموضوعات واسعة تستوعب رسائل أو بحوثا طويلة. وهو ما لا نطيقه، ولا يسع له المقام هنا.
وكلُّ قصدِنا في ما كتبناه هنا بإشارات سريعة وإيجاز شديد إلى درجة الاكتفاء بعنوان الموضوع وتعريفِه أحيانا، هو التذكير بمصادرِ ثقافتنا الموروثة والبناء الداخلي لهذه المصادر في إطار المقالة الضيق. وأردنا هنا -في الوقت نفسه- أن نذكِّر بخصوصيةٍ ذاتية فينا بالتنبيه على الوحدة العضوية بين المصادر المتنوعة لثقافتنا الموروثة والتي تبدو وكأنها منفصلة عن بعضها البعض. وقد حرصنا أثناء سردنا لهذه المواضيع على عدم الخوض في فانتازيات، وابتعدنا عن عثرات التصنع وما يشبهه من الأمور، وصَرَفْنا جل قصدنا إلى التركيز على البعد الأبستمولوجي (Epistemology)، ومن ثم حاولنا التذكير بالمناسبات بين المجالات المتنوعة لميراثنا الثقافي والفكري. وبناء على ضرورة التذكير بكل هذه المواضيع، فقد حصرنا مساحة كل موضوع، وأطللنا عليه بنظرةٍ كلية (holistic)، وتَرَكْنَا شرْحَ تفاصيله لفراسة المتخصصين. وإننا نربط انصراف التفكير في المستقبل إلى التفصيل في هذه المواضيع بما إذا وافى العمر، ونكتفي بالإشارة إلى الأبحر بقطرات.
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، أكتوبر 1999؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.