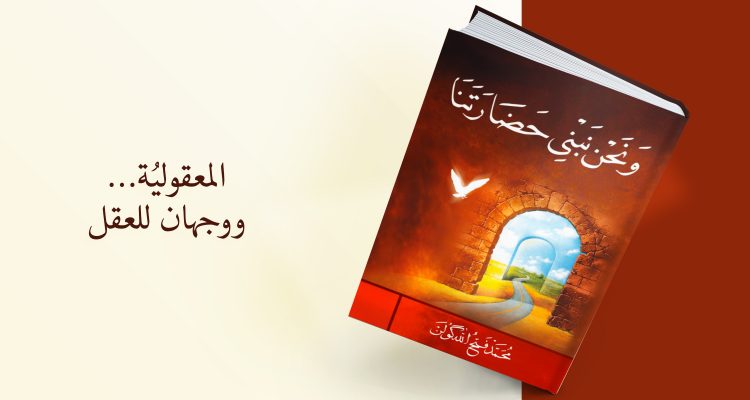العقل “جوهر” مجرد عن المادة، لكنه ملاصق لها.. وامتداد نوراني للغيب في عالم الشهادة.. وهو من أهم جوانب الروح، وأضوأُ وأنفذُ نورٍ لماهية الإنسان، فارقٍ بين الحق والباطل… وهو “النفس الناطقة” الذي يعبِّر عنه القدماء بالـ”أنا”.. ومن مقتربِ المتصوفة هو: اسم من أسماء جبريل عليه السلام كما يسمونه “النور الأعظم” و “عرش محمد”… وفي مصطلح بعض الصوفية: هو جوهر إنساني يسمونه: “العقل الجزئي” أو “العقل المجازي”، وبالنسبة لتعلقه بالأمور الأخروية “عقل الْمَعاد”.
إن العقل -بمعنى من معانيه- هو مركزُ حراسةٍ للروح باعتباره موجِّهًا للإنسان إلى التفكر والإدراكِ والفهمِ ومانعا له عن القبائح وحاثا له على المحاسن. والفلسفةُ تهتم كثيرا بـهذا “العقل”، وعلمُ الكلام يربط به كثيرًا من مسائل “أصول الدين”، وبعضُ المتصوفة يقسمونه باعتباره خيرا أو شرا ومفيدا أو ضارا إلى قسمين: “العقل السماوي” و”العقل الترابي”. ونكتفي هنا بهذه الإشارات، لأن تناول العقل بكل خصائصه، الأصليةِ منها والتبعيةِ، تضيق عنها مقالتنا هذه. كذلك نطوي هنا صفحةَ اعتبار العقل -حسب المنظور الإسلامي- سببًا من أسباب العلم، مع أهميته الخاصة. وكذا سنكتفي بالتذكير بأن العقل مناط التكليف والعنصرُ الأساسي للتفكر، والجوهرُ الأول للمحاكمة المنطقية، والمميزُ للإنسان عن الحيوان والناقلُ إياه إلى مستوى الإنسان الحقيقي، وخيرُ هبة من الخالق للإنسان… فسنتناول هذه الجوانب منها على أنها موضوعات تبعية بالنسبة إلى هذه المقالة القصيرة، قد نعرّج عليها هنا بإشارات سريعة للتذكير ببعض أوجهها.
ما نريد أن نركز عليه هنا بإيجاز هو العقل في إطار وظائفه -وذلك حسب رؤية الأستاذ النورسي في رسائل النور- وهو إما العقل المنشئ (العقل المكوِّن) الذي يتكاتف مع الوحي والإلهام والوجدان، وإما ضده الذي هو العقل الضيّق غيرُ الملتفت إلى النواحي الروحية، المنسلخُ من العلائق السماوية، المحدِّد قدرةَ مرونته ومجال حركته. ولا نخوض أثناء البحث -حتى وإن وُجدت مناسباتٌ من بعض الأوجه- في فرضيات “العقل النظري” و”العقل العملي” من مقتربِ “كانْط” أو في ملاحظات “لالَند” عن “العقل المُنشِئ” و”العقل المُنْشَأ”. ونكتفي بهذا التذكير السريع، لأنها مواضيع تستوعب كتبا ولكن ليس لها فوائد ملموسة في الواقع العملي.
العقل باعتبار أعماقه الكامنة -في رأي بديع الزمان النورسي والمفكرين المسلمين- عينٌ تَقرأ كتابَ الكائنات، وأُذنٌ داخليةٌ منفتحةٌ على اهتزازات واسعة ومتنوعةٍ، إذ يقوِّم الأصوات والأنغام التي يسمعها ويربطها بمعانٍ مختلفة، وإدراكٌ شامل ومحيطٌ متطلعٌ بتفحصٍ يتجاوز حدود الأشياء والحوادث، وبصرٌ باطنيٌّ منفسح في كشف عوالم الوجود وما بعد الوجود. والإنسان بالعقل يقوِّم ما يراه بالعين ويسمعه بالإذن، فيصل إلى حُكم، وبدلالته يسيح خلف أستار الوجود، بل يرتقي به إلى مقام مخاطبة الله (جل وعلا)، ويتأهل لحمل بعض مسؤولياته: الجبريةِ منها والاختيارية، ويتحرى عن الكائنات والحوادث طرًّا، ويشخِّصها، ويؤصلها، ويسير إلى الله تعالى. ففي الخير والأمور الحسنة يجمع العقلُ منطقَنا وتفكيرنا مع الثراء الواسع للوحي والإلهام، ويصير مرجعًا للنداءات الواردة من الماورائيات. أما في الشر والقبح، فيورِد التفسيرَ المنطقيَّ للحدود الإلهية ويكبح جماح الرغبات المنفلتة للنفس ويضع إستراتيجيات ضد هجماتها. وفوق هذا، يمنحنا خططًا للتفلت من شِباك الشيطان المختلفة، ويضرب على أهوائنا ورغباتنا الجسمانية قيودًا وسلاسل مصنوعة من أفكار منصهرة في بوتقة المحاسبة والمراقبة. وهو يكبت الأهواء النفسانية ما دام محافِظًا على سماويته ويمنعُها من دناءاتها المتولدة من خصوصياتها، فكأنه شُرطيٌّ حارس أو موظف رقيب يحفظ القيم الإنسانية. وبدهي أن هذه من خصائص “العقل السماوي” أو “عقل الْمَعاد” ولا تمتُّ إلى “العقل التّرابي” أو “عقل الْمَعاش” بِصلة.
وقد كان من المناسب في هذا السياق أن نتحدث عن العقل وقيمته ومكانته في المسؤولية وحجيته في القرآن والإسلام، لكننا نريد أن نحصر الكلام فيما هو معقول وغير معقول حسب القرآن الكريم ومن منظور بديع الزمان النورسي.
لقد تقرر في نظام التفكير الإسلامي -من المنظور القرآني- أن هناك ما يسمَّى بـ”العاقل” و”غير العاقل”، والطبيعة والخلق، والأسباب والقدرة الخالقة فوق الأسباب، والموجود بنفسه والموجود بإرادةٍ محيطةٍ، أو بتعبير عام آخر: هناك التحليق في أفق التوحيد أو التخبّط في وحل الشرك. فمنذ وجود الإنسان استمرت مسرحيةُ “مَفِيسْتو – فاوست”( ). (الملحوظة الزمنية المربوطة بوجود الإنسان هي من وجهة وجودٍ خصوصي لمفسِّرٍ وممثل خارجي وهو الإنسان. فالأصل من وجهة التفسير المجرد للكائنات والحوادث، شموليةُ الحال بعينه على ما قبل خلق الإنسان أيضا) وسيدوم صراع الأخيار والأشرار أبدا، وستستمر المفاصلةُ بين الشياطين والأرواح الشيطانية، وبين الأرواح المستعدة لقبول الحق والحقيقة.
ففي كل عصر ما فتئ ممثلو “غير المعقول” الذين يربطون وجود الكائنات والحوادث بفكر التكون الطبيعي والأسبابِ المادية والطبيعة يشكلون صفًّا، ويتجمعون حينًا حول آلهة الطبيعة المصطنعة، وحينًا آخر حول القدرة الموهومة للأسباب، فلم يتوانوا عن محاربة ممثلي “المعقول”: الأنبياءِ والأصفياء والمؤمنين. وأصحابُ هذا الصف مع أنهم بدلوا إستراتيجياتِهم حسب الزمان والمكان، ولكن عزيمة الحرب وعقلية الكفاح عندهم واحدة لم تتبدل؛ فإما أنهم أحالوا الخلق والتنظيم والإماتة والإحياء وأمثال ذلك من لوازم حقيقة الألوهية إلى ما لا يتجاوز وجودُه الوهمَ كالأسباب والصُدَف والطبيعة، وإما حاوَلوا ربط الأفعال الإلهية -ولو من بعض الوجوه- بهذه المسائل. ولا شك في إلحاد الصنف الأول من هذا الصف. أما الصنف الثاني فقد وقعوا في الشرك، لإشراكهم الأشياء التي خلقها الله تعالى، في أفعاله الإلهية. فإن عقيدة التوحيد تَعتبر أدنى مُحاصَّة ومشاركة أو مماثلة -بأي وجه من الوجوه- للقدير المطلق، الخالق، المنشئ، المحيي، المميت، الرازق، القيوم، السميع، البصير، القيوم.. شركا وغير معقول.
فمن هذا المنظور، فإن عقيدة التوحيد التي هي من القواعد الأساسية في القرآن الكريم موافِقة للعقل، فهو “معقول”؛ ورَبْط الوجودِ بالأسباب والطبيعة وأشياءَ أخرى مناقضٌ للعقل، فهو “غير معقول”. ولعل من المفيد أن ننوّه هنا إلى أن المعقول يتضح أكثر فأكثر بذكر اللامعقول حسب ما تقرر من أن “الأشياء تُعرف بأضدادها”.
إذن، الضرورة تحكم -في حال التخلي عن ربط كل الأمور بالتوحيد الحقيقي- بالحاجة إلى مؤثِّرين كثيرين يمتلكون قوة الإله في الخلق والإنشاء والإماتة والإحياء والإبصار والقيومية… فتصورٌ كهذا، يقود إلى تقبُّلِ محالات متسلسلة كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو تَناقض صريح مع العقل.
يتحول مفهوم “المعقول” و”غير المعقول” (الذي يلجأ إليه الكلاميون بعناوين متعددة) عند بديع الزمان النورسي إلى صوتٍ قرآنيٍّ ونَفَسٍ توحيدي خاص. فالمتتبع للقضايا الإيمانية في رسائله سيتعرف على المعاني التي أضفاها القرآن الكريم على هذين المفهومين (“المعقول” و”غير المعقول”). والقرآن الكريم في آيات كثيرة مثل: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا﴾(الأنبياء:22). يدعونا دائما إلى المحاكمة العقلية والمنطقية في هذا الموضوع، ويفتح أمام المنطق آفاقًا جديدة.
إن القرآن، يحيل كل المسائل التي يتناولها -ما عدا أوامره التعبدية المتعالية- إلى العقل والمنطق والمحاكمة، ولا يَترك في توجيهاته ونداءاته ثغراتٍ عقلية أو قلبية أو روحية البتة. بل لم يزل معبرا عن الفكر السليم والمحاكمة العقلية المنهجية والمنطق المنضبط ضد الأحكام والمزاعم المختلفة التي يَبْنِيها خصومه الكثيرون على “غير المعقول”… فأفحمهم، هم وكلَّ أنواع مغالطاتهم وديماغوجياتِهم وجدليتِهم، وحَسَم الأمرَ بظهوره وغلبته عليهم. وهو ما نعتبره، في الوقت عينه، ظهورا وغلبة لرسُل الحق تعالى وللعقل السليم عليهم.
وإن دورة التاريخ الدائمة هو التناوب بين مراحل الفتور إزاء الوحي وإهمال “العقلي”، ومراحلِ ظهور التنور السماوي والنشاط العقلي. فمتى ما استضاءت القلوب وتنورت العقول بالأنوار التي ينشرها الأنبياء، وانكفأت الجسمانية والمادية في زاويتيهما، واستقرت الفيزيائية والميتافيزيقية في مكانهما الصحيح، وتَقدم “العقل السماوي” (بتعبير مولانا جلال الدين الرومي) و”عقلُ المعاد” (بتعبير الإمام الغزالي) على “عقل المعاش” و”العقل الترابي”، فقد تحقق -حينذٍ- تزاوُجٌ جديدٌ يين القلب والعقل وميلادٌ جديد. هذا الميلاد هو ميلادُ ربطِ الوجود بمالكه الحقيقي حسب وعيِ العصر وإدراكه مرة أخرى، بتفسير الوجود من جديد، وميلادُ خلاصِ الإنسان من التناقضات الداخلية… ومتى ما عميت الأبصار عن أنوار السماوات وأُهمل العقل وأُبعد التفكير ونُسي “المعقول” بالكلية (بمعناه الخاص)، فقد ارتفعت راياتُ “غير المعقول” في كل المجالات، وانكب حشود البشر على وجوههم في التناقضات، فجعلوا زرْدُشت أو عُزيرًا (عليه السلام) أو المسيح (عليه السلام) ولدًا لله -حاشاه- ووقعوا في انحرافات وضلالات مثل “ثالث ثلاثة”!.. وحينئذٍ انقلبت الموازنات والنُّظم المتعلقة بالوحي والعقل عاليها سافلها.
وقد يتجسد “غير المعقول” في “وَدٍّ” و “يَغُوثَ” و” يَعُوقَ” و”نَسْرٍ”، أو في “النور والظلمة” كما عند المجوس، أو في روحٍ كليةٍ، أو في أصنام “اللاّت” و”مَناة” و”العُزّى” و”نائلة” و”إساف”، أو في حوادثَ مخيفة ومفزعة في كتاب الطبيعة مثل النار والنهر والبرق والريح. وفي كل حالٍ، الأرواحُ القابلة للاعوجاج والانحرافِ تنجرف أحيانا إلى هاوية الانحراف انطلاقا من حسن النية، كما في تأليه “ودّ” و”يغوث” و”يعوق” و”نسر”، أو تندفع في طريقٍ خاطئ فتبعد عن الصواب، لالتفاتهم عما هو معقول وسماوي. وقد يغفلون عن القضية لضيق زاوية الانحراف في المركز. وحين الانتباه في نقطةٍ على المحيط بعيدًا عن المركز تتعسر العودة إلى نقطة البدء لتوسع الزاوية. ثم يبدأ التلطخ بتفسيرِ أجلِّ الحقائق، تعليقًا بالأوهام والخيال. إن هذه “اللامعقولية” هي مخالَفة صريحة للعقل وللوحي وانحرافٌ واضح، سواء بإحالةٍ صريحة لكل قضاءٍ إلهيٍّ إلى صنم من الأصنام المتنوعة، أو بربطٍ خفيٍّ للمشركين في منظور “الوسطاء” الشفعاء المقرِّبين زلفى، ربما بدوافعِ اختلاقهم للتبريرات أو الديماغوجية.
المعقول واحد أبدًا.. فكلَّما حصل انحراف عنه، حصل السقوط في الكثرة غير المعقولة بلا انتباه ولا وعي… فأقاموا “الكثير الحقيقي” مقام “الواحد الحقيقي” في صور شتى: كما أسند الصابئون الولادة والموت والسعادة والشقاء والبلاء والمصائب إلى الشمس والقمر والنجومِ بكيفيةٍ تشبه معتقداتنا حول القدر، وأسند الأنيميون هذه الأمور إلى الروح الكلية، والمجوسُ إلى النور والظلمة، والوثَنيون إلى الأصنام بأسمائها وصفاتها المختلفة. حتى إذا أراد الوحي أن يردَّهم عن هذا الانحراف قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾(الزخرف:23)، ولم يفكروا بتاتا بتعديل مسارهم إلى الطريق السماوي أو العقلي.
فأولئك ما كانوا يبالون بالمعقولية فيما يعتقدون ويؤلهون. ومآربهم كانت محصورة في أهوائهم ورغباتهم والاقتداءِ بآثار آبائهم متى ما نفعهم ذلك. القرآن الكريم يستصرخ العقل في أولئك المقلدين العُمي، وكلِّ اللاهثين وراء الهيكلية الصورية الجوفاء من قَبلهم ومن بعدهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ * وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾(البقرة: 170-171)
ولنا أن نستطلع هذا في الأسلوب العام للقرآن الكريم؛ فالقرآن الكريم يخاطب المشركين المعاصرين لسيدنا (صلى الله عليه وسلم) مرة بعد مرة بلسان العقل، ويوسع آفاقهم بلسان المنطق، ويحقنهم بالمعقول بقوة المحاكمة المنطقية، ويعيد عليهم صفحات من ديمومة التكرر التاريخي، ويضعضع -بسرد الأمثال- لامنطقيةَ الشرك في تلك الأيام إلى جانب الفكر الإلحادي في قابل الأيام، ويدعو إلى التعقل في كل الأمور.
إن سيرة الأنبياء والمرشدين الذين اتبعوهم مَشْهرٌ لعرض نماذج حية ضد كل نوع من أنواع الكفر والإلحاد والشرك، ومنبر لسرد أشد الخطب إقناعا. والقرآن الكريم يأخذ بيد تلاميذه مرة بعد مرة ليسيح بهم في تلك المشاهر، ويُسمع خدامه أجلَّ الخطب العصماء بأصدق الأصوات.
ومثال ذلك قصة إبراهيم (عليه السلام) التي تتكرر في القرآن الكريم مرارًا، لأنه من أقوى أصوات فكر التوحيد. فتَراه محطِّما لأصنام المشركين من قومه، أو مقوضًا لأركان فكر المشركين، أو ضاربا على أفواههم بالأقفال المصنوعة في مصنع العقل، فهم لا ينطقون، أو حاملاً إلى السماء فَهْمَهم المشركَ وتوهُّمَهم الألوهيةَ في النجوم والشمس والقمر، ليحلَّ رباط الأجسام السماوية، فتتساقط على أفهامهم المنحرفة عن الربوبية، فتخرّ أنقاضا وركاما يئطُّون تحتها، ويفتح سبلاً واسعة تُوصِلُ إلى الله تعالى للقادمين من بعدهم.
ثم يصرخ في المصرين على غير المعقول تارة أخرى: ﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾(الأنبياء:54). ثم تراه قد حطم أصنامهم وقام منتصبًا وموبِّخًا منطق شركهم المنحرف الضال قائلا: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾(الأنبياء:66-67). إنه يصرخ ويوبخ حتى يوجِفَ أرواح المشركين من قومه والمشركين من بعدهم جميعًا.
ومثلما كان إبراهيم (عليه السلام)، كان الأنبياء العظام: نوح وهود وصالح وشعيب وموسى… وكلهم أجمعون صلى الله عليهم وسلم، أدَّوا الرسالة نفسها وساروا في الطريق بعينه مع تنوع اللون والنمط حسب تنوع الأحوال والأوضاع، فاتبعوا نهج “العقل السماوي” ونشروا “المعقول” جميعًا. وعلى النقيض كان صفُّ أهل الكفر والإلحاد والشرك الذين أفنوا أعمارهم في السجن الضيِّق للهوى والرغبات، وأسْرِ الفهم والفكر المتوارَث من الأجداد، فأهدروها في مد الشعور المنحرف والفكر الضال وجزرِهما وأشهروا اللامنطق على الدوام.
لقد حث الأستاذ النورسي بإصرار على قراءةِ كتاب الكون واستشراف آفاقه والتطلع إلى معرض الوجود. وحثُّه هذا تعبير عن المفهوم المتوارث من ممثلي المعقول: الأنبياء والأصفياء والأولياء وعلماء الإسلام. ومع استحضار اختلاف الخط حسب الزمان، كان محتوى الرسالة والطريق المتبعة واحدًا لا يتغير: التحري المستمر في الأرض والسماء… وخضُّ الأشياء واستبطان مغازى الأشياء والأحداث… وتسليمُ كل الأشياء إلى مالكها الحقيقي… وبعد ذلك، الإحساسُ باطمئنان هذه المعقولية في الوجدان، وتحوُّلُ العلوم المؤدية إلى المعرفة: كل علم إلى نبع يُروي الذوق الروحاني… ومن ثم، تقاسُمُ من في الأرض ومن في السماء تلك الحالَ الروحيةَ.
يرشدنا القرآن الكريم في كثير من آياته البينات إلى هذه الطريق ويدلنا على أن المعقولية هي تعلق الفكر وانشداده باللانهاية: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ * وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾(ق:6-11)، فيلفت النظر إلى السموات وإلى الأرض وإلى الرزق، ويدعونا إلى التعقل والتفكر والتعمق في الإيمان والإثراء في المعرفة، ويؤكد مرارًا على أهمية المحسوسات، ويدعونا دائمًا إلى استطلاع الأرض التي نعيش عليها: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾(الحج:46). والقرآن هنا يومئ إلى أصل الحرمان والخسران وإلى أنه في القلوب التي عميت بصيرتُها. وهو يوبخ مرارًا من لا يستعمل عقله وبصيرته حين يمر من غير تحقيق وتدبر بآيات الأرض والسماء، وكذلك ينبه إلى أهمية “النية” و”النظر”، وأن الرؤية المجردة لا تجدي شيئا: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾(يوسف:105).
والقرآن الكريم أنموذج فريد للمعقولية من أوجه كثيرة تجتمع كلها فيه. فهو -مع حثه على استطلاع كتاب الكائنات- أنموذجٌ بمتانةِ تقديمِه للقضايا الكبرى وإثراء الفكر بمحتواه، وإحاطةِ رسالته، وسحرِ ألفاظه، وتأثيرِ أسلوبه، ووقْعِ صدقيته… نعم، إن مستنَد القرآن هو الوحي، لكن طريقه لا يغادر فَلَك العقل. فهو يَطرق باب المخاطَبين مسجِّلاً ومُثْبِتًا كل مَعانيه ومفاهيمه لدى العقل والمنطق والتفكير، ويمضي إلى القلوب بأسلوب يحفّز الانتباه، وينطق كابحًا اعتراض العقل والحس والشعور، ويروِّض المتتلْمذين عليه دوما بالمعقولية… فالقرآن الكريم يستند إلى الوحي ويتعامل مع البشر في سفح المعقول في كل الأمور… والأمر سواءٌ؛ في تقديمه مئات المسائل المتشابكة بتناغم وتجانس لا يُدرَك شأوه حتى في تحليل المسألة الجزئية، أو في صفاءِ وخلوصِ وتأثيرِ كل تذكرة ومعنى من معانيه، وكذا في الارتقاء بالقلوب المستعدة للإيمان إلى الاطمئنان، أو في إقناع الأرواح المترددة.
فنقول من هذه الوجهة: إن مستطلعي الأشياء والحوادث القادرين على قراءتها، والمسنِدين إياها -من ثم- إلى التوحيد، هم في طريق المعقول… وكذلك الذين يستمعون إلى القرآن الكريم وينصتون إليه ويستمرئونه يُعَدّون في الطريق العقلي. وبالمقابل، من يعجز عن النفوذ إلى بواطن الوجود والحوادث ويبقى خارجها، فليس في الطريق العقلي، وكذلك من لا يستمع إلى القرآن ولا ينصت إليه ولا يستمرئه فليس مستفيدًا من أنوار العقل استفادة كاملةً.
نعم، المعقول: هو قراءة الوجود والأشياء، والتفكيرُ بها وتقويمها… ومن بَعدِ التقويم ربطُها بوشائج الإيمان والمعرفة والخالق. واللامعقولُ: هو إسناد كل شيء من الأشياء وكلِّ حادثة من الحوادث إلى الأسباب المختلفة أو الطبيعة أو أمور أخرى… المعقول: هو استغناء الخالق وجودًا وتوحيدًا عن الشريك والنظير والمُعين؛ (/أمّا) وغيرُ المعقول: هو فكر الشرك والإلحاد بصوره وأشكاله كافة… المعقول: هو ضرورة الأنبياء والرسل المرسَلين من الله إلى البشر لشرح الأشياء والحوادث وتفسيرِ الوجود وربطِه بالحقيقة المفردة؛ وغير المعقول: هو رد النبوة والرسالات الإلهية… ويمكن توسيع هذا الإطار حسب الملاحظات الواردة في رسائل النور، إلى أن يستوعب الأركانَ الإيمانية جميعًا. وأظن أن هذا القدر كافٍ هنا، وأحيلُ إلى كتب مفكري الإسلام للتوسع في الموضوع.
من زاوية أخرى، العقل يعني الفهم والإدراك واستجماع الفكر. وهو بهذا المعنى وسيلة مهمة لتفهُّم الأمور الداخلة ضمن تعريفه، ومن المقومات الحيَوية للروح؛ فبالعقل نفهم ما نفهم، وبه نعلم ما نعلم، ونقوِّم ونستنبط الحاصلَ والناتج. وضده الحمق والغباء وعدم الإدراك. الحمقى والأغبياء ومعدومو الإدراك لاهثون في طريق اللامعقول بلا هدف ولا مقصود… فلا يفهمون كتاب الكائنات ولا يتآلفون مع الأشياء ولا يستمعون إلى القرآن ولا يدركون أسرار التكليف… ومحال على هؤلاء أن يفهموا الدين وروحه وغايةَ الوجود ومقصوده. ويُسنَد إلى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) قول مآله: “أن الأحمق عدونا (/عدوّ لنا)”… فجعله مولانا جلال الدين الرومي عنوانا وصاغه شعرًا بلسانه الفصيح (ترجمته):
“قال النبي (صلى الله عليه وسلم): الأحمق عدو لنا، شقي يقطع طريقنا.
إذَنْ العاقلُ حبيبنا… نَسِيمُه المعتلُّ بردٌ يفوح رَوْحًا وريحانا.
فإنْ غضِبَ العقلُ مني.. فسبَّني وشتمني، أُطأطِئْ رأسي وأُدِمْ صمتي،
لأن العقل من (الله) الذي يمنُّ عليَّ بالفيوض أبدًا.
أما الأحمق فإنْ وَضَع في فمي حلوى، أعتلّ من حلواه ويصبني بالحمَّى”.
وكذلك كبار الربانيين الآخرون يرون العقل السماوي المستمدَّ من “الأخرويات” وثاقًا يوثَق به الرغباتُ الجسمانية، فلا تستطيع الميولُ الجسدية أن تعبر عن نفسها (/تلعب دورها السيئ) إلا إذا انفلتت من هذا الوثاق. فالعقل في هذا المعنى قفل حديديٌّ لحفظ القيم الإنسانية ومفتاح سحريٌّ للسعادة البشرية. العقل لجام الرغباتِ النفسية وقفلٌ يَغلق فمَها، وهو أيضًا جناح ملائكيٌّ تُحلِّق به الروح إلى عالم الخلود. النفس تجرف الإنسان (/كل ساعة) إلى معضلات ومشكلات مختلفة كل ساعة بأباطيلها وترهاتها. وضدُّها العقل، إذ هو قوة سماوية تبدد لعبة النفس. فإذا ارتبط بالقلب وتزود وتغذى من “وارداته”، وأدام التزودَ منه، فإنه لا يترك عدوًّا إلا صرعه ودحره؛ أما إذا انقطعت وشيجته عن القلب وانقلب من السماوية إلى الترابية، فإنه يصير خائنًا يرشد الأعداء ويقيم في جيرة الشهوات ويدافع عن الحقد والبغض وينضم إلى القوة العمياء فيقاوم السماويةَ ويخوض في الجدَلية فيكدُّ في إلباس الباطل لباس الحق ويحسب المغالطة براعة، فيجادل مخلِّفًا وراءه الاختلافَ والتفرق، ويحسب فضح الآخرين وتَرَاجُعَهم غلبةً وظفرًا… فيتمادى في قتل القلب كل ساعة ويقيم على أنقاضه سرادق النفس، ويتلطخ كل يوم مراتٍ عديدةً بلوثيات تسر الشيطان وتفجر الروح بالبارود.
فالعقل الذي انفلت إلى هذا الحد وصار عنصرا للجماح، يكون -بحسب تعبير مولانا الرومي- “مصدرَ وهمٍ وظنٍّ، لا بدّ من أن يُذبَح قربانًا أمام المصطفى (صلى الله عليه وسلم)… ثم يُقالَ: حسبنا الله، ويستأنف المسير إلى الله”. ويقولُ الشاعر فضولي رحمه الله( ) بيتًا في هذا العقل المشؤوم (ترجمته):
أريد من عقلي إشارة ودلالة
وعقلي يريني ضياعًا وضلالة
ويؤكد الكاتب الهولندي أرامسوس في “مدح للجنون”: أن لا نفْع ولا فائدة ترجى من عقل كهذا… مستهزئًا وساخرًا به.
نتذكر خلاصة حكيمة هي أنه: “إذا فسدت الأشياء الثمينة، صار ضررها أشد من الأشياء المضرة”.. ونقول: إن هذا العمق العميق هو الفارق بين الإنسان وسائر الأحياء، والجوهر الناصع الذي يصعد به إلى مقام “المتلقي لخطاب الله تعالى”، والمعلم والدليل الأول له للارتقاء إلى الحياة القلبية والروحية، يجعله كالملائكة ما دام متغذيًا بالسماوية وقارئًا لكتاب الكائنات ومحوِّلاً ما يطالعه إلى المعرفة. أما إذا انقطع عن الله تعالى وارتبط بالطبيعة أو النفس، فيكون حية تلسع وعقربا تلدغ في كيان الإنسان، وينقلب إلى سم يميته موتا أبديا، بدلا عن أن يكون إكسير حياته الأبدية.
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، يوليو 1999؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.