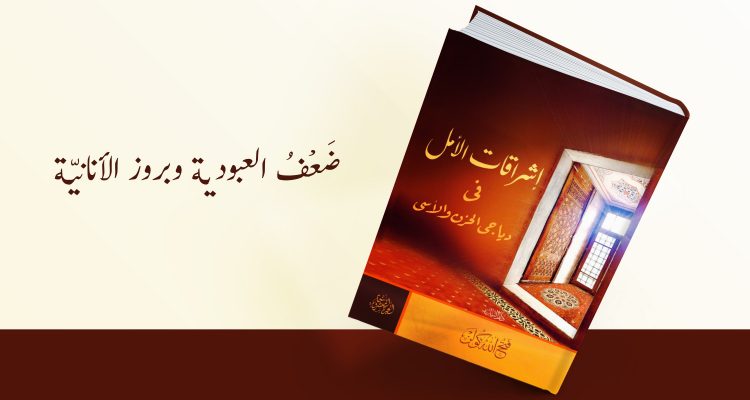سؤال: ذكرتم فيما مضى أن ضَعف العبودية سببٌ أساس في زيادة قوّة الأنانية وحبِّ الذات، فما ماهيّة العلاقة بين ضَعف العبوديّة وقوّة الأنانيّة؟
الجواب: العبودية كلمة مشتقة من الجذر “عَبَدَ”، ومعناها أن يؤدّي الإنسان مسؤولياته تجاه ربه، مستشعِرًا خضوعه التام بين يديه، والعِبادة أيضًا مشتقة من الجذر ذاته، غير أنّ بين الكلمتين بعض اختلافٍ في المعنى، فالعبادة بإيجاز هي: تحويل المعلومات النظرية الخاصة بالإيمان إلى واقع عملي في ظلّ نظامٍ ونسقٍ معينين، أما العبوديّة فهي: أن يمارس الإنسان حياته مستشعرًا حقيقة كونه عبدًا لله؛ بعبارة أخرى: العبوديّة هي أن يتعمّق الإنسان في الخضوع باستمرار ويعيش حياته في ظلّ الإحسان مستشعرًا مراقبة الله تعالى له، أما العبادة فهي أن يفي الإنسانُ بمسؤوليّات عبوديّته كما أمر ربه سبحانه وتعالى.
فما من عبدٍ جعل همَّه عبوديّته واستشعرَ في ثنايا وجدانه شعورًا عميقًا بعباداته فأدّاها ثمّ استطاع من خلال الممارسة والتدريب أن يتعمّق في عبوديته، إلّا انسلّ من أيّ عبوديةٍ أخرى، إن السبيل الوحيد للتخلّص من العبودية لغير الله هو أن يكون الإنسان عبدًا لله حقًّا، فمن لم يكن عبدًا لله فهو عبدٌ للأصنام والأيقونات والطواطم وأصحاب القوّة والنفوذ… إلخ.
والحق أن الله جلّ جلاله هو الذات الأحديّة المستحقّة للعبادة، فهو -كما يقول أهل التصوّف- المعبودُ المطلق والمقصود بالاستحقاق؛ وهذا يعني أن حقّه علينا ووظيفتنا ومسؤوليتنا نحوه أن نعبده وأن يقترن حِراكُنا في كلِّ لحظةٍ من حياتنا بشعور العبوديّة له جلّ وعلا، وبعبارة أخرى: إنه تعالى المقصودُ لأنه هو الله، والمحبوبُ لأنه هو الله، والمعبود لأنه هو الله، ولذا فإن عبودية غير الله من الأصنام والأيقونات والأساطير والطواطم وغيرها من المعبودات الناشئة عن الضلال والانحراف هي كفرٌ صريح وضلال بيّن؛ لأن الله تعالى هو المستحقّ والجدير بالعبادة، فهو المعبود الحقّ وحده دون سواه.
وهكذا فإن العبد إذا جعل همّه عبوديته فلا يفكر في الخضوع والتذلل والانحناء إلّا إلى الله تعالى، ولا يرى نفسه أعلى أو أميزَ من الآخرين مطلقًا، ولا يجعل لنفسه منزلةً أو مكانةً تعلو منزلةَ عبوديّته؛ لأنه على وعي دائمًا بأنه أمام المعبود المطلق سبحانه وتعالى مجردُ عبدٍ تُقيِّدُ العبوديّةُ عنقَه بِقِيادِها وتُحكِم الوَثاقَ على قدمِه بأغلالها، ومثل هذا الإنسان يعزو دائمًا كلَّ ما حقّقه من نجاحاتٍ وما أصابه من جمالٍ إلى الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأنه أذابَ نفسَه وأنانيّته وذاتيّته في بوتقة العبوديّة، ربّما تغرّه نفسه فتدور رأسه وتتكدّر بصائره لما أحرزه من نجاحاتٍ تفوق إمكانيّاته، ولكنّه سرعان ما يقمع كلَّ هذه المشاعر السلبيّة التي برزت في داخله بشعور العبوديّة الكامن في أعماق روحه.
التناسب العكسي
وكما رأينا ثمّة تناسبٌ عكسيّ بين التعمّق في العبودية من جانبٍ وبين ازدياد قوّة الأنانية وحبّ الذات من جانبٍ آخر، بمعنى أنه بقدر ما يتعمّق الإنسان في عبوديّته بقدر ما يحتاط لنفسه وأنانيته ويتمكن من السيطرة والتحكم في مشاعره السلبية التي تموج في داخله، وبالمقابل فإنّ الإنسان يُصبحُ أنانيًّا بل وحتّى نرجسيًّا بقدر ابتعادِهِ عن عبوديّته لربه؛ لأنه مع الوقت ينسى نفسَه كلّما ابتعد عن وظيفة العبودية التي تذكّره بماهيته، فينسب إلى نفسه كلَّ ما أحرزه من نجاحاتٍ، بل إنه قد يتمنى أن تُنسب إليه حتى الأعمال الجميلة التي قام بها الآخرون، ومن ثمّ يجتذبه التصفيق والتهليل إليه جذبَ الدوّامة.
أما من يقف خاضعًا معقود اليدين أمام الحقّ تعالى ويقضي حياته كلّها بهذا الشعور فلا ينسى نفسه أبدًا، ويقرن حركَتَه دائمًا بشعورِ أنه مخلوقٌ عاجزٌ ضعيفٌ فانٍ مغلولُ القدمين طوقُ الرقّ مضروبٌ حول عنقه، وهذا الشعور بالعجز والفقر يُشعل الرغبة إلى أفق “هل من مزيد؟” من العبادة والعبودية، إن هذا الإنسان مهما أدّى من العبادات أو صلّى آلافًا من الركعات دائمًا ما ينطلق لسانه بـ”اللهم ما عبدناك حقّ عبادتك يا معبود، وما شكرناك حقَّ شكرك يا مشكور، وما عرفناك حقّ معرفتك يا معروف، يا من أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ولو عرفناك حق المعرفة لَذُبْنا وتلاشينا…”؛ لأن هذا العبد يُدرك أن ما يقوم به من عباداتٍ هي بمثابة لا شيء بالنسبة للنعم التي مَنّ الله عليه بها.
نِعمٌ لا تُعدّ تتطلّب شكرًا لا يُحدّ
إن من أعظم نعم الله على الإنسان أنه قد علا فوق مستوى الجمادات، ووُهبت له الحياة، فغدا كائنًا ذا شعور، ليس بحيوان أو نبات، وفوق كلّ ذلك عرف خالقَه تعالى، وأُتيحت له فرصة فتح أبواب الخلود بمفتاحٍ مفعمٍ بالأسرار كمفتاح الإيمان، فتلمّس السبيل لأن يكون جديرًا بالجنة، فهذه بلا شكّ نعمٌ عظيمةٌ لا مقابل لها في الدنيا؛ لأن مَن أَسبغ عليه كلَّ هذه النعم العظيمة هو الله تبارك وتعالى.
فلو أن الإنسان وعى هذه النعم، وتوجّه إلى ربّه، وتعمّق في العبودية، وصار بطلًا من أبطال “هل من مزيد؟”، وحاول دائمًا أن يزيد من معرفته ومحبّته وعشقه واشتياقه نجّاه الله -بفضله وكرمه- من دوّامة الأنانية وحبّ الذات، وكما يقول الشيخ “محمد لطفي أفندي” رحمه الله:
ألَا يحبّ المولى مَن أحبّه؟
ألَا يرضى عمَّن هرول لنيل مرضاته؟
لو وقفتَ له على الباب.. وفديته بالروح والنفس والأحباب
وعملت بأمره، أما يُجزل لك الأجر والثواب؟
والحق أن الله تعالى يُرشِدنا إلى ذاته ويشعرنا بوجوده عبرَ آلافٍ من الحوادث كل حين، وإننا لو حاولنا مقابل ذلك أن نتتبّع هذه الحوادث بدقّةٍ وتيقّظٍ وفكرٍ منظّمٍ منسّقٍ، وسعينا إلى أن نجمع صورَ هذه الحوادث كلّها على اختلافها حتى نفهم المعنى الذي تعبر عنه كلّيةً، وفتَّشنا عن السبل التي تتيح لنا السير إليه تعالى؛ فلن يتركنا سبحانه وتعالى في منتصف الطريق؛ لأننا ما عهدنا عليه تعالى أنه تخلّى عن أحدٍ سار إليه ألبتة.
إكسير العبودية في عصر الأنانية
لقد توالى التاريخ فازدهرت فترات منه وأظلمت أخرى، فأحيانًا ما كانت الأرضُ تعصي السماء، فتمسك السماءُ عنها ماءها، فتستحيل الأرض صحراء جرادء من أوّلها إلى آخرها، وأحيانًا أخرى كانت السماء تفيض بوابلٍ من الرحمة زخًّا زخًّا؛ فتنبت الأرضُ سنابل بها سبعُ حبات أحيانًا وسبعمائة حبّة أحيانًا أخرى. أجل، أحيانًا ما كان النور يتغلّب على الظلام حتى يتقلّص الظلام تمامًا، ويهيمن جوّ الروحانيين والملائكة على جوّ الشياطين، وبتعبيرٍ آخر: يسيطر عالمُ الملكوت على عالمِ الـمُلْك، وخيرُ مثال على ذلك هو عصر السعادة النبوي؛ إذ انعدمَ فيه المناخ الملائم للشياطين وانتشارهم هنا وهناك، ولقد شهدت العصور اللاحقة حقوبًا زاهرةً تُشبه هذا العصر.
ولا يقلّ في يومنا هذا أيضًا عدد الذين يشعرون ويُحسّون في كلّ ذرّةٍ من أعماقهم بالعبودية لله تعالى، ويعيشون دومًا الإحساسَ بمعيته تعالى بفضل مشاعرهم العميقة التي تتجاوز مجرّد الإحساس، ولو لم يكن الأمر كذلك لما ظلّت هذه الأرض تدورُ في فلكها؛ لأن الله تعالى ينظر إليها بمنظور عباده الذين يؤدّون حق عبوديتهم مخلصين له الدين، أما أمثالنا من المجرمين المذنبين المتخبّطين فإنه يعفو عنهم إكرامًا لذوي الروحانيات العظيمة أولئك؛ فيمدّ في عمر الكون لأجل حرمتِهم لديه، ولا يجعل عاليَه سافلَه لأجل خاطرهم.
إن عصرنا عصر الأنانية، إلّا أنه بدأت فيه فترة جميلة من حيث العبادة والعبودية بعون الله تعالى؛ وفي الخبر: “اِشْتَدِّي أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي”[1]؛ إن آخر نقطةٍ في الظلام تشير إلى بدء النور والضياء؛ إذ يتراءى سوادٌ حالكٌ في الأفق قبل الشفق إلا أنه آخر سواد الليل، وإن جاز التعبير: فإن هذا يعني انبثاق خصائص الليل للمرة الأخيرة. أجل، إن الظلمات تكتَنِفُ الأفقَ كلّه مرة أخرى بكلّ حنقها وغيظها، لكنّ لُواحَ الفجر الكاذب بَعدَ ذلك يُعتبر أصدقَ شاهدٍ على طلوع الفجر الصادق؛ لأنه لم يخطئ من قبلُ قط؛ فحيثما وُلد الفجر الكاذب وُلِدَ الفجرُ الصادق عقِبه بمدّة وجيزةٍ جدًّا.
والحاصل أنه بقدر ما يتعمّق الإنسان في العبادة والعبودية للحق تعالى -حتى وإن كان ذلك في عصر الأنانية- بقدر ما تتخلّى عنه الأنانية وتهجره، ويضيقُ مجالها شيئًا فشيئًا، تمامًا كما تضيق دائرة الظلام كلّما اتسعت دائرة النور؛ فالتضاد الذي بين الأنانية والعبوديّة هكذا بالضبط تمامًا؛ إذ يتطوّر أحدهما على حساب الآخر، وبقدر ما يتعمّق العبد في العبودية بقدر ما تضمحلّ فيه الأنانيّة، فيعزو ذلك الإنسانُ كلَّ شيء إلى القدرة الإلهية مع مرور الوقت، أما قيمة النجاحات التي يحقّقها فإنه يقدّرها بناءً على تحقّق رضاه تعالى وتوجُّهه سبحانه من عدمه، وفي النهاية تذوب وتتلاشى أنانيته وحبّه لذاته تمامًا ويفنى عن نفسه ويبقى بالله عز وجلّ، يذكره ويصدح به في كل مكانٍ يتجوّل فيه.
[1] القضاعي: مسند الشهاب، 1\436؛ الديلمي: مسند الفردوس، 1\426.