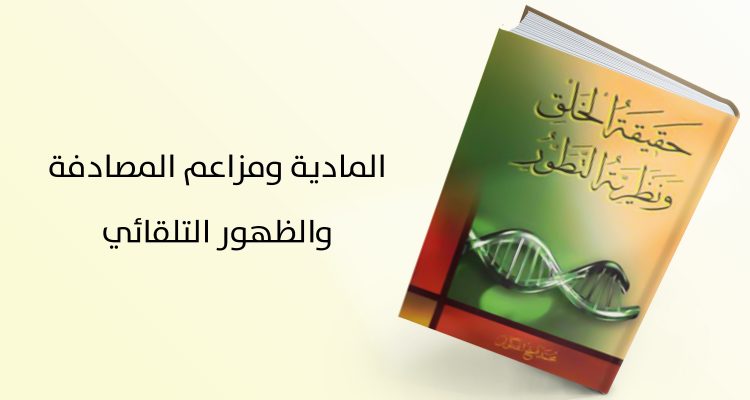نجد في أساس نظرية التطور مزاعم الظهور التلقائي للوجود نتيجة المصادفات. كان لامارك -الذي يعد أبو نظرية التطور قبل دارون- يسند التطور إلى الله. وكان يرى في التطور قابلية أعطاها الله تعالى للأشياء وللطبيعة. لذا كان من أنصار التطور الخلاق. بينما نرى في المقابل أن دارون أسند أساس الوجود إلى المادة وإلى الذرات وإلى الروح الخلاقة الموجودة فيها. لذا يعد دارون -بوجه من الوجوه- من أنصار “وحدة الوجود”. أما الذين جاءوا من بعده فقد ربطوا الوجود كله تماماً بالمادة، فانحرفوا إلى المادية وإلى الإلحاد بشكل كلي، واختاروا استعمال نظرية التطور كسلاح وكواسطة لإنكار الله.
والذين يناصرون نظرية التطور اليوم في عالمنا هم الملحدون من أصحاب الفلسفة المادية. فهؤلاء يؤمنون بأزلية المادة. ولكم أن تتصوروا مقدار هذا الجهل المعلن باسم العلم عندما ترى بأن هذا الوجود الذي يستلزم علماً لانهائياً وقدرة وإرادة وحياة لاينسب الى صاحب هذا العلم اللانهائي والقدرة والإرادة والحياة بل ينسب إلى المادة الخالية من الحياة ومن الشعور ومن العلم والقدرة والقوة، والتي لم يتفق العلماء بعد على تعريفها ولا على ماهيتها، والتي تتحول في يد الإنسان من شكل إلى شكل، وأعطوا لهذه المادة العاجزة موقع الخالق.
وأنا عاجز عن وصف الألم الذي أحسه عندما أفكر بخالقي ومعبودي -الذي أرتبط به بكل روحي وكياني- فأجدهم يقرنونه بالمادة، علماً بأن العلم وكرامته والفكر الموضوعي لا يوجب هذا مطلقاً. لأن إسباغ صفة الأزلية والخلق إلى المادة -حاشا لله- يعني التزام الطرف المعارض والمخالف، وهذا لا يليق بالفكر العلمي والموضوعي. ثم إن إنكار الله تعالى -حاشا ألف ألف مرة- وقبول عدم وجوده يكون قبولاً للنفي، واثبات هذا يرجع إلى الشخص النافي. بينما لا يمكن إثبات النفي.
لذا لا يمكن مطلقاً إنكار وجود الله تعالى، ويبقى هذا زعماً دون أي دليل. وفي مقابل عدم وجود أي دليل ينفي وجوده تعالى، هناك أدلة لا تعد ولا تحصى على وجوده. ولا يمكن عدم رؤية هذه الأدلة إلا إن قام الشخص بإنكار وجود نفسه وإنكار وجود الكون كما فعل السوفسطائيون. وهذا وهم واضح يوجب التخلي عن العقل وعن الحياة ومغالطة بينة ولا شيء غيرهما. إن مجرد ادعاء هذا الوهم والدفاع عنه والتزامه يكفي برهاناً على الوجود.
ولكن على الرغم من كل هذه الحقائق الجلية نجد أن العديد من الناس فقدوا إيمانهم أو ساورتهم الشكوك حول الكثير من الحقائق التي كانوا يؤمنون بها. ونظراً لاستخدام نظرية التطور في هذه السبيل ولهذا الغرض رأينا في سبيل ردّ نظرية التطور ونقضها إثبات أن المادة ليست أزلية وليست خالقة. ولكي نقوم بهذا كان علينا أن نتناول باختصار الزعم القائل أن الوجود بأكمله يستند إلى المادة، وهو أجهل زعم طوال ما عرفه التاريخ من مزاعم.
نود أولاً أن نذكّر بأن التطوريين -سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا- يتوهمون مكاناً لانهائياً. لأن إسباغ صفة الأزلية على المادة، وسحب بداية التطور إلى زمن غير معلوم ضمن هذه الأزلية، يعني إسباغ صفة الأزلية على المكان، لأنه لا يمكن التحدث عن الزمان وعن المكان بشكل منفصل، لارتباط أحدهما بالآخر.
إن الزمن يملك وجوداً اعتبارياً (اسمياً)، والمكان هو الذي يجعل الزمان بعداً للأشياء وللحوادث. بدون المكان لا يكون للزمان وجود. أما ما نطلق عليه اسم المكان فهو عبارة عن عالم المادة، أي عالم الذرات. لذا فعندما تتم البرهنة على عدم أزلية المادة، يظهر أمامنا عدم أزلية المكان والزمان. وأي شيء لا يملك صفة الأزلية لا يمكن أن يكون خالقاً ولا أن يظهر للوجود بنفسه تلقائياً.
ثم إن القانون الثاني للديناميكية الحرارية (الثرموديناميك Thermodynemic) الذي أصبح معروفاً من قبل الكثيرين ينفي أزلية المادة. إن القانون الأوّل للديناميكية الحرارية هو حول حفظ الطاقة. أما القانون الثاني فهو قانون كارنوت المشهور. وحسب هذا القانون فإن الجسم الحار يبعث الحرارة حواليه حتى يأتي يوم تنتهي فيه هذه الحرارة.
كما أن مصادر الضوء والطاقة تبعث الضوء والطاقة حواليها حتى يأتي يوم تتساوى فيه الطاقة في جميع أرجاء الكون، فيقف انتقال الطاقة. وهذا وإن كان لا يعني فناء الطاقة، إلا أنه يعني الموت ويعني زوال الزيادة والنقصان في الكون. وضع كارنوت هذا القانون نتيجة مشاهداته وتجاربه عندما كان يغلي الماء في بيته، وعندما كان يلاحظ حرارة مدفأته. ثم تم توسيع تجاربه هذه وربطها من قبل كبار العلماء بنظام معين، ويتم اليوم تدريس وتعليم هذا القانون باسمه.
لا يمكن اليوم ذكر شيء أكيد حول تأثير الديناميكية الحرارية الكلي في الكون. ولكن يمكن القول بأن الكون ليس كتلة واحدة صلدة، بل يتالف من أجزاء. وما يجري على جزء منه يجري على الكل فيه. وقد دلّت التجارب والمشاهدات في هذا الميدان بأنه إن لم تقم القيامة قبله بسبب من الأسباب، فإن القيامة الناتجة عن قانون الثرموديناميك (الديناميكية الحرارية) ستقع حتماً، أي ستنفد الطاقة في الكون وينهار النظام System فيه.( ) وقد يتساءل البعض عن العلاقة الموجودة بين عدم أزلية المادة وبين هذه القيامة الثرموديناميكية، أو ما الطعنة التي توجهها هذه العلاقة إلى أزلية المادة والزمن؟
لنبين أولاً بأن الظاهر هو أن الذين يقولون بأزلية المادة لا يعرفون معنى الأزلية. فلو وضعت أصفاراً بعدد رمال جميع الصحارى في الأرض أمام الرقم واحد، لعدّ هذا الرقم الهائل صفراً بالنسبة للأزل. وكذلك الأمر بالنسبة لأكبر عدد يمكن أن يتفتق عنه ذهن الإنسان أو يستطيع التفكير فيه أو تخيله فهو أيضاً يعد صفراً بالنسبة لمفهوم الأزل. لأن الأزل يعني اللانهاية. والشيء الأزلي يتصف بما يأتي:
لا يكون مركباً، ولا يتركب. بل يكون بسيطاً وغير قابل للتجزئة. لا يتغير ابداً، ولا يمكن التدخل فيه. يكون خارج الزمان والمكان، أي يكون خارج كل حركة متعلقة بالزمان والمكان. يكون أبدياً، لأنه في جميع الأحوال خارج الزمان. ولكون الأزل والأبد خارجَي الزمان، فهما يلتقيان في نقطة واحدة بوجه من الوجوه. ولا توجد أي خاصية من هذه الخواص في المادة. فالمادة متغيرة، ولا يمكن تصورها خارج نطاق الطاقة حسب ما يقرره قانون الديناميكية الحرارية (الثيرموديناميك). كما أنها صالحة لكل نوع من أنواع التراكيب. ثم إنها موجودة تحت قيد الزمان والمكان.
وفي مقابل هذا نرى أن علماء الكلام يقولون في حق الله تعالى: (ما ثبُت قِدمُه امتنع عَدَمُه)، وهذا يشير إلى أن المادة لا يمكن أن تكون منشأً للوجود، كما يشير إلى صفات الذات العلوية التي يجب إسناد الوجود إليها.
يتألف المكان بالمقياس الصغير من الذرات، وبالمقياس الكبير من النجوم. وفي شمسنا -التي هي نجم من هذه النجوم- يتحول 564 مليون طن من الهيدروجين إلى هيليوم في كل ثانية، وهكذا تنشر حواليها طاقة كبيرة بشكل ضوء وملايين السعرات من الحرارة. ويصل جزء من هذه الطاقة إلى الأرض وإلى جميع المنظومة الشمسية. ويتألف الكون من أمثال هذه الشموس. وفي يوم من الأيام ستنفجر شمسنا بقوة لامركزية انفجاراً مرعباً جداً عندما ينفد وقودها، تعقبه حركة انكماش مركزية وتقلص. أي لا تستطيع بعده مد أسباب الحياة للأرض، أي ستكون القيامة قد قامت.
وبما أن الكون يتالف من أمثال هذه الشموس كلبنات أساسية له، فلا يمكن تصور أزلية هذه الشموس التي تتجه الطاقة فيها إلى النفاد. لأن الشيء الأزلي -كما ذكرنا سابقاً- لا يكون مركباً، لأنه لا يدخل تحت دائرة الزمان والمكان، لذا لا يتعرض إلى النقصان وإلى النفاد، ولا يحصل عنده أي تغير مهما كان ضئيلاً.
بينما نرى أن المادة والعالم المادي في تغير مستمر، وفي تغير دائم من حال إلى حال، ويتعرض إلى الانحلال والتفكك ثم التكون من جديد، أو تكون هي سبباً في التفكيك والتغيير. لذا فهناك بداية للمادة ونهاية لها، وهي محكومة بقيود الزمان والمكان. وكل ادّعاء خارج هذا يعدّ ادعاء وفرضية لا نصيب لها من الصحة. ويعترف دارون نفسه بعجزه في هذا الموضوع وضعفه فيقول: (نظراً لأنني لم أكن موجوداً في العهود التي عاشت فيها هذه الأحياء شعرت بضرورة تقوية هذه المسألة ببعض الفرضيات).
والفرضيات، وإن كانت تستند إلى بعض المعلومات الأولية تعني آراء ووجهات نظر لم تتم تجربتها. فكما قدم دارون فرضيته هذه يمكن لي أن أقدم فرضية بأن إنساناً استطاع -بفضل حركة أرضية ما- أن يقفز عشرة آلاف متر ولم يحدث له شيء. فهذه أيضاً فرضية، فإن اعترضت عليّ وقلت بأن الإنسان الذي يقفز عشرة آلاف متر سيموت من قلة الأوكسجين قمت بتقوية فرضيتي فأقول: “أنتم تتحدثون عن الشروط الحالية، ولكن الشروط كانت مختلفة في عهد من عهود الأرض، لذا تيسر وقوع هذا الأمر”. فإن كانت فرضيتي هذه غير علمية ومجرد زعم فلا يوجد هناك فرق في هذا الصدد في ادعاءات نظرية دارون أو في الداروينية. إن التطور فرضية تقوم بتكذيب جميع القوانين السارية الأخرى في الكون وفي الحياة، وتقوم بملء جميع الثغرات والفجوات الموجودة فيها بفرضيات أخرى. لذا فلا تحمل قيمة أخرى خارج هذا النطاق.