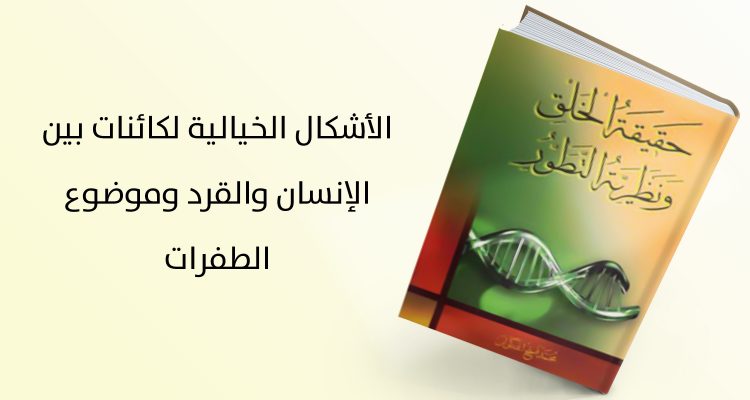توضع أشكال معينة جنباً إلى جنب في الكتب الدراسية بزعم شرح نظرية التطور. ترى في هذه الأشكال شكل قرد ثم شكل ربع قرد، ثم نصف قرد ونصف إنسان، ثم ثلاثة أرباع الإنسان وأخيراً صورة شخص أوروبي في منتصف العمر.
وكل هذا خداع في خداع. فلماذا تطور ذلك القرد يا ترى ولم تتطور بقية القردة؟ ولماذا ظهر في الأخير رجل في منتصف العمر، ولم تظهر إمرأة؟ وكيف تم تطور المرأة؟ هل تطور قرد واحد، أم تطورت قرود عديدة في الوقت نفسه؟ ولماذا لم تتطور القرود مرة أخرى في الأماكن التي احتشدت فيها القرود بمحض المصادفة وتطورت؟ وأي قسطاس علمي يرضى بأن تتم الإجابة على كل هذه الأسئلة -التي تبين الثغرات العديدة الموجودة في هذه النظرية- بالمصادفات وبالفرضيات؟ وأين حرمة العلم؟ وماذا لو كانت كل هذه الجهود تتم باتجاه فكرة الخلق، التي تنفي وجود المصادفات في الكون، وتقول: إن جميع الدلائل تشير إلى وجود قدرة وعلم وإرادة لانهائية هي التي خلقت سلسلة الحياة هذه. أليس هذا أفضل وأليق وأكثر علمية؟
موضوع الطفرات
الطفرات إحدى نقاط الارتكاز المزعومة لنظرية التطور. وهي الفرضية القائلة بأن التغيرات الحاصلة في شفرات جينات الكائن الحي عن طريق المصادفات أو عن طريق ظروف البيئة تكون إحدى عوامل التغيير عند الانتقال من نوع إلى آخر.
إن الكروموزومات الموجودة في نواة الخلية -التي تعد بمثابة مركز القيادة في الخلية- تحتوي على الجينات. وكل الخصائص والمواصفات العائدة للكائن الحي موجودة ومسجلة في جينات هذه الكروموزومات (على شكل جزيئات D.N.A.). وجزيئات (D.N.A.) -التي تشكل آلية القيادة والأوامر- بمثابة مخزن جيني للمعلومات، وقد خلقت بحيث تستطيع حتى من استنساخ نفسها، لذا فهي مرآة إلهية.
فكما يقوم جهاز الكومبيوتر عند الضغط على زر من أزراره بتقديم المعلومات المبرمجة في ذاكرته من قبل وعرضها أمامنا، كذلك تقوم هذه الآلية بتطبيق البرنامج المدمج فيها بكل كفاءة ودون أي نقص أو قصور، بل تقوم بتشفير هذا البرنامج على الدوام. وبواسطة هذه الشفرات تستطيع الحفاظ على خصائص نوعها وتكون حارسة له عند إصدار الأوامر لتحريك مختلف الفعاليات. أي أنه ما من ثأثير خارجي يستطيع تغيير هذه الشفرات ولا اجتياز الحواجز والأسوار والموانع التي وضعتها هذه الشفرات. فلا تستطيع لا الطفرات ولا أي شيء آخر تغيير خط ذلك النوع.
صحيح نحن نعلم بأن مختلف الإشعاعات والمواد الكيمياوية والظروف الأخرى للبيئة تُحدث بعض التغييرات في شفرات جينات الأحياء وفي برامجها. ولكن مثل هذه التغييرات الحاصلة في الشفرات الجينية -والتي يطلق عليها اسم الطفرات- لأي سبب من الأسباب لا تستطيع العمل على إنتاج نوع جديد من الأحياء، ولا تغيير أي كائن حي من نوع إلى نوع آخر.
ولكن على الرغم من كل هذا فإن الداروينيين الجدد يزعمون بأن هذه التغيرات تتلاحق وتتجمع مما يؤدي في النهاية إلى ظهور نوع جديد. ولكن أيكفي عمر أي فرد لحصول كل هذه التغيرات عنده؟ أي أيكفي عمر الفرد ليتحول إلى نوع آخر بهذه التغيرات؟ من الواضح أنه لا يكفي. ولكن لنفرض أنه يكفي، فهل هذه التغيرات تكون مفيدة وبمقياس يكفي لتحويله إلى نوع آخر؟ هذا مستحيل. أي إن هذه التغيرات الحاصلة في الفرد تكون من النوع السلبي مثل تشوه الأعضاء أي من النوع الذي يضر بالنسل، وقد أيد علم الجينات هذا الأمر. كما لم يتم حصول العكس حتى الآن.
إن الأبحاث الأخيرة الجارية حول مرض السرطان تشير إلى أن التأثيرات الضارة مثل الإشعاعات وتلوث الجو، تعد من الأسباب المؤدية إلى تخريب الخلية وتشويهها مما يكون سبباً في حدوث مرض السرطان. ثم إنه لم تتم مشاهدة أي تغييرات من هذا النوع لا في الإنسان ولا في الأحياء المجهرية من العهود السابقة التي تستطيع الأبحاث العلمية الاستناد إليها. وقد أجرى رجال العلم -للبرهنة على صحة هذا الزعم- تجارب على ذبابة الفاكهة “دروسوفيلا” سنوات عديدة، وحصلوا على أكثر من 400 نوع مختلف من نسلها.( ) ويعطينا البرفسور “عاطف شنكون” المعلومات الآتية حول هذه التجارب فيقول:
(ومع أننا لم نلاحظ حصول أي تغيرات جذرية في ماهيتها، إلا أنه تم حصول تغيرات عليها نتيجة تعرضها للطفرات. ولكن لم يتم الحصول على نسل جديد نتيجة تلاقحها وتناسلها).
والخلاصة أن التجارب العديدة التي أجريت على أكثر من 400 من ذباب الفاكهة أظهرت أنه -مع حصول تغيرات طفيفة عليها- من المستحيل أن يتغير نوعها أو ماهيتها. فقد حدثت تغييرات غير ذات أهمية على ذبابات الفاكهة نتيجة تأثير الشروط والظروف البيئية عليها مثلما يحدث على الإنسان من تغييرات بسيطة من ناحية اسمرار الجلد، أو ارتفاع ضغط الدم. وعندما تمت عمليات التناسل بين هذه الذبابات المتعرضة لهذه التغيرات لم يتم الحصول على نسل جديد، أي أصبحت هذه الذبابات عقيمة، كما أن تشوهات عديدة ظهرت عليها.
لقد أعطي للإنسان حق وصلاحية التدخل في عمل الطبيعة بمقياس معين، لأنه خليفة الله في الأرض ومكلف بإعمارها واكتشاف العلوم وتطويرها واستخدامها في هذه السبيل، مما يوجب عليه مثل هذا التدخل. ولكن هذا التدخل لن يستطيع تغيير الحيوانات من نوع إلى آخر. أما في النباتات فيمكن -حسب القوانين التي وضعها الله تعالى في الطبيعة- بواسطة عملية التطعيم في الأشجار الملائمة للتطعيم الحصول على نوع آخر من الأشجار. ولكن يجب التنويه بأن هذا غير ممكن في جميع الأشجار، فأي شجرة كانت ملائمة للتطعيم حسب طبيعة خلقها فيمكن تحويلها إلى نوع آخر بالتطعيم. ولكن لا يوجد في عالم الحيوان تغيير بهذا المقياس. ولكن يستطيع الإنسان بعملية التلقيح، أيْ باستخدام مني جاموس مثلاً من نوع جيد لتحسين نسل جاموسة أدنى منه نوعية.
وخارج هذا النطاق فقد سمح الله بعملية التناسل والإنجاب بين الحصان والحمار. ولكن البغل الناتج من هذه العملية -التي تعد عملية استثنائية في عالم الحيوان- يكون عقيماً. أي إن مثل عمليات التناسل التي تتم بين أجناس مختلفة من الحيوان تكون الذرية الناتجة عقيمة، فلا يمكن ظهور نوع جديد منها. ولم يلاحظ -خارج هذا الأمر- أن تراكمات للطفرات ضمن شريط زمني طويل يمكن أن تنتج نوعاً جديداً من الأحياء. ولم تنتج من المحاولات العديدة التي جرت على بعض أنواع الأحياء سوى فروقات طفيفة كقصر في السيقان، أو اختلاف في الألوان. ولكن كل نوع حافظ على نفسه وعلى خواصه وأصله، فبقي الذئب ذئباً وبقي الخروف خروفاً.
والتدخل الإنساني لا يقلب الذئب إلى خروف، ولا الخروف إلى ذئب. وهذا الأمر ليس صحيحاً وجارياً في مثل هذه الأحياء المعقدة التركيب فقط، بل لم تتم مشاهدة تغيرات ذات بال حتى في البكتريات التي هي أصغر الكائنات الحية. وقد لوحظ أن هذه البكتريا التي تتكاثر بالانقسام كل عشرين دقيقة بالرغم من كونها تصاب بالطفرة بعد 60 ألف جيل من أجيالها فإنه لا يوجد أي فرق بينها وبين أجدادها من البكتريا التي عاشت قبل 500 مليون سنة، ولا مع أجدادها من البكتريا التي عاشت قبل مليار سنة كما أثبت ذلك علم المتحجرات.
والمسألة الأخرى هي -كما ذكرنا ذلك باختصار من قبل- أن علماء المتحجرات يقولون بأنه لكي نقبل بحدوث التطور يجب العثور على الحلقات الوسطى والمراحل الانتقالية بين الأحياء. ولكن بعض الداروينيين لا يرون ضرورة لوجود هذه المراحل الانتقالية ويرون أن الكائن الحي يستطيع القفز فجأة إلى نوع أعلى، فيقولون بأن من الممكن مثلاً أن يخرج طائر من بيضة تعود لحيوان زاحف.
ويقوم علماء الجينات بالرد على هؤلاء، ويقولون باستحالة قيام أي كائن حي مثلاً بتبديل 1000 صفة وخاصية مرة واحدة. يقول الدكتور “لوكومت دنوي Dr.Lecomte de nouy”: (يحتاج الحصان إلى خمسة ملايين سنة لكي يستطيع تبديل خمسة أظلافه بظلف واحد). لذا فإذا أخذنا هذه المسألة في ضوء هذا التكامل التدريجي فإن زعم حدوث مثل هذه الطفرة الفجائية ليس إلا سخفًا واضحاً. فإن قيل لنا بأنه تغير تدريجياً وعندما بلغ نقطة معينة تبدل فجأة، عند ذلك نقول لهم بأن من الضروري حدوث هذا التطور والتغير خطوة فخطوة. فمثلاً يجب لكي يتحول الحصان إلى كائن بظلف واحد وجود حصان بأربعة أظلاف، ثم حصان بثلاثة أظلاف ثم حصان بظلفين.
ولا شك أن التغير يجب ألا يقتصر على عدد الأظلاف، لأن الجسم عندما يقوم بفعالياته فإن كل جزء منه مرتبط بعلاقات وثيقة مع الأجزاء الأخرى. وحتى عندما يندمل جرح في الجسم يمكن ملاحظة اندماله بسهولة. لذا فلا يمكن عدم ملاحظة كل هذا التغير الكبير. والخلاصة أن من المستحيل أن يخرج طائر من بيضة زاحف. لأن تغيراً بقوة مئات من الطفرات سيؤدي إلى هلاك ذلك الكائن الحي في لحظة واحدة.
تحدث انقسامات سريعة وتكاثر سريع في الأحياء المجهرية. فمثلاً تنقسم بكتريا Ascherichia coli كل عشرين دقيقة وبشكل متعاقب. وتتناسل ذبابة الفاكهة ثلاثين مرة في السنة الواحدة. أي أن السنة الواحدة لهذه الذبابة تعادل مليون سنة من سنواتنا، فما يحصل لدى الإنسان من تغير طوال مليون سنة يجب أن يحصل لدى هذه الذبابة في سنة واحدة. فلو حصل تغير في النوع لدى هذه الذبابة في سنة واحدة قبلنا آنذاك أن مثل هذا التغير النوعي قد يحصل لدى الإنسان في مليون سنة. ولكن الحقائق المشاهدة هي على النقيض من هذا تماماً.
وهناك من علماء المتحجرات من يذكر أن البكتريا والطحالب الخضراء والزرقاء عاشت في العهد السلوري والبرمي وهي من العهود الجيولوجية القديمة. ويرد في بعض الكتب أن هذه البكتريات وجدت قبل 300 مليون سنة، وفي كتب أخرى أنها وجدت قبل 50 مليون سنة، وأنها طوال خمسين أو 300 مليون سنة لم تتغير وأن البكتريات الحالية تشبه تلك البكتريات السابقة تماما.
وقد يعترض بعضهم علينا فيذكر بأن متحجرات الطحالب الخضراء والزرقاء قليلة جداً، وهذا يؤدي إلى تعذر البرهنة على تعرضها لأي تغيير أو تطور. ولكننا على أي حال نتكلم عن الكائنات الحية التي لها القابلية على سرعة التكاثر مثل البكتريا. فهذه الكائنات لم تتغير ولم تتطور طوال مدة خمسين وربما طوال ثلاثمائة مليون سنة.
كما لم تتم مشاهدة أي تغيرات في الحيوانات في الحدائق الطبيعية التي أنشئت في مختلف أنحاء العالم وفي حدائق الحيوانات والتي عرضوا فيها هذه الحيوانات لمختلف الظروف الطبيعية. وهناك مختبرات عديدة تطبق فيها أبحاث ومحاولات لإحداث الطفرات، ولكن لم يتم الوصول حتى الآن إلى أي نتيجة. أما بعض الحوادث الجزئية التي ادعوا أنهم نجحوا فيها في هذا الصدد فترجع إلى الخصائص الفطرية الموجودة في تلك الأنواع. أي أن هذه الأنواع لها قابلية لظهور هذه التغيرات فيها. هذا مع العلم أن قانوناً -كالتطور- يدعي أنه هو الأساس في تفسير الكائنات الحية وفي تفسير الحياة لا يمكن أن يكون محدوداً في نطاق ضيق جداً وفي مشاهدات وتغيرات جزئية، بل يجب أن يكون شاملاً لجميع الأحياء.
لقد وضع الله تعالى استثناء لكل قانون عام في هذا الكون، لكي لا يتعلق الإنسان بهذه القوانين وينسى الفاعل الحقيقي وراءها الذي هو الله تعالى رب العالمين. وعلى الرغم من هذا فلم يتم العثور حتى الآن على حادثة تحول في هذا المستوى في الأبحاث الجارية في المختبرات.
يوجد في هذا الصدد حادثة الكائن الحي الذي يطلق عليه اسم Allopoliploidi والذي يوجد في جنسه نوعان مختلفان، حيث تمت مضاعفة عدد الكروموزومات ثُم تَمَّ إجراء عملية التناسل بينهما فظهر نوع هجين منهما. فمثلاً إن قمنا بمضاعفة عدد الكروموزومات في الكرنب والفجل ثم قمنا بعملية تلقيح بينهما حصلنا على نوع جديد من الفجل. ولكن هذا يحدث في عالم النباتات، وكلما ترقت الأحياء ووصلت إلى مستويات أعلى استحال ظهور هذه الأمور. لذا فلا يمكن العثور على أمثال هذا في عالم الحيوانات وفي عالم الإنسان.
القيام بمضاعفة عدد الكروموزومات، وكذلك القيام بعمليات التناسل بين الأنواع المختلفة يؤدي في الظروف الطبيعية إلى عقم الحيوان الناتج من هذا التناسل (كالبغل مثلاً). ونظراً لأن مثل هذا المخلوق لا تكون أمامه فرصة ليصبح أباً أو أمّاً لذا نقوم بمضاعفة عدد كروموزوماته إلى الضعف. وكما ذكرنا فإن هذا الأمر غير وارد في عالم الحيوان، وإن كان وارداً في عالم النباتات. إن عدد الكروموزومات في الإنسان يبلغ 46 كروموزوماً. أي أن هذه الكروموزومات هي التي تعين الصفات البيولوجية للإنسان، وهي التي تعين ماهيته.
وعلى الرغم من هذا فعندما يتغير هذا العدد ويصبح 45 أو 47 أو 48 كروموزوماً، فلا يظهر هناك نوع آخر من الأحياء، بل يظهر إنسان مشوه وغير طبيعي. أي إن الفرق في عدد الكروموزومات يؤدي إلى تشوهات جذرية. لذا فلو قمنا بمضاعفة عدد الكروموزومات عند الإنسان فلا نحصل على نوع آخر من المخلوقات، بل على طفل بشري ولكنه يموت قبل أو بعد الولادة ولا يعيش. أما عندما يكون التغير في عدد الكروموزومات بمقياس لا يؤدي إلى الموت، فالنتيجة تكون ظهور العاهات والتشوهات والأمراض. لذا فإن التلاعب بعدد الكروموزومات في عالم الحيوان وفي عالم الإنسان لا يجلب سوى الكوارث. أي أن الطفرات -التي تعني تدخلاً في نظام D.N.A. للكائن الحي- تؤدي إلى نتائج ضارة وتأثيرات مميتة عند الأحياء. لذا لا يمكن الحديث عن طفرات تؤدي إلى تغيرات كبيرة ومفيدة في الوقت نفسه.
وقبل إكمال هذا الموضوع يجب التطرق إلى أمر آخر، وهو زعم بعض التطوريين -ولاسيما في تركيا- بأن شفرات خريطة الجينات في الإنسان قد تم حلها. وهم يريدون استخدام هذا الأمر كدليل على التطور، بينما يذكر العلماء الحقيقيون بأنه من السابق لأوانه القول بحل شفرات خريطة الجينات في الإنسان. ففي مقابل الادعاء بأن نسبة معينة من الجينات متراصة، نرى هناك عدم اتفاق حول عدد الجينات الموجودة في الإنسان، فهم يعطون أرقاماً تتراوح بين 28 ألفا إلى 140 ألفا من الجينات.
ويقول العلماء بأن رصّ نسبة من هذه الجينات لا يعني حل شفرات خريطة الجينات. كما يشيرون بأنه لا يمكن بهذا قراءة “كتاب الحياة”. كما يذكرون بأن النجاح المتحقق حتى الآن في هذا الموضوع يساعد فقط في تشخيص بعض الأمراض الجينية. لأن معرفة شفرة جين من الجينات لا يعني معرفة البروتينات التي يقوم هذا الجين بإنتاجها في الجسم، ولا معرفة أي البروتينات ستتأثر بهذا البروتين أو تؤثر فيه، فهذا الموضوع ليس واضحاً حتى الآن.
إن الخالق ذا الرحمة غير المحدودة كما وضع المعلومات الجينية بشكل مزدوج، كذلك جعل شفرات الأحماض الأمينية -من باب الأمن والاحتياط- أكثر من شفرة واحدة. وهذه المعلومات الجينية مثل لغة إن لم تُقرأ بشكل صحيح وتتم ترجمتها بإنتاج بروتين جديد فلا قيمة لها. لذا كان من الضروري تحول هذه المعلومات بشكل صحيح وبالمقدار الصحيح وفي الوقت المناسب إلى بروتينات، علاوة على ضرورة وجود هذه المعلومات من ناحية استمرار الحياة والصحة.
والسؤال المطروح هنا: من الذي يعطي الإذن لاستعمال بعض هذه المعلوات الجينية الموجودة في الكروموزومات -والتي يشكل كل منها موسوعة معارف كاملة- ولا يسمح لبعضها الآخر؟ لقد دلّت الأبحاث أن هناك بروتينات تملك خاصية وقابلية فتح معلومات معينة وقراءتها، وغلق معلومات أخرى ومنع قراءتها. وبعبارة أخرى إن الشفرات الجينية تحل رموزها وتُقرأ من قبل مجموعة من البروتينات لاستعمالها في صنع البروتينات، حيث تقوم هذه البروتينات المصنوعة بتعيين متى وبأي شكل يجب أن تتم قراءة هذه المعلومات.
فيا ترى من أين تتلقى هذه البروتينات أوامرها، ومن الذي يوجهها في هذه الفعاليات التي يعدّ مجرد اكتشافها حتى من قبل الإنسان -الذي يعد أرقى الأحياء من ناحية الشعور والفكر والعلم- فتحاً كبيراً ونجاحاً متميزاً؟ وكيف تصل هذه البروتينات إلى وضع تستطيع فيه تدقيق البرنامج الجيني الذي أخذته من أجل إنتاج نفسها ثم السيطرة على هذه المعلومات فيما بعد؟ ونستطيع أن نشاهد برنامجاً غامضاً عند القيام بإنتاج نسل جديد. كما أن من المدهش جداً ما نراه من قابلية الحيوان على إصلاح الأعضاء الجريحة أو المقطوعة أو التالفة وتجديدها، وإن كانت هذه الأمور تجري تحت ستار من الإلفة.
فالخلايا الموجودة في الأعضاء المقطوعة أو التالفة كانت خلايا اعتيادية في الجسم، ولم تكن قد تميزت. فمثلاً عندما تُقطع رجل من أرجل الضفدع تبدو أن الخلايا نفسها -وكأنها تلقت أمراً سرياً من مصدر ما- تتمايز وتقوم بتشكيل خلايا غضروفية وخلايا عظمية وخلايا عضلية والأنسجة الجلدية (Epitelyum) لكي تشكل منها ساقاً جديدة.
فهل يوجد تخطيط لبناء الأرجل في هذه الخلايا؟ هل هناك مثل هذا التخطيط تعرف منه هذه الخلايا أن الكائن الحي بحاجة إلى رجل فتقوم بصنعها وتنفيذ هذا المخطط؟ ولماذا لا تنشط هذه الخلايا إلا عندما يحتاج الجسم إلى مثل هذه الفعالية؟ وبما أنه يستحيل على الخلايا معرفة هذا، وبما أنه لا يوجد في الجسم ولا في الطبيعة أي آلية أو مركز يقوم بتزويد الخلايا بمثل هذه المعلومات والإيعاز إليها للقيام بهذه الفعاليات إذن فهناك من يعرف جميع حاجات الجسم، وله القدرة على تلبيتها… إذن هناك من يعرف مكان وزمان كل هذه الأعمال والفعاليات.