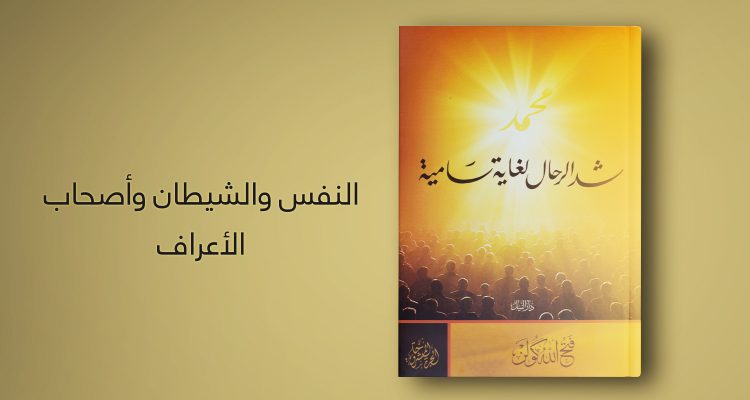سؤال: في آية: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 175/7) يتحدث القرآن الكريم عن شخص شقيّ غوى وضلّ في نهاية أمره، ورغم أنه أُوتي من الآيات ما أُوتي كي يعثر على الحقِّ والحقيقة، إلا أنه أعرض عنها واتبع الشيطان، فما الذي يجعل خاتمة الإنسان سيئة على هذا النحو بعدما كان يسير في الطريق المؤدية إلى الحقّ؟
الجواب: للانحراف عن طريق الحق التي نسير فيها أسبابٌ على رأسها الغفلة عن حقيقةٍ مهمة، وهي أن الله خلق الموت والحياة ليبتلينا، وهذا الأمر ماضٍ في كلِّ لحظة منها؛ ثم ما تورثه هذه الغفلة من انخداع بغوايات النفس والشيطان، والأصلُ أن الإنسان يعيش على الدوام صراعًا مع آلية النفس ومع الشيطان الذي لا يُعرف أين، ومتى، وبأي شكل سيتعرض للإنسان ويخادعه، فهؤلاء الأعداء يدنون من الإنسان غالبًا في صورة أصدقاء، فيُزيّنون له الأمور، فيرى الصوابَ خطأً، والقبيحَ حسنًا، والباطلَ حقًّا، فيُضلّونه؛ فعلى الإنسان أن يظل يقظًا حذِرًا دائمًا يتصدّى لوساوس النفس والشيطان لئلا ينخدع بهذه الحِيَل، وإلا فإن لحظة غفلة قد تسوقه إلى الوقوع في حيلٍ يصعب أو يستحيلُ النجاةُ منها.
ولكُم أن تعدّوا كل شيء تشتهيه أنفسنا وأجسامنا من زينة الدنيا الجذابة مادّةً يستخدمها الشيطانُ الخَدّاع في الخداع؛ أجل، إن الشيطان العدوَّ اللدودَ يُغري الإنسان بما قد يستهويه، في حين أن بعض الأشياء التي تعجبنا قد تكون في عاقبتها سمًّا زعافًا، كما قال الله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 216/2)، وبتعبير آخر: إن العسل المسموم مهما أعجبَنا ونحن نتذوقه ونتلذذ بطعمه كثيرًا في أول الأمر، فقد يجعلنا نعاني مغصًا شديدًا بعد ذلك؛ وعكس هذا: قد يواجه الإنسان أحداثًا ظاهرها مقلق مؤلم، فإذا تحمل ألمها ومعاناتها إذا به كأنه يطير معها، ويصل إلى الرَّوح والريحان، مثال هذا لو أن نهرًا بباب أحدكم بوسعه أن يغطس فيه ويتطهر فإذا بالشيطان يوهمه أنه نهر مرعب وعميق جدًّا، فمن نظر إلى المسألة بالعقل السليم، والحسّ السليم، والقلب السليم، وعرف حقيقتها وانغمس في النهر رأى أن الماء لا يبلغ الكعبين، وأنه نافع يطهر وينظف، هذا هو الشيطان يسعى لاستجراركم إلى الشرّ بحيله الخبيثة، ويود لو يمنعكم من أعمال الخير بتضليل يبدو في الظاهر أنّه إيجابي؛ لأنه -كما وصفه القرآن الكريم- “مسوِّلٌ”، “مزيِّنٌ” يزيّن الذنوب للناس.
انتهازيٌّ يترقب لحظة الغفلة
أجل، إن الشيطان هو العدو اللدود للإنسان، يرصد دائمًا أوقات غفلة الإنسان، ويترقب الموضع الذي يستطيع أن يضربه منه، ونقاطَ ضعفه مثل الشهوة، والخوف، وحب المنصب، والولع بالمنفعة، فإذا وجد فرصته قلب الإنسان رأسًا على عقب، واطَّرَحه أرضًا.
ويذكر القرآنُ الكريم أن الشيطان يُضمر للإنسان الحقد والضغينة، وأنه يمتلئ بُغضًا وكُرهًا له، يقول: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 16/7-17).
وكذا ذكر في سورة “ص” الحقد والبغض والحسد الدائم الذي يُكِنُّه الشيطانُ للإنسان؛ قال تعالى على لسان الشيطان: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (سُورَةُ ص: 82/38)؛ ومن تأمّل كل هذه الكلمات ونحوها في جميع آي القرآن الكريم رأى أن همزات الشيطان ووساوسه هي التي تقف وراء جميع زلات الإنسان وكبواته وسقطاته، وتصرفاته وسلوكياته غير المسؤولة تجاه الحق تعالى.
من اكتفى بما عنده فهو مخدوع
لا جرم أنّه لا ينبغي للإنسان أن يقف من هذا العدو اللّدود موقف أصحاب الأعراف، بل عليه أن يدلِّل بعقله ومنطقه وعقلانيته ومحكَمات الكتاب والسنة على صدق قيمه التي يؤمن بها؛ أي لا بدّ أن يحصِّن صرح الإيمان والتوكل لديه، ويلوذ بالعناية الإلهية ليفوز ببشرى الآية الكريمة ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (سُورَةُ النَّحْلِ: 99/16)؛ وبتعبير آخر: إن مَن يكتفي بمُعطيَات البيئة الثقافية التي نشأ فيها، ولم يستطع أن يتخلَّقَ بالقيم التي يؤمن بها ولا أن يرقى بإيمانه إلى أفق الإيمان التحقيقيّ، فلا مناص من وقوعه في حبائل الشيطان.
يذكر القرآن الكريم كما ورد بالسؤال إنسانًا مترددًا مذبذَبًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيقول: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 175/7).
ففي هذه الآية يقصّ علينا القرآن الكريم رحلةَ إنسان خاسر لنستلهم منها العبرة والعظة: لقد آتاه الله آيات بينات أي حُججًا وأدلة أو كراماتٍ ومعجزاتٍ تنفتح لها العيون والآذان، ويصدُق بها اللسان، ويُساق بها القلب إلى الفكر المستقيم، ومع هذا كلّه انسلخ منها واتبع هواه، نفهم من هذا أن ذلك التعِس مع كلّ ما لديه من خصائص ما زال من أهل الأعراف أي لم يستطع أن يحدد مكانه أو أن يضع قدميه على أرض متينة.
أو قل: صحيح أن هذا الإنسان نشأ في بيئة صالحة إلا أنه لم يتخلق بفضائلها التي هيأتها له؛ أجل، إن هذا التعِس وريثَ البيئة الثقافية لم يُجهد نفسه ولم يكابدْ حتى يدلِّل على صدق علمه وعقيدته، بل لم يُعمِل فكره بحقّ، ولم يطلق العنان لإرادته حتى يعيد صياغة عالمه العقائدي والفكري والشعوري من جديد، فتعثر في الطريق، وانقطعت به السبل، وأصبح من الخاسرين، ولم تنفعه معرفته بالاسم الأعظم واطّلاعه على أسرار الألوهية وأسرار الربوبية كما قال بعض المفسرين؛ لأن هذه المعلومات لم ترسخ في جوانيته.
إذًا من لم يتعهد تراث أجداده بالإصلاح والتجديد ويعيد النظر فيما لديه من معلومات، ويتأكد من صحتها، فهو معرّض غالبًا لأنْ يلقي الشيطانُ بذور الوسوسة والشكّ فيه، ويكدّر قلبه وعقله.
ملازمة المجالس الإيمانية
ثم كشف الحق سبحانه وتعالى أمر هذا الذي ما زال في الأعراف بقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/176)؛ هوى الراحة والشهوات والشهرة والتقليد والتصفيق والتهليل، وتعلّق بأهوائه وشهواته ونسي أن الله تعالى هو صاحب كلّ ما لديه من نِعَم، فلما نسي هذا كله أصبح هو أيضًا من المنسيِّين.
وبعد ذلك يقول الحق تعالى فيه: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/176)، وبعد بضع آيات يقول: ﴿أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/179)، فدل هذا أنّ مَن يتردى إلى مثل هذا الحال ينحطّ إلى مرتبة أدنى من مرتبة الأنعام.
إن الإنسانَ أشرف مخلوقات الله، وهو مرشح لكل رفعة وجلال، وقد تبوأ مكانة أعلى حتى من الملائكة، ومع هذا فإنه إن هوى وزلت قدمه فلن يقع على أرض مستوية، بل سيهوي في هوّة سحيقة، والمعنى أنَّه إن أصبح أسيرًا لرغباته وشهواته عجز عن أن يحافظ حتى على رتبة الإنسان العاديّ، وتدنّى إلى رتبة الحيوان.
وهكذا نجد بلاغة القرآن الكريم تتجلى في العدول عن اللين واللطف في التعبير نظرًا لهول القضية المذكورة وعظمها، فيشبّه سلوك مثل هذا الإنسان بسلوك الكلب.
وزبدة القول: إذا لم يثبت المرء على منهجه الذي يسير عليه، ولم يتزود بزاد يؤهله للسير فيه، ولم يكن لديه عزم وتصميم على تجديد نفسه، ولم يتمسك بحقيقة “جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ… أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ”[1]، فمن المحتمل أن يتعثر بإحدى هذه العراقيل في أي وقت.
ومعنى ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يجعل همّه المحافظة على إيمانه بكل عزم وإصرار حتى يتسنى له تجاوز كل هذه العراقيل والوصول إلى الهدف المنشود، وأن يحيط نفسه بسياج منيعةٍ، وأن يغذِّي روحه دومًا بالعمل الصالح والمجالس الإيمانية.
[1] مسند أحمد بن حنبل، 14/328.