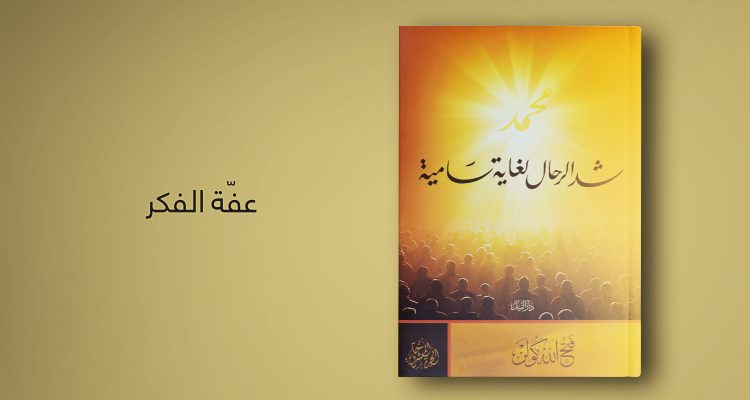السؤال: ثمة مصطلحات تذكرونها أحيانًا مثل “عفّة الفكر” أو “شرَف الفكر”، فهلّا تفضّلتم بإيضاح المراد بهذين المصطلحين؟
الجواب: الفكر والحركة من أهمّ المقومات التي توصلنا إلى حقيقة الوجود، وبهما نجدد كياننا المعنوي ونحافظ عليه من العواصف العاتية، ثم إن الفكر بالمعنى الإجمالي وإن كان قبل الحركة إلا أنه بالمعنى التفصيلي ينمو داخلها، والمراد أن من شُغل بموضوع ما وأعمل فكره وعقله فيه واجتهد في قراءته قراءة صحيحة، لن يستوعبه ويستمرئه إلا بعد الشروع في تطبيق هذه الأفكار والتعايش معها؛ لأن الأمر يقتضي رُؤى جديدة بعد الشروع في تطبيق الخطة، وهذا يسوق إلى أفكار أكثر عمقًا، وبهذا تستقر الأفكار الإجمالية على أرضية متينة؛ وأهمّ مبدأ نحرص عليه في جميع أفكارنا ونيّاتنا التي تحتضن الحركة هو عِفّة الفكر، سواء أكان الفكر إجماليًّا أم تفصيليًّا؛ ومن ثم علينا أن نعدّ الولاء لعفة الفكر من مقتضيات شخصياتنا، وأن نحافظ عليها كأنه ماء أعيننا مهما كانت الظروف والأحوال.
الأفكار السليمة منجم للتصرفات السليمة
قد نلقى من بعض الناس معاملة فظّة، لكن لا ينبغي أن يسوقنا خطؤهم إلى خطأ آخر البتة؛ أجل، علينا أن نلزمَ قيمنا الأساسية مهما كانت الظروف والأحوال؛ أمّا إن حدث انحراف في أفكارنا وسلوكنا ردًّا على تصرفات هذا أو ذاك، فسيتولد عنه سلسلة انحرافات بلا ريب، وهذا سيؤدي في النهاية إلى أن نَضِلّ الصراط المستقيم؛ والحق أنا ينبغي ألا نتيح لأحد أن يشغل أذهاننا بَلْهَ أن ينحرف بنا عن الجادّة، وفي سبيل المحافظة على عالمنا الفكري ومنهجنا الفكري وشلّالنا الفكري علينا أن ننأى بأنفسنا عن أي استفزاز مؤثر؛ لأن الهدف الأساس للاستفزازات صدُّ الساعين في طريق الخير عن بلوغ غايتهم المثلى، ومحاولةُ توجيههم إلى وجهة أخرى، أي فالمقصد الرئيس هو قطع الطريق لئلا نبلغ الهدف وللعدول بنا إلى وجهة أخرى.
إذًا لا ينبغي أن تؤثر الافتراءات في رواد الفكر السليم، بل عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في المحافظة على عفّتهم وشرفهم على الدوام، وهذا لا يمنعهم حقّهم في دحض الافتراءات بالبيان أو التصحيح أو التفنيد؛ أجل، لا بد أن نفكر دائمًا باستقامة حتى تستقيم الأفعال والتصرفات التي ستُبنى على هذا الفكرِ النظريِّ؛ أمَّا لو ساقتنا كل عاصفة تهبّ علينا واطَّرَحتنا جانبًا، نكون قد ضللنا السبيل الذي كنّا نسير فيه، وسلكنا دروبًا وعرة، وأخطأنا الطريق في النهاية.
مَن حسُنتْ فِكرتُه استمتع بحياته
يقول النبي صلى الله عليه وسلم “أَفْلَحَ مَنْ كَانَ سُكُوتُهُ تَفَكُّرًا، وَنَظَرُهُ تَعَبُّرًا”[1]؛ يدل هذا البيان النوراني أن المرء يُؤْجَر على حُسن الفكرة كما يؤجَر على العبادات، هذا وإن الانشغال بالأفكار التي لا سبيل إلى تحقيقها يعد إهدارًا لطاقتنا، لكنني أرى أن الإنسان لو تمنّى خيالًا أن لو كانت لديه المقدرة على تغيير صورة هذا العالم ووضْعه في شكل أبهى وأكثر حيوية، فإن تصورات هذا الإنسان وخيالاته تصطبغ بلون العبادة وصورتها؛ إن الوظيفة التي تقع على عاتق المؤمن هي الانشغال بالأمور الحسنة على الدوام، والسعي في إطار هذه الأفكار الحسنة، يقول الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي -طيّبَ الله ثراه- في كتابه “المكتوبات”: “مَنْ حسُنت رؤْيته حَسُنتْ رَوِيّتُه، ومن حسُنت رويّته استمتع بحياته”[2]؛ أي إنما تغدو حياة الإنسان متعة لها نغمة، ويعيش كأنه يسير في أروقة الجنة إذا حسُنتْ فكرتُه.
لدى الإنسان استعداد فطري للتفكير؛ فإن لم يوجّه استعداده هذا إلى طريق إيجابي، فربما يجرّه هذا الاستعداد إلى سبل سلبية كالأنانية والبوهيميّة؛ وليس هذا في التفكر فحسب بل إن التصورات والتخيلات التي لا تُستخدم في الخير قد تضع الإنسان وجهًا لوجه أمام هذا الضرب من السلبيات؛ فعلى المؤمن أن يتحرك دائمًا بالقيم التي يؤمن بها، وأن يحفِل بها، وأن يقرأ ويفكّر دائمًا، وعليه أن ينهل ويتغذّى من المصادر الأساسية باستمرار دون أن يسمح بحدوث أي فراغ في حياته، وعليه أن يعطي إرادته حقَّها فينأى بعيدًا عن مشاعر وأفكار تأباها آلية الوجدان، فإن هبّت عليه رياح سلبية رغم كل جهوده، فعليه أن يحاول التخلص من هذا المناخ كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مَن أبحر في خيالات تخلّ بعفّة الفكر يصل إلى نقطة يبدو فيها كمن أبحر بعيدًا جدًّا عن الشاطئ، فلم يعد يعثر من جديد على قارب يرجع به عن السلبيات التي غاص فيها؛ أجل، إن عجز الإنسان عن قطع السبيل على الحقد والكره والغيظ والشهوة الجارية في عروقه، فقد تحطّم هذه الأمور السدودَ وتستصدرُ قرارات منحرفة تجعل المرء يرتكب أعمالًا مشينة.
على الإنسان أن يوفِّي إرادته حقَّها في هذا الباب من جانب، وأن يسأل الله تعالى الحفظ من الجانب الآخر، فإن استطاع فعل هذا عاش حياته -بعون الله تعالى- في الحِمَى وكَنَفِ الحفظ، لكن لا بد من اليقظة والحذَر الدائم، فلا يَأمن أن ينقلب على عقبيه حتى أكثرُ الناس استقامة، وما علينا عندما نهتز ونوشك أن نسقط إلا أن نقوّم عِوجنا، ونتوجه إلى الله تعالى من جديد قائلين: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/23).
الأهواء والرغبات بلباس الفكر
ومما ينبغي الانتباه إليه من أجل عفّة الفكر أن الأهواء والرغبات قد تتدثر بدثار الفكر، وتنحرف بالعبد عن الطريق القويم؛ والمعايير الشرعية هي وحدها المقياس في تحديد ما هو هوًى ورغبةٌ وما هو فكرٌ، فإذا ما ثُرْتَ على إنسان لتصرفات وأقوال أغضبتك وآذتك، فانظر أولًا ما الذي أغضبك: أهو الإضرار بالحق والحقيقة أم ماذا؟ فإن لم يكن ثمة ضرر فأنت إنما تثور وتنفعل من أجل نفسك، فردّ الفعل الذي وقع مصدرُه الهوى إذًا، أما المعيار الذي وضعه القرآن الكريم عند التعرض للأذى فهو ﴿اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سُورَةُ فُصِّلَتْ: 41/34)، وعملًا بهذا المعيار فإن معاملة من آذاكم تكون بمحاولة كسرِ شدة غضبه وانفعاله بالابتسامة والوجه الطليق، أما إيذاء المقدسات والحقوق العامة فليس لك أن تعفو عنها؛ لأنك إنما تعفو وتصفح عن حق تملكه فحسب، أمّا حقوق الله تعالى فإنه لم يَكِل إلى أحد حقّ العفو عنها، فليس لأحد -أيًّا كان- أن ينوب عن الله فيها، وخلاف ذلك إساءة أدب مع حقوق الله.
نعم، قد تلبس الأهواء والرغبات لباس الأفكار، فيحسبها الإنسان -بتزيين من الشيطان والنفس الأمارة- فكرًا، وربما يرتكب أخطاءً تحت تأثيرها؛ لاحظوا هذا في بعض المناقشات الفضائية التي ينتقد الناس فيها بعضهم بعضًا بلا هوادة، فهم دائمًا ما يقولون عكس ما يقوله الطرَف الآخر، سواء أكان ما يقوله صحيحًا أم خطأً، وكأنهم انقطعوا للمعارضة فحسب، حتى لو فرضنا المحال وقال مناظره: “بيدي مفتاح الجنة، ادخلوها الآن بإذن الله وفضله”، وانفتحت أبواب الجنة على مصراعيها أمامهم بإشارة منه، ورأوا بأم أعينهم جمال الجنة الأخَّاذ، فلربما يقولون: “كلا، إننا نأبى دخول هذه الجنة، فإن هذا طريق الكسل والعطالة، ينبغي أن نسعى في الدنيا أكثر!” أي إن السفسطة في الرد ديدنهم حتى تجاه الأقوال والأفكار الأكثر منطقية وقبولًا؛ فهذا الضرب من الكلام وراءه الشيطانُ، والباعث عليه الهوى، ويتوهم الإنسان أنّه هو من فكّر وتصوَّرَ كل هذه الأمور.
وقد يسقط بعض المؤمنين في فخ الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء هذا؛ فإذا ذُكّر أحدهم بالموت أَلبس رغباتِه وأهواءه مثل حبّ الحياة وحبّ الأولاد والعيال والتلذّذِ بالدنيا لباس الخدمة، ويقول بدافع من هواه: “ينبغي أن أبقى هنا، وأن أبلّغ الحق والحقيقة لناسٍ كثيرين”، يقول هذا والحق أن على كل مؤمن صادق أن تفيض نفسُه شوقًا إلى لقاء ربّه، وأن يستشعر شوقًا عارمًا للقاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللجلوس على مائدة كل من سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم، ويتنسَّم معهم عبير المناخ وتلك الألطاف، مع ما يجب عليه من الأدب في هذا ليقول: “ربِّ أعوذ بك أن أتعجل لقاءك فأُسيء الأدب معك، فلا علم لي هل آن أواني أم لا؟”.
والوجدان حَكَمٌ مهمٌّ للغاية في هذا الباب، فعلى الإنسان أن يقوِّم كل ما يصدر عنه لاختبار وجدانه تقويمًا دقيقًا، وأن ينضبط بالمعايير الصحيحة في كل اختياراته وقراراته؛ فإن استطاع فعل ذلك فقد اجتنب تلبيس الهوى والهدى والمنطقية والعقلانية بالرغبات والأهواء.
[1] الديلمي: مسند الفردوس، 1/421.
[2] سعيد النورسي: المكتوبات، نوى الحقائق، ص 575.