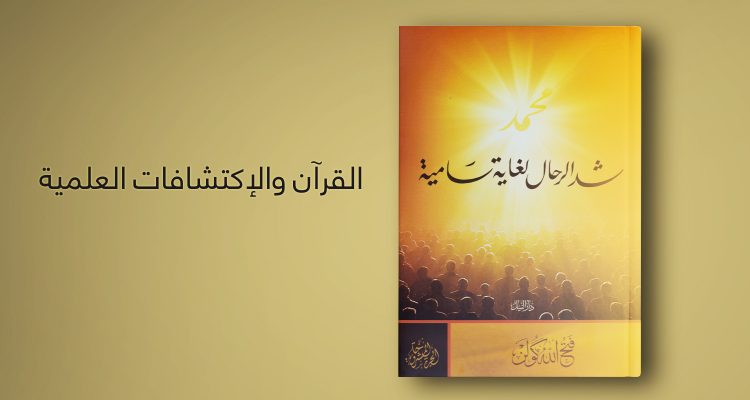سؤال: كلما ذُكر اكتشاف أو اختراع علمي قيل: في القرآن الكريم إشارة إليه، فما المنهج الذي على الباحثين أن يسلكوه عندما يبحثون الحقائق العلمية في القرآن الكريم؟ وما الرسائل التي يحملها هذا القسم من الآيات للباحثين خاصة في العلوم الطبيعية؟
الجواب: لله تبارك وتعالى كتابان اثنان: القرآن والكون، فيستحيل تَعارُضهما.
أجل، فالقرآن المعجز البيان مصدره صفة الله “الكلام”، وكتاب الكون الكبيرُ مصدره صفة الله “القدرة والإرادة”، والقرآن الكريم ترجمةٌ أزلية وقولٌ شارح وبرهانٌ واضح لكتاب الكون، إن القرآن يشرح كتاب الكون فيستضيء الكون بنوره، وبتعبيرٍ آخر: القرآنُ يفسّر الأوامرَ التكوينية والأسرار الإلهية والأفعال الربانية.
ولما كان الفرقان العظيم الشأن يفسِّر الكون ويشرحه، تضمن إشارات لبعض العلوم والفنون التي تبحث في حوادث الكون؛ فبَحَث العلماء منذ قديم الزمان في الآيات التي تشير إلى الحقائق العلمية كما التي في المسائل الإيمانية والتعبدية والأخلاقية، وكانت لهم آرء في تفسيرها وتأويلها.
إليكم مثلًا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله (ت 310هـ/922م): جاءت آراؤه قريبة من نتائج الأبحاث العلمية في زماننا؛ أجل، قام هذا المفسِّر العظيم منذ أكثر من ألف سنة بتفسيرات وتأويلات تفوق المستوى العلمي في عصره، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ (سُورَةُ الْحِجْرِ: 15/22) ذكر تلقيح الرياح للأشجار، والأغرب أنه عرض لتلقيح الرياح السحابَ لينزل المطر، رغم أنه عاش في عصر لم تكن له دراية بعدُ بأن في السحاب شحنات موجبة وسالبة.
وليس ابن جرير فحسب، بل هناك مفسِّرون آخرون أتحفونا بآراء متميزة في تفسير آيات الأوامر التكوينية، غير أن هذه المسألة لم تُفرد بالدراسة في فرع علمي متخصص مستقل إلا في القرنين الأخيرين، بدأ العلماء في زماننا يبحثون المسائل العلمية في القرآن الكريم لكن في ظل العلم الوضعي في هذا العصر.
وممن عرض لتفسير بعض الآيات في الحقائق العلمية: الشيخ محمد عبده (ت 1323هـ/1905م) وأنجبُ طلابه الشيخ رشيد رضا (ت 1354هـ/1935م)، إلا أنهما قد خالفا في بعض آرائهما ما ذهب إليه المفسرون.
وقام العالم المصري طنطاوي جوهري (ت 1358هـ/1940م) بتفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم في ضوء التطورات الحديثة في العلم والفن، وسمى كتابه “الجواهر في تفسير القرآن الكريم”، لا نستطيع القول بأن هذا الكتاب على المستوى المطلوب في في كل موضع، لكنه محاولة لتفسير كثير من الآيات في ضوء نتائج العلم الحديث، وعدّه بعض العلماء موسوعة أكثر منه تفسيرًا.
وكان لعلماء آخرين جهدٌ في هذا الأمر أيضًا.
وحمادى القول أن جهود كثير من العلماء في الآونة الأخيرة فَتحت آفاقًا جديدة في التفسير العلمي للقرآن الكريم، وقامت حوله دراسات كثيرة في العالم الإسلامي، وممن قاموا بدراسات مهمة في هذا المجال الأستاذ الدكتور “زغلول النجار”، فقد تابعتُ برامجه على التلفاز زمنًا طويلًا؛ إن هذا العالم الكبير قامة عظيمة ذات مستوى علمي فائق، سبَرَ أغوار القرآن الكريم، ولم يجد صعوبة في الحديث عن هذا المجال، وعبّر عن المسائل التي يتناولها بدقة تامة.
أما الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي فلم يفصّل كثيرًا في هذا الموضوع، واكتفى بشرح آيات دار حولها جدل في زمانه مثل: انبجاس الماء من الحجر بضربةٍ من عصا سيدنا موسى عليه السلام، وجلب “الذي عنده علمٌ من الكتاب” عرشَ بلقيس؛ لكنه أشار إلى أن الحقائق العلمية الواردة في معجزات الأنبياء هي أقصى ما يمكن أن يصل إليه العلم والاختراع في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن فيها تشجيعًا للناس على الدراسة والبحث، يقول: “إن القرآن الكريم بإيراده معجزات الأنبياء إنما يخطّ الحدود النهائية لأقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر في مجال العلوم والصناعات، ويشير بها إلى أبعد نهاياتها وغايةِ ما يممكن أن تحقِّقه البشرية من أهداف، فهو بهذا يعيّن أبعد الأهداف النهائية لها ويحددها، ومن بعد ذلك يحث البشرية ويحضّها على بلوغ تلك الغاية ويسوقها إليها، إذ كما أن الماضي مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه، فالمستقبل أيضًا حصيلة بذور الماضي ومرآة آماله”[1]؛ وفي رأيي أن وجهة النظر هذه لا بدّ من العناية بها كثيرًا.
منزلة الاكتشافات العلمية في المقاصد العامة للقرآن الكريم
أما عن نسبة الاكتشافات والاختراعات العلمية المذكورة في القرآن الكريم، فقد ذُكرت بقدر منزلة هذه الاكتشافات في المقاصد العامة للقرآن الكريم؛ والنظرة الشاملة إلى القرآن المعجز البيان تكشف أن من أولوياته توجيهَ البشر إلى طريق السعادة الأخروية من خلال بيانه لأركان الإيمان والإسلام، وضمانَ سعادتهم الدنيوية بما شرع من أحكام ونُظُم للفرد والأسرة، أي إنه أعطى الأولوية للمسائل الحياتية التي تهيئ للإنسان سبل السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة.
والنظر إلى المسألة في ضوء هذه المعايير يبين أن مسائل الاكتشافات والاختراعات العلمية جاءت في القرآن في درجة تالية للموضوعات الأساسية الكفيلة بسعادة الدارين، ثم إن القرآن الكريم كتاب يخاطب الناس جميعًا لا أرباب العلوم فحسب، وكما أن موضوعاته عامة للناس جميعًا فكذلك أسلوبه يفهمه غالب الناس، ولو أن القرآن راعى أفق أرباب العلوم فحسب -وهم 5% لا أكثر- وأورد موضوعاته وفقًا لمستواهم، لَما استفاد منه 95% من البشر.
عُقدة الدُّونية والتأويلات المتكلفة
إن من المنهج المستهجَن الواجب تجنبه نسبةَ أشياء غير لائقة بالقرآن الكريم إليه، والتكلفَ في تفسير آيات الحقائق العلمية، والسعيَ وراء التميز فيها، أمّا تقويم حقائق القرآن الكريم في ضوء نتائج العلوم الوضعية فهو سوء أدب مع كلام الله تعالى؛ أجل، إن السعي وراء تطويع تفسير القرآن الكريم للقضايا العلمية والطبيعية -وكأن تلك العلوم واختراعاتها هي الأصل- والاستعانةَ بها لإثبات صحة قضايا القرآن الكريم منهج لا يتناسب مع كلام الله ألبتة.
أمر آخر: إن للقرآن الكريم أسلوبًا خاصًّا به في عرض القضايا العلمية، وهذا الأسلوب مناسب لمستوى كلّ من المخاطبين في الماضي ومن قطعوا مسافات هائلة في العلوم والفنون اليوم، أي ليس هناك أيّ تضاد أو تعارض بين ذكره لحقائق علمية تُكتشف اليوم وكونه آيات بيّنات راعت مستوى فهم الناس في ذلك العصر، فالقرآن الكريم تحدّث مثلًا عن المراحل التي يمرّ بها الجنين في بطن أمه في سورة الحج والمؤمنون وغافر وغيرها، فقرأها الأولون وفهموها واستفادوا منها وَفْقًا لأفق إدراكهم، وأخذت أطباءَ النساء والتوليد في عصرنا الدهشةُ والإعجابُ أمام هذه الحقائق التي بيّنها القرآن الكريم إجمالًا بأسلوبه الخاصّ.
مسألة أخرى لا بدّ من مراعاتها عند تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ظل التطورات العلمية: ينبغي أن يُذكر أنّ في المسألة احتمالات ممكنة وأنه لا قطع فيها، أي قد تتضمن هذه الآيات والأحاديث معاني أخرى، لا سيما أننا لو أجرينا دراسة في مجال جديدٍ وقطعنا بتفسير الآيات فيها قبل أن تتضح ماهيةُ المسائل العلمية التي نتناولها فإن وقوعنا في أخطاء فادحة وارد.
ولا بدّ أيضًا من الرجوع إلى الدراسات السابقة في التفسير، للوقوف على ما ذكرته المراجع الرئيسية حتى الآن في الموضوع.
ومن المفيد هنا التطرق إلى المسألة التالية: ينبغي لمن سيعمل في التفسير العلمي أن يكون بدايةً على دراية كبيرة بالعلوم الشرعية: يتقن اللغة العربية ويعرف دقائقها وقواعدها، ويكون على دراية بعلم التفسير والحديث والفقه وأصوله وأصول الدين… إلخ، وأن يتزود بمعلومات في العلوم الطبيعية بقدر يؤهله لفهم موضوعات هذه العلوم؛ وكذلك يجب على الباحث في العلوم الوضعية أن يتزود بمعارف موسوعية في العلوم الدينية، كما يجب عليه أن يسبر أغوار تخصصه كي يتمكن من الوصول إلى الحقيقة.
والمؤسف أن هذين العِلْمين يسيران الآن في اتجاهين مختلفين، فترى متخصصًا في العلوم الطبيعية يغذّ السير في مجاله ولا يعرف عن الدين إلا قليلًا، ومعنى “لا يعرف” أن التزود بالمعلومات الأولية ليس معناه العلم بالدين، بل إنْ كان يحفظ القرآن كله ويحفظ صحيح البخاري أيضًا فلا يعني هذا أنه على علم تام بدينه، لأنه لا بد من معرفة الأصول حتى يتسنى للمرء الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة.
قلوب مؤمنة عاشقة للاكتشافات
إن الغرب اليوم ينقّب ويدرس الحوادث والموجودات بما يجريه من دراسات في مجال العلوم الطبيعية، وليس لنا إلا أن نحتار ونعجب من إقدامهم وجهودهم في هذه الدراسات، لكنهم لا يعرفون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فصاغوا كلَّ شيء في قالب ضيق في إطار الحدود المادية للأشياء، فجاءت الأنظمة التي وضعوها أقرب إلى المادية أو الوضعية أو الطبيعية، أي إن أفق الباحث الغربي محدود بما تسمح به هذه الأنظمةُ التي ترى المادة كلّ شيء.
يؤكد الباحثون في تاريخ العلم والفلسفة أن العلماء المسلمين قاموا بدراسات مذهلة في العلوم والفنون حتى القرن الخامس الهجري، وهذه الفترة هي عصر نهضتنا؛ أجل، لقد أجرى العلماء المسلمون دراسات خطيرة في الطب والهندسة والفلك يوم لم يكن للغرب أي تصور عن مثل هذه المسائل، وابتكروا اختراعات هائلة، لكن منذ عشرة قرون أي بعد القرن الخامس الهجري نأسف أنا أهملنا هذا الأمر وتركناه حيث هو، فاستلم الغرب الراية وتقدموا نحو الأمام كثيرًا، وبهذا تسنى لهم وضع الحجر الأساس للنظام الحالي للعلوم الطبيعية، فأسَّسوا الأمر على أفكارهم، وقيّموا الأشياء والأحداث وفقًا لآرائهم.
إن للعقل المجرد حدًّا ينتهي إليه في إدراك الحقائق، فهو إنما يدرك قسمًا منها فقط، وله حد معلوم في توضيحه للمسائل محل البحث، لكن هناك مسائل لا تُفهم إلا بالوحي، والقولُ الفصلُ فيها للوحي وحده.
إذًا لا بدّ من إعادة بناء النظام العلمي والبحثي على توازن صحيح يراعي الروح والميتافيزيقا إلى جانب المادة، وعندئذ يمكنكم أن تقيّموا بدقة الأشياءَ التي دققتموها بالتلسكوب والميكرسكوب وأشعة إكس.
ولا يعني هذا أننا نقول: إنّ كلّ ما اكتشفه الغرب خطأ؛ لأن لوجود العقل حكمة، فكم مِن حقائق ما اكتُشفت إلا اعتمادًا على العقل، فوجوده له حكمة، لكن لا بدّ من إعادة دراسة جميع النظريات المكتشفة حديثًا استنادًا إلى المادة فقط، وتقويمها بالتحليل والنقد والتمييز بين صحيحها وسقيمها، وهذا منوط بإعادة بحث العلوم الوضعية في مدار القرآن الكريم وفي إطار عقيدتنا، ولا ينجح في هذا إلا من يفهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا.
ويتحدث البعض في هذه المرحلة عن استيراد العلوم و”أَسْلَمَتِها”، وهي محاولة قاصرة لا تُنتج، فهي كالثوب المستعار؛ والواجب هو تناول المسائل بأصولها، وتقويمها بالتحليل والنقد في ضوء القاسم المشترك بين العقل السليم والحس السليم والخبر المتواتر؛ وبهذا نصل إلى نتائج سليمة، وهذا مرهون بتربية عُشّاق الحقيقة والعلم والاختراع.
فإن رغب المسلمون في تأليف كتاب تفسير للقرآن الكريم يخاطب مستوى إنسان العصر فلا بدّ أولًا من تشكيل لجنة من المتخصصين لهم باعٌ واسع في كافة العلوم، فتتدارس المسائل فيما بينها أولًا، وتميز الصحيح من السقيم في ضوء معايير علم الأصول وعلم أصول الدين، ولا تثبت أي تفسير أو تأويل إلا بعد اتفاق الوعي الجماعي.
فإن شُكلت لجنة كهذه من المتخصصين في العلوم الإسلامية والعلوم الوضعية فلن يشوب هذا العمل -بعون الله وفضله- تهافت أو خيالات، ولن يكون عرضة للتأويلات المتكلفة.
أملنا ورجاؤنا أن يقدِّم علماءُ عصرنا الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان كلَّ جهودهم في هذا، ويقولوا ما ينبغي قولُه في التفسير المنشود استنادًا إلى كلّ تجاربهم؛ وهذا بعضُ ما للكتاب العزيز القرآن الكريم علينا -نحن مسلمي اليوم- من واجب الوفاء والولاء له.
[1] سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة العشرون، المقام الثاني، ص 278.