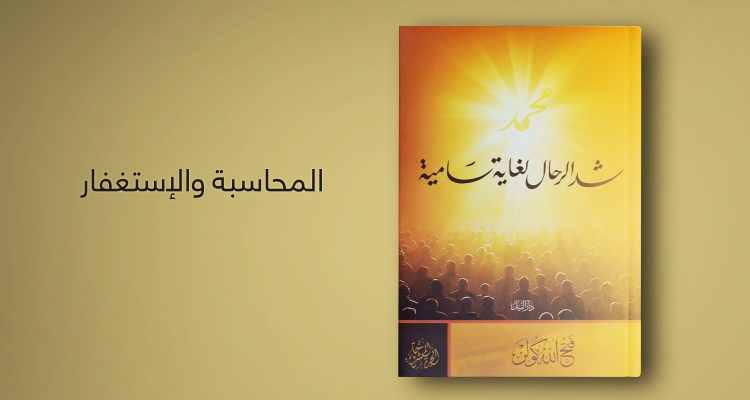سؤال: ما المعايير التي ينبغي أن يلتزم بها المؤمن عند التعرّض للبلايا و المصائب حتى يمكنه اجتيازها بشكل يتلاءم مع سلوكه الإيماني؟
الجواب: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 4/79)، فكلّ مَن يصدِّق بهذا البيان عليه أن يعزوَ أولًا كلَّ مصيبة وبليّة ألمّت به إلى أخطائه وذنوبه، فمثلًا لو سقط ما في يدِك من طبقٍ أو كوبٍ على الأرض فاعلم أن هذا من نفسك، واحمله على انحرافٍ في تعقلك أو تصورك أو تخيّلك في تلك اللحظة، ثم اسأل نفسك: “هل فعلت ما لا يليق بالحضرة الإلهية حتى أُصبت بمثل هذا؟”، لأنه لا تقع أي حادثة في الكون عبثًا؛ فلو نظرنا في الحياة بإمعان فسندرك أنّ أية مصيبة ولو صغيرة جدًّا تعد إنذارًا أو تحذيرًا، وفي كل حادثة عبرة، فإنْ فهمها الإنسان وتوجّه إلى الله وعمل من الخير ما يكون كفارة لهذا البلاء، فقد يكون هذا وسيلةً لدفع ما هو أعظم من الحوادث والبلايا بفضل الله وعنايته؛ أجل، إنّ كل مصيبة من هذا النوع بمنزلة تنبيه وكفارة في الوقت ذاته، فالكوبُ المكسور مثلًا قد يحطِّم سلسلةً من البلايا والمصائب، ويطهِّر الإنسان من بعض ذنوبه، كما جاء في الحديث الشريف: “مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ”[1].
البحث عن المجرم الحقيقيّ
والواقع أننا لا نستطيع أن ندرك دائمًا بشكل جليّ صريح ما وراء الحوادث من أسباب، لكن على القلب المؤمن أن يفتِّش عن أخطائه وعيوبه أولًا حتى في الحوادث الغامضة التي نزلت به، فمَن يتهم نفسه يكون قد خطا خطوة مهمة في البحث عن المجرم الحقيقي، أمَّا إن برّأ نفسه وراح يبحث عن المجرم في الخارج فلن يجده وإن قضى عمره كلّه في البحث عنه، وبذلك ينفق عمره في اتهام الآخرين.
وفي هذا يقول الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي: “والآن عرفتُ السبب الحقيقي في قيامهم بظلمي وتعذيبي، أقول وكلي أسف: إن ذنبي هو اتخاذي خدماتي القرآنية وسيلة للترقي المعنوي والكمالات الروحية”[2].
إنّ ما ذكره هذا الإنسان الكامل لَيكشف لنا عن مدى عمق محاسبته لنفسه، ومعنى كلامه أنه لا ينبغي أن نتّخذ من خدمة الإيمان والقرآن سبيلًا إلى الألطاف والعطايا الإلهية أو طريقًا لبلوغ مرتبة الولاية أو حتى للوصول إلى غايات سامية كالفوز بالجنة والنجاة من النار، فمَن جعل هذه الأمور منتهى غاياته في خدمته الإيمانية والقرآنية أفسد الأمر؛ لذا لا بدّ أن تكون غايتنا الأمُّ هي تحقيق الإخلاص ونيل الرضا الإلهي، ولا ينبغي أن تتغلب الرغبة في دخول الجنة والخوفُ من النار على تحقيق العبودية الحقيقية، ولا جرم أن الله تعالى سيجزينا بالثواب الجزيل على ما قمنا به من أعمالٍ مزدانة بالإخلاص، هذا وإنّ عباداتنا قاصرة محدودة أما نعم الله تعالى فهي كثيرةٌ لا تُعَدّ ولا تُحصى، هب أنك ملِك العالم ولديك تريليونات، فلا بدّ أن يعتريك الخوف عندما تنفق منها لأن الإنفاق ينقص ما في يدك، أمّا نعم الله تعالى فهي كثيرة حتى لو حاول العادّ إحصاءها لما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فما تسألونه ليس شيئًا مقارنة بما سيؤتيكم الله تعالى من فضله.
لا بدّ من تجنب أي نوع من الشكوى
إن مَن لا يستطيع إدراك الأسباب الحقيقية وراء البلايا والمصائب التي يتعرض لها تبدر منه كلمات تنمّ عن شكوى الله تعالى إلى الناس؛ إن للإنسان أن يشكو مَن ظلمه إلى المسؤولين والأوساط العامة إحقاقًا للحق، أي مَن لحق به الظلم له أن يشكو مَن ظلمه إلى الحقّ والخلق، ثم ينتظر حكم الحقّ تعالى وما يجريه على ألسنة الناس، لكن الإنسان ليس له ألبتة أن يشكو اللهَ سبحانه وتعالى إلى خلقه، وناهيك عن القول الصريح فإن التأفف والتضجر من المصائب والبلايا يُعَدّ أيضًا شكوى، فليتجنّب العبد أي كلمة أو سلوك يوحي بالشكوى من الله سبحانه وتعالى صراحةً أو ضمنًا.
أما عدّ الإنسان هذا البلاء أو تلك المصيبة من نفسه فأمر مرهونٌ بمحاسبته لنفسه محاسبة شديدة، والمحاسبة رهنٌ بإيمانٍ بالله والآخرة راسخٍ في القلوب.
وفي الأثر عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا”[3].
وفي هذا دلالة على أنّ محاسبة النفس ذات علاقة وثيقة بالإيمان بالحساب في الآخرة.
ولو تأملنا أوراد الأئمة العظام وأذكارهم لرأينا أنهم قد أنفقوا حياتهم في محاسبة شديدة للنفس: محاسبةٍ نابعة من خشية الحساب في المحكمة الإلهية الكبرى، وربما لم نحاسب أنفسنا ونزجرها عن غيّها طول عمرنا كما كان يحاسبها الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في وردٍ واحد من أوراده.
وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي أيضًا يزجر نفسه زجرًا عنيفًا، ثم لا يغلق باب الرجاء، فيتوجّه إلى الله طالبًا العفو والمغفرة بما معناه: “كم عبدٍ لجأ إليك وما عاد خالي الوفاض”، ومن ذلك قوله:
“يا ذا الجلال والإكرام، يا محيطًا بالليالي والأيام، أشكو إليك من غمّ الحجاب وسوء الحساب وشدة العذاب، وإن ذلك لواقعٌ ما له من دافعٍ إن لم ترحمني، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، ولقد شكا إليك يعقوب فخلَّصتَه من حزنه، ورددتَ عليه ما ذهب من بصره، وجمعتَ بينه وبين أولاده… ولقد ناداك نوحٌ من قبل فنجَّيتَه من كربه… ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفتَ ما به من ضُرّه… ولقد ناداك يونس فنجّيتَه من غَمِّه… ولقد ناداك زكريا فوهبتَ له ولدًا من صلبه بعد إياس أهله وكبر سنه… ولقد علمتَ ما نزل بإبراهيم خليلك فأنقذتَه من نار عدوه… وأنجيتَ لوطًا وأهلَه من العذاب النازل بقومه… فها أنا ذا عبدُك، إن تعذبني بجميع ما علمتُ من عذابك فأنا حقيقٌ به، وإن ترحمني كما رحمتَهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأَحَقُّ مَن أكرمَ به، فليس كرمُك مخصوصًا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذولٌ بالسَّبق لمن شئتَ من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك”[4].
وأذكّر هنا بوِرْد مهمّ جاء في “القلوب الضارعة”[5]، ينبغي الأخذ به في هذا الباب، وهو “حِزب الاستغفار الأسبوعي” للإمام الحسن البصري رحمه الله[6]، فقد أفردت هذه الشخصيةُ العظيمة استغفارًا خاصًّا لكل يوم في الأسبوع، وقد بالغ في ذكر عيوبه وهوّل من أمر ذنوبه، والحسن البصري كما هو معروف علَمٌ من أكابر التابعين، نهل من نبع الصحابة، وتصدى للفِرَق الباطلة المختلفة في البصرة حتى دحرَها، ويمكن أن يقال عنه: إنه غلَّق أبوابَه عن الذنوب والآثام حتى في رؤاه وأحلامه، وممن نهل من علم هذا البطل الإمامُ الأعظم أبو حنيفة النعمان عظيم الشأن؛ ومع تلك الخصائص كلها نراه يهوّل من أمر ذنوبه وعيوبه حتى إنك لتحسب أنه أعتى مجرم اقترف ذنبًا في الدنيا، فتراه يتوجّه إلى الله بلسانِ المفلس وحالِهِ وكأنه من ذوي الإصرار على اقتراف الذنوب، وهكذا يمضي في محاسبة نفسه كل يوم.
المحاسبة تفضي إلى الاستغفار
محاسبة النفس على الأخطاء والعيوب تحمل على التوبة والاستغفار، ففي سورة الفرقان أورد الحقُّ سبحانه وتعالى ضروبًا من الذنوب، وأوعد مرتكبيها بالعذاب في الآخرة، ثم إنه -رغم ما ارتكبوا من الموبقات- بَشَّرهم بما سيحظَون به في الآخرة إن هم أنابوا إلى ربهم وثابوا إليه مرة أخرى:
﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (سُورَةُ الفُرْقَانِ: 25/70).
دلت هذه الآية أنّ مَن تشوّهت روحه بما ارتكب من الذنوب إن تاب واستغفر من فوره، وعقد العزم على التطهر الحقيقي، وجدّد إيمانه، ولازَم العمل الصالح، بدّل اللهُ تعالى سيئاته حسنات؛ أجل، سيمحو اللهُ سبحانه وتعالى ذنوب هذا العبد أيًّا كانت، سواء اقترفتها يداه وقدماه أم عيناه وأذناه، أو كانت امتعاضًا في وجهه أو إيماءً، فإنه سبحانه يمحوها جميعًا ويبدّلها حسنات.
وأشار الأستاذ بديع الزمان إلى معنى تحتمله هذه الآية: يبدّل الله قابليات الشر لدى الإنسان إلى قابليات للخير[7]؛ وهذا يعني أن التوجه إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة والأوبة يترتب عليه أن تتبدل ميول الشر في طبيعة الإنسان إلى ميول للخير والحسنات.
الاستغفار: ماء الحياة للبعث من جديد
عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ، فَلْيُكْثِرْ فِيهَا مِنَ الِاسْتِغْفَارِ”[8].
وقد بلغ سيد الأنام عليه أفضل التحيات وأكمل التسليمات ذرى هذا الأفق، يقول: “وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (وفي رواية: مِائَةَ مَرَّةٍ) “[9].
وتفسير هذا الأمر برقيّه الدائم في أفق معرفته ممكن، وكذا تفسيره بأنه أسوة رائد لأمته، فكلّ راعٍ في جماعة أو لجنة تغدو سلوكياته وتصرفاته الطيبة والقبيحة قدوة لمن خلفه؛ فلو أن مدير المؤسسة أرسى مبادئ نفعية يتحرى بها منافعه الشخصية، فسيجرّ الناس من ورائه إلى السرقة، وإن تحرّى الخير والبرّ على الدوام كان عاملًا مؤثرًا في توجيههم إلى الخير؛ وبهذه النظرة يمكننا أن نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله مائة مرة في اليوم، فوجَّه أتباعه بسنّته هذه إلى العروج بأجنحة الاستغفار نحو آفاق تحلّق فيها الملائكة.
نعم إنّ المرء إذا ما أمعن النظر في نفسه ومسيرته وجد -أيًّا كان مستواه- كثيرًا من الأخطاء والعيوب تستوجب الاستغفار؛ فقد تكون عينه زلّت بنظرة أثناء سيره من مكان إلى آخر، أو ربما أُثني على أحدٍ أمامه فهمّ بالتهكم عليه والسخرية منه، وقد يكون سقط في مستنقع الغيبة وهو لا يعي… فالاستغفار الاستغفار، فإنّ أي ذنب من هذه الذنوب قد يُهلك صاحبه، فلنضع هذا نصب أعيننا.
وأشار الأستاذ النورسي إلى أن الذنوب وإن كانت صغيرة قد تُوبِق الإنسانَ، فقال: “احذر! انتبِه إلى موضع قدمك، وخَفْ من الهلاك، فلا تهلك في أَكلةٍ، أو كلـمة، أو طَرْفة، أو شارة، أو بقلة، أو قبلة… فتَهلِكَ معك لطائفُك العظيمة”[10].
والناس في الدنيا يُخضعون كل شيء لحساب دقيق حتى أعمالهم الدنيوية، فيقومون بدراسات واسعة حول مشروع ما، ويستثمرون أموالهم في ضوئها، ثم يقوِّمون الوارد والمصروف في آخر كلّ شهر، ويقررون هل هذا العمل مربحٌ أم لا؛ فإذا كنّا نقوم بهذه الحساب والتقويم في أمور الدنيا الفانية أليس حريًّا بنا أن نجعل لحياتنا الأبدية حسابًا أكبر وأعظم؟.
ومن المفيد هنا أن أنوه بأمر آخر في هذا الباب، يقول الأستاذ بديع الزمان رحمه الله رحمة واسعة: “إن الدعاء والتوكل يمدّان ميلان الخير بقوة عظيمة، كما أن الاستغفار والتوبة يكسران ميلان الشر ويحدّان من تجاوزه”[11]؛ أي إن التوبة والاستغفار يحولان دون ميلان الإنسان إلى الشر، فهما مطرقة تشدخ رأس الذنوب والمعاصي وتقطع دابرها، والدعاء والتوكل يعززان ميول الإنسان إلى الخير؛ فمَن استمسك بجناحَي التوبة والاستغفار والدعاء والتوكل ارتقى مباشرة إلى أوج الكمالات الإنسانية، بل قد يجد نفسه خلف مفخرة الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأستدرك فأقول: ألا ليت الإنسان يقيم سدودًا تحول دون تخريب حياته القلبية والروحية ابتداء، فهذا أفضل من أن يشتغل بالترميم، لأن ترميم الشيء الخرِب وإعمارَه صعب جدًّا.
وأذكر أنني عندما ذهبت إلى مدينة “أَدِرْنَه” رأيتهم قد بدؤوا في ترميم مسجد “السليمية”، وقضيت هناك ست أو سبع سنوات ولم ينته الترميم،، بينما تمّ بناء هذا المسجد في عهد السلطان سليم الثاني في ست سنوات؛ نعم، إن ترميم الشيء الخرب ليعود كما كان أصعب كثيرًا من إعادة بنائه؛ فليس من السهل إذًا إعادة صياغة مَنْ تشوّهَت رُوحه بذنوبه، فليحيَ المرء حياة تحول بينه وبين الدمار والخراب ابتداءً، ثم يمضي في حياته يقظًا حذرًا من الذنوب والآثام.
[1] صحيح البخاري، المرضى، 1؛ صحيح مسلم، البر والصلة، 49.
[2] سعيد النورسي: السيرة الذاتية، ص 475.
[3] عبد الله بن المبارك: الزهد، ص 103؛ ابن أبي شيبة: المصنف، 7/96.
[4] القلوب الضارعة، ص 311.
[5] القلوب الضارعة:هو كتاب يجمع بين دفتيه مختاراتٍ من أدعية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والصحابة الكرام وكبار الأولياء والصالحين. ومعظم هذه الأدعية التي جاءت بهذا الكتاب وأشرف على جمعها الأستاذ محمد فتح الله كولن مقتبسةٌ من كتاب “مجموعة الأحزاب” للشيخ ضياء الدين الكومشخانوي من علماء العهد الأخير للدولة العثمانية.
[6] القلوب الضارعة، ص 142.
[7] سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة الثالثة والعشرون، المبحث الثاني، ص 358.
[8] الطبراني: المعجم الأوسط، 1/256؛ البيهقي: شعب الإيمان، 2/152.
[9] صحيح البخاري، الدعوات، 3؛ صحيح مسلم، الذكر والدعاء، 41.
[10] سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة عشرة، المذكِّرة الرابعة عشرة، ص 187.
[11] سعيد النورسي: الكلمات، الكلمة السادسة والعشرون، المبحث الثاني، ص 536.