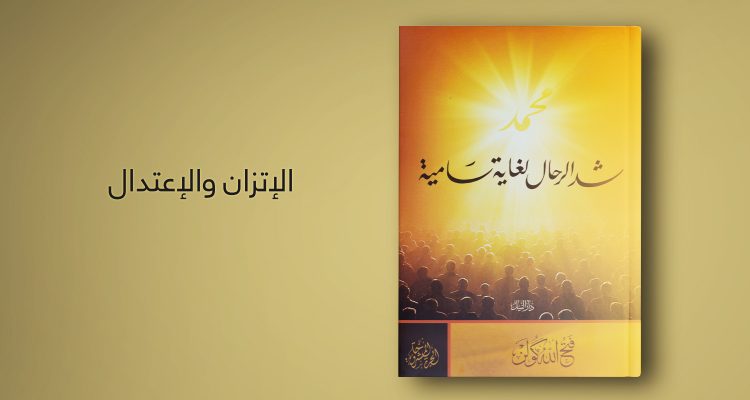سؤال: عصرنا هذا فيه انحرافات فكرية خطيرة في كل ساحات الحياة تقريبًا، وتقع فيها ألوان من المغالاة، فما الذي ينبغي مراعاته حتى لا يقع منا إفراط أو تفريط في هذا الصدد؟
الجواب: إن الاتزان والحفاظ على الاعتدال أمر مهم للغاية لنتمكن من أن نجعل الدين حياةً لحياتنا، ونطبقه كما يريد الله؛ ذلك أن الانزلاق إلى الإفراط أو التفريط إنما يكون حين يُفتقد الاتزان، وعندئذ تتكون دائرة فاسدة؛ إذ إن الإفراط يولّد التفريط، والتفريط يولّد الإفراط؛ والواقع أن السبيل إلى السلامة من الإفراط والتفريط هو اتباع سنة مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الصراط المستقيم، فهو من كان يوصي أمّته دائمًا بالاعتدال.
الصراط المستقيم
يُعرَّف الصراطُ المستقيم في منظومة الفكر الإسلامي بأنه اعتدالُ كلٍّ من “القوة الشهوية”، و”القوة الغضبية”، و”القوة العقلية”، فاعتدال هذه القوى جميعًا يعبّر عنه بـ”الصراط المستقيم”؛ وثمة أمور أخرى كثيرة مثل المنافسة والتنافس والنية والنظر وغيرها يمكن وزنها بهذا الميزان، أو فلنقل: إنّ لكلّ ما جُبل عليه الإنسان من طباع -حسنة كانت أم سيئة- صراطًا مستقيمًا.
مثال ذلك “النظر”، ومعناه قراءة الأشياء والحوادث وتقييمها، فالناظر المتفائل يمثل الإفراط، والمتشائم يمثل التفريط، أمّا الناظر إلى حقيقة الأمور فهو وسط بينهما؛ ومعلومٌ أن المتفائل هو من يتغاضى عن الشرور والشناعات ويتناول كل شيء من منظور حسن جميل فحسب، أما المتشائم فهو من يرى كل شيء سيِّئًا حالكَ السواد، وأما الناظر إلى الحقيقة أو الناظر بالهُدى فإنه يسعى ويجهد كي يرى كل شيء على حقيقته؛ والواقع أن “مَنْ حسُنت رؤيتُه حَسُنتْ رويّتُه وجمُل فكرُه؛ ومن جمُل فكرُه تمتَّع بالحياة وعاش حياة طيبة” كما ذكر الأستاذ بديع الزمان في “نوى الحقائق”.
هذا ويلزم -حتى في الأشياء المستقبحة- العناية بالأفكار الطيبة، والتقييمات الجميلة طالما أمكن التأويل، لكن هذا لا يعني تجاهل الواقع، والعيش في عالم الخيال والأحلام؛ إذًا ما ينبغي فعله هو رؤية كل شيء كما هو دون هروب من الحقائق ولا تجاهلٍ لها، ودون الوقوع في تشاؤم أو يأس، وهذا هو الاتزان في “النظر”.
والواقع أنّ النفس المستقرّة في ماهية الإنسان، التي تبدو كأنها شرٌّ في الظاهر تصبح خيرًا له إن استقام على الصراط المستقيم؛ بل إن الشيطان الذي يُضِلّ الناس ويفتنهم بوسوسته وتزيينه، إن وَعَيْنا الحكمة من خلقه فربما يكون ذلك دافعًا للمرء لأن يتوجه إلى الحق تعالى دائمًا ويلجأَ إليه؛ أمَّا إذا ما نُظر إليه -والعياذ بالله- كأنه قوة مستقلة، فمعنى ذلك أنه قد نُسبت إليه قوة وسلطة وهْمية كتلك التي يتوهّمها قومٌ في النور والظلمة -وهذا هو الضلال-؛ فهم يدّعون أن كلًّا منهما مصدرُ قوة قائم بذاته، وأنّ النور لا ضرر منه، وأنه يتعين إسعاد من يمثلون الظلام؛ فهم من أجل إثبات هذا الفهم المعوجّ يحملون أوزارًا لا يبلغها عقل ولا خيال؛ وقد عمَد عبدة الشيطان أبناء الفلسفة نفسها إلى استرضاء الشيطان ليتقوا شرّه كما يزعمون؛ نعم، من الإفراط أن ننسب لمخلوقٍ عاجزٍ -لا سلاح له ولا سلطان علينا إلا الوسوسة والتزيين- قوى وقدرات لا تكون إلا للخالق، ومن التفريط أن نتغافل عن همزه ولمزه، ونستهين بوسوسته وتزيينه، بل إن في هذا تجاهلًا لهدي الكتاب والسنة وإعراضًا عنهما؛ وذلك أنَّ الشيطان عدوّ مبين للإنسان، فإن ظل الإنسان غافلًا ولم يُعطِ إرادَته حقَّها فقد يخسر سعادته الأبدية على يد ذلك المخلوق الغدّار المكّار.
ضحايا النجاح
كما أنَّ التوازن مهمٌّ للغاية في توقّي ما هو شرّ مُهلك هو مهمٌّ كذلك في توخّي الحذر إزاء ما يُساق إليك من خيرٍ، أي كما ينبغي التوازن في استغلال المشاعر الجانحة إلى الشر وتوجيهها نحو طريق الخير، ينبغي أيضًا لزومُ الصراط المستقيم وتجنب الإفراط والتفريط في أعمال البدن والروح في الإيمان والعبادة والأخلاق؛ فمثلًا لا بدّ للمرء أن يتحرّى الدقة والكمال في كلّ ما يقوم به من عبادات وأعمال من صلاة وزكاة وصوم ودعاء وكذا التفكّر والذكر والتدبّر؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه الحكيم: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (سورة التَّوْبة: 9/105)، فهذا أمرٌ بأداءِ الأعمال على الوجه الأكمل أداءَ من يعلم أن أعماله معروضة بين يدي الله ورسوله والمؤمنين أرباب البصيرة.
والخلاصة أن على المرء وهو يؤدّي أي عبادة أن يكون شغله الشاغل “يا ترى! هل أدّيتها كما ينبغي؟”، وأن يسعى دائمًا إلى الكمال، وينبغي أن لا ينسب النتيجةَ إلى نفسه أبدًا ولو أدّى عباداتِه على أكمل وجه، وألا يغترّ ويسيء الأدب بين يدي ربّه بأن ينسب الفوز والنجاح إلى نفسه؛ لأن الله تعالى هو خالق النتيجة.
وهكذا فإن كان من التفريط التقصيرُ في أداء العبادات والتكاليف، وأداؤها في غفلة وفتور بلا عناية أو اهتمام؛ فمن الإفراط اغترارُ المرء بما بذله من جهد فيما قام به، وتجاهُلُه لتوفيق الله له بنسبته النتيجة إلى نفسه، فهو بذلك يسيء الأدبَ بين يدي الله تعالى؛ فُيرجف إيمانه ويُودي بنفسه في أودية الشرك والنفاق؛ فهو وإن بذل بادئ الأمر جهدًا عظيمًا وتحرى الدقّة والكمال في عمله، إلا أنه استغلّ في النهاية ما حققه من نجاح في الشهرة والسّمعة.
وحقيقٌ بمن نجح وتفوَّق في عمل عمله في سبيل الله أن يتّسم بالتواضع والمحو والحياء، وأن يردّد كما يقول محمد لطفي أفندي:
هُوَ أَمْرٌ فَوْقَ حَدِّي وَأَنَا عَبْــدٌ ضَعِيفٌ لَسْتُ أَهْلاً للكَرَمْ!
فَلِمَاذَا كُلُّ هَذَا اللُّطْفِ وَالإِحْــسَانِ؟
أجل، على الإنسان أن يؤدي ما يقوم به على أكمل وجه، وأن يحقّر نفسه ويذلّها كما يضرب الدبّاغ الجلد بالأرض يهذّبه ويحسّنه؛ وعليه ألا ينسى أبدًا أن ما أحرزه من فوز ونجاح قد يكون ابتلاءً واستدراجًا، وأن يخشى دائمًا الضلالَ والهلاكَ.
انظروا، لقد ظهر مَن يدّعي النبوة أمثال الأسود العَنْسِيّ ومسيلمة الكذاب في عصر أضاء فيه النور الحقيقي كلَّ مكان، وأفَلَت دونه الشموسُ والأقمار، فهؤلاء البؤساء كانوا ضحايا لقدرات ومهارات اكتشفوها في أنفسهم، فانسحقوا وهلكوا تحت براثن الكبر والأنانية.
دعاوى المهديّة في عصر الأنانية
لا جرم أن هذا الضرب من الزيغ والضلال لا يختص بعصر دون آخر، فقد وقع على شاكلتها كثيرٌ في كلّ عصر ومصر؛ وفي عصرنا أناس مفوَّهون إلى حدٍّ ما، تراهم يدبّجون شيئًا في سطر أو سطرين، وربما قطعوا مسافةً يسيرةً في المجاهدة، ثم إذا بهم يضيّعون التوازن ويحاولون أن يجعلوا من أنفسهم قِبْلة وبوصلة، ويقومون ويقعدون بـ”الأنا” و”حبّ الذات”؛ ولما رأوا السُّذَّج من الناس يتحلّقون حولهم رغم ضآلة ما قاموا به ظنوا أنفسهم أقمارًا تهدي السالكين، وكأنّ هذا هو السبب في كثرة من يدّعون المهدية في زماننا، أعرف منهم خمسة أو ستة في تركيا، ومنهم ثلاثة أرادوا أن يلتقوا بي.
جاءني منذ فترة يسيرة شابٌّ في الثانية والعشرين من العمر، وقال: “أستاذي، كنتُ أحسب نفسي حُسينيًّا فقط، ثم ثبت بالدراسة والتمحيص الدقيق أنني حَسَنِيٌّ أيضًا”؛ فتحدثتُ إليه عن المحو والتواضع، وأنّ التكبّرُ وحبّ الظهور أمارة الصِّغار، أما العظام فأمارتهم الانحناء تواضعًا كما العصا.
وبعدما ذكرتُ له ما ذكرتُ انصرفَ وأنا أحسب أنه قد اقتنع، لكنه لما خرج قال: “حسنًا يا أستاذي، لكن ماذا عسى المرء أن يفعل إن كان مكلَّفًا لا خيار له في هذا الأمر؟”.
ليس هناك مقام سوى النبوة يجب على صاحبه إعلانُه والإبلاغ عنه، حتى وإن كان هذا الشخص أبا حنيفة أو الشافعيَّ فليس من وظائفه إبلاغ الناس عن كونه أبا حنيفة أو الشافعيَّ، والمهديةُ كذلك؛ لكن يتعذر إقناع من حبسوا عقولهم في تصوّرٍ كهذا؛ نسأل الله أن يهدي كل مغرور أنانيّ إلى الصراط المستقيم.
وأذكِّرُ أخيرًا إلى احتمال وجود مثل هؤلاء المدَّعين ضمن دائرة صالحة مركزُها المحو والتواضع والإخلاص ونكران الذات، وإقناعُهم أصعب لأنهم يشتقون أنانيتهم الذاتية من أنانية الجماعة، فيقول أحدهم: “كنتُ إلى الآن تلميذًا، وكان لفلان ألف من الملائكة والأرواح، ثم إن تسعمائة منهم فارقوه وأتوني”.
وهناك أمثلة كثيرة مختلفة في كل عصر على مثل هؤلاء الذين قد يتعرضون للإغواء والخداع، ويصبحون أسرى للنفس والشيطان.
فلا يغيبنَّ عن خَلَدِ أحدكم أن انتشار الأشواك حتى في وقت نبات البذور وازديان البساتين بالورود أمر محتمل، فالحذر واليقظة والبصيرة وإن كنت تسير في بستانٍ كهذا.
أجل، ظهورُ الضالّين المُضِلِّين وارد في كلّ وقت، فيتبعهم السذّجُ من الناس؛ وكما تنمو الأشواك مع الورود فقد يصخب العقعق عندما تغرّد البلابل، وربما تعجب العقعقةُ أناسًا لم يسمعوا شدو البلبل الرائع ولم تألفه آذانهم.
إنّ سدّ الباب لئلا ينخدع أحد بادعاءات هؤلاء يقتضي أن نتحرك بحذر ويقظة دائمة، وأن ننظر إلى الحوادث ونرصدها ألف ألف مرة بفِراسةٍ كتلك التي عند سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.