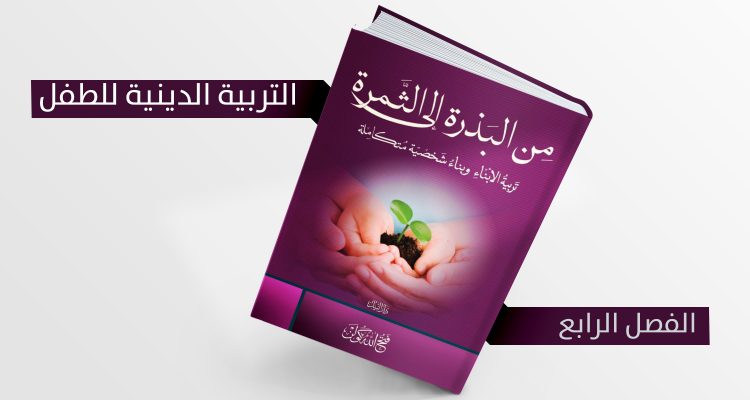كما أوضحنا سابقًا فإن الزواج مسألة بالغة الأهمية، ومن ثمّ يجب الوقوف عليها بقدر جدّيتها وأهميتها، ولذا يجب أن يأخذ المقبلون على الزواج في اعتبارهم أنهم سيُصبحون في وضع المعلّم والمعلّمة لأولادهم، لذا فعليهم ألا يفكّروا في الزواج إلا عندما يصلون إلى المستوى والعمر الذي يؤهلهم للقيام بهذه المهمّة الكبيرة.
فها هو الإمام جعفر الصادق يطلب من تلاميذه تأخير زواجهم لمدّةٍ معيّنة، كما يمنع الإمامُ الأعظم أبو حنيفة النعمان طالِبَه الإمام أبا يوسف من الزواج لفترةٍ معيّنة قائلًا له: “عليك أن تُكمل بدايةً مرحلة التربية والتعليم، وتتعلّم ما يجب عليك تعلّمه إلى أن يحين الوقت الذي تتزوج فيه، وإلا ما استطعتَ أن تكمل تحصيلَك العلميّ، زد على ذلك أنه لا بدّ أن يكون لديك عملٌ تنفق منه على أسرتك بالحلال، فإن تجاوزتَ هذه المرحلةَ اتضحت مسيرتك الحياتية”.
أجل، إن أبا حنيفة ينصح تلميذه الذي وصل إلى مقام قاضي القضاة في عهد العبّاسيّين بهذه النصائح.
أما ما يجب فهمه من هذه النادرة فهو أن مؤسّسة الزواج مؤسّسة مهمّة جدًّا، ومن ثم تجب العناية بالمقبلين عليها؛ وهل تُرى وصلوا إلى المستوى الذي يؤهّلهم ليكونوا معلّمين ومربّين لأطفالهم؟ وهل هم في مستوى وعمرٍ يسمح لهم بمشاركة إنسان آخر الحياةَ؟ وهل يملكون الأدوات اللازمة لتهيئة أبنائهم وفقًا لعالمنا الفكري؟
فإن أجاب المُقبلون على الزواج بـ”نعم” على هذه الأسئلة وكانت لديهم ثقةٌ في أنفسهم استطاعوا القيام بهذا الأمر بكلّ أريحيّة، ولكن إن كانوا عاجزين عن إدارة أنفسهم ولا يستطيعون أن يتوافقوا مع بضعة أشخاص على بعض المسائل المشتركة، ويثيرون القلاقل كلّ يوم، فلا يمكن أن يُقال إنهم قد وصلوا بعدُ إلى المستوى الذي يؤهّلهم للزواج وتربية الأطفال.
ينبغي لكل فردٍ من أفراد الأمّة أن يكون الإسهامُ في إقامة مستقبل أمّته المثالي أحدَ أهدافه المنشودة، وهذا منوطٌ بوجود الفرد المثالي والأسرة المثالية.
أجل، لن يستطيع تحقيق مثل هذه الغاية إلا الذين هم كالكعبة المشرّفة في طهارة قلوبهم، وكقِمّة “إفرست” في علوّ مقاماتهم الرفيعة، والذين امتدت بنيتهم الشعورية كعمودٍ نورانيٍّ إلى سدرة المنتهى، فهذا الأمر ليس من شأن النواصي القذرة، والأفئدة الصدِئة، والعاصين لرب العباد سبحانه وتعالى، أما الأجيال النّيّرة العامرة بالإيمان والتي تكاملت داخليًّا وخارجيًّا فستُحقِّق هذه الغايةَ بفضلٍ من الله وعنايته، وأريد أن أكرّر هنا ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخبَّاب بن الأرتّ رضي الله عنه: ” وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ”[1].
وما أجمل هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ “محمد لطفي أفندي” ، والتي تعبّر عمّا نريد أن نقوله:
لـــــــــــــــو خـــــررتَ خــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــرَ الـــــمـــــــــــــاء…
وانهمرت عيناك مثل أيوب بالدموع والبكاء…
لـــــــــــو وقــــــــفـــــــــــــتَ لــــــــه عـــــــلــــــى الـــــــبـــــــــاب…
وفـــــديــتــــــه بــــالـــروح والـنـــفــــــس والأحـــــبـــــاب…
وعـــــــــمـلــت بـــــأمره، أمـــا يُـــجــزل لــك الــثــواب؟
أجل، ثمّة بشارةٌ جديدة تُزفّ إليك في كل منزلٍ خررت خرير الماء فيه، ثم اصطدمت رأسك بالحجارة هنا وهنالك فقلتَ: أهناك عوالم أخرى أرحل إليها؟ بل إنك ستستشعر عنايته مرّةً أخرى، وستمضي إليه دون تعثّرٍ ألبتة، واعتقادنا وإيماننا بربّنا يدور في هذا الإطار، وإننا على قناعةٍ تامّةٍ وإيمانٍ راسخ بأنّ الله تعالى لن يخيّب حسن ظنّنا به.
من أجل ذلك تطرّقنا إلى هذه المسائل، وما أردنا أن نوضِّحه في الأساس هو مسألة تحلية النشء بروح الأمّة على الصعيد التربوي، وقد أشرنا في فصلٍ سابق إلى مسألة أن يتحوّل البيت إلى مدرسة ومركز تربويٍّ، وحاولنا أن نؤكد على ضرورة أن يتحلّى الأبوان بالشفقة والرأفة والرّقّة، وأن يقوما بالسلوكيّات الإنسانية التي يرجون أن يرَوها في المستقبل لدى صغارهم.
1- تربية الطفل من وجوه متعدّدة
لو أردنا أن يصبح أولادنا من ذوي الجرأة والشجاعة فعلينا ألا نُخيفهم بالحديث عن مصّاصي الدماء والعمالقة والجان والغول، بل يجب علينا أن نقوّي فيهم روح المقاومة الداخليّة التي تمكّنهم من مواجهة جميع السلبيّات.
فإذا رغبنا في أن ينشأ أولادنا على الإيمان فلا بدّ أن يتبدّى الإيمان في كل أحوالنا؛ في تصّرفاتنا وحركاتنا وحساسيّتنا إزاء بعض الأمور وبسماتنا وقسماتنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا ومُقاساتنا ومُكابداتنا ومراعاة الشفقة لدى الآخرين، كما يجب أن تكون قلوب أطفالنا مفعمةً بكلّ هذه الأمور.
أجل، يجب أن نكون كما يحبّ أطفالنا أن يرونا، وأن نتجنّب التصرّفات التي قد تجعلنا صغارًا في أعينهم.
علينا أن نكون أعزّاء أجلَّاء في أنظار أطفالنا؛ حتى تجد أقوالنا صدى لها في قلوبهم، ولا يتمرّدوا على طلباتنا، ومن هنا يمكن أن نقول: قد يصير الآباء المستهترون رفقاء لأبنائهم فقط لا أكثر، ولكن لا يمكن أن يكونوا مربّين ومعلّمين لهم، ولا يستطيعون تربيَتهم كما يرغبون.
ينبغي أن تكون بيوتنا بمثابة المدرسة ودار العبادة والمركز التربويّ؛ حتى نشبع مشاعر أطفالنا وأرواحهم وقلوبهم؛ فلا نجعلهم عبيدًا لشهواتهم.
2- تعويد الطفل على المسجد منذ الصغر
كان الأطفال في عصر السعادة يغدون ويروحون إلى المسجد رغم صغر سِنّهم، ولكن للأسف أصبحنا نعتبر الآن اصطحاب الأطفال إلى المسجد متنافيًا مع آداب المسجد، وللأسف أيضًا فإنّ العديد من المساجد نراها تحفل ببعض الشيوخ غلاظِ القلوب الذين يتراءون للطفل وكأنهم زبانية جهنم، الأمر الذي يبعث الخوف والرهبة في نفوس الأطفال، والحال أن هؤلاء الشيوخ ليسوا على القدر المطلوب من المعرفة الدينية، كما أن معلوماتم الدينية ورؤيتهم العامة وأفكارهم محدودة -مع الأسف- إلى درجة كبيرة، ومع ذلك يحسبون أن العبس في وجوه الأطفال وتقطيب الوجه لهم يحفظ قدرَ المسجد ومكانتَه، بيد أنهم بأفعالهم هذه يبعثون الخوف والرعب لدى الأطفال من المسجد، كما أنهم يقومون بعملٍ يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنّته صلى الله عليه وسلم في تنظيم الصفوف للصلاة في المسجد أن يتقدّم الرجال ويقوموا في الصف الأول خلف الإمام، ثم الصبيان، ثم يأتي من بعد ذلك النساء في الصف الأخير مراعاة للطبيعة البشرية.
وعلى ذلك فإن اصطحبنا الطفل إلى المسجد شعر بشوقِ روّاد المسجد إلى صلاة الجماعة، ومتعتِهم عند أدائها، وازداد ارتباطه بالحياة الدينية، ومن ثمّ يجب أن نقدّم الهدايا للأطفال وأن نشجّعهم على الصلاة، لا أن نطردهم من المسجد أو نعنّفهم أو نخيفهم، لا بدّ أن نحبّبهم في المسجد وفي حديقة المسجد، ونحافظ على أن تظلّ قدسيّةُ المسجد حيةً في مشاعرهم.
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنت ابنته زينب رضي الله عنهما، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها[2]، فهذا هو حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلنا فيه أسوة حسنة.
ولم يرِدْ عنه صلى الله عليه وسلم أيُّ كلمةٍ نابيةٍ أو فعلٍ يشير إلى إخراج الطفل من المسجد، ولذا غدا من الضروري أن نخصّص زاويةً جميلةً في حيّنا كمصلّى، وموضعًا في بيتنا كمكان خاصّ بالصلاة؛ فكلما نظر الطفل إلى ما حوله شاهد لوحاتٍ تذكّره بالله، ومن ثمّ يحيا حياةً لدنّية، ويحدّد طريقه بإرادته الحرّة ووجدانه الحرّ.
فإن تناولنا المسألة من حيث الصلاة فقط نقول بأن الأب إذا أمسك الطفل من يده حين يبلغ السنّ التي يستطيع فيها أداء الصلاة وأوقفه بجوار أمّه على سجّادة الصلاة، واستطاع أن يربط الطفلَ بالمحراب الأبديّ بقدر صدق أحواله لنجح نجاحًا كبيرًا في هذا الأمر العظيم؛ لأن الصلاة مسألةٌ مهمّة للغاية من حيث التوجّه إلى الله جلّ جلاله.
3- الردّ على الأسئلة وإزالة الشبهات منذ البداية
قد تراود الطفلَ بعضُ الأسئلة والشبهات حول الصلاة وغيرها من القضايا الدينية، لا سيما وأن الأطفال المنغلقين على أنفسهم قد لا يستطيعون في الغالب مصارحة والديهم بما يعتمل في صدورهم من هذه الشبهات الدينية، فمن الأهمّيّة بمكانٍ أن نتّخذ شتّى الوسائل حتى نريح الطفل ونجعله يعبّر عمّا في داخله، فإن كبر ونمت في داخله مثل هذه الأسئلة والشبهات فإن كلّ شبهة أو شكٍّ في أي مسألة دينية لم يقدر على فهمها، أو أي أمر لم يستوعب حكمته أو معناه يتحوّل إلى ثعبانٍ وعقرب يلدغ قلبه.
بل إن هذه الشبهات أحيانًا ما تتعاظم بسرعةٍ في عالمه الداخلي حتى إننا لا نفطن إلى أنها قد تقضي على هذا المسكين في يومٍ من الأيام.
فقد يتظاهر وهو معكم في المسجد بذكر الله وتحميده وتقديسه وتهليله والحال أنه قد رزح تحت شبهاته ووقع فريسةً لوساوسه، إننا إن لم نعالج هذه الوساوس والشبهات في حينها فلا مناص من أن الطفل عندما يلتحق بالجامعة لِيحرِزَ مكانة مرموقة في الحياة سيواجهنا بأفعالٍ وأفكارٍ ومشاعرَ لا نوافق عليها مطلقًا نظرًا لما يدور في ذهنه من شبهات وشكوك في الدين، ومن ثمّ علينا ألا ندع قلبه وعقله وروحه في حالةِ خلوّ أبدًا وأن نغذّيها على الدوام وفقًا لمستواه وعمره.
كان الآباء والأمهات قديمًا يعهدون بأطفالهم للمربّين والمربّيات من بني جلدتنا، فكان هؤلاء المربّون والمربّيات ينفذون إلى عوالم الطفل الداخليّة ويحاولون أن يجدوا علاجًا لآلامه يتناسب مع عالمه الروحيّ، وفي الواقع الوالدان هما من يجب عليهما أن يقوما بهذه التربية، فإن لم يستطيعا فعليهما أن يجتهدا في البحث عن مربّين مثقّفين يعهدان إليهم بهذا الأمر مثل اجتهادهما في البحث عمّن يعتني بشؤون منزلهما، عليهما أن يفعلا ذلك وألا يسمحا بضياع أبنائهما، إننا لا نستطيع أن نرسّخ في نفس الطفل عقيدةً متينةً وعبوديّةً راسخةً وخُلقًا رفيعًا إلا بهذا القدر من الحساسيّة.
4- الدعاء وأداء العبادة في مكانٍ يتمكّن الطفل من رؤيتنا فيه
يجب علينا أن نخصّص مكانًا وزمانًا للعبادة داخل البيت، فمثلًا نأخذ الطفل ونصطحبه إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس مع الجماعة، وإن لم يتيسر ذلك فنقوم بأدائها -إن أمكن- في جماعةٍ داخل البيت، وأداؤها في المسجد أفضل خاصةً في الأوقات التي لا تستطيع الأم أن تصلّي.
أجل، عندما لا تصلي الأمّ نظرًا لظروفها الخاصّة فقد يقع في نفس الطفل أنه لا حرجَ في ترك الصلاة والدعاء في بعض الأوقات، وحتى لا يقع هذا فإن الذهاب إلى المسجد في هذه الأيام خاصةً قد يُعدّ إعادة تأهيلٍ يتناسب مع جدّية المسألة وأهمّيّتها، وقد يُجبر النقص أيضًا كالآتي: يمكن للمرأة في أوقاتها الخاصّة أن تتوضّأ وتجلس على سجّادتها وترفع يديها متضرّعةً لربها سبحانه وتعالى، وبهذه الطريقة تُثاب على فعلها وكأنها قد صلّت بالفعل وتُسدّ الثغرة أيضًا، وقد ورد مثل هذا التفسير في كتب الفقه.
إن مسألةً كهذه في غاية الأهمّيّة من حيث تربية الطفل؛ لأنه بهذه الوسيلة لن يرى أبدًا في البيت جبهةً لا تسجد أو عينًا لا تدمع أو يدًا بالدعاء لا تُرفع، بل سيشاهد في البيت دائمًا حساسيّة ودقّةً وشعورًا عميقًا بالعبوديّة، ولذا حتى يدرك سبب عدم استطاعة أمّه القيام بأداء العبادة في بعض الأوقات ويستوعب روح المسألة ومكانتها في الدين؛ فمن الأفضل أن نأخذه من يده ونذهب به إلى المسجد.
ولا ريب أنه سيأتي يومٌ يغدو فيه الطفل كالمنبّه بالنسبة لكم إذا ما سمع الأذان، فينبّهكم قائلًا لكم: الصلاة يا أبي، وحتى إن كنتم مشغولين بأعمالكم ولم تسمعوا الأذان، وسمعه هو؛ جاءكم ونبّهكم إلى الصلاة، وهكذا يذكّركم بكل ما كنتم تذكّرونه به خلال فترةٍ سابقة.
فضلًا عن ذلك لا بدّ أن تحدّدوا ساعةً خاصّةً في يومكم لدعاء ربّكم، تعبّرون بها عن مشاعركم وتكشفون فيها عما يدور في صدوركم، وتُظهرون بالفعل أن الله تعالى هو الملجأ الوحيد دائمًا، ومن المفيد أن تجهروا صراحةً بأدعيتكم؛ فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون تلك الأدعية المرويّة لنا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوها إلينا، فكثيرًا منها روتها السيدة عائشة رضي الله عنها، كما كان لسيدنا علي ولابنيه الحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين نصيبٌ في رواية مثل هذه الأدعية.
وعلى ذلك يجوز أن يسمع مَن حولكم ما تدعون به، مع ملاحظة أن يكون هدفُكم هو تعليم ولدكم، فإذا ما رجوتم منهم أن يكون حسّاسًا تأخذه القشعريرة عند ذكر الله تعالى فيتحتّم عليكم أن تكونوا هكذا بدايةً.
ثمّة مشاهدُ لا يتسنّى لي أن أنساها أو لا أشعر بالقشعريرة عندما ترد على خاطري، وقد أحدثت هذه المشاهد التي تعكس ارتباط جدّتي رحمها الله بالله تعالى تأثيرًا كبيرًا في نفسي، فقدتُها وأنا ما زلت صغيرًا، كان أبي رحمه الله إذا ما تكلّم عن أمور تتعلّق بدين الإسلام أو قرأ القرآن تُراها تنتفض في مكانها، حتى إنك إن ذكرت الله عندها وجاشت مشاعرك بجانبها سرعان ما يمتقع لونها ويذبل وجهها، وتظلّ رازحةً تحت هذا التأثير أربعًا وعشرين ساعة، فكان لهذا الحال تأثيرٌ كبير في حَالَتِي الروحيّة.
أجل، كانت جدّتي أمّيّةً لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنها كانت تحاول أن تعمل بقدر ما تعلم، ومن ثمّ أحدثت أفعالها الصادقة وبكاؤها ونحيبها تأثيرًا كبيرًا في نفسي، كثيرًا ما جلستُ بين يدي مشايخ عظام، واستمعتُ لأحاديثهم المشحونة بالانفعالات، غير أنه يمكنني أن أقول إنّ ما تعلّمتُه من دروسٍ تلقيتها عن أفعال جدتي التربويّة لم أستطع أن أتعلّمها من أحد، ويخيل إليّ أنّني أدين بإسلامي بشكل عام لجدتي وللأفعال الصادقة التي عاينتُها لدى أبي وأمي.
سامحوني إن ابتعدتُ عن موضوعنا، ولنعد إلى ما نحن بصدده…
أجل، من المهمّ جدًّا أن يعدّل الوالدان من أوضاعهما، فكما أسلفنا عليكم أن تحدّدوا ساعةً معيّنةً في اليوم يرى فيها الطفل أنّاتكم وعبراتكم وإسراركم لربكم بما يدور في نفوسكم، وجيشانَكم وغيابكم عن وعيكم ودعاءكم له سبحانه صراحةً فاتحين له قلوبكم، فلا سبيل للطفل أبدًا أن ينسى رؤيته لكم وأنتم تنازعون أنفسكم من أجل آخرتكم، وإحساسه بكم وأنتم تذكرون ربكم، ثم بكاءكم أمامه سبحانه رجاءَ رحمته.
في الواقع إن علينا أن نراقب الله في أنفسنا ونحن نؤدّي عبادتنا له سبحانه وتعالى؛ فلا بدّ أن يكون ركوعنا وسجودنا وقيامنا وقومتنا من الركوع على صفةٍ تذكّر به سبحانه على الدوام.
علينا أن نتخيّل حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى على النحو التالي: لنتصور أننا لقينا ربّنا سبحانه فقال: “انهض يا عبدي، واعرض عليّ ما عملتَه في حياتك”، فقمنا ووقفنا أمام عظمته سبحانه وتعالى معقودي اليدين راجين رحمته.
ما أعظمه من إنذارٍ لِمَن حولنا أن نشعر حقًّا بكبريائه وذلّتنا! يقول سيدنا علي رضي الله عنه فيما أخرجه الترمذي في “الشمائل”: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى منزله جزّأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءًا لله، وجزءًا لأهله، وجزءًا لنفسه، ثم جزّأ جزأه بينه وبين النّاس”[3].
أجل، يجب أن تكون لنا ساعة معيّنة ووقت نورانيّ مع ربّنا سبحانه حتى يجعل الطفلُ من هذه المشاهد التي يشاهدها عتادًا لعبادته وذخيرةً لإيمانه إذا ما حان الأوان، فإذا ما واجهته فيما بعد مخاطر الانحراف الفكريّ والعمليّ وجد هذه اللوحات تُسعفه وتأخذ بيده وكأنها أحزمة أمان.
وهكذا لا بدّ أن تنسكب العبرات ويعلو التأوّه والنحيب حتى يعيش الطفل أحوالًا تحول بينه وبين سقوطه وتعثّره، فهذه لوحاتٌ خالدةٌ تستقرّ في بؤرة اللاشعور لديه، فإذا ما همّ فيما بعد بارتكاب سيئةٍ لاحت هذه المشاهد في خياله من النافذة الممتدة إليه وحذّرته قائلةً: “ماذا تفعل يا بنيّ!” وهكذا تصبح تلك المشاهد مرشدًا مرافقًا له في حياته، وتصير أفعالكم يدَ عنايةٍ تمتدّ لإغاثته في سقطاته، تأخذ بيده وتنقذه من شتّى المخاطر.
5- احترام القرآن الكريم
إن تلاوة القرآن الكريم وتعليمه للأطفال يحوز أهمّيّة كبيرةً أيضًا، ولكن ثمّةَ أمرٌ لا يقلّ أهمّيّةً عن تلك المسألة وهو إثارة شعور الطفل بأن ما يُتلى هو كلام الله، فمن الأمور التي نشاهدها كثيرًا في أيامنا أن بعض الناس يقرؤون القرآن ولا يتجاوز القرآنُ تراقِيَهم مع الأسف، ولذا إن استطعتم أن تكونوا قدوةً حسنةً لأبنائكم في قراءة القرآن فاقرؤوه وكأنكم تتلونه في حضرة ربّكم سبحانه وتعالى أو بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تفتحون قلوب مَن حولكم مرّة أخرى.
أجل، لو أنكم لا تتمالكون عبراتكم عند قراءة القرآن فلا ريب أن أبناءكم سيستوعبون أمورًا كثيرة عندما يرونكم، وأنا على قناعةٍ تامّة بأن مما يجعل إنساننا متبلد الشعور قراءة القرآن بلا روحٍ وبلا خشية.
جاء في حديث شريفٍ قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَزَّنُ بِهِ”[4]،وجاء في حديث آخر: “إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا”[5].
فإذا كان القرآن قد تناول الإنسان بكلّ ما يحيط به من أحزان ومشاكل -ولا ريب في ذلك- فعلينا أن نعبّر عن هذا الحزن بأحوالنا، غير أن الوصول إلى هذا المستوى يقتضي معرفة ما بالقرآن، فنحن ربّما نوقّر القرآن ونبدي كلّ تعظيم وإجلالٍ له، إلا أنّ سعينا للوقوف على معانيه على اعتبار أنه كلام الله فيه مزيدٌ من التعظيم والتوقير، فضلًا عن ذلك فإن هذا السعي يُساعد الطفل على أن يشعر بعمقٍ أكبر في قلبه وذهنه بمعاني القرآن الكريم، فتمتلئ روحُه بها، ويرتوي ظمؤه الروحي بشكلٍ يتناسب مع مستواه.
لكن من اكتفى بالوقوف على معاني القرآن الكريم ولم ينفتح للمشاعر الدينية يعدّ ناقصًا، أما من لم يصل إلى هذا القدر على الأقل فهو خائب خاسر، إذ من الضروري أن يتعلّم الإنسان ما في الألفاظ القرآنية من معانٍ مقدّسة حتى يمكنه أن يحظى بما وعد به القرآن الكريم للبشر، وبالتالي نُعلّم ذلك لأطفالنا.
وها هو “الحافظ المناوي” ينقل لنا واقعةً عند شرحه للحديث الشريف الذي ذكرناه آنفا:
كان طفلٌ يقرأ على بعض الصالحين القرآنَ، فرآه شيخُه مصفرَّ اللَّون، فسأل عنه، فقالوا: إنه يقوم الليل بالقرآن كلّه، فقال له شيخه في هذه الليلة:
“استحضِرْني في قبلتك وكأنّك تقرأ عليّ القرآنَ في صلاتك ولا تغفل عني!”.
فلما أصبح قال له: “ختمتَ القرآنَ كالعادة؟”.
قال الشابّ: “لم أقدر على أكثر من نصفه”.
فقال الشيخ: “في هذه الليلة استحضِر مَن شِئتَ من الصحابة الذين سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلتك واقرأ عليه”.
ففعل، فلم يمكنه إلا قراءة نحو ربعه، فقال له الشيخ في الليلة التي بعدها:”اقرأ الليلةَ على من أُنزل عليه”.
ففعلَ، فلم يقدر على أكثر من جزءٍ، فقال له:”الليلة استحضِرْ أنك تقرؤه على جبريل الذي نزل به واعرف قدرَ من تقرأ عليه”.
ففعل، فلم يقدر إلا على سورة، فقال الشيخ: “الليلة تُبْ إلى الله وتأهَّب واعلم أن المصلّي يناجي ربَّه، وقِفْ بين يديه فانظر حظّك من القرآن وتدبّر ما تقرأ، فليس المراد جمع الحروف بل تدبّر المعاني”.
ففعل فأصبح مريضًا فعاده أستاذُه، فلمّا أبصره الشابُّ بكى وقال:
“جزاك اللهُ عني خيرًا، ما عرفتُ أني كاذبٌ إلا البارحةَ، لمّا استحضرتُ الحقَّ وأنا بين يديه أتلو عليه كلامَه، ووصلتُ إلى قوله تعالى “إياك نعبد” لم أرَ نفسي تصدُق في قولها فاستحييتُ أن أقول “إياك نعبد” وهو يعلم كذبي وصرتُ أردّد في القراءة كلامه إلى “مالك يوم الدين” حتى طلع الفجر، وقد احترق كبدي، وما أنا إلا راحلٌ له على حالة لا أرضاها من نفسي”.
فمات فدُفِن، فأتاه أستاذُه فناداه فأجابه من القبر: “يا أستاذ أنا حيٌّ قدمتُ على حيٍّ فلم يحاسبني في شيء”.
فقام أستاذُه مريضًا فلحِقَ به[6].
حتى تنفتح قلوبنا للقرآن لا بدّ من التأمّل في معانيه، والوقوف على مفرداته، وتعظيمه لكونه كلام الله تعالى، وقراءته بأسلوبٍ يعبّر عن احترامنا وتقديرنا له، فإنْ فعلنا ذلك جذبَ القرآنُ القارئ والمستمعَ إلى مناخه، وفتح لهما أبوابه السماويّة على مصراعيها.
وإننا لا نقصد من نقل هذه الحادثة سالفةِ الذكر أن نقول: لا تقرؤوا القرآن إلّا بشرط التفكّر والتأمّل هكذا، ولكنني أرى أن الوقوف عند بعض المسائل مثل: القضايا التي يحدّثنا القرآن عنها، والتغيّرات التي يُحدِثُها القرآن في أرواحنا؛ تقتضيها مسؤولية اصطفائنا لأن نكون مخاطبين له، ولا يُتصوّر أن القرآن سيؤثّر في حياتنا الفردية والاجتماعية ما لم يُحدث هزّات روحيّة في كياننا، علينا أن نتغيّر بالقرآن، ونتّجه إلى آفاقه، ونشعر بأعماقه ومعنوياته؛ حتى يكشف لبصائرنا عن أسراره.
لنرجع إلى موضوعنا، ونقول: أجل، إن هذا الفتى لم يمتْ، بل انتقل إلى الرفيق الأعلى؛ لقد توقّف قلبه نتيجة الانفعال الذي قد يُحدثه القرآن في القلوب الطاهرة، فارتحل إلى ربّه، ولا جرم أنه سيعيش حياة أبدية، إنه لم يستطع أن يتجاوز قول الله تعالى “إِيَّاكَ نَعْبُدُ”، وظلّ حتى الصباح يكرّرها.
وشخصٌ آخر أحسّ بمثل هذه الحالة الروحيّة في الكعبة المشرفة، عندما وضع رأسه على جدار الكعبة قال: “يا ربّ”، ثم توقّف وكأنّ لسانه قد انعقد، وراودته فكرة: “هل تملك القدرة على قول هذا؟ لماذا ما زلتَ تُرائي؟” لم يستطع أن يكمل بقيّة كلامه، فإن ما اختلجَه عبارةٌ عن مشاعر لا يُمكن شرحُها أو إشعارُها لأحد؛ إنها مشاعر جيّاشة استغرقت بضعَ دقائق، وبعد ذلك لم يستطع حتى ذلك الشخص نفسه أن يشرح الحال التي كان عليها.
والآن لو أنّنا حافظْنا على هذا المنهج في بيوتنا، وأبدَينا بتصرفاتنا عشقَنا لكتاب ربّنا، وكأننا بالفعل جلوسٌ في حلقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سرعانَ ما انبَعثَت الحياة في أرواح من حولنا كالعشب الذي يتهاطل عليه المطر، ولأصبحت حياتنا الاجتماعية في صورةٍ يغبطنا عليها الملائكة والروحانيّون.
أ. لا تنفِّروا
يشهد تاريخنا القريب أن أجيالَنا الذين نشؤوا في بلدنا وفي البلدان الإسلامية الأخرى لم يستطيعوا أن يستوعبوا -بقدر الكفاية- رسائلَ الدين التي تحمل اليسر والبشرى في طيّاتها، ولو أننا فَحَصْنا ذلك بقلبٍ سليمٍ وعقلٍ صحيحٍ لأدركنا أن السببَ في هذا هو العجزُ عن إدراك المعنى وفتورُ الهمّة.
أجل، لم يستطع المؤمنون في ذلك العهد أن يُدركوا المعنى الذي تعبّر عنه مقولة “آمنّا بالله”، بل وعجزوا عن الحفاظ على التناغم والتناسق بين العالم الداخليّ والخارجيّ، ولم يفهموا بأعماقهم الوجدانيّة الظواهرَ المتعلّقة بالدين، وللأسف حتى عندما أصبحت التربية الدينية مادةً تُدرّس في المدارس اكتفى بعض معلمي مادة الدين والأخلاق في هذه المدارس بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال ولم يقتنصوا الفرصةَ التي أُتيحت لهم، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل طبّقوا مناهج تربويّة خاطئةً على الطفل الذي ليس له علاقة قوية بالدين، وبذلك قضوا حتى على شعور حرمة الدين الذي كان يحمله هؤلاء الأطفال، لا شكّ أنهم لم يقوموا بذلك بغيةَ قطع صلة الطفل بالدين، ومع الأسفِ فإنّ هذا الخطأ الجسيم لم يُتَلافَ بعدُ، بل ما زال يتكرّر منذ عصورٍ مضت.
وحتى الآن لا نستطيع أن نقول إننا نستغلّ كلّ الإمكانيات التي تفضّل الله تعالى علينا بها، إنّ بعضَ الشباب يأتوننا ورؤوسهم محمّلة بكثيرٍ من الأسئلة والشبهات حول القضايا الدينية، وبدلًا من أن نقوم بوظيفتنا نحوهم فنحبّبهم في الدين، ونرسّخ في عقولهم أن الله هو المقصود والمطلوبُ الأوّل، ونزرع في قلوبهم حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطار دائرة العقل والمنطق؛ إذ بنا نُعرض عن هذا كلّه، ونبعث الخوف في نفوسهم؛ إذ ندين بأن الأمور التي يمكن أن يؤديها الطفل فيما بعد بشوق واشتياق في داخله أعظم أهمية من الأمور التي أعرضنا عنها.
أجل، إن كنا نكتفي بتحفيظ الطفل بعضَ الأشياء وكأنّ مسألة الدين عبارةٌ عن شكليّات ليس إلا؛ فقد جعلنا من أنفسنا سببًا لإعراضه عن الدين وبغضِه له، ولو التحقَ بدرسٍ دينيٍّ ما التحق بالآخر، فكيفما يتحتّم علينا ألا نُطعم طفلَ السادسة أشهر طعامَ البالغين فكذلك يجب ألا نضغط عليه في مسألة الحفظ حتى يبلغَ سنًّا معيّنة، فلربّما يحاول في المستقبل أن يحفظ بنفسه بعد أن يتذوّق شعور الإيمان.
فتناول هذه المسألةِ يجب أن يتمّ في إطار العملِ على تحبيب الطفل في الدين، وحضّه على التفكير، وحثّه على الإذعان لأمور الدين وتعلّمها، فإن لم نسلك هذا الطريق وأغرقنا هذه العقول البريئة في الأرقام الحسابيّة، ولجأنا إلى منهج تكثيف الواجبات وتحفيظه إياها؛ فقد تسبّبنا -عن قصد أو غير قصدٍ- في نفوره من الدين والمشاعر الدينية، وبذلك نكون قد أسأنا له ظانِّين أننا نخدم الدين.
على المؤمنين أن يكونوا في يقظةٍ من هذا الأمر، ويعملوا على تحبيب الطفل في الدين بكلّ جوانبه، وبدلًا من شحن عقله بالمسائل الحسابيّة نحاول فتحَ قلبِهِ وعقلِهِ على الروح والمعنى، ويلزم أن نغرز في قلبه حبّ القرآن الكريم حتى يُصبِحَ تعلُّمُ القرآن واستيعابُ مقاصدِهِ الإلهيّة هدفًا من أهدافه الحياتية الرئيسة، حتى يقول في نفسه: “اللهم أحسن إليّ بفهم دينك، لأتعلم هذه المقاصد السبحانية، ويمتلئ قلبي بحبّ كتابك العظيم”.
ب. الحفاظ على أداء الفروض والنوافل بانتظام
يقول الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (سُورَةُ طَهَ: 20/132).
على الأب والأم ألا يقصِّرا في أداء الوظائف الدينيّة، حتى لا يلمح الطفلُ أيَّ قصور لدى الأبوين في هذه المسائل؛ فقد كان سيّد الكونين صلوات ربي وسلامه عليه لا يتهاون في أداء صلاة التهجّد أبدًا، وكانت له أذكارٌ وأورادٌ يردّدها ليلًا ونهارًا، فإن حدث ولم يتمكّن من أداء شيء من هذه الأوراد والأذكار في موعدها أدّاها قضاءً في وقتٍ آخر رغم أنه لا يجب عليه ذلك، وبهذا يبيِّن بوضوحٍ ألّا بد من المواظبة على عبادة اعتادها الإنسان.
وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ضرورة المواظبة على العبادة التي شرعوا فيها، فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من العباد والزهاد في عصر النبوة، كان يريد أن يصوم الأيام كلها، ويصلي حتى الصباح، والأدهى من ذلك أنه لمّا تزوج لم يقرب زوجته ليالي، فاشتكت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان أبيها، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعاتبه بخصوص زوجتِه، ولندع عبد الله رضي الله عنه يكمل لنا الحديث:
كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي:
“أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟”.
فَقُلْتُ: بَلَى، يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ.
قَالَ: “فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ”.
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: “فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ”.
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟
قَالَ: “كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ”.
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: “فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ”.
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: “فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ”.
قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ: “فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا”.
قال عبد الله رضي الله عنه: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، وَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ”.
يقول رضي الله عنه: “فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”[7].
يقول هذا لأنه من الصعب أن يداوم الإنسان على هذا القدر من العبادة بعدما أسنّ وشَاخَ، وصعبٌ على مثل هذا الصحابي أن يفوته شيءٌ مما اعتاده من العبادات، لأن أهم شيء عنده أن يجده نبيُّه عليه الصلاة والسلام كما تركه.
قصة عبد الله بن عمرو هذه تُعدّ مثالًا جليًّا لموضوعنا، فعلى الإنسان إذا ما همّ بعبادةٍ وجعلَها عادةً له ألا يدعها مطلقًا، جاء في حديث شريف: “إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ”[8]، فإن لم يكن بوسعنا فعل ذلك فعلينا أن نكتفي بالقدر الذي يسعنا فعله –فيما عدا الفرائض- حتى لا نصغر في عين أطفالنا، إن كنا نكتفي بأداء الفرائض والسنن فعلينا ألّا نقصّر فيها، ولو كنّا بدأنا صلاة التهجد فعلينا أن نواظب على أدائها، كما ينبغي إن كنا قد شرعنا في أداء صلاة الأوّابين والإشراق والضحى أن نحافظ على أدائها، لا بدّ من ذلك حتى لا تذهب بالطفل الظنون ويعتقد عدم اهتمام المواظبة على مثل هذه الأمور إذا ما شُرع فيها.
وهكذا تصبح الجدّيّة في أداء العبادات جزءًا من ذاتيّة الطفل، فإن رأى فيكم قصورًا في هذه المسألة نبّهكم إليها وقال لكم: “أبي إنك لم تصلِّ صلاة الإشراق، ولم تقم لصلاة الضحى”، فضلًا عن ذلك يجب أن تُؤدّى العبادات في خشوعٍ تام وخشية بالغة؛ حتى يمتلئ وعي الطفل بهذه المشاعر الإيجابيّة.
وما حاولنا توضيحه حتى الآن إنّما هو لمن يعنيهم الأمر مثلنا. أجل، هذا هو السبيل لمَن يرجو أن يكون أبناؤه من العقلاء الواعين المتديّنين من ذوي الحسّ والشعور؛ لأنّ كلّ شيءٍ له سبيلُه الخاصّ الموصل إليه، وبالسير فيه تُحصد النتيجة، وبعبارةٍ أخرى نقول إن رجونا أن ينشأ الطفل على الطريق المستقيم وأن يكون له منهجُ حياة فلا بدّ أن يكون لنا أوّلًا طريقٌ ومنهجٌ في الحياة، يجب أن تتّحد أفكارنا وتصرّفاتنا حتى يتشبّع الطفل بهذه الأشياء عند رؤيته لها تتحقق أمامه بعينها، فإذا ما فعلنا ذلك انتظمت حياتنا وحاز أبناؤنا سعادة الدنيا والآخرة، وهذه الأمور تتبدّى كالحِمْيَة أو الوصفة العلاجيّة، ومن ثمّ لا بدّ من عدم التذمّر أو الشكوى عند القيام بها، إنها تشبه تناول الأدوية اللازمة صباح مساء دونما ارتيابٍ أو انقطاع، فبذلك تتّزن تصرّفاتنا ويسود التناغم والانتظام بيوتَنا.
أجل، يجب أن يشعر الطفل بالاحترام والخشية والأدب ومراقبة الله في نظراتنا وبسماتنا وكل أحوالنا؛ حتى تفيض روحُه بهذه المشاعر.
ج. الشعور بتعظيم شعائر الله
ثمّة ألفاظٌ مقدسةٌ بالنسبة لنا، تكمن وراءها معانٍ مقدّسة، فلفظ الجلالة “الله” يحمل مفهومًا ذا قدسيّةٍ كبرى، والإيمان به ركنُ الإيمان الركين، فمن لا يؤمن بالله لا يُتصوّر أن يعيش حياةً إسلاميّةً وإيمانيّةً، وهذا مفهومٌ عظيمٌ، ولذا فعلينا ألا ننسى مطلقًا أننا مكلّفون بترسيخ هذا المفهوم في الأذهان وتأصيله في القلوب وإشغال العالم الخياليّ للطفل به اعتبارًا من سنٍّ معينة، وهي مرحلةٌ تبدأ -كما يرى البعض- في الفترة من السابعة إلى التاسعة من العمر، ولكي يعيشَ النبي صلى الله عليه وسلم في خيال الطفل فلا بدّ أن تدور أحاديثنا في البيت عنه عليه الصلاة والسلام دائمًا، فلو كانت تدور عن فناني التلفزيون والسينما فحسب، أو لَو شغل التفلزيون والسينما أفقَ المشاهدة لدى الطفل لسيطر على خياله هؤلاء الفنانون والفنانات، فإذا ما سألناه عن الرياضيّين أو الفنانين أو الموسيقيّين تراه يعرفُ العديدَ منهم لكنه لا يكاد يعرف أسماء أربعةٍ من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا ريب أن هذه الأمور لن تعود بالنفع على ذاكرته وعقله الباطن، وسيُحشى ذهنُه بأمورٍ لا طائل منها تؤدّي إلى “فسق الخيال”.
يجب أن تكون كل أفكارنا وتصرفاتنا تعبِّر عن قدسية ما قدَّسه الدينُ، فمثلًا الكعبة مكانٌ مقدّس، ولذا علينا أن نبدي كلّ احترامٍ وتقديرٍ لها عند التعبير عن مشاعرنا نحوها أمام الطفل، علينا أن نطأ الأرض في احترامٍ وتقديرٍ إذا ما اقتربنا من الكعبة أو المدينة المنورة، بل يمكن أن نذهب بالأمر إلى أبعد من ذلك فنقول: يجب أن يكون مبدؤنا في سَيرِنا في الأماكن التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو مبدأ الإمام مالك رضي الله عنه، حيث كان يكره أن يدوس بحذاءٍ على أرضٍ دُفن فيها رسول الله، وأن يركب دابةً تطأ بحافرها موطِئ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه عند قدومه من مكانٍ بعيدٍ إذا وصل إلى مشارف المدينة وأسوارها ينزل عن دابته ويمشي حافيًا، ولا جرم أن الطفل الذي يرى هذا سيفيضُ قلبه بتوقير الروضة الشريفة وصاحبِها صلوات ربي وسلامه عليه.
وتسري هذه القدسيّة أيضًا على القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (سُورَةُ الْحَجِّ: 22/32). نعم، إن تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وتقوى القلوب تتطلّب معرفةَ القلب بالله وتوقيره والركون إليه وطاعته وإدراك الحقيقة الإلهية تمامًا.
إن تعظيم الشعائر مسألةٌ جدُّ حياتيّة، فمثلًا: المسجد من الشعائر فيجب أن ينظرَ الطفل إليه نظرة تعظيم خاصة؛ حتى يُذعن أن كل الطرق الموصلة إلى الله تمرّ به وتتقاطع معه، فإذا ما ارتفع الصوت اللاهوتي للمؤذّن قائلًا: “الله أكبر” عظم هذا القول في نظر الطفل فكرّره، فإذا ما انتهى المؤذّن من أذانه رفع يديه قائلًا: “اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ”.
خلاصة القول: إننا إذا آمنا بالله وأحببناه وامتلأت قلوبُنا بمشاعر التقوى والتعظيم لشعائره استطعنا أن نغرز هذه المشاعر في قلب الطفل وأن ندلّه على عظمة ربّنا ونحبّبه فيه، ونغرس في ذاتيّته أنه لا محبوب ولا مقصود ولا مطلوب سوى المعبود المطلق سبحانه وتعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه: “حَبِّبُوا اللهَ إِلَى عِبَادِهِ يُحِبَّكُمُ اللهُ”[9]، ومحبة الله لا تتأتّى إلا بتمام معرفته؛ لأن الإنسان صديق ما يعرف، وعدوّ ما يجهل، فالملاحدة والزنادقة يعادون الله لأنهم لا يعرفونه عز وجل، فلو أنهم عرفوه لأحبّوه.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سُورَةُ الذَّارِيَاتِ: 51/56)، ويفسر ابن عباس ومجاهد هذه الكلمة “لِيَعْبُدُونِ” بـ”لِيَعْرِفُونِ”[10]، بمعنى أن الإنسان إذا ما عرف الله توجّه إليه بالعبادة، فإن جهله ناصبه الجحود والعداء، من أجل ذلك لا بدّ أن نوضّح للطفل بدايةً كلّ هذه الأمور؛ حتى يعرفه هو أيضًا ويفيض قلبه بهذا الشعور، وبالتالي يتوجّه بكلّ تقدير وتوقيرٍ له، غير أن لكلِّ مستوى أسلوبَ تعريفٍ خاصًّا به، ومسألة التعريف بالله يتحدّد مستواها وفقًا لعمر الطفل ومستواه، فقد يكفي الطفل في سنٍّ معيّنة أن نقول له بأسلوبٍ مجرّد ودون حاجةٍ إلى دليل: إن هذه المائدة التي أمامه قد أحسن الله بها علينا، أما مَن هم في سنٍّ متقدّمةٍ أكثر فعلينا أن نوضّح لهم أن المطر الذي يتوق إليه الإنسان والحيوان والنبات وينهمر فوق رؤوسنا إنما يتنزّل من السماء بفضلٍ من الله وعنايته، ويفيض بمحض رحمة الله تعالى، أما مَن هو في سنّ أكثر تقدّمًا فيستدعي أن نحدّثه مثلًا عن قانون التبخّر الذي وضعه الله تعالى في البحار والأنهار، وقانون تساقط الأمطار على شكل قطرات في الهواء، وأن كل هذا لا يمكن أن يقع على سبيل الصدفة، بل إن كلّ شيء يجري بعناية الله وفضله، أما الأطفال النوابغ فعلينا أن نعرّفهم بالله ونحبّبهم فيه باستخدام البراهين الخاصّة بالعلوم الطبيعية.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي”[11].
ولا تتخلل مسألة تحبيب الطفل في الله أيّ صعوبةٍ إذا ما انتهجنا في سبيل تحقيقها المنهجَ الصحيح، فمثلًا إذا ما وفّرنا للطفل كتب السِّيَرِ بدلًا من الكتب عديمة الفائدة التي تقع عينُه عليها، أو على الأقلّ إن أعطيناه كتابًا يمكن أن يطّلع عليه في كل لحظة مثل كتاب “حياة الصحابة” لمحمد يوسف الكاندهلوي فأغلب الظنّ أن الطفل بذلك سيجد الفرصة للتعرّف على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وسيملأ كلّ واحدٍ منهم عينَه وسيتعاظم في نظره وكأّنه بطل حياته، ومن ثمّ سيسعى إلى الاقتداء والتشبّه بهم، فيحاول أن يصبح مثل سيدنا حمزة في شجاعته، وسيدِنا عليّ الكرّار في إقدامه وجرأته، وسيدِنا أبي بكر في صدّيقيّته، وسيدِنا عمر الفاروق في بالغِ عدالته، رضي الله تعالى عنهم آلاف المرّات، آمين.
أجل، من الأهمية بمكان أن نضع المصحف الشريف وكتب السير وكتب المغازي التي تدور حول حياة الصحابة رضوان الله عليهم في ركنٍ أساسي من البيت؛ وأن نعمل على تغذية قلوب أطفالنا بما في هذه الكتب من معلومات، وأن نسعى إلى تحبيب الأجداد إليهم وتعليمهم الافتخار بأبطالنا التاريخيين.
وهنا أريد أن أنوّه بنقطةٍ مهمّةٍ، وهي: إن الرجوع إلى الأدلة المختلفة للردّ على الشبهات والشكوك التي تسلّطت على عقيدتنا من جراء النظريّات الفلسفيّة والقوانين العقليّة، وإن كان ذلك من مقتضيات العقل والمنطق، فإن الاشتغال بالمنطق المجرّد قد يُطفئ أحيانًا الحياة القلبيّة للإنسان ويدفعه إلى اليأس والقنوط، فعلى الإنسان بعد أن يقوم بالوظائف التي يقتضيها عقلُه ومنطقه ويؤدّي ما عليه من مهام تتعلّق بهذا الأمر أن يشرع في البحث عن أمثلةٍ حيّةٍ من الواقع العملي تعكس هذه الأفكار والمشاعر، وعلى ذلك فإن عجزتم عن أن تضربوا للأفكار الدينية التي تلقنونها للطفل أمثلةً حيّةً من الحياة العملية حتى يستوعبها؛ فستظل هذه الأفكارُ مجرّد نظريّاتٍ في ذهنه حتى وإن تحدثتم بلسان الفيزياء والكيمياء والفلك، واستعنتم بالأدلة النفسية والآفاقية الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيّته، بل حتّى وإن دلّت لكم السماء مصعدًا نورانيًّا تعرجون إليها من خلاله.
فإن لم نستطع أن نُثبِتَ لأطفالنا أن الأحكام الدينيّة والأخلاق العالية التي تحدّثنا لهم عنها قد كان لها وجودٌ في أزمنة معيّنةٍ من التاريخ؛ فقد تبدو هذه الأمور وكأنها نوعٌ من الخيال والطوبيا، ومن ثمّ فنحن مضطرّون إلى أن نوضّح بأمثلةٍ حيّةٍ أن هذه القيم كان لها وجودٌ حقيقي في تاريخنا ويمكن معايشتها مجدَّدًا.
فما زال الكثير من الشبهات يدور في أذهاننا وقلوبنا حول إمكانية معايشة هذه القيم حتى وقتٍ قريبٍ، حتى لقد انتشرت كالوباء فكرةٌ تقول: “ربما وقعت هذه الأحداث، ولكن من المحتمل أن تكون قد وقعت مرّةً واحدةً، أما وقوعُها مرّةً أخرى -لا سيما معايشتها- أمرٌ صعبٌ للغاية، بل قد يبدو هذا الأمر ضربًا من الخيال والطوبيا”.
إننا على يقينٍ بأن مَن يعرف الله ونبيه صلى الله عليه وسلم عندما يرى هؤلاء الشباب -الذين نشؤوا يحبّون ربهم ونبيّهم عليه الصلاة والسلام سيدرك إمكانية أن تعيش جماعةٌ مثل الصحابة فيما بعد.
والحقّ أن لدينا ثقة كبيرة في إمكانيّة وجود هذه الجماعة التي تشبه الصحابة والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله “الغُرَباء”[12]، وهو يزفّ إلينا إشاراته وبشرياته؛ وأنهم سيرفعون راية الدين المبين إلى أوج الكمالات.
إنَّ ما نحمله في قلوبنا من تقوى وحبٍّ لربنا وتوقيرٍ له وتعظيمٍ للمسجد وغيره من الشعائر يأخذ بقدر اطّلاعنا على الآيات التكوينيّة شكلَ صروحٍ مقدّسةٍ في نظر الطفل، وكلّ واحدةٍ من هذه الصروح يمثّل دعوةً للمثول بين يدي الله، وبالمناسبة نريد أن نذكِّر هنا بأبيات جديرة بالذكر والتقدير للشاعر التركي “يحيى كمال”:
أنـت أمــــرٌ ســـــمـــاوي أيّـــهــــــــــــا الأذان المحمـــــديّ
لا يــكـــــفـــي لـــصــــداك الـــــــــــــعـــــالـَــمُ الـدنـيـــــــــــويُّ
وتــــــــــغــرق الــسـمـاواتُ الــســبــــعُ فــــــــــــــي الأنــــــوار
لـمَّا حلَّق من آلاف المآذن الروحُ المــــــحمـــديّ
وتــشــاهــد الأرواحُ كـلُّـهـا حـقــيقةَ “اللــــه أكـــــــبر”
إذا انــعـكـس على الـعــــــرش الأذانُ المــــــحـمديّ.
الأذان هو من أهمّ الرموز في المشاعر السامية للإسلام، وهو وسيلةُ تجهيزٍ معنويّ قبل الصلاة، كما أنه في الوقت ذاته تعبيرٌ عن أن عظمة الصلاة تكمُن في أنها عبوديّة لله، كما أنه نداءٌ ودعوةٌ من الله سبحانه وتعالى، فلو ربّينا أطفالنا على هذه المشاعر جاشت قلوبهم عند سماع الأذان واغرورقت أعيُنهم وتدفّقت مشاعرهم وارتَجّت أوصالهم في خوفٍ ومحبة، وإننا بمشيئة الله تعالى سنعمل على إحياء هذه الوظيفة التي ورثها آباؤنا عن أجدادهم ونقلوها لنا رغم ما تعرّضت له هذه الوظيفة من هزّات وضربات.
أجل، سنعلن عن شعائر الله، ونعرّف جيل المستقبل بقيمتِها وقدرها، ونحبِّب الجميع في الله ورسوله وكتابه المعجز البيان.
والخلاصة أنه يجب علينا القيام بحياتنا التعبّدية في بيوتنا، وأن نسعى بلا تضييعٍ للوقت إلى إزالة الشكوك والشبهات التي تدور حول الدين وما زالت عالقةً في أذهان أطفالنا، كما ينبغي أن تكون لنا ساعاتٌ محدّدةٌ في بيوتنا نتقرّب فيها من ربّنا سبحانه وتعالى؛ ونستقبل فيها الرحمات الإلهيّة المنهمرة علينا، وتتجّه أبصارنا إلى ربّنا في خوفٍ ورجاء، وتفيض صدورنا حزنًا وأسى. أجل، يجب أن تكون هناك ساعة نتصوّر فيها وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ولكن لا بدّ أن ينعكس هذا التصوّر بشكلٍ أو بآخر على الطفل والزوجة.
إنّ هذه الأمور التي تتعلّق بحياتنا التعبّدية والعقائديّة في الإسلام لَتُعتبَر قيّمةً عظيمة، وعندما يراها الطفل ويشعر بها في المستقبل سيدعو لكم اعترافًا بالجميل.
إن تعظيم شعائر الله يعني التعظيم القوليّ والفعلي للقيم العظيمةِ في نفسها والتي عظّمها الدين وعظمتموها أنتم كذلك. نعم، حينما يتردّد اسم الله العليّ العظيم في الأذان تحلّق حقيقة “الله أكبر” في الآفاق، وترفرفُ في عالم الأرواح، وتتوشّح القلوبَ، فإذا ما رأى الإنسان هذه الجماليّات تنتابه النشوةُ وتبتسم له الحظوظ.
[1] صحيح البخاري، المناقب، 25؛ سنن أبي داود، الجهاد، 97.
[2] صحيح البخاري، الصلاة، 106؛ صحيح مسلم، المسجد، 41.
[3] الترمذي: الشمائل المحمدية، ص 192.
[4] الطبراني: المعجم الكبير، 11/7؛ أبو نعيم: حلية الأولياء، 4/19.
[5] سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 176؛ أبو يعلى: المسند، 2/50.
[6] المناوي: فيض القدير، 1/190.
[7] صحيح البخاري، الصوم، 54؛ صحيح مسلم، الصيام، 182.
[8] صحيح البخاري، الرقاق، 18؛ صحيح مسلم، صلاة المسافرين، 218.
[9] الطبراني: المعجم الكبير، 8.
[10] البغوي: معالم التنزيل، 4/288.
[11] سنن الترمذي، المناقب،31.
[12]وهو حديث “إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ“. (صحيح مسلم، الإيمان، 232؛ سنن الترمذي، الإيمان، 13).