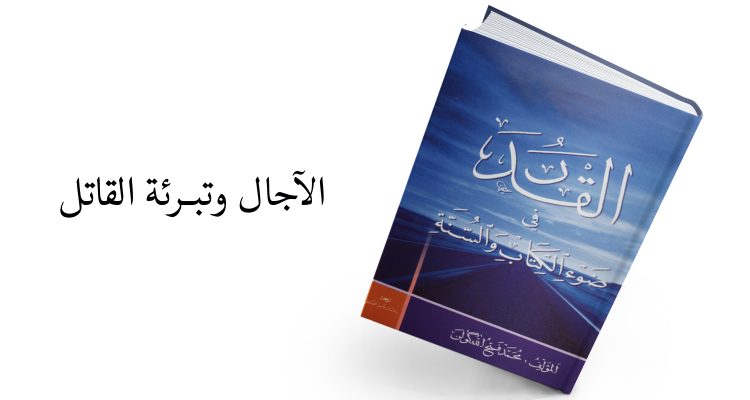السؤال: إن كان وقت الأجل وكيفيته معيناً مسبقاً فما ذنب القاتل؟
الجواب: إن زمن الموت وكيفيته قد عُيّنا مسبقاً كما هو معيّن لكل شيء. بمعنى أن ما هو وارد وواقع للكائنات قاطبة وارد وواقع أيضاً لحياة الإنسان وموته. فالحقيقة التي لا يمكن العدول عنها هي بلوغ كل موجود إلى الوجود بطرق معينة ومضي حياته وفق أسس معينة، ثم بعد مدة معينة يجري انسحابه من مسرح الحياة.
نعم، إن كل شيء يولد وينمو ثم يموت سائراً وفق خطة مرسومة معيّنة له ضمن دائرة قدر عامة واسعة جداً. فهذا نظام عام أزلي لا يتبدل ويمتد حتى للآباد.
إنه من الواضح جداً بالعلوم الحديثة وبقواعدها وأسسها الثابتة الشاملة النابعة من صميم الكون الذي يسير وفق نظام دقيق وفي انسجام بديع يحيّر العقول، أن لكل شيء تعييناً مسبقاً وتقديراً معيناً بدءً من الذرات إلى المجرّات. ولا يمكن إيضاح النظام البديع للكون ولا الانسجام الرائع الذي فيه، بل لا يمكن إحراز أي تقدم في العلوم الصرفة إلاّ بمثل هذا التعيين والتخطيط المسبق.
إن ما في الكون الواسع من نظام دقيق وهندسة رائعة والسائر وفق قوانين رياضية مقننة معينة هو الذي يدفع إلى القيام ببحوث ودراسات في مختبرات الفيزياء وفق أسس معينة ودراسة وشرح علم التشريح ضمن قواعد معينة، أو الانطلاق إلى أعماق الفضاء. إذ لا يمكن قطعاً البحث عن العلوم في كون لا نظام فيه وفي عالم لا خطة فيه وفي مجموعة من الطبيعة التي لا تعمل بنظام. بل العلوم أصلاً غدت عدسة لقسم من القواعد والأصول فدخلت الكتب تحت عنوان “العلوم”.
لا شك أننا هنا لا نريد الحط من أهمية العلوم ومكتشفاتها، بل نريد التذكير بموقعها ومكانها، ونلفت النظر إلى ما هو أهم وأجلّ وهو النظام والانسجام البديع الذي كان موجوداً في الكون قبل كشف العلوم عنه. فكأن هذا النظام كالقلب النابض للكون. فما أعظم القدرة التي عينت هذا النظام البديع بخطة قدرية مسبقة وجعلته أساساً للكون أجمع. حتى ظهر من علماء الاجتماع من يريد تطبيق هذه القوانين المهيمنة في العالم “النازلة من الأعلى” على المجتمعات الإنسانية. فعلى الرغم من أن الدعوة إلى القدر إلى هذا الحد أو بتعبير أصح الجبرية المفرطة معرضة للاعتراض والانتقاد دائماً إلاّ أنها ذات مغزى عميق من حيث الاعتراف بالنظام الحاكم على العالم أو بالخطة الأزلية المسبقة للعالم.
إن أية حقيقة تمس العقيدة مستغنية عن إسناد وتصديق من خارجها، ولكن جيلنا الحاضر غير المحظوظ الذي زاغ بصره بكثير من النظرات الأجنبية وانحرف قلبه بكثير من هذيانات خارجية عندما نخاطبه: “ارجع إلى رشدك!”، نعتقد أن بيان التناقض -ولو بالإشارة- في أقوال الذين أفسدوا هذا الجيل وأصلّوه فيه فائدة. وإلاّ فسير الكون برمته وفق تناسب بديع ونظام دقيق، من الذرات إلى المجرات والانسجام الكامل والتعيين والتقدير المسبق الذي يربط كل شيء ببعضه، يملأ البصر، مما يدل على حاكمية مطلقة مهيمنة. فالعوالم مذ خلقها الله منقادة إلى هذه الحاكمية المطلقة وتخضع في تحولاتها خضوعاً تاماً لأوامرها.
وعلى الرغم من أن الخلق الأول جبري كلياً بالنسبة للمخلوقات كافة، بما فيها الإنسان وما شابههه -ممن له الحرية والإرادة- فإن هذه المخلوقات ذات الإرادة والحرية تتمايز عن أقرانها في الأمور التي تندرج تحت إرادتها، ولأجل هذا التمايز يأخذ التعيين المبدئي (المسبق) نمطاً خاصاً به.
وفي الحقيقة إن السؤال الوارد نابع من عدم إدراك هذه الجهة المتميزة في الإنسان، وعدّه كالأشياء الأخرى تماماً. ولهذا نعتقد أن إدراك مثل هذا الفرق بين الإنسان وسائر المخلوقات -حتى لقسم منه- يحلّ المسألة. أما بقية المسألة فهي عبارة عن قبول إحاطة العلم الأزلي بكل شيء.
نعم، إن للإنسان قابلية الحرية والإرادة والميل والاختيار بخلاف المخلوقات الأخرى. وينسب إلى الإنسان الخير والشر والثواب والعقاب حسب تلك الحرية والإرادة والميل والاختيار.
ومهما كانت إرادة الإنسان وميله ضئيلاً أمام عِظَم النتائج الحاصلة، إلاّ أن الله سبحانه قد قبِلها شرطاً وسبباً لإظهار ذلك الأمر الجزئي -الذي نسمّيه الإرادة- على هيئة ميلٍ نحو الخير أو الشر، فيكون الإنسان بموجب توجه تلك الإرادة نحو الخيرات أو الشرور مذنباً أو بريئاً. والحادثة الناتجة من هذا الميل مهما كانت ثقيلة بحيث لا يمكن أن تحُمّل على ظهر الإنسان إلاّ أنه هو الذي دعاها وطلبها بميله إليها؛ لذا فالعقاب والثواب يعودان إليه. وتعالى الله عن المسؤولية التي قدّرها وعيّنها وخلقها في وقتها علواً كبيراً.
ولنفهم هذا في ضوء هذا المثال:
لو ربط الخالق العظيم حادثة عظيمة كتبدل المواسم بشهيقنا وزفيرنا. وقال: “إنْ تنفّستم أكثر من هذا الحد شهيقاً وزفيراً فسوف أبدل الوضع الجغرافي لموقعكم”. فلو ارتكبنا المحظور لعدم رؤيتنا علاقةً ما بين تنفسنا وتبدل الموسم حسب قاعدة “تناسب العلية”، وهو سبحانه وتعالى بدّل الموسم حسب ما وعد، فالمسؤولية تقع على عاتقنا حيث إننا السبب في ذلك، رغم أن الفعل يفوق طاقتنا بكثير.
ومثل هذا أيضاً: إن كل إنسان يعدّ آثماً ويعاقب، أو بريئاً ويكافأ حسب ما لديه من إرادة جزئية واختيار. وذلك لكونه سبباً في النتائج الحاصلة.
والآن لنقف قليلاً عند الشقّ الثاني من المسألة، أي كيفية التوفيق بين العلم الإلهي المحيط بكل شيء وإرادة الإنسان.
في العلم الإلهي، كل شيء في الوجود وما وراءه هو جنب إلى جنب ومتداخل، بأسبابه ونتائجه. بحيث يكون في تلك النقطة، قبلُ وبعدُ، السبب والنتيجة، العلة والمعلول، الابن والأب، الربيع والصيف… وجهان للواحد. فيُعلم بعدُ كقَبلُ، والسبب كالنتيجة، والمعلول كالعلة ويحكم هكذا.
فأيما شخص وبأي شكل وبأي اتجاه يكون ميله، وبأية جهة سنستعمل، إرادته التي هي شرط عادي، فإن تقدير وتعيين تلك النتائج الحاصلة من تلك الأسباب المعلومة مسبقاً لا تقيّد إرادة الإنسان ولا تكرهه على شيء. لأن ميول الإنسان قد أُخذت بنظر الاعتبار وعدّت فقدّرت بحقه هذه التقديرات. لذا فإن إرادته قد قبلت إذن وأُعطيت لها الأهمية. مثال ذلك:
لو قال شخص عظيم لخدّامه: “متى ما كتَمتم سعالكم تنالون الهدايا السخية، ومتى ما اصطنعتم السعال فلكم العقاب والحرمان من الهدايا”. فمعنى ذلك أنه قد قبل إرادتهم وعزّزها.
وكذلك الأمر هنا. فلو قال الله I لعبدٍ من عباده: “إذا ما أظهرتَ ميلاً بهذا الاتجاه، فأنا أخلق ما ملتَ إليه، وأنا أُعيّن ذلك من الآن حسب ميلك إلى ذلك”. فمعنى هذا أنه سبحانه قد أعطى أهمية لإرادة الإنسان.
وبناء على هذا فكما أنه لا تقييد في التعيين المبدئي فلا إكراه أيضاً بما يخالف رضا الإنسان قطعاً.
ثم إن القدر والتعيين المبدئي (المسبَق) عبارة عن الخطة العلمية الإلهية إن جاز التعبير. أي علمه بالإنسان وميول الإنسان ووضع خطة وبرنامج وفق ما سيقوم به الإنسان.
والعلم لا يعني وجود ما سيحصل بشكل من الأشكال في الخارج، بل إنَّ قدرة الخالق وإرادته هي التي توجد ذلك الشيء في الخارج بشكل من الأشكال وحسب ميول الإنسان. ولهذا فالأشياء التي ستظهر وتَرِدُ إلى الوجود لم تَرِدْ لأنها عُلمت هكذا. وإنما عُلمت بالأشكال التي وردت. وهذا هو التقدير المَبدئي والتعيين الأولي. وعلماء الكلام يعبّرون عن هذا بأن “العلم تابع للمعلوم”، أي كيف يكون الشيء هكذا يُعلم. وليس لأنه عُلم هكذا فحَصل. فكما لا يلزم خططنا العلمية وجود ما تصورناه من الأشياء، كذلك بديهي أن ما نعدّه خطط الخالق من التعيينات المبدئية ليس من الضروري أن توجِد شيئاً في الخارج.
حاصل الكلام: إن الله المحيط بعلمه الواسع بكل شيء -السابق واللاحق- يعلم الأسباب كالنتائج، ويعلم النتائج كالأسباب. فقد علم سبحانه مَنْ ينوي النية الحسنة ليؤدي عملاً حسناً، ومن يحاول ارتكاب السيئات. وحسب هذه النيات والمحاولات عيّن وقدّر ما سيخلق… فيخلق الأشياء التي قدّرها حسب مشيئته عندما يحين وقتُها وحسب ميل المكلّف ونيته.
ولهذا فإن التعيين المبدئي لموت الشخص وكيفيته وكون الشخص الآخر سبباً في الحادث لا يرفع المسؤولية، وذلك لأن التقدير قد قُدّر بأخذ إرادة الإنسان وحريته بنظر الاعتبار، ولهذا يسند جرمه إليه ويحاسب عليه.
ونرى من الضروري الاطلاع على المصدر الأساس في هذه المسألة العميقة المتعلقة بالقدر ودراستها مكرراً، لأن ما بيّناه عبارة عن توضيح بمستوى العوام، ضمن الأُسس الرصينة للسلف.