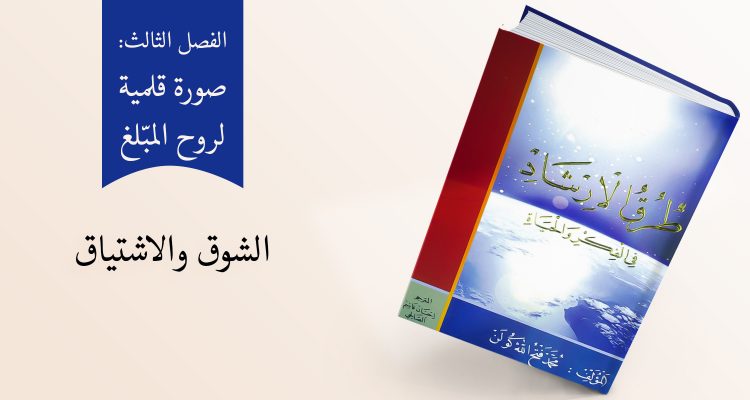المبلّغ يؤدي وظيفته في جو مفعم بالعشق و الشوق ويكون التبليغ شوقه وعشقه، لا يبتغي عنهما عوضاً. ويلزم أن ينبّه هذا الشعور فيه. غير أن إيقاظ هذا الشعور ليس من السهولة بمكان، بل عسير جداً، وكذا تحققه يطول كثيراً. فلولا أن بنى الرسول هذا الشعور في أصحابه في بدء الدعوة، ولو لم يجعلهم عشاقاً للحق والحقيقة، لما كانت الرسالة ضمن دائرة الأسباب تتحقق بأبعادها الواسعة.
فهذا سيدنا خالد بن الوليد يقابل قائد الروم فيعرض الإسلام عليه أولاً.( ) فنرى التبليغ أوّلاً ثم تتكلم السيوف. تُرى بمَ يوضَّح هذا إن لم يكن شوق التبليغ يفوق كل شيء.
فلقد استحوذ تأثير هذا الشوق والعشق العظيم للتبليغ على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فهجروا أوطانهم منتشرين في أرجاء الأرض لأجل التبليغ.
ولنذكر واحدة منها:أُسِر خُبَيب وأُخِذ إلى مكة، وبعد أن قضى مدة طويلة في السجن أُخذ أمام مشهد عظيم للإعدام، فكان حزيناً مكدّراً لأنه لم يجد الفرصة سانحة لتبليغ ما أودعهم الرسول الكريم من وظيفة الإرشاد، والآن يساق إلى الإعدام مكبّل اليدين ومعقد اللسان. فكان يجول ببصره إلى من حوله دون توقف باحثاً عمن يبلّغه شيئاً من الدين، ولكن دون جدوى حيث لا يجد أحداً، رغم أن فيهم من سيكون من الصحابة في المستقبل. ولكن بالنسبة لذلك اليوم لم تُفتح بعدُ بصيرتهم.. وقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمّهما وأحسَنهما. ثم أقبل على القوم فقال: «أمَا والله لولا أن تظنوا أني إنما طولتُ جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة».( ) ثم رفعوه على خشبة الإعدام.. والآن آن الأوان للوداع الأخير فصوبت نحوه الحربة، بيد أن خُبَيباً يجول ببصره أيضاً إلى مَن حوله علّه يجد من يبلّغه، فما كان يبحث عمن ينقذه من الموت، بل كان يريد أن يجد أحداً لينقذ حياته الأبدية ولو في هذه اللحظات الأخيرة.. فيا لله ما أخيب الموت في نظر أولئك العشاق لتبليغ دعوة الله عندما يغلبون على أمرهم فلا يستطيعون ذلك.. وفي هذه اللحظة سنحت فرصته بغير حسبان، إذ سأله أحد كبار مشركي قريش، وظاهر السؤال ليس مهماً بقدر ما سيكون جوابه مثقلا بالحكمة، وبقدر ما يكون فرصة لأداء وظيفة الإرشاد، وربّ شرارة من فكر تكون سبباً لإضرام نار الإيمان في قلوب الكثيرين في المستقبل. والسؤال هو: “أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟”
لا شك أن هذا السؤال لا يُسأل عنه مسلم، فكيف يُسأل “خبيب” ذلك الصحابي الجليل. بيد أنه كان يترقب اغتنام فرصة للتبليغ عقب السؤال؛ فلقد طفح جيشان وجدانه بين السرور الغامر والكدر الممض فلا يسعه شيء، لذا سعى ليقول شيئاً ولو قصيرا كصلاته التي صلاّها، بل كان عليه أن يُقحم الحياة كلها في جملة واحدة، يظل التاريخ صامتاً صاغياً إليها وتبقى أذن الزمان ترن بها.. وهكذا كان؛ قال: «والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي».( ) فيا له من وفاء، فاسمُ به أيها الروح الطاهر.
وبعد أن قال هذا الكلام ذهب عن خُبَيب ما كان يشعر به من ضيق لعدم إيفائه بواجب التبليغ. فغدا يشعر بالخفة كالريش. ولم يبق له إلاّ سلام الوداع للرسول r ثم السير إلى الجنة.. ولم يفكر قط أيمكن أن يبلغ السلام من مكة إلى المدينة أم لا؟ لأنه يعلم أنه يبعث بسلامه إلى نبي عظيم.كان آخر ما نطق به على خشبة الإعدام “السلام عليك يا رسول الله”. وكان الرسولr جالساً مع أصحابه في المدينة، وإذا به قام وقال: «وعليكم السلام يا خُبَيب».( )
نعم، كل صاحب دعوة عليه أن يَبْلُغ ما بلغه خُبَيب في عشق التبليغ والشوق إليه. كي يمكنه أن يقول لسير التاريخ المخالف: قف! و يمكنه أن يتجاوز تيارات الزمن المخالفة أو المضادة ويعيد الزمن إلى مجراه الصحيح، ليكون مؤدياً حقيقة وظيفة خليفة الله في الأرض.