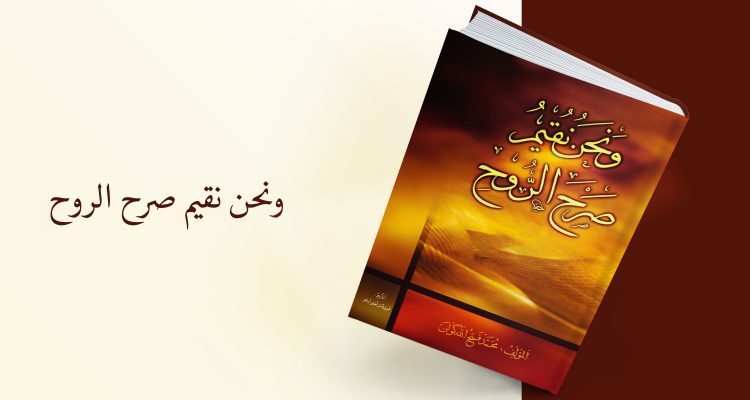سبق أن أشرنا إلى صفات “ورثة الأرض” إجمالاً. ونريد الآن أن نتفسح في ملامحها بشيء أكثر تفصيلاً:
الوصف الأول لوارث الأرض هـو الإيمان الكامل. يحدد القرآن الكريم “الإيمان بالله” غايـة لخلق الإنسان في أفق المعرفة وروح المحبة وبُعدِ العشق والشوق وتلوّن الخطوط الروحانيـة. والإنسان مكلّف ببناء عالمه الإيماني والتفكري حيناً بمد الدروب من ذاته إلى أعماق الوجود، وحينـا بالتقاط شـرائح من الوجود وتقييمها في ذاتـه. ويعني هذا في الوقت عينه ظهور الحقيقة الإنسانية الكامنة في روحه. فالإنسان لا يستطيع أن يستشعر ذاته، والأعماق في ذاته، ومقاصد الوجـود وغاياته، ويطلع على كنـه الكائنات والحوادث وما وراء سـتار الأشياء، إلاّ في ضياء الإيمان… وبعد الاطلاع يحيط فهماً بالوجود في أبعاده الذاتية.
إن الكفر نظام منغلق وخانق. ففي نظر الكافر: بـدأ الوجود بفوضى، وتطور في المجاهل المخيفة للصُّدف، وينـزلق متسارعاً إلى نهاية رهيبة. وفي هذا السير المتدحرج والمنـزلق، ليس لنا مكان ضيق، بل ولا موطئ قدم فيه نفحة رحمانية ينشرح بها الروح، أو نسيم أمان يحتضن آمالنا الإنسانية.
أما إنسان الإيمان المستشعر بمنشئه وخط حركته، وتوجهاته: إلى أين وإلى ماذا، ووظائفه، ومسؤولياته، فإنه يرى كل شيء نـوراً وضياء، ويطأ قدمه من غير قلق أينما يطأ، ويسير نحو هدفه الموجّه إليه بـلا خوف وفي ثقة… وإذ يسير، يُنَقّب خمسين ألف مرة عن الوجود وما وراء سـتار الوجود، ويرشح الأشياء والحوادث خمسين ألف مرة في الأنبيق، ويصر على طرْق كل باب، ويبحث عن وشـائج المناسبة مع كل شيء… وحين يقصر ما علمه وما وجـده، يكتفي بالحقائق التي رآها وعرفها في وجه التحقيقات التي استحصلها هو أو غيره حتى ذلك الحين، ثم يواصل المسير.
في إطار هذه الموازين، يُعد سائح الإيمان مكتشفاً لمصدر مهم للقوة. هذه الخزينة والذخيرة التعبوية، العائدة للأبعاد الأخرى، والمرموز لها بـ”لا حول ولا قوة إلا بالله”، لتبلغ من الأهمية موقعاً يلغي حسّ الحاجة إلى مصدر غيره عند من يحوز على هذا المصدر للقوة، وهذا النور. فإنه لا يـرى إلا هو سـبحانه، ولا يعرف إلا هو، ولا يفر إلا إليه هو، ولا يحيا إلا متوجها إليه هو، فيستطيع تحدي كل القوى الدنيوية بقدر توغل معرفته واعتماده على الله، ويعيش في شوق، ولا يقع في التشاؤم والسوداوية حتى في أشد المواقف سلبية، مع أمل القدرة على النجاح في كل شيء.
وأكتفي هنا بهذا القدر عن هذا الموضوع محيلاً إلى تراث ضخم من الآثار تعالجه، وفي مقدمتها كليات رسائل النور.
الوصف الثاني للوارث هو العشق الذي يُعد أهم إكسـير للحيـاة في الانبعاث من جديـد. إن من يُعَمّر ويجهز قلبه بالإيمان بالله وبمعرفته، يحس حسب درجته بمحبة عميقة وعشق أصيل لكل البشر، بل لكل الوجود… يحس فيعيش عمره كله وسط حالات المد والجزر للعشق والمواجد والجذبات والانجذابات والأذواق الروحانية التي تحتضن الوجود كله جمعاً. وكما في كل مرحلة زمنية، نحن بحاجة في الحاضر إلى أن تفيض القلوب من العشق، وأن تطفح من الشوق، في فهم جديد وطري، لتحقيق انبعاث عظيم. فما من حركة أو حملة باقية باعتبار نتائجها، من غير العشق… وخصوصاً إن كانت الحركة أو الحملة ذات امتدادات إلى العقبى وأبعاد ما وراءها. إن العشق الذي نقدمه في إطار تعيين موقعنا في ثنايا المناسبات والعلائق أمام الله سبحانه، الحاضر الموجود الخلاق… واستشعار الحظوظ من أن وجودنا مخلوق باعتبار وجودنا ظل ضيائه ووجوده هو… وتَقَبُّل كلامه غايةً للخلق، والسعي لتصيّدها بلا توان أو وهن، هو مصدر للقوة مكنون بالسر، وسرمد لا ينضب. ولا ينبغي أن يهمل ورثة الأرض هذا المصدر، وأن يَحْيَوه جياشاً وفواراً. لقد تعرف الغرب على العشق في أبعاد تلون المادة من خلف الفلاسفة وأجواء الدخان والضباب الفلسفية، فذاق طعمه وعاش الشبهات والتذبذبات على طول الطريق. أما نحن فننظر إلى الوجود، ومصدر الوجود، بعدسة الكتاب والسنة، ونحقق حب الخالق الذي نذكي جذوته ولهيبه في قلوبنا، والعشق والحمى، والعلائق التي نرتبط بها مع الوجود كله من أجله هو، باللجوء إلى رحاب موازنة المصدرين، مع الانفتاح على الميتافيزيقا. ذلك بأن منشأ الإنسان، وموقعه في الكائنات، وغاية وجوده، والصراط الذي يسير فيه، ونهاية هذا الصراط في هذين المصدرين، منسجم انسجاماً عجيباً مع فكر الإنسان وحسه وشعوره وتوقعاته، فلا نملك دونه -إذ نحس به- إلا الإعجاب والاندهاش. هاتـان المحجتان البيضاوان، هما لأرباب القلوب فوارة العشق والشوق ومَنْجَم الجذب والانجذاب. فلن يعود خالياً من يراجعهما بصفوة الحس وإذن الاحتياج، ولن يموت أبداً من يلجأ إليهما. والمفيد أن يلجأ اللاجئون بتعمق وإخلاص الإمام الغزالي والإمام الرباني السرهندي والشاه ولي الله الدهلوي وبديع الزمان النورسي، وأن يقتربوا بحماس مولانا جلال الدين الرومي والشيخ غالب ومحمد عاكف، وأن يتوجهوا بالحركية لخالد وعقبة وصلاح الدين ومحمد الفاتح وياووز سليم… نعم، وخطوتنا الثانية هي أن نمزج عشقهم وشوقهم الطافح غير المقيد بالأزمنة والأمكنة كلها، بأصول عصرنا وأساليبه ووسائله، في بيدر واحد، لنصل إلى روح القرآن الذي لا يحده زمان ولا يبلى، وبالتالي إلى ميتافيزيقية كونية.
الوصف الثالث للوارث هـو التوجه إلى العلم بميزان العقل والمنطق والشعور. هذا التوجه الذي يشكل جواباً عن تمايل البشر وحَيْدهِ في انسياق البشرية بفرضيات سوداء في مرحلة زمنية معينة، سيكون خطوة مهمة باسم الخلاص الإنساني. ولقد أشار بديع الزمان النورسي إلى أن البشرية تتوجه في آخر الزمان بكل طاقتها إلى العلم والفن… فتستمد كل قوتها من العلم… ويمتلك العلم مـرة أخرى الحكم والقوة… وتصير الفصاحة والبلاغة وقوة الإفادة موضوعا في سبيل قبول الجمهور للعلم، وموضع اهتمام الجميع… ويعني عودة الحياة إلى العلم والبيان.( ) ولا نرى سبيلاً غير هذا، يسلخنا من أجواء دخان الأوهام وضبابها المحيط ببيئتنا، ويوصلنا إلى الحقيقة، بل إلى حقيقة الحقائق. فإن عبورنا لفراغ قرون، وبلوغنا حدّ الإشباع في المعرفة، وإثبات وجودنا وثقتنا بأنفسنا مرة أخرى بتعمير خراب حس الانسحاق المزمن في شعورنا الباطن، لابـد له من إمرار العلم في منشور الفكر الإسلامي، وتمثيله والإفادة عنه. وقد شهدنا في تاريخنا القريب خللاً ملموساً في الفكر العلمي وتزلزلاً في توقير رجال العلم يصعب تعميره، بسبب تشتت التوجهات والأهداف حينا، أو اختلاط المعلومة بالعلم، والعلم بالفلسفة حيناً آخر. واستفاد الأجانب المقيمون في بلادنـا من هذا الفراغ فائدة جمة، فافتتحوا المدارس بنشاط في كل زاوية من زوايا الوطن، ولقحوا أجيالنا باللقاح الأجنبي من خلال أعشاش التعليم. وتطوعت شريحة منا لتمكين خير أبناء الوطن استعداداً وقابلية، من اشغال مقاعد الدارسة فيها، بل حتى بتقبيل الأيدي والأرجل، ليزيدوا في السرعة المطردة للتغريب. ثم بعد مدة، ضاع الدين وضاع الإيمان، فالدين خراب والإيمان تراب عند هذه الأجيال الغرة المخدوعة. ضاع، فوقعنا كأمة في ابتذال الذات فكراً وتصوراً وفناً وحياة. وهل نعجب من النتيجة، ما دامت هذه المدارس التي سلمناها الأدمغة الطرية بلا توجس أو قلق، تضع في اعتبارها من غير استثناء وفي كل وقت، تقديم الثقافة الأمريكية والأخلاق الفرنسية والعادات والأعراف الإنكليزية، على العلم والتفكير العلمي. ولذلك، بدأ شبابنا التسلي بألعاب الماركسية والدوركهمية واللينينية والماوية، منقسمين إلى معسكرات شتى، بدلاً عن اللحاق بالعصر بعلمهم وفنهم وتقنيتهم. فمنهم من واسى نفسه بأحلام الشيوعية ودكتاتورية البروليتاريا، ومنهم من انغرز في عقدة فرويد، ومنهم من ضيّع عقله في الوجودية مشدوداً إلى سارتر، ومنهم من أسال ماركوس رضابه، ومنهم من أهدر عمره لاهثاً خلف هذيان كامو… لقد عشنا هذا كله في الوطن، وتولى ما يسمى بموائل العلم دَوْر الحاضن لذلك. وفي مرحلة الأزمة هذه، لم تن أصوات القتام وأفواه السواد من تلطيخ اسم الدين وأهل الدين، وتشهير أنواع الجنون الغربي أمام الأنظار. من العسير علينا أن ننسى تلك المرحلة ودُماها الرخيصة. إن من هيأوا تلك الأرضية ضد إرادة إنساننا ووطننا، سيُذكرون دائماً في وجدان الحشد البشري على أنهم مجرمون تاريخياً.
والآن، نريـد أن ندع مهندسي تلك الأيـام السـوداء في خلوة مع مساوئهم، وفينا منهم غثيان في أنفسنا وأنين في قلوبنا، ونتحدث عن عمال الفكر المشتغلين في بناء مستقبلنا.
نعم، لابد من تحقيق تجددنا الذاتي في ظل الفكر العلمي الذي نشحن شبابنا به، وبتمازجهم تمازجاً كاملاً بالعلم والفكر، كما فعلنا ذلك قبل الغرب بقرون مديدة. إن القلق المحسوس بـه في الوجدان العام لسيرنـا المنحوس، وخفقان القلوب بسبب العيش تحت الوصاية سنين وسنين، ورد الفعل لدى إنساننا على استغلالنا قرونا، أورثنا اليوم شهقة كشهقة النبي آدم، ونشيجاً كنشيج النبي يونس، وأنيناً كأنين أيوب عليهم السلام. لكننا نحس اليوم بانكماش المسافة واقترابنا من نقطة الوصول إلى مسافة خطوات، بدفع هذا الشعور والعقل، وبإرشاد تجارب التاريخ.
الوصف الرابع للوارث هـو إعـادة النظر في ملاحظاته عن الكائنات والإنسان والحياة، وتمييز الصحيح من الخطأ فيها بميزان دقيق. ونذكّر بما يأتي في هذا الشأن:
1- إن الكائنات كتاب أشهره الله تعالى أمام العيون ليراجَع باستمرار، والإنسان منشور بلوري مؤهّل لرصد الأعماق في الوجود وفهرست شفاف للدُنى جميعاً.. والحياة تَرَشُّحُ هذا الكتاب وهذا الفهرست، وَتَمَثُّلُ المعاني في انعكاس صدى البيان الإلهي. وما دامت الكائنات والإنسان والحياة باعتبار تلوناتها أوجهاً متنوعة لحقيقة واحدة -وهي كذلك حقاً- فإن تفريقها عن بعضها وتقطيعها ظلم وازدراء للوجود والإنسان، لما فيه من إخلال بانسجام الحقيقة.
إن قراءة بيـان الله الحق سـبحانه من صفة الكلام الجليلة، وفهمه، وإطاعته، والانقياد لـه واجب… فكذلك معرفة الحق تعالى وإدراكه بدلالة الأشياء والحوادث جميعاً، التي صورها سـبحانه بعلمه وأوجدها بقدرته ومشيئته تعالى.. ثم رؤية طرق التوفيق، أسـاس لا يمكن التخلي عنه. فإن الفرقان العظيم من صفة كلامه هو، روحُ الوجود كله والمصـدرُ الأوحد لسعادة الدنيا والعقبى. وإن كتـاب الكائنات هـو جسدُ تلك الحقيقة، وحركية مهمة مؤثرة في حياة الدنيا مباشـرة، وفي حياة العقبى بالوسيلة، باعتبـار تمثيلها لفروع العلم المتنوعة واحتوائها عليها. إذن، لإدراك كلا الكتابين وتحويل فهمهما إلى الواقع العملي، ثم نسج الحياة كلها بمقتضى فهمهما: جزاء الحسنى، ولإهمالهما وغض البصر عنهما، وحتى لتفسيرهما تفسيراً غير مناسب أو إهمال تحويلهما إلى الواقع المعاش: جزاء السوء.
2- ينبغي تقييم الإنسان بالتحري عن الأعماق الإنسانية الحقيقية في الشعور والفكر والشخصية. وكذلك تقييمه في نظر الحق تعالى وعند الناس، كامن في تلك الخصوصيات. فإن الخصال الإنسانية السامية وعمق المشاعر والفكر وسلامته الشخصية كبطاقة اعتماد مطلوبة دائماً وفي كل مكان. ومن يكدر إيمانه وإذعانه بأوصاف وأفكار كفرية، ويُثير القلق والشبهة في محيطه بشخصيته، لن يكون مظهراً لتجلي تأييد الحق تعالى وعنايته. وكذلك لا يمكن أن يحافظ على احترام الناس له وثقتهم به. فإن الحق تعالى، والناس، يقيّمون الإنسان بخصاله الإنسانية وشخصيته الرفيعة ويكافئونه على ذلك. وبناء عليه، لا يتصور أن يتحقق نجاح عظيم أو الحفاظ على نجاح قد تحقق، على يد أناس فقراء في قيمهم الإنسانية وضعفاء في شخصياتهم، وإن ظهر عليهم مظاهر المؤمنين الصالحين. كما لا يتصور أن يفشل فشلا ذريعاً أناسٌ يتقدمون خطوات في سلامة شخصياتهم وخصالهم الإنسانية السامية وإن لم يظهر عليهم مظاهر المسلمين الصالحين. فإن تقدير الله تعالى ومكافأته تنظر إلى الخصال والصفات، وكذلك حُسن قبول البشر يقوم عليها بدرجة ما.
3- ينبغي أن تكون الوسائل إلى الهدف المشروع والحق، شرعيةً وحقاً. إن السائرين في الخط الإسلامي يتحرّون في كل عمل مشروعية الحق في آمالهم وغاياتهم كلها. والتزام مشروعية الوسائل إلى ذلك الحق أيضاً واجب عليهم. فلا يمكن تحصيل رضا الحق تعالى من غير الإخلاص والصدق الذاتي، ولا يمكن خدمة الإسـلام وتوجيه المسلمين إلى مراميه الحقيقية بوسائل شيطانية البتة. ولعلنا نرى حيناً إمكانية ذلك. لكن المستهلك لرصيده من الاعتبار والاحترام في سبل الباطل، والفاقد لرعاية الحق تعالى والتفات الناس إليه، لن يدوم نجاحه أمداً بعيداً يقيناً.
الوصف الخامس للوارث هـو أن يكون حراً في التفكير وموقِّراً لحرية التفكير. إن التحرر وتـذوق حس الحرية عمق مهم لإرادة الإنسان وباب سحري ينفتح على أسـرار الذات. ومن العسير أن نصف بالإنسان مَن لم ينطلق في ذاك العمق ولم يلج من ذاك الباب. ومنذ سنين وسنين ونحن نتلوى ألماً في طوق الأسـر الخارجي والداخلي الرهيب. ولقد ضيقوا علينا وسلطوا أثقالهم أنواعاً وألوانا على مشاعرنا وأفكارنا ونحن في طوق الأسـر الذي يخنقنا… فدع عنك التجدد والتطور في هذا التحديـد للقراءة والتفكير والإحساس والحياة، واسأل إنْ كان في قدرة الإنسان البقاء بملَكَاته ومواهبه الإنسانية في هذا الوسط؟ فإن حماية المستوى الإنساني البسيط والخام في هذه الأرضية عسير، فكيف بإنضاج بشر يسمقون إلى العُلى بروح التجديد ويمدون البصر إلى اللانهايات؟ فلا ننتظر في هذا الوسط إلا أناساً ضعاف الشـخصية وأرواحاً هزيلة ضاوية ومشاعر مشلولة. ونعرف من تاريخنا القريب أن الأسرة والشارع ومؤسسات التعليم وأوساط الفنون قد نفخت في أرواحنا الأفكار الشاذة والموازين الفاسدة، فقلبت رأسـاً على عقب كل شيء، من المادة إلى الروح، ومن الفيزياء إلى الميتافيزيقا. في هذه المرحلة المذكورة، كنا نبدي انحرافا إذ نفكر، ونخطط لكل شيء على محور الأنانية، ولا نحسب حساباً لوجود معتقدات وقناعات أخرى غير معتقداتنا وقناعاتنا، ونلجأ إلى القوة باستمرار كلما سنحت الفرص. وإذ نلجأ إلى القوة، نخنق أنفاس الحق والإرادة والفكر الحر ونجثم على صدور الآخرين. والمؤلم أن هذه الأمور لم تنته بعدُ، ولا نجزم بانتهائها في المستقبل. لكن الواقع يقتضي -إذ نمضي في طريق التجديد أمةً- أن نعيد النظر إلى المحركات التاريخية لألف سنة مضت، وأن نستجوب “التغييرات” و”التحولات” المختلفة لمائة وخمسين سنة مضت. هذا ضروري، لأن الأحكام والقرارات تُقَوْلَب في الحاضر حسب مقدسات(!) مصطنعة. والقرارات المنبثقة من تحت ثقل الفهم السائد المعلوم معلولة… وغير ولودة… وعاجزة بديهةً عن الإعداد للمرحلة المضيئة المأمولة. ولئن أُعدّت لشيء، فإنها تُعِدّ للتصارع بين الحشود المنحشرة في شِـباك غرائز الحرص القاتلة، والخصام بين الأحزاب، والعراك بين الشعوب، والصدام بين القوات. وإنها اليوم هي سبب تضارب شريحة مع أخرى، وتحول التنوع إلى التخاصم، وحتى الوحشية المشهودة في الأرض! فربما كان العالم يختلف عما عليه الآن اختلافاً بعيداً، لو أن البشر لم يكونوا أنانيين ومنساقين للرغبات وقساة إلى هذه الدرجة.
علينا إذن أن نكون أفسح في حرية الفكر وحرية الإرادة في مسيرتنا نحو عوالم مختلفة، سواء في سلوكنا مع الآخرين، أو من زاوية أنانيتنا الذاتية وتمسكنا برغباتنا. فالحاجة ماسة اليوم إلى صدور متسعة تحيط بالتفكير الحر وتنفتح على العلم والبحث العلمي وتستشعر التوافق بين القرآن وسنة الله على الخط الممتد من الكائنات إلى الحيـاة. ولن يقتدر على ذلك في هذا الزمان إلا جماعة تتحمل دعوة مشبعة بالدهاء. وفي الواقع كانت هذه الأمور العظام تمثل في أفراد دهـاة في الماضي. لكن كل شيء اليوم توسـع في التفريعات توسعاً يعجز الفرد الفريـد عن حمل العبء، فحلت الشخصية المعنوية والتشاور والشعور الجمعي محل الدهاء. وهذا هو خلاصة الخطوة السادسة لورثة الأرض.
ولا يمكن إلصاق هذا الفهم بالمجتمع الإسلامي في تاريخنا القريب. ذلك لأن التعليم التقليدي لم يزد على ترداد مسلماتها الثابتة، والمدرسة التقليدية أطلت على الحياة من حافاتها وأطرافها، والتكية (الزاوية) دفنت نفسها في الميتافيزيقا تماماً، والثكنة توترت بالقوة وحدها وزمجرت بالقوة وحدها. فمن الإجحاف إذن أن نحمّل هـذه المؤسسات في تلك المرحلة مسؤولية نمط الحياة.
في تلك المرحلة، هيمن الفكر السكولاستيكي( ) (Scolastique) على التعليم التقليدي ولم يتنفس إلاّ هواءه، وعاشت المدرسة التقليدية مشلولة لغلق أبوابها بوجه العلم والفكر والحرمان من قوة الإبداع والإنشاء، وسَلَّتْ التكية والزاوية نفسَها بقراءة المناقب بدلاً عن العشق والشوق، واستحكمت في ممثلي القوة عقدة إثبات الذات والتذكير بالنفس بصورة متكررة لظنهم أنهم قد أُهمِلوا… وفي خضم ذلك، انقلب كل شيء رأسـاً على عقب، وانقعلت شجرة الأمة لتهوي إلى الأرض. ويبدو أن هذه الزلازل لن تسكن إلى يومٍ يتهيأ فيه السعداء الذين يمهّد القدر دروبهم لاستخدام هذه الحركيات استخداماً أمثل، ولتنفيس الاختناقات بين القلب والعقل وفتح ممرات الإلهام والتفكر في أعماق الإنسان النفسية.
الوصف السابع للوارث هو الفكر الرياضي. لقد حقق الأوائل في آسيا في الزمن الماضي، ثم الغربيون، نهضتهم بفكر القوانين الريـاضية. ولقد كشفت الإنسانية في تاريخها كثيراً من المجاهيل والمغلقات بدنيا الرياضيات المفعمة بالأسـرار. فإذا تركنا التصرف المفرط للحروفية جانباً، فإنـه لولا الرياضيات لما توضحت المناسـبات بين البشر ولا بين الأشـياء… فهي -كمصدر نور- تضيء طريقنا في الخط الممتد من الكائنات إلى الحياة، وترينا ما بعد أفق الإنسان، بل أعماق عالم الإمكان العسير التفكير فيه وتحمله، واللقاء بغاياتنا.
لكن العلم بالأشياء المتعلقة بالرياضيات لا يعني أن العالِم بها رياضي. الرياضي يجمع بين الرياضيات وقوانينها فكرياً، ويصاحبها دائماً في الطريق الممتد من الفكر الإنساني إلى أعماق الوجود. يصاحبها دائماً من الفيزياء إلى الميتافيزيقا، ومن المادة إلى الطاقة، ومن الجسد إلى الروح، ومن الشريعة إلى التصوف. إننا مضطرون إلى قبول الأسـلوب المزدوج لفهم الوجود فهما شاملاً: وأعني الفكر التصوفي والبحث العلمي. لقد أرهق الغرب نفسه لملء فراغ جوهر لم يعرفه أساساً، فحاول سد الحاجة نسبياً بالالتجاء إلى الروحية (Mysticism). أما نحن، فلسنا بحاجة إلى التفتيش عن شي أجنبي أو اللجوء إلى أي شيء لعالمنا المتمازج بروح الإسلام على مدى الزمان. إن مصادر طاقتنا موجودة في منظومتنا الفكرية والإيمانية. فالمفيد أن نحيط بفهمنا هذا المصدر والروح كما هو في ثرائه الأول… فنشهد عندئذٍ شيئاً من المناسبات الخفية في الوجود والمحركات المنسجمة لهذه المناسبات، ونبلغ إلى تطلع مختلف، وعرفان ذوقٍ مغاير، في النظر إلى كل شيء.
بعد تقديم خلاصة قصيرة عن الفكر الرياضي قد تبدو غامضة وإسرافاً في الكلام، لكني أثق بدوي أصدائه في المستقبل، أريـد أن أنوّه إلى الوصف الثامن وهو فكرنا الفني. لكني بناء على ملاحظات معينة، أكتفي هنا بقول جولفر: “بعض الأوساط ليست على استعداد حتى الآن للانخراط في هذه المسيرة بمقاييسنا”، فاختم بهذا التنويه.