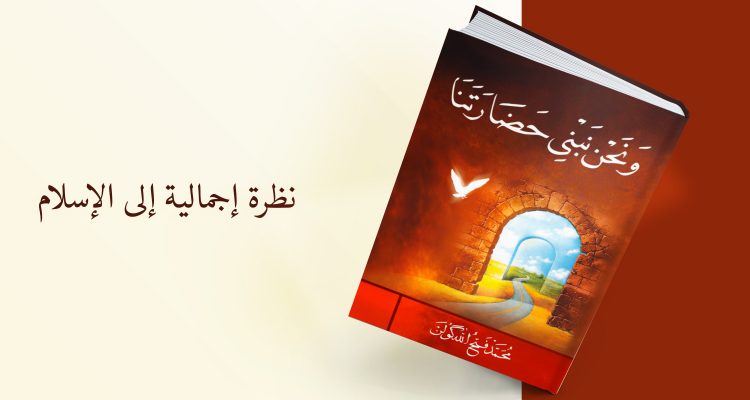الإسلام مشتق من مادة السلم والسلام، ومعناه استسلام العبد لله تعالى، وانقياده لأوامره، وانخراطه في السير في طريق سليم وسديد نحوَ السلامة، وبثُّ الأمان في الناس وفي كل شيء، كما يعني سلامة الآخرين من لسانه ويده.
أساس الإسلام ومبدؤه هو الإيمان والإذعان، ومنتهاه الإحسان والإخلاص. وحقيقةُ الإسلام بإيجازٍ، هي أن يصدِّق المرء بحقيقة الألوهية تصديقًا لا يحتمل الضد مطلقًا، ويوثقَ رابطة قلبه بالحق تعالى، ويؤديَ التكاليف أداءً دقيقًا ورقيقًا وكأنه يرى اللٰه تعالى أو يراه الله تعالى، وأن يسعى في بلوغ رضا الله في كل عمل يعمله.
وقد عرّف بعضهم الإسلام تلخيصًا بأنه: “التسليم لله سبحانه وتعالى وإظهار الانقياد والولاء له بالشكر قولاً وفعلاً وحالاً، والمكوث في الرغب والرهب الدائم”. فالذي على هذا الحال، يسمى مؤمنًا أو مسلمًا -وليس إسلاميًّا (Islamist-İslamcı)( )- ويعتبر مرشَّحا لنيل السعادة الأبدية
إن الإسلام الذي يستند إلى الوحي الإلهي، وبلَّغه الرسول r وتَمثَّله وأحياه وطبَّقه.. دين سماوي. والمؤمن والمسلم هو من يجعل الإيمان بهذا الدين، إحياءً لحياته. ففي أساس الإسلام وباطنِه الإيمانُ والإذعان والتسليم، وفي ظاهره الطاعةُ والانقياد والعمل الصالح. وعرَّف السلف الدين بأنه: “وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات”. وإنما يمكن الحصول على الثمار الدنيوية والأخروية لمنظومةٍ حركيةٍ فعَّالة كهذه بقدر جعلها عنصرًا لإحياء الحياة، وبمقدار تمثُّلها في الواقع. وإلا فيتعسر الحديث عن محاسنها إذا أقصيت إلى خارج الحياة.
ومع الانتباه للتمييز اللغوي بين الإسلام والإيمان، فالرأي الأرجح المقبول، هو أنْ لا إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام؛ الإيمان باطن، والإسلام هو الظاهر بانعكاسه على القول والفعل والحال. والنظام الإلهي الذي نسميه “الدين الحق” هو الأمر الجامع لذلك كله. فالدين هو عنوان إلهي يعني أنْ يكون الإيمان والإسلام بجميع شُعَبهما وكلياتهما حياة للحياة. وإن القبول بهذا النظام على هذا الوجه وتطبيقَه في واقع الحياة، هو التصرف المؤمن، والذي يمثله بهذه الحال هو “المتديّن” التقي وليس “الديني”( ). فبناءً على هذا، الذين يظنون أن الدين مجردُ “اعتقادٍ”، وكذلك “المسلمون بالثقافة” الذين لم يتقبلوه قبولاً خالصًا في صميم قلوبهم، كلاهما مخدوع. وجليّ أن كلتا الزمرتين محرومة، وستحرم، من حسن ثواب الدنيا والآخرة التي وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الدين والتدين.
لكن لا يصح احتساب العمل جزءًا من الإيمان استنادًا إلى ما ذكرناه آنفا؛ فمن اعتقد بأن العمل فرض ثم تَرَك إقامتَه وإجراءَه على وجهه فمع أنه يكون آثمًا ومرتكبَ ذنبٍ، لكنه يعتبر مؤمنًا. ولا علاقة لهذا الذي نقوله بأفكار “المرجئة” البتة، ذلك بأن الاستهانة بالذنوب مع الإيمانِ شيء، وتقويمَ المسألة في إطارِ “أن الله إن شاء غفر، وإن شاء عذب” شيء آخر. والإيمانُ -حسب القرآن- أصلٌ لابد منه، وأساسٌ ضروري لا يقوم شيء إلا به، وأما الإسلام فهو الوسيلة الوحيدة لصيرورة الإيمان من أعماق طبع الإنسان.
فالعمل من غير إيمانٍ نفاقٌ، وتركُ العمل رغم وجود الإيمان فسقٌ. ولا يُغفر عن النفاق بتاتا باعتباره كفرًا مخفيًّا ومضمرًا، أما الفسق أو الفجور، فيحتمل فيه المغفرة -في كل وقت- بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الحق تعالى. وبهذا الاعتبار، ينبغي أن نحافظ على حسن الظن بحق تارك العمل الذي لا يزدري به أو لا يستحقره أو لا يستهين به، وأن لا نحكم عليه بالكفر؛ وأما تارك العمل الذي يستحقر المؤمنين لكونهم مسلمين ويُسَفّههم، فللظن به وجه آخر غير الوجه الأول.
ويَجدر أن نذكّر ههنا، بأن محطّ الإيمان ومحل انكشافه هو القلب والوجدان، وبأن الله تعالى يريد -بمقتضى الإسلام- أصلاً مهمًّا آخر مع هذا القبول الوجداني، ألا وهو العمل الصالح والخلُق الحسن. فمِن هذه الوجهة، ينبغي على المؤمن أن يحفظ -في كل وقت- ما صدّق به وآمن، سواء الأمور النظرية أو الشؤون العملية، إلا أن يُكره أو يُضْطر.
نعم، كما أنه لابد من تجنّب الشرك وكلِّ شوائب الشرك، لكي نكون مسلمين، ينبغي -كذلك- تعليق القلب بالله بإخلاص، وعبادةُ الله كأننا نراه أو كأنه يرانا، وإجراءُ التصرفات الاجتماعية في إطار “الخلُق الحسن” الذي يأمر به الإسلام… وذلك كله، انعكاس لصور الروح الإسلامية على حياة الإنسان بأبعاد تجلياتها المختلفة. إن هذه الشؤون التي يمكن أن نُرجعها إلى الإيمان والإسلام والإحسان -كما ورد في حديث جبريل المشهور- هي بعينها، سلسلةٌ من اللوازم المرتبطة ببعضها البعض والمتداعيةِ فيما بينها، وأعماقٌ مختلفةٌ لشأنٍ واحدٍ، مع الأخذ بالاعتبار أن الأصل الأساس هو الإيمان، وذلك باعتبار فروق الظاهر والباطن للحقيقة الواحدة. إن الباطن يستدعي الظاهر ويربو به، وإن الظاهر يستند إلى الباطن ويتأسس عليه ويقوم به. وإن العملي هو صوت لروح النظري وجوهرِه.
فما دام أصل المسألة كذلك، فادعاء أن الدين محضُ مسألةٍ وجدانية، استهانةٌ بروح الدين ووقاحةٌ وتجاوُزٌ للحد. والذي يُظهِر قبولَه للدين -والله يتولى السرائر- ثم يقول: “اعتبرْ بما في قلبي”، ثم يتعدى ذلك إلى اعتبار الانشغال بالجوانب العملية للدين تطرفًا، فإنما يُمنّي نفسه بالأوهام الفارغة ويستتر عن المؤمنين بقناع الإيمان. إن تفسير الإيمان والإسلام تفسيرًا يمالئ أهواء الناس وغرائزهم، يخرجه عن دائرة الدين السماوي، ويجعله نظامًا بشريًّا؛ والأصل أن الإسلام وضْعٌ إلهيّ إلى البشر لإنقاذهم من الأهواء والغرائز وربطهِم بالحق وهداية الحق تعالى. أو بتعبير آخر، هو مجموع السنن الإلهية المنـزلة لإخراج البشر من سجن الحيوانية وضِيق الجسمانية، وتجهيزِهم للانطلاق والسياحة في الإقليم الرحيب الفسيح للقلب والروح. وإن روح هذا النظام الذي لا نظير له هو الإيمان، وجسدَه هو الإسلام، وشعورَه هو الإحسان، وعنوانَه المعظم هو الدين.
الدين -وكما قلنا في البداية- يخاطب العقلاء وأصحاب الشعور، ويوجههم بإرادتهم واختيارهم إلى الخير الدنيوي والأخروي، ويَعِدُ المستجيبين له، بالسعادة الأبدية. إن موقع المكلفين حيال الدين ليس الانسحاق تحت مسؤولياتهم إزاءه، بل -انطلاقًا من حقيقةِ “الخالقُ أعلم بخلقه”- تعليق الصلاح والحَسَن والخير والسعادة الأبدية بإرادتهم -في مستوى الشرط العادي- في علم الله وبإرادته وتقديره، تكريمٌ وتلطيفٌ من المشيئة الكلية إلى الاختيار الجزئي الموهوب لهم قديمًا. والدين بهذا الوجه من حيث أداؤه المعبِّر عن الألوهية وتفسيرُه المعبر عن العبودية، يختلف اختلافًا بيّنًا عن التنظيمات المتشكلة في صورة أديان؛ فأولا وقبل كل شيء، المخاطَبون في هذا الدين هم أصحاب العقول والإرادةِ، الذين يسْعَوْن إلى تطبيق هذا النظام الذي وضعه الله تعالى، ويَجِدُّون في تمثله. وبهذا الاعتبار يمكن تفسير الدين من وجهة أخرى بأنه: لطفٌ وتوجهٌ خاص إلى جاهزيةٍ خاصة. فإن عديم العقل والإرادة، ليس مكلفًا بالدين، وليس محلا للتوجيه إلى الخير.
نعم، إن العقل والإرادة هما الشرط الأول للدين وأهم أركان “التدين” الذي معناه أن يكون الإسلام حياةً للحياة. ويعني هذا، أن من لا عقل ولا إرادة له، ليس محلاً للتكليف بمسؤولية الدين التي تتطلب قابلية التمييز بين الخير والشر. فهو في حِلٍّ من الدين الذي هو مجموعة القوانين الإلهية، التي تَشترط العقلَ والاختيارَ أولاً، ومن التدين الذي هو مِن خَلقِ الله تعالى وكسبِ البشر.
وإن هذا الدين -باعتباره وضعًا وتكليفًا من العليم بخلقه- يرشد ويقود إلى الخير أبدًا، ويُجيش القلوب بوعدِ حُسن العاقبة، ويدعو إلى التحوط والحذر بوعيدِ سوء العاقبة. وأوامره ووصاياه في هذا الصدد، باقية وثابتة لا تَخلَق جدَّتها. فإن هذه الأوامر والوصايا، ذات أداء أزلي وهندام أبدي… تَخْلَق الأنظمةُ كلها وتَبلَى، وتبقى هي جديدةً وندية ومغبوطة، إلا في عينِ مَن مَنعتْه الأحكامُ المسبقة من النظر السليم. فما من وسيلة أو طريق للخير والسعادة من نتاج عقل البشر، إلا ويُحكم عليها بالزوال أو القِدم.. ويَعرض عليها التبدل من مجتمع إلى آخر، وتتـرهل وتخرق بمرور الزمان، وتستهلك وتتهرأ بالغلط والتصحيح المستمرَّيْن… فهي لا تتعدى أن تكون “نُظَيْماتٍ” تُـمَـنِّي بخيرات نسبية وإضافية في مستوى معين، بل تبدو وكأنها تُمَنّي بالخيرات بالنظر إلى ظاهر أمرها، لكنها لم تحقِّق قط ما تصبو إليه البشرية في الماضي، ولن تحقق أمانيها البتة في المستقبل.
أما الدين الحق، فقد جاء برسالات البُشرَى التي تستجيب لكل مطالب الإنسان المخلوق للأبدية، والمرشحِ لها، والمتقلبِ دائمًا في آمال السعادة الأبدية. وإذ جاء بها لم يكلِّف الإنسانَ بتكليفٍ يخالف ماهيته وذاته، ولم يُهمِلْ رغبةً مِن رغباته ولا مطلبًا من مطالبه؛ فالعقول السليمة والأفكار المستقيمة تُقِرُّ أنْ لا إغفال ولا إحجام في هذا الدين عن رغبات الإنسان ومطالبه وأمانيه، ولا تَناقُض في أوامره التكوينية أو في تفسيرها. وفوق ذلك كله؛ إنه منظومة ممتازة، مفصلة حسب ماهية الإنسان وقابلياته وآماله وميوله، يَعِده ويرجيه بالسعادة الأخروية ورضى الحق تعالى وإمكان رؤية الله سبحانه.
وما دام امرؤ يعيش حياته وفاقًا لدين الإسلام، فإنه يستفيد من النعم المشروعة كافة في هذه الدنيا، وكذا يقضي عمره في نشوة السير في الدروب الموفية إلى الجنة بملاحظة الاطمئنان إلى حظوته بمزيد من ألطاف الحق تعالى حينما يحين الأوان، مع نوال الثواب وحسن الجزاء في الأخرى بقدر يتعدى الخيال والتصور. هذا، وإذا وسعه أن يعيش حياته بالارتباط الدائم مع رضا الحق تعالى -وهو الأساس في التدين- فلعلنا لا نكون مبالِغين إذا قلنا إنه يباري الملائكة. وبالمقابل، يقف المتنكر للدين الحق، والمنقادُ “لعقل المَعاش”، والمنتسبُ إلى تنظيمات مختلفة متشكلة في صورة أديان، والمُناصرُ للنُّظُم البشرية أو الدنيوية (اللادينية)… عاجز عن تبيان ما يُطَمْئِن الإنسانَ أو يُقنعه بشأن حاضره وقابله، وسوف يعجز لا محالة! لأن هذا الدين هو نظام الله في الأرض. والله هو الخالق، والخالق هو الأعلم بكل شيء. ولا جرم أن كل فكر ومنهج ونظام بشريٍّ لِما أنه نتاج الإدراك المنحصر، من الممكن أن يعتلّ في أغلب الأحوال بعلات الأغراض والمنافع الشخصية أو العائلية أو القومية. ولذلك هي مُنْبَتَّةٌ لا تُوصِل إلى الخير المطلق، ولا يُرتجى منها السعادةُ الأبدية. فالمنظومات والنُّظُم المختلفة المحصورُ أفقُها بالأغراض الشخصية والنعراتِ العرقية والمصالح الطبقية والفئوية، مهما بدت متكاملة، فلن تستجيب لرغبات الإنسان ومتطلباته غير المحصورة. فإن من طبيعة هذه الأمور أن يكون أصحابها ذوي ذهنٍ كدر، وعقلٍ مشوش، ومنطقٍ أعمى، وشعورٍ قصير النظر، ووجدانٍ وبصيرةٍ ملبدةِ الأفق بالدخان والقتام… فهم لا يستطيعون أن يبصروا ما ينبغي أن يُرى، وإن يبصروا يبصروا شتاتًا وشيئًا معوجًّا، فتخرج تفسيراتهم مثقلة بالأغلاط وكليمة بالأخطاء.
الدين الحق نظام فريد لا يُضِل، ووضْعٌ إلهيٌّ فسيح ورحيب يفتح آفاقًا دنيوية وأخروية جديدة. فهذا النظام اللاهوتي “دينٌ” باعتبار أبعاده الاعتقادية، و”شريعةٌ” من وجهته العملية، و”ملّة” بوظائفه الاجتماعية… وهذه المعاني هي المقصودة متى ما نقول: “الملة الإسلامية”. الواقع أن أسلوب إجراء الحركات والفعاليات كلها يتوافق مع جوهر الإيمان، وكيفما كانت الصورة التي عليها الإيمان. والهيئة الاجتماعية تأخذ شكلها حسب تلك التصرفات والسلوكيات والفعاليات. ولذلك يجب على المؤمن الذي آمن إيمانًا سديدًا، وجعلَ هذا الإيمانَ بالعمل الصالح عمقًا من أعماق طبيعته وجِبِلّته، أن يكون عاشقًا للحقيقة، ومنحازًا إلى الحق، وعادلا، ومستقيمًا، وأمينًا، ومثالاً للخلق الحسن، وسالكًا سبيل العلم والمعرفة، ومشدودًا شدًا مُحْكمًا إلى الجاذبية القدسية للدين، ومنشغلا بدافع الارتقاء إلى موقع العنصر الفعال في الموازنات الدولية… فتجده متحفزًا في هذه الأحوال، بل لابد أن يكون كذلك، وأن لا يتأخر طرفة عين حتى يحقق ما يريد.
إن المؤمن الذي كَمُل إيمانه وارتقى إيمانه إلى مرتبة الإذعان، وأعمالُه كلها موزونة بموازين الحق، وقلبُه موصول في كل وقت بربه، وتصرفاتُه كلها منطبعة بتلك الصلة الربانية… هذا المؤمن لن يستوقفه هذا وذاك، ولن يدور البتة في فَلَك الآخرين مهما كانوا؛ يقوم ويقعد حاملاً شعور الانتماء إلى أمة شريفة ممسكة بالمركز (أمة الوسط)، ومتميزًا بخصاله في كل حركة من حركاته. إنه يحس بتوقير غائر حيال كل إنسان وكل شيء مخلوق، لأجل الخالق، ويتوقى من الدنايا التي لا تأتلف مع نعمة “الإنسانية”، ويَبرز بين الناس بفائقيةِ دينه وإيمانه وفكره وسلوكياته، وإذ يتصرف كذلك، لا يعتريه قط استعلاءٌ أو كبر، ولا يفكر في إكراهِ غيره على قبول فهمه وفلسفته في الحياة. فهو يتقبل الآخر “كَمَا هُو” بملاحظةِ أن النظام الذي آمن به يَقطع سبيل الإكراه في الدين؛ فيعيش بمحبةِ مسلكه ومشربه بدلاً عن إجبار الآخرين على معتقداته، ويُشهر أفكاره ومعتقداته ويمثلها تمثيلاً سليمًا، ويعتني عناية شديدة بأن يكون أنموذجًا يغبطه الناس، وإذ يقوم بذلك، لا يستجدي إعجابًا ومديحًا من أحد قطّ، بل يَحتسب كلَّ عمل من ضرورات السبيل لكسب رضى الحق تعالى؛ فلا يفكر إلا في مرضاة الحق تعالى في كل قول وعمل وسلوك، ويعرف أن المباهاة والبهارج جراثيمُ تَقتل القلب، ويتمسك بالحق تعالى بإخلاص كامل، ثم يمضي في مسيرته.
فالأصل أن الإسلام جاء لإنقاذ البشر من الإكراه، وتحفيزِهم لاختيارٍ جديدٍ بإرادتهم الحرة مخاطِبًا عقولهم ومنطقهم، وليس لدفع أتباعه إلى الضغط على هذا وذاك للقبول بنظام معتقداتهم أو إكراههم عليه. ففي الأيام التي طُبِّق الدين بلا نقص ولا فتور، فإن جاذبيته المعنوية لم تَدَعْ حاجةً إلى ألاعيبِ المنطق الملتوية، أو القوة الطائشة، أو القهر الصريح أو الخفي، أو الجبر والإكراه؛ فلقد نطقت الحالُ وأبانت، ووضَّح اللسانُ المبهماتِ، فإذا خلا الميدانُ للقول، خوطب الوجدان، وبَشَّر البيانُ وأنذر، متحليًا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يُضغَط على أحد لا قولا ولا فعلا ناهيك عن الإكراه والجبر، بل كان الإكراه والجبر ممتنعًا، لأن الإسلام لا يَقبل إيمان المكرَه والمقهور، ولأن الأعمال القائمة على الجبر والقوة القاهرة تُناقِض جوهره وروحه. بل لا يَحتسِبُ الدينُ الحقُّ من العبادات عملا ليس في أصله الإخلاص أو رضى الله تعالى. فلا يَرى في إيمان المكره والمقهور إيمانًا، بل نفاقًا، ولا الأعمالَ أعمالاً، بل رياءً بشُعبها كافة. لذلك، لا يجيز الإسلامُ الإكراهَ في الدين، ويمنعه بنص القرآن: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾(البقرة:256)، فيقطع دابرَ القهر لأنه يَعتبر الرياء عينَ النفاق، ويَعتبر النفاقَ كفرًا مستورًا. والحال أن الإسلام جاء ليقتلع جذور الكفر، ويمحوَ الشرك من الشعور والفكر، ويُغلقَ أبواب الرياء والسمعة.
لكنَّ مَنْعَ هذا الإكراهِ والجبر، لا ينفي الإجبار الداخلي للوجدان، أو التأثُّرَ والميل الشبيه بالقهر، المتولدَ في القلب المؤهلِ لمعرفة فضل التوقير وحق الاحترام حيال التعبير عن الحق قولاً وفعلاً. فمن الطبيعي أن يخاطَب وجدانُ البشر جميعًا بالأسلوب القرآني في كل فرصة متاحة، وأن تُحَفّزَ الفطراتُ السليمة، وأن تُخلَّصَ البشريةُ من الشرك وشوائبه بتوجيه القلوبِ الممهدةِ والمستعدة، إلى الله تعالى، ويُهَيَّجَ الإيمان ونورُ الإسلام وشعورُ الإخلاص والإحسانِ في القلوب، بتبليغ الناس جميعًا أنَّ أصفى الهداية وأخلصَها ممثلةٌ في سيدنا محمد r، وأن حقيقة الإنسان والأشياء والكائنات قد نودي بها في القرآن، وأن الحُكم والحكمة في قبضة الله تعالى. فَبذلك يُبعث في القلوب نورُ الإيمان والإسلامِ وشعورُ الإحسان والإخلاص، ويُنادَى الجميعُ إلى التوحيد الحقيقي. وهذا من الضرورات اللازمة لإيماننا بالإسلام واستجابتنا لدعوة سيدنا r.
إن نبينا خاتمُ الأنبياء، ورسالته التي قَدمها للإنسانية أكملُ الرسالات وأتمها، وأهدى الوسائل إلى الله وأضمنها وأوثقُها؛ ولم ترشِد إلا إلى الصواب والهدى. فمتى ما وَجد هذا الدينُ من يمثِّله صدقًا صار ظلاً للحق، يلجأ إليه الناس من كل فئة سراعًا ليتفيأوا في ظله، وأَبطَل سحرَ الأنظمة الشيطانية كلها، ولم يَترك أتباعَه من غير نور حتى في أحلك الأحوال. فإن كان لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يعبر عن نفسه تعبيرًا كاملاً، فذلك بعداوة خصومه الألدّاء المستمرة بلا توانٍ منذ عصور، وحقدِهم وبغضهم وتشويههم لصورته ومحاربتهم له من جهة، ولجهل منتسبيه وخذلانهم وغفلتهم من جهة أخرى. ولكن دوام هذا الحال محال؛ فحينما يحين الوقت، فسيَجد الفرصةَ لكي يعبّر عن نفسه كرّة أخرى في مناحي الحياة كافة، ويتكلم بصوته الخاص، ويشعشع في العيون بألوانه ورقوشه الذاتية، ويحسِّس بكنهه في كل مكان بتناغمه وانسجامه السماوي، وذلك بفحوى “الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه” (رواه البيهقي)، وبفضل أوليائه الذين يتولونه بخالص قلوبهم، ويربطون مصيرهم به، فيَجعلون غايةَ خَلْقِهم السيرَ في خطه.
نعم، حينما تنتبه هذه “الأمة” إلى أنها الأمة المصطفاة من الله، وأنه هو اختار لهم اسم “المسلمين” بمنطوقِ ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾(الحج:78) فستقول: ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾(الحج:78)، وتتوجه إلى ربها الكريم، وتستسلم لحكمته، وستسمو في النهاية -لا محالة- إلى حال التعبير عن ذاتها بالصورة التي يريدها الحق تعالى.
والصحيح أن إحراز هذا الموقع من الأمور التي يمكن أن تتحقق فعلاً في كل وقت. فإن الإسلام هو الدين الخاتم الكامل الذي اختاره الله تعالى ليشرِّف به الإنسانيةَ. وهو بختمه وبكماله، تفصيلٌ وبسطٌ وأداء للأديان السماوية كلها حسب متطلبات الزمان الأخير. لكن هذا النظام الكامل محروم الآن من تمثيل في مستوى تمثيل الشهود الأوائل، ومبتلىً بسوء الحظِ في أيدي نفرٍ عديمي الوفاء، فهو لذلك محكوم عليه اليوم بالانحباس في الضيق وهو رحيب، وبالمنع من الكلام بلهجته الخاصة. وهذا يعني -في الوقت نفسه- تضييقًا وحظرًا على الأديان السماوية كافة… إذ من البديهي أن الإسلام جاء مصدقًا للأنبياء جميعًا، ولرسالاتهم كلها مراعيا ما بلغه إدراك البشر وفهمُه… فصار بمثابةِ نداءٍ جامعٍ لأصواتهم وأنفاسهم أجمعين. وإن انقطاع صوت هذا النداء السماوي، وفي عصرٍ جمحت وطغت فيه الأفكارُ والمعتقداتُ الماديةُ والطبيعية، هو انهزام وخسران للأديان الأخرى أيضًا تجاه هذه التيارات العفريتية المتمردة، بل يعني انقراضَها تمامًا. فالإسلام ذودٌ عن الدين الحق وصون له. وكذلك هو – باعتبار أن دعوة الأنبياء جميعًا واحدة- بمثابة نقطةِ استنادٍ للنُّظُم السماوية الأخرى ونقطةِ استمدادٍ لها وشاهدٍ يشهد لها. فإحياء الإسلام مجددًا يُعَدّ إحياءً لها أيضًا في معنى من المعاني، بإصلاح الجوانب اللازم إصلاحُها، وتجديدِ وإعمارِ ما ينبغي إعادة تعميره ولو جزئيًا، وفتحِ آفاق جديدة أمام أَتْباعها بالضوابط ذات الدور التأسيسي فيها. وإني أظن ذلك كله ممكنا، وأحسب أن وحدة المصدر مُعِين وسند متين في هذا الأمر.
إن الأديان كلها ركزت على أصول وأسس معينة واحدة، وأكدت على حقائقَ بعينها. ومن حيث الضوابط الأصلية -وبالتناسب مع أحوال الزمان وحاجاته- كلُّ نبي بعثه الله تعالى قام بدور الامتداد لمن سبقه والمكمل والمتتم له.. وصَدَّق رسالةَ السابق أو السابقين، وكمَّلها حسب الأحوال والشرائط، وبسط للأمور التي تتطلب التفصيل، وجدد المسائل المحتاجة إلى تجديد، وفي الأحوال كلها أكد على الأمور الأصيلة بعينها؛ فالتوحيد والنبوة والبعث والنشور والعبادة هي المسائل المقدَّمة العزيزة لكل نبي… فهي الزبدة في دعوة الأنبياء والمرسلين أجمعين، مع حق التنوع في الأسلوب والتعبير والبيان والأداء. أما الفروق في الديانات، أو الإجمال والتفصيل، والإطلاق والتقييد، والوضوح والخفاء… وأمثالها في المسائل المختلفة، فتتعلق بأفق إدراك البشرية وتَحَضُّرِها وتطورها. فقد شرَّع الحق تعالى لكل أمة أوامر وقوانين خاصة تتعلق بالفروع حسب مبلغ علم تلك الأمة وإحاطتها، ونوعِ معضلاتها وحاجاتها، ووضَّح مجدَّدًا الأسسَ التكوينية والضوابط التشريعية حسب إدراك المخاطَبين، وبَيَّن تَنَزّلاته الكلامية بتنوعاتها المتعددة ببعدِ تجلٍّ مختلف في كل مرحلة. فتوالى التنوع والتجديد في أمور مثل تفصيل الإجمال وإطلاق المقيد وتعميم الخاص وتوضيح المبهم، مع أن محور المضمون والمنطوق واحد وثابت. فكم من المسائل هي كافية للمبتدئ والبدوي، تستدعي تفصيلا أكثر للمنتهي والحضري.
فهنا نشهد تبدلاً دائمًا في المسائل التبعية الثانوية في رسالات الأنبياء والرسل ابتداءً من أولهم إلى خاتمهم، بالصورة المبينة آنفًا، لكن هذا التبدل لم يمس أبدًا روحَ الرسالة الأصل، ولم يغادر حدود التفرعات. أما التفرق والاختلاف والصراع والحروب الناشئة منهما بين أتباع الأديان السماوية، فليس مردها إلى الدين والتدين بل إلى تفسيرات خاطئة كان يسوقها المبتدئون من أتباع الأديان الذين لم يحافظوا على أصل الرسالة الإلهية وتربوا على الانجراف وراء المصالح والحقد والبغض والانحراف والأهواء والنـزوات… ولا زالت القضية كذلك. فمن أجل ألا تقع أنواع التنازع والتفرق كما وقع أمس، ولكي نلم الشعث إن كان قد وقع اليوم، يجب القبول بالإيمان وبالإسلام وفاقًا للأصول والأسس التي وضعها الله تعالى، وجعْلُها جزءًا لا يتجزأ من طبعنا وجِبِلّتنا. ولكن الحاجة ماسة إلى “العمل الصالح” لكي يثمر هذا الإيمانُ ويبدي قوتَه… بعبارة أخرى: حتى يسبغ الحياة على الوجدان؛ فبقدر إسناد الإيمان بالعمل الصالح، وإمداد المؤمن بالعبادة، يقترب إلى الله تعالى، ويظل محافظا على هذا القرب واكتسابِ رضاه. وإلاَّ، فالإيمان الذي لم يُمَدَّ بالعبادة ولم يُسنَد بها، لن يبدي قوته تمامًا. وكذلك المؤمن الذي ليس له عبودية لن يستطيع الثبات منتصبًا على ساقيه أمدًا طويلا. ولذلك ما برح القرآن الكريم يُتبِع الإيمان بالعمل الصالح ويُذكِّرُ بظاهر “العمل بالأركان” مع باطن “التصديق بالقلب” الذي هو الركن الأساس، ولا يفتأ ينبه إلى الحزم في مناسباتنا الداخلية والخارجية، الباطنة والظاهرة… إذ الإيمان أساس وحيد للعمل، والعملُ سُور للإيمان وصونٌ وشاهد وضمان له.
إن التصرفات الحسنة غير المستمدة من الإيمان هي أعمال توافقت مع الصواب لا يُحتَمَل دوامها وتماديها بتاتا… ولا تُمنِّي بمستقبل واعدٍ البتة. والإيمانُ من غير عمل إيمانٌ غير مسنود، قد يَعرِض عليه التصدعُ والانهيار، ولا يُحتَمَل انفساحُه وتوسعُه، وتقليدٌ بارد عبارة عن مقبولات نظرية. أما الإسلام الذي نسميه “الدين الحق”، فهو العنوان المبجَّل للعمل بكل المسؤوليات والتكاليف التي جاء بها القرآن، إلى جانب الإيمان القلبي الصادق بمجموع الأصول والفروع لهاتين الحقيقتين.
فالإسلام بهذا الفهم هو المصدر الفريد الوحيد لسعادة الإنسان القلبيةِ والروحية، والمادية والمعنوية، والدنيوية والأخروية. غير أن الاستفادة من مصدر كهذا على الوجه الأتم قد نيطت بالاستخدام الأمثل للأجهزة الظاهرية والباطنية الموهوبة للإنسان بالفطرة. فالذين يستخدمون مواهبهم الأولية كأجهزةِ استقبالٍ للواردات الثانية، يبدأون أعمالهم بالمحاسن والألطاف، ويقضونها بالمحاسن والألطاف في الأجواء الزرقاء “للدوائر الصالحة”،( ) ويُفلحون بإنجازِ أعمالٍ تُنبئ عن مدارجِ الأبدية في كل آن ولمحةِ بصرٍ من حياتهم.
وما برح الإسلام مصدرَ عزٍ وقوة لأتباعه الذين يؤمنون به ويَحيَونه بصدق، وقد أسعدهم بقدرِ صدقِ انتسابهم، ولم يُوقِعْهم قط في خذلانٍ دائم أو متمادٍ. فمنذ عهد الصحابة وحتى اليوم كَمْ عشنا بفضله في فترات مختلفة عصورًا ذهبية وأقمنا حضارات زاهية. وبالمقابل في مراحل الشؤم التي وَلَّينا الدينَ ظهورَنا وقطعنا علاقته عن الحياة! توالت علينا النكبات وضجت الجموع عويلاً في الانكسارات، وانقصم ظهر المجتمع حتى عجز عن القيام. ولكنْ -حتى في تلك المراحل- هناك الكثير ممن ظَلَّ مؤمنًا بالدين وقوته، غير أنهم حدَّقوا بأبصارهم في أفق الجدود والحظوات الخارقة، وقاموا وقعدوا حالمين بعنايةِ الكرامات الخارقة، وغضوا البصر عن العادات والسنن الإلهية. ومعلوم أن على المؤمنين أن يؤمنوا بإمكان وقوع ألطاف الحق تعالى منةً منه وفضلاً.. لكن علهيم أيضا أن لا ينسوا البتة أنّ الوسيلة إلى استمداد هذه العناية هي الهمة والمجاهدة. وقد تفضَّل الله تعالى بتذكيرنا في الآية الكريمة ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾(العنكبوت:69)، بأن الألطاف التي يخلقها ويظهرها تقترن بعزم الإنسان وإرادته، فنبهَنا إلى أهمية الجهد والمثابرة في نفس الوقت الذي قطع فيه السبيل أمام الشرك فكأن السعي والجهد من أمارات توفيقه وتوجهه الخاص.
ولابد أن أنبّه ههنا إلى أنه ينبغي أن لا يحمل محاولتنا لتفسير وشرح النظام الإلهي الجاري في الوجود والحوادث، وفاعلية هذا النظام باطراد وانسجام وكأنه تابع للأسباب… ينبغي أن لا يحمل ذلك إلى أننا نقوِّم الأحداث من منظور فكرة “التعين السابق”(Determination)؛( ) فغاية ما نريده هي التذكير بأن الإرادة الكلية والجزئية في تصرفات الإنسان تَوَجُّهٌ ذو لون من المشيئة الإلهية، وكذلك التذكير بأهميتها في مستوى الشرط العادي. وأذكرّ من فوري هنا بأمرٍ آخر هو: أنه -سواء اعتبرنا “الإرادة” مَيلا أو تصرفا جزئيا في ضمن ذلك الميل- لا بد أن يَستعمل المؤمن قابليةَ الترجيح هذه والتي يحسها في وجدانه باتجاهِ تحقيق ما يريده الحق تعالى ويشاؤه، وأن يحفظ عزمه وثباته على هذه الحال. فاللازم أن يتجنب المؤمن ما يقبِّحه الشرع، وأن يسعى إلى المعروف، ويَثْبُتَ بأطواره ومواقفه في موضعِ تمثيل الإسلام ثباتًا دائمًا، حتى تكون كل لقطة من حياته أنموذجًا لوجه من أوجه الإسلام، وحتى يُصوِّر الإسلام في ذاته ويشدو به في صوته ويجسده في شكله باعتباره الممثلَ الصدوق لهذا الدين، وحتى يستخدم كل قدراته التي وهبها الله له في جعل الإسلام إحياءً للحياة… فيتحرى في كل صغيرة وكبيرة من أعماله كلها -مهما كانت- رضا الرب تعالى، وحسب تعبير بديع الزمان: أن يكون العمل لله، والابتداء لله، واللقاء لله، والتكلم لله… والتحرك أبدًا في دائرةِ “لله، ولوجه الله، ولأجل الله”، وتكون الثواني والدقائق والساعات والأيام في هذا العمر الفاني أجزاءً من زمانِ طريق البقاء، وتغدوَ وسائل لسعادته الأبدية.
وعلى المؤمن أن يغذي إيمانَه بنياته وتصوراته وإرادته وبرامجه، ويؤديَ حق إسلامه، وألا يرسل نفسه إلى الغفلة دقيقة واحدة أو ثانية واحدة، حتى لا يقع في التفسخ. وعليه أن يحرك مكوك الشعور والحس والإرادة دائمًا من الإيمان إلى “الحركية”، ومن “الحركية” إلى الإيمان، وينسج نقوش قماش حياته ورقوشه وكأنه يعرض لمشاهدة أنظار الله تعالى بكامل انشراحِ الصدر.
إن الكفر والإلحاد جهنم في القلب، وتَرْك العمل الصالح غربة ومخمصة ووحشة. ولا مفر من ظهور اختلال الشخصية في أمثال هؤلاء بين حين وآخر. إن عزائم هؤلاء خائرة وأفكارهم سائبة وإراداتهم مشلولة. وإن الذي يقوي الإرادة إنما هو الدعاء والعبادة، والذي يقتلع جذور الأحاسيس والانقيادات الفاسدة إنما هو التَوَجُّه إلى الحق تعالى والإنابة إليه.. ولم يحدُث أن انقطع في الطريق من تَوَجَّهَ بوجهه إلى الله بالمعايير الإسلامية… ولئن تعرض نفر منهم إلى اهتزازٍ بسبب ضعف منهم، فلم يُصرَع أحد منهم على ظهره تمامًا… فكيف بمن شد وثاق حياته بوشيجة الإحياء؟!
ولن يستطيع المؤمن أن يصمد واقفًا على ساقيه ولا ينكبَّ على الأرض إلا إذا عاش حياةً ذاتية وبعزم الإحياء. هذا ما شهدناه أبدًا. فهو عادة سبحانية لمشيئة الله الكلية، وتبديلُها وتغييرها محال على كل أحد. ولا جرم أن أعداءً ألِدّاء يَبرزون دومًا ضد الذين يعيشون الحياة في هذه الاستقامة، تطفح صدورهم غيظًا وحقدًا عليهم ويقعدون لهم كل مقعد ليسحقوهم، ويتربصون بهم الدوائر، ويتصدون لهم كل يوم بخطر جديد. ولكن المؤمنين حق الإيمان يخرجون دائمًا من هذه المحن أشد شحذًا من قبل، بل يتبدلون إلى أخرويين ورِبيين وربانيين… وبمشاعر الرضا، يغيرون المصائب إلى رحمات، وزخاتِ البلايا إلى مرشِّحات للتطهير والتصفية، فلا ينخلعون عن فكرهم وسلوكهم الذاتيَين.
فالواجب علينا -نحن المسلمين- أن نَعود إلى أنفسنا وقيمنا، ونعزم على البقاء بذاتنا، ونتغذى من مصادرنا بأقصى قدراتنا. وإن مصدر الدين الإسلامي ومنبعه هو القرآن والسنة. فهو فائض من صدرهما وقد أحرزت الأمة الإسلامية موقعًا تُغبط عليها، وصارت قدوة للأمم، ما دامت متمسكة بهذا النظام الإلهي. وبالمقابل كلما ابتعدت عن قيمها الذاتية، وقَلدت الأجانب، وسقطت أسيرةَ أهوائِها ونزواتها، انكبت على وجهها من بؤس إلى بؤس، ومن عارٍ إلى عار.
فيلزمُ المسلمَ ألا يهمل قيمه الذاتية البتة، وأن يحاول الاستفادة من المصادر الأجنبية بشرط استئذان النُّظُم والقواعد الأساسية الذاتية، وتنقيتها بالترشيح في تلك المصافي. ولكي لا يُساء فهمُ المقصود، نقول: إن الإسلام لا يمنع المسلمين من تعلم علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفضاء والطب والهندسة والإدارة العامة وإدارة الأعمال والزراعة وأمثالها، بل يحثهم على التخصص فيها وأخْذِها والاستفادة منها من أي مصدر كان. لكنه لا يريد أن يبقى المسلمون تبعًا لغيرهم على الدوام، بل يحبذُ لهم الاستفادةَ مما عند الأجانب من هذه الأمور، ثم التخلصَ السريع من استجدائها، وإقامةَ عالمهم الذاتي في الأوامر الإلهية التكوينية كما في الأوامر التشريعية.
وكان أجدادنا في عصورنا الذهبية، يتذكرون مرارًا وكل يوم أنهم خلفاء الله في الأرض، ويتحرون مراد الله ورضاه في كل حركة من حركاتهم الدنيوية والأخروية، ويمحصون أحوالهم بميزان الأوامر التشريعية، ويقيسون مدى صلتهم بربهم، ويَجِدُّون في التعرف على الأسس التكوينية بعشق جادٍّ للحقيقة والبحث، ويَحُدّون البصر لاستطلاع الوجود والحوادث، ويحثون السير في السلوك إلى التوفيق بين ما اطلعوا عليه فعلموا، وما سمعوه ففهموا، وبين العائلة والمجتمع والوجود كله، فيهرولون من العلم إلى العرفان، ويحلقون من المعرفة إلى المحبة، فيرون في كل شيء وحادثة وتبليغٍ من الحق تعالى، وسيلةً للسمو نحوه، ويضعونها في مقدمة أعمالهم الدنيوية وملاحظاتهم الأخروية.
ولقد بلغوا أفقًا كهذا الأفق لأنهم عاشوا الإسلام وأحيوه باعتباره كلاً لا يتجزأ، وبحبهم إياه من صميم قلوبهم وتحبيبهم له، وبجعلِ الحياة الإسلامية غايةَ حياتهم. فلما توطد في قلوبهم روحُ حركةٍ كهذه توطُّدًا مكينًا، تأسَّس توازُن الدنيا والعقبى تلقائيا وجَعَلهم مجتمعًا متوازنًا. فصاروا مقتدرين على التعبير عن ذواتهم في كل مكان وفي كل مجال للحياة. فما برحوا، بفضل ذلك، يتجددون ويتغيّرون في دائرة “مقوماتهم” الذاتية، ويهرعون إلى التغيير، ويتعمقون على الدوام، ويصبحون بإيمانهم وحركيتهم أساتذةً يُعلمون الإنسانية دروسًا في الحضارة في رقعة جغرافية واسعة. فكانوا مرايا للحق تعالى في حركاتهم وسكناتهم، وكلامهم وصمتهم… وكانوا في كل تصرفاتهم وسلوكياتهم المتناغمة المؤتلفة كأن كل واحد منهم آلة موسيقية تُشْجي بأناشيده تعالى… ويَدْعون إليه بنداءاتهم الحرَّى كنداء الدلَّال. فكأنهم -بتعمقهم وعرفانهم هذا- مجتمعُ صحابة، وكأنهم ممثلون لخصال كثيرة تَرجع إلى رؤية النبي r.
فإذا ما دخل هؤلاء المنورون إلى العلاقات مع الله تعالى أو تفكروا في عقباهم، فإنهم -بين فينة وفينة- يرسلون أنفسهم في رحاب المعرفة، ويرتعشون بالخشية من أعماقهم، وتوجف قلوبهم، ويستغرقون في المحاسبة، ويجددون مراجعة كل شيء فيهم، ويَزِنون معايير القلب كل مرة، ويحسون دائما بوطأة المسؤوليات والتكاليف على أكتافهم كالجبال، وتذوب النفس والجسمانية فيهم ذوبانًا يبدلهم إلى موجودات روحانية، وبالأخص إذا ما فاض القرآنُ والحقائقُ التي يستهدف القرآنُ شرحَها، وانصبت في قلوبهم، فإن هذه القلوب التي غدت وكأن كل واحد منها بيت من بيوت الله ستتطهر من كل خاطر أجنبي، فلا تفكر إلا به تعالى، ولا تشعر إلا به، وتشرق شمس النهار به، وتغيب به.
والأصل أن القلب المؤمن لا يَسَعُ الإسلام إلى جانبِ معتقدٍ غيره أو تصورات أخرى. فما إن يدخل الإيمان والإسلام القلبَ، حتى يكنسَ المتقبلاتِ الخاطئة ويمسحها ويلفظها، وتصبغ العبادةُ كلَّ جهاته بلونه، ويصونه شعورُ الإحسان تحت دفيئةِ أن يرى الحق أو يراه الحق، فلا يَبقى فيه إلا الأنسام التي تهبُّ منه تعالى.
فبفضل هذه العلاقة مع الله تعالى، والقائمةِ على أساس الإيمان والإسلام، تتجلى في فكر الإنسان وسلوكه استقامة لا تتذبذب، وإخلاصٌ متماد، وشعورٌ مستمر في التعاون، وهمةٌ قلبية للتساند، وأخلاق أخروية. فالإيمان النافذ إلى دواخل الإنسان بهذه الدرجة، يتجلى في أحوال المؤمن كلها، سواء في الوظيفة أو التجارة أو معاملات الأسواق أو سائر الأنشطة الاجتماعية، فيطبع بصماته عليها، ويرسم على روحه صورةَ معناه، وتنقلب الصورة بمرور الزمان إلى قصيدة معنوية تُقرأ على تصرفاته وسلوكياته كلها… فكأن مؤمنا في مثل هذا التماسك هو المعنيُّ بمقولةِ: “إذا رأيته ذكرتَ الله تعالى”.
ونعتقد أن الإيمان والإسلام بالمعنى الحقيقي هو هذا، والوضعُ الإلهي الذي نسميه “الدين” هو العنوان الجامع لكل ذلك، و”التدين” اسم لصيرورة هذه الحقيقة الجليلة حياةً أو إحياء للحياة. مبدؤه يستند إلى أجمل الكلام وأحسنه: كلمةِ الشهادة أو كلمة التوحيد.. ومنتهاه يمضى حتى يصل إلى رؤية الحق تعالى. فكل مَن يرَضى به ويعيشه على هذا الحال -والله يتولى السرائر- هو مؤمن ومسلم ومتدين من وجهة الكتاب والسنة… وأي اسم أو عنوان آخر غير ذلك قد يذكر به يعني تهوينًا من شأنه ووضعًا من قدره.
ويَرِد في المصطلحات الإسلامية بلساننا تعبيرات مثل: “إسلام” و”مسلمان-مسلم” و”ديندار-ملتزم” عَلَمًا على المسلم. لكن لا يرِد فيها كلمات دسها الأجانب عن قصدٍ إلى لساننا فاستعملها البعض، مثل “إسلامي” (Islamist) و”دينيّ”. إننا لم نتعرف على مثل هذه الألفاظ والأوصاف في ديننا من قبل وإلى عصرنا الحاضر. ولا يهمنا أنْ وردت بعينها أو بأشباهها في الأديان الأخرى أو المنظومات المتشكلة في صورة أديان غير ديننا. فبموجب ديننا، المسلمُ الذي يرتكب الذنوب أو يقع في الخطيئة يكون “آثما”، لكنه يبقى “مؤمنا”. والذي يترك العمل بأمور من الأسس الإسلامية، بشرط عدم إنكاره لها، يبقى “مسلما”. فعلى هذا الاعتبار، تسميةُ الذي يبتغي أن يعيش الدين كاملاً بــ”الإسلامي” (Islamist) أو “الديني” غيرُ مناسب، كما أن تسمية تارك العمل بقسم من الأوامر الإسلامية أو المتقاعس عنها بـــ”الكُفري” أو “الضلالي” أو “الفسقي” تعبير غير لائق. وأرى أن على الجميع أن يصون نزاهة لسانه، وأن يفكر ويتكلم بمستوى يليق بالإنسان، وأن يتعلم كيف يحترم كل أحد.
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، يوليو 2003؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.