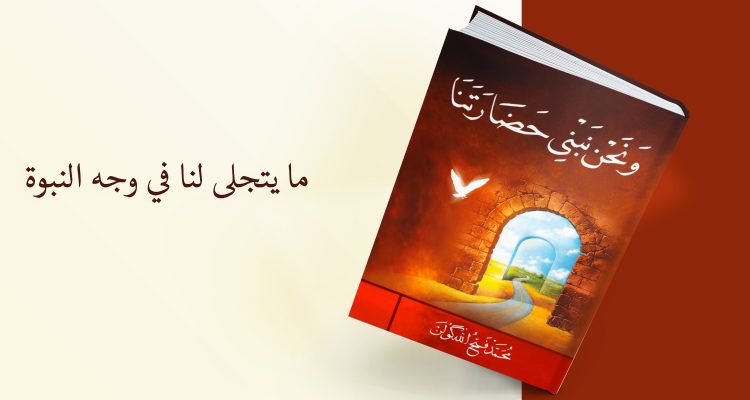كما شاء الله تعالى أن تكون الكائنات والأشياء مَعلما من معالم معرفتِه والعلمِ به، كذلك أراد أن يُعَلِّم عباده بلسان الوحي: مطالعةَ الأوامر التكوينية والتنـزيلية متداخلةً ومتمازجةً، وتعزيزَ المعاني المنسابة من العين إلى القلب بالنفحات القادمة عن طريق الأُذُن والتي تغشى الروح، وإظهارَ مفهوم الألوهية باعتبار الذات والصفات والأسماء “من حيث هو هو”، وبالتالي إشعارَ العباد مسؤولياتِهم حيال ذلك، وكيفيةَ نهوضهم بهذه المسؤوليات والتكاليف، مع ملاحظة آدابِ وأركانِ الطريق التي يمشون أو سيمشون فيها، وما يترتب على الغاية التي سيَبلُغونها. وكما أن معرفة أمور الغيب المطلقِ معرفةً سليمة وصحيحةً تقتضي الوحيَ، كذلك الوحيُ يقتضي النبوةَ بالضرورة. فبناءً على هذه الضرورة، شَرّفَ الله تعالى كل مرحلة زمنية، و-باعتبار بعض المراحل الزمنية- كل قارة، بوجود نبي من الأنبياء. وبعبارة بديع الزمان النورسي رحمه الله: “إن القدرة الأزلية التي لم تَدَعِ النمل بلا أمير، ولا النحلَ بلا يعسوب، لم تَدَعِ البشريةَ في أي زمان بلا نبي”.
خلق الله تعالى هذه الكائنات بعلمه وإرادته، وألبسها لباسَ الوجود الخارجي، وجَهَّزَ كلَّ مخلوقٍ -حيٍ أو ميت، كثيفٍ أو لطيفٍ، أرضيٍّ أو سماوي- بأنواع الحِكَم والمصالح ورَبَطَه بغايات معينة ووجَّهه إلى أهداف معينة. وإنه تعالى من جانب آخر وفي طولِ موجةِ تجلٍّ آخرَ لكي يُعْلِم عن ذاته بذاته، ولينبئ –في هذا الصدد- كلَّ أحد بوجوده، وليُشْعِر ذوي الشعور من الموجودات خاصة بغاية خلقهم، ولأي شيء ولأي مكان هم مرشحَّون، وما هي مسؤولياتهم وتكاليفهم… لهذا كله، أَرسَل إلى الأقوام رسلاً مجهَّزين بتجهيزات خاصة لبيان أسرار الألوهية ونظام العبودية… وكما أراد أن يُعْلِمنا بوجوده بواسطة ألوانِ مخلوقاته ورقوشها وأدائها وتناغمها ومعناها ومحتواها، فكذلك أراد بواسطة هؤلاء المختارين المصطفَين أن يُشعِر أرواحَنا في بيانه التنـزيلي من وراء سِتار التنـزلات، بأسرار الربوبية وغايةِ الخلق، ونتيجةِ الفطرة، ومَوقعِ الإنسان على وجه الأرض، وأحوال المعاد… وذلك حسب مدارك البشر، ودرجةِ حسهم وشعورهم، مع رعاية التناسب المحكم بين ذاته وصفاته وأسمائه.
إن الحق تعالى -وله حِكَم كثيرة في كل شأن، ودائرةُ ربوبيته تحتوي على حِكَم ومصالحَ لا تحصى- لم يخاطِب الجميعَ مباشرةً في أوامره التنـزيلية والتشريعية، ولم يكلِّمهم كلَّهم عيانا بيانا، بل اصطفى -حصرًا- لمثل هذا الأمر المهمِّ غايةَ الأهمية والخاصِّ جدَّ الخصوصية بعضَ ذوي السجايا الممتازةِ المجهزين بجهاز خاص والعائشين في مقام القلب والروح، فكلَّمهم. وبواسطة ذوي الاستعدادات السامقة هؤلاء، والفطراتِ الباهرة، والسجايا السامية، بَلّغَ وجدانَ البشرية غايةَ الخلق، وحكمةَ الوجود، ومعنَى ومحتوَى الدنيا وما فيها، وكنهَ “العوالم الأخروية”، وسبلَ الجنة، التي تُوصِل الإنسانَ إلى الأبدية في ذلك العالم. وإذ نبههم إلى ذلك؛ فأحيانا ارتعشت القلوب وارتعدت منها، وأحيانا استشرفت العالمَ الآخر وفاضت شوقا إليه. وأعلمهم الحق أيضا أن الدنيا مِن مشارقها إلى مغاربها مَشْهَرٌ برّاقٌ لعرض تجليات جماله، وأنها موضعُ حصادِ الزروع لحساب الأبديات… فبكل ذلك أنقَذَ الإنسانَ من وحشة الوحدة، وغيابِ الغاية، والانفلاتِ من الوظيفة، وضياعِ الهدف، وعَلَّمَه بأن هذه الدنيا حجرةُ انتظار “للآخرة”، وفرَّح الأرواحَ الملائمة والمستعدة فبشَّرهم بأمرٍ فوقَ الوجود واستشعارِِ الوجود، وهو الأبدية ورؤية جماله تعالى.
ولقد حقق الله سبحانه هذه الغايات والأهدافَ السامية جميعًا بهؤلاء الأخيار المصطفَين الذين سماهم “الأنبياء”، وجعلَهم ألسِنةَ الوجود والأشياء، ومترجميه ومفسريه، وهُداةً راشدين للوصول إلى العبادة والاستقامة والإخلاص والدار الآخرة. فهؤلاء الفطرات الساميةُ، ساحوا في ساحات وظائفهم، وأعلنوا الحق، وأسمعوا تبليغاته للبشر، فأرشدوا الناس الذين في مجال مسؤولياتهم.
إن الأنبياء أجمعين -مع تفاوت درجاتهم وتفاضُلهم فيما بينهم- كلٌّ منهم هو مثال الفطرة الطاهرة، وأنموذجُ الأخلاق العالية، وصرحُ العفة والطهارة، وبَطَل الأمانة، ومثال الوفاء والصدق. فكل منهم إنسانٌ قدوةٌ يشارُ إليه بالبنان في كل عصر وزمان، بشخصيته السامقة، وسلوكه الجاد، وأحواله الموحية بالثقة، واستقامته التي لا تحيد، وصدقِه الثابت في كل الأحوال، ووفائه الذي يعدل وفاء الملائكة، وصبره الراسخ كالجبال، وشعوره العميق كلَّ العمق بالعبودية. هؤلاء هم بمثابة الناطقين باسم عالَم الربوبية، والمرايا العاكسةِ للأوامر والأسرار الربانية في ستار التنـزلات الإلهية…
وذلك بصورهم ومظاهرهم المتكاملة من غير أدنى نقص، وبِسِيَرهم المذكِّرة بالحق تعالى لكل ذي عين، وبمجرى حياتهم المنفتحةِ للخوارق دائمًا، وبجاهزياتهم واستعداداتهم الراقية القادرة على حل المعضلات التي تُواجههم بحَملة واحدة، سواء الفردية منها أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، وبتأثيرهم الخارق على محيطهم، وببيانهم الفصيح الباهر، وبمقاييسهم المتناسبة والمتوازنة فيما بينها حول حقائق الإنسان والكائنات والألوهية، وبما يتمتعون به من الحاهزية الراقية التي تفوق المكتسبات البشرية والتي تؤهلهم لإشباع جميع اللطائف الإنسانية؛ القلبيةِ والروحية والذهنية والفكرية والحسية، وبسلوكياتهم المبصرة والمتوازنة في رعاية المعادلة العامة، والنابعة عن فهمهم الراسخ للانسجام الداخلي والخارجي لعموم الكائنات والوجود.
نعم، إنَّ كل نبي هو مرشدٌ أمينٌ في الطرق الموفية بالإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة، وناصحٌ أمين لتحفيز القلوب إلى المحاسن الإلهية، ومرشدٌ كاملٌ في النفوذ إلى أرواح المخاطَبين، وذو خبرة ومهارة عالية في نحت أفكار وأحاسيسِ الذين يتناولهم وتشكيلِها وصَقْلِها، ثم ربطِها بالغاية والهدف من خلقهم، وهو مربٍّ كاملٌ في انتزاع الخصال السيئة والعادات الفاسدة والطباع الملوثة، وإحلالِ القيم الإنسانية الرفيعة محلها… وهو مُخَلِّصٌ عَزومٌ غايةَ العزمِ وصَدوقٌ غايةَ الصدق، قويُّ الإيمان، متين الثقة بالله، مطمئن إلى حقانية الرسالة التي يبلِّغها، يتكلم دائما مطمئنًا من غير تذبذب وترددٍ، لا يصيبه وجل ولا يبالي حيال أعظم الدواهي، ولكنه -في الوقت نفسه- يتحرك بدراية وفطنة. إنه مُخلِّص عظيم لا يخدع ولا يُضِلَّ من تبعه قط، ولا يندم من تبعه على اتِّباعه البتة. ذلك بأن الأنبياء هم أغنى الأمناء على أسلم خزائن العلوم اللاهوتية النقية الندية التي تفوق أشواطا وأشواطًا ما نلناه، أو سنناله، عن طريق مشاعرنا وفكرنا ومنطقنا ومحاكمتنا العقلية، وآمَنُ المرشدين في طريق الإيمان والمعرفة والمحبة والعشق والشوق والذوق الروحاني، وأَوْثَقُ الهُداة الموفين الْمُبلغِين إلى الحق تعالى. فالمتيقِّظون للحق تعالى إنما تيقظوا بندائهم، والمترنّمون بالمعرفة إنما انحلت عقد ألسنتهم بسقيا كوثرهم، والمتحرون عن رضا الحق تعالى إنما وجدوا ما يتحرون عنه في جوهم وفضائهم، والتواقون إلى أسرار كتاب الكائنات إنما قرؤوا طلاسم هذا الكتاب قراءة صحيحة بأبجدياتهم ومعطياتهم.
الأنبياء هم أرباب السمو والارتقاء المادي والمعنوي، وروادُ طريقِ الكمالات العقلية والروحية، وأساتذة كل النُّظم والترتيبات: الدينيةِ، وكذا الدنيوية، ومهندسوها. فبفضلهم ارتقى الإنسانُ من مستوى الحياة البيولوجية، فبلَغَ مرتبةَ “أَحْسَن تَقْوِيم” التي تُعَدُّ تعبيرا آخر عن “الإنسان الحقيقي”، وبواسطتهم اكتَشَف ذاتَه، وفَهِم موقعَه بين الموجودات، وبالاقتداء بهم أَحسَّ بالعمق الموجود في مستوى حياة ذوي الهمم العالية، من أمثال الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين، وتذَوَّق طعمَها… وأيضًا، بتعليمهم وإرشادهم وإشعارهم رأى الإنسانُ الوجهَ الحقيقيَّ للدنيا، فاعتبرها مختبرًا، أو دارَ كيمياء، أو صيدليةً، أو قصرا منيفا، أو مَشْهَرا عظيما. وبتعبير الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي إن الله تعالى إذْ أمر الناسَ باتِّباع الأنبياء، أراد أن يشرِّفهم بالتعرف على أعماقهم المعنوية لتنفسح طريقُ الاستفادة من هذا المصدر الفياض… وزد عليه، أنه أَطْلَعَ الإنسانَ على وسائل الارتقاء المادي في المستويات المختلفة لتجليات المعجزات التي هي أمارات صدق الأنبياء وعلاماتُه، أو -في الأقل- أَرسَلَ إشعاراتٍ بشأن هذا الموضوع، حَرَّكَ بها أنظمةَ الاستقبال في الأرواح الحساسة والمستطلِعةِ، وفَتَحَ أبوابَ التقدم التكنولوجي في خيالها، وهيأ لها الأرضية لإثارة العصف الذهني فيما بينها.
نعم، كلُّ معجزة هي إشارة وإشعارٌ وتذكيرٌ وتداعٍ باعتبار الأوامر التكوينية، ودعوةٌ إلى تفحُّصِ خصائصِ هؤلاء المصطفَين في مختلِف المجالات.. كالسفينة المعجزة المصنوعة في الترسانة النبوية لنوح u… وقميصِ إبراهيم u الـمَخِيط في مَعملِ “حسبي الله”، المقاوِمِ للنار، والمذكِّرِ “بالأمْيَنت” المتحمِّل لأعلى درجات الحرارة، بل بما هو أشد مقاومة منه… وساعةِ يوسف u المجهولةِ الكُنهِ التي منَّ بها الله عليه بشكل معجز جراءَ بحثه عن جدول الأوقات والذي احتاج إليه إلى درجة قريبة من حد الاضطرار… وعصا موسى u التي تُذَكِّرُ بمضخات الماء والآبارِ الإرتوازية… وتليينِ الحديد لداود u بتذويبه وتشكيله وتفريغه في القوالب الذي يصوِّر في الأذهان صناعةَ الصلب والحديد… وجَلْبِ سليمان u لعرش بلقيس برسمه وشكله وصورته، وربما بكل زينته المحيطة به، هذا الذي يجلب معه خيال التلفزيون والإنترنت وما هو أبعد منهما، وأيضًا، قطْعُ هذا النبي الجليل مسافة شهرين في يوم واحد المحفِّز لتكنولوجيا الطائرات الحديثة، وكذلك إجراءاته u في عالمِ ما وراءَ المادة والفيرياء بتسخير الجن والعفاريت والشياطين له، التي تشير إلى المداخلة في العوالم الميتافيزيقية والتي تضع الحدود النهائية للباحثين في حقل عالم الأرواح. وكذلك تَحَاوُره بـ”منطق الحيوانات” الدال على فن ألسنة الطير والنمل والحيوانات الأخرى وتعلُّمِ شفرات التفاهم بينها، بل حثه على ذلك… ومعجزات عيسى u التي تتعدى خيال الإنسان إلى مسافات أبعد مما تَوصَّل إليه الطب الحديث وعلمُ الجينات في يومنا هذا بإضفاء الحياة على ما ليس له روح، وإبرائِه للأكمه والأبرص، وإحيائه الأموات، بإذن الله تعالى… وأخيرا مئات المعجزات لمفخرة الإنسانية r التي تَعْدِل جميع تلك المعجزات.
النبي، هو قابليةٌ واستعدادٌ وجاهزيةٌ متعاليةٌ ربانيةٌ، لأخذِ وفهمِ العلم الذي هو من جملة العلم الضروري باعتبار وروده من الله تعالى، وذلك باستلامه وفهمه كما هو، ثم نَقْلِه إلى الآخرين من غير أن يَخلط به أدنى شيء يخالف جوهرَه ولبَّه وذاتَه. فكما أن عملية الحياة والتكاثر بالسَوْق الإلهي( ) في الإنسان العادي والموجودات الأخرى مهمة وضرورية، -وهذا تشبيه من الأدنى- فكذلك تَجري وظائفُ ومسؤولياتُ الأرواح التي حظيت بالنبوة، في إطارٍ طبيعي أشبهَ بتلك المنوَّه عنها. (إضافةً إلى أهميةِ وقيمة مشاهدتهم ومراقبتهم، وقيامهم بالتشخيص والتثبيت، واجتهادهم حسب الحاجة، وذلك بوجدانهم الذي هو عبارة عن مزيج من اللطيفة الربانية والحس والشعور والإرادة). فإنهم يتلقَّوْن الأوامر من الحق تعالى بجهازهم الداخلي كطرف من طبيعتهم، ويبلِّغونها كضرورة لفطرتهم… يبلِّغونها ولا يفتُرون، ولا يميلون إلى راحة، بل يتحركون دائمًا كما أُمِروا. وإذ يتحركون، لا يقعون في انتظارِ مأمولٍ، فكأنهم يلبون أية حاجة من حاجاتهم الفطرية.
يفسر الجمهور الأعظم الخدمةَ والفعالية التي يوفيها الأنبياءُ العظامُ والمرتبطةَ بالاصطفاء الإلهي والتوظيف الرباني والمقترنَةَ بجهازهم الداخلي، بأنها من نوع الأفعال الضرورية لوجدانهم الطاهر. فالنبوة بناءً على هذا التفسير عطيةٌ وموهبةٌ إلهيةٌ منحها الله تعالى للأرواح التي هي كالرشحة في استعدادها لعرضها ما ينعكس عليها من غير خلل وعطل، كما وَهَب لهم الفطرةَ السليمة والطبيعةَ المستقيمةَ، إلى جانب “الوجدان” المتوجهِ بكل ركن من أركانه -باعتبار الجهاز الداخلي- إلى غاية وجوده -ويمكن أن نسميه الوجدان المنفتح تمام الانفتاح-… والنبيُّ ممثِّلٌ خاص لهذه الموهبة والعطية المقدسة.
ولذلك قيل إن النبوة هي فهمُ ما لا يُفهم بالإدراك البشري والعلمُ به، ونقلُه إلى المخاطَبين الآخرين من غير خلل أو انكسار. وعُدَّ النبيُّ -من هذه الوجهة- نقطةَ اتحاد المبدإ والمنتهى. فالله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾(البقرة:269).. ومعناه أنه تعالى رفع الأنبياءَ إلى درجاتٍ ومناصبَ رفيعة، ثم أشعر وجدانَ الآخرين “بأسرار الألوهية” و”أسرار الربوبية” بواسطة هؤلاء المصطفَين، فنوّر عقولهم.
وإنه إكرام من الله تعالى يَعدل نعمةَ خَلْقِنا وحظوتِنا بالوجود -بل هو فوق تلك- مَنَّ به علينا -نحن الذين يمكن أن نتعثر فتنقطع بنا السبل، أو نحتار فنضيع- أن أرسَلَ إلى الإنسانية هذه الشخصياتِ الساميةَ المصونةَ المعصومة. نَعَمْ، الوجودُ نعمة، وإيضاحُ الكائنات والحوادثِ كلها -بعد الوجود- وتفسيرُها ومن ثم إظهارُ أعماقِها الأخروية والإلهية بواسطة الرسل، إنما هو لطفٌ وأكرامٌ آخر. وإن الطبيعة غير الملوَّثة لكل إنسان نقيٍ، وكلَّ وجدان مبصرٍ، يمكن أن يَبْلُغ -ولو بدرجات مختلفة- بالاستفادة من هذه الإيضاحات والتفاسير أعلى مواقع يغبطها الروحانيون، وقد بَلَغها مَن بَلَغَ…. وعلى الضد، فالذين تخبطوا في كماشة الكبر والظلم والانحراف والتقليد الأعمى كما أنهم لم يحسوا ولم يُقدِّروا حظوة الوجود، كذلك فَاتَهُمْ إدراكُ هذه النعمة الثانية، و-بإرادتهم في مستوى الشرط العادي- تعثروا بعماهم وصَمَمِهم وبَكَمِهم، قائلين: ﴿لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا﴾(الفرقان:7)، فعصوا وتمردوا وأظلمت آفاقهم تمامًا.
إن إرسال الأنبياء وتعيين المرسلين لهو من الأمور العالية الخاصة بالله تعالى. وبناءً على ذلك فكل عمل وإجراء له علاقة به تعالى، لابد أن يناط بعقليةِ إبراهيم حقي القائل (ترجمته):
“في كل شي له حكمة،
فلن يفعل الله عبثا”،
ثم يتحرى عما ينطوي عليه من الحِكَم بقدر أفق إدراك العقل.
وقد نستنبط حِكَمًا ومصالح مهمة من إرسال الأنبياء مِن بشرٍ مثلنا، وإحساسِهم بما نحس به في أبعادهم الحياتية، وتلذُّذِهم بما يطيب لنا أيضًا، وتذوُّقِهم عينَ ما يؤلمنا وما يلذُّ لنا، وإحساسِهم في أرواحهم بمثل احتياجاتنا وبما نَعدُّه ضرورة، وتحمُّلِهم المسؤولياتِ والتكاليفَ من أمثال ما تُحَمَّل على أممهم ومخاطبيهم… فنقول: إنما حصل ذلك ليسهُل تقليدُهم، بل الأحرى اتِّباعُهم… وباختصار: ليمثلوا الجانب الأرضي لرسائل الحق تعالى ضمن سماويتها. لكننا نقول معها: “اللهُ وحده عليم ببواطن الأمور”، ونجدد استسلامنا لحقيقةِ: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾(الأنعام149)، ونعتبر أنَّ أعظم الحكمة هو السكوت أمام “العليم الحكيم”، ونرجح رَبْط ألسنتِنا بقلوبنا والاستغراقَ في مراقبة التمكين.( )
لكن ينبغي ألا يغيب عنا -مع كل هذه الخصوصيات لسادتنا الأنبياء والمرسلين الكرام- أنهم بشر من أمثالنا. نعم، إنهم بشر مثلُنا… بشرٌ، أهمُّ خصالهم الإيمانُ والعبوديةُ، ووظيفتُهم التي اصطفاهم الله من أجلها هي تبليغ الإيمان والعبادةِ للآخرين، ورَفْعُ العوائق بينهم وبين الحق تعالى. وليس من وظائفهم تحويل الجبال والأحجار إلى ذهب، أو تبديلُ مجرى الأنهار، أو تحويلُ الصحارى القاحلة إلى جنان خضراء، أو إنزالُ الطعام من السماء… صحيح أن القرآن بعينه يورِد كثيرًا من أمثال هذه المعجزات الكونية الحاصلة بيد هؤلاء الأنبياء ويربطها بالنبوة؛ لكن كل هذه المعجزات؛ هي من جهةٍ ألطافٌ ربانية خاصةٌ وأجرةٌ عاجلة لهؤلاء الكمَّل مقابلَ عبوديتهم الخالصة وشعورِهم بالمسؤولية ومَواقفِهم بين يدي الحق تعالى… ومن جانب آخر هي توجهات خاصة والتفاتات ربانية حصلت بالمشيئة والإرادة الإلهية لبعث الاطمئنان في نفوس أممهم.
إن تحويل الحجر والتراب إلى ذهب وتبر، والفحمِ إلى ألماس على يد الأنبياء، وإحياءَ الموتى بأنفاسهم، مقترنًا بدعوة النبوة، هو تجلٍّ للألطاف الإلهية في طريق القبول بنبوتهم، ونسيمُ إحسانٍ لسَوق آمالهم إلى اليقين. هذا، وليست هذه المعجزات بأعجب من أن يَجعل الحقُّ تعالى -بعناية خاصةٍ منه- الأرواحَ المنكِرة يشعرون في وجدانهم بحقيقة الإيمان، ويُليِّنَ الطبائع المنغلقة على الكفر، ويجعلَهم يَشعرون بالله، ويَنفخَ الحياةَ في تلك القلوب الميتة… بعبارة أخرى: هذه المعجزات التي حصلت بخلق الله تعالى هي وقائعُ ثانويةٌ وتبعية لا تُعدُّ في محور الفَلَك الأصلي للنبوة، بل هي تأييدٌ وتسليةٌ للأنبياء، ووسيلةُ إذعانٍ وتسليمٍ للمخاطَبين.
وأرى من المفيد تكرار التذكير بأن الوظائف الأصلية للأنبياء هي: تصفية الإنسان من الأخلاق الذميمة والخصال الفاسدة التي تُعيق وصولَه إلى الله تعالى وتؤدي إلى ابتعاده عنه؛ مثل الكبر والظلم والانحراف وتقليدِ الآباء والخضوعِ لمؤثرات النفس والجسمانية، وتحفيزُ الأخلاق الحسنة والخصالِ الحميدة في البشر؛ مثل التواضع والوقوف عند الحد، والتفكيرِ المستقيم، والتزامِ الحق، والتوجهِ إلى الحياة القلبية والروحية، وتذكيرُهم بمواقعهم ومسؤولياتهم، وتعليمُهم التوقيرَ في علاقتهم مع الخالق والشفقةَ بالمخلوقات، ولفتُ أنظار قلوبهم إلى محاسن اللانهاية، لأنهم خُلقوا للأبد ولن يُروِي غليلَهم شيءٌ إلا الأبدية، وحجزُهم عن الزلل بتلقينهم التمييزَ بين الأمور التي تهم البشرية جمعاء، مثل الصواب والغلط، والمفيد والمضر، والحَسَن والقبيح، والحق والباطل، والباقي والفاني، وتفهيمُهم إياها بصورةٍ تَفْقَهُها العقول المتحررة عن الأحكام المسبقة ويَقْبَلُها الوجدان السليم، وتثبيتُ الهداية والضلالة ووضعُهما في الأطر التي وضعها الحق تعالى، وإشعارُ الأرواح بالمحاسن اللانهائية للوصول إلى الحق تعالى وبالقبائح الرهيبة للانحراف والتيه، وتعليمُهم عقيدة الألوهية والربوبية كما يريدها الله تعالى وليس كما يصوِّره الهوى والرَّغَبَات النفسانية، وإرشادُهم إلى ربط كل شيء برضا الحق تعالى، وهدايتُهم إلى الطرق الموصلة إلى ذلك الأفق، وإخبارُهم بعقاب المنكِرين وبثواب جنان النعيم للمؤمنين في الأخرى… وأمثالُها من الوظائف إجمالاً. وإنَّ توقُّع شيء من الأنبياء خارج وظائفهم جهلٌ بالنبوة واستهجانٌ صريح بالأنبياء. وجوابُ القرآن واضح عن كلِّ طلبٍ توقُّعٍ خارجَ وظائفهم: ﴿قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾(الأنعام:50).
نعم، إن الأنبياء إنما يتبعون وحي الله تعالى ويَسْعَون بغاية همتهم إلى الهتاف به وتفسيرِه وتمثُّلِه. فما يعلمونه ويقولونه ويعملونه وكل ما يريدون تنفيذه وتحقيقَه هو عبارة عن تبليغِ وتمثُّلِ الرسالة التي حمَّلهم الله العليم الحكيم إياها بأسلوب خاص. وبعبارة أخرى، هم حيالَ الرسالة الإلهية بمثابة موظفِ توزيعٍ وتقسيمٍ وتبليغٍ على مَورد الوحي الذي هو “المنهل العذب المورود”. ولئن فَسَّروا أو اجتهدوا في مواضعَ وفقًا لمـُحْكَمات الوحي، فقد سعوا إلى التعبير عن كل شيء حسب منهج العلم الإلهي المحيط ودائرته، وراعَوا المرادَ الإلهي والمرضياتِ الإلهية في كل حركاتهم.
الأنبياء يواصلون حياتهم في ظلال الوحي، ولا يبتغون في أي من أعمالهم إلا رضا الحق تعالى، ويسيرون في السبيل التي أرشد إليها الهادي سبحانه، ويفوِّضون نتائج حركاتهم وفعالياتهم كلها إلى الله U، ويؤجلون الحصول على ثمار سعيهم وهمتهم إلى آخر محطة في الآخرة. الأنبياء ومن اتبعوهم بإخلاص، لا ينجرفون بحب الدنيا والرغبةِ في المناصب البتة، ويَنوطون كل حركاتهم وتصرفاتهم بمشاعر التقوى، ويَعُدُّون بصيرة الخضوع للوحي عينَ الهداية، ويسيرون في هذا الصراط السوي الوضاء بكامل مَلَكاتهم العقلية والروحية والقلبية والحسية، ويرون السير في هذا السبيل ضمانًا للخلاص والتخليص، ويربطون حياتهم كلها بهذه الرؤية وهذا الفهم.
وإن عقل الإنسان ومنطقه ومحاكمته -ويمكن اعتبار كل ذلك شيئًا واحدًا- كلما تقبَّل النبوةَ وما يرتجى منها، واستطاع أن يستفيد من هذا النبع الفياض استفادة تامة، فإنه من جانبٍ، سَلَكَ -وسيسلك- الطريقَ الموفي إلى الثغر الحدودي لمساحة ذاته، ومن جانب آخر نجا -وسينجو- من أن يكون وسيلة لإضلال الآخرين.
والأهمُّ قبل كل شيء في مثل هذا السلوك، التسليمُ للقدرة المطلقة والعلمِ المحيط الذي يتحكم في كل الوجود والأشياء. ولكُم أن تسمُّوا هذا إخضاعَ ثمرات العقل والمنطق، ومختلفِ المناهجِ والبحوث والتجاربِ المختلفة المستحصلة عن طريق العقل والمنطق، لتمحيص الوحي، من أجل ترقية الأرضيات إلى سماويات، وإضفاءِ روح الجوهر على الأعراض.
والحقيقة أن الذي خلق العقل هو الله تعالى، والذي هدى العقل إلى طريق التعمق بواسطة الوحي هو الله أيضا. فلقد فتح الله تعالى عيون بني الإنسان بالعقل، وضَمِنَ للعقل سلامة النظر والتفكير،ِ بالوحي، فمهَّد له مجالا واسعا للمحاكمة، وببيانه المحيط أقام على البشر الحجةَ الـمُلزِمة. بعبارة أخرى: جعل الله تعالى مؤسسة الوحي -التي تضم الكل معًا- بمثابة مختبرٍ لتوحيد السبل المختلفة في شتى المجالات للعقل والمحاكمة التي لا تفتأ تعرض أحوالاً مبعثرة ومنقطعة عن بعضها، ولتمحيص مستحصلات القياس التي استحصلت، ولتمحيص المقاييس أيضًا.
فبناءً على ما سردناه من مجموع الملاحظات هذه، نؤمن بعدم احتمال السير في أمان، ولا العيشِ بلا غلط وهدر في هذه الطرق المختلطة المشتبكة، من غير الاتباع للأنبياء العظام -على نبينا وعليهم الصلاة والتسليمات- الذين كل واحدٍ منهم في عصره أمينٌ وخبير وعليم بالخصوصيات المتنوعة للطرق التي يسلكها. وكذلك نؤمن بأن الوحي إكسيرٌ يحمي عقل الإنسان من شتى أنواع الهذيان، وبأن الأنبياء أطباء حاذقون يستعملون هذا الإكسير حيثما ينبغي. نعم، إن هؤلاء المصطفَين هم مرشدون وضَّاؤون يصونون عقل الإنسان من الانحرافات المختلفة، ويفتحون أمامه آفاقا لاهوتية مما وراء العالم المادي تعدو أهداف العالم المادي. وإنَّ يد العقل والمنطق والمحاكمة التي تبايع هؤلاء المرشدين، تَضْمَنُ في الوقت عينِه الاستفادةَ القُصوَى من طاقاتها. فنحن المؤمنين بالنبوة والوحي، نحترم محصولات العقل والمنطق والملكات العقلية، لكننا نؤمن أيمانا جازمًا بأنها لا تملأ ما يتركه الوحي من فراغ قطعًا إذا ما أُهمل، ولا تحل -أبدًا- محل مبلِّغِي الوحيِ الصادقين والكاملين.
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، أبريل 2001؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.