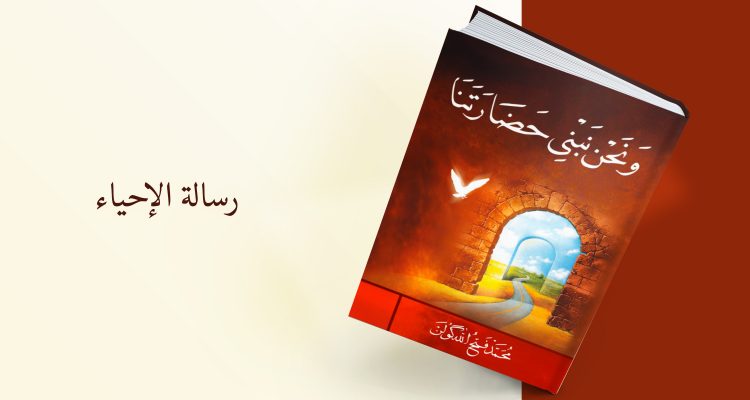لم نعرف حتى اليوم أيديولوجية نجحت في جمع البشر في ظلها زمنا طويلاً، بل ولا أيديولوجية اكتَشفت كلَّ الضرورات اللازمة التي يتطلبها جمع البشر تحت سقف واحد. ومع الادعاءات الباهرة، لم تستطع الدولُ الغربية التي هيمنت على قسم واسع من الأرض في التاريخ القريب أن تُحقق الأمان والحبور الدائم للعالم، ولا الشعوبُ الاشتراكية والشيوعية في الشرق، ولا “المحايدون” الذين يستوي وجودهم وعدم وجودهم، والذين عَبَّر عنهم “جميل مَريج” بـ”رجال الأعراف”.
إن هذا الإخفاق في تحقيق الوعود زعزع أركان الثقة لدى الذين هم في موقع المتلقي، بالإضافة إلى أنَّ عَجْز الحلول المطروحة عن البلوغ إلى مستوى العالمية، وقصورَها عن احتضان البشرية كلها، ومخالفتَها للطبيعة الإنسانية، قد أوقع الجميع في أزمةِ انعدامِ الثقة، بل في الريبة والشك في وعودِ كل من يعد! فلذلك تقف الإنسانية اليوم مع كل نظامٍ يُعرض عليها موقفَ الشك والقلق والاستهزاء.. لأنها باتت تعتقد أن الأنظمة التي فُرضت عليها حتى اليوم لم تَعمل كما ينبغي، بل عجزت عن العمل، وبالتالي هناك خلل في الأنظمة كلها!. وهذا يَقتلع بعض المحاسن التي غرستها تلك الأنظمة، فلا يُبقيها في ذاكرة البشر إلا خيالاً بائسًا ورؤى خائبة.
وكما أنَّ نقص قطعة صغيرة في نظام ميكانيكي متكاملٍ، يعطل عملَ النظام ويحوِّله إلى ركام، فكذلك هذه الأيديولوجيات؛ برزت إلى الميدان بادعاءات مبهرة، لكنها كانت عليلة بعلل وبيلة؛ مثل التصادم مع الطبيعة البشرية، والعجزِ عن احتضان الفئات كلها، والقصورِ في إنجاز وعودها، والضعفِ في الاستجابة للحاجات الإنسانية؛ والأنكأ إغفالُها مجموعة من القيم الإنسانية، بل تأجيج بعضِها مشاعرَ الحقد والبغض والغيظ بين البشر… فذلك كلُّه قوَّض أركانَ الأيديولوجيات كلها فخلفتْ خرائبَ وأنقاضا فكرية، أو قُلْ: هكذا حَدْسُ المجتمعات وظنُّها. ولذلك يمكن القول بأن الجميع اليومَ -إلا شرذمة قليلة- في حالةِ تزعزُعٍ وخيبةِ أمل وترقبٍ مريب وبحثٍ عن مَخرج خارق للأسباب.
بناء على ذلك، فإن أمتنا أولا وبالذات، ثم الإنسانية جمعاء، بحاجة ماسة إلى فكر سام يقوي إراداتنا، ويشحذ هممنا، وينوّر أعيننا، ويبعث الأمل في قلوبنا، ولا يعرِِّضنا للخيبة مرة أخرى. أجل، نحن بحاجة شديدة إلى أفكار وغايات وأهداف سامية، ليس فيها فجوات عقلية أو منطقية أو عاطفية، وتكون منغلقة تجاه السلبيات التي ذكرناها آنفًا، وصالحةً للتطبيق كلما سمحت الظروف. إننا نشهد مرحلة يتغير فيها مركز العوالم الفكرية في الأرض، وبدأ الناس يتوجهون بشكل أساسي ودائمي إلى الأفكار بدلا من الأشخاص، واضطر البشر بعد التجارب الفاشلة إلى المبالغة في التمحيص. فإن وُفِّقْنا في استثمار هذا الوضع العام بإستراتيجيات متماسكة ومنسجمة، ونظَّمنا التحفز المعنوي الموجود في المجتمع والنشاطَ الفعال المتراكم فيه منذ عصور، حول هدف سامٍ، فلسوف يجتمع الجمهور الأعظم من الإنسانية -ولو بنسبة معينة- حول هذا المركز الجاذب، إن لم يكن من يومه، ففي القابل القريب.
لكن ينبغي بادئ ذي بدء تعيينُ ذلك الهدف السامي. فلقد تعرضت أمم عديدة في الماضي، كما تتعرض في الحاضر، لهزات شديدة مع كونها تملك سياسات، ولكنها فشلت في ربط تلك السياسات بهدف سام وسليم، وقَصُرَ باعُها في النفوذ إلى قلوب البشر. صحيح أن هذه الحال أشد ظهورًا في البلدان التي لم تستقر فيها الحضارة والديمقراطية استقرارًا كاملاً؛ لكن الأمم التي ادعت لنفسها أستاذية العالم في الحضارة والديمقراطية، ليست أحسن حالاً في هذا الأمر؛ فمهما كان بهرج ظواهرها، ومهما زعمت دعاياتها، فإن عديدًا من الدول التي تبدو عظيمة بترفها وبذخها وأبهتها، إنما تُلهي في الواقع حشودَ الغافلين بالخدع الوقتية لحركتها في فلك النفعية، و تتباكَمُ إذ تدعو الحاجةُ للحديث عن الغد، بدلا من بث الأمل في مستقبل مشرق مغبوط أو حياة راقية… والأنكأ للجرح أنها تتمادى في تجويع القلب والروح والوجدان.
فالواجب علينا الآن -مع وضع كل هذه السلبيات نصب أعيننا- أن نضع أمامنا أهدافا سامية نتخذ في سبيل تحقيقها قيمَنا الذاتية أسسا لصياغة سياسات ومشاريع مستقبلية، حتى يتحققَ الاستقرار في سياساتنا… وإذ يتحقق ذلك، نتمكن من استخدام هاتين القوتين في الاتجاه عينه، من غير السماح للصِّدام بينهما. ونقول: “من غير الصدام بينهما”، لِعِلْمِنا بأن أيَّ نشاط أو حركة معينة، مهما تمثلت بمشاعر مخلصة، قد لا تكون بنَّاءة دائمًا. إن النية الخالصة جديرة بالتقدير باعتبارها بُعدًا معنويا في الأعمال الصائبة؛ لكن لا تحمل المعنى نفسَه البتة إذا كانت وصفًا من أوصاف العمل الخاطئ. إن أية حركة من الحركات قد تكون بنَّاءة أو هدَّامة حسب طريقة عرضها وأسلوب طرحها. وإذ يفيد العقلُ والمنطق والمشاعر قيمةً في أي مخطط أو مشروع، فإنه من المهم جدًا وجودُ تمثل سليم ومتين له، إلى جانب انعدام الثغرات العاطفية. وأحيانا قد تُبيد الأعمال بعضُها بعضًا بـ”التعارض” و”التساقط” وإن كان كل عمل من هذه الأعمال بمفرده خيرًا وصالحًا؛ فعندما يحاول أفرادُ النمل أن تنقل مادة إلى خليتها، فتتشوش بموجات الحس المؤقت أو باختلاف الأهداف في برنامجها الانسياقي المشترك، يَسحَبُ بعضُها المادة إلى جهة وبعضها إلى جهة أخرى. فتبدد طاقتها كلها ثم لا تتقدم إلى الهدف… كذلك المجتمعات التي لا توجد لها أهداف سامية ومُثُل عليا، أو وُجِدت ولم تَمتلك معها جاهزيةً ذهنيةً تناسبهما، فإنك تجدها تتحرك باستمرار، لكنها لا تقطع شوطا، لأن قطع الأشواط يتطلب -منذ البداية- تعيينَ هدف سام يوقره الوجدان ويُرغِّب فيه الانسياقَ الداخلي في نشوة كنشوة العبادة، ثم تفعيلَ منظومة سليمة حسب معطيات الظروف والبيئة العامة، ثم توجيهَ مختلف دورات الطاقات إلى نقطة واحدة معينة، ويعني ذلك تسخير التراكم العلمي والتجريـبي والطاقةِ الكامنة لأمرِ ذلك الهدف السامي والغاية المنشودة.
لقد تكاتفت المساعي الفردية كلها إبان الكفاح الوطني (حرب الاستقلال) في اتجاه تحقيق “تركيا المستقلة”. فهذا الهدف كان بسيطا جدا، ولكنه استطاع أن يحوز على الاحترام من كل الفئات، فيستحوذَ على العقل والمنطق والعواطف، ويكثِّفَ الحركاتِ كلَّها في نقطة واحدة. فكانت هذه القوة -في إطار الشروط العادية والأخذِ بالأسباب- كافيةً لتحقيق الهدف المنشود. غير أن كل نصرٍ وظفرٍ يستجلب الفتور والزهو. لذلك، مِن الصعوبة بمكانٍ الحفاظُ على نقاء لون الفكرة من التغير، وإدامةُ وجودها بحيويتها التامة. ونترك تقويم مدى نجاحنا في هذا الأمر للتاريخ… ونقول: إنه لا مفر للمجتمع الذي يعيش مشاعر الظفر والنصر وينتشي بهما، من ارتخاء التحفز المعنوي ومن التورط في دوائر الحلقات المفرَغة للفتور، ما لم يستمر إمدادُه بغذاء الأسباب الجديدة المحفِّزة نحو الأهداف والغايات السامية. وقد لا نُصيبُ إذا حصرنا أسباب ارتخاء هذا التحفز، في الفتور المصاحب للانتصارات، أو نشوة النصر، أو الانقباض واللامبالاة اللذَين قد يعتريان طبع الإنسان، فهناك أمور أخرى تولِّد شروخًا واسعة في حياتنا الفكرية وفي حركياتنا؛ مثل تصرفات الزعماء والمرشدين التي لا توحي بالثقة فتُوجِد التذبذبَ والشك، أو مثل ضعفِ قدراتهم وأهليتهم، أو ضيق أفق المثقفين أحيانا إلى درجة العجز عن رؤية مَواطئِ أقدامهم، بله إبصارَهم لمواقع نقل الأمة إلى آفاق جديدة، أو ضعفِنا كأمة عن الإحاطة بواقع حالنا، أو نقصِ التحفيز فينا، أو تقديم التفكير الميكافيلي النفعي على القيم الدينية وقيم الأمة…
ونحن الآن في مواجهة سلسلة من الأزمات المختلفة الناشئة من بيئة مفعمة بكل هذه المحاذير. وحالُنا يوحي بإمكان انفلات الذات وإرسالها، والوقوعِ في تبعثرٍ وتشتت يؤدي بنا إلى الانحلال والذوبان. ولا شك أن هذا يثير شهية العدو، ويخذل الصديق. بل الأدهى والأمرّ هو احتمال أن نُصرَع ونسقط -حفظنا الله تعالى- إذا تكاسلنا في سد هذا الكم من الثغرات العقلية والمنطقية والعاطفية المفتوحة في حياة الأمة. وحتى نجنِّب أمتنا من الفظائع والفواجع التي لا مفر منها في حال سقوطنا، فمن الضروري والمحتَّم أن ننسلخ ونتزحزح تمامًا عن التيه في انعدام الهدف، وقابلية الانصياع للاستعمار والاستغلال، ونفسية العيش تحت الوصاية، وهي الحالات الملازمة لدول العالم الثالث… وعلينا أن نتشبث بالسعي مستعينين بالله تعالى، ونستهدي التوفيق الإلهي في وحدة الأمة وتَوافُقها، ثم نركِّز على كينونتنا الذاتية ونتعقب أهدافنا وغاياتنا السامية.
ومن الظاهر عيانا وبيانا، أننا لن نتغلب بمشاريعَ سبق أن تعودناها، على كل هذه السلبيات في مرحلة عاصفة تُواجهنا فيها مهاوٍ سحيقة متشابكة، وجسور منهدَّة وطرق متوعرة، وبأمة مرهَقة بمحن متنوعة لم نشهدها في تاريخنا إلا قليلا. إن مثل هذه الأحوال غير الاعتيادية، تستدعي هممًا وجهودا تتجاوز الهمة والحمية الإنسانية، وطاقةً تعلو فوق ما هو المعتاد. وبالتالي قد تكون هذه الأحوال المدلهمة أحيانا ميلادًا تاريخيا للأمم، بمخططاتها، ومشاريعها، وإستراتيجياتها، وعقولها النابغة التي تنتج هذه المطلوبات، وممثليها الأبطال الذين جَلُّوا عن أن يعيشوا لأنفسهم بل نذروا حياتهم لإحياء غيرهم.
ولذلك، نؤمن -في هذا الوقت الذي نرجو ونأمل فيه أن نكون أمة عظيمة- بضرورةِ وضعِ مناهجَ ومشاريعَ مصوغةٍ بعقلية محترفة ومتخصصة، بل -قبل ذلك- بضرورة إعدادِ أجيال مثالية مستهدِفةٍ إنشاءَ أمة عظيمة. إنَّ تحقيق هذا الفكر بدرجة معينة، وإنْ كان في دائرة صغيرة، وظهورَ نماذجه في آلاف الأبطال الذين تركوا دُورهم وأوطانهم مهاجرين إلى أرجاء الأرض المختلفة، بروح الكفاح الوطني (حرب الاستقلال)، وسعيَهم في زرعِ فسائلِ “روح الأمة” في كل مكان، ووضْعَهم اللبنات الأولى لثغور حُلم المستقبل الكبير في جهات الأرض المختلفة، وعَرْضَهم لعالمهم الروحي والمعنوي حيثما حلُّوا، وكدَّهم مِن أجْل إبراز موقع أمتنا الموروثِ من أعماق التاريخ لِتملأَ مَقعدها الشاغرَ اللائق بها في التوازن الدولي، ونجاحهم في كل ذلك بقدْر معين… لهي أمثلة شاخصة ومهمة، تُرينا ما يمكن أن تفعله الأجيال التي تَعَلَّقَ قَلبُها بفكر سامٍ إلى حد العشق.
وإن هذه الكوادر “المحتسبة” التي قد تجوع أحيانا وتعطش أخرى، لكنها تتدرع دوما بالإيمان والأمل والعزم، وكأنهم المعنيون بوصف محمد عاكف: “مستعينون بالله، متشبثون بالسعي، مستسلمون للحكمة الإلهية”، هؤلاء يَحُلُّون -بحَملة وانطلاقة واحدة، وبنفخة واحدة- معضلاتٍ تَعجز دولٌ كبيرة أن تَحُلها بأنشطةِ “لوبياتها” وصَرْفِها الملايينَ على إعلاناتها. فينبغي أن لا يستهان بهذا “التكوين” الباهر، ولا يعلَّل بسلسلة الصُدَف، ولا يُربطَ بمكانة الدول المهاجَر إليها. بل السر في هذه الحركة الرائعة هو توجُّه القلوب المخلصة إلى الله تعالى، ومَنُّ الله تعالى بزيادة الإحسان على هذه الأمة التي تَوارثت العزَّ من أعماق تاريخها. نعم، يناط النجاح في هذا العمل -كما في كل نجاح- بالهمة والحميَّة من الصدور النابضة بالإخلاص، وبالوفاء من الأمة، وبالتوفيق من الله تعالى.
إن الأبناء المضحين اللائقين بهذه الأمة الوفية، يهرعون أفواجا باسم وطن المستقبل الكبير، إلى الغربة والحرمان، وفي أيديهم مشاعل العلم والعرفان، كالذين كانوا يتَحَدَّون اليأس والعجز في أشد محن التاريخ، وكالحملات الباهرة المتدفقة في انبعاث فجائي، والمترعرعة بجلوات الغنى والوجود على الرغم من الفقر والعدم، وكالجيوش المتقدمة إلى الموت في سرور وانشراح، على وقْع الأناشيد الوطنية، على رغم أنف التضييق والافتراء والاتهام مثلما يحصل اليوم. هؤلاء يؤدون منذ سنوات من غير توان أو فتور، رسالةً مهمة لحساب أمتنا وشعبنا وبلدنا، ونبعُ قوتِهم التي لا تنفد هو إيمانهم، ووقودُ مشاعلِ عشقِهم وحماسهم الذي لا يخمد هو هدفهم السامي وفكرهم وروح الأمة.
إن الذين يجهلون الأهمية الحيوية لهاتين المقومتين، ولا يعقلون القدرة التي يوجِدها الإيمانُ والأهدافُ السامية في الإنسان، فيتساءلون في شك ممزوج بالحقد والبغض أحيانا، وفي رفض غاضب متشرب بالهذيان أحيانا: “كيف يحصل كل هذا؟ ما مصلحتهم في هذا؟”… هؤلاء بقولهم هذا يفضحون أنفسهم ويُظهرون مدى حرمانهم من الأهداف والأفكار السامية.
ومن المسَلَّم به، أن الفكر والهدف السامي نشيدٌ يحرك الأجيال المثالية، و”مولِّدُ طاقةٍ” يَشحن طاقتَهم الدائمة، ومنبعٌ صافٍ يمد عشقَهم وحماسهم، ومشاعرُ فياضةٌ متدفقة تَرفع إلى السماء نداءَ مصيرهم. وبفضل هذا الفكر السامي، تصل المساعي الفردية المتوسعة باطراد والمتحولةُ إلى حركة جماعية، وإلى عمق مختلف وتدفق مختلف وإيقاع مختلف، و-بطبيعة الحال- إلى نسق مختلف، فتجدُ لتيارها مجرىً حتى وإن اضطُرَّت إلى اجتياح القمم لمواصلة المسيرة.
ففي عصورِ تخبُّطِ الإنسانيةِ في الظلمات، كان أهم مصادر القوة لتلك الثلة من المجاهدين الأوائل المنبثقةِ من صدر الصحراء هو إيمانهم واعتبارهم تفريغَ إلهاماتِ إيمانِهم الفوارةِ في قلوبهم إلى صدور الآخرين هدفا أسمى؛ فبحَملة واحدة بَدَّلوا مصيرَ الدنيا من النحس إلى السعد، وبنفخة واحدة صاروا صوتَ الأمل ونَفَسه في ثلاث قارات. وكانت المقومات عينُها وراء الأمل العثماني الكبير؛ فهي التي استنهضت عشيرةً من هضاب آسيا، ودفَعَتْهَا للسير إلى الأناضول لتُقيمَ دولةً عظمى. وأيضا هي التي كانت في عقول أبطال الكفاح الوطني (حرب الاستقلال). وكذلك جموع الهند الذين لم يكن يبدو على سيماهم أمارات الحياة في أواسط القرن العشرين، فحركهم إلى الحرية والاستقلال حماسٌ عظيم؛ كان أساسَ قوته إيمانُ ذلك الشعب وأمله، وفكرةُ أن يَحْيَوْا ويَبقوا بذاتهم ومقوماتهم.
لكن ينبغي أن يكون الهدف السامي، الذي يُلهِب الحماسَ في صدور الناس ويدفعُهم إلى التحرك، هدفا منضبطا بضوابط معينة، ومرتبطا بنظام معين؛ فإن كنتَ مهندسًا، فعليك أن تُعِدّ العدّة قبل البدء بإنشاء صرح؛ فتتفحصَ متانةَ عناصرِه وسلامتَها، وانسجامَ آحادها فيما بينها ومشاركتَها في جمال ذلك الصرح ومظهره. وهل يتحقق الكمال من غير توافر التوافق والمواءمة والانسجام في الأجزاء كلها!؟ إنَّ الهمم والمبادرات الفردية، إنْ لم تنضبط بالتحرك الجماعي ولم تنظَّم تنظيمًا حسنا، فستؤدي إلى تَصادُم بين الأفراد لا محالة… وبالتالي سيَختل النظامُ، وتَنهضُ كل حملة في عكسِ اتجاهِ حركةٍ أخرى، وتُنقِص كلُّ عملية من قيمة الناتج حتى يقرب من الصفر، كما في حاصل الضرب لكسور الأرقام ببعضها في الحساب. وكما أشرنا سابقا، ينبغي أن لا تُطفأ جذوةُ الطاقات الفردية بتاتا، باحتساب ضرر قد تسببه. بل على العكس؛ تجب العناية الرفيعة حتى لا تُهدَر ذرةٌ واحدة من تلك الطاقة، وتُوجَّهَ نحو تحقيق الهدف المنشود الذي تم تعيينه سابقا، ويزاح خُلُق المصادَمة في النفوس، ويستبدل بروح التوافق، بل يُطَبّعَ كل إنسان بهذا الطبع مهما أمكن.
وقد لا نجانب الصوابَ إن قلنا: إن الأديان كلها جاءت لترسيخ هذا الفهم خاصة، ضمن أبعاد تبليغاتها الشاسعة؛ فقد وَضع كلُّ دين ضوابطَ لتنظيم القدرات الفردية، فحَوَّلَتْها إلى مقومات مهمة في توجيه كل الطاقة الكامنة الموجودة نحو المسير إلى حضارة جديدة وعمران جديد. فبإرشاد الدين يوازِن كل فرد حريتَه وفعالياته الشخصية، مع حركة المجتمع وفعالياته؛ فيتصرف حرًا موفيًا إرادتَه حقَّها من جهة، ومحافظًا على تكامل الحركة مع الآخرين من جهة أخرى، فينجح في تحقيق الأمرين معًا. كالنجم التابع في موقعه، يدور في فلكه حول مركز الجذب، وحول نفسه في الوقت عينه. ولا يغترنَّ أحد بحيوية الحركات ونشاطها كلٍّ على حدة مهما بلغت، إن لم ترتبط أجزاءُ التكامل والتوازن بمنظومة أقوى وأمتن؛ فربما لا يُسنِد بعضها بعضًا في خط المقصود العام، فتولد أحيانًا نتائج أشد سوءًا من السكون والجمود. خلاصة القول: إن السكون والجمود، وكذلك الفوضى في الحركة، كلاهما موت. والمحتوم على الأمم التي تضعضعت نفوسُ أفرادها بمثل هذا الموت أن تُغلَب وتُطرَد إلى خارج مسرح التاريخ.
ومن دوافع الميل إلى التحرك الفردي في الإنسان؛ الأنانيةُ، وثقةُ الإنسان بنفسه، وقصورُ فهمه لحدود قدرته، وقصورُ إدراكه لمدى تأثير روح التوحد والتجمعِ والفعالياتِ المشتركة والوفاقِ والاتفاق في جلب العناية الإلهية. وكذلك، قد تتسبب الشهرةُ والمنصب والطموحاتُ الشخصية والنوازع الأخرى في تقدُّم الملاحظات ِوالنوازع الفردية إلى الصف الأمامي. وقد يَظهر بمثل هذه الملاحظات والنوازع منحوسون نسوا أهدافهم وبيئتهم تمامًا، وخنعوا لمطالب الأكل والشرب والنوم وطرحِ الفضلات، بعدما كانوا في صفوف “الخدمة – الدعوة” يهتفون بأناشيد الخدمة ويبذلون قصارى جهدهم طلبًا لـتحقيق مرضاة الله تعالى. إن من ينسى المقصود ويُضيّع الغاية المنشودة سيسقط –بالضرورة، كائنا من كان- في شباك الأنانية، وتحل رغباته الجسمانية محل عشق “الخدمة – الخدمة”، وتنطفئ عنده مشاعرُ “العيش من أجل الآخرين”.
من هذه الزاوية، يمكن القول بأن قضيتنا الكبرى التي تفوق كل القضايا هي إلهاب جمرة “الرغبة في إحياء الآخرين” في أرواحِ أفرادِ الأمة مرة أخرى، وتنقيةُ الأفكار الغريبة المندسة والحائلةِ بين “الأمة” وأهدافِها السامية.. ومِن بعده، تحريكُ طاقتها التي تبدو خامدة، وحثُّها بتحفيز جيد وبأنشطةٍ وفعالياتٍ منضبطة ومنظمةٍ، على السير نحو هدفها التاريخي كرة أخرى. ومن الضروري لمثل هذه الحركة تحديدُ معالمِ المساحات المشتركة التي ستُشَكِّل المحورَ لحركة المجتمع المشتركةِ بكل شرائحه من بدو وحضر، ومثقفين وحرفيين، ومعلمين وطلبة، وخطباء ومستمعين… ونعني بالمساحات أو القواسم المشتركة أمورا مثل السعي لجعل أمتنا عنصرًا مهما في التوازن الدولي… والعزم والإصرار من كل فرد على أداء هذه الرسالة بلا فتور مهما كان ثمن التضحيات… والتركيز على أولوية الفكر، وموازنته مع مشاعر روح الأمة، ومن ثم منعِ حصول الثغرات العقلية والمنطقية والعاطفية أثناء التحرك الجماعي… واحتساب عشق الحقيقة، والتوق للعلم والبحث وسائلَ للارتقاء العَمودي نحو الله تعالى، وتغذية المجتمع بهذه المفاهيم دائمًا.
ومن هذا المنطلق، نحن نؤمن بأن الأشخاص الذين يتقاسمون هذه الأهداف والغايات السامية سيُحافِظون على حماسهم وحيويتهم، وستُجرَى الفعالياتُ والأنشطة الجماعية بانسجام ووئام، وسيُستفاد من الوقت والإمكانات بأَجدى وسائلِ التحفيز السريعة، وستَبقى أبوابُ التجدد مفتوحة أبدا بفضل السماح للتفكير بالتوسع.
ولتحقيق هذا كله، لا حاجة إلى تلقين المسلم فهما جديدًا للإسلام، ولا إلى إعادة تعليم الإسلام للمسلمين؛ وإنما المطلوب العمل على تفهيم المسلم الأهميةَ الحيوية لما يعرفه عن الإسلام فعلاً، وقوةَ تأثيره، وديمومتَه الأبدية. لكن المؤلم حقا أن الأقوال في هذه المسألة مختلفة اختلافًا بينًا إلى درجة تحير العقول… فهوى النفس يتقدمُ العقلَ ويغتصب مقام الألوهية، والعواطف تُصدِر أحكاما من فوقِ عرش المنطق… وكما نرى هذا الانحراف لدى نفر من اللادينيين الذين احترفوا الإنكار والإلحاد والذين تعودوا مهاجمة الدين، فكذلك من الممكن أن نراه أيضا عند بعض المتعصبين المحرومين من الحياة القلبية والروحية، الذين يحسبون أنهم فقط متدينون.. هذان الصنفان قد يبدوان مختلفَين فيما بينهما حسب الظاهر، لكنهما كَفَرَسَيْ رِهَانٍ في الإضرار بالدين والأمة والوطن.
الصنفان كلاهما لا يوقر روح الدين، وكلاهما لا يتسامح في التفكير الحر، وكلاهما منغلق أمام فكرة المشاركة والتقاسم. رأسُ مالِهم الأعزُّ هو الفِرية والزور والتشويه، وأجود فنونهم هو النميمة واللمز على غير المحسوبين منهم… لا يهمهم إلامَ يلجأون، ولا على من يستندون؟ فالمهمُّ أن يبتلعوا ويأكلوا من لا يستسيغون وجوده. والحقيقة أن الفريقَين يبذلان في هذه المسألة جهدا عظيما وحثيثا أظن أنهم لو صرفوه فيما يليق، لَعمَّروا الأرض كلها.
وبدهي أنه في هذه الأجواء المظلمة الخانقة، وفي ميدان الذين لا يفكرون ولا يبصرون ولا يعلمون، لن توجَد الحياةُ الفكرية والعشق إلى الحقيقة والتحري في سبيل العلم والبحث… وإن وُجدت، فلن تنمو وتتطور… وإن نمت وتطورت، فلن تغادِر عالمَ الأحلام والفانتازيا. وإنّ حالنا المنكسرَ البائس شاهدٌ على ما نقول ليس بلسان واحد بل بألف لسان.
لكن الحال يقتضي في الواقع أن تكون عقليةُ أمتنا عقليةَ إعمارٍ وإنشاء، وأن ننجو من هذه الحالة التي نتخبط فيها والتي نعاني فيها من فقر التفكير وغياب الأهداف. ونحن اليوم بحاجة ماسة -قبل كل شيء- إلى هدف سام بعيد المرام، هو انبعاثنا برؤيتنا الحضارية وبثقافتنا الذاتية. ولكي ترتقي أمتنا -كصرح سامق- على أركان القيم التاريخية وقواعدها لابد لها أن تزيد من الصبر على الأوجاع والعذاب وتباطُؤِ الزمان الذي قد يوصل الإنسان إلى حد الجنون. إنَّ مراعاة سيرِ تطورِ الأحداث ضمن طبائعها منوطةٌ بسعة المعرفة بهذه الطبيعة. القرآن الكريم يخاطب سيدنا r فيقول: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾(التوبة:42)، فيُسَرِّي عنه r ويُوبِّخ المتخلفين المتهاوين في الطريق.
وحسب المنظور الإسلامي، يُعَدُّ المقصود حاصلاً بنوال الهدف البدهي لكل حركة أو انطلاقة، وهو رضى الله تعالى. فسواء بعد ذلك إن تحققت نتيجةُ الخدمات المقدَّمة باسم أمتنا بارتقائها إلى المكان اللائق بها في التوازن الدولي، أو لم تتحقق؛ فإن المؤمن يسعى لنوال رضاه تعالى في كل خدمة إيمانية وكل فعالية دعوية. فبهذه النظرة يتحول غيرها من الأهداف إلى أهداف إضافية واعتبارية ومجردِ وسائلَ تؤدي إلى الهدف الحقيقي.
المصدر: مجلة “يَنِي أميد” التركية، يناير 1999؛ الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغْلو.