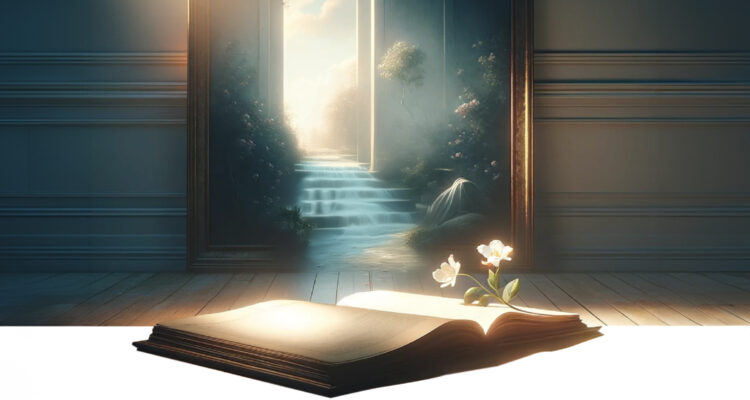لدينا مبدأٌ راسخ، ونظرةٌ أساسيةٌ تحكم تعاملنا مع الأمور: ما دام العمل لا يتعارض مع روح الدين، فقد حرصنا دائمًا على أن نراه في دائرة الخير، وأن نقوّمه بنظرةٍ إيجابيّةٍ، وأن نبذل ما في وسعنا لتقديره وتشجيعه.
بل حتى في بعض المواقف التي يُمكن أن تُفسَّر بالسوء، سعينا إلى إيجاد مسوّغاتٍ معقولةٍ لها، نستخلص منها معنى حَسنًا أو دلالةً طيبة.
وعندما واجهتنا تصرفاتٌ أو مواقفُ غيرُ لائقةٍ؛ أجبرنا أنفسنا على التحلّي بالتسامح وضبط النفس، ولم نُضخِّم المسائل الجزئية أو نجعل منها أسبابًا للخصومة والانقسام.
لم نشتبك مع أحد، ولم ننبش أحقاد الماضي، ولم نخلق ساحاتٍ جديدةً للنزاع، بل اعتبرنا مثل هذه السلوكيات والمواقف طريقًا مهمًّا لتحقيق التوافق والتسامح بين مختلف الفئات، فإدراكًا منّا لما خلَّفَته الخلافات والانقسامات والضغائن والعداوات المستمرّة منذ سنواتٍ من آثارٍ سلبيّة على أفراد المجتمع، سعينا إلى تهيئة أرضيّة للمحبة والمودّة، وإلى ابتكار سبلٍ جديدة تمنح المجتمع جوًّا من المحبة والتسامح.
الحمد لله ألف ألف حمد، إذ منَّ علينا فرأينا في زمنٍ وجيزٍ ثمار ما بُذل من جهدٍ وسعيٍ مخلص.. فالمشكلات التي استعصت على العنف والحدة بدأت تُحلّ واحدةً تلو الأخرى بالمحبة والرحمة، وأولئك الذين حاول بعضهم إخضاعهم بالقهر والإكراه لم يرفضوا دعوات التلاقي على القواسم المشتركة، والمغاليق الصدئة التي لم تفتحها القسوة والفظاظة، فتحَتْها الرِّقَّة واللين.
ذلك أن الإنسان المخلوق في أحسن تقويم، والمجبول على الشوق إلى الكمال، لا يمكن أن يبقى لا مباليًا أمام الخير والإحسان، فكل عملٍ يُقام باسم المحبة والتسامح كان ولا يزال جهدًا محمودًا في ميزان الإنسانيّة.
فمن ذا الذي يضيق صدرُه بأولئك السائرين على درب مولانا جلال الدين الرومي، وحاجي بكتاش الولي، وأحمد يسوي، ويونس أمره، الذين فتحوا صدورهم للعالمين؟! أن يُحتضَن الناس جميعًا، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، لأنهم بشر فحسب؛ وأن تُفتح القلوب للجميع دون استثناء؛ وأن يُبيَّن أن جوهر الوجود قد نما على تربة الحبّ، وأن الإسلام في حقيقته دينُ محبةٍ ورحمةٍ… أيّ ضررٍ يمكن أن يجيء من هذا؟
إذا كانت كلُّ هذه القيم تُعدُّ -في الأمس واليوم على السواء- سلوكًا مقبولًا وجميلًا في نظر الإنسانية، فلماذا يقلق بعض الناس منها ويستشعرون منها الضيق؟
أولئك الذين لا يكفّون عن تمجيد مولانا “جلال الدين الرومي”، ولا يتركون اسم “يونس أمره” يغيب عن ألسنتهم، ويذكرون “أحمد يسوي” بإعجابٍ، ويفخرون بتراث “حاجي بكتاش الولي”، تراهم اليوم يُلصقون شتى التهم بأناسٍ يسعون إلى إحياء الروح نفسها في أرجاء العالم!
ولِمَ ذلك؟
لأن مشكلتهم الحقيقية ليست مع ما يُنجَز، بل مع من ينجزه!
إنهم يرون أنه لا خوف من أولئك الذين رحلوا في بطون التاريخ، ولا بأس في مدحهم، ما داموا لا يُشكّلون خطرًا حاضرًا، ولا ينافسون أحدًا في ساحة التأثير.. لكن حين يكون الفاعلون من أبناء هذا الزمان يبدأ ميزانهم بالاختلال، وتتبدل المعايير.
فأيًّا كان العمل جميلًا، ومهما كان أثره طيبًا، فإن مجرّد أن القائمين به ينتمون إلى رؤية فكرية مغايرةٍ كفيلٌ بأن يثير في نفوسهم الهواجس والريبة.
يُنظر عندئذٍ إلى من يُعيدون صدى أفكار “مولانا” و”أحمد يسوي” و”يونس أمره” بنفس الرهافة والصفاء، ويجاهدون لترسيخ جوٍّ من المحبة والتسامح بين أفراد المجتمع، على أنهم خطرٌ يُخشى منه، وتهديدٌ ينبغي الحذر منه!
إنهم يخافون أن يتحوّل أولئك مع مرور الوقت إلى قوّةٍ مؤثّرةٍ، أو أن يمتلكوا من النفوذ ما يُحرجهم، أو يضطرهم يومًا إلى الجلوس معهم على طاولة الحوار والتفاهم.
لو أن هذه النفوس التي تعاني جنون العظمة عاشت في عصر مولانا جلال الدين الرومي لَسَعت إلى قمع صوته أو نفيه، ولو أن مولانا عاش في أيامنا هذه، وتشكّلت حوله حَلقةٌ متناميةٌ من الناس يومًا بعد يوم، وهرع بعضُ الناس إليه مقتنعين بدعوته؛ لاعتُبِر هو الآخر خطرًا كبيرًا عليهم، ولوضعت بعض الكيانات المظلمة الخططُ لإخماد صوته، ولَبادَرتْ الأفواهُ المشؤومة التي لا تنطق إلا لِتكيلَ شتى الإهانات والافتراءات على مَن تعلنهم خصومًا لها إلى ترديدِ الكلام نفسه عن أحمد يسوي، ولَظلّتْ تفكر كيف تقمع تأثير يونس أمره الذي أسر القلوب بما نشرَه من محبةٍ وتعاطف، ولَأعلنوا أن حاجي بكتاش خائنٌ ووضعوه في السجن؛ لأنهم لا يطيقون وجود إرادة خارجة عن إرادتهم، أو قوّةٍ وسُلطةٍ غير قوّتهم وسلطتهم.. وللأسف، لا تزال النزعة العسكرية التي سادت في الفترات الماضية مستمرَّةً حتى يومنا هذا تحت أسماء وألقاب مختلفة، ولا ترحم مَن لا يسيرون على خطاها، ولا يلتزمون بخارطة طريقها.
أمام هذا القدر من التناقض واللامنطق، قد تهتزّ المعنويات في بعض الأحيان، وتضعف القوة الروحية في مواجهة ما يُرى من ظلمٍ أو افتراء.. في مثل هذه المواقف، قد تتسلّل إلى الأذهان تساؤلات مقلقة:
“هل نحن على صواب؟! هل أخطأنا الطريق؟! لماذا يقف هؤلاء ضدنا؟!”
والحقيقة أن الخطأ ليس فيما نفعله، ولا في الجهود التي تُبذل بإخلاص.. فما يجري اليوم هو الامتداد الطبيعي، حرفًا بحرفٍ وروحًا بروحٍ، لما فعله مولانا جلال الدين الرومي في زمانه.
إن لـ”مولانا” في هذا العصر ورثةً بالروح، ولـ”سلطان ولد” خلفًا في الطريق، ولـ”أحمد يسوي” امتدادًا في الدعوة والنور؛ رجالًا ونساءً يسيرون على النهج ذاته، ويُجدّدون نغمة الحبّ الإلهي في أسماع البشرية ضمن قالبٍ جديدٍ يليق بعصرهم، محافظين على الجوهر الذي لا يتغير: دعوة الإنسان إلى الله بالمحبة والنور.
غير أن بعض الناس لا ينظرون إلى جمال العمل نفسه، بل يوجّهون أبصارهم نحو من يقومون به؛ ذلك لأنهم -منذ البداية- وضعوا هؤلاء في خانةٍ مسبَقةٍ، وأصدروا في شأنهم أحكامًا قطعيّة، ووسموهم بوصمة “الآخر” و”الشرّ”، ومن ثمّ صار كلُّ عملٍ يصدر عنهم، مهما بلغ من الجمال والنقاء، يُعدّ في نظرهم شرًّا وباطلًا.
فالحكم عندهم لا يقوم على قيمة الفعل، بل على هوية الفاعل! منطقُهم الضيّق يقول: “ما دام هؤلاء هم الذين يفعلون، ففعلهم شرٌّ لا محالة!”.
ولو أنهم أخذوا بأيدي الناس إلى الجنة، ووقَوْهم من نار الهلاك، وأحيَوا الضمائر بالإيمان، وأنبتوا في القلوب بذور الجنة الصغيرة حتى تزهِر بالطمأنينة، ومنحوا العالم سكينةً وسلامًا؛ لظلّ عملُهم في عيون أولئك مذمومًا، وهم في قواميسهم متَّهَمون.
فالقضية ليست في الحقيقة ما يُفعَل، بل في القبول المسبق أو الرفض المسبق؛ إنهم قالوا لأنفسهم منذ البدء: “نحن نرى هؤلاء آخرين، ونحكم على أعمالهم بالسوء”، وهنا تكمن المشكلة.
لا ينبغي لكل ما يجري أن يُوهِن العزائم أو يُضعف القوة الروحية، بل الواجب أن يكون باعثًا على مزيدٍ من الثبات والإصرار، وأن تُضاعَف الجهود في مواصلة الخير.
صحيحٌ أن الإخوة والأخوات العاملين في الميدان أدرى بما يفعلون وبما ينبغي أن يُفعَل، ولستُ هنا في مقام توجيهٍ أو وصايةٍ أو إشارة، غير أنّي أستأذن في أن أقول كلمةً خالصة:
في مثل هذه الأحوال، لا يصح أن نستسلم للذعر أو الارتباك؛ فالفزع إنما هو صورةٌ من صور اضطراب الآخرين، وانعكاسٌ لمخاوفهم هم، لا لموقفنا نحن.. إنهم هم الذين يخشَون كلّ شيءٍ، ويرتعدون من كلِّ بادرة ضوءٍ.
لذلك ينبغي أن نمضي في خطواتٍ تُدهشهم وتربك حساباتهم؛ فإن خرج هذا العام عشرة آلاف إنسانٍ يبثّون إلهامات قلوبهم في صدورٍ متعطّشةٍ في أرجاء الأرض، فليكن العام القادم مائة ألف، والذي يليه مائتين، ثم أربعمائة، فثمانمائة ألف…
فلنبحث عن سُبلٍ تجعل خدمة الخير تتسع على نحوٍ هندسيٍّ متصاعد، يفيض أثرها في الآفاق.. وحيثما أقاموا المتاريس في وجهكم، أو حشدوا الجموع لمحاصرتكم، فلتقابلوهم بخطواتٍ من المحبة والحوار والاحتضان الإنساني، بخطواتٍ إيجابيةٍ صافيةٍ تُفلت من أيديهم فلا ينالون منكم شيئًا.. وحين يسعون إلى اللحاق بكم، لن يروا إلا غبار الخير الذي خلّفتموه وراءكم.
وحينذاك، سيعجزون عن مجابهتكم، ويتعثّرون في سعيهم لإيقاف ما أنجزتم من جميل الأعمال؛ لأنهم سيغرقون في دوامة الهلع التي أنتجتها أوهامهم، ويظلّون أسرى لظنونهم السوداء حتى تُشلّ أيديهم أمام فيض الجمال المتحقق.
وكلما ازدادت قلوب الناس انجذابًا إليكم بجاذبيّتكم القدسية، وكلّما ازداد وعيُ الجماهير بعقلانية ما تفعلون واتّزان ما تقولون، حينها فقط سيتلوّى مَن في صدورهم ظلمةٌ كالخفافيش أمام نور الفجر، وربما يجنّ جنونهم من شدّة الحسد والضيق من ضياء الحقّ الساطع.
وينبغي أن ننتبه إلى أنه ليس هدفنا أو همّنا أن نُخرِج هؤلاء عن صوابهم، فنحن لا نؤمّن على الدعاء بالشرّ، ولا نسعى للانتقام، ولا نتمنى الشرَّ لأحدٍ، ولا يمكن أن يكون هَمُّنا أن يُصاب أحدهم بمكروه أو يُساق إلى الجحيم بسبب الهوس الذي يعيشه.. لربما رويتُ لكم الحادثة التالية عشرات المرات: ذات مرة، كان أحد الذين ألحقوا أكبر أذًى بالخدمة يتحدّث عنها بحقدٍ وعداء فخطر في ذهني للحظةٍ عابرةٍ فكرة أنّ مآله إلى النار، -لا حرج في ذلك من حيث الظاهر؛ لأن ثمة شخصياتٍ عظيمة مثل محمد بهاء الدين النقشبندي، والإمام الغزالي، والعلامة النورسي قد دعوا أيضًا على الظالمين بالجحيم والعذاب المهين، ووجدوا في ذلك عزاءً لهم في مواجهة الظلم الشديد الذي عاشوه- لكنها كانت مجرد فكرةٍ عابرةٍ فقط، إلا أنني لما دخلتُ غرفتي فاضت عيناي بالدموع، وأجهشتُ بالبكاء قائلًا: “لا يا رب! لا أتمنى هذا، ولا يمكنني أن أطلب منك معاقبة هؤلاء الذين يؤذوننا، ويحاولون -كذبًا وافتراءً- تشويه سمعة الذين كرسوا حياتهم للخدمة في سبيلك، فهذا طلبٌ ثقيلٌ جدًّا” ولكن رجوت أن تتجلى مشيئَتُك في هدايتهم.
فليسمع العالم كله؛ إن هذا هو ما يعتلج في صدورنا! لا نتمنى لأحدٍ أن يهلك بسبب جنون العظمة أو غضبه أو قلقه أو آلامه النفسية والجسدية، فمثل هذه الفكرة لا تخطر حتى على بالنا.. دعاؤُنا الوحيدُ هو أن يرزق اللهُ الجميعَ الفهمَ السليم والإنصاف! وأن يريهم الحقيقة كما هي بما يتناسب مع قيمتها وقدْرها! ويا ليتنا جميعًا نحتضن كلَّ عملٍ فيه خيرٌ للإنسانية، فنتربّع على عرش القلوب، بدلًا من أن نضيّع وقتنا في العصبية والعناد والإقصاء، لأن هذه الأمة تنبض بقلبٍ واسعٍ تحتضن به أيَّ شخصٍ، وترفعه فوق رأسها بمجرّد أن ترى منه أدنى خيرٍ، فهدفُنا واضح وهو الفوز برضا الله عز وجل عن طريق تأليف القلوب وإشاعة السكينة في عالم الإنسانية بأسره.. وإن أولئك الذين يختلِقون المشاكل وكأنها موجودةٌ، هم في الحقيقة مصدر المشكلة.. إننا أبناء مولانا جلال الدين الرومي وأحمد يسوي، ولهذا تنبض قلوبنا حبًّا للإنسانية، أما الذين يعيشون على الحقد والكراهية والغلّ فهم “الآخر”.. إننا ملتزمون بعهدٍ لا نُخلفه، وهو أننا لن ننظر إلى أحدٍ على أنه “الآخر”، بل سنفتح قلوبنا حتى لمن يروننا كذلك، ولو رأينا أحدَهم يتقدّم نحونا بخنجرٍ لَقلْنا له: “تعال يا صديقي العزيز، إن لك أيضًا موقعًا في قلبي”.
اللهم يسر لنا السيرَ في سبيلك، ووفِّقنا إلى مضاعفة الأعمال الصالحة والمواظبة على القيام بها!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: موقع هيركول، الرابط التالي: https://herkul.org/alarabi/assaerun-ala-darb-mawlana/