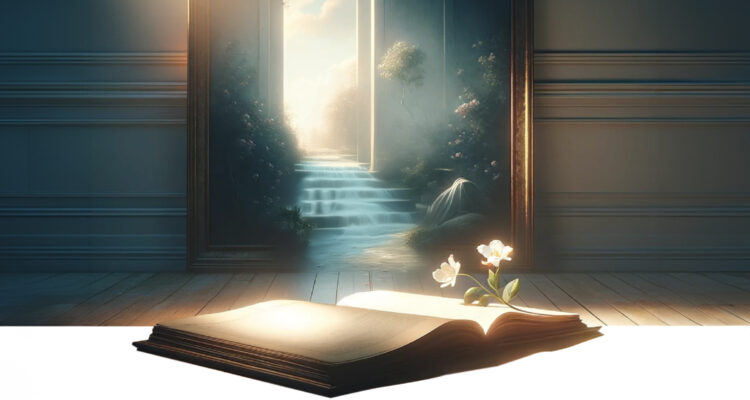القدر هو ما فصّله الله سبحانه -في علمه- من تخطيط وتنظيم وتصميم للأشياء. والعلم بالشيء لا يعني إيجاده، إذ لو عرفت تصميم ألف بناء وحفظت خطة عمل لمئات المصانع، فلا يأتي بعلمك هذا أي شيء للوجود، بمجرد ما في حافظتك من تصميم وتخطيط. إذ لإيجاد تلك المباني والمصانع لا بد من إرادة وقدرة. وبخلافه فذلك التخطيط والتصميم ليس إلا علم يخصك وحدك. فأنت تدور فيه خيالاً، وأي عارض في خيالك يؤدي إلى ذهاب تلك البنايات والمصانع، حتى إذا ما ضعفت المخيلة وجفت ينابيعها تصبح كأن لم يدر فيها شيءٌ قط من المعرفة والتصميم والتخطيط.
إن الذين وُهبوا بصيرة نفّاذة وفراسة قوية يستطيعون أن يحدسوا بعض مقدرات الإنسان المستقبلية بمجرد النظر إلى سيماه.
ونقول أيضاً: إن القدر من نوع العلم، والعلم تابع للمعلوم دائماً؛ أي على أيّ كيفية يكون المعلوم، كذلك يحيط به العلم. وليس المعلوم تابعاً للعلم. وحيث إن الأمر هكذا فإن الله سبحانه يعلم ما سنعمل وكيف نعمل بإرادتنا، ويضع تقديره على وفق علمه. فعلمُه محيط بكل شيء؛ بل التعبير بـ”أن هذا الشيء يعود إلى علمه” سوء أدب مع الله؛ إذ لا شيء خارج علمه، وإنما نستعمل هذا التعبير لتقريب المسألة إلى العقل وبقصد التوضيح.
التعبير بـ”أن هذا الشيء يعود إلى علمه” سوء أدب مع الله؛ إذ لا شيء خارج علمه، وإنما نستعمل هذا التعبير لتقريب المسألة إلى العقل وبقصد التوضيح.
لنفكر -مثلاً- في قطار يقطع المسافة بين محطتين معلومتين بزمن معلوم. فهذه نتيجة محسوبة ومحسومة وهي معلومة قبل حركة القطار بكثير. وتطبع هذه المعلومات في قوائم ولوحات أحياناً. فالنتيجة المعلومة هذه عبارة عن تخطيط وتصميم. والآن إذا ما قسنا المثال على مسألتنا نقول: “إن هذه النتيجة هو القدر”. إلاّ أن هناك أمراً وهو أن هذه المعلومات التي لدينا ليست قوة جبرية تدفع القطار إلى الحركة؛ بمعنى أن القطار لا يسير إلى المحطة المعنية لأن هذه الخطة مرسومة ومصممة، وإنما لأن القطار سيكون في تلك المواعيد في تلك المحطات حسب تصميم هذه الخطة، أي في قَدَر القطار يُسجّل هكذا، حيث إن العلم تابع للمعلوم. فكيفما يكن الشيء يكن العلم به، ويوضع التقدير بحقه وفق ذلك العلم.
إن علم الله سبحانه محيط بكل شيء من جميع جهاته. فهو سبحانه يقدّر تقديره وفق هذا العلم المحيط.
إن علم الله سبحانه يطل من الأعلى، ينظر في آن واحد إلى كل ما حدث ويحدث وما سيحدث كأنه حادث الآن. فالسبب والنتيجة، والعلة والمعلول، والبداية والنهاية، مندمجة كلها في علمه، منحصرة كلها في نقطة واحدة بلا زمان ولا مكان. ولهذا فليس هناك أول وآخر، وقبلُ وبعدُ. أي أن علم الله سبحانه محيط بكل شيء من جميع جهاته. فهو سبحانه يقدّر تقديره وفق هذا العلم المحيط. ولهذا فهذا التقدير قد حسب حساب إرادة الإنسان في الأفعال الإرادية ولا يخرجها من حسابه، أي لا يبطلها.
إن أفعال الإنسان محفوظة كلها مسبقاً في اللوح المحفوظ، وأن ما قُدّر له بعد ذلك وعُلّق على عنقه هو ما استُنسخ من هذا اللوح المحفوظ، كما هو واضح في الآية الكريمة: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾(الإسراء: 13).
نعم إن كل ما سيفعله الإنسان قد كُتب مسبقاً، وإنما هو بأفعاله يضع ما كُتب في حقه موضع التنفيذ. وإن هذا القدر المكتوب هو ما عُلم بعلم الله من أفعال سيفعلها، أي معلومة مسبقاً. وهذا العلم ليس قوة تجبره على الفعل. وإذا ما قورن الكتاب المعلق على عنق الإنسان مع ما يسجله الملائكة من أفعاله، يشاهَد أن الإنسان لم يفعل سوى ما كُتب له بحذافيره. والله سبحانه سيُقرئ الإنسان هذا الكتاب ويحاسبه وفق ذلك.
إن كل ما سيفعله الإنسان قد كُتب مسبقاً، وإنما هو بأفعاله يضع ما كُتب في حقه موضع التنفيذ.
وبهذه المناسبة أريد أن أشير إلى ما يأتي:
إن الذين يزاولون مسائل الروح مزاولة جادة يقولون: “إن الروح قرين الجسد، يعني إن مع البدن المثالي هناك جهة ثانية للإنسان فيها ما يخص حياته من تقدير وتعيين؛ لذا يمكن معرفة ما هو مقدّر للإنسان -إلى حدّ ما – عندما يكون الإطلاع كاملاً على ماهية روحه ووظيفته”.
القدر هو ما فصّله الله سبحانه -في علمه- من تخطيط وتنظيم وتصميم للأشياء. والعلم بالشيء لا يعني إيجاده.
هذا وإن المشتغلين بـ”علم القيافة” (أي المعاني التي تفيدها الجهة المادية للإنسان كالخطوط الموجودة في كفه) يرون: أن هذه الأمور تعني انعكاسات للقدر على جسم الإنسان. أي يمكنهم أن يعرفوا ما سيقع على الإنسان من أحداث ولو بشكل جزئي. حتى إن الذين وُهبوا بصيرة نفّاذة وفراسة قوية يستطيعون أن يحدسوا بعض مقدرات الإنسان المستقبلية بمجرد النظر إلى سيماه. وهذه الأمور ليست معرفة بالغيب، لأنهم يعتقدون أن الأسرار التي تخص القدر قد وضعت على شكل إشارات وعلامات في جسم الإنسان. وحتى لو كانت هذه الإشارات غيبية بالنسبة للجاهلين بهذا العلم؛ فإن الغيب بالمعنى الحقيقي لا يُحصر في هذه المعلومات. بمعنى أن ما أوردناه لا يُعارض حكمَ “لا يعلم الغيب إلاّ الله”. إذ إن محاولة معرفة القدر من الإشارات والعلامات الموضوعة في جسم الإنسان كان علماً موجوداً حتى في عصر النبوة، وكان يسمى العالم به (القائف). والرسول لم ينكر هذه المعرفة، بل قد أحضر قائفاً وأطلعه على أسامة وأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما وهما مضطجعان، وغطاهما الرسول r وأقدامهما بادية من الغطاء، حيث كان أسامة أبيض البشرة بخلاف والده، ولهذا دار اللغط حولهما.
«عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ قائف والنبيُّ شاهدٌ وأسامةُ بن زيد وزيدُ بن حارثةَ مُضْطَجِعان فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ. قال فسُرَّ بذلك النبيُّ وأعجَبَه فأخبر به عائشةَ».