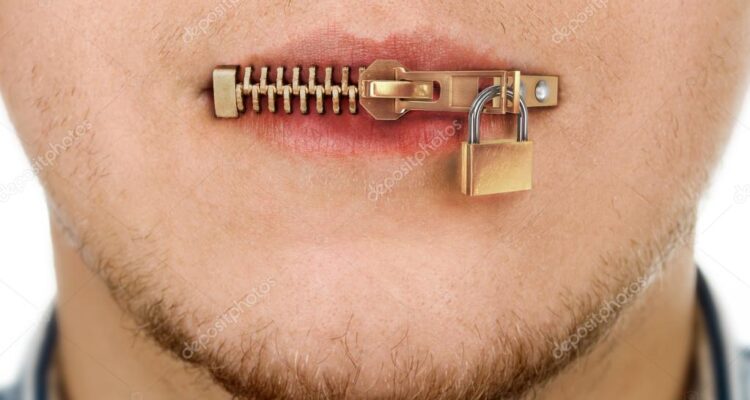إنَّ الواجب الذي يقع على كاهل مَنْ نذروا أنفسهم لخدمة الإيمان والقرآن في مرحلة شاعت فيها مشاعر الأنانية أكثر فأكثر، وأُثيرت الحوادث السلبية باستمرار، وتطاول الجميع بعضهم على بعض؛ هو احتضانهم البشرية جمعاء بمزيد من الحب والتسامح أكثر من أي وقت مضى، فإن قابلوا هذه النوعية من الأعمال السلبية بمثلها فقد أساؤوا إساءة عظيمة لمجتمعاتهم أنفسهم وللإنسانية قاطبة على حد سواء.
وبما أننا بشر فقد نغضب ونسخط إزاء بعض الأحداث الأليمة، وننهزم لغضبنا وسخطنا، بل إنه قد تنبري في أنفسنا أحيانًا مشاعر الحقد والغضب تجاه فئة من الظالمين والمُعتدين ممن يتجاوزون الحدود في أفعالهم، بيد أنه يجب علينا أن نقمع هذه المشاعر السيئة وألا نسمح لها بالظهور؛ وذلك عبر إيفائنا إرادَتَنا حقَّها، بل ويجب علينا -ما استطعنا- أن نُذيب تلك المشاعر ونقضي عليها بواسطة نظام هضمنا وعفونا المعنوي، فإذا ما تمكنا من السيطرة على غضبنا الذي يفور ويغلي كالحمم البركانية فزنا من ناحية بثواب العبادة، ومن ناحية أخرى لم نشارك في توسيع رقعة الانقسامات والصراعات في المجتمع.
يجب على الإنسان أن يوفي إرادته حقَّها، وألا يسمح لمشاعر العداوة بأن تحكمه، فإن بدت الكراهية والحقد مرة واستقرّت في صدره فقد يصعب جدًّا اقتلاعُها والتخلّص منها.
ومن المؤسف أن السبّ والشتم والتجريح صار مألوفًا أو موضةً في يومنا هذا؛ فالجميع لسانهم سليط، وأسلوبهم مؤذٍ وجارح، حتى وإن استحق البعض هذا فإنه لا فائدة أبدًا من الإساءة إليهم بالقول؛ بل إنه يؤدي إلى الضرر، وكما أن السب والشتم في حق المذنبين لا يؤجر عليه المسلم، فإنه ليس فضيلة أيضًا، ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة ولو بنصف كلمة تشير إلى أن قول: “لعنكم الله” لمن شقّوا سيدنا زكريا عليه السلام بالمنشار، أو لمن قتلوا سيدنا يحيى عليه السلام أمر تعبدي يؤجر عليه المرء.
ليتنا نستطيع أن نوسّع قلوبنا لاحتضان الأشرار والسّيّئين، ونتمنى لهم الخير، فنقول مثلًا: “اللّهم ألقِ الإيمان في قلوب مَن يسيئون إلينا واشرح صدورهم للإيمان والإسلام والإحسان! اللّهم اهدهم الصراط المستقيم!”، إنني أرى هذا تصرّفًا إنسانيًّا، وفكرًا إنسانيًّا، وسلوكًا إنسانيًّا، وعندما يمكن للمرء أن يتصرّف بإنسانية لا ينبغي له أن يتدنى إلى غير ذلك، وعلى سبيل المثال فإذا ما ركلكم أحدهم أو ضربكم فلا يمكن أن يُوصَفَ فِعْلُهُ بالعمل الإنساني، وإذا ما قابلتم إساءَته بمثلها فإنكم تنسلخون تمامًا من إنسانيتكم، وجميعُ النصوص القرآنية والحديثية تحثُّ المؤمنين وتشجعهم على التصرف بطريقة إنسانية.
حُسْنُ خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم
طالعنا في كتب الحديث أن مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم بكى حزنًا على موت بعض الناس مثل ابنه إبراهيم، والصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، لكن أيًّا منهم لم يهزه عليه الصلاة السلام بقدر ما هزه استشهاد حمزة رضي الله عنه؛ ذلك أن عينيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضتا بالدمع حزنًا حين رأى جسد عمِّه حمزة رضي الله عنه الذي أحبه أكثر من نفسه وقد مُثِّل به في ساحة الحرب يوم أحُدٍ، إلا أنه برغم هذا لم يُكِنّ في صدره بغضًا ولا كرهًا لا لـوحشي الذي غرس حربته في صدر سيدنا حمزة، ولا لهند التي تسببت في هذا، ولا لأبي سفيان أيضًا، وقد انضم وحشي لاحقًا إلى صفوف الصحابة، وحين جاء الوقت أخذ مكانه في الجيش الذي أعدَّه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لمواجهة مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، فغرس حربته هذه المرة في صدر ذلك الكذاب.
يجب على المؤمن ألا يدنس فمه ولسانه وقلبه بالكلمات القبيحة السيئة، وألا يستثير الآخرين ضده، بل يجب عليه أن يسعى إلى حل المشكلات عبر تمثيل قيمه بشكل مثالي ولائق.
ولو أن النبي الأكرم أخذ موقفًا ضد وحشي وتحدث ضده، فالأرجح أنه ما كان سيشرف بالإسلام، ولا أن يقاتل ببطولة في اليمامة، وبالمثل لو أن أفراد عائلة بني أمية لم يروا الشفقة والمسامحة والرحمة الواسعة من النبي الأكرم لما كانوا سيدخلون في الإسلام.
لم تكن مسامحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطفه وعفوه وصفحه موجهة لقاتلي عمه فقط؛ فلقد عفا حتى عن مشركي مكة الذين مارسوا ضده كل أنواع الشر طيلة حياته في مكة، وحرموا عليه ماءً يشربه وطعامًا يأكله، ولم يمنحوه حق الحياة وفرص العيش حيث وُجِد، وأصدروا الأوامر بقتله، ولم يتركوه وشأنه حتى في موطن هجرته بعد أن ترك مكة ورحل عنها، لقد خاف الجميع يوم الفتح من إمكانية محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحقّه من قبل.. كان يدور بخلدهم: “تُرى هل سيقابِل الظلم والتعذيب الذي مارسناه ضدَّه بمثله؟”، بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ“[1]، وهذا هو مضمون ما قاله يوسف عليه السلام لإخوته: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/92)[2].
لو أن النبي الأكرم أخذ موقفًا ضد وحشي وتحدث ضده، فالأرجح أنه ما كان سيشرف بالإسلام، ولا أن يقاتل ببطولة في اليمامة.
أية مروءة هذه! لم ينبس ببنت شفة لهؤلاء الذين ساموه كل أنواع الغلظة والجفاء طوال هذه السنوات، لم يهتم ولم يبالِ بإساءاتهم التي ارتكبوها بحقه، ولم يقف عندها، ولم يتوجه إلى معاقبتهم، بل وحتى إنه لم يتحدث عنها كيلا يُحرجهم، لقد كان سخيًّا كريمًا لأقصى درجة تجاه هؤلاء الذين ندموا بالفعل وكانوا يتشوفون إلى عفوه وصفحه، والواقع أن هذا كان دليلًا على تحلّيه بالأخلاق الإلهية.
أجل، نكرّر فنقول: لا فائدة أبدًا تعود على المرء من الشتم والإساءة إلى هذا أو ذاك، فمثل هذه الكلمات تضيف مزيدًا من السلبيات إلى تلك السلبيات الموجودة بالفعل، وتؤدي إلى تكوُّنِ دائرة مفرغة، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/108)، والقرآن الكريم يحرم سبَّ وشتمَ الأوثان مثل اللات ومناة والعزى وإساف وغيرها التي عبدها مشركو مكة من أمثال أبي جهل وعتبة وشيبة وابن أبي معيط والوليد بن المغيرة؛ إذ يقول: “لا تقولوا للأوثان: خسف الله بكم الأرض، قهركم الله!”، لماذا؟ لأن عبَدَتها سينبَرون هم أيضًا فيقولون في الله ربكم -حاشا وكلا- ما لا يليق من الكلام.
من المؤسف أن السبّ والشتم والتجريح صار مألوفًا أو موضةً في يومنا هذا؛ فالجميع لسانهم سليط، وأسلوبهم مؤذٍ وجارح، حتى وإن استحق البعض هذا فإنه لا فائدة أبدًا من الإساءة إليهم بالقول.
لهذا السبب يجب على المؤمن ألا يدنس فمه ولسانه وقلبه بالكلمات القبيحة السيئة، وألا يستثير الآخرين ضده، بل يجب عليه أن يسعى إلى حل المشكلات عبر تمثيل قيمه بشكل مثالي ولائق، ودعوني أذكركم بعبارة لطالما كررناها: “الحال مفتاح لحلول جميع المعضلات”، فالأساس هو أن يمثل الإنسان قيَمَه تمثيلًا سليمًا، وأن يكون قدوة حسنة.
مقابلة الإساءة بالإحسان
لطالما كان رجائي من الله تعالى بشأن من يكتبون ضدي ويسيئون إليَّ باستمرار أن يأتي الحق تعالى بهم أمامي ذات يوم، ويقدرني على فعل الخير لهم؛ فمثلًا إن أجد سيارة أحدهم تعطلت بينما أمرّ من الطريق، أتوقف وآخذه إلى سيارتي، وأوصله إلى حيث سيذهب، وأقابل بالإحسان الإساءة مثلما أوصى القرآن الكريم وجسَّدَ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه المعاملة، وبإذن الله تعالى لا نؤذي أحدًا بسبب جوره وتحقيره وإهانته لنا، ولن نكسر بخاطر الآخرين وإن كسروا هم بخاطرنا، ولن نؤلمهم وإن آلمونا؛ لأن القلوب في يومنا تحتاج إلى البناء والتلاحم، وليس إلى التدمير والتفريق.
والواقع أن الظالمين والمتكبرين يستحقون الرأفة والعطف أكثر من الإهانة والإساءة، فالإنسان يتألم لهم حين يفكر في أحوالهم التي سيكونون عليها في الآخرة، فهل يُسَبُّ شِمْرُ بن ذي الجوشن وأبو لؤلؤة المجوسيّ، وابن ملجم أم يؤسَف ويُشفَق عليهم؟! أعتقد أنكم إن تروا حرمانهم من الرحمة في الآخرة يتحرك ضميركم، وتتألم قلوبكم لحالهم.
بما أننا بشر فقد نغضب ونسخط إزاء بعض الأحداث الأليمة، بل قد تنبري في أنفسنا أحيانًا مشاعر الحقد والغضب تجاه فئة من الظالمين والمُعتدين، بيد أنه يجب علينا قمع هذه المشاعر السيئة وألا نسمح لها بالظهور.
يجب على الإنسان أن يوفي إرادته حقَّها، وألا يسمح لمشاعر العداوة بأن تحكمه، فإن بدت الكراهية والحقد مرة واستقرّت في صدره فقد يصعب جدًّا اقتلاعُها والتخلّص منها، ومنْ تتلوث خلاياه العصبية بمثل هذه المشاعر السلبية يفكّر باستمرار في الشر، حتى وإن كان يعتقد أنه يتصرّف بعقله، إلا أنه غالبًا ما يتحرّك بتأثير الأحاسيس التي تضخّها فيه تلك المشاعر السيئة، بيد أن الواجب الذي يقع على عاتق من نذروا أنفسهم للقرآن وعشقوه هو أن يتحرّكوا بالعقل والمنطق والمحاكمة العقلية، وأن يتجولوا في المناخات الفسيحة النقية للقلب والروح والضمير.
ولهذا السبب، يجب ألا نسمح للحوادث السلبية أن تحوِّلنا إلى رموز وأساطين للكراهية والبغض، لا ينبغي لنا أن نورث الكراهية والغضب للأجيال القادمة، لا يجب أن نخطئ فنبني هوية أساسها الكراهية.. على العكس، يجب أن نعتمد أساسًا على بناء هوية عِمادُها الحبُّ والاحترام.. قد يخطئ البعض ويضطهدوا ويغدروا، وهناك أمثلة لا حصر لها من هذه الشرور مطوية تكررت خلال مراحل التاريخ، بيد أنه لا ينبغي لنا أن نرتكب الأخطاء نفسها، وإن شوّهوا وأعتموا أيامهم وطالعهم، فلا ينبغي لنا نحن أن نعتم ونشوِّه أيامنا ومستقبلنا.
[1] متفق عليه.
[2] ابن هشام: السيرة النبوية، 2/412؛ البيهقي: السنن الكبرى، 9/199.