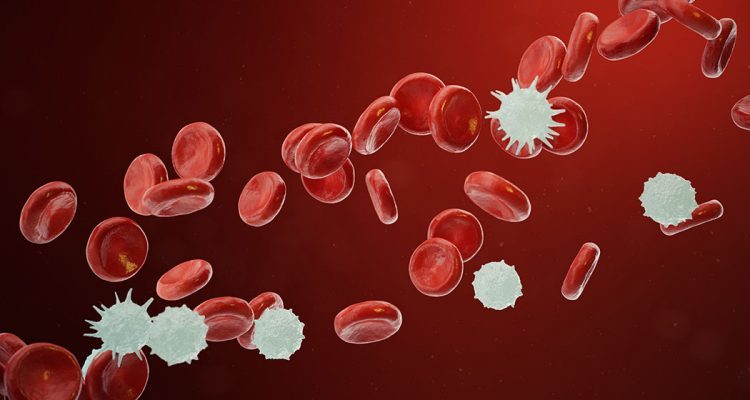سؤال: يقولون: “لا وجود من العدم ولا عدم من الوجود”، فهل هذا القول صحيح؟
الجواب: ينسب هذا القول إلى لافوازييه (Lavoisier)، وهو ادعاء محض، يقولون: المادة تتألف من الطاقة، وهي صورة متشكلة منها، فالمادة من الطاقة والطاقة من المادّة وهكذا دواليك، إذًا لا عدم من الوجود ولا وجود من العدم، فمثلًا الأحياء على الأرض إذا ماتوا تآكلوا وغدوا ترابًا، فما يزالون موجودين وإنْ بصورةِ تراب، والهيدروجين في الشمس يتحول إلى هليوم، وتنتشر أشعتها وإشعاعاتها وموجاتها في أرجاء العالم، بل تمتد إلى عدة منظومات أخرى فتستفيد منها، فكيفية الوجود هي التي تتغير، أما الوجود نفسه فباقٍ.
كلنا شاهد على إفناء ما هو موجود وإيجاد ما هو معدوم، فهو سبحانه يوجد النور في لحظة، ثم يُفنيه ويوجد الظلمة مكانه، ثم يفني الظلمة ويوجد النور مرة أخرى.
أولًا: عندما يقول لافوازييه: “لا وجود من العدم ولا عدم من الوجود” يمكن أنه يريد بذلك أن الموجود لا يفنى بنفسه، ولا يوجد المعدوم أيضًا بنفسه. فلا قدرة للمصادفات والأسباب على الإيجاد والإفناء بل إن البشر وهم الذين يتمتعون بأكبر قابلية في الوجود لا طاقة لهم بإفناء موجود أو إيجاد معدوم، وهم إنما يقدرون على تغيير مركبات الموجود فحسب، فالموجود يحافظ على وجوده ويظلّ المعدوم معدومًا إلى الأبد، أمَّا إذا أسندنا الأمر إلى الحق سبحانه فسينقلب الحكم رأسًا على عقب، فالله تعالى يُفني الموجود ويوجد المعدوم، فالمعاند القائل “لا وجود من العدم” وهو يرى في كلّ ربيع آلافًا من النباتات تُخلق من العدم، هو أولى بالعدم.
إن وراء المادة عالَمًا عظيمًا واسعًا مغايرًا للمادة، عالم يتجلى فيه المعنى الحقيقي والنور الإلهي والذات الأحدية، ولا علم لنا به؛ فيدُ العلم قاصرة لا تبلغه.
أجل، إن الله تبارك وتعالى يُفني الموجود ويُوجد المعدوم، والحقُّ أنَّه لا اعتراض للافوازييه على هذا.
ثانيًا: هل يحيط علمنا القاصر بمسألة الوجود والعدم ليصح مثل هذا الادعاء؟
منذ أبيقور وطاليس والناس يظنّون أن الذرّة هي أصغر أجزاء المادّة، أمَّا اليوم فاكتشفوا أنها تتشكل من أجزاء أصغر، من إلكترونات فيها شحنات كهربائية سالبة، وبروتونات فيها شحنات إيجابية، ونيترونات غير مشحونة، وكلها تدور حول نواة الذرة، ولم يكن لأحد علمٌ بهذه المسألة في الماضي، وأصبحت اليوم معلومةً لكل أحد، بل اكتشفوا الآن أن تلك الأجزاء تنشر موجات على الدوام.
فمعلوماتنا في تجدُّد مستمرّ، بل في كل لحظة تُخزَّن معلومات جديدة في ذاكرتنا المعلوماتية، وبينما تطرأ على نظرية الذرة تغيرات عدّة، نشأت نظرية وحدة الطاقة الضوئية (الفوتون)، فصبَّ العلماء جهودهم على الجُسَيمات.
كان النبي ﷺ يرى الجنة حقيقة، ويأخذ عناقيدها بيده، ويرى جهنم، ويُفزِعه ما فيها من أهوال وفظائع، فهو ﷺ كان يتصل بعالم المادة المضادّة وهو ما يزال في عالم المادة.
نظنُّ أننا نعلم الكثير، بيد أن ما نعرفه عن الوجود بالنسبة لما نجهله ليس سوى قطرة في بحر.
كنا نظنّ حتى الأمس القريب أنّ كلّ شيء يتشكل من الذرات، أمَّا اليوم فنظرية المادة المضادة تقول إن هناك “ذرة مضادة” تقابل الذرة، وبوسعنا أن نلحظ هذا عند قوله تعالى:﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ اْلأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾(سُورَةُ يس: 36/36).
أمعنوا النظر في الإيمان الذي لقّنه القرآن الكريم والحقائق العلمية التي أشار إليها: فمن كلّ شيء خلق سبحانه زوجين، من الذرّة حتى الكواكب السيَّارة، أمَّا الأحد بلا شريك فهو واحد، لا يتجزأ ولا ينقسم، ولا يَطْعم ولا يشرب، ولا يحده زمان ولا مكان، ولا يُدرَك بالكم والكيف، فوجوده ذاتيّ، سبحان ربّي الأجلّ الأعلى، فهو مبرأ ومنزه عن الحدوث وملابسة الحوادث.
إن مسألة المادة المضادّة والذرة المضادة والبروتون المضاد والنيترون المضاد التي اشتغل بها العلماء كثيرًا في عالم الفيزياء والفيزياء الفلكية من أندرسون إلى أسيموف على اعتبار أنها نظرية جديدة لَتثبت لنا قِصر حدود معارفنا وقلة استيعابنا المعرفي. فالإنسان المغرور بعلمه يدرك من هذه الاكتشافات الحديثة أن علمه نقطة في بحر، فالإنسان كلما قرأ ازداد علمه وجهله على حد سواء.
المكان ذو البعد الثلاثيّ المرئيّ له بُعْدٌ رابع هو الزمان”، ولا ريب أن هذا منوط بالإدراك والحدس.
وبعدما اكتشف أندرسون البوزترون، اكتشف شيئًا آخر يدور مكان الإلكترون. إن ما اكتشفه كان مشحونا بشحنة موجبة، ومن المعلوم أن الإلكترون لا بد أن يكون مشحونًا بشحنة سالبة، وهذا يثبت أن هناك مادة مضادة تقابل المادة. وما زال العلماء يشتغلون الآن ويبذلون قصارى جهدهم لحلّ هذا السر. وإن واصلنا التعداد امتدّ بنا الموضوع إلى: الجسيم المضاد والبروتون المضاد والنترون المضاد والإلكترون المضاد والجزئي المضاد… ولربما يقال مثل هذا للكائنات الحية -رغم أنه لم يُكتشف بعد- أعني النبات المضاد والإنسان المضاد والحيوان المضاد…
يقول أينشتاين وهو الذي ظهر صدق كثير من تنبؤاته: “المكان ذو البعد الثلاثيّ المرئيّ له بُعْدٌ رابع هو الزمان”، ولا ريب أن هذا منوط بالإدراك والحدس، فلو كنتم في هذا المكان مثلًا فنظرتكم إلى الأشياء ستختلف كليًّا، فهناك مكانٌ آخر غير ما نحن فيه، ولم يتشكل ذلكم المكان مطلقًا عن تحوّل مادة أخرى.
ما العلاقة بين المادة والمادة المضادة؟
يقال إنهما مخلوقتان تتمكن إحداهما من القضاء على الأخرى.
ويقول العلماء: ستقضي المادة على المادة المضادة في يوم ما؛ بيد أنه لا يوجد أي دليل يؤكد كلامهم.
كنا نظنّ حتى الأمس القريب أنّ كلّ شيء يتشكل من الذرات، أمَّا اليوم فنظرية المادة المضادة تقول إن هناك “ذرة مضادة” تقابل الذرة.
لو فرضنا صدق بعض دعواهم وقلنا: إن كثافة المادة على الأرض أكثر من المادة المضادّة، وكانتا متقابلتين عندما خُلق الكون، ثم أكل كلٌّ منهما الآخر وقضى عليه، وأخيرًا اقتضت أسباب شتّى بقاء بقيّة من المادة، فتفوقت على المادة المضادة، ومنها نشأ هذا العالم.
ما يقولونه تأباه العقول؛ فلو وقع مثل هذا لما كان يسوغ الكلام عن وجود مادّة مضادّة على الأرض، فمقتضَى ذاك الادعاء أن المادة المضادة قد قضي عليها منذ بدء الخلق.
وبمنظار آخر: دعوى وجود ما هو مضاد للمادّة والذرة تشير إلى عالم خفيّ عنّا، فنحن خُلقنا من مادة مرئية، ولربما خُلِق الجنّ من مادة شبيهة بالمادة المضادة؟ ولِمَ يأبى أناسٌ خلقَ الملائكة من نور؟ أوليس من الممكن أن الملائكة أوتيت قوَّةً تمكنّهم من القضاء علينا؟
نظنُّ أننا نعلم الكثير، بيد أن ما نعرفه عن الوجود بالنسبة لما نجهله ليس سوى قطرة في بحر.
وفي سيرة الأنبياء ما قد يشير لذلك، ففي القرآن أن الملائكة نزلت وتمثّلت بصورة أشياء ماديّة فأهلكت أقوامًا، فلو أمرها الله تعالى وأذن لها لدّمرت الكون بـسلسلة إجراءات؛ فللمادة نسيج معين وللمادة المضادة آخر كما الجن والملائكة، فمَثَل الدنيا والآخرة كمثل المادة والمادّة المضادة، والمكان والمكان المضادّ، والزمان والزمان المضادّ.
كان النبي ﷺ يرى الجنة حقيقة، ويأخذ عناقيدها بيده، ويرى جهنم، ويُفزِعه ما فيها من أهوال وفظائع، فهو ﷺ كان يتصل بعالم المادة المضادّة وهو ما يزال في عالم المادة.
إذًا إنَّ وجود العالم بمادَّته ومادّته المضادَّةِ ليس شيئًا يسيرًا، وعليه فلا محلّ لقول قائل “لا عدم من الوجود ولا وجود من العدم” بناءً على قولٍ مهجور قيل قبل قرن.
وأجدني مضطرًّا لأكرر أنّ ما نعرفه عن العالم نزرٌ يسير، فقديمًا قامت القيامة حول مادة الأثير، وحاول فريق إثبات وجودها بأدلة شتى، وأنكره آخرون مثل مايكلسون وفقًا لما دلَّت عليه نتائج أبحاثهم، فعارضهم لورينز هذه المرة قائلًا: “كلا، لا يمكنكم أن تقولوا هذا”، فكانوا جميعًا يقولون ما هَدَت إليه أبحاثهم. أليس غريبًا إذًا القطعُ بحكم في مسألة الوجود والعدم رغم كل ما لا نعلم ماهيته ومنه الإنسان؟
منذ أبيقور وطاليس والناس يظنّون أن الذرّة أصغر أجزاء المادّة، واليوم اكتشفوا أنها تتشكل من أجزاء أصغر، من إلكترونات فيها شحنات كهربائية سالبة، وبروتونات فيها شحنات إيجابية، ونيترونات غير مشحونة.
ويمكن أن تهلك يومًا ما واحدةٌ من المادة والمادة المضادة، فتتطور الأخرى، لربما ترون يومئذ كائنات تحسبونها بشرًا مثلكم، فإذا لمستموها إذا بأيديكم تنفذ من ناحية إلى أخرى، فسموّها إن شئتم جنًّا أو ملائكةً أو أجسامًا لطيفةً.
بعد كل ما ذكر يتضح أنّ وراء المادة عالمًا آخر، “والذين يبحثون عن كل شيء في المادة، عقولهم في عيونهم؛ والعين في المعنويات عمياء”[1].
إن وراء المادة عالَمًا عظيمًا واسعًا مغايرًا للمادة، عالم يتجلى فيه المعنى الحقيقي والنور الإلهي والذات الأحدية، ولا علم لنا به؛ فيدُ العلم قاصرة لا تبلغه.
ثالثًا: كلنا شاهد على إفناء ما هو موجود وإيجاد ما هو معدوم، فهو سبحانه يوجد النور في لحظة، ثم يُفنيه ويوجد الظلمة مكانه، ثم يفني الظلمة ويوجد النور مرة أخرى.
وما زالت هذه الأحداث تتكرر أمام أعيننا، وفي كل موسم يخلق من العدم نباتًا وحيوانات لم تكن شيئًا لنرى بأعيننا عمليات إيجاد المعدوم وإفناء الموجود، ويوم تفنى هذه المخلوقات كلها سنشهد كيف يفنى الوجود أيضًا، فينكشف سرُّ الآيةِ الكريمة: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ (سُورَةُ الرَّحْمَنِ: 55/26)، وسيفنى كل ما على الأرض بجوانبه المادية.
أجل، كل شيء فان، ولا باقي إلا الله تعالى؛ فهو القادر على إفناء الموجود وإيجاد المعدوم.
المعاند القائل “لا وجود من العدم” وهو يرى في كلّ ربيع آلافًا من النباتات تُخلق من العدم، هو أولى بالعدم.
والخلاصة أنّ الأفكار الغائمة هي ملاذ الماديين بنصب إلهٍ ماديّ أو قُل نصب المادة إلهًا، بدلًا من الخالق البارئ الذي يُفني الموجود ويوجد المعدوم، والذي يُشعرنا بوجوده عن طريق عجائب صنعه في الكون؛ ويدّعون أن المادة هي التي تدبّر أمر العالم، وما القوى الكيماوية والميكانيكية سوى خصائص لها.
والحق أن حقيقة المادة التي عدّوها كل شيء مجهولة؛ والغريب أن الماديين الملحدين لله لأنهم لا يعرفون كنهه -وهذا لأن الخلق عاجزون عن إدراكه- لا يرون بأسًا في عدّ المادة التي لا يدركون حقيقتها أصلَ كل شيء.
دعك من تناقضاتهم، وهلم إلى شيء من منهجهم الفكري:
المادة عندهم هي أُسّ الخلق والوجود، فهي تتحكم في كل شيء، بل إن القوة أسيرة بيدها؛ فبينما يحاولون تفسير حقيقة الوجود تجدهم يحيلون أمر العالم وانتظام الكون وتوازنه إلى ذرات عمياء لا علم لها ولا وعي ولا إدراك.
وعلى الإنسان أن يكون أعمى بلا وعي لينطلي عليه هذا الخزي من خرافات لا صلة لها بالعلم.
ذاك هو أبرز ما بيننا وبين الماديين من اختلاف، فالمادة عندهم أساس كل شيء، وحركتها وتشكلها ذاتيان، وكأنهم يعتمدون في هذا على المشاهدة والتجربة.
أما نحن -معتمدين أيضًا على المشاهدة والتجربة والعلوم الطبيعية- فنؤمن بأن المادة موجود أعمى بلا وعي ولا إدراك، تستمد حركتها وقوتها وتأثيرها في المركبات مِن مدبِّر عليم قدير وجودُه ذاتيّ وأمرُ كل شيء إلى علمه وقدرته تعالى.
نعم فالدوغمائية هي صبغة الماديين ومنهم المعاصرون، فالقضايا النظرية المحتملة يظهرونها علميةً قطعيةً، ليضلوا الناس؛ وهم أنفسهم من ثاروا على دوغمائية المسيحية لينكروا كل شيء، وإذا بهم يقعون أخيرًا في الدوامة نفسها والغيّ نفسه لكن من طريق آخر.
ومستندهم في معظم دعاواهم التي أعلنوها إمّا تأويلات خاطئة أو أقيسة فاسدة؛ ومنها دعواهم أنه لا عدم من الوجود ولا وجود من العدم، ولو جاء يوم أثبت فيه العلماء خطأ دعاواهم قطعًا فسيختلقون غيرها ليستندوا إليها في إلحادهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]المكتوبات لبديع الزمان سعيد النُورْسي: نوى الحقيقة 55.
المصدر: فتح الله كولن، الرد على أسئلة العصر، دار النيل للطباعة والنشر