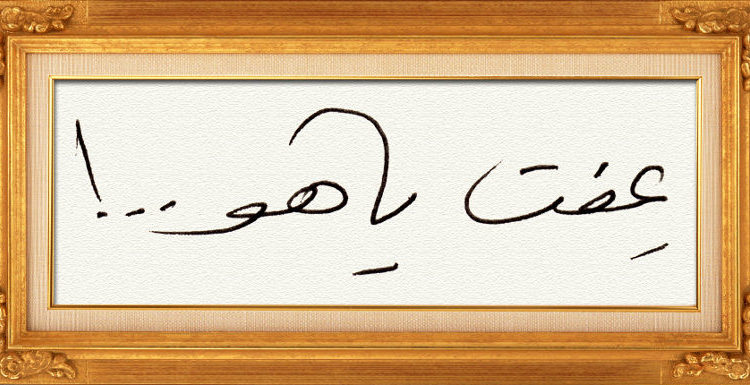سؤال: إلامَ يرشدنا موقف سيدنا يوسف عليه السلام تجاه الخطيئة في قوله: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/33)؟
الجواب: عند النظر في قصة سيدنا يوسف عليه السلام نرى أن حياته كانت محاطة بالصعوبات والامتحانات منذ البداية؛ فقد أُلقِي في بئر وهو لا يزال صبيًّا حديث السن، وبيع في الأسواق مثل العبيد، وعاش بعيدًا عن بيته ووطنه، وافتُري عليه، وقضى زمنًا طويلًا في السجن.. ذلك لأن “أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ”[1]، لذا لم يتسنَّ لأي نبي أن يُبعث دون أن يذوق في حياته ألوانًا من الابتلاءات، ولو أمكن هذا لتحقق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفخرة الإنسانية؛ إلا أنه في مكة قد أُوذي وضُرب وأهين بأبشع الصور، وقُوطع وعُزل عن المجتمع، فلما استحال عليه العيش في مكة ترك وطنه في وحشة وكرب، إلا أنه لم يسلم من أذاهم حيث ذهب أيضًا، فهناك عانى كل أنواع الإيذاء والقسوة والجفاء.
لقد أصبح السجن منحةً إلهية ليوسف عليه السلام؛ لأنه صِين هناك وأدى رسالةً ووظيفة مهمةً على حد سواء، وانفتح له الطريق المؤدي إلى المكانة الرفيعة.
إذا ما نظرتم إلى صفحات التاريخ، فسترون أنه إلى جانب الأنبياء، هناك الكثير من أولياء الله قضوا حياتهم في خضم آلاف الصعوبات وتعرضوا لشتى أنواع العذاب، وعلى حد قول ضياء باشا (ت: 1880م):
الجاهل يعيش في ترفٍ ونزهةٍ ورخاءٍ
والعارف يسبح في دوّامة المحن والبلاء
فبينما ينعم أهل الدنيا والهوى بترف العيش؛ يواصل العارفون حياتهم في عوز شديد، هذه سنة الكون، ولا نعرف حكمة الله في ذلك؛ فربما يريد أن يفيض بالنعم والمنن في الآخرة على عباده الأصفياء الذين يحبهم زخًّا زخًّا.
الإكرامات الإهية المترتبة على الامتحانات
طلب سيدنا يوسف عليه السلام إلى نيل ذُرًى أسمى من كل الذُرى رغبة منه في معرفة الله ومحبة الله، وقد أخضعه الله تعالى لامتحانات مختلفة ليُعلِمَه أن “الطريق إليه سبحانه يمر من هنا”.. إلا أنه عليه السلام لم يُبدِ أي استياء إزاء أيٍّ منها، وإذا ما واصَلْنا تناول المسألة وفقًا للبيان القرآني ترون أنه عليه السلام لم ينبس ببنت شفة لإخوته الذين ألقوه في البئر، ولا اشتكى حاله إذ مكث في السجن ظلمًا، على العكس من ذلك، إنه عندما وجد في السجن بعض القلوب متوجهة إليه دعاها فورًا إلى الحق تعالى، ومن ثم جعل من السجن مدرسة، ومن يدري أي نوع من الأسس وضعه هناك؟!، ثم أي نوع من الأنشطة قد بدأه هناك بحيث سيؤدي لاحقًا إلى إيمان الكثير من الناس؟!
الإيمان الذي لا يُدعم بالأعمال الصالحة ولا يتعمق بالتفكر والتدبر يصعب عليه للغاية حماية الإنسان من الخطايا.
وكما هو معلوم فإن أحد الامتحانات الصعبة التي تعرض لها سيدنا يوسف عليه السلام كانت تتعلق بعفته، وعلى النحو الذي ذكر في سورة يوسف فقد خرج سيدنا يوسف عليه السلام من البئر الذي أُلقي فيه على يد أفراد القافلة، وباعوه في سوق النخاسة في مصر، واشتراه عزيزُ مصر، واتخذه ولدًا له وآواه، ونشأ وتربى في القصر، ولما صار شابًّا وسيمًا يجذب الانتباه، عرضت عليه امرأةُ العزيز الفاحشةَ، فرفض هذا العرض القبيح بقوله ﴿مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/23)، ونجح بعفته في اجتياز هذا الامتحان.
وهناك قولان مختلفان بشأن لفظ “ربي” الوارد في الآية الكريمة؛ وفقًا للقول الأول المقصود بهذا اللفظ هو العزيز، وفي هذه الحالة يكون المعنى هكذا: “لقد احتضنني سيدي وآواني، فكيف لي أن أخونه متجاهلًا كل هذه النعم والفضائل؟!”، أما بالنسبة للقول الثاني فإن المقصود من لفظ “ربي” هو الحق تعالى، إذ يحتمل أنه كان يقصد النعم التي منَّ بها عليه مالكُ الملك والملكوت الحقيقي، أيًّا كان ما يفهمه مخاطبوه.
من لا يستطيعون أن يجعلوا الإيمان ملء ضمائرهم ووجدانهم، وجزءًا لا يتجزأ منها، وعمقًا من أعماق طبيعتهم يستحيل عليهم أن يُصبحوا رموزًا للعفة.
لقد أنقذه الله جل جلاله من مثل هذه الخطيئة منحة إلهية وكرامة ربانية عليه، فقد يمنح الله بعض الناس قدرًا كبيرًا من الإمكانات المادية، وقد يأخذ بيد البعض الآخر من الشارع ويضعهم في مناصب مهمة، ويهب بعضهم أولادًا صالحين، كل واحد من ذلك كرم إلهي عظيم، ولكن لا شيء أعظم من صيانةِ المرء عفّتَه وسمعتَه ومجدَه وشرفه، والتزامِ العفة مدى الحياة، وحفظِ العينين والأذنين عن التدنيس، والسيرِ إلى حضرة الله بحسن الخاتمة.. كلُّ ذلك يُعد واحدًا من أعظم أنواع الإحسان والنعم التي يهبها الله تعالى للإنسان.
وهكذا منَّ الله تعالى على سيدنا يوسف مثل هذه المنَّة، ولم يسمح لشيء أن يُخلَّ بعفته، واستطاع عليه السلام بكل نزاهته وعفته أن يتخلص من نداء الخطيئة هذا، ولما صار لاحقًا مطمح نظر النساء شعر بالقلق من أن الأمر سيصير أكثر تعقيدًا ففضّل دخول السجن حتى يتسنى له الابتعاد عن الفتنة والخطيئة بقوله: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/33)؛ وبالتالي فقد أوفى بحق إرادته مرة أخرى، وقاوم الخطيئة، واستطاع الصمود والبقاء رمزًا للعفة.
إذا أراد الإنسان أن يعيش بأمان في ظل اسم الله “المؤمن”، فعليه أن يحاول إدراك أفق الإحسان؛ وهذا يعني أنه يجب عليه ممارسة عباداته وعبوديته بإحسان وكأنه يرى الله.
لقد أصبح السجن منحةً إلهية ليوسف عليه السلام؛ لأنه صِين هناك وأدى رسالةً ووظيفة مهمةً على حد سواء، وانفتح له الطريق المؤدي إلى المكانة الرفيعة، ولأنه استغل هذه المنحة الإلهية استغلالًا جيدًا صارت المنح الواردة فيما بعد مظهرًا لدائرته الصالحة، فالمنح تولِّد المنح، لقد اتسعت دائرة المنح إلى أن جاء يومٌ صار فيه يوسف عليه السلام شعلة ضياء ومصدر نور لأهل مصر فأضاء عالمهم.. بل إن أطياف ذلك الضياء استمرت حتى عهد سيدنا موسى عليه السلام.
العلاقة بين العفة والإيمان
ليتنا نحن كذلك نستطيع امتلاك الشعور والفكر نفسه إزاء الخطايا، ليتنا نستطيع مجابهة الصعاب بدلًا من الغوص في الذنوب وعصيان الله تعالى، إن هذا مرهون بالإيمان القوي بالله تعالى، فهو ليس أفقًا يمكن إحرازه بإيمان تقليدي أو نظري، والإنسان يمكنه أن يقبل أسس الإيمان كلها بقوله (آمنت بالله…) متأثرًا بالبيئة الثقافية التي ينشأ فيها، لكن الإيمان الذي لا يُدعم بالأعمال الصالحة ولا يتعمق بالتفكر والتدبر يصعب عليه للغاية حماية الإنسان من الخطايا، ومن لا يستطيعون أن يجعلوا الإيمان ملء ضمائرهم ووجدانهم، وجزءًا لا يتجزأ منها، وعمقًا من أعماق طبيعتهم يستحيل عليهم أن يُصبحوا رموزًا للعفة.
على الإنسان ألا يقع رهينة للنفس وألا يدخل في مجال تأثيرها بأن يقيم جدرانًا وأسوارًا دائمة بينه وبين الخطايا، وهو ما يُطلق عليه في المصطلح الديني اسم “سد الذرائع”
إذا كان الإنسان يريد أن يعيش بأمان في ظل اسم الله “المؤمن”، فعليه أن يحاول إدراك أفق الإحسان؛ وهذا يعني أنه يجب عليه ممارسة عباداته وعبوديته بإحسان وكأنه يرى الله، وأن يؤديها مدركًا أنه جل وعلا يراه ويراقبه، ومن يتحرك بشعور المراقبة في جميع الأوقات، أي إن من يحوِّل إيمانه إلى مكتسبات في وجدانه بشعور الإحسان سوف تتاح له فرصة العيش الطاهر النظيف تمامًا دون أن تخالطه أو تلتصق به أدناس الخطيئة، ولا شك أن من أحرز قمم الإيمان والعبادة والإحسان إذا ما عُرض عليه عمل قبيح سيئ سيقول: ﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/33).
مخالفة النفس
وكما يلاحظ في الآية السالفة الذكر أن سيدنا يوسف عليه السلام لا يترك الحيطة والحذر بالرغم من أنه رمز للعفة والنقاء، إذ يقول ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾، كما يقول في بقية السورة ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة يُوسُفَ: 12/53)، فيؤكد أنه لا يمكن الوثوق بالنفس الأمارة، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا يقول داعيًا الحق تعالى “يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ“[2]؛ ذلك لأن المرء حين يختلي بنفسه ربما يأتي أفعالًا صبيانية، وربما يزل ويهوى، وقد ينخدع بحيل الشيطان وإغوائه، نسأل الله عز وجل أن يقينا مثل هذه المواقف والمحن.
من لا يستفيد من الملذات والمتع المشروعة، فلا يأكل ولا يشرب بقدر ما يحتاج إليه، ولا يتزوج في الوقت المحدد، يصعب عليه مقاومة حيل الشيطان والنفس.
وعليه فإن طريق التعبد السليم لله تعالى يمر من خلال معارضة أهواء النفس ونزواتها، وحتى تتسنى السلامة من ألاعيب النفس وحيلها وفخاخها يجب ابتغاء السبل الموافقة للإرادة الإلهية والاهتمام بالصدق والإخلاص، فإذا كنتم تضطلعون بأعمالكم كلها مراعاة لأوامر الله تعالى ونواهيه، فإنكم لا تسقطون في شراك النفس وشباكها، ويقول الإمام البوصيري في قصيدته “البُردة”:
وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِهِمَا وَاِنْ هُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ
أما في بيت آخر فيقول:
وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَـــــاعِ وَإِنْ تَفْـطِمْهُ يَنْفَطِــمِ
عندما وجد يوسف عليه السلام في السجن بعض القلوب متوجهة إليه دعاها فورًا إلى الحق تعالى، ومن ثم جعل من السجن مدرسة، و من يدري أي نوع من الأنشطة مارسه أدى لاحقًا إلى إيمان الكثير من الناس؟!
أجل، إذا ما فُطم الطفل من الرضاع، وتحقق العزم والإصرار على تنفيذ ذلك فإنه لا يطلبه مرة ثانية، لكن الطفل إن لم يُفطَم في الوقت المناسب تعذّر فطامه بعد ذلك، وعليه فالمؤمن يجب عليه أن يكون حازمًا منذ البداية تجاه رغبات النفس وأهوائها، وألا يتهاون إطلاقًا في هذا الأمر، لدرجة أنه يجب أن ينظم حياته كلها ويقيمها على أساس مخالفة الشيطان والنفس، ولا سيما أنه أصبح من الصعب في عالمنا اليوم البُعد عن الخطايا بعد أن صارت أكثر شيوعًا وانتشارًا، وعليه فثمة حاجة ماسة للحيطة والحذر الدائم، واجتناب مواضع الشبهات.
بناء الأسوار في مواجهة النفس
على الإنسان ألا يقع رهينة للنفس وألا يدخل في مجال تأثيرها بأن يقيم جدرانًا وأسوارًا دائمة بينه وبين الخطايا، وهو ما يُطلق عليه في المصطلح الديني اسم “سد الذرائع”، فقد وضع علماء الأصول مبدأً كهذا انطلاقًا من آيات كريمة مثل آية ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورة الأَنْعَامِ: 6/152)، وآية ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (سورة الإِسْرَاءِ: 17/32)، فعلى الإنسان أن يُغلق من البداية السبيل المؤدي إلى الخطايا والآثام المحتمل أن ترتكبها أعضاء مثل اليد والرجل والعين والأذن واللسان، وأن يكون يقظًا دائمًا أمام أسباب الخطايا وسبلها، وألا يتجول في الأماكن التي يحتمل أن يقع فيها في الخطيئة والزلل محترزًا “على أية حال”، حتى لا ينفرج الباب لأن تُذله نفسه لاحقًا، وكما أنه من المقدر أو المتوقع أن تزل قدم من يسير في الثلج، أو تغوص رجل من يسير في الوحل، أو يغرق من يغوص في الأعماق دون معرفة السباحة فيحتمل كذلك أن من يدنو من الخطايا والذنوب ويحوم حولها يقع فيها، ذلك أنه بعد الدخول في طريق الذنوب يكون الرجوع منه والتصدي لرغبات النفس وأهوائها أصعب.
إذا ما نظرتم إلى صفحات التاريخ، فسترون أنه إلى جانب الأنبياء، هناك الكثير من أولياء الله قضوا حياتهم في خضم آلاف الصعوبات وتعرضوا لشتى أنواع العذاب.
وقد شبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه الشريفة من يخرج بمفرده أو يخرجان بمفردهما في سفرٍ بالشيطان؛ وقال “الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ“[3]، وبهذا يعلمنا ضرورة بناء أسوار وحواجز أمام الخطايا والشرور، والحذر منها منذ البداية، فاحتمالُ ارتكاب الفرد الواحد للخطإ مرتفعٌ، وحتى وإن كان احتمال ارتكاب شخصين للخطإ أقل بكثير من ارتكاب شخص واحد له، إلا أنهما قد يتفقان على شر معين، أما ارتكاب ثلاثة أشخاص لهذا الفعل فهو أقل وفقًا لحسابات الاحتمالات؛ لأن كل واحد منهم يراقب الآخر، ويصبح حارسًا على عينه ولسانه ويده وقدمه؛ فإذا كان أحدهم سيزل أو يتردى أمسك به الآخرون فورًا.
لهذ السبب، يجب على من يحرص على حماية نفسه من الأهواء والنزوات ألا يترك نفسه للوحدة؛ فمن ترك نفسه للوحدة فقد أهملها ولم يهتم بها، وإذا اعتبرنا أنفسنا غالية فيجب أن نتّخذ لها بعض الحراس بينما نخرج في طريقنا؛ فلا نُمكِّن الشيطان من أن يسرق قيمنا الخاصة بنا، ولا ندعها ضحية للنفس، ولا نضيعها بسبب الأهواء والرغبات.
بينما ينعم أهل الدنيا بترف العيش؛ يواصل العارفون حياتهم في عوز شديد، هذه سنة الكون، ولا نعرف حكمة الله في ذلك؛ فربما يريد أن يفيض بالنعم والمنن في الآخرة على عباده الأصفياء.
نعم، إن العيش في جماعة -أي أن تكون في مجتمع متحد فكريًّا وشعوريًّا- سيقدم الجو المناسب كما تقدم الصوبة الزراعية ذلك لزروعها ونباتاتها، واللهُ يحمي الأفراد الموجودين في جماعة ويصونهم أكثر؛ فعناية الله بالجماعة مختلفة جدًّا، ومن يأخذ مكانه في جماعة لا يزل أو أنه نادرًا ما يزل، ذلك لأن أعضاء الجماعة يشبهون الحجارة المتراصة في القبة؛ فكما يمكن لهذه الحجارة التعاضد والوقوف معًا دون الوقوع والسقوط؛ فإن الأمر هكذا تمامًا بالنسبة للناس إذا شكلوا وحدة واحدة بتعاضدهم وتكاتفهم؛ إذ يحتمون بذلك من الانزلاق والسقوط، وخاصةً إذا عمقوا مجلسَهم بجلسات إيمانية، وأسد بعضهم الخير لبعض، وعززوا علاقاتهم وقووها، فإن الله يصونهم ويشملهم بحمايته، ويحفظهم من الانزلاق، لذلك من الضروري الانتساب إلى هيئة وطائفة صالحة.
الدائرة المشروعة تكفي لتحقيق المتعة
ثمة أمر آخر يجب مراعاته من أجل عيش حياة تتميّز بالعفة، ألا وهو عدم السير في الاتجاه المعاكس للفطرة؛ وعدم إغلاق الأبواب أمام المتع والأذواق التي تكون في إطار الدائرة المشروعة، إن إغلاق الأبواب منعًا لاستفادة الشيطان من نقاط ضعفنا، وتدعيمها بالمتاريس من الخلف أمر مهم للغاية، ومن لا يستفيد من الملذات والمتع التي في الدائرة المشروعة، أي الذي لا يأكل ولا يشرب بقدر ما يحتاج إليه، ولا يتزوج في الوقت المحدد أو لا يستفيد من النعم الأخرى، يمكن أن يصعب عليه مقاومة حيل الشيطان والنفس، فعلى حين هناك إمكانية لحماية أنفسنا من بعض السلبيات عبر طريق الاكتفاء بالمتع والملذات التي في الدائرة المشروعة؛ فليس من الصواب أن ندين أنفسنا ببعض الحرمان دون وجود سبب قاهر يدفعنا إلى ذلك.
لم يتسنَّ لأي نبي أن يُبعث دون أن يذوق في حياته ألوانًا من الابتلاءات.
وهنا يجدر بنا أن نُذكِّر بأن هناك حالات خاصة ببعض الأشخاص لا يمكن أن تكون مثالًا وقدوة بالنسبة لنا، فهناك شخص واحد فقط يمكننا أن نتخذه قدوة لنا؛ إنه مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم، علينا أن نسعى إلى اكتساب نظرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب والزواج والمنزل والمال والملك، واجبنا أن نتبع سبيل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أولًا، ثم الصحابة من بعده، ثم سبيل السلف الصالح من بعدهم، ثم سبيل العلماء والفقهاء، فالطريق طريقهم، والمنهج منهجهم، يجب علينا أن نُلجم رغبات النفس وأهواءها عبر اتباعنا هذا الطريق والمنهج، وأن نُلزم أنفسنا بما في الدائرة المشروعة من ملذات ومتع، ونغلق أمامها كل الطرق المؤدية إلى الحرام.
[1] مسند الإمام أحمد: 10/45.
[2] النسائي: السنن الكبرى، 6/147؛ البذار: المسند، 13/49.
[3] سنن أبي داود، الجهاد، 79؛ سنن الترمذي، الجهاد، 4.