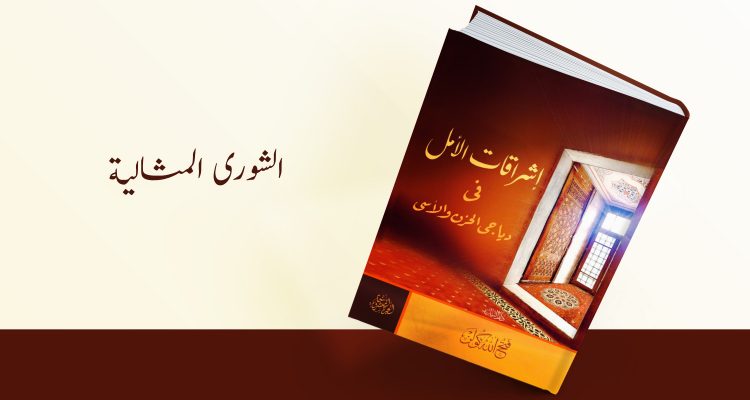سؤال: ما هي أصول وآداب الشورى في الإسلام ؟
الجواب: لقد بيّن القرآن الكريم بشكلٍ صريحٍ وواضحٍ لا يحتاج إلى تفسيرٍ أو تأويل أن الشورى وصف ملازم لجميع المسلمين، وأمرَ القلوب المؤمنة بتطبيق هذا المبدأ الذي لا غنًى عنه في كلّ نواحي الحياة. فمثلًا يقول تعالى في سورة الشورى:
﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (سُورَةُ الشُّورَى: 42/38).
واقترانُ الشورى بالصلاة والإنفاق في هذه الآية يدلّ على أهمّيّة الشورى في المجتمع المؤمن وأنها عملٌ يعادل العبادة، كما أن إطلاق اسم “الشورى” على هذه السورة لكونها تتضمّن نصًّا يتعلّق بها له مغزًى عميق.
وفي آية أخرى يأتي الأمر بالشورى صراحة، قال تعالى:
﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 3/159).
الشورى.. حتى في لحظات الغضب والانكسار
ولا يعزب عن علمكم أن هذه الآية الكريمة قد شرّفت بنزولها في أحلك اللحظات؛ إذ إن نزولها كان بعد تزعزُع مؤقّتٍ تعرّض له المسلمون خلال غزوة أُحُد وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استشار أصحابه فيما يتعلق بالخروج إلى الغزوة، ثم قرر الخروج نزولًا على رأي أصحابه، لكن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد وقعوا -عن غير قصدٍ- في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال المعركة؛ لعدم استيعابهم بعدُ الدقّةَ في امتثال الأمر النبويّ استيعابًا كاملًا، فتعرّضوا حينذاك لهزّةٍ مؤقّتةٍ -أقول هزّة حتى أتجنّب التعبير بكلمة الهزيمة-، وجُرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسال الدم المبارك من وجهه الشريف، واستُشهد الكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفي هذا الموقف المتأزِّم تنزل هذه الآية الكريمة التي يستهلّها ربُّنا تبارك وتعالى بملاطفة حبيبه صلى الله عليه وسلم فيقول:
﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: 3/159).
ويمكننا أن نوضّح المعنى المراد من هذه الآية الكريمة فنقول: أيّها الحبيب المتأدّب بأدب ربّه، لستَ -قطّ- فظًّا غليظًا حادَّ الطباع، إذ لو كُنتَ كذلك لَمَا التفّ هؤلاء الناس حولك وما خرجوا معك إلى ساحة المعركة، ولَانفَضُّوا مِن حولك، أيها الحبيب المتأدِّبُ بأدب ربِّه، إن كان قد وقع منهم خطأٌ في الاجتهاد ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ أي لا تتوانَ في أمر الشورى فشاوِر مَن حولك من الناس مرة أخرى.
أجل، لقد أحدَثَتْ هذه الهزّة النسبيّة اختلالًا واضطرابًا في كلّ شيءٍ، وانفطر القلب النبويّ فهو لا يخرج عن كونه بشرًا، وفي هذه الأثناء التي جُرحت فيها مشاعر الكثيرين من الصحابة رضي الله عنهم تنزل هذه الآيةُ اللطيفة التي تأمر بالتشاور بالأمر من جديدٍ، والحال أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجةٍ إلى التشاور، فقد كان صلوات ربّي وسلامه عليه -كما ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه- دائمَ الاتّصال بالسماء صباحَ مساء، وقد أطلعه ربُّه على ما سيقول وما سيُقدم عليه من خطوات وما سينجزه من أعمال، ولم تُعرقل دعوةَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عقبةٌ ما، فإذا ما واجهتهُ عقبةٌ؛ مهّد الله له السبل وأفسح له الطرق وقال له: “سِرْ، فالطريق طريقُك والزمان زمانُك”، لكن الرسول الهادي الأكمل -ليس في زمانه فقط بل في كلّ الأزمنة- كان يشاور أصحابه ليوجِّه أمته المكلّفة باتباعه قائلًا بلسان الحال: “كونوا كما تكونون؛ رؤساء، أو ولاة، أو إداريين، ولكن لا تختزلوا الأمر في وجهة نظركم، واستشيروا غيركم ولا تُخضعوا الأحكام التي تصدرونها لأهوائكم الشخصية”.
الشورى تضمن شراكة الجميع في الأمر
الشورى مسألةٌ مهمّةٌ جدًّا في الفعاليات والقرارات المتعلّقة بالجميع، حتى يصبح الأمرُ أمرَ الجميع، فإن أسهم الإنسان برأيه في أمرٍ ما، وإن كان رأيًا عاديًا اعتبر نفسَه جزءًا من هذا الأمر، وحمل على عاتقه إنجازه وإن كان ثقيلًا، لكن إن لم يؤخَذ رأيُه واقتراحاته ولم يساهم بعقله وفكره في الأمر؛ فإنه سينأى بنفسه عن التدخُّل فيه وسينفض يديه عنه، فالواجب إذًا العملُ على أن يستوعب الناسُ أن القيام بالأمور المهمة يشبه حَملَ كنزٍ كبير، والحرصُ على مشاركة الآخرين في الأمر حتى تتكاتف الأيادي وتتضافر الجهود ويخفّ هذا العبء الثقيل، ومن ثمّ فيمكننا القول إذا أُهملَ مبدأُ الشورى في الأسرة ساد التوتر والاضطراب في أرجاء هذه الأسرة، وإن أُهمل داخلَ هيئةٍ أو مجتمعٍ لحقهما الضرر الكبير، أما إن أهملت على مستوى الدولة أفضى ذلك إلى وقوع الكثير من التوتّر والاضطرابات والمشاكل على نفس المستوى.
أجل، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: “ما نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ”[1]. ويُفهم من إطلاق اللفظ هنا أنه لا بدّ من تطبيق هذا المبدأ في كلّ نواحي الحياة على أن تكون البداية من أصغر دائرة.
آداب المناقشة والمدارسة عند الشورى
وبعد أن تطرّقنا بإيجازٍ إلى ضرورة وأهمّية الشورى عمومًا؛ نعرّج الآن على شروط الشورى المثاليّة:
بدايةً أقول: إن اتّخذ الفرد قرارًا بينه وبين نفسه واعتبره من المسلّمات، ثم حاول نسج كلّ المسائل وفقًا لهذه المسلّمات فهذا يعني الجهلَ بروح الشورى، وحتى لا يتدخل الشخص بهواه في الأمر، ولا يحسبن هواه هو عين العقل والمنطق؛ ولذا ينبغي له أن يقيّم الآراء التي ترِدُ على خاطره -بشأن الأمور المناط التشاور حولها- بعقلٍ وحسٍّ وقلبٍ سليم، فضلًا عن حواسّه الباطنيّة، ويسجّل ملاحظاته حيال ذلك، ويحدّد إطار الموضوعات التي سيتمّ التشاور حولها، وبعد ذلك يطرح الموضوع على طاولة المشاورات، وليس من الصواب توقُّع حسن القبول دائمًا لأفكارنا المطروحة عند التشاور حتى وإن كنّا نعتقد أصالة وجودةَ هذه الأفكار والمقترحات، ومن ثمّ فإذا لم تلقَ مقترحاتُنا في مجلس الشورى حسنَ القبول؛ فعلينا أن نقول لأنفسنا: “معنى ذلك أنني لم أستوعب المسألة تمامًا أو أنني أخطأت في فهمها”، ولا نعاند أو نصرّ على آرائنا.
أما عن الأصول التي يجب اتّباعها في الشورى؛ فهي المناقشة والمدارسة، وهما لا يعنيان قطعًا الجدال والخلاف، وقد حُرّرت في آداب المناقشة والمناظرة عدةُ مؤلفات، ووُضِعت لها مبادئ وضوابط حتى تتمحور حول الكتاب والسنة، والمناظرة تعني في الحقيقة: مقابلةَ النظائر في مسألة ما، فمثلًا عند التشاور في مسألةٍ خاصّةٍ بالاقتصاد نجد أن كلّ الآراء تشبه بعضها بعضًا لأن الموضوع يدور حول الاقتصاد، والهدف الحقيقي هنا هو تبلوُر الحقيقة وظهورها؛ لأن “بوارق الحقيقة تتجلّى من تصادم الأفكار”[2] أما الخلاف والجدال فلا يولّدان ومضات الحقيقة، بل التفرقةَ والانقسام؛ لأن الأصل في المناظرة هو الإنصاف واحترام رأي الآخر، أما الجدال فالشأن فيه الإصرار على الرأي ومحاولة إيقاع الخصم في موقفٍ حرجٍ.
وفي الواقع لا يُمنى المغلوب بأيِّ خسارةٍ عند التشاور في أمرٍ ما؛ لأنه حينذاك يدرك خطأ رأيه، ويتعلّم شيئًا جديدًا لم يعرفه من قبل، أما الغالب فما فعله هو أن كرّر رأيه في المسألة فحسب، وربما يصيبه الكبر والغرور ويقول: “انظروا لقد كنتُ محقًّا في رأيي”.
* * *
الشورى ليست وسيلةً لإرغام الآخرين على تقبّل أفكارنا
وإنّ أهم مقياسٍ في تقويم المسائل بضوابط الإنصاف والضمير خلال الشورى ذلك المقياس الذي يذكره القرآن الكريم عند الحديث عن ميزان الأعمال، يقول تعالى:
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ $ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ: 99/7-8).
بمعنى إن رجحتْ كِفّة الشر ولو بمقدار ذرّةٍ على كِفّة الخير فيما طُرِح من آراء حول أيّ مسألةٍ فعلينا أن ننحّي هذه الآراء جانبًا، والعكس صحيح فإن رجحت كفّة الخير ولو مثقال ذرّةٍ أيضًا على كفّة الشرّ فعلينا الأخذ بالرأي المطروح والتمسّك به، كما هو الشأن في ميزان الأعمال فما دام الحقّ سبحانه وتعالى جعل رجحان الخير على الشر ميزانًا لعباده وحكم بذلك فعلينا نحن أيضًا أن نجعل هذا الأمر دستورًا لنا عند تشاورنا، وعلى ذلك فإن رجحتْ كفّة الخير لرأيٍ من الآراء المطروحة ولو مثقالَ ذرّة فلا عبرة حينذاك للأقدميّة واللقب والمنصب والشهرة والنفوذ؛ فإنّ اتّخاذ مثل هذه الصفات معيارًا رغم سطوع الحقيقة ووضوحِها واستغلالَ عناصر القمع والإجبار؛ يعني تدميرَ روح الشورى.
أجل، لا بدّ أن تخلو الشورى من عنصر القمع وفرض الأفكار، فأفضل الناس هو ذلك الشخص الذي يجلس في مجلس الشورى مع ذوي الأراء الأخرى وكلُّه آذانٌ صاغيةٌ فإذا انتهى أحدهم من عرض فكرته يقول له: “أنت محقٌّ في هذا الأمر، وأنا أؤيّد كلّ ما ذكرتَه، ولكن بجانب هذا فقد لاحتْ فكرة بخاطري، فما تقولون بشأنها؟”، وهذا هو الإنسان الشريف الذي يحافظ على شرف المشورة، أما مَن لم يعبأ بمسألة الإنصات إلى الطرف الآخر ويعتقد صحَّةَ رأيه دائمًا فهو إنسان مسكينٌ غلبته نفسه فاتخذها إلهًا، ومثل هذا المسكين الذي أسْلسَ قيادَه إلى نفسه وخضع لها، إن تحدّث فإنما يتحدّث لحساب نفسه في الحقيقة وإن ظنّ أنه يتكلّم باسم الدين والخدمة، ولا شك أنّ ما يطرحه من أفكارٍ سيُقابل على الدوام بردّ فعلٍ سلبيّ.
من أجل ذلك يجب على الإنسان أثناء التشاور أن يتجنّب الفظاظة والغلظة في أقواله وأفعاله وتصرُّفاته، وأن يهذّب أفكاره حتى يضمن حسن القبول لها، فإن لم يتخلّ الإنسان عن حدّته وغلظته ولم يعرض أفكاره بأسلوبٍ لطيفٍ ليّنٍ استاء الآخرون وامتعضوا.
الأولوية للحقّ لا للأقدميّة والمنصب
ثمّةَ أناسٌ ضعافُ النفوسِ يحاولون خلال الاستشارة استغلالَ أقدميّتهم ونفوذهم، وإرغامَ الآخرين على تقبّل أفكارهم، ومثل هؤلاء الناس يستغلّون صراحةً -وإن كان بلا قصدٍ- خدماتهم التي يبذلونها من أجل الدين؛ في سبيل تكريس أقدميّتهم وتعزيز مناصبهم، والحال أنه لا يحقّ لأحدٍ أن يحجب اليمنَ والبركةَ التي تفيض بها الشورى بمثل تلك التصرفات الأنانيّة النفعيّة.
وفي هذا الصددِ نورِدُ الواقعة التالية: اجتمع الإمام الحسن البصري مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم في مجلسٍ واحد، كان الذين يغشون هذا المجلس يوجّهون الأسئلة للصحابة رضي الله عنهم ويراجعونهم، والحقّ أن هذا هو الذي يجب أن يكون؛ لأن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد شهدوا مجلسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطبغوا بجوِّ هذا المجلس المبارك. وأعتقد أن شهود مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمرّةٍ واحدةٍ هو وسيلةٌ لتنزُّل الفيوضات والبركات بما يُعادل قراءة القرآن الكريم كاملًا عشر مرّات؛ لأن الحقّ تعالى كان يتجلّى في كلّ أفعاله صلى الله عليه وسلم وتصرّفاته، وكلّما نظر أو استمع أو تكلّم أو حرّك لسانه وشفتيه تبدّت حقائق إيمانه بالله تعالى، ويعبّر الشاعر الصوفي عن هذا الحال بقوله: كُلَّمَا سَجَدَ تَجَلَّى اللهُ.
بمعنى أن من ينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينمحي أمام ربّه تعالى في سجوده يشعر بوجود الله تعالى بل وكأنه أمامه جلّ جلاله ، ولا يعني ذلك أبدًا -معاذ الله- أن الذات الإلهيّة قد حلّت في الذات النبويّة، بل إنّ هذا تأكيدٌ على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعبّر عن ربّه في كلّ أفعاله وتصرّفاته، ولا جرم أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين يغشون مجلسه صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون جوًّا متميزًا، فإذا تصوّرنا أن هؤلاء الصحابة كانوا يرتبطون به صلى الله عليه وسلم قلبيًّا وظلوا طوال عمرهم حريصين على شهود مجلسه صلوات ربي وسلامه عليه عدّة مرّاتٍ في اليوم؛ لأدركنا قيمة الإنصات لكلام هؤلاء الصحابة والتشاور معهم، فضلًا عن ذلك كانت الحياةُ بكلِّ مجالاتها الاقتصاديّة والإداريّة والاجتماعية تتمحور حول الدين، وترتبط بنصوصه، ولذا كان الناس يلجؤون إلى قواعد الدين الراسخة الثابتة في مسألة حلّ المشكلات الحياتية، وهذا هو السبب في أن الناس في زمان الإمام الحسن البصريّ كانوا يتردّدون على سادتنا الصحابة الذين نهلوا من منبع الدين وما زالوا على قيد الحياة للاستفادة منهم وتبادُلِ الرأي معهم.
وفي مجلسٍ كان يجمع بين أحد الصحابة رضي الله عنهم والإمام الحسن البصري طُرح سؤالٌ على هذا الصحابي، فأجابَ، فلما انتهى من الجواب جاء دور الحسن البصريّ في الكلام، وكان يجلس في الخلف، فلما شرع هذا الشاب -الذي يتراوح عمره ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين عامًا- في الكلام أخذتْ الصحابيَّ الدهشةُ والحيرة، فقال ذلك الصحابي المنصِف الذي يدور مع الحقّ أينما دار بما تعلّمه من أخلاقٍ على يدِ سيدِنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كيف تسألوننا وهذا الرجل بينكم؟”.
نعم، كما شاهدنا في هذا المثال لم يستخدم الصحابي الكريم تبعيتَه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمكانةَ والمنزلةَ التي تبوّأها بصحبته لرسول الله عليه أكمل التحايا عنصرًا للضغط والإجبار، ولكنه وجّه الأنظار إلى ذلك الشاب لمِا رأى لديه من حصافة رأيٍ وتأثيرٍ قويٍّ في الكلام، فضلًا عن أنه كان يعتقد أن كلام هذا الشابّ هو أكثر نفعًا، وفي رأيي أن هذا هو الأسلوب الذي لا بدّ من مراعاته في استيعاب روح الشورى.
ومع الأسف تلاشتْ مسألة إحقاق الحقّ بهذا المستوى في أيّامنا، فمَن يتمتّع بقدرٍ من المكانة والمنزلة يريد أن يُسمَع له دائمًا وأن تنخرس ألسنةُ الآخرين عند حديثه، فضلًا عن ذلك نجد أن بعض الأفراد الذين يشكّلون مجلس الشورى بدلًا من الاستماع إلى كلام الآخرين يمهّدون الردود للاعتراض على كلامه، وأحيانًا يعاندون بلا داعٍ، ويشعرون بضرورة أن يقولوا شيئًا للردّ على ما يقوله الطرف الآخر، وليس هذا فحسب بل ينسجون أحيانًا أفكارًا شيطانيّة لإفحام الطرف المقابل، ومن ثمّ لا يمكن في مثل هذا الجوّ الاستفادة ممّا يطرحونه من أفكارٍ في مجلس الشورى وإن كانت عين الحقيقة.
بيد أن “شأن الحقّ عالٍ وسامٍ لا يُضحّى به بأيّ شيءٍ كان”[3]، ومن ثمّ لا بدّ من توجيه جميع الأقوال والأفعال إلى طريق الحقّ، وهذا ما أكّد عليه بديع الزمان سعيد النورسي، فقد أوصى هذا الجبلُ الأشمُّ طلّابَه ألا يأخذوا الكلام الصادر عنه على عواهنه لمجرّد أنه تفوّه به، فهو نفسه قد يُخطئ وينسى، فيا ليت الجميعَ يتحلّى بهذه السعة من الأفق! ولا يغيبنّ عن أذهاننا ألبتةَ أن “كُلّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ”[4]؛ ولسنا نحن مؤيدين بالوحي كما كان الأنبياء مؤيدين به.
يكفي أن تُعبّر الحقيقة عن نفسها
من جانبٍ آخر ينبغي لنا ألا ننزعج أو نتضايق إن ظهرتْ الحقيقة على يد الغير أو بفضلِ كلامهم، فإن كان هناك فكرة مقبولة معقولة وغيرُك يستطيع أن يطرحها فليس من السلوك الإيمانيّ أن تقول في نفسك: “لِم لا أتكلم أنا وأحظى بتقديرِ وإعجاب الجميع بما أقدّمه من أفكارٍ جميلةٍ؟” ولكن إن دعتْ الضرورة إلى الحديث عن موضوعٍ ما ولم يتكلّم أحدٌ وكان عدم الكلام سيتسبّب في ضياع الحقّ أو أن يعيش البعض شيئًا من الحرمان فيجبُ علينا حينذاك أن نقوم نحن بمهمّة الحديث في هذا الموضوع إحقاقًا للحقّ وإعلاءً لشأنِه، وعلينا في مثل هذا الموقف أن نراعي جيّدًا الجوّ العام ومدى تقبّله لمِا يُقال؛ حتى لا يتسبّبَ هذا الأمرُ في ردِّ فعلٍ سلبيّ، والأولى هو الصمت عند استشعار عدم الاحترام للكلام، بل إنّ هذا ما يقتضيه احترامُ الإنسان للفكرة التي سيقدّمها؛ لأن المخاطبين إن أبدوا ردَّ فعلٍ على ما يُقال منذ البداية فمِن الصعب للغاية تقبّلهم للكلام فيما بعد وإن كان حقًّا، بل إن هؤلاء المخاطبين قد يُحاولون بشتّى الطرق فيما بعد أن يختلقوا مسوّغات مختلفة فيما بينهم لعدم تطبيق هذه الفكرة، إذًا علينا أن نؤثر الصمت على الكلام إلى أن نستشعر باحترام الجوّ العام للحقيقة، فحينذاك لا بد من الحديث حتى يستفيد الجميعُ من الفكرة المطروحة.
وعلى مَن يشاركون في عملية التشاور أن تكون غايتهم إحقاق الحقّ، لا سيّما إن كانوا من ذوي الكلمة المسموعة فعليهم أن يتصرّفوا بدقّةٍ بالغةٍ في هذا الأمر؛ لأن من المعروف أنّ هؤلاء إن تحدّثوا في أيّ أمرٍ لاقوا احترامًا بالغًا من مخاطبيهم، ولكن قد يتخلّل كلامَهم بعضُ الأخطاء أيضًا، من أجل ذلك يجب عليهم إحقاقًا للحقّ ألا يخجلوا من الرجوع عن أخطائهم إن أدركوا خطأ كلامهم، ويتقبّلوا هذا الأمر برحابة صدرٍ.
فضلًا عن ذلك فإن تكلّم مَن لا حقَّ له في الكلام مع وجود مَن هو أولى به فقد يتسبّب هذا في إغفال المفيد من الكلام، وإثارة بعض الشائعات التي لا محلّ لها.
فر من الغيبة فرارك من الأسد
ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الشورى هو الحذر من الوقوع في الغيبة أثناء الاستشارة، وإلّا خسرنا في موضعٍ هو أدعى للكسب، ودنسنا ألسنتنا وآثرناها على قلوبنا، وأطفأنا نور حياتنا الروحيّة والمعنويّة في الوقت الذي كنا نظنّ فيه أننا نخدم في سبيل الحقّ، من أجل ذلك لا بدّ من مراعاة الدقّة البالغة لعدم الوقوع في الغيبة، فإن وقعنا فيها دون قصدٍ فلا بدّ من طلب السماح ممن اغتبناه، بل لا بد من تحديد إطار الموضوعات التي سنتحاور حولها حتى لا يُساق الناس إلى جهةٍ خاطئة، ولا ينفرج البابُ لسوء الظن، وتجنبًا لمثل هذه الأمور يجب على مَن يتكلّمون وإن كان كلامُهم هو محضَ الحقيقة أن يصمتوا عندما يتطلّب الأمر ذلك، عليهم أن يصمتوا أوّلًا، وإن تكلّموا فلا بدّ أن يسبق كلامَهم تفكيرٌ أعمق ويقولوا في أنفسهم: “كيف يمكننا أن نذكر هذه الحقيقة دون أن نجرح مشاعرَ أحد؟”.
أجل، ينبغي أن يكون سكوتُ المؤمن تفكُّرًا، وكلامُه حِكمةً؛ بمعنى أنّ الإنسان إن وجد الحكمة في كلامه تكلّمَ وإلا سكَتَ، كما يقول الشاعر: “إن كنتَ محدِّثًا فحدّثنا عن الحبيب وإلا فاسكت”، فإن بدتْ أماراتٌ للحديث عن أمورٍ لا توصّل الناسَ إلى الله ولا تفسحُ المجال للوصول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نسكتَ ونعضّ على هذا اللسان الشقي الذي أعطيناه من الأهمّية ما يزيد عن القلب فإن لم يستطع الإنسانُ أن يعضّ على لسانه مع أنّ الحال يقتضي ذلك فلن يسلم الآخرون من عضّه لهم.
ويجب علينا ألا ننسى أبدًا أن الجروح التي تسببها الحِراب من الممكن مداواتها أما الصدور التي جرحتها الكلماتُ فمِن الصعب مداواتها وتعميرها.
[1] الطبراني: المعجم الصغير، 2/175.
[2] “ضياء باشا (Ziya Paşa)” (1825- 1880م): شاعر تركي، كان من دعاة التجديد، له ديوانان “ظفرنامه” و”خرابات” في ثلاث مجلدات.
[3] بديع الزمان سعيد النورسي: السيرة الذاتية، ص 117.
[4] سنن الترمذي، صفة القيامة، 49؛ مسند الإمام أحمد، 20/344.