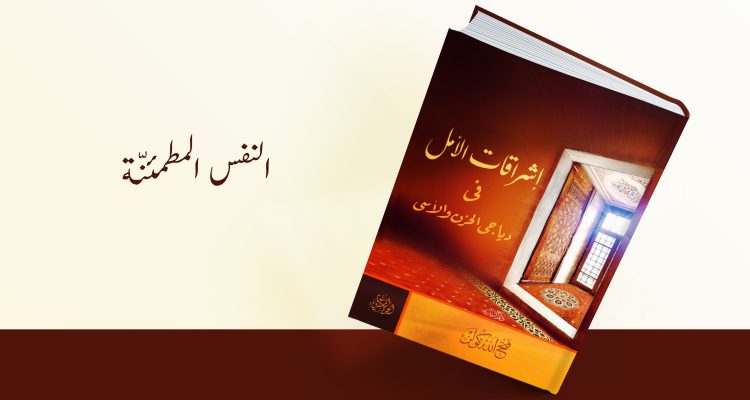سؤال: إن من جملة الصِّيَغِ التي أوصانا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ندعو بها قوله: “اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ”[1]، فما الذي يمكن أن نفهمَه من لفظة “النفس المطمئنة” الواردة في هذا الدعاء الشريف؟
الجواب: إنّ الحديث حول النفس المطمئنّة يتطلّب استطرادًا بعض الشيء، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: “أَعْدَى عَدُوٍّ لَكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ”[2].
وهنا يشيرُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النفس هي ألدّ أعداء الإنسان؛ وعليه أن يتعهّدها بالمجاهدة والتزكية على محور الدقة والحذر، وكما هو معلوم لـمّا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جهاده مع المشركين قال: “قَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ”، قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الأَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: “مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ”[3]؛ لأنّ مجاهدةَ الإنسان لعدوٍّ خفيٍّ بين جنباته يتحيّن الفرصة للهجوم عليه لهو أصعبُ كثيرًا من جهاد العدوّ الذي يراه عيانًا بيانًا أمام عينيه، ومهما بلغت الصعوبات المادّيّة التي تتخلّل جهاد الأعداء من تضاربٍ واقتتالٍ فثمّة احتماليّةٌ للظفر بالغنائم أو ما شابهها من مكتسَبات آجلةٍ بوقوع النصر، غير أنّ ما يجنيه الإنسان من مجاهدته لنفسه وغلبته عليها وقهرها لا يدركه غالبًا في الوقت الحاضر، وإنما يفوز به في الآخرة، والحال أن الإنسان بطبيعته يطمع في الثواب الآنـيّ العاجل كما قال ربّنا سبحانه وتعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ $ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ (سُورَةُ القِيامَةِ: 75/20-21).
أجل، إن الإنسان بطبيعته يريد أن يحصل على نتيجة سعيه وجهده على الفور، وأن ينال أجر عمله على وجه السرعة، وعلى ذلك فالجهاد من أجل إعلاء كلمة الله وإن كان كبيرًا بحدّ ذاته إلا أنه يظلّ صغيرًا مقارنة بالجهاد الأكبر، وإنّ المجاهدةَ التي نتحدّثُ عنها تكون لأُولى مراتب النفس وهي “النفس الأمارة بالسوء”: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سُورَةُ يُوسُفَ: 12/53).
النفس اللَّوَّامة
كما هو معلومٌ فإن النفسَ التي هي ألدّ أعداء الإنسان وإن كان من شأنها أن تأمر بالسوء إلا أنّها مهيّأةٌ أيضًا للتبدّل والترقّي، ولو أنّنا أحسنّا تربيتها وتزكيتها لتحوّلت إلى مطيّةٍ تقرّب الإنسانَ من الله وتجرّه نحو الفلاح، ومثالُ تبدُّلِ ورقيِّ النفس قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ (سُورَةُ القِيامَةِ: 75/2).
فالنفس هنا هي تلك التي خطت الخطوة الأولى وحقّقت الانطلاقة الأولى في مثل هذا التبدّل والترقّي، وهي التي تلوم صاحبَها على ما أصابه من خطإٍ أو ارتكبه من معاصٍ، فتحاسبه وتجعله يبحث عن سبلٍ للخلاص ممّا ترّدى به من دركات اللوثيات، أو عن أسبابٍ أخرى للكفاح حتى لا يتكرّر سقوطه في نفس الأخطاء والمعاصي مرّة أخرى، وتسوقه إلى التوبة والاستغفار، وإنّ تخلُّصَ الإنسانِ من أسارة نفسه الأمارة، وانتقالَه إلى مرتبة النفس اللوامة له أهميةٌ بالغة في تزكية النفس وترقّيها؛ لأن هذه الخطوة هي نقطة انطلاقٍ أُولى على سلّم مراتب النفس الأخرى، فلا يتحقق ارتقاء الإنسان تدريجيًّا إلى النفس المُلْهَمة، ومنها إلى النفس المطمئنة، وإلى النفس الراضية، فالنفس المرضية، وصولًا إلى النفس الصافية أو الزكيّة إلا بالانتقال أوّلًا من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، وكما أن الزاوية الصغيرة في مركز الدائرة تشكّل زاوية كبيرة في محيطها فكذلك هذه الانطلاقة وإن كانت صغيرة في المركز إلا أنّ لها أهميةً كبيرة بالنسبة للنفس، كما أنها صعبةٌ بقدر أهميتها؛ لأنه لا بد من تغيّرٍ معين حتى تتحقّق مثل هذه الانطلاقة؛ وبتعبيرٍ آخر لا بدَّ من محوِ القديم ووداع الماضي والإعراض عن الإلف والعادة، وسلوك طُرُقٍ جديدة.
وهكذا فإن النفس التي تلوم صاحبها على ما اقترفه من أخطاء وما ارتكبه من معاصٍ، وتتوجّه دائمًا إلى الله بقولها ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 7/23)، وتكشف عن إرادتها وعزمها على عدم التردي في هذه الذنوب مرةً أخرى؛ إن استمرت على مكافحتها ومجاهدتها فإنها ترتقي إلى مرتبة النفس المُلْهَمة التي تخفق وتحلّق في سماء أفق القلب والروح.
النفس المُلْهَمة
والنفس الملهمة هي التي قطعت كلّ السبل أمام أنواع الشرور متوجّهةً إلى ربها عزّ وجلّ في حركاتها وسكناتها، وتتجلّى فيها المواهب الإلهيّة بقدر ما فيها من الصفاء والنقاء والطهارة، وإن الله ليُلهِمُها الحسنى والطيّبات وما يُفضي إلى رضوانه جلّ جلاله، وهو القائل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سُورَةُ العَنْكَبوتِ: 29/69)، ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا $ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (سُورَةُ الشَّمْسِ: 91/7-8).
النفس المطمئنّة
والنفس المطمئنّة هي التي بلغت أوجَ الكمالات في أفق الإيمان والعرفان، وأغلقت الأبواب وأوصدَتْها دون كلِّ الأشياء ما عدا رضا الله تعالى ومرضاته، فلم يكن لها أيّ تشوُّفٍ آخر، يقول جل وعلا: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ $ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي $ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ (سُورَةُ الفَجْرِ: 89/27-30).
مثل هذه النفس تعيش دائمًا في توجّهٍ إلى الله، وتستغلّ كلَّ دقيقةٍ أو ثانيةٍ من عمرها في سبيل الفوز برضا الله، وترضى دائمًا بقضاء الله تعالى وقدره؛ إذ إنّ إحساس الإنسان بالرضا في نفسه عن الإجراءات الإلهية لهو مؤشِّرٌ على رضا الله تعالى عنه أيضًا؛ وعلى ذلك يرى بعضُ المحقّقين أن النفس الراضية والنفس المرضية بمثابة جناحين مفتوحين للنفس المطمئنة، فمثل هذا الشخص الذي يرضى عن الله ويرضى الله عنه لا يُفرّقُ بين الجفاء إن كان من جلاله والوفاء إن كان من جماله، فكلاهما صفاء بالنسبة له، فضلًا عن ذلك فإن هذا الإنسان على اعتبار أنه من أبطال “هل من مزيد؟” يحاول ويسعى إلى أن يزيد معرفته دائمًا وأن يكون قريبًا من ربه بناءً على قربه سبحانه وتعالى منه، وذلك بتخطّي المسافات التي تبعده عنه.
النفس الراضية
نلاحظ أنّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب في دعائه المذكور آنفًا نَفْسًا مطمئنّةً أوّلًا، ثم طلب لها أوصافًا يمكننا أن نسمِّيَها أعماقَ تلك النفس أو أجنحَتَها التي تُحلِّقُ بها في الآفاق الربانية.
وبعدَ أن طلب النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ربه “نفسًا مطمئنّةً” أعقبَ ذلك مباشرةً بِطَلَبِ أن تكون هذه النفسُ “مؤمنةً بلقاء الله المحتوم عاجلًا أم آجلًا” بقوله: “تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ”؛ لأن إيمانَها بأن الطريق الذي تسيرُ فيه سيُوصلُها إلى الذات الأبدية لا محالة، وتحرُّقَها رغبةً في لقاء الله وشوقًا إليه، وانشغالَها بذلك سيُلقي في أعماق الإنسان طمأنينةً راسخة لا تتزعزع.
ويرغبُ النبيُّ الأكرم صلى الله عليه وسلم بقوله: “وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ” أن تملكَ النفسُ المطمئنّة صفةَ الرضا بقضاء الله تعالى، ومع أنَّ بعض العلماء عَرّفَ القضاءَ بأنه: تحديد الحقّ تعالى الأشياءَ وفقًا لـ”التعيُّنات”؛ فإن معظمَ علماء أصول الدين يرون أنّ القضاء هو: إنفاذُ ما قُدِّر وكُتب في لوح المحو والإثبات إذا ما حان وقته.
والحوادث التي يتعرّض لها الإنسان طوال حياته قد تكون حسنة، وقد تكون سيّئةً بالنظر إلى ظاهرها، إلّا أنّ الإنسان يستطيع بِنِيّتِه أن يُحوِّلَ كلَّ ما قَدَّره الله تعالى له إلى خير كامل؛ فإن استقبلَ -مثلًا- المحنَ والمصائبَ بالصبرِ والرضى، وقرن كلّ نعمةٍ ونجاحٍ بالحمدِ والشكرِ فقد نجح في توجيه هذا كله إلى ما يعود بالنفع عليه، لكن إن كان يتشكَّى ويسبّ القدرَ وعابه كلما أصابه “جفاءٌ من جلاله تعالى”، وأنكر الجميل وجحد كلما أصابه “وفاءٌ من جماله تعالى”، وإن زعمَ أنه أُوتي ما أُوتِيَ على علمٍ عنده؛ صار هذا شرًّا وضرًّا بالنسبة له، أي إن كونَ النعمة أو النقمة خيرًا أو شرًّا بالنسبة للإنسان أمرٌ مرتبط ومرهونٌ بموقفه تجاهها، والحاصل أنَّ رضا الإنسان عن كلِّ ما قدَّره الله جلّ جلاله وقَضَاه بحقّه أمرٌ في غاية الأهمّيّة.
النفس المرضيّة
وأخيرًا يطلب سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى بقوله: “وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ” القناعةَ والقبولَ بكلّ شيءٍ قدّرَه له، ومَنَّ بِهِ عليه، وثمّةَ موضعٌ يجدرُ بالإنسان ألا يقنع عنده، بل عليه أن يحرص عليه ويستزيد منه، ألا وهو الإيمانُ بالله تعالى وطلبُ رضاه سبحانه؛ ويلزمه أن يتصرّف بشغفٍ وهوسٍ وحرصٍ شديدٍ طلبًا لرضا الله تعالى، وألا يقنع أو يتوقّف عن طلب المزيد من ذلك، وبتعبير آخر؛ فإنْ كان ثمّة موضعٌ الطمعُ فيه والحرصُ محضُ عبادةٍ فهو محبةُ الله ورسوله. أجل، ينبغي للإنسان ألّا يكتفي أبدًا بما يتحصّل عليه وهو يسير في درب الرضا الإلهيّ، وعليه دومًا أن يستزيد من طلب رضاه تعالى قائلًا: “هل من مزيد، هل من مزيد؟” إلّا أن الأساس فيما يتعلّق بالأمور الخاصّة بالدنيا والبدن والجسمانية هو القناعة بِقضاء الحقّ تعالى وقَدَرِهِ، وهذه صفةٌ أُخرى من صفات الإنسان الكامل الذي أبحرَ نحوَ عالمِ “النفس المطمئنّة”.
يطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق تعالى هذه الأمور المهمة كلَّها في دعائه هذا صباح مساء، ولا ريب أنه يطلب هذا كلَّه ارتباطًا بأفقه الفسيح وطلباته الخاصة السامية النبيلة، فإنْ قيّمنا طلباته هذه من زاوية ضحالتنا وأهدافنا البسيطة؛ فقد ارتكبنا حماقةً وأسأنا الأدب معه صلى الله عليه وسلم وصِرنَا وكأننا نحاول إنزاله إلى مستوانا الوضيع نحن، إلّا أنّه ينبغي لنا أن نستفيد مما طلبه سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمورٍ في دعائه، ونتّخذه دليلًا وهاديًا لنا، وفي دعائه هذا يُعلي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الهمّة إلى أقصى درجاتها؛ فيُعلِّمُنا بذلك أن نطلبَ الذروةَ دائمًا والمعالي أبدًا، ومن ثمّ فينبغي لنا ألا تَضْعُفَ همَمُنا أو تَفْتُر أبدًا، بل علينا كذلك أن نشحذ همَمَنا وإرادتنا دائمًا، فعلوّ الهمّة من الإيمان، ونسعى ونجتهد طلبًا لرضا الله جلّ جلاله بنفسٍ مطمئنةٍ مؤمنة حتى آخر نفس من أنفاسنا.
النفس الزكيّة أو الصافية
وهذه هي ذروة سنام الأمر وغايته، وهي مرتبة المقرّبين، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (سُورَةُ الشَّمْسِ: 91/9)، وإن السالك حينما يتدرّج على سلّم مراتب النفس مرورًا بالمطمئنة وغيرها ويصل إلى هذه المرتبة العالية فإنه يُحسّ بخفقان أجنحة الملائكة من حوله حتى لكأنه يتجوّل في الآفاق الملائكيّة، ولن نتعدّى الحقيقة إن قلنا:
إن الإنسان حينما يبلغ هذه القمّة يغدو مخلوقًا أعلى من الملائكة.
[1] الطبراني: المعجم الكبير، 8/99.
[2] الديلمي: مسند الفردوس، 3/408.
[3] البيهقي: الزهد، 1/165.