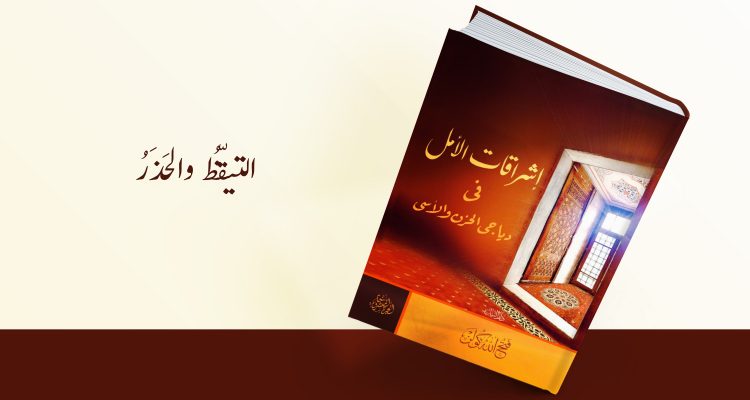سؤال: ما الأمور التي يجب الحذرُ منها والتيقُّظُ لها في طريق الخدمة الإيمانية؟ وكيف ينبغي أن يكون هذا التيقُّظ؟
الجواب: التَّيَقُّظُ من اليقظة بمعنى الصحوة والإفاقة والتنبّه، ولفظُ “التيقّظ” فيه معنى التكلّف لأنه من صيغة “تَفَعُّل”؛ ولذا يُقصد به: أكملُ انتباهٍ وأبلغُ دقّةٍ وأعمقُ تعمُّقٍ وأعلى حساسيةٍ وأسمى درجات الحيطة والحذر، كما يمكننا أن نعرّفه بأنه: إيقاظُ جميع الملكات الشعوريّة والفكرية -فضلًا عن البصريّة- حيال استقراء الحوادث، وتشخيصها تشخيصًا سليمًا، وعدمُ الاقتصار على التأويلات والتقييمات التي يوحي بها رأيٌ واحدٌ أو شعورٌ واحدٌ، وفحصُ ومراجعةُ الرؤى والقرارات في كلّ مسألةٍ مرةً تلو أخرى… فالإنسان المتيقّظ هو الذي يرى نفسَه كطيّارٍ يُدرك أنّ أيّ خطإٍ أو خللٍ يصدر منه مهما كان صغيرًا يُمْكِنُ أن يوديَ به وبمن معه إلى السقوطِ والهلاك؛ يرى ذلك فيأخذُ بمجامع الحيطة والحذَرِ دائمًا حتى لا يتردّى أو يسقط.
التيقّظ في عهدٍ ساد فيه النفاق
إن التيقّظ بالنسبة للأرواح التي نذرَتْ نفسها لخدمة الإيمان والقرآن يحمل أهمّيّةً خاصة في هذا العصر الذي استحكمَ فيه النفاق، ومن ثَمّ فعلى تلك الأرواح بدايةً أن تحسنَ استقراءَ الزمن الذي تعيش فيه، وتعملَ على تحليل الظروف الراهنة تحليلًا سليمًا، وتتعرّفَ جيّدًا على خصومها الذين جُبلوا على العداوة، ولا يغرنّها قربهم منها فإنهم يستترون وراء ستار النفاق على هيئة دوائر متداخلة؛ ومهما فعلتْ الأرواح المتفانية وبذلت وسعَها حتى لا تَظهرَ كجبهةٍ مبارزة ومناهضة فإن هؤلاء الذين طارَ صوابُهم حسدًا وغيرةً قد يتحكّمون بتلك الأرواح، فيبثّون نيران مشاعرهم العدائيّة في شتى دوائر الحياة أعلاها وأدناها، بل إن هؤلاء الذين أَسَرَهُمُ الحقدُ والغِلُّ يتربصون بهم الدوائرَ.
أجل، ينبغي لهذه الأرواح أن تعيَ ما تحمِلُهُ على عاتقها من مهمّةٍ جِدّ حسّاسةٍ، وأن تتمتّع مع كل انطلاقة أو خطوةٍ تخطوها بشجاعةٍ باهرة لا تُقهَر، وعقيدةٍ راسخة لا تتزعزَع، وثباتٍ على الطريق المستقيم، وإلى جانب هذا كله؛ عليها أن تضع حسابًا للتخريبات التي قد تصدُرُ عن الجبهات المعادية نتيجةَ فَوَرَانِ غيظِها وتفجُّرِ حِمَمِ حقدِها وكُرْهِها، وإلا تسبّبت في أخطاء وإخفاقات تضرُّ بالحركة التابعة لها، لذا فإن اتّخاذ الحيطة والحذر والدقّة البالغة في هذا الأمر يُعدّ عمقًا وبعدًا من أبعاد التيقظ.
والواقع أن القلب المؤمن يحسب ويُفكّرُ لِغَدِهِ كما يَحْسِبُ ويُفكّرُ لِيَومِهِ، ولا يتقيّد بحاضره فحسب، ولا ينبغي له ذلك؛ لأنّ الحسابات اليومية أو المرحليّة لم ولن تقتلعَ أيّ مشكلةٍ من جذورها، فمنذ عدة عصور وتُطرح الحلول غير الجذرية لمشاكل العالم الإسلامي، وتوضع السياسات اليومية المؤقتة للمشاكل العملاقة دون جدوى، ولذا فإن من يحسبون أن السياسات اليومية المؤقّتة قادرةٌ على حلّ المشاكل في بلادهم والعالم الإسلامي وجَعْلِه عنصرًا من عناصر التوازن الدولي، ومحطَّ أنظار العالم وموضعَ تقديرِهِ فقد خَدعوا وانخدَعوا.
أجل، إننا إذا ما نظرنا نظرةً موضوعية إلى ذاتنا كمجتمع لألفينا أنْفُسَنا غيرَ قادرين على التحديد التام لعِلَل آلامنا الممتدة منذ عصور، ولم نستطِع تشخيصَ الداءِ تشخيصًا سليمًا، فضلًا عن وصف الدواء وصفًا حكيمًا.
لذا فعلى القلوب المؤمنة في زماننا أن تسير متيقّظة كالعيون الساهرة وليس كالذي يسير أثناء النوم، وأن تنظر بشموليّةٍ إلى الحوادث، وأن تُقلّبَ النظرَ كرّةً بعدَ أخرى في كلّ خطوةٍ تخطوها، وأن تراجع مرّةً أخرى كلَّ عملٍ تقوم به، وأن تعالجَ المشاكل كإنسانٍ تيقّظَت كلُّ ملكاتِهِ الشعوريّة والفكريّة بتمامها، والأحرى أنّ عليهم أخذَ الحَذَرِ عند نماءِ أيّ طقطقةٍ إلى مسامعهم وكأنهم جنود الوطنِ المرابطون على حدوده، وأن يحتاطوا في كلّ لحظةٍ تحسُّبًا لأيّ خطر، وأن يستعدّوا دائمًا لمكافحة السلبيات بما في أيديهم من حلولٍ متاحة.
التيقّظ حيالَ النجاحات
ومن جانب آخر: فإنّ ممّا منّ الله تعالى به على الذين يسعون لخدمة الإنسانية في يومنا هذا ابتغاء مرضاته أن جعلَهم مبلِّغين للحقّ والحقيقة في شتى ربوع العالم، فإن لم نحتَطْ لهذا الأمر فلعلّنا -معاذ الله- نقع في الغفلة ونَنْسُبُ إلى أنْفُسِنا من النجاحات ما يجب عَزْوُهُ إلى الذات الإلهية، أجل، علينا أن نوفّيَ إرادتنا حقّها إلا أن الإرادة شرط عاديٌّ لتحقّق شيءٍ ليس إلا، والحقيقةُ أنّ الخالق هو، والصانع هو، والفاعل هو، والذي يجعلُ الشتاءَ ربيعًا هو، والذي ساقنا إلى كل هذه الجماليات هو سبحانه وتعالى؛ ولذا فلا يصحّ أن تدور بِخَلَدِنا أفكارٌ من قبيل: “نحن فَعلْنا، نحن صَنعنا”، بل يجب أن نعتبر كلّ جمالٍ نحصل عليه لطفًا وتفضّلًا منه سبحانه وتعالى، وأن ننسب النعمة إلى صاحبها الحقيقي، أخذًا بمبدإ التحدّث بالنعمة، والحقّ أن مثلَ هذا التصرّف الحذِرِ كفيلٌ بتوالي مزيدٍ من النِّعَمِ الإلهيّة تترى؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ: 14/7).
فضلًا عن ذلك علينا أن نتجنّب بقدر المستطاع الغلوَّ والإطراءَ الزائدَ في نعْتِ أصدقائنا الذين يُشاركوننا الدرْبَ نفسه؛ لأننا قد نوقعهم في عشق المقامات التي يُحْسِنُ الناسُ فيها ظنهم، وبذلك ندقّ أعناق أصدقائنا بأيدينا دون وعي منّا، حيث إن استخدام عبارات المدح والثناء في حقّ مَن نُحسِنُ الظنّ بهم قد يثير شعور الغيرة لدى آخرين ممن يشاركونكم الطريق ويتقاربون معكم في المنهج، وقد يسوقهم ذلك إلى الحقد والحسد، فكلّما طافت ألسنتكم بعبارات المدح والثناء حولَ شخصٍ تحبُّونه أثَرتُمْ في الآخرين شعور الإنكار والجحود تجاهَهُ، وبذلك يكون جزاؤُه منكم الإساءَة له بدلًا من الإحسان إليه، لذا فالصدقَ الصدقَ، والحذرَ الحذَر مع بعضكم البعض، وإياكم ومَذْقَ الإطراءِ والإطنابَ في التقريظِ لمن تُحبُّون، وعلينا أن نسعى دائمًا لنكون صادقين أوفياء مع بعضنا، وبدلًا من أن ننعت فلانًا بالولاية وفلانًا بالقطبية ندعو الله قائلين: “اللّهم لا تحرمنا من الصدق والوفاء لإخواننا!”.
والحاصل أنكم إن كنتم تحملون حبًّا جمًّا وشوقًا صادقًا لشخصيّةٍ معيّنةٍ فعليكم أن تُعَبّروا عن حبّكم وشوقكم بالعمل على تحقيق الغاية المثاليّة التي أرشدكم إليها في إطار الكتاب والسنة، أما الإطنابُ في إطرائه أمام هذا أو ذاك فمِن شأنه أن يُثِيرَ حقد وكره الآخرين له، وبذلك تكونون قد أسأتم له وأنتم تُريدون الإحسان إليه، وهكذا فإن مراعاة الدقّة والحساسيّة في الحديث عن كبارنا الذين نُكِنّ لهم كل تقدير واحترام يُعدّ بعدًا آخر من أبعادِ التيقّظ على طريق الخدمة الإيمانية.
سؤال: ماذا يعني التيقّظُ بالنسبة للطامحين إلى السياحة في أفق القلب والروح؟
الجواب: قد يركن “السالكُ طريقَ الحقِّ” إلى الرجاء حيال ما يَرِدُه من وارداتٍ وهباتٍ أو ما ينهال عليه من تجلِّيات عامة تتحقّق في أحوال ومقامات معينة؛ فيدخل في نوعٍ من الشطح والتحرّر، فثمّة حاجةٌ ماسّة جدًّا إلى التمكين والتيقّظ في مثل هذه النوعية من الأحوال التي تمثّل ابتلاءً وامتحانًا بالنسبة “للسالك”، فالله جلّ جلاله يمتحنكم بتدفُّقِ الإحسان والجماليّات، ويمُنّ عليكم بما يساوي الجوهرَ قيمةً، فإن فرحتم كالأطفال بهذه الهِباتِ والنعم ونسيتم في خضمّ ذلك صاحبَها فإنكم حينئذٍ ترسبون في الامتحان، لذا فالواجبُ على الأعين في مثل هذه الأحوال -التي تُمْطِرُ عليكم فيها الإحساناتُ وابلًا صيّبًا- أن ترى صاحب تلك النعم وتَرقُبَه ولا تحيد عنه، وأن تجيشَ القلوبُ بها من باب “شكر المنعم” فحسب، وعلى حدّ قول فضيلة الأستاذ سعيد النورسي فإنه ينبغي لنا عند شكر أيّ مُحسن إلينا ألا نتجاهل مَنْ أرسله. أجل، إن الإنسان العازم على السياحة في أفق القلب والروح يحتاج دومًا إلى التمكين والتيقّظ الحقيقي كي يستطيع الحفاظ على التوازن اللازم أمام الهِبَاتِ والوارداتِ التي يحظى بها.
“لستُ أنشدُ شيئًا سوى رضاك!”
إن الجانب المتعلِّق من هذه المسألة بالأرواح التي نذرت نفسها في يومنا الحاضر مختلفٌ قليلًا؛ لأنهم -وبحسب مقتضى مسلَكِهم- لا ينشدُون مثل هذه المقامات المعنويّة، وإنَّ الأستاذ النورسيّ بعد أن بيّن أن الهدفَ الأسمى للإنسان هو الإيمان بالله، ثم معرفة الله التي تنشأ من الإيمان، ثم محبة الله التي تنبع من معرفته جل وعلا؛ أضاف إلى ذلك “اللذة الروحية”[1]، بيد أن ثمّةَ أمرًا دقيقًا يجب الانتباه إليه ههنا ألَا وهو: أن الثلاث الأُول ممّا ذُكر أعلاه “إراديٌّ” بمعنى أن على الإنسان أن يبتغيها بإرادته، وبتعبير آخر: فإنكم تُوَفُّون إرادتكم حقّها كشرطٍ عاديّ في الحصول على الإيمان بالله ومعرفة الله ومحبة الله، وتتوسّلون وتطلبون وتبحثون وتتجوّلون في عوالم الأوامر التكوينيّة، وتُراعون الأوامرَ التشريعيّة، وتذكرون الله وتتفكرون، وتبذلون قصارى جهدكم في ذلك، أما بالنسبة لمسألة اللذة الروحية فإنها ليست “إراديّةً” بالمعنى نفسه، أي لا تُطلَب بالإرادة، وإنما قد يَهَبُ الله تعالى مثل هذا الفضلِ لمن يسلكون طريقَ الإيمان والمعرفة والمحبّة، إلّا أنكم إن طلبتموها بدايةً، وربطتم بها الإيمانَ بالله ومعرفةَ الله ومحبةَ الله فهذا يعني أنكم خفّضتم سقف مطالبكم وابتغيتم من النتائج ما هو ضئيلٌ وصغير، أمّا إن ربطتم عبوديّتكم برضاه وتوجّهه فحسب فهذا يعني أنكم ارتقيتم أفقًا تعجزُ الدنيا عن تقييمه أو وزنه، بل وتُستَقَلُّ وتَتَضَاءَلُ اللذة الروحية إلى جانبه، ومن هنا فإنه لا ينبغي الخلطُ بين “الإرادية واللاإرادية”، وعلينا أن نحثّ الخطى دائمًا خلفَ ما هو إراديّ وأن نُوَفّيَ الإرادةَ حقّها في هذا الموضوع، فإن كان الشيء غير الإراديّ قد مُنَّ به علينا وَهْبًا خارجَ إرادتنا ودون طلبٍ أو رغبةٍ منّا فلا بدّ لنا من مقابلة ذلك بالشكر والحمد، والتعبير عن شعورنا بالمنّة والامتنان، والتحدث بنعمِ ذي الجودِ والإحسان.
إن الإلهام والكشف واستقراء ما في نفس الإنسان والإحساسَ بالحوادث قبل وقوعها والانفتاحَ في الرُّؤَى على عوالم مختلفة… كل هذه الأحوال والمقامات ليست أساسًا أو هدفًا يُبتغى؛ فنحنُ نسلكُ طريقَ الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين لم يلتفتوا إلى هذه النوعية من الخوارق التي قد تجد النفسُ الأمّارةُ إليها سبيلًا، ولم يُلْقُوا لها بالًا؛ وإنّهم إذ أجرى الله على يدِ بعضهم بعضَ الكرامات مثل الإحساس بالشيء قبل وقوعِهِ، وإجراء الحقّ على لسانهم؛ إلا أنهم لم ينشدوا الكشف والكرامات قطّ؛ فلم يتغيَّوا سوى غاية يتيمة؛ ألَا وهي الحصول على الرضا الإلهيّ؛ ولذا فإنه يجب علينا نحن كذلك أن نتحرّك في هذا الفلك، فإن حظينا نحن أيضًا ببعضٍ من الهبات والواردات دون أن نطلبها وجب علينا أن نقابلها بقولنا: “إلهي! نعمةٌ لم أكنْ أنا الحقيرُ أهلًا لها، فما سرُّ هذا اللطفِ والإحسان؟!”، وأن نخافَ كونَها نوعًا من “الاستدراج”، وأن ترتعِش فرائصُنا خوفًا ووجلًا، وربما ينبغي لنا أن نقول عقب ذلك: “ربي! كنتُ أريد أن أُحبّك أنت فحسب حبًّا ولِهًا، وإنّي لأطلبنَّ لقاءَك مثل المجذوب، فإن كنتَ منحتَني هذه الأمورَ لتبعثَ فيَّ الشوقَ والغيرةَ فلكَ الحمدُ والشكرُ والثناءُ الحسنُ ألفَ مرّةٍ ومرّة! غيرَ أنني لا أطلب شيئًا آخر سوى رضاك”.
[1] انظر: سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب العشرون، المقدمة، ص 271.