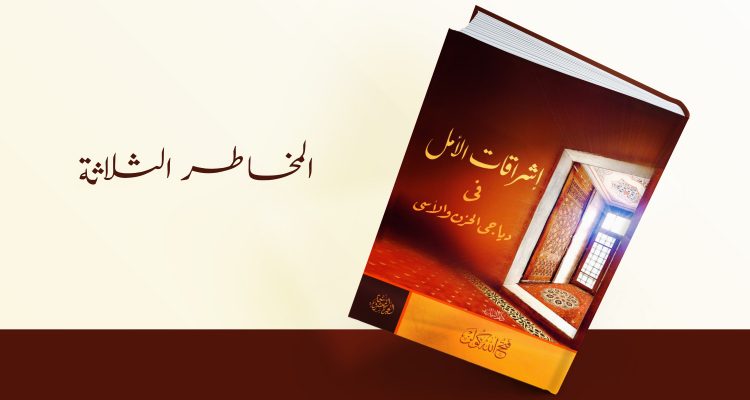سؤال: ذكرتم فيما سبق أنّ مَنْ يسعون في خدمة الإنسانية على موعدٍ مع ثلاثة مخاطر: إثارة مشاعر الغبطة لدى إخوانهم الذين يُشاركونهم الدربَ نفسَه، وإيقاظُ الكره والحقد لدى المؤمنين الآخرين بسبب الأنانيّة الجماعية، وتحريك مشاعر العداء لدى الخصوم بالتباهي بالأعمال التي تعِد بمستقبل مشرق، فما الأمور التي لا بدّ من مراعاتِها حتى نأمن هذه المخاطر الثلاثة؟
الجواب: رغم أن الغبطة مباحةٌ شرعًا ولا بأس بها إلا أنّ هذا ليس على إطلاقه، بل هو منوطٌ بأسُسٍ ومعاييرَ معيّنة؛ فمثلًا: قد يرى شخصٌ في أخيه مزيةً جميلةً فيغبطه عليها، ويتمنى أن يحظى بالمزيّة نفسها، فلا حرجَ في ذلك بدايةً، لكنّه ومع مرور الوقت ربما ينتقد ذلك الشخصُ القدرَ بشكلٍ ضمنيٍّ فيقول في نفسه: “لماذا لا أكون أنا أيضًا محظيًّا بهذه المزيّة”، وما تفتأ مشاعر الغيرة والحسد حتى تتيقّظ لديه تجاه مَن يغبطه، فإن وقع ذلك فهذا يعني خروجَ الغابط من دائرة المباح، وحوَمانَه حول دائرة الشبهات والمحذورات، وكما أن هذه النوعية من الغبطة محذورة فكذلك القيام بتصرفاتٍ تحرّك مشاعر الغبطة لدى الآخرين محذورٌ أيضًا، فقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات في حديثه الشريف الذي يقول فيه: “الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ”[1].
وهكذا فإن شعور الغبطة الذي من شأنه أن يتحوّل إلى حسدٍ؛ مَثَلُه كَمَثَلِ الوقوف على خطٍّ بين الحلال والحرام، فإذا ما انحرف الإنسانُ قليلًا هَوَى في دائرة الحسد والغيرة؛ ولذا كان هذا النوعُ من الغبطة وما يثيرها من تصرّفات وسلوكيات من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتوقّاها، ولقد نبّهنا الأستاذ النورسي رحمه الله رحمة واسعة إلى هذا الأمر وحذَّرَنا في رسالته “الإخلاص” فقال: “لا تنتقدوا إخوانكم العاملين في هذه الخدمة القرآنيّة، ولا تُثيروا نوازع الغبطةِ بالتفاخر والاستعلاء، لأنه كما لا غبطةَ في جسمِ الإنسان بين اليدين، ولا انتقادَ بين العينين، ولا يعترِضُ اللسان على الأذن، ولا يرى القلبُ عيبَ الروحِ، بل يكمّل كلٌّ منهم نقصَ الآخر ويستر تقصيره ويسعى لحاجته… فكذلك نحنُ جميعًا أجزاء وأعضاء في شخصيّةٍ معنويّةٍ”[2].
التنافس: التسابق في الخير
والتنافس -الذي يشبه الغبطة من ناحيةٍ ما- هو عملٌ إيجابي لا حرج فيه؛ ويعني: التسابق نحو النفيس في سبيل الحقّ والحقيقة، وبذل الجهد والنية من أجل عدم التخلّف عن ركب الإخوة الذين يجاهدون ويكابدون في سبيل إعلاء كلمة الله، ولقد دعا القرآن الكريم المؤمنين إلى مثل هذا التنافس في الأعمال الأخروية بقوله: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ: 83/26).
ففي المسابقات الدنيوية ينجح شخصٌ ويخسر آخرون، وقد يولّد هذا الوضع شيئًا من الاستياء والامتعاض لديهم، أما القلب المؤمن الموقن بالآخرة فإنه ينظر إلى التنافسِ الذي يُبتغى به مرضاة الله تعالى بالمنظارِ القائلِ: “إن إخواني الذين يبذلون جهدهم من أجل إعلاء اسم الله تعالى في كل أنحاء العالم سيُهرعون بمشيئة الله تعالى إلى حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشربون من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا يظمؤون بعدها أبدًا، وهذا أمرٌ يدعوني إلى أن أشارك في هذا السباق حتى لا أتخلف عنهم”، يمكن اعتبار هذه المنافسة الشريفة نتيجةً إيجابيةً للغبطة.
وينبغي في مثل هذا التنافس في الحقّ أن يتحلّى الناذِرون أنفُسَهم للخدمة في سبيل الله بروح التضحية فيما أحرزوه من مكاسب وإن كانوا لا يتشوّفون إلى أيّ أغراضٍ دنيوية كالتقدير والتصفيق والمنصب، وأن يُؤْثِرُوا الآخرين على أنفسهم، وأن تتَّسِعَ صدورُهم لإمكانيّة كسبِ الآخرين هذا السباق، ولا يعزُبُ عن علمِكم المعيارُ الذي وضعه فضيلة الأستاذ النُّورسي لطلب المنصب وهو ضرورة ترجيح التَّبَعِيَّةِ على الـمَتبوعيَّةِ لِـمَا تحمله الـمَتبوعيَّةُ من مسؤوليّاتٍ وتُنذر به من أخطار[3]؛ لأن الريادة والإمامة توقِظان وتثيران مشاعر نفسانية مختلفة، فينبغي للإنسان أن يكون على وعي كبير وحذرٍ بالغ في هذا الأمر، لذا وإن كنتم أكثر الناسِ أهلًا لمنصبٍ ما فعليكم تقديمُ الآخرين على أنفسكم وترجيحُ التبعية على المتبوعيّة.
روح الفتوة والمروءة الممتدة إلى الآخرة
دَعْ عنك التشوّف إلى التصفيق والتقدير الدنيويّ، فلا بد للمؤمن من رحابةِ صدرٍ يكشفُ بها فتوَّتَه ومروءَته ويؤثِر أخاه على نفسه حتى في مسائل الانتفاع بالنعم الأخروية في الدار الآخرة، يُروى أن العلماء والأغنياء الصالحين إذا ما وصلوا إلى باب الجنة رغب كلٌّ منهم أن يتقدّم أخوه عنه، ولعلّه يوجَدُ في مثل هذه التضحية والمروءة من اللذَّةِ والمتعة ما يُحاكي الجنّةَ ونعيمها. أجل، ربما هناك ذوقٌ روحانيٌّ لدنّي يرجُحُ الإمامة عندما ينسلُّ الإنسانُ إلى الخلف كالجماعة التي تصطفُّ وراء الإمام، ويُؤْثِرُ غيره على نفسه.
علينا ألا نضيّق من دائرة خُلق الإيثار. أجل، إننا إن قَصَرْنا الإيثار على الأكل والشرب واللبس، فهذا يعني أننا ضيّقنا واسِعًا، وحجّمنا دائرةَ التضحيةِ الرحبةَ وأزهقنا روحها، بيد أنّ على الأرواح التي نذرت نفسَها في سبيل الحق أن يكون لها موقفٌ ثابت وشجاع؛ يؤهّلها أن تقول: “إنني لا أرغب حتى في الجنة، وإن رأيتُ إيمانَ أمّتِنا في خيرٍ وسلامٍ فإنّني أرضى أن أُحرق في لهيب جهنم؛ إذ بينما يحترق جسدي يرفُلُ قلبي في سعادة وسرور”[4]، وأن تربط خَلاصَها بخَلاصِ الآخَرين، وأن تعمل على استغلال هذه الحياة القصيرة في سبيل الحياة من أجل الآخرين، فإذا ما تقابلَتْ أمام باب الجنة مع ألفٍ ممن كانت وسيلة لهدايتهم قالت بشجاعة: اللهم إني لا أدري هل أدَّيتُ بحقٍّ شكرَ النعم التي أسبغتَها عليّ، وهل كنتُ مخلصًا في الأعمال التي قمتُ بها، اللهم أدخِل إخواني الجنة من قبلي”؛ بمعنى أن على الإنسان أن يمحو نفسه تمامًا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يلفت الأنظار إلى غيره على الدوام.
الأنانية الجماعية
أما الأنانية الجماعية فتتغذّى على الأنانيّة الفرديّة والنفس، فقد لا تكفي الأنانية الفردية لبعض الناس الذين يتصارعُون من أجل التعبير عن أنفسهم، فينتمون إلى جماعة معينة، يركنون إليها ويعتمدون عليها، رغبةً في إظهار أنفسهم بقوةٍ، واستغلال قوة هذه الجماعة أو الحركة في الدعاية لأنفسهم، فيؤكِّدون مرَّةً أُخرى على أنانيّتهم، ويحاولون أن يُظهِروا أنفسَهم بسلوكيات وأفعال مختلفة؛ وبذلك يغدون أسرى لأنفسهم وشيطانهم بهذه النرجسيّة والأنانية الجماعيّة الأقوى من أنانيتهم الفردية.
ومهما حاول بعضهم إخفاءَ نواياهُ الحقيقية في غلافٍ من التواضع والمحو إلّا أنّ فطرةَ الإنسانِ تستشعِرُ -بقدرٍ ما- ماهيةَ هؤلاء الأنانيّين؛ لذا فإنّ الأنانيةَ تُفقد الإنسانَ اعتباره وقدره، وتمنحُ الآخرين فرصةَ الاستخفاف به واعتزاله.
وهكذا فإن الذين يتحركون -في كلّ الدوائر من أدناها إلى أقصاها- وفقًا لأنانيتهم الجماعية يثيرون الغبطة أو الحسد في نفوس أتباع الجماعات والحركات الأخرى، ومع الأسف فإنّ أمثِلةً كثيرة يمكننا أن نراها في أيامنا الحالية.
لا سيما إنْ همّ أتباع حركةٍ معينة وصلت إلى بعض النجاحات وجعلوا أنفسهم على رأس الحركة التي ينتمون إليها، ونسبوا إلى أنفسهم كلَّ الجماليات، ورغبوا في أن يُشار إليهم بالبنان على الدوام، وغضّوا الطرف عن خدمات الآخرين، فإن هذا سيؤدي إلى تشكيل جبهةٍ معادية لتلك الجماعة أو الحركة التي ينتسبون إليها؛ لأن هناك مسلمين صادقين عقلاء متحمّسين في كل شريحةٍ من شرائح المجتمع وفي شتى الجماعات والحركات، غير أنه لم يكتب لهم أن يقوموا بعُشر معشار الخدمات التي قام بها الآخرون رغم نزاعهم وسعيهم الحثيث في سبيل الحق والحقيقة منذ أمدٍ بعيد؛ ولذا يشعر هؤلاء الناس بشيء من الاستياء إذا ما أخذ أتباعُ حركةٍ معينة في الحديث عن أنفسهم وعن النجاحات الكثيرة التي حققوها؛ ومن ثمّ فعلى أتباع هذه الحركة التي أحرزتْ هذه النجاحات أن يكونوا على وعي وحذرٍ بالغ حتى يَئِدُوا المشاعر السلبية التي قد تنشأ لدى الآخرين الذين يسعون في مختلف سبل الخدمة؛ فإذا ما تحدّثوا عن خدماتهم نسبوها إلى الدوائر الواسعة بقدر الإمكان.
فمثلًا: قد يأتيكم بعض المنصفين العارفين بالجميل من أتباع الحركات الأخرى ويثنون على ما قمتم به من خدمات، فعليكم حينذاك أن تقولوا لهم: “في الواقع إن كلَّ هذه الجماليات كانت من أمانيكم وغاياتكم المثلى، كنتم تُدنْدنون بها، وتسطّرون ملاحمها طوالَ سنوات، وبذلتم جهدًا كبيرًا في هذا السبيل، فكنتم أنتم أوَّلَ مَن شرع في تقديم هذه الخدمات، ولكن الله تعالى سخّر لهذه المرحلة بعضَ إخوانكم فحقّقوا هذه الغاية المثالية التي بدأَتْ بجهدكم وعزمكم”.
والحقيقة أنَّ كل إنسان مُنصِفٍ ذي ضميرٍ يُقرُّ بأنَّ لكل جماعة وحركة جهودًا حقيقية مهمةً في انبعاث المجتمع من جديد؛ فترى بعضَهم وقد زانُوا أرضَ الوطن -من أقصاها إلى أقصاها- بِدُورِ ومراكز تعليم القرآن الكريم؛ إذ إنّهم في ذلك الوقت الذي شحّ فيه تعليمُ القرآن جابوا البلاد قريةً قريةً، وقصبةً قصبة، وسعوا في شتّى الأسقاعِ إلى تعليم الناس كتابَ ربّهم جلّ جلاله، والبعضُ رعى الشبابَ واعتنى به عبر افتتاحه مدارس في كل مكان قدرَ استطاعته، أما البعضُ الآخر فقد افتتح المعاهد الإسلامية، وكليات الإلهيات، والمراكز التعليمية، والمدن الطلابية فأسهموا بذلك في الوفاء بمسؤوليّاتهم تجاه الشعب والأمة، إذًا فإن كان ثمةَ انبعاثٌ اليوم بقدر معين، فإنَّه تحقّق بفضل تكاتُفِ الجهودِ المبذولةِ من كلّ الجماعات والحركات، ما ذكرنا منها وما لم نذكر.
وأظن أنكم حين تتناولون المسألة بهذا الأسلوب آنفِ الذِّكْرِ فإنه لن يُخيَّلَ لأيِّ مُنصفٍ أنَّه حُكم عليه بالعدم، أو أنّه هُضِمَ حقّه، أو أنّه لم يُؤبَهُ به؛ وبهذا فإنه لن يرتكب ذنوبًا من قبيل إساءة الظنّ والحسد والغيرة.
الوهم والمخاوف التي تُحَفِّزُ مشاعرَ العداء
ينبغي للأرواحِ الناذِرَة نفسَها للخدمة في سبيل الله ببصيرةٍ وحكمة أن تتحلّى بروحِ الشجاعة والمروءة التي تنسِفُ الهمومَ والمخاوفَ نسفًا، وليس ذلك تجاه بيئتها الصديقةِ فحسب، بل وتجاه مَنْ أتوا بتصرّفاتٍ وحركاتٍ عدائية ضدها لعجزهم عن مشاركتهم المشاعرَ والأفكارَ ذاتها، يقول “حافظ الشيرازي” حول هذا الموضوع: “نَيلُ الراحة والسلامة في كلا العالمين توضّحه كلمتان: معاشرة الأصدقاء بالمروءة والإنصاف، ومعاملة الأعداء بالصفح والصفاء”، فإن كُنَّا مؤمنِينَ وندينُ بأنّ الشفقةَ مبدأٌ من مبادئنا الأساسيّة فإنَّه يَتحتَّم علينا أن نتصرّفَ تجاهَ الجميعِ برحمةٍ ولينٍ، إضافةً إلى أنه يجب عليكم -من أجل استئصالِ أوهام مَن يتخوَّف ويقلقُ من المستقبل- أنْ تُبيّنوا بشتّى الوسائل أنكم لا تنشدون أي غرضٍ دنيويّ في المستقبل وأنكم لا تَبتَغونَ شيئًا آخر سوى الرضا الإلهي، حتى إنَّه ينبغي أن يُردَّد ذكرُ تلك الحقائق ويُكرَّرَ بلغةٍ واضحةٍ وصوتٍ جَهْوَريٍّ تسمعه الدنيا بكلِّ عوالمها.
دَعْكُم من التشوّف إلى حكمِ بلدةٍ ما أو دولة ما، فإننا لا نطمح حتى إلى زعامةِ قريةٍ، وكلُّ هَمِّنا وغايتُنا الوحيدةُ هي: أنْ يُسمعَ اسمُ الله واسمُ النبي صلى الله عليه وسلم في كلّ أرجاء المعمورة، وأن تنهلَ الإنسانيّة التي خُلقت مكرَّمةً من مناهل الفضائل التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتُبلَّغَ القلوبُ اسمَ الله الجليل؛ فيرفرف فيها كالراية، وإننا نطرد من أذهاننا كل الأفكار التي تخالف هذا، ونطرحها إلى أبعد ما يكون، بل وإن أقبلت علينا الدنيا بكل مفاتنها فإننا نَــركُـلُ السلطنة الدنيوية بأطراف أقدامنا، لأنّنا نسعى إلى اقتفاء أثر سيد السادات محمدٍ صلى الله عليه وسلم خطوةً خطوةً، ونتأسّى به قولًا وعملًا، إذ رفض الدنيا التي تمثلت له، يقول: “هَذِهِ الدُّنْيَا مُثِّلَتْ لِي فَقُلْتُ لَهَا إِلَيْكِ عَنِّي!”[5]، وذلك لأننا نطلب رضا الله تعالى الأعظم والأكبر من محاسن هذه الدنيا الجذابة الكذّابة، والفانيةِ بكلّ ما فيها مِنْ مفاتنَ، والواقعُ أن عدم صُدورِ أو وجودِ أدنى إشارة أو علامة منا تستدعي قلقَ أو تخوُّفَ بعضِ الطوائف والشرائح في ثقافاتٍ وفي مناطق جغرافية مختلفة جدًّا ليؤيدُ ويؤكّدُ -بكل وضوحٍ- فكرتَنا وقناعتنا هذه.
ومع أن هذه هي الحقيقةُ إلّا أنّهُ يجبُ التأكيدُ على هذه الأفكار في كلّ مناسبةٍ وموقفٍ، وإلا فإنْ التزَمْنا الصمتَ ولم نَقُل أيَّ شيء في هذا الشأن؛ فلربما يتبَنّى بعضُ المخلصين الذين يُحسنون النيّة قناعاتٍ وآراءً خاطئة من عند أنفسهم إذا ما نظروا إلى تطوّر الخدمات التعليمية وأنشطة الحوار؛ فيُخيّمُ عليهم القلقُ والمخاوف… فإذا كان للمقرّبين منكم -الذين يقفون عن يمينكم وشمالكم أثناء الصلاة- أن ينغلقوا على مجموعةٍ من الأفكارِ الخاطئة حيالكم؛ فلكم أن تتصوّروا مدى القلق الذي يمكن أن يَشعر به أولئك الذين يُعادونكم ويجهلون عالمكم الداخلي ولا يعلمون أن غايتكم اليتيمة هي ابتغاء رضا الله تعالى، ومن هذه الناحية فإن الأرواح الناذرَةَ نفسَها للخدمة في سبيل الله -بدءًا من طفل السابعةِ إلى شيخ السبعين أو حتى من هو أكبر- عليها أن تتذكّرَ دائمًا وأبدًا أنها لا تضع في حسبانها أيَّ شيء مستقبلي بشأن السلطنة الدنيوية ولا تطمح إليها ولا إلى ما يمكن أن تحقّقه من إمكانات، وينبغي لهم أنْ يَنْأَوا بأنفسهم عن كل قولٍ وفعلٍ وتصرُّفٍ وسلوكٍ قد يُثِيرُ لدى أهلِ الدنيا -الذين يرون الدنيا كلَّ شيءٍ ويتعلّقون ويربطون حيواتهم بها فحسب- الخوفَ من فقدان الإمكانيات الدنيوية.
[1] صحيح البخاري، الإيمان، 39؛ صحيح مسلم، المساقاة، 107.
[2] انظر: سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة الحادية والعشرون، دستوركم الثاني، ص 221-222.
[3] انظر: سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة العشرون، السبب الرابع، ص 211.
[4] بديع الزمان سعيد النورسي: السيرة الذاتية، ص 492.
[5] البيهقي: شعب الإيمان، 13/113؛ الحاكم: المستدرك، 4/344.