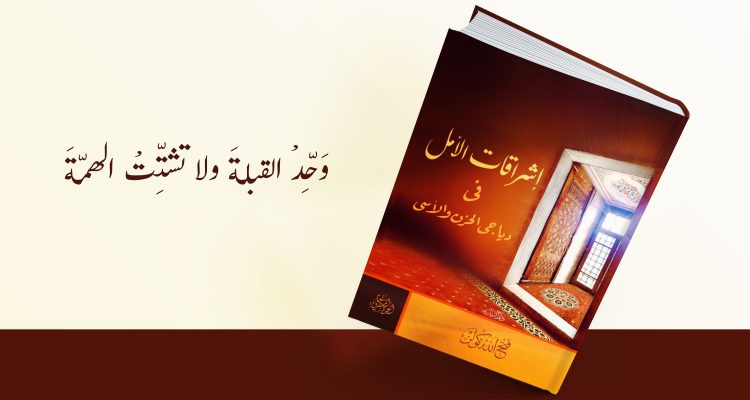سؤال: ذكر الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله في موضعٍ من رسائله أن الإمام الربانيّ أحمد السَّرْهَنْدِيّ قُدِّس سرّه قد أوصاه في واحدةٍ من التوافقات الخالصة بتوحيد القبلة[1]، وبناءً عليه اعتصَم بديع الزمان بالقرآن الكريم وجعلَه المرشدَ الأوحد له، فما الذي تكشف عنه هذه الحادثة في وقتنا الحالي؟
الجواب: في البداية أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمرين قد يُفهمان خطأً:
الأول: يجب أن نعلم أن الأستاذ النورسي رحمه الله رحمة واسعة لم يكن يستصوب اتخاذ مثل هذه التوافقات (التفاؤلات) والرؤى أحكامًا عامّةً؛ لأن الأحكام المستقاة منهما أحكامٌ خاصة وليست موضوعيةً، فضلًا عن ذلك لا بدّ من تأويل هذه التوافقات والرؤى تأويلًا صحيحًا، وتأويل الرؤى يُعنى به التوصّل إلى نتيجةٍ ما من خلال تأويل بعضِ الرموز المعينة، ومن ثمّ يختلف ما يرد في الرؤيا عن الحقيقة التي تعبر عنها، وهذه الأسس التي سقناها حيال التوافقات والرؤى أمورٌ مسلّمٌ بها، ولا بدّ أن الأستاذ النورسي عندما اهتدى إلى هذا التوافق؛ استقرّت نتيجتُه في ذهنه، وصدّق عليه قلبُه، ورآه متوافقًا مع تجاربه، ولذا أعطاه هذا القدر من الأهمّية ونقله لنا.
أما الآخر فهو: إن عبارةَ “وحِّد القبلة نحو القرآن” التي صاحبت هذا التوافق لا يُقصد منها أن الأستاذ النورسي قد انفصل عن القرآن الكريم وهجره، وأخذ يلهث وراء أمور أخرى حاشاه، فحياته ظاهرة للعيان، ومن المعلوم لدى الجميع أنه قد ظل طوال حياته يسعى وراء الحقائق القرآنية دون سواها، وعلى ذلك فإن عبارة “وحِّد القبلة” ما هي إلا هدفٌ دُلّ عليه الأستاذ في أفقِ توافقٍ خاص، والواقع أنه كان خلال المراحل الأولى من حياته يبتغي تناسبَ إقامةِ الحق والحقيقة والتعبير عنهما مع روح ومقتضيات عصره، وفي هذا السبيل طوّف بالتكايا والزوايا، وتعرّف بالكثير من الناس، لكنه لم يقابل أحدًا -وفقًا لرؤيته- يعي مشاكل العصر التي ينبغي الوقوف عليها ويهتمّ بها ويطرح حلولًا تتناسب مع روح العصر، وإزاء هذا الوضع رأى ضرورةَ تناول المشاكل التي اعترضت حياةَ المسلمين بأسلوب ومنهجٍ مختلفٍ، وفي النهاية توصّل إلى أن القرآن الكريم هو المرشدُ الأوحدُ الذي يجب الرجوع إليه والاستعانة به.
وإذا ما نظرنا إلى العهد الذي عاشه الأستاذ النورسي لوجدنا أن كلَّ شيء في ذلك العصر قد أصابه الخراب والدمار، وانقلبت جميعُ القيم رأسًا على عقب، ولقد صور لنا الشاعر محمد عاكف هذه الأيام بقوله:
خراب ديارٍ وانهيارُ بيوتٍ واستيحاشُ صحراء
وانمحاق البركة من الأيام، وافتقار الليالي إلى الغاية العلياء
فلما شاهد الأستاذ النورسي كلّ هذا أدرك عِظم الداء، فبحث يمنةً ويسرةً عن علاجٍ ناجعٍ له، ورغم أنه حاول أن يوضّح مدى شدّة وفداحة ما وقع من دمارٍ وخراب، وضرورةَ معالجة المسألة من الأساس مجدّدًا، والاهتمامَ بمسألة الإيمان؛ فإنه مع الأسف لم يجد إلا القليل مـمّن يتفهّمون همّه، وبناءً على ذلك يمّم وجهه شطرَ القرآن الكريم، ولكنه لـمّا فعل ذلك لم يقصر نفسه على مناهج التفسير التقليدية، ولكن انتهج لنفسه منهجًا خاصًّا استقاه من منهلِ القرآن الكريم نفسه، وبهذا المنهج قدّم لنا وصفاتٍ علاجية من الدساتير الماسيّة للقرآن الكريم تداوي جميع أمراض عصرنا.
تحديد مشاكل العصر أوّلًا
والحقُّ أنّ الكثير من العلماء ظلّوا -على مدار قرون متعدّدة- يبحثون عن حلولٍ تلبّي متطلّبات وظروفِ عصرهم، فحرّروا مؤلّفاتهم على هذا الأساس؛ ولقد ظهرت -على سبيل المثال- العديد من المشاكل المختلفة في عهد الإمام الغزالي مثل: تسلّل الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي، وانتشار أفكار المعتزلة والجبرية، وظهور فرقتي الباطنية والقرامطة، وقد طعّمت الفلسفة اليونانيّة بجانبها الباطنيِّ العالمَ الإسلاميَّ آنذاك، مما نتجَ عنه تأثُّر كثيرٍ من المسلمين؛ فمثلًا نجد الفارابي وابن سينا -في باكورة أعمالهما الفكريّة- قد تأثّرا بالفكر الفلسفي الذي وفد علينا من خلال ترجمة مؤلفات أفلاطون وأرسطو التي تعتمد في الأساس على أفكار سقراط، فما كان من الإمام الغزالي إلا أن بذل كلّ طاقته في سبيل توجيه الناس في عصره إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الفضلاء رضي الله عنهم أجمعين، وتمّ له ذلك بفضل من الله؛ إذ أسَّسَ منهجًا وطريقًا خاصًّا بعيدًا عن الفلسفة اليونانية، وأضفى على الفلسفة الإشراقية لونًا خاصًّا.
وكذلك اشتغل الإمام الرباني بحلّ المشاكل التي انتشرت في عصره، وكما تعلمون أنه معاصرٌ لسلطان الهند “جلال الدين أكبر شاه” الذي كان مهيمنًا على مقدرات بلاد الهند، لقد ادّعى هذا الشاه كالتاريخانيّين (الحداثيّين الذين يُنكرون صلاحية نصوص القرآن لكل زمانٍ وأوان) في عصرنا أن الكتاب والسنة لا يتوافقان من حيث ماهيتهما الحقيقية مع روح العصر الذي يعيشون فيه، وابتدع خلطةَ ديانة؛ بمعنى أنه سعى إلى تشكيل ديانة جديدة تشتمل على توليفة من اليهودية والمسيحية والبوذية والهندية وشيءٍ من الإسلام، وبناءً على ذلك شكّل الإمام الرباني أسوارًا حول الإسلام يجابه بها هذا الفكرَ الضالَّ المنحرفَ، واستطاع بِرُوحِ التجديد الكامنة في أعماقه أن يُشيّدَ صرحَ الروحِ في العالم الإسلامي مرة أخرى.
والواقع أن هذه الهمّة ومثيلاتها مستقاة من همّة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انزوائه في “سلطنة حراء” قبل زهاء ستة أشهر من نزول الوحي عليه، فمن غير المعقول ألا تفكّر مثلُ هذه العقلية الرائعة وهذا الإنسان المحظي بجاهزية خاصة في المشاكل التي كانت منتشرة في العصر الجاهلي قبل أن ينزوي إلى “سلطنة حراء”، فكم أضْنَتْ هذه الروح الفريدة نفسها وأنهكت عقلها قبل أن تُشَرِّف غار حراء في سبيل توجيه الناس إلى الله والدّين الحنيف! وفي النهاية نزل الوحي منهمرًا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ووَجَّهَ الله تعالى وَجْهَ نبيّه صلى الله عليه وسلم إليه تعالى، وأرسل له شرعةً جديدةً فيها العلاج الناجع لكل أمراض ومشاكل العصر.
الدساتيرُ القرآنيّةُ الماسيّةُ وَصْفَةٌ طبيةٌ لعصرٍ مريضٍ
حين طالع الأستاذُ بديعُ الزمان “المكتوبات” للإمام الربّاني ووقع له هذا التوافق أخذ بوصيته الداعية إلى ضرورة التوجُّهِ التامّ مجدّدًا إلى القرآن الكريم، والبحثِ عن علاجِ مشكلاتِ العصرِ في ثنايا حقائق القرآن الماسيّة دون سواها، وهذا يعني أنّ النتيجة التي ظهرت لبديع الزمان في هذا التوافق تتّفق مع المشاعر والأفكار المستقرّة لديه مسبَقًا، بل إنها في نفس الاتجاه، وبناءً عليه قَطَعَ علاقته بكل شيء وركّزَ في نقطة واحدة، وكثّف هِمّته على هذا الموضوع حتى إنَّه لم تُثْنِه عنه لا المضايقات ولا النفي ولا السجون ولا المعتقلات قطُّ، ولم تُجبره على التراجع ولو حتى خطوةً واحدةً؛ وذلك لأنَّه كان يؤمن يقينًا بأنَّ نجاة الإنسان المعاصر وخلاصه سيتحقّق بالدساتير القرآنية الماسيّة، وأنّ هذه النجاة ستكون مصدرَ أملٍ لنجاة آخرين كُثُر.
وإذا ما نظرتم إلى الأمر من زاوية يومنا المعاصر؛ تَعَذّرَ عليكم أن تروا الشناعاتِ والدناءاتِ التي ارتُكبت في تلك الفترة رؤيةً كاملةً، ولا تستطيعون الوقوف على الصورة بكلِّ تفاصيلها، فحتى كبار العلماء الذين عاشوا في ذلك العصر ممن يُوصفُ كُلُّ واحد منهم بــ”العلامة” تذبذبوا بين هذا وذاك؛ بحيث إنكم حين تنظرون إلى مؤلّفاتهم تجدون بعضَهم قد ماشى نظريّةَ التطوّر، حتى إنَّ بعضَهم قال: إنَّ التطوُّرَ نظريّةٌ، وإنَّه إذا ما أثبتَتْها العلوم التجريبيّة ذات يومٍ؛ فمن الممكن التوفيقُ بينها وبين الآيات القرآنية.
أجل، في هذه الفترة ارتجّ جذرُ المجتمعِ بمقوّماته الأساسية، وتوالت فيه الانكسارات والمصادمات تترى، وظهرت عقلية سامية تعرف كيف تنظر إلى الحوادث نظرةً كليّةً شموليّةً، وتبصر الأسبابَ والنتائجَ مجتمعة، ولقد أخذت هذه العقلية بعين النظر والاعتبار توصيةَ الإمام الربّاني تلك؛ نتيجة مطلَقِ ثقتها به، وبتعبيرٍ آخر: وافقَ توافقُها هذا توافقاتِه الداخليةَ الخاصة؛ فاستفادت من هذا الاقتران وواصلت المسير في هذا الطريق.
آفاق جديدة بوجهة نظر جديدة
يمكن في يومنا الحاضر أيضًا -انطلاقًا من المنافذ التي تركها بديع الزمان مفتوحةً- تقديمَ صورة جديدة للمسائل والقضايا التي تناولها، وإكسابَ الناس انفعالًا جديدًا؛ فعليكم أن تعرضوا بأسلوبٍ ومنهجٍ مختلفٍ تلك الحقائقَ التي تناولها هو بحيثُ تأسِرُ أَلبابَ مَنْ يطّلعون عليها فيقولوا: “كنا نقرأ هذه القضية لسنوات عديدة إلا أننا لم نفهمها على هذا النحو قط”، ويشعروا بانفعالٍ وحسٍّ جديد في أرواحهم، والواقعُ أن معظم كلامه عميقُ المعنى والمحتوى إلى درجة أنْ يُشَكِّلَ كلٌّ منه أطروحةً علميةً مستقلّة بذاتها؛ بيد أنَّ القدرة على رؤية هذا العمق تتطلّب سعيًا إلى اطّلاعٍ وقراءةٍ تتجاوز الشكليّات لتنفذ إلى اللطائف الكامنة في الداخل، وكما تعلمون فإنّ العالم المغربي المرحوم “فريد الأنصاري” قد ألَّف كتابًا جميلًا بعنوان “مفاتيح النور” يُعنى بالمفاهيم الرئيسة في رسائل النور، فلماذا لم تُجرَ في بلدنا دراسةٌ حول آثار هذا الإنسان المبارك تكون بقدر أفق ومستوى تلك التي أجراها الشيخ فريد الأنصاري؟ لماذا عجزنا أن نُقيِّم آثار هذه القامة السامقة الممتازة الفريدة تقييمًا من زوايا مختلفة؟ الواقع أنّ المرء يتأوّه كلَّما فكّر في هذه الأمور ويعجز عن أن يمنع نفسه من التحسُّر والأسف.
ومع ذلك فالأمرُ أهمّ بكثير من مجرّد التفجّع والتأسُّف؛ ففي رأيي أنّ الواجب الذي يقع على عاتق العقول المستنيرة في عصرنا هو مطالعة هذه المؤلفات القيمة للأستاذ بديع الزمان بوجهة نظر جديدة، لا سيّما ذوي الأفق العلميِّ الواسع، الخبراء في مجال الدراسات الدينية، فإنَّهم يستطيعون من خلال القراءة المقارنةِ تناولَ تلك المؤلفات ومطالعتها مع مؤلفات العلماء العظام من أمثال الإمام الماتريدي والإمام الغزالي وعز الدين بن عبد السلام وابن سينا وفخر الدين الرازي؛ مما يولّد في الضمائر هيجانًا وحماسًا جديدًا تجاهها، بل لا يكتفون بهذا فحسب وإنما يحللون تلك المؤلفات الممتازة وفقَ منهج قراءة ومطالعة جديد، وانطلاقًا من المنافذ التي تركها فضيلة الأستاذ النورسيّ مفتوحةً؛ يستطيعون إعدادَ جيلٍ من العلماء قادرٍ على استحداثِ منهجٍ علميٍّ للمستقبل، وتأسيسِ عِلمِ المناهج الفقهيّة، إلى جانبِ إجراء دراسات سليمة حول بعض العلوم كالفقه والحديث والتفسير.
[1] يقول الأستاذ بديع الزامن: “وجدتُ كتاب “المكتوبات” للإمام الفاروقي السرهندي، مجدد الألف الثاني فتفاءلت بالخير تفاؤلًا خالصًا، وفتحته، فوجدت فيه عجبًا… حيث وردت فيه رسالتان كتبهما الشيخُ إلى “مِيرْزا بديع الزمان” فأحسست كأنه يخاطبني باسمي، إذ كان اسم أبي ميرزا وكلتا الرسالتين كانتا موجهتين إلى ميرزا بديع الزمان فقلت: يا سبحان الله، إن هذا ليخاطبني أنا بالذات، لأنني كنت ألقب قديمًا “بديع الزمان”، ومع أنني ما كنت أعلم أحدًا قد اشتهر بهذا اللقب غير الهمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري، فلا بد أن يكون هناك أحد غيره قد عاصر الإمام الرباني السرهندي وخوطب بهذا اللقب، ولا بد أن حالته شبيهة بحالتي حتى وجدت دوائي بتلك الرسالتين… والإمام الرباني يوصي مؤكدًا في هاتين الرسالتين وفي رسائل أخرى أن: وحِّد القبلة أي: اتبع إمامًا ومرشدًا واحدًا ولا تنشغل بغيره! لم توافق هذه الوصية -آنذاك- استعدادي وأحوالي الروحية… وأخذت أفكر مليًّا: أي المشايخ أتبع! أأسير وراء هذا، أم أسير وراء ذاك؟ احترت كثيرًا وكانت حيرتي شديدة جدًّا، وحينما كنت أتقلب في هذه الحيرة الشديدة… إذا بخاطرٍ رحمانيٍّ من الله سبحانه وتعالى يخطر على قلبي ويهتف بي: “إن بداية هذه الطرق جميعها… ومنبع هذه الجداول كلها… وشمس هذه الكواكب السيارة… إنما هو القرآن الكريم فتوحيد القبلة الحقيقي إذًا لا يكون إلا في القرآن الكريم… فالقرآن هو أسمى مرشد… وأقدس أستاذ على الإطلاق… ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن واعتصمت به واستمددت منه…” (بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات، المكتوب الثامن والعشرون، الرسالة الثالثة، ص 430-431).