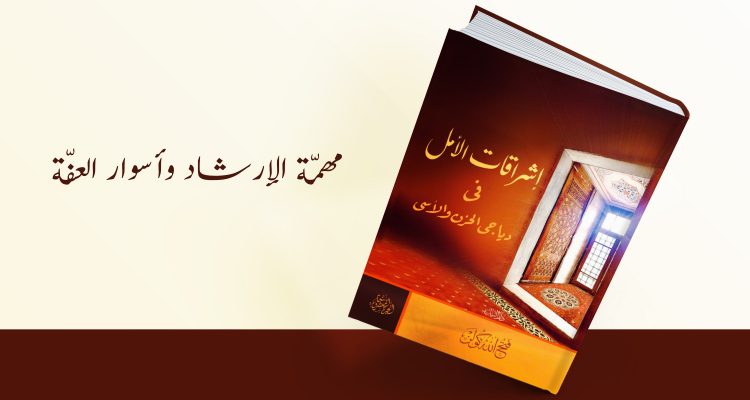سؤال: ماذا يعني مفهوم العفة التي يجب أن يتحلّى بها ممثّلو نهج النبوة؟
الجواب: أنفق جميع الأنبياء حياتَهم في سبيل تقديم الرسالات السماويّة إلى البشرية، ولم يتشوّفوا إلى أي أجرٍ من أحدٍ، وعاشوا حياتهم في تواضعٍ ومحو؛ تجنبوا الإسراف، ولزموا القناعة، وعاشوا في بساطةٍ وزهد، ومع أنّ بعضهم قد آتاه الله السلطنةَ والملكَ -مثل نبيّ الله سُليمان وأبيه داود عليهما السلام- إلا أنّهم لم يَدَعوا حياة التواضع، بلْ وجّهوا كلّ قوّتهم وإمكانيّاتهم في سبيل رفعِ رايةِ الدين الحقِّ، لم يسحرهم الـمُلكُ الذي آتاه الله لهم، ولم يَغْشَ أبصارَهم. أجل، لم ينلْ أحدٌ من عفّتهم وعصمتهم، مـمّا دفع الناس إلى الثقة بهم، وظلّوا طوال حياتهم أوفياء لخصال النبوة، ومِن ثمّ فلا بدّ للذين يسيرون في طريق النبوّة أن يُؤدُّوا هذا الطريق حقّه، وهذا لا يتأتّى إلا بالتحلّي بهذه الأوصاف الملازمة للأنبياء؛ أما مَن لم يتمكّن من التحلّي بها -دعْ عنك عدم أدائه لوظيفة الإرشاد والتبليغ- فمن المحتمل أن يسلك طريق الشيطان وإن كان مسلمًا.
لا يقتصر تشوّه السمعة على المخطِئ فحسب
وعلى ذلك فإن الذين يسعون في وظيفة الإرشاد والتبليغ قد يجلبون الخزيَ والعارَ إلى الهيئة التي ينتمون إليها باقترافهم الذنوب وارتكابهم الأخطاء الصغيرة التي تمسّ الصدقَ والعفّةَ لا سيما إن كانت هذه الهيئة تتبوّأ مكانًا عاليًا؛ لأن مثلَ هذه الهيئة مثلُ الجسدِ الواحد إذا أصابت النجاسةُ عضوًا منه اشمأزّت وتأثَّرَت منها سائرُ الأعضاء، ولذلك فلا يصحّ لِمَنْ تطايرت النجاسة إلى طرف ثوبه أن يقول: “لا ضير لأنها لم تمتدّ إلى وجهي ويدي وعيني”، وعلى نفس الشاكلة فليس من الصحيح أن ينتمي الشخص لهيئةٍ ما، ثم لا يتحكّم في عينه وأذنه ويده ولسانه، ولا يكتفي بالأذواق والملذات ضمن الدائرة المشروعة، ويظلّ يحوم حول الدائرة غير المشروعة ثم يقول: “ما أنا إلا مجرَّدُ كَعْبٍ، أو قدمٍ أو كوعٍ في هذا الجسد… ولقد ظننت أن النجاسة التي لطختني لن تلحق بالآخرين الذين يعملون في نفس دربي”!
ومن هنا فإن الوظيفة الملقاة على عاتق الذين يسعون في سبيل خدمة الحقّ هي أن يحذروا من تطايُرِ أو تناثُرِ النجاسة عليهم ويراعوا الدقة البالغة في هذا، وأن يحافظوا على نقائهم وطهرهم على الدوام، وألا يخرجوا عن دائرة العِفَّة في أي شأن من شؤونهم من مأكلٍ ومشرَبٍ وقيامٍ وقعود، ومع استخدام أعضائهم كلها من يدٍ ورِجْلٍ ولسانٍ وعينٍ، كما يجبُ على المرشد الحقيقيّ مبلِّغِ الحقِّ والحقيقة أن يظلّ وفيًّا لغايته المثلى، ثابتًا صامدًا، لديه الجرأة والشجاعة لأن يرفع يديه قائلًا: “اللهمّ إن كنتُ مددتُ نظري أو ألقيت سمعي إلى شيءٍ لا ترضاه فخذْ منِّي روحي”، وعليه كذلك ألا يسمح لنفسه بتلطيخ وجه الإسلام أو تدنيسه أبدًا؛ لأن الأنبياء وهم الممثّلون الحقيقيّون لطريق الإرشاد والتبليغ لم يسمحوا لذرّة واحدة من الطين أن تُلامس أذيالَـهم وإن كانت من قبيل عموم البلوى، ولم يسمحوا لأحدٍ بأن ينال من شرفهم ألبتة.
“اللّهم لا تُخْزِ أصدقائي بي، ولا تُخزني بأصدقائي!”
إن أيّ إنسانٍ لا يُراعي هذا القدرَ من الحساسية اللازمة فقد اعتدى على حقّ الآخرين، وألحَقَ بهم الضررَ، ومن ثمّ فإن لم يسامح هذا الشخصَ كلُّ من ينتمي إلى تلك الهيئة فدخولُه الجنةَ أمرٌ مشكوكٌ فيه، وهذا يدعونا إلى أن ندعو الله ونتضرّع إليه دائمًا قائلين: “اللّهم لا تُخْزِ أصدقائي بي، ولا تُخزني بأصدقائي”.
ومع الأسف فإن بعضًا ممن يوصفون بأنهم مسلمون اليوم قد اجترحوا من السيّئاتِ ما يشدهُنا ويجعلُنا نتلوّى أَلَـمـًا ونحنُ نقول: لَيْتَهم لم يتبعوا هوى أنفسهم ولم يرتكبوا هذه السيئات! ليتهم ماتوا وأُحْيوا مرّات ومرّات وما تخلّوا عن عفّتهم وصدقهم، ولم يسلكوا طريقَ هذه اللوثيات!
عفّة الحديث
من جانبٍ آخر فلا بدّ لمن يتبوّأُ مقامًا معيّنًا -وإن كان هذا أمرًا لا يسري علينا نحن البسطاء- أن يفكّر مليًّا قبل أن ينبِس ببِنتِ شفةٍ من أجل الذين يتبعونه؛ لأن منزلتهم تقتضي منهم أن يفكروا مليًّا في كلّ كلمة قبل أن تخرجَ من أفواههم، ثم يقدّمونها لمخاطبيهم متناسقة على شكل مصاريع من الشِّعْرِ؛ لأنَّ الكلامَ الذي يُقالُ دونَ مراعاة لما يستوعبه المخاطبون أو حسابٍ لنوعية ردّ الفعل الذي قد تنجم عنه من شأنه أن يَشُقّ جروحًا غائرةً وكأنّه الحربةُ في صدور المخاطبين، ومداواة هذه الجروح صعبةٌ وعسيرةٌ في كثير من الأحيان، بل إن الكلام الذي يُقال دون تفكُّرٍ ورويّةٍ قد يؤدِّي إلى الخلاف والافتراق؛ فربَّ كلمة تُشعِلُ فتيلَ الحرب بين المتخاصمين، وربّ جملة تتسبّبُ في هلاك أمّة، وربّ حربٍ أدلَعَتْ نيرانَها بنتُ شفة.
قِيَمُنا التي هي العناصر الأساسية لِجَنَّتِنا المفقودة
العفة والعصمة والصدق والوفاء هي قيمُنا التي فقدناها -مع الأسف-، وتلك القيمُ هي العناصرُ الأساسية التي تقوم عليها جَنَّتُنا المفقودةُ، فلو أنكم تريدون إقامة جنّةٍ من جديد فعليكم أن تهيِّئوا هذه المستلزمات الأساسية لهذه الجنة، ولقد وضع لنا الأنبياءُ العظام صلوات الله وسلامه عليهم رسمًا هندسيًّا لهذا البناء الحضاريّ، ثم جاء مِنْ بعدِهم المجتهدون والمجدّدون والأولياءُ والأصفياءُ، وأنشؤوا صورًا مختلفة لهذا الرسم المعماري استجابةً لدواعي التجديد التي يقتضيها العصر، وكأنهم يقدِّمون للمخاطبين رسالةً مفادها: “وفِّقوا بين سلوككم وأعمالكم وبين الرسوم والمناهج التي وضعناها لكم؛ لأن المفهوم الحقيقيّ للعبودية لا يتأتى إلا باتِّباع هذا المنهج”.
وما أجمل ما قاله الشاعر “محمد عاكف” في هذا الصدد:
“أينَ الإسلام؟ بل أين الإنسانية؟ لقد افتقدناهما بالتمام
فإذا كانت الغاية خداع العالم فلا مخدوع والسلام
وكم من مسلم حقيقي عرفتُ! إلا أنهم في القبر يرقدون تحتَ الركام
لستُ أدري أين أجِدُ الإسلام! كأنّه في السماوات العُلى فوقَ الغمام!”
لا أريد أنْ أُقنّط أحدًا بقولي هذا، فينبغي للإنسان أن يُوصد أبواب اليأس ولا ييأس أبدًا، لكن يجب عليه إلى جانب هذا ألا يتوانى لحظةً واحدةً في مراقبة نفسه ومحاسبتها؛ لأن منْ يُحاسبُ نفسه في الدنيا يَسلَمُ في الآخرة، فها هو الإنسان العظيم الذي قال عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم “لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ”[1]، يقضي حياته كلَّها محاسبًا نفسَه ويسائلها وهو الذي قال: “حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا”[2].
ولذا ينبغي للإنسان أن يُنظِّمَ حياته وفقًا لمنطقٍ رياضيّ جادّ؛ لأنه بينما يمكن تكثِيرُ الحسنات بحيث تصبحُ الآحادُ عشرات، والعشراتُ مئات، والمئاتُ آلافًا إلى ما لا نهاية؛ فقد يتسبب خطأٌ بسيطٌ في أن يضيع كلُّ شيءٍ هباءً منثورًا، وبتعبير آخر؛ فالإنسان إذا عاش حياته بالمحاسبة والمراقبة حقًّا استطاع أنْ يُكثِّر القليلَ، وإلا فإنّ أخطاءً طفيفةً قد تذهبُ بحياته تمامًا، ولهذا فإن فضيلة الأستاذ بديع الزمان بينما ينثر الضياء على أرواحنا بحِكَمِه يحذِّرنا قائلًا: “فاحذر! وخفِّف الوطء، وخَفْ من الغَرق، ولا تُهلِك نفسك بأكلةٍ أو كلمةٍ أو لمعةٍ أو إشارةٍ أو بَقْلَةٍ أو قُبلةٍ، فتَذهب عنك لطائفُك العظيمة التي شأنُها أن تستوعب العالمين”[3].
وقد قال مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم: “إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ”[4]، لأن العين تنظر إلى الشيء أحيانًا، فتخطو القدم صوبه مباشرةً، ثم تمتدّ إليه اليد، وفي النهاية تُرتكَبُ أكثر الأفعال البوهيمية خِزيًا وعارًا، فإن كان مُرْتَكِبُ ذلك الفعل منتميًا إلى زمرةٍ معيّنة فقد يُعزى إلى أفرادِ تلك الزمرة قاطبةً كلُّ ما ارتكبه من جُرمٍ ومنكرٍ، وإن وضعْنا في حسباننا أنَّ هناك من يَتحَيّنُ فرصة وقوع غيره في مثل هذه العثرات في يومنا الحاضر كي يتسنّى له اتّهام طائفةٍ عظيمة بهذا الفعل… إن وضعنا ذلك في حسباننا تأكّدت لنا ضرورةُ الحذر الشديد والحيطة في هذا الصدد.
صيانة الأمانة
إذًا بالله عليكم! هلمَّ بنا نبني أسوارًا خلفَ أسوار، وحصونًا إثر حصونٍ حتى لا تُرتكب مثل هذه النوعية من السفاهات والوقاحات التي تُخجِلُ هيئةً بأكملها، وينبغي لنا ألّا نكتفِي بهذا فحسب، بل نوصد أبوابًا خلف أبوابٍ، ونقول لأعوان الشيطان إذا جاؤوا: “لا تُتْعِبُوا أنْفُسَكم هباءً، فالأبوابُ موصدةٌ دونكم”، وبهذه الطريقة نَفِي -آمنين مطمئنّين بإذن الله- بوظيفة الإرشاد والتبليغ حيث نكون.
حريّ بنا ألا نتبع هوى أنفسنا فنحطّم الدنيا التي منَّ الله بها علينا بما فيها من أَوجُهِ الجمال والخير، والحقيقة أن الحق تعالى وهب القلوب المؤمنة التي قد لا تعرف بعضها البعض كثيرًا من الإمكانات والتجلّيات التي لم تتيسّر ولو حتى للقوى العظمى، بل ولا للدول الكبيرة، ولو أننا تفرّغنا تمامًا لحَمْدِ الله على ما وهَبَنا من نِعَمٍ، وملأنا وقتنا كلّه بتردادِ كلمة “الحمد لله” دون أيّ انشغالٍ آخر عنها؛ فلن نوفي النعمة حقها، والشاعر “سعدي الشيرازي”[5] يقول: “لا بدّ من الشكر مرتين عند كُلِّ نَفَسٍ”، أما الفضل الذي نحن بصدده فإنه شرف ومنَّةٌ تفوق كلَّ نَفَسٍ.
والحاصل أن الِحمْلَ ثقيلٌ، والأمانة مقدّسةٌ جدًّا، لا تستطيعون الوفاء بها حتى وإنْ حملتموها محفوفة بفريق من الحراسة المشدّدة، لأنها أمانة الله، أمانة رسول الله، أمانة المجددين والسلف الصالح، إذًا بالله عليكم هلمَّ بنا نقتَفِ آثارهم، فلا نخذلَ بني جلدتنا في هذا الشأن! ولنَعِشْ بعفّتنا، ولندفنْ أهواءَنا، بل لا نكتفِ بدفنها، لنضعْ صخورًا عليها، ولنحافظْ بهذا على إيماننا، فلا نخسر آخرتنا، حريٌّ بنا ألا نكون مثل من يملؤون جيوبهم وأكياسهم وحقائبهم حين تلوح لهم الفرصة، وألا ننخدع نحن أيضًا كما انخدع الظّانُّون أنَّ الدينا هي كلُّ شيء، وألَّا نسير على خُطى السائرين في إثر قارون، وألا نَتَفرعَنَ كالمُتَفَرعِنِين، بل على العكس ينبغي لنا أن نتأسّى بسيّد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ونعضّ على سنّتهم بالنواجذ.
[1] سنن الترمذي، المناقب، 17.
[2] سنن الترمذي، القيامة، 25.
[3] بديع الزمان سعيد النورسي: اللمعات، اللمعة السابعة عشرة، المذكرة الرابعة عشرة، ص 187.
[4] الطبراني: المعجم الكبير، 10/173.
[5]سعدي الشيرازي: هو الشيخ مصلح الدين، من شعراء الصوفية الكبار، ولد في مدينة “شيراز”، وكان من مريدي الشيخ عبد القادر الكيلاني، قضى ثلاثين سنة من عمره في الأسفار، ونظم الشعر، من أشهر كتبه كتاب “كُلستان”.